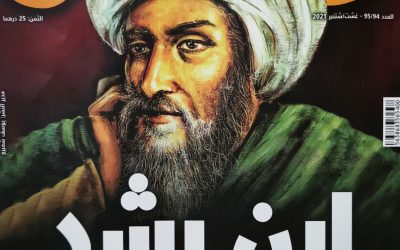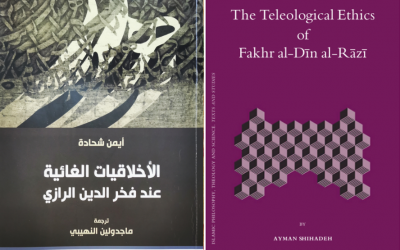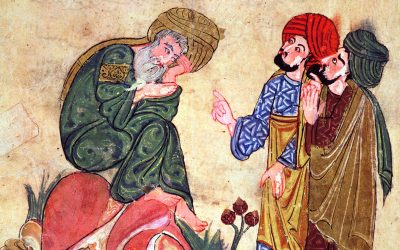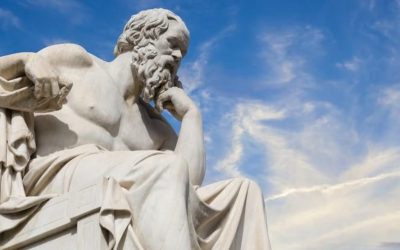![]()
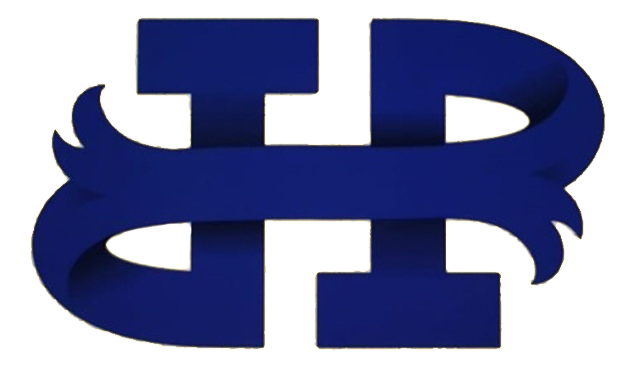
عن تمثيلات واستعارات ابن رشد

قراءة نقدية في كتاب فؤاد بن أحمد، تمثيلات واستعارات ابن رشد: من منطق البرهان إلى منطق الخطابة. بيروت-الرباط-الجزائر: منشورات ضفاف-دار الأمان-منشورات الاختلاف، 2012.
محمد الولي[1]
كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ سايس – فاس
1. حول المعنى الحرفي. حينما نتوخى التعبير عن شيء ما، وليكن ”الحب“، فإن السياق يضعنا أمام اختيارين للتعبير عن هذا الشيء ووصفه. إننا قد نقول، حينما نختار العبارة الحرفية: ”الحب“، أو ما يرادفه من قبيل ”الغرام“ أو ”العشق“ أو ”الهيام“… إلخ، حيث اللفظة حرفية الدلالة، ولا يتطلب السياق أية عملية تأويلية حينما ترد في سياق مثل: ”الحب، أو الغرام أو العشق أو الهيام، قد ينتهي بالزواج.“
2. حول المعنى الاستعاري. إلا أننا قد نستخدم، بدل العبارة الحرفية، عبارة مواربة، فنقول مثلاً: ”الحب مغامرة“ أو ”صفقة“ أو ”مشروع“ أو ”مقامرة“ أو ”حمى“ أو ”عاصفة“ أو ”مرض“ أو ”جنون“ أو ”زلزال“…إلخ. وذلك تبعاً للمعنى الذي يراد إبرازه في الحب والمعاني الأخرى التي يراد إخفاؤها. وبما أننا نفترض تشابهاً بين المعنيين، فإننا ندعو هذا المقوم ”استعارة“.
3. حول المعنى التمثيلي. يمكن لهذه المشابهة أن لا تتحقق بين شيئين اثنين، بل بين نسبتين اثنتين. ”التماثل هو تساوي نسبتين،“ حسب عبارة أرسطو.[2] مثال ذلك قول بيركليس في رثاء شباب أثينا: ”لقد اختفى من المدينة الشبابُ الذين قضوا في الحرب، كما لو أن السنة فقدت ربيعها.“[3] فالمشابهة هنا تنصبُّ على نسبتين هما، نسبة الشباب إلى الحاضرة، ونسبة الربيع إلى السنة. هذا الضرب من الاستعارة هو الذي يُدعى التمثيل أو المماثلة أو التناسب analogie.
4. حول التمثيل الرياضي. هذا المقوم المدعو تمثيلاً، أي أنالُوجيَا، هو نظير التمثيل في الرياضيات، وهو يصاغ بالشكل التالي. إن 4:8=5:10. وفي الوقت الذي نجد هذه العلاقة الأخيرة قطعية أو يقينية، فإن علاقة التمثيل في العبارتين السابقتين محتملتين فقط وليستا يقينيتين. وهذه تستعمل كثيراً في الخطابة والشعر وفي الفلسفة، وكل ما يند عن الدراسة التجريبية والمنطقية. كما نجد لها استعمالاً ما في المجال العلمي، كأن نقول إن علاقة الأسماك بالزعانف مثل علاقة الطيور بالأجنحة.
5. وقد تدل كلمة أنَالُوجيَا على المشابهة عامة لكي تشمل التشبيه والاستعارة والتمثيل والمثل proverbe والأمثولة allégorie والرمز. إنها تدرج كلها في دائرة علاقات المشابهة، التي تتعارض مع دائرة العلاقات الكنائية التي تقوم على التجاور.
هذا الطريقة التعبيرية الاستعارية والتمثيلية طالما صرخ العلماء والفلاسفة ملء حناجرهم بأنها لا تناسب إلا الشعر والخطابة، أما العلم—قل أيضاً الفلسفة—فإنه متحفز دائماً لصد أي تسرب لمثل هذه الأدوات إلى مجالاته. يقول پْيِيرْ گيرُو: ”إن سنن التخاطب العلمي مجبر على حماية السنن من أي عدوى تمثيلية analogique.“[4]
إلا أن هذا الموقف من العبارات التمثيلية أو الاستعارية، الذي هيمن لقرون في خطاب العلماء والفلاسفة، قد بدأ يفقد كل بريقه في القرن العشرين. فقد تم إنصاف التمثيل والاستعارة وكل العبارات القائمة على التشبيه التي كانت تعتبر من معدن الشعر. لقد تم إنصافها واعتبرت الأداة التي لا يتوسل بها الشعراء وحسب، بل هي الأداة التي تُنجد اللغة المفهومية المهيأة للإحاطة بالواقع وتحليله حينما تتراجع خائبة إثر اصطدامها بوقائع لا تسلم مفاتيحها لهذه المفاهيم. لهذا يقول أورتِيگا إيْ جَاسيتْ في العشرينات من القرن الماضي في مقالة ذائعة في إسبانيا والتي لا يشار إليها في الدوائر الفرنسية: ”حينما يعترض كاتب ما على استعمال الاستعارة في الفلسفة فإنه يعبِّرُ بكلُّ بساطة عن جهل بما هي الفلسفة وبما هي الاستعارة. لا يمكن لأي فيلسوف أن يدعو إلى هذا المنع […] الاستعارة أداةٌ ذهنية نتمكن بواسطتها من الإحاطة بما هو أبعد عن كفاءتنا المفهومية. فبواسطة ما هو أقرب وما نسيطر عليه نتمكن من الاتصال الذهني بما هو بعيد وفالت. الاستعارة إضافةٌ إلى ذراعنا الذهني، وهي تمثِّل في المنطق قصبة الصيد أو البندقية.“[5]
وإذا كانت الاستعارة مخصوصة بسيادة يعترف بها الجميع في مجالات الفنون اللفظية واللغة الطبيعية وفي مجالات العلوم الإنسانية، فإن هناك من يذهب إلى أن العلوم التجريبية تستنجد هي نفسها بالاستعارة.
كلمة أخيرة في هذا التقديم. من اللغة المتداولة. تأملوا كلمات: ”شرف“ و”سقط“ و”انهار“ و”تفوق“ و”ضل“ و”بلغ“… إلخ، التي تعني في الأصل ”ارتفع“ و”هوى“ و”تهدم“ و”علا“ و”خرج“ و”تاه“ و”وصل إلى غاية ما.“ إذن، هذه الكلمات هي في الأصل استعارات وقد أصبحت اليوم منطفئة. وهذا الضرب من الاستعارات شائع في لغة التداول اليومي.
وحينما يعمد الفلاسفة، أو غير الفلاسفة، إلى استعمال الاستعارة للتعبير عن المعاني التي تستعصي على اللغة المتداولة أو العلمية، فإنهم يطبقون ما هو من طبائع اللغة المتجذرة التي لا يمكن لأحد تخطيها. وذلك ليس لأن المعاني المطلوبة بالاحتواء تنتمي إلى العوالم المجردة والنفسية والغيبية وحسب، بل إن العوالم المادية هي نفسها لا تستغني عن الاستعارة إذا أرادت أن تقدم صورة جديدة عن العالم الذي يراد وصفه.
بطبيعة الحال، ونحن نقترب من كتاب تمثيلات واستعارات ابن رشد، للدارس فؤاد بن أحمد، الذي يخوض في مجمله في أمور فلسفية وميتافيزيقية ومدنية، فإن هناك اتفاقاً على أن وجود مجالات لا تنصاع للبحث العلمي الدقيق، المنطقي أو التجريبي، يتطلب الاستنجاد بالتمثيل والاستعارة. تذكروا جيداً كيف يستعين علماء الذهن البشري بمفاهيم الإعلاميات. والعكس صحيح أيضاً استعانة المفاهيم الحاسوبية بمفاهيم الذهن البشري. في هذا الإطار ينبغي وضع كتاب الزميل الباحث فؤاد بن أحمد تمثيلات واستعارات ابن رشد: من منطق البرهان إلى منطق الخطابة. إن الأداة الأساسية للحديث عن كل ما يتصل بالحياة الدينية إنما هو الاستعارة والتمثيل وهو جنس من الاستعارة. وإذا كان الفحص الدقيق لمجمل ما ورد في الكتاب لا يتحمله هذا العرض المختصر، فإننا سنتوقف عند بعض الأفكار الواردة فيه.
يبدأ الكتاب بطرح مسألة القيمة العلمية للتمثيل والاستعارة. إن الأمر يتعلق بنقاش عمر قروناً. ”تذهب دراسات إبستملوجية، ومنطقية في العصر الحديث، إلى اعتبار التمثيل وجهاً من وجوه الاعوجاج في التفكير، ومن أساليب الغلط، أو على الأقل لا يمكن التعويل عليه بصورة أساسية، كما لا يمكن الثقة في كل منتوجاته، فإن دراسات أخرى انتهت إلى نتائج مخالفة تماماً، بحيث تثبت له أدواراً في العمليات المفهومية والاستدلالية لا يمكن المنازعة فيها، بل من الدراسات ما ذهب إلى حد اعتباره الآلية الأكثر خصوبة ومرونة وانفتاحاً، من قبيل دراسات إيمَانوِيل سَاندرْ ومُوريسْ دورُولْ وجُورجْ لايكُوفْ ورُونِي لُوكرِيكْ ومِيشِيلْ سِيرْ وآخرين.“[6]
وعلى الرغم من أن بعضهم يتمسك بالاعتدال بصدد هذا الأمر، إلا أنهم يستعينون بهرم يعتلي قمته البرهان (أو السلجسموس) ويليه في الترتيب وسط الهرم الاستقراء، في حين أن التمثيل يحتل المرتبة الأدنى في هذا الهرم، بل يضعونه في مرتبة أدنى من الاستقراء. وعلى كل حال فلا نستغرب من الفلاسفة والعلماء التجريبيين والعقلانيين اتخاذ هذا الموقف الذي يعتبر الاستعارة والتمثيل عائقاً علمياً في وجه بناء معرفة علمية حقيقية؛ فحيث لا يكون الحساب ولا التجربة ممكنين في الخطاب العلمي فإننا نحيل كل ما عداهما إلى سلة الأوهام والآراء النزقة والشعر والخيال. ولكن فلنتذكر أفلاطون، الذي بنى صرحه الفلسفي على المعاداة التامة للتمثيل، إلا أن مؤلفاته الفلسفية كثيراً ما استعانت بالتمثيل والاستعارة. فلنتذكر أمثولة الكهف وكل التفاصيل المتعلقة به. بطبيعة الحال هذه استعارة أو تمثيل عظيم أو أليغوريا ممتعة. وقد بالغ أفلاطون في الاستعانة بمثل هذه الاستعارات والتمثيلات بحيث أن أحد الباحثين خصص له بحثاً مستفيضاً سماه استعارات أفلاطون.[7]
ومن المفارقات العجيبة ولكن المتكررة على امتداد أزيد من عشرين قرناً، ما أثبته فؤاد بن أحمد بصدد الراحل محمد عابد الجابري، الذي لم يكتف بتبني موقف تشريف البرهان على حساب الاستعارة والتمثيل، بل أقام على هذه الأرضية الرملية تمييزاً بين فلسفة ابن سينا المشرقية وفلسفة ابن رشد المغربية باعتبار الأول يستخدم في حجاجاته التمثيل في حين أن الثاني يستعمل البرهان. والواقع أن هذه النظرة من قبل الجابري فيها الكثير من الاستعلاء. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هناك من ساير الجابري في هذا الحكم المجافي للنزاهة العلمية والاستقراء المتقصي، فإن فؤاد بن أحمد قد يكون مصيباً كبد الحقيقة حينما ذهب إلى أن ”إغفال الأستاذين الجابري والعروي للوظائف التي قامت بها آليتا التمثيل والاستعارة في فلسفة ابن رشد، وكذا تصنيفهما له ضمن التيار المناهض للتمثيل والاستقراء، إنما هما أمران يعودان إلى عدد من الأسباب التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بنصوصه، وبالمسائل النظرية التي كانت تشغله في هذه النصوص، ذلك أن من شأن العودة إلى هذه الأخيرة أن تكشف عن أوجه تسخيره للتمثيل وللاستعارة.“[8]
كثيرون هم الباحثون الغربيون الذين يؤكدون أنه لا مجال لتفادي استعمال الاستعارة حتى في المجالات العلمية الدقيقة ناهيك عن الفلسفة واللاهوت. يقول جَانْ مُولِينُو: ”إن الاستعارة والنموذج التمثيلي هما من الأدوات المشتركة بين الفكر المنطقي والفكر المتوحش، وبين اللغة الحَرْفية واللغة المجازية.“[9]
وعلى هذا الأساس فقد كان موقف فؤاد بن أحمد سديداً وهو يتطابق تماماً مع موقف جَانْ مُولِينُو من التمثيل والاستعارة. فلنستعرض قوله: ”ليس الحديث عن التمثيل في فلسفة ابن رشد تنقيصاً من قيمة هذا البناء الفلسفي على اعتبار أن هذا التنقيص هو نفسه ناتج عن نظرة تقرن التمثيل بأنماط من الفكر ”الخرافية“ أو ”البدائية“ أو ”الطفولية الساذجة“، وتعتبره تراجعاً عما أنجزته ”العقلانية اليونانية“ […] ألسنا نكون قريبين من المطلوب إذا قلنا إن آليات التمثيل والاستعارة والاستقراء الناقص كانت تؤدي […] مهمات التعليم ومهمات الكشف والبناء الافتراضي، كما كانت جسراً بينها؟“[10]
والواقع أن الاستعارة، والتمثيل جنس منها، ليست مقصورة على الشعر والخطابة ولغة التداول اليومي، بل إن نفوذها يتخطى بكثير هذه المجالات، مع العلم أن بعض الباحثين والفلاسفة لا يكفون عن الإشارة بشكل صريح أم ضمني إلى تجريد الفنون من شرف الحديث عن الواقع. إنهم يقيمون أسواراً زائفة بين دوائر النشاط الإنساني. وقد تكون عبارة مِيرْسِيَا إلْيَادْ التالية أحسن رد على من يطعنون في حقوق التمثيل والاستعارة للحديث عن الواقع: ”إن الصور [ونحن نقول الاستعارات] هي من حيث بنيتها نفسُها متعددةُ القيم. فإذا كان الذهن يستعمل الصور لأجل الإمساك بالواقع النهائي للأشياء، فلأن الأشياء بالضبط تظهر بطريقة متناقضة، وتبعاً لذلك يتعذر التعبير عنها بالمفاهيم[11] […] إن الصورة باعتبارها حزمة من الدلالات، هي الحائزة للحقيقة، وليس لواحدة من دلالتها ولا لواحد من مستوياتها المرجعية العديدة. إن ترجمة صورة ما إلى مصطلحات ملموسة، واختزالها في واحد من مستوياتها المرجعية، هو أسوأ من بترها، إننا بذلك نعدمها، ونبطلها باعتبارها أداة معرفة.“[12]
نماذج من استعارات وتمثيلات ابن رشد
- الاستعارة والتمثيل بين الإثبات والإنكار
يقول فؤاد ابن أحمد: ”ينتقد ابن رشد من يعتقد بأن لله وجوداً مادياً يشبه وجود مخلوقاته، على غرار ما فعل كثير من المتكلمين، مشياً وراء ظاهر القرآن، حيث آمنوا بأن لله جسداً ويداً وعيناً وغيرها من الجوارح.“ ويؤكد ابن رشد هذا بقوله: ”أما الفرقة التي تُدعَى بالحشوية فإنهم قالوا إن طريقة معرفة وجود الله تعالى هو السمع لا العقل […] وهذه الفرقة الضالة، الظاهر من أمرها أنها مقصرة عن مقصود الشارع في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى معرفة وجود الله تعالى. وذلك يظهر من غير ما آية من كتاب الله تعالى أنه دعا الناس إلى التصديق بوجود الباري سبحانه بأدلة عقلية منصوص عليها.“[13] ويعلق بن أحمد على هذا الكلام والوصف للحشوية بقوله: ”ويمكن أن نستخلص عناصر الموقف الحشوي كما يفهم من النص السابق:
. السمع وحده طريق إلى الاعتقاد، وهذا لا مدخل فيه للعقل وأدلته؛
. التجسيم والتشبيه، أي تشبيه صفات المخلوقات والأشياء المادية الجسيمة ونقلها إلى الله نقلاً تحصل معه المطابقة“[14]
الواضح من كلام ابن رشد أن هذه الحشوية تؤمن بالقراءة الحرفية للقرآن الكريم. ولهذا فهي لا تنفي الصفات الجسدية والمادية عن الخالق. إلا أن وصف بن أحمد يشكو من بعض الاضطراب، فهو متردد بين وصف الحشوية بالحرفية ووصفها بالتأويلية التي يتم من خلالها نفي كل الصفات المادية عن الخالق. ففي الوقت الذي يقول: ”فبعد أن وصف قراءه الحشوية للقرآن و”مطابقتهم“ بين الإله والإنسان، وهو الأمر الذي يعني أنهم يلتزمون بالقراءة الحرفية، يعود لكي يؤكد أنه ”لا تخلو أطروحة هذه الفرقة من بعض الأفكار المتصلة بموضوع الاستعارة والتمثيل. فقد استعارت هذه الفرقة خصائص الإنسان بما هو حيوان لتلحقها بالإله.“[15]
التسليم بوجود الاستعارة والتمثيل يعني نفي الصفات التجسيدية والإنسانية عن الخالق. الاستعارية والتمثيل ينتقلان من المعاني الأولى إلى الثانية لأجل عقلنة النص القرآني. لهذا يمكن أن نعتبر هذه القراءة استعارية وتمثيلية. وهذا يتنافى مع القراءة الحرفية التي هي أقرب إلى أذهان العوام. بهذا نفهم كلام رشيد الخيون حينما يقول: ”ومع تأثر المعتزلة بالفرق والفلسفات الأخرى، لكنهم استخدموا طريقتهم الخاصة في التنزيه، بعد أن وصل الأمر ببعض المجسمة والمشبهة إلى تخيل الله على هيئة إنسان أو هو معبود إنساني، وفي هذه الآراء ما يؤدي للعودة إلى الآلهة المنحوتة على هيئة إنسان أو حيوان، كما كان عند الوثنية قبل الإسلام.“[16] ورغم خطورة المسألة، فإن المعتزلة استخدموا حرية الرأي وسلطة الدليل العقلي في مناقشاتهم مع معارضيهم، حيث ”أول الآيات القرآنية الدالة على تشخيص أو تجسيم تأويلاً عقلياً ينفي دلالاتها المادية.“[17]
والواقع أن المعتزلة والفلاسفة وكل العقلانيين نزاعون إلى قراءة القرآن قراءة تمثيلية استعارية، والفرق المحافظة نزاعة إلى القراءة الحرفية التي لا تعترف بالتأويل الاستعاري والتمثيلي. والظاهر أن الحشوية تتبني القراءة الحرفية خلافاً للمعتزلة والفلاسفة. ولهذا كان المعتزلة هم مهندسو البلاغة العربية المجازية والاستعارية والتمثيلية.
- استعارة وتمثيلات غذائية
أ. لا نستغرب أن يعمد فيلسوف إلى استعارة العسل للفلسفة. إن عدو الفلسفة قد يعترض على هذا التمثيل، وقد يختار السم. إلا أن ابن رشد قد حجز للسم دوراً تمثيلياً واستعارياً غير ما يمكن أن يفعله خصوم الفلسفة. فلنبدأ بالعسل. إن مجرد استحضار العسل يثير في ذهن المتلقي مجموعة من الإيحاءات الإيجابية، ويدفع إلى الظل كل الإيحاءات السلبية. هذه الإيحات الإيجابية هي التي جعلت ابن رشد يعتمده تمثيلا للفلسفة. وعلى الرغم من أن الفلسفة ليست مفيدة دائماً ولكل الناس، فإن ابن رشد يستدرك لكي يستعرض أضرار العسل. هذا التأرجح لكل من التمثيل أو الاستعارة والمستعار له لمما حفز على استعمال هذه الاستعارة. إلا أن ابن رشد يؤكد أن العسل هو مفيد بالذات، و الأذى الذي يمكن أن ينالنا منه فهو عرض وكذلك الفلسفة، فهي مفيدة بالأصل أما أضرارها فهي عرضية لا يمكن أن ترقى إلى الطعن في التفلسف. كما أن العسل لا يمكن الطعن في فوائده، فقط لأن هناك أعراضاً سلبية له.
ولقد ساق ابن رشد شروحاً مستفيضة لتبرير هذا التمثيل أو الاستعارة. والظاهر أن من شأن تقصي هذه الشروح التفسيرية والمبرِّرة إضعاف الاستعارة. بل إن شيوعها بين العوام واستعمالها في سابقات شبيهة من شأنه أن يورث هذا التمثيل نوعاً من الابتذال وبالتالي الضعف الشعري والإقناعي. ويتعزز هذا الرأي إذا عرفنا أن آخرين غير ابن رشد قد تداولوا استعمال العسل استعارة في سياقات شبيهة. لا بد في التمثيل من جذوة تُذكيه. إن ما يدعى شعرياً في التمثيل من شأنه تقويته على المستوى الحجاجي والإقناعي.
ومن الأغذية المستعملة للتمثيل للفلسفة الماء. وقد عالجه ابن رشد بالطريقة نفسها التي عالج بها العسل، أي بالتمييز بين ما هو ذاتي وما هو عرضي. فإذا كان الذاتي مفيداً وكان العرض مؤذياً لا ينبغي منع الاستفادة من الخصائص الذاتية لهذا التمثيل في الحالين. ومع هذا، فإنني مرة أخرى أجد في هذا التمثيل الابتذال نفسه. كأن ابن رشد يتناول الشبيه أو الاستعارة مما يكون في متناول اليد. واللافت أن بن أحمد قد لاحظ ضعفاً في هذا التمثيل، وفسر ذلك بقوله: ”غير أنه يصعب علينا أن نوافق ابن رشد على هذا التمثيل، لأن المثال والمطلوب لا يتنميان إلى مجال مشترك بالنسبة لجميع الناس، فما هو من باب الضرورة غير ما هو من باب الأفضل. إن الناس قد يعيشون بدون حكمة، لكن حياتهم ستتوقف متى توقفوا عن شرب الماء، فالعطش الفلسفي لا يقتل الناس، كما يفعل الماء. ربما كانت الفلسفة كالماء بالنسبة لمن هو أهل لها فقط. لكن تمثيل ابن رشد قد يحمل بعض المعاني القدحية غير المعلنة في حق من لا يمارس النظر العقلي فكما أن العطش يقتل بالذات، فكذلك الحرمان من الفلسفة بالنسبة لأهلها قد يجعل هذا في حكم الأموات، أو ”إنساناً باشتراك الاسم“، من هنا تغدو الفلسفة، كالماء في نظر ابن رشد، أعني حاجة حيوية تتوقف عليها حياة الإنسان.“[18]
ومع هذا فإن طرفي التمثيل هما بالضرورة ينتميان إلى جنسين مختلفين. إذ القرب بين الطرفين يضعفه، ويمكن أن ينتهي لكي يصبح مقارنة. ومما يحمل دلالة أن يصنف شايم بيرلمان المقارنة ضمن الحجج شبه المنطقية، والتمثيل ضمن الحجج التي تبنين الواقع؛ وبين الإثنين الحجج المستندة على بنية الواقع. التمثيل هو المقوم ذو الأرومة الإبداعية العظيمة. وبهذا وصفه أفلاطون ”إن التماثل analogie هو الأجمل من بين كل العلاقات بين الأشياء.“[19] ولم تكن هذه العلاقة هي الأجمل إلا بسبب ”الجمع بين أعناق المتنافرات في ربقة واحدة،“ حسب عبارات عبد القاهر الجرجاني. ولهذا يقول أيضاً سْكْروتَانْ: ”التمثيل قنطرة تمتد فوق الحدود التي لا يتم إلغاؤها مع ذلك، إذ إن التناسب العقلي لا يبطل الفوارق.“[20]ويقول شايْمْ بِيرلْمَانْ: ”ومن جهةٍ أخرى فلكي يقوم التناسب، فإن الموضوع والشبيه ينبغي أن ينتسبا إلى مجالين مختلفين، فحينما تكون العلاقتان منتسبتين إلى المجال نفسه، ويمكن أن تندرجا تحت نفس البنية المشتركة، فإن التناسب يترك المكان للاستدلال بالشاهد أو المثال، إن الموضوع والشبيه يمثلان حالتين للقاعدة نفسها“[21]
3. يقدم ابن رشد تمثيلاً آخر هو خبز البُرّ الذي هو بصفاته الذاتية أجود أنواع الخبز كما أنه من أجود الأغذية. إلا أن هذا النوع من الخبز يناسب بعض الأفراد ويؤذي نوعاً آخر. إلا أن أذى هذا الخبز هو مؤذ بصفاته العرضية، بينما الأصل هو الفائدة. كذلك الشريعة هي مناسبة وملائمة للمؤهلين دينيا والموصوفين بالتقوى. والذين لا تفيد معهم الشريعة فهم شواذ. ولهذا فلا يمكن الطعن في الشريعة لأنها لا تفيد الشواذ. يكاد يكون هذا المثال تكراراً للمثالين السابقين، هناك غذاء مفيد بالطبيعة ومؤذ بالعرض. كذلك الشريعة مفيدة بالطبيعة ومؤذية لمن يعدم الحوافز الإيمانية.
ومع هذا فلا بد من تعليق بسيط. تكاد تكون كل هذه الأمثال مستقاة من الثقافة المتداولة. فكل الناس على علم بطبائع هذه المواد، بل وكلهم يمكنهم أن يستعملوها بهذا المعنى الذي قصده ابن رشد. بمعنى أن البذرة الابتكارية ضعيفة في هذه التمثيلات.
يمكن أن أقدم مثالا لمعنى التمثيل الابتكاري من نظرية التواصل المعاصرة. تذهب النظرية التقليدية إلى اتخاذ النموذج التلغرافي لتحليل عملية التواصل. فإذا كان التواصل في رأيها عبارة عن نقل أفكار من شخص إلى آخر بحيث أن هذه الأفكار تخرج من فمه قطعةً قطعةً، مثل حبات المسبحة، فترسل عبر خط تواصلي هو الهواء أو معادل آخر كالورق والسبورة، فيتلقاها المخاطب بدوره قطعة قطعةً. هذه العملية التواصلية تقوم على قرار إرادي لطرفي عملية التواصل. وهكذا دواليك. النموذج التلغرافي يقوم إذن على باث ونص وقناة ومتلق أو مخاطب. فالفكرة تخرج في هذا التصور من ذهن الباث وتنقل عبر خط تواصلي فتُحشَر في ذهن المتلقي.
وقد تعرض هذا التمثيل التلغرافي لنقد صارم من منظري مدرسة بَالُو آلتُو الأمريكية التي استبدلت هذا التمثيل بعد أن لاحظت قصوره في الإحاطة المناسبة علمياً بهذه العملية. والتمثيل الذي قدمته هو نموذج الأوركسترا حيث كل العناصر المصاحبة، وضع الجسد والوجه والعطور والروائح أو انعدامهما التي تصدر عن الجسد والزي والمكان وزمن المكالمة والعناصر الخارجية كالأشياء المستعملة تساهم في التواصل وفي بنية الرسالة… إلخ.
حينما نتكلم، نتكلم بكل هذه العناصر، والذي نحاوره يتأثر لا محالة بكل هذا. وقد تسبقنا هذه العناصر إلى الكلام. فالذي يكذب ويزعم أنه يقول الحقيقة يمكن لامتقاع وجهه أن يقول شيئاً آخر غير هذا. فإذا كان امتقاع الوجه، وهو عنصر خارجي، يقول الحقيقة، فإن الكلمات تكذب… إلخ.
التواصل إذن ليس مجرد كلمات ترسل في الهواء إلى متلق ما كالتلغراف، بل هو عملية تتضافر فيها كل عناصر السياق الواسع.
- تمثيل الشريعة بالطب
أولا ينبغي نفي التباس معين وهو أن اللجوء إلى التمثيل هو نهج نعمد إليه لاستحالة ”البرهنة“ بالوسائل المعهودة في العلوم النظرية أو التجريبية. وهكذا ففي المجال الذي نحن فيه علينا أن ننسى ”اليقين“. كل الاستنتاجات التي نخلص إليها مهما بلغت رتبة ترجيحها هي خلاصات مؤقتة نقبلها على سبيل الاحتمال لا اليقين. اليقين متروك للتجربة العينية أو المختبرية أو الرياضية. ولهذا، ففي التمثيل لا نقع على طبائع الخطابة وحسب، بل نقع أيضاً على طبائع الشعرية. ولهذا أنظر بكثير من الحذر حينما ألاحظ بن أحمد يقول: ”وهكذا فابن رشد ينطلق في تمثيله من مقدمة تقتضي باشتراك الطب والشريعة في غاية واحدة هي فعل الصحة. لكن إذا كان الطبيب يهتم بصحة الأبدان بدناً بدناً، فإن صاحب الشريعة يهتم بصحة الأنفس اهتماماً جماعياً سواء تعلق الأمر بحفظ صحة المدينة أم باستردادها إن فقدت […] هذه المقدمة المشتركة بين الطبيب والشارع أو بين الشريعة والطب هي التي تجعل التمثيل صحيح التناسب، بل يقينياً.“[22] والواقع أن هذا الأمر يصعب تصديقه. إن هذا التمثيل وهو من أرومة استعارية طالما أننا نقارن، بل نشبه مجالين مختلفين من حيث الجنس، ألا وهما الطب وهو علم تجريبي، والشريعة وهي مدونة من القوانين. إن إسقاط الطب على الشريعة، أي النظر إلى الشريعة من خلال غربال الطب لا يمكن، ومهما بلغت درجة رجحانه، أن يصل إلى مرتبة اليقين. اليقين محجوز للبرهان التجريبي أو الرياضي. ولنستمع إلى مَاكسْ بلَاكْ كيف يعالج الأمر: ”فلنفترض بأنني أنظر إلى السماء عبر قطعة من الزجاج التي تم تسويدها تسويداً شديداً والتي تركت بدون تسويد بعض خطوطها: إنني لن أتمكن بهذا إلا من مشاهدة الكواكب التي تُرَى من خلال الخطوط غير المسوَّدة المهيأة بشكل مسبق على صفحة الزجاجة، وسيبدو تنظيم هذه الكواكب منسجماً مع بنية الزجاجة المذكورة . بالإمكان أن نعتبر الاستعارة مثل هذه الزجاجة، ونسق ”الموضوعات المرافقة“ للكلمة التصويرية، مثل شبكة الخطوط المسطرة عليها، ويمكن أيضاً أن نقول إن الموضوع المركزي ”يشاهد من خلال العبارة الاستعارية —أو إذا جاز القول، نقول إنه ناتج عن ”إسقاطه على ”فضاء الموضوع الثانوي“ — (في هذا التمثيل الأخير ينبغي أن نسلم بأن نسق التضمنات للتعبير التصويري يحدد قانون الإسقاط.
يمكن أن نستعين بمثال آخر. فلنفترض أنه قد توجب علي أن أصف معركة بالتوسل بكلمات تنتسب في جملتها إلى ألفاظ الشطرنج. إن هذه اللعبة تعين نسقاً من التضمنات ستهيمن على وصفي: إن الانتقاء المفروض للمعجم الشطرنجي سيجعل بعض مظاهر المعركة مشدًّدة، في حين أن الأخرى تَخفُتُ، وأن المجموع يصبح منظماً بطريقة يمكن أن تنتهك بشكل أشدًّ الأنماط الأخرى من الوصف. إن معجم الشطرنج يصفِّي ويحوِّل: إنه لا ينتقي وحسب. إنه يبرز مظاهر من المعركة التي ما كانت لتظهر إطلاقاً من خلال وسيط آخر؛ مثل النجوم التي لا تمكن مشاهدتها إلا بواسطة التلسكوب.“[23]
- تمثيل : البدن/ المنزل/ المدني (الفارابي)
يقول بن أحمد: ”لجأ الفارابي إلى المقارنات والاقتباس ونقل الخبرة المستفادة من مجال معرفي إلى آخر، وهذه كلها وجوه للتمثيل. يقول وهو يمثل بالطبيب المعالج مدبر المدينة أو الحاكم: ”كما أن الطبيب إنما يعالج كل عضو يعتل بحسب قياسه على جملة البدن وإلى الأعضاء المجاورة له والمرتبطة به بأن يعالجه علاجاً يفيده به صحةً ينتفع بها في جملة البدن وينفع بها الأعضاء المجاورة له والمرتبطة به. كذلك مدبر المدينة ينبغي أن يدبر أمر كل جزء من أجزاء المدينة. فالتمثيل بمهمة الطبيب يساعد على فهم مهمة الحاكم، كما تلعب المقارنة بالطب دوراً مهماً في نسج التصورات المدنية وتعضيدها.“[24]
الحقيقة أن تمثيل الحاكم بالطبيب يبرز، بل يشدد الصفات السلمية بل الإيجابية للحاكم وينفي عنه كل صفات العنف التي طالما اعتمدها الحكام. وبطبيعة الحال فلا يمكن أن نكذب الفارابي بسبب هذا التمثيل، لأن كل تمثيل يبرز صفات ويطمس أخرى.
- مراتب الأعضاء البدنية ومراتب أعضاء المدينة
يقول الفارابي: ”وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب، وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذلك الرئيس، وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله، ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس، وأعضاء أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة —فهذه في المرتبة الثانية—، وأعضاء أخر تفعل الأفعال على حساب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية، ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترأس أصلاً. وكذلك المدينة، أجزاؤها مختلفة الفطرة، متفاضلة الهيئات. وفيها إنسان هو رئيس وآخر يقرب مراتبها من الرئيس. وفي كل واحدة منها هيأة وملكة يفعل بها فعلاً يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس. وهؤلاء هم أولو المراتب الأول. ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء. ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم، فيكون هؤلاء هم يخدمون ولا يخدَمون ويكونون في أدنى المراتب، ويكونون هم الأسفلين.“[25]
يضع الفارابي هنا تمثيلاً للهيئة الحاكمة على شكل سلم، له قمة ووسائط وأسافل. قمة تأمر ولا تؤمر، ووسائط تأمُر وتِؤمر وأسافل تُؤمَر فقط. هذا تناسب شائع وهو يذكر بشكل من الأشكال بتناسب أشهر منه عند المعاصرين؛ ألا وهو الهرم: قمته ووسائطه وأسافله. إلا أن هذا الأخير لم يستخدم لأجل توزيع السلطة فقط، بل يستخدم أيضاً لبيان التوزيع الكمي للساكنة. يبدو هذا التناسب أغنى من تمثيل الفارابي السابق.
ج. ملاحظات الفارابي النقدية بصدد التمثيل
يقول بن أحمد: ”لم يكن استعمال الفارابي للتمثيل الطبي عموماً ليحول دون تسجيله شكوكاً حول نجاعة هذه الآلية ووثاقتها، خاصة عندما يكون استعمالها في حل من كل انضباط. فملاحظة التشابه الظاهري بين واقعتين يجب ألا يدفع الذهن في اتجاه مسايرة الأحكام السائرة؛ لأن التشابه نفسه قد يحجب تبايناً خفياً عن الحس. وكما كتب الفارابي: ”إذا وجد شيئان متشابهان، ثم ظهر أن شيئاً ثالثاً هو سبب لأحدهما، فإن الوهم، يسبق ويحكم بأنه أيضاً سبب للآخر؛ وذلك لا يصح في كل متشابهين؛ إذ التشابه قد يكون بعرَض من الأعراض، وقد يكون بالذات.“ إن التشابه يذهلنا أحياناً عن إدراك الفروق بين الموجودات. وهذا الأمر الذي ينبه إليه الفارابي مبكراً هو الذي يقع على رأس قائمة الأسباب التي حملت الناس قديماً وحديثاً على التشكيك في التمثيل. فالتشابه الظاهري قد يؤدي إلى آراء متضاربة متكونة بناء على عمليات تمثيلية. ومن هنا ضرورة امتحان التمثيل للنظر في ما إذا كانت الأحكام المتكونة منه مناسبةً للواقع ومنسجمة مع ما هو متوفر من المعرفة العلمية.“[26]
صحيح أن هناك تشكيكاً في التمثيل والاستعارة، ولكن لا يمكن الاستغناء عنهما. ولعل أرسطو هو أحسن من يبين بعبارة مختصرة وعبقرية هذا التمييز بين مجالي البحث ونمطي الاستدلال: ”إن الرجل المكتسب للمعرفة يبدو أنه لا يسعى، في الواقع، في كل جنس من البحث إلا إلى درجة الدقة المناسبة لطبيعة الموضوع. وبتجاهل هذا الأمر فمن المنتظر أن نتلقى من باحث في الرياضيات حججاً مقنعة فقط، ومن خطيب برهنات بمعناها الدقيق.“[27]
ملاحظات أخيرة
أ. يتطلب التمثيل باعتباره من الجنس الاستعاري أن يحقق صورة. أي أن يكون عبارة بشيء ملموس عن شيء مجرد أو ملموس. والتعبير بالمجرد، علاوة على أنه يتنافى مع الطبيعة التشبيهية والاستعارية والتمثيلية، فإنه نادراً ما يستعان به سواء في الشعر أو في طرق الاستدلال. والمعهود هو انفلات شيء مجرد واستعصاؤه على الاستسلام للعقل، هنا يتم الاستنجاد بشيء ملموس لأجل التمكن منه. ولهذا فإن استعانة ابن رشد بتمثيل النفس للمدينة إنما هو سباحة ضد التيار، وضد الوظيفة الطبيعية للتمثيل وكل أجناس العبارة الاستعارية، أي التصويرية. ولحسن الحظ فقد نبهنا بن أحمد على خطورة هذا النوع من الانزلاق.
ب. للتمثيل دوران: أحدهما توضيحي، أو ديداكتيكي يستعان بخدماته لأجل تسهيل نقل الأفكار إلى الغير. وهنا تكون الفكرة جاهزة يطلب توصيلها، فيستعان بالتمثيل. والدور الثاني هو دور الاستكشاف أو الابتكار. ابتكار معنى، لا توصيله، أي محاصرة الظاهرة بالتمثيل لكي تفصح عن مكنونات جديدة لا يمكن الوصول إليها بغير التمثيل. إننا نستعين بالأشباه لكي نوقع في شباكها مظاهر جديدة من الواقع. وحينما تدرك هذه المظاهر يمكن لاحقاً الاستعانة بتمثيل ناقل للفكرة.
ج. للتمثيل واجهة شعرية. فحينما نربط لأول مرة بين شيءٍ معهود بشيءٍ آخر مجهول ربطاً موسوماً بقدرة المبدع على إيقاع التشابه حيث لم نعتد مشاهدته وحينما يكون مطبوعاً بسحرٍ ما نعجب به وننتشي لشعريته. تذكروا الأركيسترا. إن هذا التمثيل علاوة على قوته الابتكارية الاستكشافية فيه الكثير من طبائع الاستعارة بل الشعر. للتمثيل أرومة خيالية أي شعرية.
د. التمثيل كائن حي حينما نتلقاه فور ابتكاره ننتشي بجماله. إلا أن العادة والتكرار وتداوله بين العقول وانتشاره بين الناس يصاب بالبلى والشيخوخة والابتذال فلا يكاد يرى. بهذا يصبح مواطناً نراه ولا ننتبه لوجوده. لقد ابتكر في يوم من الأيام. وذلك المبتكر أصبح عادة. بل نثراً. هنا تفرض الحاجة نفسها لابتكار تمثيل جديد جدير بأن يرينا مظهراً آخر جديداً من الواقع. هذا التمثيل الأخير الجديد لم يأت لتفنيد الأول، بل لمجرد الكشف عن مظهر آخر للواقع لا غير. هذا الواقع الجديد المحمول بالتمثيل الجديد لا يُفنِّد السابق. إن الأمثال لا يفنِّد بعضُها بعضاً. لا تُفنَّد الاستعارة باستعارة أخرى يمكن تفنيدها بالبرهان أو القياس.
هـ. ولأن الواقع الإنساني متعدد الوجوه، فلا يمكن تناوله إلا بالتمثيل، الذي يكون هو بدوره حاملا لخميرة التعدد. ولهذا لا يمكن نقل التمثيل أو الاستعارة إلى لغة نثرية.
بيبليوگرافيا
الخيون، رشيد. مذهب المعتزلة، من الكلام إلى الفلسفة: نشأته ومبادئه ونظرياته في الوجود، ط. 3. بيروت: دار مدارك للنشر، 2015.
Aristóteles. Etica Nicomáquea, Etica Eudemia. Madrid: Editorial Gredos, 1985.
Aristoteles. Retorica. Introducción, traducción y notas por Quintín Racioneroed. Madrid Biblioteca Clásica Gredos, 1990.
Black, Max. Modelos y metáforas. Madrid: Editorial Tecnos, 1966.
Charles, Anick. “Analogie et pensée sérielle chez Proclus.” Revue internationale de philosophie (Analogie), n. 87 (1969) : 69–88.
Eliade, Mircea. Images et symboles. Paris : Gallimard, 1952.
Gasset, José Ortega y. “Las dos grandes metáforas.” in Obras completas. Vol. II, 3 a edición. Madrid: Revista de Occidente, 1954.
Guiraud, Pierre. La Sémiologie. Paris : PUF, 1973.
Louis, Pierre. Les métaphores de Platon. Paris: Les belles lettres, 1945.
Molino, Jean. “anthropologie et métaphore.” Langages (Métaphore), n. 54 ( Juin, 1979) : 103–125.
Perelman, Chaim et Olbrechts-Tyteca. Traité de l’argumentation. Bruxelles : ULB, 2008.
Secretan, Philibert. L’analogie. Paris, PUF, 1984.
للتوثيق
الولي، محمد. ”عن تمثيلات واستعارات ابن رشد.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2059>
محمد الولي
[2] Aristóteles, Etica Nicomáquea, Etica Eudemia (Madrid: Editorial Gredos, 1985), 246
[3] Aristoteles, Retorica, Introducción, traducción y notas por Quintín Racioneroed (Madrid Biblioteca Clásica Gredos, 1990), 234.
[4] Pierre Guiraud, La Sémiologie (Paris : PUF, 1973), 66
[5] Ortega y Gasset, “Las dos grandes metáforas,” in Obras completas, 3 a edición (Madrid: Revista de Occidente, 1954), ii, 387.
[6] بن أحمد، استعارات وتمثيلات ابن رشد، 11–13.
[7] Pierre Louis, Les métaphores de Platon (Paris: Les belles lettres, 1945).
[8] بن أحمد، استعارات وتمثيلات ابن رشد، 16.
[9] Jean Molino, “anthropologie et métaphore,” Langages (Métaphore), n. 54 ( Juin, 1979) : 103–125, 123.
[10] استعارات وتمثيلات ابن رشد، ص. 28
[11] أي بلغة مطهَّرة من الاستعارية.
[12] Mircea Eliade, Images et symboles (Paris : Gallimard, 1952), 16–17
[13] بن أحمد، استعارات وتمثيلات ابن رشد، 53.
[14] بن أحمد، استعارات وتمثيلات ابن رشد، 53.
[15] بن أحمد، استعارات وتمثيلات ابن رشد، 53.
[16] رشيد الخيون، مذهب المعتزلة، من الكلام إلى الفلسفة: نشأته ومبادئه ونظرياته في الوجود، ط. 3 (بيروت: دار مدارك للنشر، 2015)، 104.
[17] حسين مروة، النزعات المادية، 1، 653؛ نقلا عن الخيون، مذهب المعتزلة، 104.
[18] بن أحمد، استعارات وتمثيلات ابن رشد، 98.
[19] Platon, in Anick Charles, “Analogie et pensée sérielle chez Proclus,” Revue internationale de philosophie (Analogie), n. 87 (1969) : 69–88, 79.
[20] Philibert Secretan, L’analogie (Paris, PUF, 1984), 8.
[21] Chaim Perelman et Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation (Bruxelles : ULB, 2008), 502.
[22] بن أحمد، استعارات وتمثيلات، 105.
[23] Max Black, Modelos y metáforas (Madrid: Editorial Tecnos, 1966), 51.
[24] بن أحمد، استعارات وتمثيلات، 273–274.
[25] بن أحمد، استعارات وتمثيلات، 275.
[26] ابن أحمد، استعارات وتمثيلات، 278.
[27] Aristóteles, Etica Nicomáquea, Etica Eudemia, 133–134
مقالات ذات صلة
قراءة نقديّة: موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (557هـ-629هـ). ما بعد الطبيعة. قدم له وحققه يونس أجعون. بيروت: دار الكتب العلمية، 2017.
Muwaffaq al-Dīn ʿAbd al-Laṭīf Ibn Yūsuf al-Baghdādī (557-629). Mā ba ʿda al-ṭabī ʿah [Metaphysics]. Edited by Yūnus Ajʿūn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2017. ISBN: 978-2-7451-8878-6 Fouad Ben AhmedQarawiyyin University-Rabatموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي...
قصّة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر الله في رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان. الجيزة: بوك ڤاليو، 2021
Review of Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham by Yusuf Zaydān. Giza: Book Value, 2021. ISBN-10. 9778582106 Qiṣṣat Ibn al-Haytham maʿa al-Ḥākim bi Amri al-LāhFī riwāyat Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham قصة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر اللهفي رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان....
عن ابن رشد وما لا نعرف عنه: في الرد على حسن أوريد ومن معه
عن ابن رشد وما لا نعرف عنهفي الرد على حسن أوريد ومن معه فؤاد بن أحمدجامعة القرويين، الرباط تقديم اجتهد العربُ المحدثون في ترجمة المفردتين revue وjournal بمفردة ”المجلة،“ بعد أن نقلوا هذه من معناها القديم، وهو ”كتاب يحتوي على أشياء جليلة من الحكم وغيرها.“[1] لكنهم...
الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة: مراجعة نقدية للترجمة العربية
The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī by Ayman Shehadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut: Mominoun Without Borders, 2020. Al-Akhlāqiyāt al-ghāʾiyya ʿinda Fakhr al-Dīn al-Rāzī Li Ayman Shihadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut:...
نصّان في الأشعريّة التقليديّة: إشكالُ القيمة والأبعادُ الفيلولوجيّة والمعرفيّة
نصّان في الأشعَريّة التّقلِيديّة:إشْكَال القِيمَة والأبعادُ الفِيلولوجِية والمعرِفيّة Naṣṣani fī al-Ashʿariyya al-taqlīdiyya:Ishkāl al-qīma wa-l-abʿād al-fīlūlūjiyya wa-l-maʿrifiyya محمد الرّاضي[1]جامعة عبد الملك السعدي-تطوان ملخص تميزت نصوص المتكلمين المتقدمين في...
الفكر العلمي والثقافة الإسلامية لبناصر البعزّاتي
مقدمة يظهر أن استئناس الدارس المغربي بناصر البعزّاتي بالمسائل العلمية والتاريخية التي يثيرها الفكر العلمي والفلسفي المعاصر قد مكنه من مقاربة الثقافة الإسلامية العالمة بترسانة من المفاهيم والآليات والأدوات، فجاءت قراءته لمكونات هذه الثقافة موازية لـقراءته لتاريخ...
مصير العلوم العقلية في الغرب الإسلامي ما بعد ابن رشد
ملخص بعد النقد العنيف الذي وجهه الغزالي للفلاسفة، حصل تعديل في المسار العام للفلسفة في المشرق الإسلامي، وغَلَبَ نوع من التأليف الذي يمزج بين الكلام والفلسفة؛ أما في الغرب الإسلامي، فقد ازدهر القول الفلسفي بعد التهافت، لكن بعد موت ابن رشد، لن نشهد فلاسفة موسوعيين كبار،...
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين فؤاد بن أحمد[1] جامعة القرويين تمهيد ولد الفيلسوف والطبيب والمؤرخ والرحالة موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبي العز يوسف البغدادي، المشهور بابن اللّباد، في بغداد العام 557هـ/1162م، وتوفي...
الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري گوتاس: قراءة نقدية في الترجمة العربية
ملخص صدر كتاب ديمتري گوتاس، الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية العربية في بغداد وفي المجتمع العباسي المبكر (القرن الثاني-الرابع للهجرة/القرن الثامن-العاشر للميلاد)، عام 1998. وقد صار اليوم من المراجع الكلاسيكية في الموضوع. وقد انتبه الدارسون مبكرا...