![]()
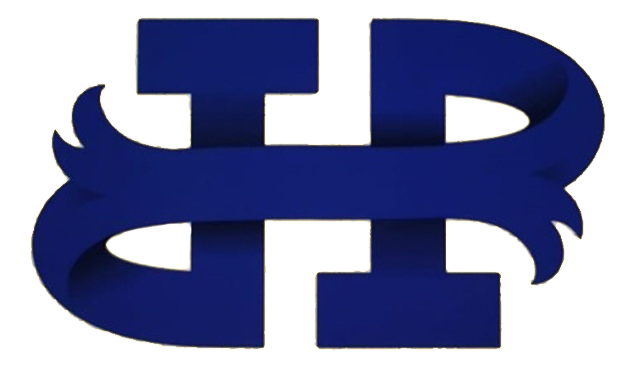
الفكر العلمي والثقافة الإسلامية لبناصر البعزّاتي

مقدمة
يظهر أن استئناس الدارس المغربي بناصر البعزّاتي بالمسائل العلمية والتاريخية التي يثيرها الفكر العلمي والفلسفي المعاصر قد مكنه من مقاربة الثقافة الإسلامية العالمة بترسانة من المفاهيم والآليات والأدوات، فجاءت قراءته لمكونات هذه الثقافة موازية لـقراءته لتاريخ الأفكار عموما. لذلك، لم يكن اهتمام بناصر البعزّاتي بالفاعلية العلمية في الإسلام وليد الصدفة، بل هو مشروع فكري صاحب الدارس منذ كتابه الاستدلال والبناء: بحث في خصائص العقلية العلمية (1999)،[1] مرورا بكتابيه: الأول في النهضة الحضارية في أوروبا خلال القرن الخامس عشر،[2]والثاني حول خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة العلمية (2007).[3] وفي إطار هذا المشروع العلمي، الذي أخذ من الكاتب سنوات ليست بالقليلة، صدر له كتابٌ جديد بعنوان: الفكر العلمي والثقافة الإسلامية (الرباط: دار الأمان، 2015). ويقع الكتاب في 400 صفحة وينقسم إلى ستة عشرة فصلا، مع مقدمة وخاتمة، وقائمة بيبليوگرافية غنية. واشتغال المؤلف بنفس الآليات التي وظفها في مؤلفاته السابقة، ليس معناه أننا بإزاء كتابة نمطية أو ستاتيكية، بل على العكس من ذلك نجدها كتابة متطورة دائما، بحيث تعمل على التجديد في آلياتها ووسائل استدلالها؛ فضلا عن اختلاف موضوعها. ويظهر أن المنهج التاريخي ملائم لنوعية هذه الكتابة، انطلاقا من اعتقاد البعزّاتي بأن الأفكار العلمية لها تاريخ؛ لكنه تاريخ قابل للمراجعة والسبك والتمحيص وإعادة البناء. ووفق هذه المقاربة، فإن موقف صاحب هذا المشروع، في توجهه العام، خاضع لهذا التصور الذي يعتبر المعرفة العلمية معرفة بنائية ونسبية وتاريخية معا.
لهذا يبدو لنا أن المقاربة التي تبناها المؤلف في هذا الكتاب لا تبتعد كثيرا عن الخلفية المحركة في كتبه ودراساته السابقة؛ ويمكن إجمالها في التمسك بإخضاع الأفكار العلمية وشبه العلمية لسياقاتها التاريخية والنظرية. صحيح أنه في هذا الكتاب يعود بنا إلى الأفكار العلمية التي راجت في العالم الإسلامي الوسيط؛ لكنه لم يتردد في ربطها بسياقاتها التاريخية والخارجية من أجل الوقوف على كيفية تطورها وانتشارها أو توقفها. والحضارة الإسلامية في نظر البعزّاتي هي حضارة موصولة بروافد ثقافية مختلفة ومتنوعة، متفاعلة المكونات والعناصر؛ ويشهد لهذا إقبال المسلمين على المعارف الأجنبية مثمرين بذلك خصوبة معرفية امتدت لقرون؛ إلا أن هذا الترحيب عرف بعض التقييدات والمعوقات، أحيانا من لدن رجل السلطة، وأحيانا أخرى من قبل بعض المذاهب الفقهية، كما لقيت اعتراضا من طرف بعض الفقهاء المتزمتين، والذين حاولوا مقاومة التجديد بدرجات، وكل حسب موقعه.
صحيح أن هناك مؤلفات اهتمت بالعلوم في الحضارة الإسلامية؛ لكن أصحابها تباينت مواقفهم حول طبيعة تشكل المعرفة العلمية في الحضارة الإسلامية، حيث نعتها البعض بـ”العلوم الإسلامية“ والبعض الآخر بـ”العلوم العربية“، بينما نظرت فئة ثالثة إلى المسألة نظرة مغايرة تماما، بحيث تعتبر، على غرار أسلافها، أن العلوم العقلية هي علوم أجنبية، وبالتالي فهي دخيلة على الثقافة الإسلامية. ومن هنا جاء تعامل هذه الفئة مع هذه العلوم مطبوعا بمواقف الرفض والإقصاء، وفي المقابل ظلوا متمسكين بالعلوم الشرعية باعتبارها بديلا لكل العلوم الأخرى. أمام هذه القراءات المتباينة، وأحيانا المتباعدة، ارتأى الدارس تقديم وجهة نظره، والتي يسائل من خلالها هذه المقاربات وأحيانا يرد عليها، وينتقدها، وأحيانا أخرى يحاورها، لأنه، وعلى حد تعبيره، ”لا رأي يضع حدًّا للنقاش المفتوح.“[4]
ويجدر بنا التذكير بأن الكتاب يأتي في سياق أعمال ودراسات سابقة عالجت موضوع العناصر العلمية والتاريخية والاجتماعية التي جاءت في إطار الأفكار والاهتمامات العلمية التي عرفتها الحضارة الإسلامية. ويكفي أن نستحضر في هذا السياق بعضا من هذه الدراسات من بينها، ديمتري گوتاس Dimitri Gutas، الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية العربية في بغداد وفي المجتمع العباسي المبكر (من القرن الثاني إلى القرن الرابع للهجرة/الثامن إلى العاشر لليلاد؛[5] وجورج صليبا، الفكر العلمي العربي نشأته وتطوره؛[6] رشدي راشد، دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها؛[7] عبد الحميد صبره، العلم العربي في حضارة الإسلام؛[8] أحمد جبار، علماء الحضارة العربية الإسلامية ومساهماتهم (العلوم الرياضية والفلكية وتطبيقاتها) ق9م- ق15م.[9] بل إن عنوان الكتاب، الفكر العلمي والثقافة الإسلامية يقرب أن يكون ”دبلجة“ لعنوان عمل ديمتري گوتاس المذكور.
لكن قبل الوقوف عند أهم محاور هذا الكتاب، نود أن ننبه إلى عنوانه الذي يحمل أكثر من دلالة؛ فهو يتألف من مركبين رئيسيين، وهما الفكر العلمي من جهة، والثقافة الإسلامية من جهة ثانية. واختيار البعزّاتي لهذا العنوان يوحي بأن الأمر يتعلق بعلاقة معينة تربط بين المركبين؛ ومن هنا لم يكن غرض الدارس النظر إلى الفكر العلمي الإسلامي بمعناه الضيق، بل بانخراط كل المعارف الوافدة من حضارات مختلفة في تأسيس هذا الفكر وتطوره والحفاظ على استمراريته. وهنا يوضح مقصوده من الفكر العلمي، قائلا: ”ونقصد بالفكر العلمي ذلك النمط من النظر الذي يسائل التفسيرات الموروثة عن الأجيال السابقة ― حول نظام الكون وظواهر الطبيعة والتاريخ واللغة …―ويعيد فحص بعض مضامينها ويبادر إلى طرح الأسئلة بشأنها من خلال آليات استدلال وبرهنة تتوخّى الوصول إلى الفهم العقلي الأصوب والأوثق ― أو الأرجح على الأقلّ―، دون ادّعاء بأن التفسير المقترح هو منتهى القول في المسائل المنظور فيها.“[10] يبدو إذن من خلال هذا الكلام أن اختيار البعزّاتي للفكر العلمي كان اختيارا مفكرا فيه، لأنه يسمح له بمعالجة هذا الفكر في إطار العلاقة مع باقي الموروثات السابقة عليه، وبالأخص الموروث اليوناني، وهذا يدل على أن الروافد الثقافية التي تلقتها الحضارة الإسلامية كان لها دورٌ بارزٌ في ظهور هذا الفكر الجديد، فضلا عن أن اختياره لـ ”الفكر العلمي“ يسمح له بضم كل المجالات والمعارف بما في ذلك الأديان السابقة على الدين الإسلامي، والتي أفادت الحضارة الإسلامية بجميع مكوناتها، من لغة وفقه وعلم كلام وطب ومنطق وفلسفة وعلم فلك وتاريخ إلى غير ذلك من أصناف العلوم والمعارف التي تندرج في هذا الفكر. وبالفعل، فقد احتضنت البيئة الإسلامية هذه الموروثات بكل مكوناتها، لكنه ترحيب كما أشرنا أعلاه لم يسلم من مواجهة ومقاومة وإقصاء، يقول البعزاتي في هذا السياق:”ولم يتكون بعض العرب إلا مع قرون من الزمن، في حين بقي عرب مسلمون آخرون يناهضون الانفتاح على المعارف والخبرات التي ظلوا ينظرون إليها باعتبارها ’أجنبية‘ عنهم.“[11]
وعليه، فالغرض الرئيسي من إصدار هذا الكتاب هو الوقوف عند ”السيرورة الثقافية التاريخية“ التي شهدتها الحضارة الإسلامية لمدة سبعة قرون. لكن البعزّاتي لن يركز سوى على القرون الأربعة الأولى، لأنها، في نظره، تمثل مرحلتي ”الاستيعاب والإبداع“ للموروثات المعرفية الأخرى. ولما كان يرى أن الدين الإسلامي مكون من مكونات الثقافة الإسلامية، كان من الضروري الوقوف عند علاقة الدين بالفاعلية العلمية، فإلى أي حد أسهم الدين في بناء هذه الفاعلية؟ ثم ما دور الثقافة العربية الإسلامية في هذا التطور الحضاري المرتبط بالعلم؟ وما دور الأديان والمعتقدات الأخرى في هذه السيرورة الثقافية التاريخية نفسها؟[12] ويعود البعزّاتي في خاتمة كتابه إلى إثارة إشكال قديم–حديث يتعلق بدراسة المستشرق المجري إغناس گولدسيهر لمواقف علماء الدين السنة من العلوم القديمة، ويعني بها علوم الفلسفة.
كانت هذه أهم الإشكالات التي دفعت البعزّاتي إلى البحث من جديد في هذا الموضوع. وهو موضوع تم تناوله من طرف دارسين عدة، كما ذكرنا؛ لذلك نجده يعمل على استحضار أهم هذه المواقف ليناقشها وليقف عند مكامن قوتها ومكامن ضعفها، خاصة في مقدمة وخاتمة كتابه، وليضع لمقاربته مكانا ضمن هذا السياق فيقول: ”رأى البعض أن ذلك اللقاء تمّ على مراحل: استقبال وترجمة فاستيعاب فإبداع، لكن المراحل غير منفصلة فيما بينها بل هي متداخلة؛ ورأى أحدهم أن الأمر يتعلق بتملّك العلوم الموروثة عن السابقين، لا بمجرّد تلقّ ساكن؛ ورأى آخر أن الأمر يتعلق بجدلية التلقّي والترجمة والإبداع. وحاول آخر تقديم تفسير مؤداه أن المجتمع الإسلامي استوعب تلك العلوم المقتبَسة من خلال تهيُّؤ مؤسّسي (إنشاء الدواوين) بغاية استعمال هذه العلوم والتقنيات والخبرات للأغراض الإدارية والاقتصادية […] ولكلّ رأي مَواطن قوّة ومَواطن ضعف.“[13]أمام هذا التنوع في القراءات المهتمة بتاريخ الأفكار العلمية في الحضارة الإسلامية، يصرح البعزّاتي بأن قراءته لهذا الفكر ستكون أكثر اقترابا من التاريخ الفعلي للأفكار العلمية مقارنةً بما قدمته هذه القراءات السابقة.
ووفق هذا التحديد الذي قدمه الدارس نفهم اقتراحه المتعلق بمكونات الكتاب التي وزعها على ستة عشر فصلا؛ وهي فصول تعكس في الواقع مكونات الفكر العلمي، مثلما تعكس علاقة هذا الفكر بالثقافة الإسلامية. وبحسب تفاصيل هذه الفصول نقترح أن ننظر في هذا الكتاب انطلاقا من أربعة أبواب؛ هذا مع أن داخل كل باب عناصر يكمل بعضها بعضا، وأحيانا تتداخل في ما بينها. وسنخصص الباب الأول للوقوف عند طبيعة المجالس وأنواعها؛ وفي الباب الثاني، سنفحص مسألتي الاقتباس والاستيعاب؛ أما الباب الثالث، فسيكون من نصيب خصوبة الفكر العلمي؛ وسيسمح لنا الباب الرابع بالإطلال على أشكال التجديد والمقاومة.
الباب الأول: المجالس وأنواعها
أحصى البعزّاتي في كتابه أربعة أنواع من المجالس العلمية، وهي على هذا الترتيب: مجلس الجدل الديني وعلم الكلام، مجلس الفقه، مجلس اللغة، مجلس الترجمة. ولكي يحصل استيعاب طبيعة اشتغالها كان لا بد من وضعها في إطار مؤسساتي.
لذلك نجد أول فصل يبدأ به البعزّاتي كتابه هو فصل بعنوان ”وظائف الدولة الجديدة“، والتي لا ينحصر عملها فقط في تسيير المال والضرائب والجنود والكتابة إلى غير ذلك من القطاعات المكونة لأجهزتها، بل هي في حاجة أيضا إلى خبرة معرفية، وهي في الحالتين معا لم تحصل هذه المعرفة من قبل فئة العرب إلا خلال القرن الثاني الهجري. ويؤكد الدارس على أن تعلم الخبرة واستيعابها صار بشكل بطيء جدا، لأن عملية نقل واستيعاب الموروث الثقافي المغاير للثقافة الإسلامية يحتاج إلى زمن قد يطول أو يقصر حسب درجة الاستيعاب وحسب درجة الإدراك لدى الفئة المستقبلة لهذا الإرث، موضحا مسألة بالغة الأهمية، ألا وهي كون اللغة العربية ”لم تكن بعد قد استوعبت المجالات الإدارية والمالية في فجر الدولة الإسلامية.“[14] ومن هنا أصبح التنافس على حد قوله محركا أساسيا في التجديد، لكن المنافسة تأخذ أشكالا مختلفة وأحيانا متباعدة، فإذا كان التنافس بناء وفاعلا، فهو لا محالة ينتج خصوبة فكرية، لكنه في المقابل إذا كان تنافسا من أجل مقاومة كل ما هو جديد على البيئة الإسلامية، فإنه ينتج جمودا فكريا وثقافيا. وهذا ما حصل تاريخيا بين الفينة والأخرى، حيث كانت بعض الفئات تعترض على الانفتاح على ثقافات مغايرة لثقافتها، فتسعى جاهدة إلى محاربتها وهو فعل مبرر بكون الفئة الممثلة لهذا الموقف لا تمتلك ”رؤى مدرِكة لما يمكن أن يكون عليه المستقبل.“[15]
وانسجاما مع ما قدمه البعزّاتي من معطيات تخص مسألتي الخصوبة واللغة، فلا ينبغي من جهة أولى أن نربط الخصوبة الفكرية بالثقافة الإسلامية بحصر المعنى، مادامت معظم الحضارات السابقة عنها قد انخرطت بشكل من الأشكال في هذه العملية، وهذا معناه أن الخصوبة الفكرية كانت سائدة قبل مجيء الإسلام، بدليل وجود مراكز ومدن عرفت تنافسا علميا وازدهارا في هذا الباب، كمدينة جنديسابور ومرو ومنطقة خراسان إلخ.. كما لا ينبغي من جهة ثانية أن نجمع بين تداول علماء الحضارة الإسلامية للعلوم باللغة العربية، لأنه عند لحظة مجيء الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية، لم تكن اللغة العربية هي لغة العلم السائدة، بل كانت اللغتين السريانية والفارسية من بين أقوى اللغات التي تشتغل بالقضايا العلمية؛ كما أن الفئات التي كانت تهتم بالعلوم والمعارف، لم تكن تمثل لا فئة العرب ولا فئة المسلمين، لأن العامل الأساسي الذي كان يوجه هذه الفئات هو عامل الوراثة حيث تعمل كل فئة علمية على توريث علمها للجيل الذي سيأتي بعدها. وصناعة الطب شاهدة على هذا الأمر. ففي العصر العباسي مثلا كانت العائلات التي تشتغل بصناعة الطب تحاول احتكار هذه الصناعة لأفراد عائلتها، ولنضرب مثالا بعائلة بختيشوع التي عاصرت الحكم العباسي بدءا من الخليفة المنصور (ت. 158هـ/755م) ومرورا بهارون الرشيد (ت. 193هـ/809م) وصولا إلى الخليفة المأمون (ت. 218هـ/833م).[16]
من زاوية أخرى يظهر البعزّاتي من خلال وقائع تاريخية أن النقاش العلمي الذي كان سائدا قد ظهر قبل مجيء الإسلام حيث ”تتميّز البيئة الثقافية التي اشتعلت فيها المجادلات بكونها ورثت ثقافات وتقاليد فكرية ورواسب فلسفية وعلمية قروناً قبل الإسلام.“[17] وقد شمل التنافس والصراع بين مختلف الفاعلين مجمل المجالات المعرفية والعقائدية. والحقبة التاريخية التي تمثل هذا الاختلاف في المعارف والعقائد أقوى تمثيل هي الفترة التي انتقل فيها الحكم سياسيا من أيدي الأمويين ليصبح ممثلا من قبل الدولة العباسية، فكان من أشهر القضايا التي اهتم بها علماء الكلام هي قضية رؤية الله وما يستتبعها من قول في صفات الذات الإلهية، وهو الأمر الذي سمح بمعرفة عناصر الكون فأصبح الانفتاح مثلا على العلوم الطبيعية أمرا ملحا وضروريا. وفي هذا المناخ الثقافي نشأ صراع ثقافي بين علماء الكلام من جهة والفلاسفة من جهة أخرى، اضطر معه كل جانب إلى تقوية أساليب الحوار والحجاج والإقناع والنقد أيضا، وهو تنافس بدأ منذ أواخر القرن الثاني للهجرة (أواخر القرن الثامن للميلاد).
وفي ظل هذا التنافس الفكري، كان للترجمة دورٌ أساسي ليس في نقل العلوم والمعارف من لغة أجنبية إلى أخرى، بل في نقل الخبرات المعرفية. ولقد أفرد الدارس فصلا مستقلا لعملية الترجمة بالنظر إلى أهميتها ودورها في الخصوبة الفكرية. يشير البعزّاتي إلى أن عملية الترجمة لم تتزامن مع فترة مجيء الإسلام بل كانت قبله. صحيح أن بعض المشتغلين من العرب كانوا في اتصال مع بعض الحضارات كالحضارة البيزنطية والفارسية، لكن ”عند بداية القرن الثالث للهجرة، أصبحت الترجمة تتمّ في نطاق خطط محددة، في سياق مشروع حضاري واعٍ بحاجاته ومراميه، في إطار مؤسسة بيت الحكمة التي كلفها الخليفة العباسي عبد الله المأمون ومستشاروه بمهمّة نقل الكتب العلمية والفلسفية ونشرها في أوساط المتعلمين، من أجل المزيد من التطور الحضاري المتّصل الذي دخلت فيه المدن الفارسية والعراقية والشامية منذ قرون عدّة.“[18] غير أن عملية الترجمة لم تكن معزولة عن ”الفاعلية العقلية“ التي تقوم بدور النقد والتصحيح والمراجعة والفحص وإعادة السبك، وهذه إشارة إلى أن من شروط المترجم الجيد أن يكون ملما بمبادئ العلوم مطلعا على أهم قضاياه. لكن أغلب المترجمين: ”لم يكونوا لا عربا ولا مسلمين، بل جلّهم ينتمون إلى ثقافات متنوعة متداخلة، يجمع بينهم البحث النظري والتجديد الفكري والرغبة في الترقية الاجتماعية؛ حيث كان هؤلاء ينتمون إلى أسر من العلماء، ورثت الخبرة والمعرفة منذ عقود من الزمن قبل الإسلام.“.[19]
وفي هذا السياق يدون البعزّاتي مجموعة من الملاحظات: أولها أن عملية الترجمة جاءت تحت الطلب؛ وثانيها أنها لم تكن عملا عشوائيا بل كان المترجم ينتقي المؤلفات ”لتكون فعالة ومثمرة في مسائل فكرية وعلمية وطبية وتقنية محددة؛“[20] ثالثها أن جل الأعمال المترجمة كانت تخضع لعمليتي المراجعة والتصحيح؛ ورابعها: ”كانت الترجمة نشاطا علمياً تمحيصياً يتغيّى التدقيق في الأفكار والتمييز بين الآراء، ويوازي عمليات التكييف والتبيئة والغربلة النقدية؛“[21]وخامسها أن الترجمة لعبت دورا هاما في الترقية الاجتماعية؛ وسادسها أن اللغة العربية لم تكن اللغة الوحيدة للترجمة، بل كانت تنافسها لغات أخرى كالفارسية والسريانية إلى حدود القرن الرابع الهجري، فـ”اللغة العربية لم تكن وحدها لغة العلم والفلسفة[22]“، بل تم تداول ”لغات عديدة: العربية والفارسية والسريانية (واليونانية في نطاق ضيق)؛ لكن الحكّام في الدولة العربية الإسلامية كانوا يرمون إلى أن تسود اللغة العربية؛ فدفعوا بالقرار الإداري في اتجاه سيادتها.“[23]
أمام هذه المعطيات التي تهم الترجمة وما يستتبعها من نقل للعلوم العقلية، يقف البعزّاتي عند مفارقة من المفارقات التي عرفتها الحضارة الإسلامية. فقد كانت هذه أقوى عسكريا لكنها كانت مضطرة إلى نقل الخبرة من ثقافات أخرى وهو ما ينعته ”بالوضع الدرامي“، فـ”المسلمون أقوى عسكريا من جيرانهم، لكنهم أضعف حضاريا؛“[24] لذلك اضطروا إلى نقل خبرات هؤلاء الجيران ومعارفهم. ومن هنا نتساءل: كيف تم هذا النقل؟ وما هي حدود استيعاب تلك المعارف والعلوم؟ وإلى أي حد استطاع هذا الاستيعاب أن يكون نشيطا وخلاقا؟ وهل كان للدين الإسلامي دور في إنجاز الفاعلية العلمية؟
الباب الثاني: بين الاقتباس والاستيعاب
يتعلق الأمر في هذا الباب بنوع من الاتصال بين حضارات سابقة ومختلفة بيزنطية وفارسية ويونانية من جهة والحضارة الإسلامية من جهة ثانية؛ وهو اتصال تحقق عن طريق الاقتباس، واتخذ أشكالا مختلفة كالسفر أو الغزو أو الترجمة إلخ… ونظرا لصعوبة تحديد أول اتصال معرفي حصل بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى يقترح البعزّاتي القرن الأول الهجري كبداية تاريخية لعملية الاقتباس. وبالفعل بعد مجيء الإسلام تفاعلت الثقافات فيما بينها وامتزجت فأثمرت ’تنوعا خصبا‘ في المعارف، شمل حتى المجالات العملية، التي تحتاج إلى ”سند تجريبي“، فلم يتوقف الأمر عند حدود نقل هذه المعارف، بل جاءت محاولة العلماء إيجاد تصويبات جديدة أحيانا تكون أكثر تقدما مما كانت عليه من قبل. ولقد تم تعزيز هذه المحاولات بالمناخ الثقافي الذي ساد بين العلماء وامتاز بالحوار والنقاش البناءين حول بعض القضايا العلمية التي كانت تشغل بال ثلة من علماء ذلك العصر، وجابر ابن حيان (ت. 198هـ/814م) كان نموذجا، من بين نماذج كثيرة، للعالم المنفتح على شتى المذاهب، وهو انفتاح من دون شك أغنى إنتاجاته المعرفية والفلسفية أيضا.[25] فالاقتباس إذن لم يتحقق بمعزل عن التهذيب والتصويب والفحص والتمحيص وإعادة النظر مجددا في مضمون هذه المعارف جميعها؛ وهو أمر خدم مسار تقدمها في البيئة الإسلامية، التي لم يخجل علماؤها من الاستفادة من الموروث العلمي اليوناني وغير اليوناني، ولم يترددوا في اقتناء هذه العلوم رغم أنها آتية من ثقافات أخرى: ”وكلهم اعتبروا إنجازاتهم استمراراً متصلا لإنجازات السابقين، ونقدا لها في بعض الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى تصويب أو تهذيب.“[26] لكن البعزّاتي سرعان ما ينبهنا إلى أن هذا الإقبال على علوم القدماء لم يسلم بدوره من بعض المضايقات التي لقيها من قبل بعض المتزمتين، إلى درجة أن بعض المؤلفات كانت تأتي خلسة إلى البيئة الإسلامية. كما أن الاقتباس لم يسلم من عملية تبيئة هذا الموروث حتى يصبح ملائما لحاجيات ومتطلبات المجتمع الإسلامي فـ ”لا شيء يجري بدون اعتبارات تفضيلية.“[27]
ربما كانت للبعزاتي نفسه اعتبارات تفضيلية هي التي دعته إلى تقديم حديثه عن علمي الطب والمنطق، قبل تطرقه في فصول تالية إلى العلوم التي اشتغل عليها علماء الحضارة الإسلامية. ويبدو أن هذا الاختيار وراءه مقاصد، أبرزها أن عملية الاقتباس حصلت بالتدريج وأحيانا ببطء شديد، وأحيانا أخرى وفق منطق الأولوية. وهذا بالذات ما حصل مع صناعة الطب، التي كانت متدوالة في الثقافة الإسلامية بحكم الحاجة الملحة والضرورية إلى هذه الصناعة، ونظرا لنتائجها العملية والمباشرة على صحة الإنسان؛ وهي نفسها الحاجة التي حركت الحضارات السابقة على الحضارة الإسلامية إلى تطوير هذه الصناعة. ولكن إذا كانت الحضارات السابقة قد ارتأت السير على نهج أبقراط والعمل على تطوير هذه الصناعة وتصويبها إن اقتضى الأمر ذلك، فإن تعامل علماء البيئة الإسلامية مع هذه الصناعة كان نوعا ما مختلفا عن تعاملهم مع باقي العلوم الأخرى فـ”الطب لم يحقق تراكما معرفيا يسمح له بالتطور في البيئة الإسلامية، لأنه ظل عملياً وعفوياً ولم يدوّن كتابةً خلال العقود الأولى للإسلام. لكن منذ استقرار الدولة الإسلامية في أواخر القرن الأول للهجرة (أوائل الثامن للميلاد)، بدأ الطب يتطور استجابة لنمط العيش الجديد في المدن. “[28] وقد لعبت ترجمة النصوص اليونانية في هذا التطور دورا مركزيا.
الأمر الآخر الذي نود أن نشير إليه في هذا السياق هو ظهور مفهوم ”الطب النبوي“[29]. وقد وقف البعزاتي عند هذا المفهوم في الفصل الذي خصصه لصناعة الطب. ويمكن أن نقول إن الطب النبوي قد تطور في سياق منافسة بل ومعارضة الطب المستند إلى الخبرة والنظر والمقتبس من الحضارات الأخرى. وقد سمي هذا الطب التقليدي طبا نبويا قصد إضفاء شرعية دينية وخلق تأثير في الأذهان. وقد ألفت كتب كثيرة فيه. ومع الفائدة العملية التي يمكن أن تكون للطب النبوي وكل الاهتمام الذي لقيه من لدن الفقهاء والمحدثين والمفكرين المحافظين بوصفه بديلا شرعيا عن الطب المرتبط بالعلوم العقلية، فإن هذا العلم لم يعرف تطورا ولا تراكما معرفيا، لأنه ظل بمنأى عن التمحيص والتحليل والمراجعة النقدية.
هكذا يظهر أن ازدهار العلوم الطبية في الإسلام لم يكن خلوا من معارضة، هذا على الرغم من أن صناعة الطب كانت آثارها مباشرة وعملية على جسد الإنسان من جهة أنها تحفظ الجسم من السقم بقدر المستطاع؛ ولا يحتاج المرء دراية كبيرة ليدرك هذه المنافع. وإذا كان هذا حال الطب فما هو وضع المنطق من عمليتي التلقي والاستيعاب؟ وكيف استطاع الفلاسفة دمجه ضمن البيئة الثقافية الإسلامية الجديدة؟
خصص البعزّاتي الفصل التاسع من كتابه للنظر في منزلة صناعة المنطق في سياق الثقافة الإسلامية. وطبعا، لم يحصل استيعاب للمنطق منذ الوهلة الأولى؛ وفي هذا يقول إن الاتصال الأولي بهذا العلم كان مجرد محاولة لـ”تقريب المنطق إلى مستعملي اللغة العربية بدون هضم وبدون تحليل للفاعلية الاستدلالية في إنجازها الفعلي؛ أي تناولوا المنطق كقواعد متعالية عن الممارسة، وكأنه ناموس يقيني قار.“[30] وهذا معناه أن درجة استيعاب المفكرين المسلمين لعلم المنطق لم يتم بنفس درجة استيعابهم لعلوم أخرى كعلم الفلك والبصريات اللذين سيعرفان خصوبة علمية متميزة، سنأتي على ذكرها لاحقا. وبغض النظر عن الموقف الرافض للمنطق، سواء من قبل بعض المحدثين وبعض المتكلمين أيضا، فإن الفلاسفة قد أدمجوا المنطق باعتباره ”آلة لتقويم الفاعلية العقلية وتسديدها وتجنيبها للزلات والمغاليط وتوجيه التعقيل في اتجاه المعرفة الحقة.“[31] كما اعتبره البعض منهم علما مستقلا، إشارة إلى الموقف الموروث عن الرواقيين. أما الموقف الثالث فهو موقف تمثله فئة ممارسي العلم، وهم في نظر البعزّاتي لم يتبعوا أرسطو بشكل تام ونهائي، مثلما لم يرفضوا الموروث المنطقي، بل إنهم كانوا: ”يأخذون بآليات برهان الخُلف والتحليل والتركيب والسبر والتقسيم بشكل دينامي عملي قبل الصياغة الاستدلالية الأمتن. فالباحثون في علوم الرياضيات والفلك والبصريات والميكانيكا، أمثال أبو سهل القوهي (ت. 405هـ/1014م) ومنصور ابن عراق (ت. 427هـ/1036م) والحسن ابن الهيثم (ت. 430هـ/1040م) وأبو الريحان البيروني (ت. 440هـ/1048م)، درسوا طرق الاستدلال من خلال الفاعلية العلمية الحيّة، تجريباً وإنشاءً عقلياً.“[32] فجاءت معالجتهم للقضايا العلمية بروح نقدية بناءة، وهو شرط لا بد منه لتحقيق الفاعلية العقلية وتطويرها.
ويشدد البعزّاتي على أن هذه الفاعلية العلمية لم يكن لها أن تحقق ما وصلت إليه من تطور وإبداع وإنجازات علمية، لولا اقترانها بالممارسة الفلسفية، فكان أن خصص لها فصلا مستقلا عنونه بـ”اللحمة الفلسفية“ والتي يفهم منها أنها ذات دور أساسي في تحقيق الترابط العضوي بين العلوم من جهة، ومن جهة أخرى تضمن للعالم تكوينا فلسفيا يعبد له الطريق إلى النظر في العلوم من زاوية الفيلسوف: فكما للمنطق دور في الممارسة العلمية للفلسفة كذلك دور في بناء العلم. فلا مجال للحديث عن خصوبة معرفية في غياب التكوين الفلسفي الذي يعد شرطا من شروط تحقيق الفاعلية. والقاعدة العامة بالنسبة للبعزّاتي تفيد أنه: ”لا يتطور الفكر العلمي في فراغ ثقافي، بل إن فرضياته وآليات الاختبار والبناء التي يشحذها تنبثق من المناخ الفكري السائد.“[33]على أن اندماج الفلسفة مع باقي العلوم لا يأخذ الدرجة نفسها والوتيرة نفسها: ”لقد كانت الفلسفة مندمجة بدرجة ما مع الطب والمنطق والعلوم الأخرى قرونا قبل الكندي، واستمرت كذلك بدرجات معيّنة“،[34] ومع اختلاف درجة حضور الفلسفة في كل علم على حدة يبقى أن: ”المكوّن الذي يشكّل لحمة بين العلوم هي الفلسفة بالذات؛ […] فالمبادئ التي تؤطّر التفكير والمفاهيمُ التي تنتقل تحت تأثيرها من علم إلى آخر، متداخلة، وينتج عن هذا التداخل تلاقحٌ مخصّب في الآليات وأدوات التجريب والتعقيل والبناء والنقد.“[35]وهي مقومات حاضرة في العلوم الوافدة من موروثات ثقافية أخرى، وهو الأمر الذي حصل التركيز عليه في الفصول المخصصة لأصناف العلوم العقلية وخصائصها وطرق اشتغالها. صحيح أنه يصعب الفصل بين عمليتي الترجمة والتلقي، لأن كل واحدة منهما تواكب الأخرى وتشملها، فليس هناك تلقي بدون ترجمة والعكس أيضا صحيح، لذلك نجد البعزّاتي يلحق صفة أساسية بعملية الاستيعاب حين نعتها بـ ”الاستيعاب الخلاق“. فبأي معنى يتحدث في الكتاب عن الاستيعاب المندمج الخلاق؟ وما هي حدوده؟
الباب الثالث: خصوبة الفكر العلمي
لا ينحصر الاستيعاب في مجال العلوم وحدها، مثلما لا ينحصر في مجال الفلسفة، بل إن الاستيعاب يخترق أيضا البيئة الثقافية الإسلامية بكل مكوناتها، ويفعل فيها، فيقدم نتائج عملية تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الدينية. هذا الترابط العضوي هو ما يفسر لنا لماذا يلح البعزّاتي في عنوان الكتاب على الربط بين الفكر العلمي والثقافة الإسلامية؛ فالفكر العلمي في نشأته وتقدمه مرتبط بشكل عضوي وفعال مع البيئة الثقافية التي نشأ فيها، مثلما هو مرتبط أيضا بمختلف الثقافات التي سبقته، فكانت من أبرز نتائج هذا الترابط والتلاقح على كل المستويات ما يطلق عليه الدارس ”الخصوبة الفكرية“، والتي هي نتيجة هذه المقومات جميعها، ففي نظر البعزّاتي: ”أن العلوم حصيلة مجهود فكري، ساهمت فيه ثقافات عديدة، بدون تقيّد بمعتقد ديني بعينه أو بمذهب فلسفي محدد؛ وحتى إن ارتبط علمٌ معيّن بثقافة ما تاريخياً ولغوياً وفلسفياً، فإن ذلك الارتباط يختفي تدريجياً من خلال الجدل الفكري والنقد العقلي من داخل ذلك العلم، فيقل تسرب القناعات المذهبية إلى المعرفة العلمية تدريجيا.“[36]
بغرض إبراز عند هذه الخصوبة العلمية، سيفرد البعزّاتي أربعة فصول للوقوف عند أهم تجلياتها، مع العلم أن كل فصل يمثل عِلمًا مستقلا بذاته. ومن خلاله يبرز المؤلف مدى حضور هذه الخصوبة وبأي شكل وفي أية حدود، لهذا نجده ينعت كل علم بنعت معين، فمثلا يفرد للرياضيات مصطلح الخصوبة،[37] بينما يقدم البصريات على أنها علم شهد تحولا شاملا،[38] في حين أن علم الفلك عرف بوادر التجديد،[39]وبين كل علم وعلم يقف البعزّاتي عند مرحلة الاطلاع والاستيعاب، ثم الإدماج والتخصيب، فالتجديد العلمي، إلى أن ينتهي بمرحلة الاستثمار. والظاهر أن هذه الفصول الأربعة المخصصة للعلوم هي بمثابة نماذج تطبيقية، يريد الدارس من خلالها الوقوف عند المراحل التي قطعتها هذه العلوم منذ الاقتباس إلى مرحلة الخصوبة والتوظيف الفعال، ومن خلال هذه العينات دائما يعمل البعزّاتي دائما على إبراز مدى تفاعل هذه العلوم مع الثقافات التي سبقتها، والتي لم تجد حرجا في الاطلاع عليها واستيعابها وإدماجها وتبييئها وفق ما تتطلبه حاجيات المجتمع الإسلامي.
لبيان خصوبة الرياضيات مثلا، يقدم البعزّاتي نموذجا بارزا في هذا المجال، ألا وهو العالم الرياضي الخوارزمي (ت. بعد 232هـ/847م)، على اعتبار أنه ”أول من أتى بأسس العلم الجديد؛“[40] لكن في الوقت نفسه نجده يؤكد على أن الخوارزمي ”لم ينطلق من فراغ […]؛ لكنه وظّف اطّلاعه بطريقة خلاقة من خلال انخراطه في حل مسائل عيانية في الفلك العملي والفرائض وحساب المساحة.“[41] فعالم الرياضيات لم يقف عند عتبة الاستيعاب والفهم، بل إنه استطاع وبشكل تدريجي تطوير هذا العلم واستثماره في مجالات عملية أخرى. وتتجلى هذه الخصوبة العلمية في علم الرياضيات على وجه التحديد، في أن بعضا من معاصري الخوارزمي قد أصبحوا قادرين على التجديد والاستمرارية في بعض القضايا العلمية، كما هو الشأن بالنسبة لأبي الفضل عبد الحميد بن واسع بن تُرك (ت. ح 240هـ/854م) الذي ”وصل إلى صيغة للجبر قريبة جداً من جبر معاصره الخوارزمي.“[42] كما اقترح علماء الرياضيات منهجا جديدا من خلال استخراج المجهول من المعلوم عن طريق سلسلة من المعادلات، فضلا عن إعادة خلق صرح جديد لهذا العلم؛ ”فقد تناسلت المسائل الرياضية وامتدت رقعة الحقول واغتنت اللغة واتسعت سبل البرهنة فيها. فمحمد بن عيسى الماهاني (ت.ح 260هـ/880م) وآخرون يصوغون المسائل الهندسية في معادلات جبرية، وثابت بن قرة (ت. 288هـ/901م) يؤسس نظريات الجبر من الدرجة الثانية على براهين هندسية؛[…] وضمن السيرورة التجديدية ذاتها، قام ابن الهيثم بإعادة سبك الأسس الأولية التي يقوم عليها الصرح الأقليدي واستنباط المبرهنات بأسلوب أبين.“[43]ومن بين الأمور التي تشهد على إبداع علماء الرياضيات المنتمين للثقافة الإسلامية مقارنة مع علماء الحضارة الإغريقية هو أن هذه الفئة الأخيرة وقفت: ”على عتبة العدد اللانهائي، لكنهم لا يذهبون إلى حدّ استنتاج أفكار واضحة من ذلك. بينما حاول علماء الرياضيات في البيئة الإسلامية تجاوز السقف الموروث عن الإغريق. فالعالِم المبدع أبو الحسن بن قُرّة يعبّر بأسلوب أوضح عن اللانهائي.“[44]
يبدو إذن من خلال هذه النماذج التي قدمها البعزّاتي كشواهد على حضور الخصوبة العلمية في مجال الرياضيات، أنها تحققت من حيث الاستيعاب والإدماج وإعادة السبك والفحص والنقد والإبداع أيضا؛ فـ”الرياضيات زمن ابن قُرّة وابن الهيثم ومَن مِن جيليْهما بلغت شأواً عالياً في الخصوبة والبرهانية يتجاوز الحدّ الذي وصلت إليه قبلهما ويفتح آفاقا جديدة من التطور.“[45] وإذا كانت الرياضيات قد أنجزت هذا المستوى من الخصوبة العلمية، فكيف استطاعت البصريات أن تصل إلى مستوى التحول الشامل؟
استفاد علم البصريات من التراكم المعرفي الحاصل على مستوى هذا العلم، لا سيما ما قدمه علماء الإغريق من مساهمات في هذا الباب، وهو تراكم وجد فيه علماء الحضارة الإسلامية ”بذور التطوير“: ”فقد تُرجم كتاب اقليدس في البصريات عند بداية القرن التاسع الميلادي من قِبل هِليا بن سرجون (ت.ح 212هـ/827م) وأبو الحجاج بن مطر (ت.ح 218هـ/833م)، بعنوان كتاب أقليدس في اختلاف المناظر.“[46] فتجاوز علماء أمثال الكندي (ت. 256هـ/873م) وقسطا بن لوقا (ت.ح 912م) وابن الهيثم مرحلة الاستيعاب إلى مرحلة التصحيح والمساءلة والنقد وإعادة السبك، وخلق مفاهيم جديدة تلائم ما وصل إليه علم البصريات من تطور، هذا دون إغفال عملية الدمج التي أكد عليها ثلة من العلماء أي دمج الهندسة بالتجريب، كما أن التركيز على بعض القضايا كقضية الانعكاس والإحراق كانت لها آثار إيجابية على الجانب التقني. هذا وقد عرف العالم ابن الهيثم بمسألة التدقيق من زاوية التجريب؛ إذ ”وصل ابن الهيثم القمّة في التدقيق التجريبي وصنع وتوظيف التجهيزات المخبرية والصياغة الرياضية. وقام بالتأليف النقدي بين الأفكار من منطلق تركيبي بنائي، مكّنه من إعادة إنشاء علم البصريات برمّته، محتوى ومنهجا.“[47] فكان لـهذا الانخراط الشامل وفي كل المستويات نتائج على علم البصريات. وبالفعل يؤكد البعزّاتي على أنه ”وبفضل بصريات ابن الهيثم، يمكن النظر من منطلق جديد في تكوّن المفاهيم والتصورات، أو الصور الكلية، التي كان يُنظر إليها باعتبارها أُطراً عقلية سابقة عن الخبرة العملية. إن الصور الكلية تنشأ في الذهن وتتعرّض للتشذيب تدريجياً في ضوء تجدّد التمرين، فتمكّن من مقابلة المدرَكات الجزئية؛ وهي التي تلعب دوراً في تكوين الأحكام وشحذ فاعلية التعقيل والتقييم؛ وبتلك الفاعلية تغتني تلك الأطر وتؤثر في المدرَكات في نفس الوقت.“[48]
إن ما يصفه البعزّاتي بشحذ الفاعلية والتعقيل والتقييم، هي شروط توفرت في علم الفلك أيضا حيث قطع هذا العلم أشواطا أساسية ساهمت في تأهيله إلى مستويات جديدة من التطور. وفي هذا السياق عرف المجتمع الإسلامي كتبا تهم علم الفلك من أبرزها: ”كتاب جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية، الذي ألّفه ابن كثير الفرغاني في منتصف القرن التاسع الميلادي.“[49] فقد اقتضى التجديد في علم الفلك، من جهة أولى، التمحيص فيما كتب حول هذا العلم من قبل الحضارات الأخرى، مثلما راعى من جهة ثانية النسبية في تعاملهم مع هذه الموروثات التي اهتمت بقضايا علم الفلك، لكنها لم تحسم في نتائجه، وهو الأمر الذي كان يدركه علماء الحضارة الإسلامية أمثال ابن الهيثم والبيروني؛ ”فقد أدرك العلماء أن ما توصل إليه العلماء من الأجيال السابقة مجرد مستوى في نموّ الأفكار، وأن العلم لا يتوقف عند حد نهائي، وأن كل معرفة تظل باستمرار في حاجة إلى تنقيح وتهذيب وبيان. ويلزم عن هذا إقرارٌ بأن كل معرفة مشروطة بظروف فكرية وتقنية وواقعة تحت تأثير السائد من المسلّمات.“[50]
فالآليات العقلية التي تحكمت في اشتغال ابن الهيثم، والمتمثلة في التنقيح والتهذيب والفحص والمراجعة، قد سمحت له بمراجعة نتائج علم الفلك على ضوء ما استجد من معطيات في علم البصريات. ويستنتج البعزّاتي من هذا المثال أن تفاعل بعض العلوم مع بعضها البعض يخدم تطورهما معا، وهذا بالضبط ما حصل مع علم البصريات وعلم الفلك؛ ”فقد كان لتقصّي ابن الهيثم في أبحاثه البصرية أثر مهمّ على أبحاثه الفلكية وأحكامه على مضامين الفلك الموروث عن القدماء.“[51]
بعد هذه الخطوة جاءت محاولة الإصلاح من خلال الكشف عن ثغرات وأخطاء العلم القديم، فتم البحث عن نماذج بديلة أو مغايرة للنموذج القديم. ولقد وقف ابن الهيثم عند ثلاثة مشاكل اعتبرها من بين أبرز المشاكل التي تعترض علم الفلك في مستوى تقدمه وهي: الرصد، ودقة الآلات، والنمذجة الهندسية.[52] ومن هنا توفق ابن الهيثم في تدخله في تغيير بعض المقادير ومراجعتها، مع الإبقاء على التصور البطلميوسي؛ لكن ابن الهيثم كان ”يعيد سبكه في قالب برهاني ورياضي أمتن. ولم يبق مستبعَدا عنده إلا فرضية دوران الأرض حول نفسها وحركتها حول الشمس.“[53]
لم يكن اختيار البعزّاتي للعلوم الميكانيكية والتطبيقية كآخر فصل من الفصول المرتبطة بالعلوم اختيارا عشوائيا؛ فقد ”أصبحت الفاعلية العلمية في الميكانيك مستوعبةً للمبادئ المتعارَفة ضمن هذا العلم، لِما قد بلغت من وضوح، ولا يشار إليها إلّا باعتبارها مدخلاً تربوياً أو تقْدِمةً إبستمولُجيةً.“[54]وحتى يحقق هذا العلم درجة متقدمة من الفاعلية، أصبح من المؤكد أن يقطع أشواطا ومراحلا، كما هو الشأن بالنسبة للعلوم الأخرى، إذ هناك أولا مرحلة الاستيعاب والاطلاع، وفي هذا الباب تدخل إنجازات ومحاولات بني موسى بن شاكر، لأنها تمثل مرحلة امتداد وتطوير لما وصل إليه البحث عند القدماء.[55] ثم تأتي بعد ذلك مرحلة ”الإدماج والتخصيب“ والتي يقارن فيها العلماء بين النماذج العلمية، وأحيانا يدمجون بعضا من مكوناتها مع بعضها البعض، كأن يتم مثلا الدمج بين الهندسة والتجريب، أو بين علم وعلم آخر كما حصل مع علم البصريات وعلم الفلك. وبعد هذه الخطوة يصل علم الميكانيكا في مرحلة ثانية إلى مستوى التجديد فـ”درس هؤلاء العلماء والتقنيون الأسس الهندسية للثقل والخفة والتوازن والطفو والضغط، وأنشأوا على منوالها تجهيزات وأدوات ومباني وجسور وأدوات مختلفة الاستعمالات؛“[56] وهو أمر يحيلنا على مستوى استثمار العلماء و توظيفهم لنتائج علومهم في جوانب عملية وتقنية أيضا. يقول: ”هكذا كان العلم الميكانيكي حلقة وصل أساسية بين الفاعلية النظرية والفعل التقني في كل مرافق الحياة العيانية؛ فعرف المسلمون أنواع التربة والأحجار والمعادن والخشب والنباتات من أجل استثمار المعرفة في صنع السيوف والأواني وموادّ النظافة والزينة وآلات الموسيقى والترفيه.“[57]ويظهر أن امتياز علم الميكانيكا في الربط بين الفعل النظري والفعل التقني، وهذا أمر مكمل وأساسي في إنجاح الفاعلية العلمية وضمان لاستمراريتها، كان مبررا كافيا ليؤخر البعزّاتي حديثه عنه.
الباب الرابع: التجديد والمقاومة
تباينت المواقف وتعددت تجاه ما يعرف بعلوم الأوائل؛ حيث شهدت هذه العلوم ترحيبا من قبل جهات كثيرة مشجعة للعلم، بما في ذلك بعض المذاهب الفقهية التي عرفت بمرونتها كما هو حال الفقه الحنفي، بينما اتخذت بقية المذاهب السنية، الحنبلية والمالكية والشافعية، نوعا من التحفظ تجاه هذه العلوم؛ وأحيانا وقفت موقفا عدائيا جملة وتفصيلا. وهكذا، فإن الفاعلية العلمية إذن لم تلق الترحيب والقبول دائما، بل كثيرا ما تمت ملاحقتها ومحاربتها، وهو الموضوع الذي أفرد له البعزّاتي الفصل الأخير من كتابه المعنون بـ”التجديد والمقاومة“.
وما قد يثير انتباه القارئ في هذا الفصل هو التصريح الجريء الذي جاء على لسان صاحبه، إذ يقول: ”الخصوبة الفكرية التي برزت منذ أواخر القرن الثامن الميلادي (بُعيد منتصف القرن الثاني للهجرة)، لم تنبُع من صميم ثقافة عربية إسلامية محضة مفترضة.“[58] وهذا قول نفهم منه أن هذه الخصوبة المرتبطة بالحضارة الإسلامية، ساهمت فيها كل الثقافات وتفاعلت معها وامتزجت مع مكوناتها، فلم يعد بالإمكان ربط هذه الخصوبة بعناصر داخلية منفردة؛ إذ ”لم يساهم الإسلام، من حيث هو معتقد ديني، في تطور النظر العلمي بأي قسط يُذكر“؛[59] لأن هذه الخصوبة الفكرية كانت سائدة حتى في ظل معتقدات أخرى وفي سياقات ثقافية مختلفة. فمن الخطأ بالنسبة إلى البعزّاتي الاعتقاد أن الفضل في تطور العلوم يعود إلى الإسلام بوصفه دينا؛ هذا اعتقاد خاطئ يجب تفاديه، لأنه لا يقدم لنا صورة واضحة ومكتملة عن هذه الفاعلية الخصبة. وبالجملة، فإن ”الإنجازات العلمية، لم تكن بفعل اتّباع المعتقد أو النصح أو الأوامر، بل كانت تندرج في سياق امتداد التفاعلات الثقافية وخصوبة التقاليد الفكرية الموروثة عن الحضارات السابقة.“[60] كما أنه من غير الصواب الاعتقاد أن هذه الفاعلية جاءت نتاج ”تحالف بين الفقه السني والعقل اليوناني ضد المزاعم الباطنية.“[61] بل إن الأمر يتعلق أساسا بإعادة ”تغيير الأولويات من خلال ترتيب التحالفات بين التيارات المذهبية، مؤديا إلى تعويل أكبر على الفاعلية النقدية، بفعل التعرف على مختلف التجارب الماضية.“[62]
ولا ينبغي أن نفهم من هذه العودة إلى تراث القدماء أن الأمر يتعلق بتفاضل بين الثقافات، إذ لا يبدو أن البعزّاتي، حين تأكيده على فكرة الاقتباس من الموروثات القديمة والسابقة على الحضارة الإسلامية، ينحاز لثقافة ما على حساب ثقافات أخرى، وإنما كان غرضه إظهار أن الخصوبة الفكرية التي عرفتها البيئة الإسلامية لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في ثقافات أخرى سابقة عنها. ففي نظره، ”لا يختلف البحث العلمي في سياق الثقافة الإسلامية عن مثله في سياق ثقافي آخر اختلافا كبيرا. ولهذا فخصوبة الفكر العلمي لدى العلماء الذين عاشوا في أحضان الثقافة الإسلامية لا تختلف كيفيا عن الخصوبة في سياق ثقافة أخرى.“[63] لكن علماء الثقافة الإسلامية كانوا على وعي تام بـأن هذه الخصوبة من فترة لأخرى تعترضها عوائق من قبل الفئة المتزمتة التي ترفض كل شكل من أشكال التجديد.
وهذا في تقديرنا ما دفع البعزّاتي إلى أن يختم كتابه بمقال قد سبق أن نشر، وهو بعنوان ”كلدتسيهر والعلوم العقلية في الثقافة الإسلامية“[64] هذا بدلا من أن يستجمع نتائج تحليلاته في الفصول السابقة، ويضع هذا المقال ملحقا لكتابه مثلا. والظاهر أن البعزّاتي قد خصص هذا الجزء من الكتاب لتناول أطروحة كان المستشرق النمساوي إغناس كلدتسيهر قد اشتهر بها بخصوص منزلة العلوم الفلسفية في الثقافة الإسلامية؛ وهي العلوم التي لم تحظ بالترحيب من قبل بعض الفقهاء والمحدّثين السنة أو ”الأورثدوكسية“.[65] وعلى الرغم من مرور قرن من الزمن على دراسة جولدسيهر وتعرضها لانتقادات كثيرة من قبل الدارسين، فقد ارتأى البعزّاتي توظيف مقاربة گلدتسيهر والدفاع عن قدرتها التفسيرية في وجه منتقديها؛[66]ففي نظره ”تظل دعوى گلدتسيهر متمتعة بنصيب مهم من الصواب؛ وقد تتزايد درجة الصواب في نفس القارئ على إثر اكتشاف نصوص أخرى للمتشددين.“[67] وحتى نفهم لماذا يوثر البعزاتي أطروحة هذا المستشرق مقارنة مع باقي الأطروحات التي قدمت مواقفَ متباينة حول ردود فعل المسلمين تجاه انتشار العلوم العقلية في الثقافة الإسلامية، نعود إلى فصول الكتاب مرة أخرى للنظر مجددا في موقف الفقهاء من الفاعلية العلمية بكل مكوناتها.
يتتبع البعزّاتي في معظم فصول الكتاب مواقف الفقهاء والمحدثين من العلوم القديمة ومن انتشار تعاطيها بين المسلمين. وقد اتخذت هذه المواقف، في غالب الأحيان، صيغة التحفظ والرفض، وأحيانا تكفير المشتغلين بها والتشنيع بهم. فبدءا بالفصل الأول المخصص للنظر في وظائف الدولة وصولا إلى الفصل المخصص لعلوم الميكانيكية والتطبيقية، لا يتردد المؤلف في الوقوف عند بعض تفاصيل هذا الرفض، والذي يتخذ أشكالا مختلفة وبمبررات واهية أحيانا. ففي إشارة منه إلى الإقبال على العلوم العقلية من قبل مجموعات من غير العرب ولا المسلمين، يشير في المقابل إلى الفئة المعادية لهذه العلوم: ”في حين بقي عرب مسلمون آخرون يناهضون الانفتاح على المعارف والخبرات المتنوعة التي ظلوا ينظرون إليها باعتبارها ’أجنبية‘ عنهم.“[68] وحتى الجدل الديني لم يسلم بدوره من هذه الهجومات: ”فكانت آراؤهم هجينة لا تسمح باستنتاج أفكار قابلة للتطوير والتوسيع، لأنهم أساساً ضد بلورة أفكار جديدة.“[69] وقد امتد هذا الرفض إلى النظر الفقهي أيضا، فـ”الفقهاء المتزمتون وقفوا ضد إعمال النظر النقدي، ومارسوا مراقبة مباشرة على السلوك، مثل ما سار عليه العمل الحنبلي من هجوم على المفكرين المتفتحين على الآراء المختلفة؛ كما عمد الحنابلة إلى العنف المادي في الفضاء العمومي.“[70] في مقابل هذه الفئة نجد فئة مقبلة على الحوار والنقد، مرحبة بمختلف العلوم العقلية، لاسيما بعض العلوم التي لها منفعة في العلوم الشرعية، كعلم الفرائض وعلم الميقات؛ ويقول في هذا: ”فعلاً، قلّة من فقهاء السنّة، وأغلبهم أحناف، أدركوا أن هذه الآليات الرياضية مفيدة، وأنها ليست خاصة بثقافة دون أخرى.“[71] لكن البعزّاتي يذكر مجددا بأن الفئة المتزمتة رفضت حتى فكرة الاطلاع على هذه العلوم التي اعتبرتها أجنبية وغريبة على بيئتها. وفي سياق الرفض تم التحفظ على الاجتهاد خصوصا من قبل المالكية والحنبلية.[72] كما تم رفض أو تداول العلوم العقلية إلى درجة أن عملية الاطلاع على مضامين هذه العلوم كان يتم في الخفاء.
وحيث أن عملية الاقتباس قد تزامنت أحيانا مع عملية الترجمة، فإن هذه الأخيرة أيضا لم تحظ بالترحيب من قبل هذه الفئة المناوئة للعلوم العقلية، إذ ”ظلت الأغلبية العظمى من المتعلّمين ذوي الثقافة العربية الإسلامية المحضة، من أهل الحديث والفقه وبعض الزهّاد والمتكلمين، غير مهتمّة بمكامن الفكر المترجَم؛ بل إن بعضهم عارض الاطلاع على هذا الفكر المنقول حتى وهُم يجهلون محتوياته.“[73] فظلوا متمسكين بالنصوص الدينية التي لا تحتاج في نظرهم إلى تصويب أو تساؤل أو أي فحص عقلي، ومن أخطر نتائج هذا الموقف هو ”التمركز حول الذات“ واعتبار الشخصية العربية هي النموذج الأمثل والأفضل.
هذا الموقف الرافض للعلوم، انعكس سلبا، إلى حد ما، على بعض العلوم. حيث قبلت فئة الفقهاء المحافظين بـ”الطب التقليدي أو النبوي“، ورفضت في المقابل ”الطب اليوناني“، فاعتبرته بديلاً عن الطب المرتبط بالعلوم العقلية، لا اعتباراً لفعاليةٍ ما في الفهم والعلاج؛ إضافة إلى أنه أقلّ تكلفة بكثير. غير أن هذا ”الطب“ لم يعرف تطوراً، لأن وظيفته الأساسية قائمة على ارتباطه بالعلوم النقلية والدينية؛ إذ لم تخضع محتوياته للفحص والتنقيح، بل ظلت عبارة عن نصائح تنتقل من جيل إلى جيل بدون تمحيص ولا مراجعة.“[74] ومثلما لم يقبل فئة المحافظون الطب اليوناني، رفض متكلمون سنة وشيعة، ومن منطلقات لغوية ودينية، منطق اليونان؛ فـ”كتب الناشئ الأكبر (ت.ح. 293هـ/905م) وأبو محمد النوبختي (ت. ح320هـ/932) […] ضد المنطق.“[75] أما الفلسفة التي أسند إليها البعزّاتي دور اللحمة بين العلوم، فإنها لم تسلم من هجوم وإقصاء من قبل هذه الجهات المتطرفة؛ فـ”الواقع أن أغلب الفقهاء المتزمتين وبعض المدافعين عن هوية عقيدية منغلقة وقفوا ضد الفلسفة معتبرين إياها مروقا […] فالفلسفة في نظر المعارضين تستلزم الجهل بالدين والتعالي على عموم الناس وادعاء الاطلاع الواسع؛ إضافة إلى أنهم يضعون حتى العلوم ”الحقة“ مع الفلسفة بحكم الترابط المفهومي بينها.“[76] وفي المقابل، فقد أدرك بعض الفقهاء ورجال الدين منافع بعض العلوم. وهكذا أقبل بعضهم على الرياضيات، لما لها من آثار عملية على بعض العلوم كعلم المواقيت وعلم الفرائض.
ولم يسلم علم الفلك من أشكال الرفض والإقصاء، لكن بالنسبة لعلم الفلك، كان رفضه أحيانا ناتجا عن عدم إلمامهم بأسس هذا العلم، وجهلهم بقضاياه فـ”عارض بعض المناوئين هذا العلم ولو عن جهل، وعارض المتزمتون حتى علم المواقيت الذي أتى بتوجيهات مفيدة في ضبط أوقات الصلاة وتحديد اتّجاه القبلة وحساب رؤية الهلال.“[77] هذا كان باختصار نموذجا يمثل حدة ودرجة معارضة بعض الفقهاء وبعض المذاهب للفاعلية العلمية ولكل نظر عقلي. ويبرر البعزّاتي هذا العداء من قبل رجال الدين بقوله: ”فهم يعادون التفكير النظري ويؤكدون على ضرورة اقتران العلم بالعمل. في حين أن من طبيعة العلوم ’العقلية‘ أنها بقدر ما تتقدم في النمو ترتقي في التجريد النظري، […] فيستتبع هذا التجريد أمرين: من جهة أن الفقهاء لا يتابعون، ولا يستطيعون متابعة، نموّ العلوم؛ ومن جهة أخرى يبتعد الفكر العلمي عمّا يسمّيه الفقهاء بالعلم النافع؛ […] فيناهضون العلم لأنهم لا يفرّقون بين التجريد العلمي والتأمّل الفلسفي والتخمين الخميائي والتنجيم.“[78] كما يوضح الدارس أن هذه الفئات المتزمتة وإن اتفقت على مبدأ عدم القبول بهذه العلوم العقلية، فهي تختلف ”حول بعض الجزئيات، من محافظ يحكم على الأفكار من منطلقات مسبقة،وكسول لا يريد أن يفكر، ومتزمّت يرفض حتّى الاطلاع على كل فكر ’أجنبيّ‘.“[79]
خاتمة
ختاما نقول إن نوع المقاربة التي اعتمدها البعزّاتي قد أسعفته في الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ظهور الفكر العلمي في سياق الثقافة الإسلامية. كما سمحت له بالوقوف عند مكونات هذا الفكر، وعند أهم المراحل التي قطعها لكي يشهد خصوبة علمية؛ وهي خصوبة بصمت تاريخ هذا الفكر، وعملت على إبراز أهم سماته؛ والممثلة أساسا في أسلوب فكري قائم على النقد والتحليل والمراجعة والتصحيح والتجديد أيضا. ولولا توفر قنوات للتواصل (مراكز علمية، وجماعة علمية، وإدماج التنظير وفعل الاختبار، وخلق أدوات جديدة إلخ…) لما حققت هذه الفاعلية درجة من الدقة التي يشهد لها تاريخ المعرفة العلمية اليوم.
لكن هذا التاريخ أيضا يشهد على بعض الإخفاقات التي كانت من نصيب هذا الفكر. وفي هذا الباب فإن تركيز البعزّاتي على ربط هذا الإخفاق بدور المذاهب الفقهية ودور بعض الحكام في إفشال هذا المشروع الفكري لم يسمح له بالنظر إلى عوامل أخرى، ربما تكون هي المسؤولة عن ذلك الإخفاق؛ ومنها عدم تمكن العلماء والفلاسفة أنفسهم من خلق مدارس وامتدادات حقيقية تمثلهم وتكمل ما قدموه من إسهامات لهذا الفكر، عن طريق التمسك ببعض الأنساق الفكرية والفلسفية؛ خاصة وأننا نلاحظ كيف استطاع بعض التيارات الفلسفية من اختراق الدوائر المعادية لها؛ ولنا في السينوية التي اكتسحت ساحة المتكلمين والأصوليين والمتصوفة خير دليل.
يبدو لنا أيضا أن الدراس قد ظل حبيس ثنائية الفكر العلمي—وهو في الغالب غير عربي وغير إسلامي—والثقافة الإسلامية، وهي في الغالب مقاومة للفكر العلمي، إلا ما كان من بعض العناصر غير العربية وغير الإسلامية فيها. وهذه الثنائية في تقديرنا لم تتجاوز الرؤية الاستشراقية التي أفصح عنها الدراس في كتابه والتي ظل متمسكا بها في خاتمته. ويبدو أن هذه الرؤية لم تسمح له بالتحرر من قيود هذه المقاربة التي تثمن عمل العلماء المشتغلين في ظل الحضارة الإسلامية والوافدين من ثقافات أجنبية، وفي نفس الوقت تحمل مسؤولية فشل أو تعثر عمل العلماء المسلمين لعلوم الأوائل إلى فئة الفقهاء المتشددين.
وأخيرا فإن تأكيد البعزاتي على أن عامل الدين لم يكن له أي دور في تلقي واستيعاب العلوم العقلية، يفرض علينا أن نسائل الدراس هل يفترض أن يقدم الدين، كيفما كان نوعه، إسهاما فعالا وإيجابيا في تطور المعارف في سياقات أخرى. فهل سبق للدين في حضارة من الحضارات أن لعب دورا مباشرا في تطور العلوم والمعارف؟ أم أن الدين، مهما يكن مرنا ومعتدلا تجاه هذه العلوم والمعارف، قد ظل ينظر إليها من منظور الخدمة والمنفعة؟
بيبليوگرافيا
البعزاتي، بناصر. الفكر العلمي والثقافة الإسلامية. الرباط: دار الأمان، 2015.
ـــــــــــــــــــــــ. ”أطروحة گُلدتسيهر عن مكانة العلوم العقلية في الثقافة الإسلامية.“ مجلة فكر ونقد، عدد 91 (2007): 65–78.
ـــــــــــــــــــــــ. الاستدلال والبناء: بحث في خصائص العقلية العلمية الاستدلال والبناء: بحث في خصائص العقلية العلمية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1999.
ـــــــــــــــــــــــ. الاستدلال والبناء: بحث في خصائص العقلية العلمية الاستدلال والبناء: بحث في خصائص العقلية العلمية، ط. 2. الرباط: دار الأمان، 2019.
ـــــــــــــــــــــــ. خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة العلمية. دار الامان: الرباط، 2007.
ـــــــــــــــــــــــ. في النهضة الحضارية في أوروبا خلال القرن الخامس عشر. الرباط: دار الأمان، 2000.
بن أحمد، فؤاد. ”الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري گوتاس: قراءة نقدية في الترجمة العربية.“ موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية. الرابط:https://philosmus.org/archives/697
جبار، أحمد. علماء الحضارة العربية الإسلامية ومساهماتهم (العلوم الرياضية والفلكية وتطبيقاتها) ق9م- ق15م. الجزائر: كليك للنشر، 2011.
جولدتسيهر، إجنتس. ”موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل.“ ضمن التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية: دراسات لكبار المستشرقين. ألف بينها وترجمها عن الألمانية والإيطالية عبد الرحمن بدوي، 123–172. القاهرة: دار النهضة العربية، 1940.
راشد، رشدي. دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011.
صبره، عبد الحميد. العلم العربي في حضارة الإسلام. الكويت: دار قرطاس للنشر، 2000.
صليبا، جورج. الفكر العلمي العربي نشأته وتطوره. بيروت: مركز الدراسات المسيحية الإسلامية، 1998.
گوتاس، ديمتري. الفكر اليوناني والثقافة العربية. ترجمة وتقديم نقولا زياده، ط.1. بيروت: المنظمة العربية للترجمة-مركز دراسات الوحدة العربية، 2003.
Gutas, Dimitri. Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries). London: Routledge, 1998.
للتوثيق
فدواش، نظيرة. ”الفكر العلمي والثقافة الإسلامية لعناصر البعزاتي: مراجعة.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2590>
نظيرة فدواش
[1] وقد صدر الكتاب أول الأمر عام 1999 بالدار البيضاء عن المركز الثقافي العربي وبالرباط عن دار الأمان. وقد أصدرت الدار الأخيرة العام 2019 طبعة ثانية منقحة للكتاب.
[2] صدر الكتاب عام 2000 عن دار الأمان بالرباط.
[3] صدر الكتاب عام 2007 عن دار الأمان بالرباط.
[4] البعزّاتي، الفكر العلمي، 14.
[5] Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries) (London: Routledge, 1998).
وقد صدرت الترجمة العربية منذ سنوات. انظر: ديمتري گوتاس، الفكر اليوناني والثقافة العربية، ترجمة وتقديم نقولا زياده، ط.1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة-مركز دراسات الوحدة العربية، 2003). ويجدر بنا أن نذكر أن من الدارسين من انتبه إلى سوء الترجمة العربية. انظر: فؤاد بن أحمد، ”الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري گوتاس: قراءة نقدية في الترجمة العربية،“ الرابط: https://philosmus.org/archives/697
[6] جورج صليبا، الفكر العلمي العربي نشأته وتطوره (بيروت: مركز الدراسات المسيحية الإسلامية، 1998).
[7] رشدي راشد، دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011).
[8] عبد الحميد صبره، العلم العربي في حضارة الإسلام (الكويت: دار قرطاس للنشر، 2000).
[9] أحمد جبار، علماء الحضارة العربية الإسلامية ومساهماتهم (العلوم الرياضية والفلكية وتطبيقاتها) ق9م-ق15م (الجزائر: كليك للنشر، 2011).
[10] البعزّاتي، الفكر العلمي، 14.
[11] البعزّاتي، الفكر العلمي، 32.
[12] البعزّاتي، الفكر العلمي، 11–12.
[13] البعزّاتي، الفكر العلمي، 13–14.
[14] البعزّاتي، الفكر العلمي، 24.
[15] البعزّاتي، الفكر العلمي، 31.
[16] يقول البعزاتي بخصوص عائلة بختيشوع التي ورثت الطب من جيل إلى جيل بالموازاة مع حكم الخلفاء العباسيون: ”ينحدر جيرايل، طبيب الخلفاء الرشيد والأمين والمأمون، من نسب من الأطباء مارسوا الطب والترجمة والتأليف خلال قرون؛ وألف هو أيضا في الطب والمنطق. وجده جورجيس بن جبرايل هو الذي استقدمه المنصور العباسي من جنديسابور لعلاجه في بغداد عام184/756؛ أما أبوه بختيشوع فكان رئيس الأطباء زمن الرشيد. وعاشت عائلة بختيشوع في تنافس مع عائلة ماسويه، أبا عن جد حول النبوغ والحظوة والثروة.“ البعزاتي، الفكر العلمي، 123.
[17] البعزّاتي، الفكر العلمي، 39.
[18] البعزّاتي، الفكر العلمي، 125.
[19] البعزّاتي، الفكر العلمي، 126.
[20] البعزّاتي، الفكر العلمي، 133.
[21] البعزّاتي، الفكر العلمي، 134.
[22] البعزّاتي، الفكر العلمي، 134.
[23] البعزّاتي، الفكر العلمي، 136.
[24] البعزّاتي، الفكر العلمي، 137.
[25] البعزّاتي، الفكر العلمي، 103–107.
[26] البعزّاتي، الفكر العلمي، 111.
[27] البعزّاتي، الفكر العلمي، 109.
[28] البعزّاتي، الفكر العلمي، 159.
[29] في الفقرة الأخيرة من فصل ’الطب خبرة ومعرفة‘ يفرد البعزاتي عنوانا للطب التقليدي، حتى يميز بينه وبين الطب الموروث من ثقافات أجنبية، فالأول تم تبنيه من قبل فئات معينة كما هو أمر بعض الفقهاء الذين آثروا هذا النوع من الطب واعتبروه بديلا لذلك الطب الوافد من حضارات مختلفة؛ يشير البعزاتي على أنه ”مع مرور الأيام سمي هذا ”الطب“― وهو مشترك بين تقاليد ثقافية عديدة قديمة― بالطب النبوي، قصد إعطائه شرعية دينية وتأثيرا على الأذهان؛ ومن أولى المؤلفات التي استعملت هذا المعنى كتاب ابن السني (ت.ح 364هـ/975م) بعنوان ”الطب النبوي.“ لمزيد من التفاصيل حول الأسماء التي تعاطت لهذا النوع من الطب، انظر: البعزّاتي، الفكر العلمي، 179– 180.
[30] في بداية هذا الفصل المخصص لصناعة المنطق، يشير الدارس إلى أن اتصال المسلمين بهذه الصناعة كان اتصالا متواضعا لم يتجاوز التلاخيص والشروح التي أنجزت في هذا الباب، ومن أبرز من اشتغل بهذه الصناعة نذكر: ابن المقفع (ت. 142هـ/752م) ويحيى بن البطريق (ت. ح. 200هـ/815م). انظر: البعزّاتي، الفكر العلمي، 181.
[31] البعزّاتي، الفكر العلمي، 190.
[32] البعزّاتي، الفكر العلمي، 199.
[33] البعزّاتي، الفكر العلمي، 203.
[34] البعزّاتي، الفكر العلمي، 205.
[35] البعزّاتي، الفكر العلمي، 206.
[36] البعزّاتي، الفكر العلمي، 239.
[37] انظر : البعزاتي، الفكر العلمي، 243.
[38] انظر: البعزاتي، الفكر العلمي، 265.
[39] انظر: البعزاتي، الفكر العلمي، 287.
[40] البعزّاتي، الفكر العلمي، 246.
[41] البعزّاتي، الفكر العلمي، 246.
[42] البعزّاتي، الفكر العلمي، 248.
[43] البعزّاتي، الفكر العلمي، 261.
[44] البعزّاتي، الفكر العلمي، 262.
[45] البعزّاتي، الفكر العلمي، 263.
[46] البعزّاتي، الفكر العلمي، 271.
[47] البعزّاتي، الفكر العلمي، 272
[48] البعزّاتي، الفكر العلمي، 283.
[49] البعزّاتي، الفكر العلمي، 288.
[50] البعزّاتي، الفكر العلمي، 296.
[51] البعزّاتي، الفكر العلمي، 298.
[52] البعزّاتي، الفكر العلمي، 306.
[53] البعزّاتي، الفكر العلمي، 307.
[54] البعزّاتي، الفكر العلمي، 323.
[55] البعزّاتي، الفكر العلمي، 313.
[56] البعزّاتي، الفكر العلمي، 320.
[57] البعزّاتي، الفكر العلمي، 326.
[58] البعزّاتي، الفكر العلمي، 331.
[59] البعزّاتي، الفكر العلمي، 336.
[60] البعزّاتي، الفكر العلمي، 346.
[61] البعزّاتي، الفكر العلمي، 332.
[62] البعزّاتي، الفكر العلمي، 333.
[63] البعزّاتي، الفكر العلمي، 336.
[64] نشرت الصيغة الأولى للمقال في سياق سجالي في صحيفة الاتحاد الاشتراكي؛ ثم أعيد نشره في مجلة فكر ونقد، عدد 91 (2007)، بعنوان: ”أطروحة گُلدتسيهر عن مكانة العلوم العقلية في الثقافة الإسلامية“. ومقالة إجناس جولدتسيهر كانت قد صدرت بالألمانية عام 1916؛ ونشر عبد الرحمن بدوي ترجمة عربية لها. انظر: إجنتس جولدتسيهر، ”موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل،“ ضمن التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (القاهرة: دار النهضة العربية، 1940).
[65] البعزّاتي، الفكر العلمي، 351.
[66] انظر ردوده على الانتقادات التي وجهها كل من جورج مقدسي وعبد الحميد صبره وديمتري غوتاس وسنيا برنتجس لدعوى غولدسيهر: البعزّاتي، الفكر العلمي، 359–363.
[67] البعزّاتي، الفكر العلمي، 363.
[68] البعزّاتي، الفكر العلمي، 32.
[69] البعزّاتي، الفكر العلمي، 55.
[70] البعزّاتي، الفكر العلمي، 72.
[71] البعزّاتي، الفكر العلمي، 74.
[72] انظر تفاصيل ومعطيات حول هذا الموضوع: البعزّاتي، الفكر العلمي، 75.
[73] البعزّاتي، الفكر العلمي، 135.
[74] البعزّاتي، الفكر العلمي، 180.
[75] البعزّاتي، الفكر العلمي، 188.
[76] البعزّاتي، الفكر العلمي، 220.
[77] البعزّاتي، الفكر العلمي، 307.
[78] البعزّاتي، الفكر العلمي، 349.
[79] البعزّاتي، الفكر العلمي، 342.
مقالات ذات صلة
قراءة نقديّة: موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (557هـ-629هـ). ما بعد الطبيعة. قدم له وحققه يونس أجعون. بيروت: دار الكتب العلمية، 2017.
Muwaffaq al-Dīn ʿAbd al-Laṭīf Ibn Yūsuf al-Baghdādī (557-629). Mā ba ʿda al-ṭabī ʿah [Metaphysics]. Edited by Yūnus Ajʿūn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2017. ISBN: 978-2-7451-8878-6 Fouad Ben AhmedQarawiyyin University-Rabatموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي...
قصّة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر الله في رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان. الجيزة: بوك ڤاليو، 2021
Review of Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham by Yusuf Zaydān. Giza: Book Value, 2021. ISBN-10. 9778582106 Qiṣṣat Ibn al-Haytham maʿa al-Ḥākim bi Amri al-LāhFī riwāyat Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham قصة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر اللهفي رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان....
عن ابن رشد وما لا نعرف عنه: في الرد على حسن أوريد ومن معه
عن ابن رشد وما لا نعرف عنهفي الرد على حسن أوريد ومن معه فؤاد بن أحمدجامعة القرويين، الرباط تقديم اجتهد العربُ المحدثون في ترجمة المفردتين revue وjournal بمفردة ”المجلة،“ بعد أن نقلوا هذه من معناها القديم، وهو ”كتاب يحتوي على أشياء جليلة من الحكم وغيرها.“[1] لكنهم...
الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة: مراجعة نقدية للترجمة العربية
The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī by Ayman Shehadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut: Mominoun Without Borders, 2020. Al-Akhlāqiyāt al-ghāʾiyya ʿinda Fakhr al-Dīn al-Rāzī Li Ayman Shihadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut:...
نصّان في الأشعريّة التقليديّة: إشكالُ القيمة والأبعادُ الفيلولوجيّة والمعرفيّة
نصّان في الأشعَريّة التّقلِيديّة:إشْكَال القِيمَة والأبعادُ الفِيلولوجِية والمعرِفيّة Naṣṣani fī al-Ashʿariyya al-taqlīdiyya:Ishkāl al-qīma wa-l-abʿād al-fīlūlūjiyya wa-l-maʿrifiyya محمد الرّاضي[1]جامعة عبد الملك السعدي-تطوان ملخص تميزت نصوص المتكلمين المتقدمين في...
مصير العلوم العقلية في الغرب الإسلامي ما بعد ابن رشد
ملخص بعد النقد العنيف الذي وجهه الغزالي للفلاسفة، حصل تعديل في المسار العام للفلسفة في المشرق الإسلامي، وغَلَبَ نوع من التأليف الذي يمزج بين الكلام والفلسفة؛ أما في الغرب الإسلامي، فقد ازدهر القول الفلسفي بعد التهافت، لكن بعد موت ابن رشد، لن نشهد فلاسفة موسوعيين كبار،...
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين فؤاد بن أحمد[1] جامعة القرويين تمهيد ولد الفيلسوف والطبيب والمؤرخ والرحالة موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبي العز يوسف البغدادي، المشهور بابن اللّباد، في بغداد العام 557هـ/1162م، وتوفي...
عن تمثيلات واستعارات ابن رشد
قراءة نقدية في كتاب فؤاد بن أحمد، تمثيلات واستعارات ابن رشد: من منطق البرهان إلى منطق الخطابة. بيروت-الرباط-الجزائر: منشورات ضفاف-دار الأمان-منشورات الاختلاف، 2012. محمد الولي[1] كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ سايس - فاس 1. حول المعنى الحرفي. حينما نتوخى التعبير عن...
الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري گوتاس: قراءة نقدية في الترجمة العربية
ملخص صدر كتاب ديمتري گوتاس، الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية العربية في بغداد وفي المجتمع العباسي المبكر (القرن الثاني-الرابع للهجرة/القرن الثامن-العاشر للميلاد)، عام 1998. وقد صار اليوم من المراجع الكلاسيكية في الموضوع. وقد انتبه الدارسون مبكرا...


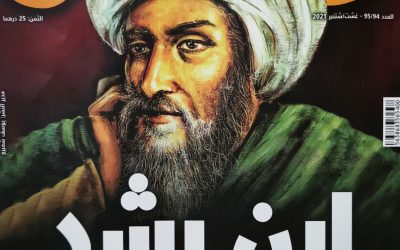
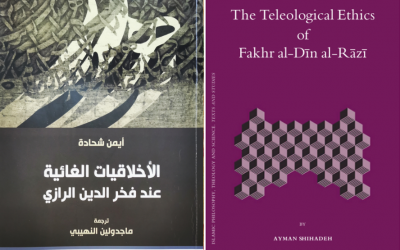




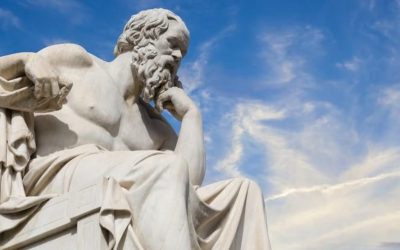
بالتوفيق أستاذتي الفاضلة دمت متألقة
أيتها الأستاذة الكريمة
لقد قرأت مراجعتكم الشيقة لكتاب “الفكر العلمي والثقافة الإسلامية” لبناصر البعزّاتي وأود أن أشكركم على وضوح العبارة وجودة التلخيص. والجدير بالمناقشة هو ما قدمتموه بخاتمة المقال من ملاحظات.
تجاوبا مع الأسئلة التي أثرتموها، أود الإدلاء برأيي في بعض جوانبها : أميل إلى الإعتقاد أن الديانات والإيديولوجيات السياسية قد تكون حينا من الدهر معارضة لبعض المنطلقات أو المكتسبات العلمية إن كانت مناهضة أو أصبحت مهددة لمصالحها.
لكن القائمين على شؤون الدين أو السياسة أو الإثنين معا، سرعان ما ينتبهون إلى فائدة تسخير ما استجد وثبت للعلم من مكانة أو منتجات ليصبح العلم ومنتجاته في خدمة السلطة الدينية أو السياسة أو الإثنين معا. فهؤلاء بشر وهم بالتالي محكومون بقانون الإندثار إن كانوا غير ملائمين للبيئة العلمية المستجدة. ولا يسعنا سوى ملاحظة أن الديانات والإيديولوجيات بكل تلاوينها ما زالت ثابتة في عصر الذرة ومفعلاتها الإيرانية وفي عصر الفضاء وفراغه ولا تكترث لما حدث ويحدث بمجال العلوم من ثورات وتغيرات على مدى القرون.
نعلم حق العلم أن إخواننا (وليس أخواتنا) من أهل الدين والسياسة قادرون على استغلال “العقلانية” والمنطق الأرسطي وفيزياءه المبررة والمكرسة لعالم منغلق تلفه سبع سماوات أو أكثر، لا يهم العدد، إذ ليس بمقدور أحد أن يعد أفلاكها أو أن ينفذ من أقطار السماوات. المهم هو ألا يتعدى الراسخون في العلم حدودهم وألا يسمحوا لأنفسهم بمخاطبة الجمهور. هكذا يتم فصل المقال فيما بين العقيدة والعلم الرصين من إنفصال. فالمنطق الأرسطي آلة وآليات صالحة لترسيخ عقيدة الموحدين مهما كانت ضيقة ولتوحيد الصف والطواف حول مركز واحد وثابت، هو أرضنا، وتحت إمرة محرك أول لا يُمكن رصده لأنه خارج فلك النجوم الثابتة ولا يحتوي على أي معلم. فتفننوا يا مناطقة عصورنا في تهافتاتكم وتناقداتكم ما شئتم طالما لم تهددوا مصالح معلومة وحدودا مرسومة ومحمية.
فما الجبر والهندسة والمنطق والتحذلقات الفلسفية سوى أدوات ذهنية يمكن استخدامها وتسخيرها لأي أغراض شئنا. وهذا ما فعلته الكنيسة حينا من الدهر وبنجاح باهر لما سخرت المنطق الأرسطي لمنح فيزياءه الخاوية مهلة أربعة قرون إضافية. وما منطق إبن رشد وعقلانية المفقود الجابري سوى واجهة لإيهامنا بوجود تقدمية عربية وأن أطباق المقاصدالشاطبية صالحة لأجيالنا وأنها مكسب وتقدم معرفي وإبيستيمولوجي عظيم. ما زالت أجيالنا تعيش نفس الأوهام التي لم ينتبه لها لا جيل إبن رشد ولا جيلي، أي جيل الجابري وأركون طاب ثراهما.