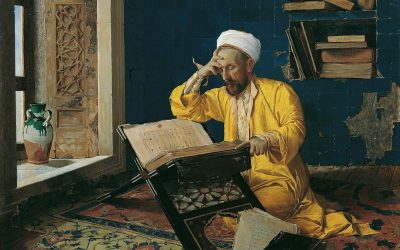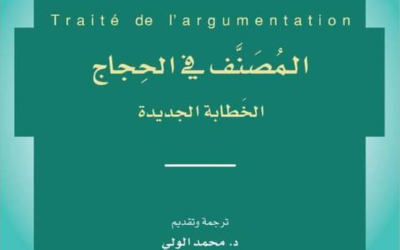![]()
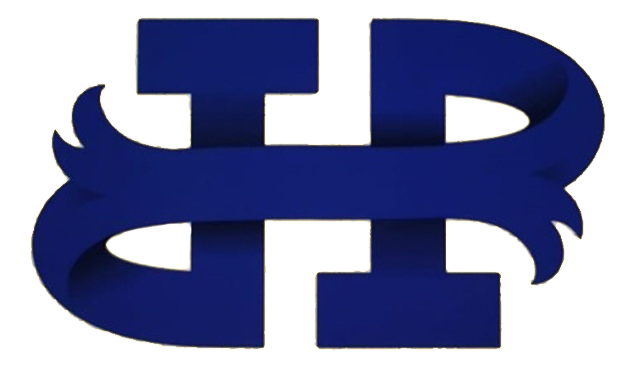
في المنجز الفقهيّ لابن رشد: القيمة والتلقّي إلى حدود القرن العشرين

Fī al-Munjaz al-fiqhī li-Ibn Rushd: al-Qīma wa-t-talaqqī ilā ḥudūd al-qarn al-ʿishrīn
On Ibn Rushd’s Juridical Theory
Significance and Reception in Muslim Contexts till the Twentieth Century
في المنجز الفقهيّ لابن رشد: القيمة والتلقّي إلى حدود القرن العشرين
فؤاد بن أحمد
Fouad Ben Ahmed
جامعة القرويين-الرباط
Al-Quarawiyyine University-Rabat
الملخص: على الرغم من أننا لم نكتب بعد تاريخًا شاملًا لتلقّي نصوص الفيلسوف والفقيه والطبيب أبي الوليد ابن رشدٍ (ت. 595هـ/1198م) وأشكال تأثيرها على العلماء والفقهاء اللاحقين في السياقات الإسلامية، فقد أصبح حكمًا مشهورًا وشائعًا بين أساتذة الدراسات الشرعية وطلّابهم أنه عندما نتحدّث في الفقه، فإن مكانة ابن رشدٍ الحفيد (الفيلسوف) ليست بالمعتبرة، وإنما المعتبر هو مكانة جده أو ابن رشد الجد (ت. 520هـ/1126م)؛ والحال أنّ إسهام ابن رشدٍ الفيلسوف في هذا الفن يختلف من حيث طبيعتُه وموضوعُه (جنسه الأدبيّ) عن تركة الجدّ: فقد كتب هذا في فروع الفقه وفقًا لمذهب مالك بن أنس (ت. 179هـ/795م)، بينما كتب ذاك في أصول الفقه (مختصر المستصفى) وفي القواعد الفقهيّة (بداية المجتهد ونهاية المقتصد).
وعندما شرعنا في تعقب أصل هذا الحكم المشهور، لم نجد أيّ شيءٍ مكتوبٍ أو موثّقٍ، وحتى لو أخذنا في الاعتبار الشهادة الفريدة التي سنوردها في ثنايا العمل، فإننا نجدها لم تقم على أيّ استقراءٍ للنصوص القديمة اللاحقة لعمل ابن رشد. وهذا ما يجعلنا نعتبر ذلك الحكم مشهورًا دون أن يكون صحيحًا، لأنه لا يصمد أمام الفحص النقديّ. وفي الواقع، فإنّ هدفنا في هذه الدراسة هو دحض ذلك الحكم من خلال عرض أشكال الانتقال والتلقي التي عرفها كتابا ابن رشد المذكوران أعلاه منذ تأليفهما حتى النصف الأوّل من القرن العشرين.
ونقسم دراستنا إلى جزأين: نقدّم في القسم الأوّل بضع لمحات من انتقال مختصر المستصفى خلال القرون الأربعة التي تلت وفاة ابن رشدٍ؛ بينما نفرد القسم الثاني لتتبع التأثير الذي مارسه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وسنحاول القيام بمهمّتين في هذا القسم الأخير: الأولى أن نجرد أشكال حضور الكتاب في المصنفات الفقهيّة (كتب الفروع) من مختلف المذاهب خلال الفترة المذكورة. أما المهمّة الثانية، وهي الأهمّ في نظرنا، فتركّز على تلقّي الجهود النظريّة والمنهجيّة التي بذلها ابن رشد لتقعيد أسباب الخلاف بين المدارس الفقهيّة الإسلاميّة السنيّة، وعلى الامتداد والتطوير الذي حصل لهذه الجهود في كتابات فقهيّة لاحقة تنتمي إلى الجنس الأدبيّ نفسه الذي يندرج فيه كتاب ابن رشد، أعني جنس القواعد الفقهيّة.
الكلمات المفتاحية: تلقي نصوص ابن رشد وفكره، القواعد الفقهية، الفقه، مختصر المستصفى، بداية المجتهد.
Abstract: Although a comprehensive history of the transmission and reception of Ibn Rushd’s (Averroes, d. 595/1198) texts and their forms of influence on later thinkers in Muslim contexts has not been written yet, a judgment has become generally accepted among students and scholars of Islamic jurisprudence: when one speaks in jurisprudence (al-fiqh) the status of Ibn Rushd al-Ḥafīd (the philosopher) is not considerable, only that of his grandfather or Ibn Rushd al-Jadd is. However, the literary genre of Ibn Rushd al-Ḥafīd’s contribution to this art is different from that the grandfather (d. 520/1126) who wrote in the branches of jurisprudence, mainly according to Malikite school. Ibn Rushd wrote in usūl al-fiqh (Mukhtaṣar al-Mustaṣfā) and legal maxims (Bidāyat al-Mujtahid wa nihāyat al-Muqtaṣid).
However, when I began a short genealogy of this generally accepted judgment, I found nothing written or documented, and even if one takes into account the unique testimony I found, this remains not based on textual evidence. This is what leads me to consider this judgment as a generally accepted one without being sound, because it does not resist to any critical examination. The objective in this study is to refute this judgment by presenting the forms of transmission and reception that Ibn Rushd’s two books, Mukhtaṣar al-Mustaṣfā and al-Bidayat al-mujtahid have known throughout their history from the thirteenth to the twentieth centuries, depending on the availability of documents.
I divided my study into two parts: I presented in the first section few insights into the transmission of his uṣūlī text, Mukhtaṣar al-Mustaṣfā, during the four centuries following the death of Ibn Rushd, while I devoted the second section to the history and the impact of his text on the legal maxims, Bidāya al-mujtahid. Two tasks to be accomplished in this last section: an enumeration of the forms of presence of al-Bidāya in juridical writings different schools during the period already mentioned. The second task, which I believe is the most important, will focus on receiving the theoretical and methodological efforts made by Ibn Rushd to expose and explain the causes of disagreements between the legal schools of Islam, and on expanding and developing these efforts through subsequent legal writings that belong to the very literary genre of Ibn Rushd’s book, the legal maxims.
Keywords: Reception of Ibn Rushd’s texts, Muslim jurisprudence, legal maxims, Mukhtaṣar al-Mustaṣfā, Bidāyat al-Mujtahid.
مقدمة
يورد ابن عبد الملك المرّاكشيّ الأنصاريّ (ت. 703هـ/1303م) قصةً غريبةً بخصوص السّيرة الفقهيّة لأبي الوليد ابن رشدٍ (ت. 595هـ/1198م)؛ إذ يخبرنا بأن اتهامًا مضمرًا بالسرقة العلميّة كان قد وجّهه الفقيه المالكيّ أبو الحسين ابن زرقون الأنصاريّ الإشبيليّ (ت. 621هـ/1224م)[1] لأبي الوليد. وموضوع الاتّهام أن بداية المجتهد ونهاية المقتصد إنما هو، في الأصل، كتاب من تأليف بعض فقهاء خراسان في أسباب الخلاف الواقع بين أئمّة الأمصار، وكان ابن زرقون قد أعاره لأبي الوليد. وبَدَل أن يردَّه إليه، زاد عليه كلامًا لأبي عمر ابن عبد البرّ (ت. 463هـ/1071م)، ولعلّ كتاب الاستذكار له هو المقصود، وكلامًا لأبي محمدٍ ابن حزمٍ (ت. 456هـ/1064م) ولعلّ كتاب المحلّى له هو المقصود.[2] وإلّا فكيف يعقل أن يكتب ”رجل غير معروف بالفقه“ كتابًا مثل بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟ وبغضّ النظر عن صدقيّة هذه التهمة المشينة، والتي لن نناقشها هنا،[3] فإنّ القصّة ذاتها تبدو لنا حاملةً لعناصر لا يبعُد أن تكون قد حصلتْ فعلاً. فنحن نفهم من تلك التهمة أنّ المؤلِّفَ قد أبدع في تأليف كتابٍ لم يُسبق إليه في المذهب المالكيّ ولا في الغرب الإسلاميّ؛ وهذا الكتاب هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ولكي يحصل هذا، فإنّنا نفترض أن يكون صاحب الكتاب قد اطّلع فعلًا على مؤلفاتٍ من أصقاعٍ بعيدةٍ كخراسان، ومعروف أهلها الأحناف بالتأليف في القواعد الفقهيّة وفي أسباب الخلاف؛ وإلى هذا، فإن المؤلف يعترف فعلا، في ثنايا عمله، باستفادته من اجتهاداتِ ابن عبد البرّ وابن حزمٍ وغيرهما. والنتيجة تأليف كتابٍ جليل الفائدة ”أعطى فيه [المؤلِّف] أسباب الخلاف وعلّل ووجّه فأفاد وأمتع به، ولا يُعلم في فنّه أنفع منه ولا أحسن مساقاً.“[4] ونرى أن نسبة الفضل في تأليف كتابٍ كهذا إلى ابن رشد الفيلسوف هي الأصل في استفزاز بعض الناس من معاصريه وأقرانه.
والواقع أنّ من يطّلع على سيرة أبي الوليد ابن رشدٍ، وعلى الرصيد العلميّ لأسرته حيث نشأ، وعلى العلوم التي تلقّى في صباه،[5] وعلى العلوم الدينيّة التي درَّس،[6] وعدد تلاميذه في هذه العلوم،[7] سيدرك يقينًا أنّ الرّجل لم يكن طارئا على علمي الأصول والفقه وصناعة الفتيا والقضاء.[8] وفضلا عن تولّيه أمر القضاء لأزيد من مرّةٍ،[9] وهي المهمّة التي لا يمكن تقلّدها دون تكوينٍ شرعيٍّ متين، فإنّ عملين هامّين في حياة الحكيم يشهدان لرسوخ قدمه في الثقافة الدينيّة ولاشتغاله بالعلوم الشرعيّة: أما أولهما فهو مختصر المستصفى أو الضّروري في أصول الفقه؛ وهو من مؤلّفات ابن رشدٍ المبكّرة. وقد ظلّ العمل في حكم المفقود إلى حدود التسعينيّات من القرن الماضيّ، أي إلى أن حقّقّه الراحل جمال الدين العلويّ ونُشر بعد وفاته العام 1994؛[10] وأعيد تحقيقه وترجمته إلى الفرنسيّة منذ سنواتٍ قليلةٍ.[11] وأمّا العمل الثانيّ، فهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ وقد أُلّف على مرحلتين على الأقلّ. ونتوفّر اليوم على نشراتٍ كثيرةٍ له تتفاوتُ في القيمة والجودة،[12] كما نتوفّر على ترجمةٍ إلى الإنجليزيّة.[13] غير أن ما يمكن أن يلاحظ هو أن العملين معًا يشهدان اهتمامًا أكاديميًا بطيئًا، مع أنّ هذا الاهتمام نفسه يعرف في العموم انقسامًا بين المشتغلين بالتأريخ للفلسفة وبالتأريخ للفقهيّات عمومًا.
وعلى الرّغم من أنّنا لم نكتب بعد تاريخًا شاملًا لوجوه التّلقي التي حصلتْ لنصوص ابن رشدٍ ولأشكال تأثيرها في النظّار بعده وفي ما ألّفه هؤلاء من أعمالٍ، فإنّ حُكمًا قد صار مشهورًا يَدور بين أساتذة العلوم الشرعيّة ويرويه عنهم طلبتُهم، دونما تردّد، مفاده أنّه عندما نتحدثُ في الفقهيّات، على مذهب مالك (ت. 179هـ/795م)، فإنّه لا يُلتفت إلى ابن رشدٍ الحفيد، وإنّما المعتبر هو ابن رشدٍ الجدّ؛ هذا مع أن ما خلّفه الحفيد في هذه الصناعة يختلف من حيث طبيعتُه ومنهجُه وغرضُه عمّا خلّفه الجدّ؛ فهذا قد كتبَ في الفروع وعلى مذهب مالك بن أنسٍ، بينما كتب حفيدُه في الأصول وفي القواعد الفقهيّة. غير أنّه عندما شرعنا في البحث عن الأصل في هذا الحكم لم نجد شيئًا مكتوبًا ولا موثّقًا، وأنه حتى وإن وقفنا على شهادةٍ فريدةٍ سنوردها أدناه، فإنّ هذه الشهادة لم تعوّل على أيّ استقراءٍ للنصوص القديمة التي جاءتْ بعد عمل ابن رشدٍ. وهذا ما آل بنا إلى أن نعتبر هذا الحكم الرائج من باب المشهورات في الظن لا في الحقيقة، لا لأنه اشتهر دونما معاندة، وإنّما لأنّه لا يصمد أمام الفحص النقدي. وهذا ما نحاول القيام به في هذه الدراسة، دفعاً لذلك الحكم المشهور، عن طريق إظهار أشكال التلقّي التي عرفها عَمَلاَ ابن رشد: الضروريّ في أصول الفقه، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد.
ونقسّم ورقتنا إلى قسمين: قسمٌ أولٌ نعرض فيه لمحاتٍ فقط عن التلقّي الذي عرفه الضروريّ في أصول الفقه في القرون الأربعة التي تلتْ وفاة ابن رشدٍ، بينما نُفرد القسم الثانيّ لمصير بداية المجتهد ونهاية المقتصد وأثره؛ وفي هذا القسم الأخير نعتبر أمرين: أوّلهما إحصاء أشكال الحضور التي عرفها الكتاب في الأعمال التي أُلفت في الفقهيّات عامّة إلى حدود القرن العشرين، من مختلف المذاهب؛ أمّا الأمر الثانيّ، وهو الأخطر والأهمّ في تقديرنا، فسنشير بخصوصه إلى حصول تلقٍّ علميٍّ للجهد التنظيريّ والمنهجيّ الذي أعمله ابن رشدٍ في باب تقعيد أسباب الخلاف وتعليله، وحصول توسيعٍ وتطويرٍ لذلك الجهد من قبل مؤلّفات تدخل في صميم الجنس الأدبيّ الذي ينتمي إليه كتاب بداية المجتهد.
القسم الأوّل:
مختصر المستصفى
ربما يكون الضروريّ في أصول الفقه أوّل عمل ألّفه ابن رشد، وذلك عام 552هـ/1158م. ومع أنّه كان قد كتبه تذكرةً لنفسه، كما يقول، فقد حقّق العملُ شهرةً معتبرةً، ربما خلال حياته كما بعد وفاته. وتجدر الإشارة إلى أنّ أبا الوليد يُعدّ واحدًا ممّن اعتنى مبكّراً بالمستصفى من علم الأصول لأبي حامدٍ الغزاليّ (ت. 505هـ/1111م)، فهو من النظّار الأوائل الذين علّقوا عليه في الغرب الإسلاميّ،[14] وقد تلته شروحٌ وتعليقاتٌ أخرى. وفي هذا السياق، يأتي تنبيه بدر الدين الزركشيّ (ت. 794هـ/1392م) في البحر المحيط في أصول الفقه إلى عناية المالكيّة بعمل الغزاليّ، وهو شافعيّ المذهب كما هو معلومٌ، حيث يقول: ”والمستصفى للغزالي، وقد اعتنى به المالكية أيضا، فشرحه أبو عبد الله العبدري في كتابه المسمى بـالمستوفى، ونكّتَ عليه ابن الحاج الاشبيلي وغيره، واختصره ابن رشد.“[15] والذي يهمّنا أن نلفتَ إليه الانتباه هنا هو أنّ أبا الوليد، وإن جاء ذكره متأخراً في كلام الزركشيّ، فهو متقدّم تاريخيّاً على الاسمين الآخرين؛ بل أكثر من ذلك إنّ عمله ذاك كان ذا أثرٍ في شرحيْ أبي عبد الله العبدريّ وابن الحاجّ، فضلًا عن أنّه كان مصدراً من مصادر الزركشيّ في كتابه الذي نقلنا منه تلك الشهادة.
- محمّد بن أحمد ابن أبي غالب، أبو عبد الله العبدريّ (ت. 626هـ/1229م)
وينقل ابن عبد الملك المراكشيّ عن ابن الزبير ما قاله بخصوص العبدريّ في الصلة: ”كانتْ له مشاركة في فنون من العلم، كالفقه وأصوله، والعربيّة، وغير ذلك، وولوع بالمنطق، حتى شرح كتاب المستصفى؛“[16] وهو المعروف بـالمستوفى في شرح المستصفى. لكنّ الكتاب ليس بأيدينا اليوم؛ ولحسن الحظ أنّ بدر الدين الزركشيّ قد احتفظ منه بنقولٍ كثيرةٍ ضمّنها كتابه البحر المحيط.[17] ويبدو من المواضع التي ورد فيها ذكر العبدريّ أنّ الرجل قد تعاطى فعلًا صناعةَ المنطق، كما يظهر أنّه قد قدّم لكتابه، المستوفى في شرح المستصفى، بمقدماتٍ منطقيةٍ في الحدّ وفي سُبُل اقتناصه.[18] وقد نَفهم من هذا أنّه قد نَهَج نَهْج الغزاليّ، في المستصفى من علم الأصول، في جعل المنطقيّات تمهيدًا لأصول الفقه.
وفضلًا عن أنّ اهتمام الزركشيّ بكتاب ابن رشدٍ، مختصر المستصفى، يقوم دليلًا على وصول هذا الكتاب إلى مصر والشام وتداوله فيهما، فإننا نستأنس من الزركشيّ نفسه أن العبدريّ قد اطلع عليه ونقل منه في كتابه المذكور. ويشهد لهذا قول الزركشيّ: ”قال العبدري: ’والمفهوم ينقسم إلى النص والمجمل والظاهر والمؤول، كانقسام المنطوق.‘ قال ابن رشدٍ في مختصره: فمثال النص: ﴿وَاسْأَلِ القَرْيَةَ﴾ [الآية، يوسف، 82]، فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية؛ وكذا ﴿حُرِّمَتْ عَلَـيْـكُم أُمَّهَاتُكُم﴾ [الآية، النساء، 23]، فإنّ المفهوم منه قطعًا تحريم النكاح. ومثال المحتمل: ”لا صيام،“ فإنه يحتمل نفي القبول أصلا، أو نفي الكمال. وقوله: ”من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة،“ فإنه متردد بين فضل الصلاة أو حكمها أو وقتها.“[19] وإلى ذلك، يظهر العبدريّ قريبًا من موقف ابن رشدٍ، حيث يروي الزركشيّ: ”وقال أبو الوليد بن رشد: ’وهو عندي جائز، إذا كان مفيدا ومكتفيا بنفسه وغير محتاج في فهمه إلى ما قبله، أو كان ليس يوجد صدق ما حذف منه، تردد المفهوم عنه بين معنيين أو أكثر، وسواء جوزنا الرواية بالمعنى أو لا. واستحسنه العبدري.‘“[20] ونرجو أن يظهر عمل العبدريّ حتى تتبيّن أكثر وجوه نقله من ابن رشدٍ واستثماره لعمله.
- ابن الحاجّ (ت. 647هـ/1249م)
أمّا الشارح الثاني الذي اعتنى بالمستصفى في الأندلس، والذي يرد في البحر المحيط ما يفيد أنّه قد استثمر مختصر المستصفى لابن رشد، فهو أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن أحمد الأزديّ الإشبيليّ، المعروف بابن الحاجّ؛ وهو نحويٌّ ومن شرّاح كتاب سيبويه، وله أيضا مختصر المستصفى من أصول الفقه.
وعمل ابن الحاجّ هذا ليس بأيدينا اليوم، وينقل منه الزركشيّ قائلًا: ”وقال ابن الحاج في تعليقه على المستصفى: ’الاستثناء المنقطع منعه قوم من جهة الغرض بالاستثناء، وأجازه الأكثرون من جهة وجوده في كلام العرب، والمجوزون لم يقدروا أن يدفعوا وجوده في كلام العرب، والمانعون لم يقطعوا الجهة التي يصح بها المنقطع على وضع الاستثناء.‘“[21] ويبدو هذا الكلام عند مقارنته بنصّ ابن رشد صوغًا جديدًا لعبارة ابن رشدٍ التي تقول:
الْاِسْتِثْنَاءُ مِنْهُ مُتَّصِلٌ، وَهُوَ الّذِي الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى فِيهِ. وَمِنْهُ مَقْطُوعٌ، وَهُوَ الّذِي الْمُسْتَثْنَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. وَهَذَا يُسَمِّيهِ أَهْلُ اللِّسَانِ بِالْاِسْتِثْنَاءِ الْمُتَقَطِّعِ. […] فَنَقُولُ: إِنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الِخلاَفُ فِي وُقُوعِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. وَهَذَا قَدْ مَنَعَهُ قَوْمٌ وَقَالُوا لاَ مَعْنَى لِاسْتِثْنَاءٍ مَا لَمْ يَتَضَمَّنْهُ الْقَوْلُ الْمُتَقَدِّمُ، وَتَسْمِيَّةُ مِثْلِ هَذَا اِسْتِثْنَاءً هَذْرٌ. وَأَمَّا الّذِينَ أَجَازُوهُ فَقَدْ تَمَسَّكُوا بِوُقُوعِ ذَلِكَ لُغَةً مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء، 77] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ [الآية، النساء، 29]. وَفِي مِثْلِ هَذَا قَوْلُ الشَّاعِرِ:
وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ الْأَوَارِيّ
وَالْأَوَارِي لَيْسَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اِسْمُ أَحَدٍ؛ وَقَوْلِ الْآخَرِ:
وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ إِلاَّ الْيَعَافِيرُ وَإلاَّ الْعِيسُ
وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنْ تَقُولَ: مَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ إِلاَّ امْرَأَةٌ. وَبِالجُمْلَةِ، فَهُوَ فِي كَلاَمِهِمْ مَشْهُورٌ وَمَوْجُودٌ كَثِيرًا. وَالْفِرْقَةُ الْأُولَى دَفَعُوا ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، وَالثَّانِيَةُ تَمَسَّكُوا بِالوُجُودِ وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُعْطُوا الِجهَةَ الَّتِي بِهَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الْكَلاَمِ بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ وَيَنْحَلُّ بِهَا الشَّكُّ الْمُتَقَدِّمُ.[22]
ويواصل الزركشيّ نقله عن ابن الحاجّ مباشرةً بعد كلامه السابق: ”قال [ابن الحاج]: ’وقد حلّ هذا الشكَّ القاضي أبو الوليد بن رشد، فقال: ’إن من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلي، كما يبدل الكلي مكان الجزئي اتكالًا على القرائن، مثلا: إذا قال: ما في الدار رجل، أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني ويقول إلّا امرأة،‘ وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء كله متصلًا، إلّا أنّ الاتصال منه في اللفظ والمعنى، ومنه في المعنى خاصة“. قال: ’وإذا تُصفّح الاستثناء المنقطع وُجد على ما قاله، وقد انفرد بحلّ هذا الشّك.‘“ [23]
- بدر الدين الزركشيّ (ت. 794هـ/1392م)
وإلى جانب ما أثبته الزركشيّ من نُقُول العَلَمين السابقين، فإنّه هو نفسه ينقل من مختصر المستصفى، حيث يقول: ”وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر المستصفى: لم يقع خلاف في أن التواتر يفيد اليقين، إلّا ممن لا يؤبه به، وهم السفسطائية، وجاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة، لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه، وإنما الخلاف في جهة وقوع اليقين عنه، فقوم رأوه بالذات وقوم رأوه بالعرض وقوم مكتسبا.“[24]
ويبدو مما بأيدينا اليوم من معطياتٍ أنّ بدر الدين الزركشيّ قد استعمل كتاب ابن رشدٍ الآخر في الفقهيّات، وهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ونوردها هنا لتعلّقها بالمقدّمة الأصوليّة التي وضعها لكتابه. يقول الزركشيّ: ”وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة، لأنّه من باب السمع والذي يرد ذلك يرد نوعًا من الخطاب.“[25] وهذا قول ابن رشدٍ في مستهلّ بداية المجتهد: ”والجنس الأول [القيّاس]، هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه؛ وأما الثاني [دلالة اللفظ]، فليس ينبغي لها أن تنازع فيه، لأنه من باب السمع. والذي يردّ ذلك يردّ نوعا من خطاب العرب.“[26]
وما يمكن أن نخلص إليه من حديثنا عن هؤلاء الذين شرحوا المستصفى واختصروه هو أنّهم قد جمعوا بين إعمال نهج الغزاليّ في التقديم بالأمور المنطقيّة للمسائل الأصوليّة وبين الاقتباس من ابن رشد.
وبين أيدينا اليوم عملٌ رابعٌ يشهد لتلقّي مختصر ابن رشدٍ. فقد نقل عن الضروري في أصول الفقه لابن رشدٍ شمسُ الدين البرماويّ، وقد تقدّم لنا ذكره في أحد الهوامش أعلاه، وذلك في كتابه الفوائد السّنيّة في شرح الألفيّة، ونصّ نقله: ”وكذلك قال ابن رشد في مختصر المستصفى: ’لم يقع خلاف في كون المتواتر يفيد اليقين إلّا ممن لا يُؤبه له.‘ قال [أي ابن رشدٍ]: ’وهم السوفسطائيّة، وجاحده يحتاج لعقوبة، فإنه كاذب بلسانه على ما في نفسه، إنما الخلاف في جهة وقوع اليقين، فقوم رأوه بالذات، وقوم رأوه بالعرَض، وقوم رأوه مُكتسبا‘. انتهى.“[27]
- أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن الأزرق الغرناطيّ (ت. 899هـ/1492م)
ويشهد عملُ ابن الأزرق الغرناطيّ المعروف بـروضة الإعلام بمنزلة العربيّة من علوم الإسلام أنّه كان مطّلعا على أعمالٍ أخرى لابن رشدٍ، كالضّروريّ في النّحو. وإلى ذلك، فقد نقل قول هذا الأخير بضرورة التمييز بين الصنائع وعدم الإقبال عليها دفعةً واحدةً في سياق حديثه عن مراعاة الترتيب في العلوم: ”ومن ثم، على الجملة، لما اختصر ابن رشد الحكيم مستصفى الغزالي في أصول الفقه أسقط منه المقدمة المنطقية قائلا: ’ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعه، فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحدٍ في وقتٍ واحدٍ لم يمكنه أن يتعلم ولا واحدًا منها.“ ومراده بعدم الإمكان بحسب الغالب على أكثر الطلاب، فإنّ أذهانهم تكلّ عن إدراك أكثر من علم واحد، في زمان واحد، على ما ينبغي.“[28] وقد كان هذا الاقتباس معينًا في إثبات صّحة نسبة مختصر المستصفى لابن رشدٍ.
- أبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ (ت. 914هـ/1509م)
ويحتفظ لنا الفقيه المالكيّ أبو العبّاس الونشريسيّ بما يفيد اطّلاعه على مختصر المستصفى. يقول في معياره:
ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ تَقْدِيرُ لَازِمِ اِبْنِ رُشْدٍ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ لَكَانَ الْاِعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ، الأَوَّلُ: أَنَّ قَاعِدَةَ التَّمْثِيلِ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ عَلَى جُزْئِيٍّ، وَهَذَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَهٌ وَبَيْنَ قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَالْاِسْتِقْرَاءِ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا عَلَى كُلِّيٍّ؛ هَكَذَا قَدَّرَهُ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ. وَظَاهِرُ تَقْدِيركُمْ هُنَا أَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ الْحُكْمَ عَلَى كُلِّيٍّ لَا عَلَى جُزْئِيٍّ، وَيُمْكِنُ الَجوَابُ بِمَا أَشَارَ اِبْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بـِالضَّرُورِيِّ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ كُليًّا، وَلَكِنْ لَا تُؤْخَذُ الثَّانِيّةُ مِنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَعْنِي الْكُليّة، وَإِنَّمَا صَحَّ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ [يُشْبِهُهُ]،[29] لَا مِنْ حَيْثُ انْدِرَاجُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ.[30]
لم يكن ما وقفنا عليه من نقولٍ من مختصر المستصفى بالكثرة التي كنّا وما زلنا نُمنّي النفس بها، لكنّ هذه النقول تكفي لإبطال أي زعمٍ بأنّ مختصر ابن رشدٍ قد تُجوهل من قبل من جاء بعده؛ كما تكفي لاستنباط أمرٍ آخر هامٍّ أيضًا، وهو أنّ الكتاب ما كان ليضمن تواصل الاستشهاد به واستعماله، إلّا لأنّه كان ضمن برنامج الكتب التي يَدْرسها طُلاب العلوم عبر القرون.
وبالفعل، بين أيدينا اليوم من الوثائق ما يدلّ على أنّ الضروريّ في أصول الفقه قد دُرّس ضمن ما يُدرّس لطلبة العلم: والوثيقة الأولى هي رحلة محمد العبدريّ البلنسيّ (ت. 725هـ/1325م)، حيث يذكر أنّ محمّدًا بن عبد الله بن داوود ابن خطّابٍ الغافقيّ المرسيّ قال: ”ولقيتُ الفقيه العالم أبا المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي ولازمته مدة إقامته بمرسية وقرأتُ عليه التنقيحات [في الأصول] للسهروردي، ومختصر المستصفى للقاضي أبي الوليد ابن رشد المسمى بـالضروري.“[31] ولسنا نحتاج التذكير هنا بالتأثير الذي لأعمال ابن رشدٍ المنطقيّة، وخاصة تلخيصه كتابي الخطابة والشعر لأرسطو في عمل ابن عميرة في نظرية الأدب المعروف بكتاب التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات.[32]
وأمّا الوثيقة الثانية فهي رحلة أبي الحسن عليٍّ بن محمّدٍ بن عليٍّ القرشيّ الشهير بالقلصاديّ (ت. 835هـ/1422م)، حيث يحكي هذا الأخير عن الكتب التي كان شيخه إبراهيم ابن فتوحٍ العقيليّ الغرناطيّ (ت. 867هـ/1454م؟) يدرّسها: ”وحضرتُ عليه بالمدرسة قراءة كتب متعددة في علوم شتى، وقرأتُ عليه بلفظي [المقالات لابن] رضوان في المنطق، والشمسية، ورجز ابن سينا [= في المنطق]، وبعض رجزه في الطب، ومختصر ابن رشد في الأصول، وجمع الجوامع وبعض الكراس للجزولي.“[33] ولا نحتاج إلى التذكير أنّنا الآن بعيدون عن زمن ابن رشدٍ بأزيد من قرنين من الزمان. وإنّ بقاء مختصر المستصفى ضمن الكتب التي يدرسها طلبة العلم إنّما هو دليلٌ إضافيٌّ على اندماج أعمال الفيلسوف الأندلسيّ ضمن الثقافة العامّة للأجيال التي جاءتْ بعده.
القسم الثاني:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
على الرغم من كثرة الشهادات التي تفيدنا بخصوص مكانة ابن رشدٍ في صناعة الفقه، فلابدّ من التذكير هنا بما أُثير من شكوكٍ وشبهاتٍ، قديمةٍ وحديثةٍ، حول أهليّته العلميّة في مجال الفقهيّات؛ ومن ثم، حول أصالة بداية المجتهد ونهاية المقتصد.[34] وردًّا لهذه الشكوك، دافع الراحل جمال الدين العلويّ بقوة عن كون هذا الكتاب ”غير غريب في المتن الرشدي.“[35] وأنّه عمل ”يقع في الصميم من اهتمامات ابن رشد،“[36]ومن جهتنا، لن نقف هنا عند معالجة علاقة الفيلسوف بالفقيه في كتاب البداية،[37] كما لن نقف عند دراسة اختياراته الفقهيّة،[38] وإنما سنستقصي —دون ادّعاء الشمولية— أقوال النظّار اللاحقين في عمل ابن رشدٍ الفقهيّ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ونقولهم منه. ولعلّ في هذه النقول ما يثبتُ امتداد الكتاب وحضوره في التراث الفقهيّ الذي جاء بعده، كما يثبت، من زاويةٍ نعتقد أنّها غير مسبوقة، أصالة الكتاب ضمن مسار ابن رشد العلميّ، وهو ما سنبدأ به.
أوّلا: هويّة الكتاب وأصالته
1. بداية المجتهد كتابٌ في القوانين والقواعد
يعود تاريخ تأليف بداية المجتهد ونهاية المقتصد إلى الفترة التي كان يتولّى فيها ابن رشد قضاء إشبيليّة، ابتداءً من 565هـ/1169م.[39] وهذا الكتاب من الأعمال التي لم يؤلّفها أبو الوليد دفعةً واحدةً، وإنّما على مرحلتين؛ فقد عرف زيادةً، وربما تهذيبًا إلى أن استقرّ مكتملًا العام 584هـ/1188م، بعد أن ضمّ إليه كتاب الحجّ.[40]
ويقدّم ابن رشدٍ بنفسه الكتاب بهذه العبارة البليغة:
فَإِنَّ الغَرَضَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْ أُثْبِتَ لِنَفْسِي عَلَى جِهَةِ التَّذْكِرَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِأَدِلَّتِهَا، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَكَامِنِ الْخِلاَفِ فِيهَا، مَا يَجْرِي مَجْرَى الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ لِمَا عَسَى أَنْ يَرِدَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا فِي الشَّرْعِ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي الْأَكْثَرِ هِيَ الْمَسَائِلُ الْمَنْطُوقُ بِهَا فِي الشَّرْعِ، أَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْطُوقِ تَعَلُّقاً قَرِيباً، وَهِيَ الْمَسَائِلُ الّتِي وَقَعَ الاِتِّفَاقُ فِيهَا، أَوْ اِشْتَهَرَ الِخلاَفُ فِيهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الإِسْلاَمِيِّينَ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُم إِلَى أَنْ فَشَا التَّقْلِيدُ.[41]
فالأمر يتعلّق بالانطلاق من مكامن الخلاف والاتفّاق في المسائل الفقهيّة لوضع أصول وقواعد يشتغل وفقها المجتهد فيما قد يرد عليه من مسائل لا حكم فيها.
ولقد قيل إنّ ابن رشدٍ قد ألّف هذا الكتاب ردًّا على الوجيز لأبي حامدٍ الغزاليّ.[42] ومع أنّه لا يوجد في صريح عبارة ابن رشدٍ ما يشهد لهذا الردّ، فإنّنا نتصوّر أنّ المقصود بالكتابة عند ابن رشدٍ، ليس هو مناهضة الكتب الوجيزة، وإنّما بالأولى تلك الكتب الفقهيّة المنتشرة في زمنه والتي لا يجمعها ناظمٌ؛[43] وذلك ما نفهمه من قوله:
إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ إِنَّمَا وَضَعْنَاهُ لِيَبْلُغَ بِهِ الْمُجْتَهِدُ فِي هَذِهِ الصِّنَاعَةِ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ إِذَا حَصَّلَ مَا يَجِبُ لَهُ أَنْ يُحَصِّلَ قَبْلَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْكَافِي لَهُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، وَاللُّغَةِ، وَصِنَاعَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ مُسَاوٍ لِجِرْمِ هَذَا الْكِتَابِ، أَوْ أَقَلَّ، وَبِهَذِهِ الرُّتْبَةِ يُسَمَّى فَقِيهًا لَا بِحِفْظِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ، وَلَوْ بَلَغَتْ فِي الْعَدَدِ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْفَظَهُ إِنْسَانٌ، كَمَا نَجِدُ مُتَفَقِّهَةَ زَمَانِنَا يَظُنُّونَ أَنَّ الْأَفْقَهَ هُوَ الَّذِي حَفِظَ مَسَائِلَ أَكْثَرَ. وَهَؤُلَاءِ عَرَضَ لَهُمْ شَبِيهُ مَا يَعْرِضُ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْخَفَّافَ هُوَ الَّذِي عِنْدَهُ خِفَافٌ كَثِيرَةٌ لَا الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى عَمَلِهَا، وَهُوَ بَيِّنٌ أَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ خِفَافٌ كَثِيرَةٌ سَيَأْتِيهِ إِنْسَانٌ بِقَدَمٍ لَا يَجِدُ فِي خِفَافِهِ مَا يَصْلُحُ لِقَدَمِهِ، فَيَلْجَأُ إِلَى صَانِعِ الْخِفَافِ ضَرُورَةً، وَهُوَ الَّذِي يَصْنَعُ لِكُلِّ قَدَمٍ خُفًّا يُوَافِقُهُ، فَهَذَا هُوَ مِثَالُ أَكْثَرِ الْمُتَفَقِّهَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ.[44]
وإذًا، فصاحب صناعة الفقه هو ذاك الذي يمتلك قانونًا يجعله قادرًا على أن يصنع لكلّ مسألةٍ أو نازلةٍ حكمًا يوافقها. ولذلك، فليست الصناعة الفقهيّة سوى تلك القوّة التي في النفس على إنتاج الأحكام، وليست مجموع هذه الأحكام، كما سيظهر من النصّ أدناه.
وإلى ذلك، تبدو لنا أصالة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في تلك الآليات المنطقيّة التي شغّلها ابن رشدٍ في عمله بقصد وضع قواعد عامةٍ لفهم وجوه الاتّفاق والاختلاف بين الفقهاء. وعليه، فالكتاب ليس مجرّد إحصاءٍ للخلافات الموجودة بين المذاهب والمدارس والفقهاء، بل هو محاولةٌ لتفسير تلك الخلافات بردّها إلى أصولها وقواعدها وأسبابها المتحكّمة فيها. يقول ابن رشدٍ في هذا المعنى:
قصْدُنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ […] أَنْ نُثْبِتَ الْمَسَائِلَ الْمَنْطُوقَ بِهَا فِي الشَّرْعِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفَ فِيهَا، وَنَذْكُرُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا الَّتِي شُهِرَ الْخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ؛ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ مِنَ الْمَسَائِلِ هِيَ الَّتِي تَجْرِي لِلْمُجْتَهِدِ مَجْرَى الْأُصُولِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهَا وَفِي النَّوَازِلِ الَّتِي لَمْ يَشْتَهِرِ الْخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، سَوَاءٌ نُقِلَ فِيهَا مَذْهَبٌ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُنْقَلْ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ تَدَرَّبَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَفَهِمَ أَصُولَ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَوْجَبَتْ خِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِيهَا أَنْ يَقُولَ مَا يَجِبُ فِي نَازِلَةٍ مِنَ النَّوَازِلِ —أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ فَقِيهٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، أَعْنِي: فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ بِعَيْنِهَا—، وَيُعْلَمُ حَيْثُ خَالَفَ ذَلِكَ الْفَقِيهُ أَصْلَهُ وَحَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ، وَذَلِكَ إِذَا نَقَلَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَتْوَى. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَتْوَى أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ النَّاظِرَ فِي هَذِهِ الْأُصُولِ، فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْجَوَابِ بِحَسَبِ أُصُولِ الْفَقِيهِ الَّذِي يُفْتِي عَلَى مَذْهَبِهِ، وَبِحَسَبِ الْحَقِّ الَّذِي يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.[45]
إذاً، لم يكن قصد ابن رشد في البداية ”تفصيل المذهب [مذهب مالك] ولا تخريجه، وإنّما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها؛“[46] أي ”ما يجري مجرى القواعد والأصول.“[47] من صناعة الفقه.
ويقول أيضا: ”قصدنا في هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء الفروع، لأن ذلك غير منحصر. وفروع هذا الباب كثيرة وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب.“[48] لذلك، لن يذكر ابن رشدٍ كلّ المسائل، لكثرتها، ثمّ إنّ الكتاب ليس في فروع الفقه، وإنما سيذكر ”أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظّار.“[49] ويقتصر ”ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقيه؛ أعني في رد الفروع إلى الأصول.“ [50] ويقول أيضًا: ”ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عن من تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره.“[51]
وهكذا، فانطلاقًا من رصد مواضع الخلاف بين الفقهاء وفهم أسباب هذا الخلاف، ثمّ ردّها إلى أصولٍ وقواعد عامةٍ، تصبح هذه بمثابة قانونٍ أو دستورٍ في نفس الفقيه المجتهد، يقدر على إعماله فيما سيواجهه من حالاتٍ مجهولةٍ في المستقبل.
ويُشعرنا ابن رشدٍ بجدّة منجزه بالقياس إلى ما كُتب من قِبَلِ المالكيّة خاصّة. فعلى الرغم من محاولات أبي الوليد الباجيّ المالكيّ (ت. 474هـ/1082م) في المنتقى في شرح الموطأ لضبط قواعد الفقه المالكي،ّ فإنّها تظلّ بعيدةً عن أن تفي بتقعيد أقوال المذهب. ويبسط ابن رشدٍ تبعات ذلك: ”وسبب العسر أن الإنسان إذا سُئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة، ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلّا ما يعطيه بادئ الرأي في الحال، جاوب فيها بجوابات مختلفة. فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه؛ وأنت تتبين ذلك من كتبهم [=المالكيّة].“[52] وإذاً، فإمّا أن يشتغل الفقيه وفق قانونٍ يميّز الحالات المتشابهة عن غيرها، وإمّا أن يشتغل وفق بادئ الرأي فينتج جواباتٍ مضطربةً؛ وهو ما كانت تعانيه الكتابات المالكيّة في زمنه.
2. بداية المجتهد وصلته بالمواضع
يبدو لنا إلحاح ابن رشدٍ على تقنين الفقه ووضع قواعد عامّةٍ له غير بعيدٍ عن روح عمله كرجل منطقٍ. فمن يقرأ أقوال ابن رشدٍ التي أوردناها في الفقرات السابقة في ضوء مجموع أعماله المنطقيّة، وخاصّة بعض الفصول من تلخيص كتاب المواضع الجدليّة لأرسطو وكتاب القوانين التي نُعمل بها المقاييس وهي المسمّاة بالمواضع له أيضًا، ويقارن بينها، يظهرُ له إلى أيّ حدٍّ كانت العدّة المنطقيّة حاضرةً وفاعلةً في مشروعه لتحديد تلك القوانين الضابطة للاستنباط الفقهيّ. وتقع هذه العدّة المنطقيّة، في تقديرنا، في الخلفيّة تمامًا من حديث ابن رشدٍ عن تقعيد الخلاف وردّه إلى أصولٍ ومبادئ تكون بمثابة دساتير أو قوانين تحكم عمليّة الاستدلال الفقهيّ. ونتصوّر أنّ هذا بالضبط هو الدور المنهجيّ الذي تقوم به المواضع في المنطق، كما حدّدها ابن رشدٍ في العملين المذكورين للتوّ.
إن المواضع هي القوانين التي منها نعمل المقاييس، سواءٌ كانت برهانيّة أو جدليّة أو خطابيّة أو غيرها. فهي التي تعطينا القدرة على استنباط المقدمات الخاصّة بمطلوبٍ مطلوبٍ في صناعةٍ صناعةٍ. وبهذا المعنى يصبح الموضع هو ما ينبغي أن يكون حاضرًا في ذهن الجدليّ مثلًا من أحكامٍ وقضايا عامّةٍ حتّى يتمكّن من تمييز وحصر المقدّمة التي عنها ينتج قوله، وكأنّ المواضع بمثابة ”معايير أو معالم“ يَرجع إليها، وذلك حتى يقوم بهذه المهمّة أحسن قيامٍ. فالظاهر، إذاً، أنّ المواضع هي مقدّمات كليةً مرتبةً في النفس بالقوّة القريبة من الفعل ترتيبًا قياسيًا كلّيًا لا على مطلوبٍ خاصٍ جزئيٍّ. وقوّة القانون الحاضر الموجود في الذهن تكمن في كونه يضمن دائمًا عمليّة احتواء الحالات الجزئيّة عن طريق عمليّة الاعتبار. وهذا تحديدًا ما يقوم به المجتهد في الفقه والفتيا.[53]
لأجل هذا، جاز، في نظرنا، تسمية كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد بكتاب المواضع الفقهية أو القوانين الفقهية، تماما كما صحّت تسميته بكتاب القواعد الفقهية من قبل أحد أهم مستثمري كتاب ابن رشدٍ في العصر الوسيط، كما سنرى أدناه.
وإلى ما سبق، يجدر بنا أن نذكر أمرين هنا: الأول هو أنّه على الرغم من حضور هذه العدّة المنطقيّة في خلفيّة كتاب البداية، فإنّها لم تكن، في نظرنا، معلنةً ولا سافرةً؛ فقد تفادى الرجل استعمال المصطلحات المنطقيّة، وهذا خلاف ما فعل الغزاليّ وغيره.[54] وأمّا الأمر الثانيّ، فقد كان ابن رشدٍ قسّم المعارفَ والعلومَ تقسيمًا فريدًا في بداية مختصر المستصفى، حيث يقول:
إِنَّ الْمَعَارِفَ وَالْعُلُومَ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ: إِمَّا مَعْرِفَةٌ غَايَتُهَا الْاِعْتِقَادُ […] وَإِمَّا مَعْرِفَةٌ غَايَتُهَا الْعَمَلُ، وَهَذِهِ مِنْهَا كُلِّيَّةٌ وَبَعِيدَةٌ فِي كَوْنِهَا مُفِيدَةً لِلْعَمَلِ. فَالْجُزْئِيَّةُ كَالْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ. وَالْكُلِّيَّةُ كَالْعِلْمِ بِالْأُصُولِ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا هَذِهِ الْفُرُوعُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. وَالْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْحَاصِلَةِ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَقْسَامِهَا، وَمَا يَلْحَقُهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ أَحْكَامٌ. وَإِمَّا مَعْرِفَةٌ تُعْطِي الْقَوَانِينَ وَالْأَحْوَالَ الَّتِي بِهَا يَتَسَدَّدُ الذِّهْنُ نَحْوَ الصَّوَابِ فِي هَاتَيْنِ الْمَعْرِفَتَيْنِ، كَالْعِلْمِ بِالدَّلَائِلِ وَأَقْسَامِهَا، وَبِأَيِّ أَحْوَالٍ تَكُونُ دَلاَئِلَ وَبِأَيِّهَا لَا، وَفِي أَيِّ الْمَوَاضِعِ تُسْتَعْمَلُ النَّقْلَةُ مِنَ الشَّاهِدِ إِلَى الْغَائِبِ وَفِي أَيِّهَا لَا. وَهَذِهِ فَلْنُسَمِّهَا سبَارًا وَقَانُونًا، فَإِنَّ نِسْبَتَهَا إِلَى الذِّهْنِ كَنِسْبَةِ الْبِرْكَاِر وَالْمِسْطَرَةِ إِلَى الْحِسِّ فِيمَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُغْلَطَ فِيهِ.[55]
فإن كان ابن رشدٍ يقصد بقوله هذا العلومَ بإطلاق، فإنّه بذلك يكون قد استغنى عن تلك القسمة التقليدية المعروفة للعلوم إلى دينيّة وعقليّة. أما إن كان يقصد علوم الشرع فقط، ولو لم ينصّ على ذلك صراحةً، فيحقّ للمرء أن يتساءل في ضوء هذه القسمة عن موقع الكتاب ذاته الذي وردتْ فيه؛ أعني ضمن أيّ جنسٍ علميٍ يندرج كتاب مختصر المستصفى الذي حمل هذا التقسيم. ونرى أنّه من غير الصواب اعتبار الكتاب داخلًا ضمن العلوم الآليّة، لأنّ ابن رشدٍ كان واضحًا في حديثه عن اندراج العلم بأصول الفقه ضمن المعرفة التي غايتها العمل. وفي المقابل، عندما ننظر في التعريف الذي يعطيه للصنف الثالث من أصناف المعارف والعلوم، يظهر أنّ بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو الأقرب إلى ذلك من حيث إنّه يعطي القوانين والأحوال التي أوجبتْ الاختلاف والاتّفاق بين الفقهاء في أحكامهم واستدلالاتهم؛ ونتصوّر أنّ هذا ما يثبتُ أصالة الكتاب وانتماءه إلى مسار ابن رشدٍ العلميّ.
فهل فُهم الكتاب وتُلقّي في الاتّجاه الذي أراده له ابن رشدٍ؟
ثانيا: مصير الكتاب
1. في كتب الفقه والفروع
ما يهمّنا أكثر في هذه الدراسة ليس ماضيّ كتاب البداية، وإنما مستقبلُه، أو بالأحرى وجوهُ تلقّيه ورواجه في العالم الإسلاميّ؛ خاصّة وأنّنا نشهد تجاهلًا لهذا الموضوع من قبل الدّارسين. فإذا كان المهتمّون بتاريخ الفلسفة الإسلاميّة لا يعيرون كبير اهتمامٍ لمصير بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فإنّه قد استقرّ، شفويًا،[56] في أوساط المشتغلين بالعلوم الشرعيّة أنّ الحفيد قد ظلّ غائبًا عن الكتابات الفقهيّة اللاّحقة في مقابل حضورٍ مشهودٍ لجدّه، أبي الوليد ابن رشدٍ. ويُعبِّر عن هذا أحد الدّارسين مؤكدًا أنّ بداية المجتهد رغم أنّه ”كان معلوما للعلماء منذ تأليفه، ومع ذلك فإنا نكاد ألّا نقف على نقل عنه مصرح به، لدى مالكية المغرب قبل هذا القرن العشرين تقريبا، وحيثما ذكر ابن رشد في كتبهم فالمراد جده، والله أعلم.“[57]
في مقابل هذا الزعم الذي لا تُؤيّده حجّة، نقول: إنّ ما يوجد بأيدينا اليوم من معطياتٍ يدفع بنا إلى القول باطمئنانٍ إن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدٍ قد كان كتابًا معتمدًا في الكتابات الفقهيّة، من قِبَلِ المالكيّة خلال حياته، كما تفيدنا بذلك شهادة ابن سعيدٍ المغربيّ (ت. 585هـ/1286م)، الذي يقول في تذييله على رسالة ابن حزمٍ في فضل الأندلس: ”وكتاب النهاية لأبي الوليد ابن رشد كتاب جليل معظّم معتمد عليه عند المالكية.“[58] وقد ظلّ كتاب ابن رشدٍ معتمدًا كذلك، بعد وفاة ابن رشدٍ، في الأدبيّات المالكيّة وغير المالكيّة، وفي الغرب الإسلاميّ وغيره.[59] وابن سعيدٍ هذا يعرف اشتغال ابن رشدٍ بالفلسفة وحدث محنته.[60] ولهذا، فإنّنا نجزم أن واقع التأثير الصريح الذي مارسه ابن رشدٍ الفقيه في كتابات الفقهاء بعده أكبر بكثيرٍ مما يشهد له اليوم ما هو متوفر من الوثائق والنصوص.
وقبل أن نسترسل في ذكر الأعمال التي استعادت واستفادت من بداية المجتهد، لابدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الكتاب ما كان ليضمن انتشاره إلّا بسببٍ من روايته من قبل طلبة العلوم الدينيّة، وابن رشدٍ ما يزال على قيد الحياة. وقد كان لهذا الأخير طلبةٌ كثرٌ في العلوم الشرعيّة، سيما وأنّه ”درس الفقه والأصول“ إلى جانب علومٍ أخرى.[61] وفي هذا الباب يفيدنا الراحل محمّد بن شريفة إفادةً هامةً جدًا يقول فيها: ”وقد روى الكتاب عن ابن رشد عدد غير قليل من أهل العلم، [و] ذكر ابن الزبير في ترجمة أبي القاسم عبد الرحمن بن علي الجزري أنه أخذ عن أبي الوليد كتابه المسمى بـالنهاية، وقد انتشر هذا الكتاب الجليل بواسطة أحد تلاميذ ابن رشد، وهو أبو الحسن سهل ابن مالك. جاء في برنامج المنتوري: ’كتاب نهاية المجتهد وكفاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أبي القاسم ابن الإمام أبي الوليد بن رشد، قرأتُ بعضه على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمر، وأجاز لي جميعه، وحدثني به عن الأستاذ أبي الحسن علي بن سليمان القرطبي عن القاضي أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص عن الوزير أبي الحسن سهل بن محمد بن سهل بن مالك عنه.‘“[62] وعندما نأخذ هذا بعين الاعتبار، يسهل علينا أن نفترض حسن تلقّيه من قبل من اهتم بالصناعة ذاتها بعد ابن رشدٍ.
وفي ما يأتي عيّناتٌ فقط من الأثر الذي كان لهذا الكتاب منذ وفاة صاحبنا إلى حدود القرن العشرين.
- ابن طملوس (ت. 620هـ/1223م)
عالجنا في أعمالٍ سابقةٍ موضوع تتلمذ ابن طملوس لابن رشدٍ، لذلك فإنّنا لا نرى داعيًا إلى استعادة ذلك هنا.[63] أما ما يهمّنا هاهنا، فهو أن نقف عند استثمار ابن طملوس كتاب شيخه، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والظاهر من المقارنة بين الجزء الذي خصّصه ابن طملوس للمقاييس الفقهيّة في كتاب القياس وبين كتاب البداية أن هذا الأخير كان مصدرًا لابن طملوس في بعض الأمثلة والمواقف التي عبّر عنها بطريقته في عمله المذكور للتوّ. ولا بأس بأن نورد مثالًا لذلك.
يقول ابن طُمْلُوس:
وَقَدْ يَجْتَمِعُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَوْصَافٌ مُنَاسِبَةٌ كَثِيرَةٌ فَيُرَجِّحُ النَّاظِرُ أَشَدّهَا مُنَاسَبَةً وَيُسْنِدُ الْحُكْمَ إِلَيْهِ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ حَدًّا أَوْسَطًا. وَقَدْ رَامَ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَحْتَجُّ لِلشَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي أَعْطَى هِيَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً، الَّتِي هِيَ الطُّعْمُ، […] وَهَذَا الَّذِي قِيلَ جَيِّدٌ وَمُنَاسِبٌ. وَلَكِنْ، إِذَا تُؤُمِّلَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي اِعْتِبَارِ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ، ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً مِمَّا اِعْتَبَرَتْهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَدْلَ إِنَّمَا هُوَ بِالُمسَاوَاةِ. وَالظَّاهِرُ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ فِي مَنْعِ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ لِمَكَانِ التَّغَابُنِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ. وَالَّذِي يَحْفَظُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمُعَامَلَةِ إِنَّمَا هُوَ الْكَيْلُ أَوِ الْوَزْنُ. فَبِهَذَيْنِ، إِذًا، يَنْبَغِي أَنْ يُعَلَّقَ الْحُكْمُ، وَيُجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عِلَّةَ الرِّبَا. فَهَذَا كَمَا تَرَاهُ مُنَاسِبٌ جِدًّا. [64]
وهذا ما يقوله ابن رشدٍ في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ”ولكن إذا تُؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر —والله أعلم— أن علّتهم [الحنفية] أولى العلل وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي.“[65]
ومع أنّ هذا الجزء الخاصّ بالمقاييس الفقهيّة يشهدُ لمعرفة ابن طُمْلُوس بأصول الفقه، ولتمرّسه بمصطلحاته، ولاستئناسه ببعض أوجه الخلاف بين المدارس الفقهيّة المعروفة (الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة)، فهو يظهر تأثّره بفقه ابن رشدٍ، ويظهر ذلك في اعتماده على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لاستقاء بعض أمثلته واتّباع بعض مواقفه، فالانتصار لحجّة الحنفيّة في تعليل تحريم الربا واضح في الكتابين معًا، كما هو واضح مدى التأثير الذي مارسه ابن رشدٍ على تلميذه.[66]
وإذا كان ابن طملوس قد ساير الفارابي في تخصيص حيّزٍ للقياسات الفقهيّة ضمن كتاب القياس؛ ومعروفٌ أيضًا موقف ابن رشدٍ الحذر ممّا يسمّى بالقياسات الفقهية، فإنّه يمكن القول أيضًا إنّ ابن طُمْلُوس إنّما يلخّص، في هذا القسم بالذات،[67] بعض الأطراف من كتاب الجهاد من بداية المجتهد لابن رشدٍ، وخاصّة الفصل الثالث الذي يحمل عنوان: ”في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو“؛ وهو الأمر الذي لا نجد له مقابلًا في الفصل الخاص بالمقاييس الفقهيّة عند الفارابيّ.[68]
- أبو الحسن عليّ بن سعيد الرجراجيّ (ت. بعد 633هـ/1235م)
عاش هذا العالم في القرن السابع الهجريّ/الثالث عشر الميلاديّ. ولا نملك تفاصيل عن حياته الفكريّة سوى أن ثمرتها كانت تأليفه لعملٍ ضخمٍ يمكن عدّه بمثابة شرح لمدوّنة مالكٍ؛[69] والكتاب معروفٌ بعنوان: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدوّنة وحلّ مشكلاتها، ويقول المؤلّف نفسه أنّه قد شرع في تأليفه عام 633هـ/1235م.[70] وطبعًا، فنحن لسنا بعيدين عن زمن ابن رشدٍ، لذلك نجده ينقل منه ومن جدّه، كما هو الشأن في هذا المثال، حيث يقول: ”قال القاضي أبو الوليد وحفيده، رحمهما الله، وأحسب أنّ مالكًا، رحمه الله، إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل، فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل؛ وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روى أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم.“[71]
- ابن الدرّاج السبتيّ (ت. 693هـ/1293م)
بين أيدينا اليوم كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السّماع للفقيه والقاضي ابن الدرّاج السبتيّ. والكتاب في عنوانه الكامل هو: الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السّماع لاستئثاره بالكفاية والغناء في إحكام أحكام الغناء، والرّد على من نغّص على المسلمين بتحريم ما أبيح لهم منه في مظانّ المسّرة والهناء، أو حال اجتماع أرباب التهمّم بالسّماع ليتبعوا أحسنه أحسن الاتّباع وأولى الاعتناء.
يجد القارئ في هذا الكتاب إحالةً صريحةً على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدٍ؛ وهو يَرِدُ في النشرة التي بأيدينا الآن بعنوان نهاية المجتهد وكفاية المقتصد؛ وهو عنوانٌ شائعٌ أيضا، وقد استعمله ابن رشدٍ نفسه. يقول ابن الدرّاج: ”وقال القاضي أبو الوليد بن رشد حفيده صاحب نهاية المجتهد وكفاية المجتهد ما نصه: ’كما أجمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت بشيء محرم العين، وكذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات، وكذلك كل منفعة كانت فرضا على الانسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها.‘ انتهى.“[72]
وقد وقف محمّد مفتاح منذ زمنٍ على هذا الأمر، حيث يقول: ”أغلب المؤلفين في الفقه لم يجدوا غضاضة في الإشارة إلى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فصاحب كتاب الامتناع [كذا] في مسألة سماع السماع استشهد بآرائه الفقهية وترحّم عليه. فقد أورد رأيه في إبطال المنفعة الشيء المحرم العين والمحرم بالشرع مثل أجر المغنيات وأجر النوائح، وأورد رأيه في إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة وكذلك الثياب والبسط.“[73] ولا يمدّنا محمّد مفتاح بتفاصيل وافيةٍ بخصوص النسخة الخطّية لكتاب ابن الدراج التي اعتمدها في دراسته؛ لكنّ الذي نفهمه ممّا اقتبسه أن هذه النسخة غير تلك النسخة التي أخرجها محمّد بن شقرون، الذي ظلّ، بدوره، يعتقد أنّ للكتاب نسخةً خطّيةً يتيمةً. وإلى ذلك، فإنّ بن شقرون يضع نهاية المقتصد وكفاية المجتهد ضمن مصادر ابن الدرّاج السبتيّ، لكنّه لا يميّز بين صاحب العمل، الذي هو ابن رشدٍ الحفيد، وجدّه، فيضع العمل جنبًا إلى جنبٍ مع جامع المقدّمات وكتاب البيان والتحصيل للجدّ الذي بدوره يحيل عليه ابن الدرّاج إحالاتٍ يسهل تمييزها عن إحالاته عن الحفيد.[74]
- أبو عمران موسى بن أبي عليّ الزناتيّ الزموريّ (ت. 702هـ/1302م)
أبو عمران موسى بن أبي عليّ الزناتيّ الزموريّ، واحدٌ ممّن شرح رسالة أبي زيدٍ القيروانيّ. وقد عوّل كثيرًا في عمله، حلل المقالة في شرح الرسالة على بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لكنّه مع كثرة النقول، لا يذكر ابن رشدٍ إلّا قليلاً.[75] والواقع أنّ من يتّتبع عمله، سيقف على مدى تعويل الزناتيّ على بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فهو يحذو في تحديد أسباب الخلاف حذو ابن رشدٍ حذو النعل بالنعل، لكن من دون أن يذكره.[76]
- أبو الحسن الصغير الزرويلي (ت. 719هـ/1319م)
علمٌ آخر أتى على ذكر ابن رشد وله أهمّيةٌ خاصةٌ في المدرسة المالكيّة المغربيّة؛ إذ يُعتبر رائدها في القرن الرابع عشر المرينيّ، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبد الحقّ الزرويليّ، المعروف بالصُغَيِّر (ت. 719هـ/1319م). ومن بين أعماله المعروفة، وإن لم تكن قد حُقّقت بعد ونُشرت كاملةً، تقييد على تهذيب المدوّنة لأبي سعيد البَرَاذِعيّ (ت. 372هـ/983م). وفي هذا العمل، ينقل الصغيَّر من بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ويصرّح بذلك.
ونورد هنا مثالًا لهذه النقول:
قَالَ الْحَفِيدُ: ”اِخْتُلِفَ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهُم الْجُمْهُورُ؛ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هُوَ وَاجِبٌ؛ وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ المَالِكِيَّةِ: هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ وَفِي حَقِّ بَعْضٍ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَفِي حَقِّ بَعْضٍ مُبَاحٌ. وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ بِحَسَبِ مَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعَنَتِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ تَحْمِلُ صِيغَةُ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿[فَانْكِحُوا] مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾[الآية، النساء: 3] وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم الْأُمَمَ“ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى الْإِبَاحَةِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ وَفِي حَقِّ بَعْضٍ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَفِي حَقِّ بَعْضٍ مُبَاحٌ فَهُوَ اِلْتِفَاتٌ إِلَى الْمَصْلَحَةِ. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقِيَّاسِ يُسَمَّى الْمُرْسَل وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ. وَقَدْ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ الْعَمَلُ بِهِ. وَقَاَل دَاوُدُ هُوَ وَاجِبٌ. وَسَبَبُ الِخلَافِ هُوَ يَحْمِلُ فِعْلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ صَحَّ مِنْهُ.“.[77]
- أثير الدين أبو حيان النحوي الغرناطي الأندلسي (ت. 745هـ/1344م)
ونتصوّر أن العلاّمة أثير الدين أبا حيّان النحويّ الغرناطيّ الأندلسيّ، الذي رحل إلى مصر من الأندلس، قد حمل معه إلى هناك نسخته من بداية المجتهد ونهاية المقتصد ضمن أعمالٍ أخرى. وقد وصلتْ عناية هذا الشيخ، الذي كان عارفا بعمل ابن رشدٍ الآخر، الضروريّ في صناعة النحو، أنّه شرع في تصنيف مسلك الرّشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشدٍ، لكنّه لم يكمله حسب ما يقول ابن شاكر الكتبيّ.[78]
- أبو إسحاق الشاطبيّ (ت. 790هـ/1388م)
لا يهمّنا في هذا الموضع استعادة النقاش بخصوص العلاقة الفكريّة المفترضة بين الشاطبيّ وابن رشدٍ، ولا الحديث عن البعد الفلسفيّ المفترض لمقاصده؛ ما يهمّنا أكثر هو إظهار المواضع التي استعاد فيها الشاطبيّ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدٍ. وإذا كان فصل المقال قد حصلتْ استعادته في الموافقات، فإنّ الاعتصام قد اقتبس من البداية وناقشه. يقول:
وَقَدْ ضَعَّفَ ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ الِاسْتِدْلَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْحَدِيثِ، وَتَفْسِيرَ مَالِكٍ لَهُ، وَذَكَرَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ: ”وَيَتْرُكْ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ“ لَيْسَ بِالظَّاهِرِ أَنَّ تَرْكَ الْكَلَامِ مَعْصِيَةٌ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ نَذْرُ مَرْيَمَ.
قَالَ: ”وَكَذَلِكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ لِلشَّمْسِ لَيْسَ مَعْصِيَةً، إِلَّا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْ جِهَةِ تَعَبِ الْجِسْمِ وَالنَّفْسِ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ، فَإِنْ قِيلَ: فِيهِ مَعْصِيَةٌ؛ فَالْقِيَاسُ عَلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ التَّعَبِ لَا بِالنَّصِّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ.“
وَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ فِي الْحَدِيثِ مَا قَالَ اسْتِنْبَاطًا مِنْهُ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ الْمُتَكَلَّمِ فِيهَا، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا، فَتَرْكُ الْكَلَامِ —وَإِنْ كَانَ فِي الشَّرَائِعِ الْأُولَى مَشْرُوعًا— فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ، فَهُوَ عَمَلٌ فِي مَشْرُوعٍ بِغَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَكَذَلِكَ الْقِيَامُ فِي الشَّمْسِ زِيَادَةٌ مِنْ بَابِ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَإِنِ اسْتُحِبَّ فِي مَوْضِعٍ؛ فَلَا يَلْزَمُ اسْتِحْبَابُهُ فِي آخَرَ.[79]
- بدر الدين الزركشيّ (ت. 794 هـ/1392م)
وإلى جانب ما أثبتناه أعلاه من نقول الزركشيّ من مختصر المستصفى، فإنّه يمكن أن نضيف اعتمادًا على ما بأيدينا اليوم من معطياتٍ أن صاحب البحر المحيط قد استعمل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ وبخاصّة تلك المقدّمة الأصوليّة التي وضعها ابن رشدٍ لكتابه. يقول الزركشيّ ”وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة، لأنه من باب السمع. والذي يردّ ذلك يردّ نوعا من الخطاب.“[80]وهذا استعادة تكاد تكون حرفيّة لقول ابن رشد في مستهلّ بداية المجتهد: ”والجنس الأوّل [القياس] هو الذي ينبغي للظّاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني [دلالة اللفظ] فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع. والذي يردّ ذلك يردّ نوعا من خطاب العرب.“[81]
- ابن فرحون المالكي (ت. 799هـ/1397م)
علمٌ آخر من الأعلام الذين تفاعلوا مع عمل ابن رشد المذكور هو ابن فرحون المالكيّ؛ وهو مغربيّ الأصل ومتوفىّ بالمدينة، وله تآليف عدّة غير منشورة إلى اليوم. ومن أعماله في التراجم الديباج المُذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، الذي يقول فيه عن ابن رشد: ”وله تآليف جليلة الفائدة منها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل ووجه فأفاد وأمتع به، ولا يعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن سياقًا.“[82] وابن فرحون وإن كان يعوّل على ابن الأبّار القضاعيّ، صاحب هذا القول في الأصل، فهذه شهادة قيّمة من القرن الرابع عشر الميلاديّ في حق بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
- زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت. 806هـ/1403م) وابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت. 826هـ/1423هـ)
وينقل لنا المحدّث والفقيه الشافعيّ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ وابنه ولي الدين أبو زرعة العراقيّ لمحةً من النقاش الذي خاضه أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد مع جدّه في ما يتعلّق بالأبعاد الطبيّة والعلميّة لتسبيع نجاسة الكلب، حيث يردّ:
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ نَجَاسَةَ الْكَلْبِ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ تَكَلَّفَ وَحَمَلَ هَذَا الْعَدَدَ عَلَى الْمَعْنَى الطِّبِّيِّ، وَأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ مَا يُخَافُ مِنْ كَوْنِ الْكَلْبِ كَلْبًا وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ، وَهُوَ السَّبْعُ قَدْ جَاءَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الشَّرْعِ عَلَى جِهَةِ الطِّبِّ، وَالتَّدَاوِي كَمَا قَالَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَكَقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي مَرَضِهِ ”هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ“ وَنَحْوِ هَذَا. وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ وَغَيْرُهُ إلَى أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ رُشْدٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي هَذَا مِنْ التَّعَسُّفِ، وَالرَّجْمِ بِالظَّنِّ مَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ رُدَّ هَذَا عَلَى قَائِلِهِ بِجَوَابٍ طِبِّيٍّ أَيْضًا، وَهُوَ أَنَّ الْكَلْبَ الْكَلِبَ لَا يَقْرَبُ الْمَاءَ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الطِّبِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَجَابَ حَفِيدُهُ عَنْ هَذَا أَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْ الْمَاءِ إنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ تَمَكُّنِ الدَّاءِ مِنْهُ؛ فَأَمَّا فِي مَبَادِئِهِ فَيَقْرَبُ الْمَاءَ؛ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الْعِلَّةَ فِي التَّسْبِيعِ كَوْنَهُ نَهْيًا عَنْ اتِّخَاذِهِ، وَلَا مَعْنَى لَهُ، وَأَيُّ مَعْنًى مُنَاسِبٌ بَيْنَ كَوْنِهِ سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا؟ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ اقْتِنَائِهِ مُقْتَضِيًا لِزِيَادَةِ الْعَدَدِ لِلتَّنْفِيرِ عَنْهُ أَمَّا كَوْنُهُ سَبْعًا فَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهُ مُنَاسَبَةٍ.[83]
- أحمد بن محمد البرنسيّ الفاسيّ المعروف بزروق (ت. 899هـ/1492م)
تُعد أعمال أحمد زروق مرجعًا أساسيًا لدى المالكيّة. ومن أهمّ أعماله شرحه لمتن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيّ (ت. 386هـ/996م) في فقه المالكيّة. واستشهاده بـبداية المجتهد ونهاية المقتصد تأكيدٌ لمكانة المؤلّف ولكتابه ضمن الأدبيّات الفقهيّة المالكيّة أساسًا في عصره.
ونجد فِي شرح زروق على الرسالة ما يلي: ”وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه؛ بخلاف الفريضة. قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ”أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع لعذر أو نسيان، وخالف ابن عليك في النسيان، واختلفوا إن كان لغير عذر فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي لا قضاء عليه ومعروف المذهب المفطر ساهيا في الفطر يقضي وإن كان في رمضان وجب عليه إمساك بقية يومه لحرمته.‘“[84]
- الحطّاب الرُّعينيّ المالكيّ (ت. 954هـ/1547م)
شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن الطرابلسيّ المغربيّ، المعروف بالحطّاب الرُّعينيّ من المالكيّة. وقد ألّف في فروع المذهب، كما ألّف في النحو؛ ومن أعماله المعروفة مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. في هذا العمل أيضًا، نجد اقتباسًا من بداية المجتهد ونهاية المقتصد، حيث يقول الحطّاب: ”وقال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد: ’واتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب إلّا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز.‘“[85]
- ابن حجر الهيتميّ (ت. 973هـ/1566م)
ويقدّم الفقيه والأصوليّ الشافعيّ ابن حجرٍ الهيتميّ ابنَ رشدٍ الحفيد بوصفه من متقدّمي أئمّة المالكيّة ناقلاً رأيه في تصرّف المحجور؛ حيث يقول: ”وقال الحفيد بن رشد، من متقدمي أئمتهم: ’وأما تصرّفه قبل الحجر، فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لم تجر العادة بفعله.“ ثم قال: ”وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا: هو قبل الحجر كسائر الناس. وإنما ذهب الجمهور لهذا الأصل، لأن الأصل جواز الأفعال حتى يقع الحجر؛ ومالك كأنّه اعتمد المعنى نفسه وهو إحاطة الدّين بماله.‘ اهـ.“[86]
- قاضي صنعاء الحسين بن محمّد بن سعيد بن عيسى اللاعيّ (ت. 1119هـ/1707م)
ويخبرنا، في هذا الباب، محمّد بن عليّ الشوكانيّ في عمله البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع عن المحدّث والقاضيّ الحسين بن محمّد بن سعيد بن عيسى اللاعيّ، المعروف بالمغربيّ، مقدمًا إيّاه بوصفه:
قَاضِي صَنْعَاءَ وَعَالِمُهَا وَمُحَدِّثُهَا […] وَهُوَ مُصَنِّفُ الْبَدْرِ التَّمَامِ شَرْحُ بُلُوغِ الْمَرَامِ، وَهُوَ شَرْحٌ حَافِلٌ نَقَلَ مَا فِي التَّلْخِيصِ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى مُتُونِ الْأَحَادِيثِ وَأَسَانِيدِهَا. ثُمَّ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ نَقَلَ شَرْحَهُ مِنْ فَتْحِ الْبَارِي؛ وَإِذَا كَانَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمَ نَقَلَ شَرْحَهُ مِنْ شَرْحِ النَّوَوِيِّ؛ وَتَارَةً يَنْقُلُ مِنْ شَرْحِ السُّنَنِ لِابْنِ رِسْلاَنَ. وَلَكِنَّهُ لَا يَنْسُبُ هَذِهِ النُّقُولَ إِلَى أَهْلِهَا غَالِبًا مَعَ كَوْنِهِ يَسُوقُهَا وَيَنْقُلُ الْخِلَافَاتِ مِنَ الْبَحْرِ الزَّخَّارِ لِلْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، وَفِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ مِنْ نِهَايَةِ اِبْنِ رُشْدٍ، وَيَتْرُكُ التَّعَرُّضَ لِلتَّرْجِيحِ فِي غَالِبِ الَحالَاتِ وَهُوَ ثَمَرَةُ الْاِجْتِهَادِ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ شَرْحٌ مُفِيدٌ.[87]
- أحمد بن مهنا النفراويّ (1126هـ/1714م)
ومن جهته، يستعيد أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي رأي ابن رشدٍ على سبيل المناقشة في مسألة حصول فضل الجماعة للفرد المسبوق في الصلاة، حيث يورد ما يلي:
وَأَقُولُ: الْأَظْهَرُ مِنْهُمَا الْحُصُولُ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ السَّابِقُ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا حُصُولُ الْفَضْلِ، وَلَوْ فَاتَتْهُ بَقِيَّةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ اخْتِيَارًا خِلَافًا لِتَقْيِيدِ حَفِيدِ بْنِ رُشْدٍ بِمَا إذَا فَاتَهُ وَبَاقِي الصَّلَاةِ اضْطِرَارًا، وَيَدُلُّ لِمَا قُلْنَاهُ أَنَّ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ مِنْ الِاخْتِيَارِيِّ بِمَنْزِلَةِ إدْرَاكِ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي نَفْيِ الْإِثْمِ، وَلَوْ أَخَّرَ اخْتِيَارًا، وَأَيْضًا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ اخْتِيَارًا يُعِيدُ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا، وَقَوْلُنَا بِتَحَقُّقِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ إلَخْ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ وَضَعَهُمَا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ أَمْ لَا؟ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَيُلْغِيهَا. [88]
- الشروح على مختصر خليلٍ
وعمومًا، فقد حصلتْ استعادة أطرافٍ من بداية المجتهد ونهاية المقتصد من قبل واضعي الشروح والحواشي على مختصر خليلٍ؛ فقد نقل إلينا كلٌّ من أبي الحسن عليّ بن أحمد العدويّ (ت. 1189هـ/1775م)،[89] وشمس الدين محمّد عرفة الدسوقيّ (ت. 1230هـ/1815م)،[90]وأبي العبّاس أحمد الصاويّ (ت. 1241هـ/1825م)،[91] ومحمّد بن أحمد بن محمّد عليش (ت. 1299هـ/1882م)[92] بعضًا من أقوال ابن رشدٍ كما نُوقشت وانتُقدت. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الشروح على مختصر خليلٍ كانت وما تزال مقرّرة لطلاّب العلوم الشرعيّة في الغرب الإسلاميّ، بالنظر إلى مكانة المختصر عند المالكيّة المغاربيّين أساسًا، فإنّنا نستطيع أن نستنتج أنّ الإحالة على البداية لم تنقطع.
- شروحٌ أخرى
ومع أنّ المقام لا يتّسع هنا لتتبّع كلّ المواضع التي ذُكر فيها بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إذ يتطلّب الأمر بحثًا أشمل ممّا نحن بصدده، فإنّه ممّا يجدر بنا التأكيد عليه أنّ ذكر هذا الكتاب وحضوره في الأعمال الفقهيّة اللاحقة لم يعرف انقطاعًا في الغرب الإسلاميّ ولا في المشرق الإسلاميّ. ويكفي أن نشير بعض إشارةٍ إلى بعض الأسماء ممّا وقفنا عليه في معرض بحثنا. فقد استشهد به العالم من بيت الإمامة باليمن محمّدٌ بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسنيّ الكحلانيّ الصنعانيّ (ت. 1182هـ/1768م) في عمله سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجرٍ العسقلانيّ أكثر من مرّةٍ، كما انتقده أيضًا.[93] واستشهد به بدر الدين الشوكانيّ (ت. 1250هـ/1834م) في مجموعه الفتح الربانيّ من فتاوى الإمام الشوكانيّ.[94]
- شروحٌ من بداية القرن العشرين
أمّا في بداية القرن العشرين، وبالنظر إلى القرب الزمانيّ وانتشار تقنيّة الطباعة، فقد سهل علينا الوقوف على استعادة دارسي العلوم الشرعيّة لـبداية المجتهد لابن رشدٍ. وهكذا، فقد استُشهد بهذا الكتاب في تفسير المنار لمحمّد رشيد رضا (ت. 1354هـ/1935م).[95]
وذكره محمّد أنور شاه الكشميريّ (ت. 1352هـ/1933م) في عمله العرف الشذيّ شرح سنن الترمذيّ.[96]
وذكره محمّد بن محمّد بن عمر مخلوف (1360هـ/1941م) في شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة.[97]
كما أتى على ذكره محمّد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الشنقيطيّ (ت. 1363هـ/1944م) في زاد المسلم في ما اتّفق عليه البخاريّ ومسلم.[98]
وبالجملة، فهذه النقول والمناقشات تشهد لرواج بداية المجتهد ونهاية المقتصد عبر القرون. ونتصوّر أنّ أعمالًا كثيرةً قد استفادت من بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ونحن وإن لم نقف إلّا على قلّةٍ قليلةٍ من تلك النقولات، فإنّما ذلك لأسبابٍ منها أنّ نصوصًا كثيرةً لم تُحقّق بعد، وأنّ أخرى منشورةٌ نشراتٍ غير نقديّةٍ، ومنها أيضًا، وأساسًا، أنّ نصوصًا تُنقل من البداية لكنّها لا تذكره بالمرّة أو لا تذكره إلّا لمامًا. وعلى الرّغم من قلّة ما وقفنا عليه من نُقولٍ، فإنّ أهمّيتها تكمن، في نظرنا، في أنّها تثبت أمرًا أساسًا، وهو أنّ العمل الفقهيّ لابن رشدٍ، المعروف باشتغاله بالفلسفة وعلوم الأوائل، قد ظلّ يُعتمد من قبل المتعاطين للفقه في السياقات الإسلاميّة.
2. في كتب القواعد الفقهيّة
غير أنّ ما يمكن أن يُلاحظ، في المقابل، هو أنّ أغلب النقول من البداية قد حصلت في كتب الفروع والمذهب، وهذه، وإن كانت هامّة من جهة دلالتها على حياة الكتاب، فإنّها لا ترقى، في تقديرنا، إلى أن تعكس الجنس الأدبيّ الذي ينتمي إليه والغرض من تأليفه من قبل ابن رشدٍ. وهذا الجنس، كما هو ظاهرٌ من نصوصه التي استشهدنا بها أعلاه، هو القواعد الفقهيّة، وهو جنسٌ أدبيٌّ مستقلٌّ، وهو غير أصول الفقه ولا هو فروعه، بل هو وفق عبارة فولفهارت هينريش ”بمثابة لاعب ثالث له مكانته الهامة إلى جانب الأصول والفروع.“[99] وبالجملة، فالأصول الفقهيّة، أو القواعد الفقهيّة الكليّة، حسب التعريف الذي يقدّمه هينريش، هي التوجيهات الداخليّة الخاصّة والتي تنطبق على عددٍ من الأشخاص في مجالاتٍ متنوّعةٍ من الفقه، حيث تُستنبط الأحكام الخاصّة بهذه الأشخاص من تلك المبادئ أو القواعد الكلية. وتعكس القواعد الفقهيّة منطق التدليل الفقهيّ لمذهبٍ بعينه، ومن ثمّ فهي تصل الهيكل العامّ بالفروع.[100]
وإذا كان الاهتمام بهذا الجنس الأدبيّ الذي تمثّله القواعد الفقهيّة ما يزال في بداياته، فإنّ الالتفات إلى الدور الذي يمكن أن يكون كتاب ابن رشدٍ بداية المجتهد ونهاية المقتصد قد لعبه في تبلور هذا الجنس في الكتابات اللاحقة يكاد يكون منعدمًا. وإذا كانت الدراسات تعود إلى شهاب الدين القرافيّ، وعمله المعروف بـكتاب الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، بوصفه واحدًا من روّاد هذا الجنس الأدبيّ، بل وتنتقل منه لتقف عند جهود أبي عبد الله المقري (ت. 758هـ/1357م) وأحمد بن يحيى الونشريسي (ت. 914هـ/1508م)، فإنّها تتجاهل تمامًا منجز ابن رشدٍ في هذا الباب.[101]
ومن هذه الجهة، ربّما يكون أكثر من ذكر بداية المجتهد لأبي الوليد ابن رشدٍ وأحال عليه هو محمّد عليّ بن حسين المكيّ المالكيّ، مفتي المالكيّة في مكّة، وذلك في عمله المعروف بـتهذيب الفروق والقواعد السّنيّة في الأسرار الفقهيّة (ت. 1367هـ/1948م). والكتاب عبارة عن حواشٍ وضعها على كلٍّ من كتاب الفروق وشرح ابن الشاط لـكتاب الفروق للقرافي. وقد نقل منه محمّد علي بن حسين المالكي واعتمده حجةً لحل مجموعةٍ من المسائل أو الإشكالات حتّى نستعمل عبارته.[102] وما يجدر بنا التأكيد عليه هنا هو أنّ اعتماد الرجل على بداية المجتهد في تعليقاته على كتاب الفروق للقرافي لم يكن عفويًا ولا من دون مقدّماتٍ، وإنّما لأنّ هناك ناظمًا فكريًا يجمع الكتابين، كما سنظهر في الفقرة أدناه الخاصّة به، وحيث ينبغي إدراج كتاب تهذيب الفروق. ولهذا يظلّ هذا الكتاب الأخير من أهمّ الأعمال التي استثمرت عمل ابن رشدٍ في بداية العصر الحديث؛ والأهمّ منه هو عمل صاحب النصّ الذي يعلّق عليه صاحبنا، وهو كتاب كتاب الفروق لشهاب الدين القرافي.
- شهاب الدين القرافي (ت. 684هـ/1285م)
تتلمذ شهاب الدين القرافي لابن دقيقٍ العيد، وهذا كان يعرف ابن رشدٍ وقد ردّ عليه؛[103] كما تتلمذ للشريف الكركي محمد بن عمران بن موسى ابن عبد العزيز المتوفّى عام 689هـ/1289م، وهو من فاس؛ ويقول عنه صاحب الديباج: ”إنه شيخ المالكية والشافعية بالديار المصرية والشامية في وقته […] ومولده بفاس وتوفي بمصر.“[104]
لكنّ الظاهر من أعمال القرافي أنّ الرجل كان ذا تكوينٍ رصينٍ في العلوم الرياضيّة والطبيعيّة أيضًا، حتى قيل عنه إنّه كان إمامًا في العلوم العقليّة. وما يشهد لهذا التكوين أنّه قد ألّف في موضوعاتٍ علميّةٍ وفقهيّةٍ-علميّةٍ دقيقةٍ. ومن أعماله في هذا الباب: كتاب الاستبصار في ما تدركه الأبصار،[105] واليواقيت في أحكام المواقيت.[106] ومن الملفت للانتباه في هذا أن يحصل الاهتمام من قبل الدارسين بالجانب العلميّ والفلسفيّ في مسيرة القرافي حتى قبل أن تُعرف أعماله في الفقه والأصول.[107]
لكن ما يهمّنا في هذا الموضع هو عمل القرافي المعروف بـكتاب الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق.[108] وهو عملٌ ألّفه لترتيب فروع الفقه وردّها إلى فروقٍ أو قواعد فقهيّةٍ كليّةٍ؛ وقد أحصى منها مائتين وأربعٍ وسبعين فَرْقًا تنتظم الفروع والجزئيات، التي كان قد اشتغل عليها في كتاب الذخيرة.
ولنقف قليلًا عند أقواله في مقدّمة كتاب الفروق ولنقرأها في ضوء بعضٍ ممّا قاله ابن رشد في بداية المجتهد وثناياه، وقد مرّت بنا:
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ الْمُعَظَّمَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ […] اشْتَمَلَتْ عَلَى أُصُولٍ وَفُرُوعٍ، وَأُصُولُهَا قِسْمَانِ، أَحَدُهُمَا الْمُسَمَّى بِأُصُولِ الْفِقْهِ؛ وَهُوَ فِي غَالِبِ أَمْرِهِ لَيْسَ فِيهِ إلَّا قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ النَّاشِئَةُ عَنْ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ خَاصَّةً […] وَالْقِسْمُ الآخَرُ قَوَاعِدُ كُلِّيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ جَلِيلَةٌ، كَثِيرَةُ الْعَدَدِ، عَظِيمَةُ الْمَدَدِ، ومُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَسْرَارِ الشَّرْعِ وَحِكَمِهِ، لِكُلِّ قَاعِدَةٍ مِنْ الْفُرُوعِ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَا يُحْصَى، وَلَمْ يُذْكَرْ مِنْهَا شَيْءٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَإِنْ اتَّفَقَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ هُنَالِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ فَبَقِيَ تَفْصِيلُهُ لَمْ يَتَحَصَّلْ.
وَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ مُهِمَّةٌ فِي الْفِقْهِ عَظِيمَةُ النَّفْعِ بِقَدْرِ الْإِحَاطَةِ بِهَا يَعْظُمُ قَدْرُ الْفَقِيهِ وَيَشْرُفُ، وَيَظْهَرُ رَوْنَقُ الْفِقْهِ وَيُعْرَفُ، وَتَتَّضِحُ مَنَاهِجُ الْفَتَاوَى وَتُكْشَفُ، فِيهَا تَنَافَسَ الْعُلَمَاءُ وَتَفَاضَلَ الْفُضَلَاءُ […] وَمَنْ جَعَلَ يُخْرِجُ الْفُرُوعَ بِالْمُنَاسَبَاتِ الْجُزْئِيَّةِ دُونَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ تَنَاقَضَتْ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ وَاخْتَلَفَت، وَتَزَلْزَلَتْ خَوَاطِرُهُ فِيهَا وَاضْطَرَبَتْ، وَضَاقَتْ نَفْسُهُ لِذَلِكَ وَقَنَطَتْ، وَاحْتَاجَ إلَى حِفْظِ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي لَا تَتَنَاهَى وَانْقَضَى الْعُمْرُ وَلَمْ تَقْضِ نَفْسُهُ مِنْ طَلَبتِهٍ مُنَاهَا. وَمَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ بِقَوَاعِدِهِ اسْتَغْنَى عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ، لِانْدِرَاجِهَا فِي الْكُلِّيَّاتِ، وَاتَّحَدَ عِنْدَهُ مَا تَنَاقَضَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَتَنَاسَبَ […].
وَقَدْ أَلْهَمَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ أَنْ وَضَعْتُ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الذَّخِيرَةِ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ شَيْئًا كَثِيرًا مُفَرَّقًا فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، كُلُّ قَاعِدَةٍ فِي بَابِهَا وَحَيْثُ تُبْنَى عَلَيْهَا فُرُوعُهَا؛ ثُمَّ أَوْجَدَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَفْسِي أَنَّ تِلْكَ الْقَوَاعِدَ لَوْ اجْتَمَعَتْ فِي كِتَابٍ وَزِيدَ فِي تَلْخِيصِهَا وَبَيَانِهَا وَالْكَشْفِ عَنْ أَسْرَارِهَا وَحُكْمِهَا، لَكَانَ ذَلِكَ أَظْهَرَ لِبَهْجَتِهَا وَرَوْنَقِهَا، وَتَكَيَّفَتْ نَفْسُ الْوَاقِفِ عَلَيْهَا بِهَا مُجْتَمِعَةً أَكْثَرَ مِمَّا إذَا رَآهَا مُفَرَّقَةً، وَرُبَّمَا لَمْ يَقِفْ إلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنْهَا هُنَالِكَ لِعَدَمِ اسْتِيعَابِهِ لِجَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَأَيْنَمَا يَقِفُ عَلَى قَاعِدَةٍ ذَهَبَ عَنْ خَاطِرِهِ مَا قَبْلَهَا، بِخِلَافِ اجْتِمَاعِهَا وَتَظَافُرِهَا. فَوَضَعْتُ هَذَا الْكِتَابَ لِلْقَوَاعِدِ خَاصَّةً، وَزِدْتُ قَوَاعِدَ كَثِيرَةً لَيْسَتْ فِي الذَّخِيرَةِ، وَزِدْتُ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي الذَّخِيرَةِ بَسْطًا وَإِيضَاحًا؛ فَإِنِّي فِي الذَّخِيرَةِ رَغِبْتُ فِي كَثْرَةِ النَّقْلِ لِلْفُرُوعِ؛ لِأَنَّهُ أَخَصُّ بِكُتُبِ الْفُرُوعِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَثْرَةِ الْبَسْطِ فِي الْمَبَاحِثِ وَالْقَوَاعِدِ.[109]
ولنا أن نسجّل ملاحظتين على الأقلّ هنا: الأولى إعلاء القرافي الواضح منذ البداية من شأن القسم الثانيّ من أصول الشريعة، والمتعلّق بالقواعد الفقهيّة، وهو جنسٌ أدبيٌّ مستقلٌّ يقع بين فروع الفقه وأصوله؛ وهذا الإعلاء أمرٌ دأب عليه المؤلّفون عند تقديم كتبهم في علمٍ بعينه، كما أنّه أمرٌ ملاحظٌ في بعض المؤلّفات في القواعد الفقهيّة التي جاءت بعد القرافي؛[110] أمّا الملاحظة الثانيّة، فهي أنّه عند قراءة هذه النصوص قد يدرك المرء مدى التقارب بين نهجي القرافي وابن رشدٍ ومدى استلهام الأوّل لمشروع الثانيّ.[111] فكتاب القرافي، وإن كان يحمل عنوان كتاب الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، فهو كتابٌ في القواعد الكليّة الفقهيّة، وكلّ قاعدةً منها تنتظم فروعًا كثيرةً في الشريعة. وفي الواقع، فإنّ القرافي هنا لا يعمل سوى على تطوير العمل الذي دشّن به ابن رشدٍ علم القواعد الفقهيّة في الغرب الإسلاميّ؛ وما يهمّنا إضافته هنا أنّ كتاب الفروق قد اعتمد فعلًا على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدٍ. ومع أنّ القرافي ينقل منه، فإنّ المثير للانتباه أنّه يطلق على كتاب ابن رشدٍ المعني عنوانًا دالًّا في سياقنا، وهو كتاب القواعد.[112]
ونستأنس بإحالة القرافي هذه لنقول أمورًا أربعةً على الأقلّ: أمّا الأمر الأوّل، فهو انتقال كتاب ابن رشدٍ إلى مصر ورواجه بها. وأمّا الأمر الثانيّ، فهو أنّ القرافي قد أتى إلى تقعيد الخلافات والفروق بعد أن اشتغل بفروع الفقه في الذخيرة، بينما ابن رشدٍ قد قدّم القواعد الفقهيّة وبقي يمنّي النفس (”إن أنسأ الله في العمر“) بوضع كتابٍ ”في الفروع على مذهب مالك بن أنسٍ مرتبًا ترتيبًا صناعيًّا؛ إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس؛ حتّى يكون به القارئ مجتهدًا في مذهب مالكٍ، لأنّ إحصاء جميع الروايات عندي شيءٌ ينقطع العمر دونه.“[113] أي ”كتابًا جامعًا لأصول مذهبه [=مالك] ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليها.“[114] غير أنّ هذا الكتاب لم ير النور. وأمّا ثالث الأمور، فهو إقرار القرافي بريادة ابن رشدٍ في علم القواعد الفقهيّة، وهو جنسٌ أدبيٌّ جديدٌ، لا نجده في ما سبق من كتب المالكيّة على الأقلّ. وأمّا رابع الأمور، وهو متّصل بالذي سبقه، فهو اعتبار القرافي كتابَ البداية عملًا في القواعد الفقهيّة، وهو ما يصدق على كتاب القرافي أيضًا، وممّا يظهر القرابة المنهجيّة بينهما. وفعلاً، فإنّ ابن رشدٍ ما فتئ يؤكّد منذ بداية الكتاب على طابعه التقعيديّ والتأصيليّ. وقد سبق أن أتينا في البداية بقوله الآخر الذي يؤكّد فيه أنّ القصد من تأليف البداية ليس هو تفصيل المذهب ولا تخريجه على طريقة كتب المذاهب،وإنّما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها. ولأجل كلّ هذا، في نظرنا، حُقّ للقرافي أن يُطلق على كتاب ابن رشدٍ كتاب القواعد.
وبالجملة، فقد أدرك القرافي الطبيعة القانونيّة والقواعديّة لكتاب ابن رشدٍ واستثمره في عمله؛ وتكفي المقارنة بين الكتابين حتّى يظهر أنّ تأثّر القرافي بابن رشدٍ يتعدّى مجرّد الاستشهاد إلى استئناف جنس القول في تقعيد الخلاف الفقهيّ في القرنين السابع للهجرة والثالث عشر الميلاديّ.
- ابن جزي: القوانين الفقهيّة على مذهب مالكٍ
علمٌ آخر غرناطي من عهد بني الأحمر يشهد أيضًا لقولنا بالتأثير الكبير لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في المؤلّفات التي أُلّفت في علم القواعد الفقهيّة؛ وهو أبو القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت. 741هـ/1340م)، صاحب كتاب القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب المالكيّة والتنبيه على مذهب الشافعيّة والحنفيّة والحنبليّة.[115] انطلاقًا من مطالعة أوّليّة لهذا الكتاب، يمكن القول بوجود أثرٍ واضٍح لابن رشدٍ واقتباساتٍ منه تمتدّ من عنوانه[116] إلى منهجه ومضامينه. وقد وقف محمّد بن سيدي، محقّق النشرة التي بأيدينا، على ما ندّعيه أيضًا؛ ونكتفي هنا بإيراد قوله كاملًا: ”ويبدو تقاربٌ بين منهجه [ابن جزي] ومنهج أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد في بداية المجتهد، مع بعض الاختلاف.“[117] وهذا الاختلاف، في نظر محمّد بن سيدي، يقوم في أنّ ”ابن جزي يعرض للخلاف في المذهب [المالكي] والخلاف العالي مجردا عن الدليل، والحفيد يعرض للخلاف العالي بالدرجة الأولى مع التفصيل والتدليل.“[118] وبالفعل، فكتاب ابن جزي كما يقول، هو نفسه، ”كتاب في قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس […] ثم زدنا على ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف بين الإمام المسمى وبين الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل […] وربما نبهت على مذهب غيرهم من أئمة المسلمين، كسفيان الثوري، والحسن البصري.“[119] ويضيف ابن جزي متحدثًا عن ثلاث ميزاتٍ لكتابه بالقياس إلى ما تقدّمه، لن نذكر سوى أولاها لتعلّقها بما نحن فيه: ”ولكن الكتاب ينيف عن سائر الكتب بثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي، بخلاف غيره من الكتب فإنها في المذهب خاصة، أو في الخلاف العالي، بخلاف غيره من الكتب فإنها في المذهب خاصة أو في الخلاف العالي خاصة.“[120] وإلى ذلك، فإنّ كتاب ابن جزي ضمّ أمورًا أخرى لا نجدها في البداية، وهو كتاب الجامع في سيرة رسول الله (ص) وفي ذكر الخلفاء وفاتحةٍ في العقيدة. أمّا دون ذلك، فإنّ ابن جزيّ ينقل من ابن رشدٍ كثيرًا. وفي هذا يقول محمّد بن سيدي: ”من أمثلة أخذه عنه قوله في باب الطهارة: ’تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا، وسجود التلاوة إجماعا، ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الأربعة خلاف القوم،‘ فهذا النصّ يشبه ما ورد عند ابن رشدٍ، مع أنّه لم يعزه إليه، ومثل هذا التشابه متكرّرٌ، كقوله في باب النكاح، عند الكلام على النظر إلى المخطوطة: ’ومنع قوم الجميع.‘ وكقوله في الصداق أيضًا: ’إن أصدقها ما لا يجوز نفيه روايتان: إحداهما إنه يفسح قبل الدخول وبعده، وفاقا لأبي عبيد…‘ لهذا من المرجّح أن يكون أخذ عنه كثيرا.“[121] وإلى ذلك، فلعلّه اعتمدَ أيضًا على ابن رشدٍ في الحديث عن علماء من خارج المذهب المالكيّ، وفي هذا يقول محمّد بن سيدي مولاي:
كما يعزو [ابن جزي] لعلماء المذهب من علماء السلف، مثل ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم من فقهاء الأمصار […]، والفقهاء من المذاهب كإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، ولم يذكر من أين أخذ هذه الأقوال، ويغلب على الظن أنه أخذها من الكتب المختصة بذكر الخلاف، مثل كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وبداية المجتهد لابن رشد، والإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، أو من كتب العلماء المذكورين.[122]
ومراجعة الكتاب ومقارنته توقفنا على وجود نقولٍ من بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ وتكفينا الإشارة إلى البابين الثامن والرابع عشر من الكتاب الثانيّ في الصلاة، وإلى الباب الخامس من الكتاب التاسع في الأطعمة والأشربة والعبد والذبائح.[123] والغريب أنّ ابن جزيّ لا يأتي على ذكر ابن رشدٍ بالاسم، كما سبقت الإشارة.
- الشريف التلمسانيّ (ت. 770هـ/1370م)
هذا اسم هامٌّ ومحوريٌّ في تاريخ التلقّي الذي حصل لكتابات ابن رشدٍ في العلوم العقليّة والدينيّة معًا. فقد درس وابن خلدون على يد الشيخ أبي عبد الله الآبليّ (ت. 757هـ/1356م)، ومن بين ما دَرّس هذا الأخير كتب ابن رشدٍ في المنطق. يقول ابن خلدون (ت. 808هـ/1406م) عن التلمسانيّ: ”كان هو قد أحكم ذلك [كتاب الإشارات لابن سينا، (ت. 428هـ/1037م)] على شيخنا الآبلي، وقرأ عليه كثيرًا من كتاب الشفالابن سينا، ومن تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد، ومن الحساب والهيئة والفرائض، علاوة على ما كان يحمله من الفقه والعربية وسائر علوم الشريعة، وكانت له في كتب الخلافيات يد طولى وقدم عالية.“[124]
وقد خلف الشريف التلمسانيّ أعمالًا هامّةً، منها: شرح جمل الخونجيّ، ومثارات الغلط في الأدلّة، إضافةً إلى مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الذي يهمّنا هنا. ويُحصي محمّد علي فركوس، محقّق الكتاب الأخير، أعمال ابن رشدٍ المنطقيّة من مصادر الشريف التلمسانيّ، كما يضع بداية المجتهد ونهاية المقتصد ضمن الكتب الفقهيّة التي كانت من مصادر التلمسانيّ في كتابه مفتاح الوصول.[125] وهذا الأمر، وإن بدا طبيعيًا وهامًّا، لأنه يثبت تأثير كتاب ابن رشدٍ، فإنّه، في تقديرنا، يحمل غير قليلٍ من الغموض والتخسيس للمكانة التي يجب أن ينزل فيها الكتاب. ولبيان ذلك، لابد من الإشارة إلى أنّ المحقّق قد قَسّم مصادر مفتاح الوصول إلى مؤلّفات أصوليّة، وقد أحصى من هذه: شرح تنقيح الفصول للقرافيّ، والمحصول للرّازيّ، وأعمالًا أخرى؛[126] وإلى مصنفات في القواعد الفقهيّة، وقد أحصى منها اثنين، هما: قواعد الأحكامللعزّ بن عبد السلام (ت. 660هـ/1261م)، وأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافيّ؛[127] ومؤلّفات فقهيّة، وفي هذا الصنف بالذات أدخل كتاب البداية لابن رشدٍ، إلى جانب المحلى لابن حزمٍ، والمنتقى للباجيّ (ت. 474هـ/1081م)، والبيان والتحصيل لابن رشدٍ الجدّ (ت. 520هـ/1126م)؛[128] وأخرى عامّة في التفسير والحديث واللغة.[129] وحسب هذا التقسيم، يغدو بداية المجتهد كتابًا في الفقه، مثله مثل الكتب التي انتقدها ابن رشدٍ، وليس كتابًا في القواعد على غرار كتابي العزّ بن عبد السّلام والقرافيّ، وقد رأينا أن هذا قد أسماه كتاب القواعد.
- قواعد الفقه لأبي عبد الله محمّد بن أحمد المقَرّي (ت. 759هـ/1357م)
وهذا الغموض الذي سقط فيه محمّد عليّ فركوس ذهب ضحيّته، أيضًا، الراحلُ محمّد الدّردابيّ في مقدّمة تحقيقه قواعد الفقه لأبي عبد الله محمّد بن أحمد المقريّ التلمسانيّ،[130] بحيث لم يتفطن إلى أن بداية المجتهد لابن رشدٍ إنّما هو كتاب في علم القواعد الفقهية، إذ يقول:
من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها هذا العلم، أو أول من وضع أسسه وتكلم عليه؛ فنجد الحطاب في شرحه لمختصر الشيخ خليل قد أشار في الجزء الأول منه صفحة 57 إلى قواعد الزهري، وكذلك أشار القرافي في الفروق في الجزء الثالث منه صفحة 263 إلى قواعدابن رشد. ولا نعلم شيئا عن قواعد الزهري أو قواعد ابن رشد، إلّا أنه من الثابت أن أبا طاهر الدباس، إمام الحنفية وراء النهرين، الذي عاش في القرنين الثالث والرابع الهجري قد جمع بعض القواعد الفقهية.[131]
والحال أن القرافيّ لم يقصد بـقواعد ابن رشدٍ غير كتاب بداية المجتهد؛ هذا فضلًا عن أنّ قواعد الفقه للمقريّ نفسه يشترك مع كتاب ابن رشد في نفس الجنس الأدبيّ الواحد، فـ”قواعد الفقه التي أتى بها مؤلفنا [=المقريّ] ليست خاصة بالمذهب المالكي، بل هي على مستوى المذاهب الأربعة، […] سواء من حيث المقارنة بين المذاهب أو من حيث الكشف عن أسرار وأسباب الخلاف داخل المذهب أو على مستوى الخلاف العالي.“[132] وبالجملة، فعلى الرغم من ولع المقريّ الشديد بالقرافيّ، فإنّ البداية لابن رشدٍ كان ضمن مصادر كتابه قواعد الفقه،[133] بل كان وراء إطلاقه هذا العنوان.
وعمومًا، فإنّنا نتصوّر أنّ مصادر أخرى في علم القواعد الفقهيّة قد استثمرت كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد،[134] لكنّ المقام لا يتّسع إلّا لما ذكرناه.
خاتمة
إذا كان أغلب التلاميذ الذين نعرفهم اليوم لابن رشدٍ هم من المشتغلين بالعلوم الشرعيّة، فإنّ أغلب المشتغلين اليوم بالعلوم الشرعيّة يشكّكون في مكانة ابن رشد الفقهيّة. أمّا المشتغلون بتاريخ الفلسفة في الإسلام، وبفلسفة ابن رشدٍ، فأغلبهم لا يعير الأمر أهميّة؛ لأنّ أعمال ابن رشدٍ التي كانت موضوع قولنا لا تمثّل الوجه الفلسفيّ الذي ينبغي الانشغال به… هذا مع أنّهم لا ينتظرون من المشتغلين بالعلوم الشرعيّة الاهتمام بابن رشدٍ أصلًا.
كان غرضنا، في هذه الورقة، مراجعة مكانة ابن رشدٍ لدى فقهاء وأصوليّي العالم الإسلاميّ بعد وفاته وإلى حدود القرن العشرين. وبناءً على ما فحصنا من وثائق ووقفنا عليه من نصوصٍ، يمكن القول أولًا: إنّ الاستشهاد بابن رشدٍ لم ينقطع، كما أنّ أعماله، ثانيًا، كانت جزءًا من البرنامج الدراسيّ لطلبة العلوم الشرعيّة في السياقات الإسلاميّة. ونتصوّر أنّ الأمر سيزداد وضوحًا مع ظهور النصوص وتحقيق الأعمال الفقهيّة.
قد يعترض معترضٌ بأنّ أغلب ما أوردناه لا يعدو أن يكون نقولًا… وليس ممّا يمكن عدّه دليلًا على اعتماده سلطةً. وجوابنا في هذه الحالة كما يلي: لم يكن طموحنا، في هذه الدراسة، أكثر من هذا، ولو أنّ ذكر ابن رشدٍ من قبل أعيان المذهب المالكيّ، وقد أحصينا بعضهم، أمر يدعو إلى مراجعة الاعتراض من أساسه. وفي كلّ الأحوال، لقد وضعنا نصب أعيننا مراجعة ذلك الحكم المشهور الذي يُزْعَم فيه دونما دليلٍ أنّ ابن رشدٍ لا يُذكر في المدوّنات الفقهيّة. بل يمكن القول إنّ ما وقفنا عليه من معطياتٍ قد أفضى بنا إلى وضع اليد على عناصر التجديد والأصالة في تلقّي بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ونختصرها في أمرين اثنين: أوّلهما أنّ ابن رشدٍ قد عمد إلى وضع عملٍ جديدٍ يرصد منطقًا للخلاف بين الفقهاء ولاتّفاقهم، وهو علم القواعد الفقهيّة، إنقاذًا للصناعة الفقهيّة ذاتها من الانتشار والفوضى؛ والأمر الثانيّ ويؤكّد الأوّل، وهو تأكيد القرافي وابن جزيّ وغيرهما لجهود ابن رشدٍ التنظيريّة في هذا الباب واستئنافهم لها.
وهنا يجب التأكيد على أنّ الأثر الذي يفترض أن يكون لـبداية المجتهد ونهاية المقتصد إنّما يجب أن يُبحث عنه لا في كتب الفروع ولا كتب الأصول —على أهميّة ذلك الأثر— لأنّ البداية ليس من هاتين الصناعتين، وإنما في الكتب التي تنتمي إلى الجنس الأدبيّ ذاته الذي يدخل تحته الكتاب، وهو علم القوانين أو القواعد الفقهيّة. ومن هذه الجهة، فإنّ الزعم بأنّ ابن رشدٍ لم يُعتبر من قبل فقهاء المذهب يغدو زعمًا غير ذي موضوعٍ، لأنّ كتاب ابن رشدٍ ليس في المذهب، هذا مع أنّ الكتاب قد استُشهد به من قبل كتب المذهب؛ أما كتب القوانين الفقهيّة، فيكفي ابن رشدٍ فضلًا أن يكون أوّل من افتتح هذا الجنس العلميّ، في الغرب الإسلاميّ على الأقلّ، كما يكفيه فضلًا أن يكون أثّر في أجيالٍ لاحقةٍ كالقرافيّ وابن جزيّ والتلمسانيّ وآخرين.
Bibliography
ʿAbd ar-Raḥmān, Ṭaha. Ḥiwārāt min ajl al-mustaqbal. Beirut: ash-Shabaka al-ʿArabiyya li-l-ʾAbḥāth wa-n-Nashr, 2011.
al-ʿAdawī, Abū l-Ḥasan ʿAli b. Aḥmad. Ḥashiyya ʿalā sharḥ mukhtaṣar khalīl. 2nd ed., vol. 2. Cairo: al-Maṭbaʿa al-Kubrā al-ʾAmiriyya bi-Būlāq, 1317 AH.
al-ʿAlawī, ʿAlī. Ijtihād az-Zarwīlī: Kitab at-taqyīd ʾunmūdaja. Tunis: ad-Dār at-Tūnusiyya li-l-Kitāb, 2014.
al-ʿAlawī, Jamāl ad-Dīn. al-Matn ar-rushdī: Madkhal li-qirāʾa jadīda. Casablanca: Dār Tubqāl, 1986.
al-ʿAmrānī, Muḥammad al-ʾAmīn. Ikhtiyyārāt Ibn Rushd al-Ḥafīd al-fiqhiyya fī Bidāyat al-Mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. 2 vols. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2011.
al-Baghdādi, ʿAdb al-Laṭīf. Kitāb an-naṣīḥatayn. Edited by Fuʾād Bin Aḥmad. In ʿAdb al-Laṭīf al-Baghdādi, al-ʾAʿmāl al-falsafiyya al-kāmila. Vol. 1. Edited by Naẓīra Fadwāsh, Yūnus Ajʿūn, and Fuʾād Bin Aḥmad. Rabat-Algeria-Beirut: Dār al-ʾAmān-Manshūrāt al-ʾIkhtilāf-Ḍifaf li-n-Nashr, 2018.
al-Barmāwi, Shams ad-Dīne al-Miṣrī. Al-Fawāʾid as-saniyya fī sharḥ al-ʾalfiyya. Edited by ʿAbdullah Ramaḍān Mūsā. Vols. 2 and 3. Riyadh: Manshūrāt Maktabat Dār an-Naṣīḥa, 2015.
al-Bulnusī, Muḥammad al-ʿAbdarī. ar-Riḥla al-maghribiyya. Introduced by Saʿd Buflāqa. Būna: Manshūrāt Būna li-l-Buḥūth wa-n-Nashr, 2007.
al-Būshīkhī, Aḥmad. Abū l-Ḥajjaj Yūsuf b. Dūnās Al-Fandllawī, Tahthīb al-masālik fī nuṣrat madhhab Mālik ʿalā manhaj al-ʿadl wa-l-ʾinsāf fī sharḥ masāʾil al-khilāf. Edited by Aḥmad al-Būshīkhī. Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2009.
al-Ḥasanī, Muḥammad b. Ismāʿīl aṣ-Ṣanʿānī. Subul as-salām sharḥ bulūgh al-marām min jamʿ ʾadillat al-ʾaḥkām. Edited by ʿAbd al-Qādir Aḥmad ʿaṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1988.
al-Ḥaṭāb, Shams ad-Dīn. Mawāhib al-jalīl fī sharḥ mukhtaṣar khalīl. Volume 3. 3rd ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
al-Haytamī, Ibn Ḥajar. al-Fatāwā al-kubrā al-fiqhiyya. Vol. 3. Cairo: Multazim aṭ-Ṭabʿ wa-n-Nashr ʿAbd al-Ḥamīd Aḥmad Ḥanafī, [n.d.].
al-ʿIrāqī, Zayn ad-Dīn. Kitāb ṭarḥ at-tathrīb fī sharḥḥ at-taqrīb. Vol. 2. Beirut: Dār ʾIḥyāʾ at-Turāth al-ʿArabī, [n.d.].
al-Jābirī, Muḥammad ʿĀbid. Ibn Rushd sīra wa-fikr. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabiyya, 1998.
al-Kashmīrī, Muḥammad ʾAnwar Shāh. al-ʿArf ash-Shadiyy sharḥ sunan at-Tirmidhī, edited by Maḥmūd Shākir, vol. 1. Beirut: Dār ʾIḥyāʾ at-Turāth, 2004.
al-Kutubī, Muḥammad b. shākir. Fāwāt al-wafayāt wa-dh-dhayl ʿalayhā, edited by ʾIḥsān ʿAbbās, vol. 3. Beirut: Dār Ṣādir, [n.d.].
al-Maqqarī, Abū ʿAbdillah Aḥmad b. Muḥammad. Qawāʿid al-fiqh, edited by Muḥammad ad-Dardābī. Rabat: Dār al-ʾAmān, 2012.
al-Maqqarī, Aḥmad b. Muḥammad at-Tilimsānī al-Ḥafīd. Nafḥ aṭ-ṭīb min ghusn al-Andalus ar-raṭīb, edited by ʾIḥsān ʿAbbās, vol. 3. Beirut: Dār Ṣādir, 1988.
al-Qalṣādī, Abū l-Ḥasan ʿAlī al-ʾAndalusī. Riḥlat al-Qalṣādī. Edited by Muḥammad Abū l-ʾAjfān. Tunis: ash-Sharika at-Tūnusiyya li-t-Tawzīʿ, 1978.
al-Qarāfī, Aḥmad b. Idrīs. al-Yawāqīt fī aḥkām al-mawāqīt. Edited by ʿAlī al-Jihānī. Oman: Dār an-Nūr al-Mubīn, 2014.
_______. Kitāb al-furūq aw ʾAnwār al-burūq fī ʾanwāʾ al-furūq. Edited by ʿUmar Ḥasan al-Qyām. Vol. 3. Beirut: Muʾassasat ar-Risāla Nāshirūn, 2003.
_______. Kitāb al-furūq aw ʾAnwār al-burūq fī ʾanwāʾ al-furūq. Edited by Muḥammad Aḥmad Sarrāj and ʿAli Jumʿa. Cairo: Dār as-Salām li-ṭ-Ṭibāʿa wa-n-Nashr wa-t-Tawzīʿ wa-t-Tarjama, 2001.
_______. Kitāb al-ʾistibṣār fī mā tudrikuhu al-ʾabṣār. MS El Escorial, no. 707.
_______. Kitāb al-ʾistibṣār fī mā tudrikuhu al-ʾabṣār. MS Ḥikmat Tīmūr bi-Dār al-Kutub al-Miṣriyya, Cairo, no. 83.
al-Qurṭubī, Abū l-ʿAbbās. al-Mufhim limā ʾushkil min talkhīs kitāb Muslim. Edited by Muḥyī ad-Dīn Dīb Mistū, Aḥmad Muḥammad as-Sayyid, Yūsuf ʿAlī Bdīwī, and Maḥmūd Ibrāhīm Bazl. 7 vols., vol. 1. Damascus-Beirut: Dār al-Kalim aṭ-Ṭayyib, 1996.
al-Wansharīsī, Abū l-ʿAbbās Aḥmad b. Yaḥyā. Al-Miʿyār al-muʿrib wa-l-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ʾIfrīqyya wa-l-Andalus wa-l-Maghrib. Edited by Muḥammad Ḥajjī [and others]. Vol. 5. Rabat: Manshūrāt Wizārat al-ʾAwqāf wa-sh-Shuʾūn al-Islāmiyya, 1981.
Amlīl, ʿAlī. As-Sulṭa ath-thaqqāfiyya wa-s-sulṭa as-siyāsiyya. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabiyya, 1986.
ar-Raʿīnī, ʿAlī b. Muḥammad. Barnāmaj shuyūkh ar-Raʿīnī. Edited by Ibrāhīm Shbūḥ. Damascus: Maṭbūʿāt Mudīriyyat ʾIḥyāʾ at-Turāth al-Qadīm, 1962.
ar-Rajrājī, Abū l-Ḥasan ʿAli b. Saʿīd. Manāhij at-taḥṣīl wa-natāʾij laṭʾif at-taʾwīl fī sharḥ al-mudawwana wa-ḥall mushkilātihā. Edited by Abū l-Faḍl ad-Damyāṭī. 10 vols. Casablanca-Beirut: Markaz at-Turāth ath-Thaqāfī al-Maghribī-Dār Ibn Ḥazm, 2007.
ash-Shanqīṭī, Muḥammad Ḥabīb ʾAllāh. Zād al-muslim fīmā ittafaqa ʿalayhi al-Bukhārī wa-Muslim. Vol. 2. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmi, [n.d.].
ash-Shāṭibī, Abū ʾIsḥaq. al-ʾIʿtiṣām. Edited by Saʿd b. ʿAbdullah ʾĀl Ḥamīd. Vol. 2. Dammam: Dār Ibn al-Jawzī li-n-Nashr wa-t-Tawzīʿ, 2008.
ash-Shawkāni, Muḥammad b. ʿAlī. Al-Badr aṭ-ṭāliʿ bi-maḥāsin man baʿda al-qarn as-sābiʿ. Vol. 2. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, [n.d.].
_______. Kitāb al-fatḥ ar-rabbānī min fatāwā al-Imām ash-shawkāni. Edited by Abū Muṣʿab Muḥammad Ṣubḥī. Vol. 6. Ṣanʿāʾ: Maktabat al-Jīl al-Jadīd, [n.d.].
aṣ-Ṣāwī, Abū l-ʿAbbās. Hāshiyat aṣ-Ṣāwī ʿalā ash-sharḥ aṣ-ṣaghīr. Edited by Muṣṭafā Kamāl Waṣfī. Vol. 1. Cairo: Dār al-Maʿārif, 1986.
at-Tilimsānī, ash-sharīf. Miftāḥ al-wuṣūl ʾilā bināʾ al-furūʿ ʿalā al-ʾuṣūl, wa yalīh Mathārāt al-ghalaṭ fī-l-ʾadilla. Edited by Muḥammad ʿAlī Farkūs. Mecca-Beirut: al-Maktaba al-Makkiyya-Muʾassasat ar-Rayān, 1998.
az-Zarkashī, Badr ad-Dīn. Al-Baḥr al-muḥīṭ fī ʾusūl al-fiqh. Edited by ʿUmar Sulaymān al-ʾAshqar and Muḥammad Sulaymān al-ʾAshqar. Vol. 1. Kuwait City: Manshūrāt Wizārat al-ʾAwqāf wa-sh-Shuʾūn al-Islāmiyya, 1988.
az-Zarwīlī, as-Ṣughyyar. At-Taqyīd ʿalā tahdhīb al-mudawwana. MS no. 463, Maktabat ʾĀl an-Nīfar, Tunis, vol. 3.
az-Znātī, Abū ʿImrān. Ḥulal al-maqāla fī sharḥ ar-risāla. MS from a private library, in Dalīl Jāʾizat al-Ḥasan ath-Thāni li-l-Makhṭūṭat. Rabat: Manshūrāt Wizārat ath-Thaqāfa, 2017.
Badawi, ʿAbdarrahmān. “Remarques et questions.” In Multiple Averroès. Edité par Jean Jolivet. Paris: Les Belles Lettres, 1978.
Ben Ahmad, Fouad. “Ṭarīqat al-jadal al-falsafī ʿinda Ibn Rushd: al-Qiyam wa-l-manāfiʿ wa-l-ḥudūd.” Mélanges De Lʾuniversité Saint-Joseph, vol LXIII (2010-2011): 259–322.
_______. Ibn Ṭumlūs al-faylsūf wa-ṭ-tabīb (d. 620/1223): Sīra biblyughrāfiyya. Rabat-Beirut-Algeria-Tunis: Dār al-ʾAmān-Ḍifāf-Ikhtilāf-Kalima, 2017.
Binsharīfa, Muḥammad. al-ʾAʿmāl al-kāmila li-Abī al-Muṭarrif Ibn ʿUmayra (d. 658 AH): 1- as-Sīra. Rabat: Manshūrāt ar-Rābiṭa al-Muḥammadiyya li-l-ʿUlamāʾ, 2018.
_______. al-ʾAʿmāl al-kāmila li-Abī al-Muṭarrif Ibn ʿUmayra (d. 658 AH): 4- al-Muʾallafāt: a- At-Tanbīhāt ʿalā mā fī at-tibyān min at-tamwīhāt. Rabat: Manshūrāt ar-Rābiṭa al-Muḥammadiyya li-l-ʿUlamāʾ, 2018.
_______. Fahrasat al-Mantūri. Edited by Muḥammad Binshrīfa. Rabat: Manshūrāt ar-Rābiṭa al-Muḥammadiyya li-l-ʿUlamāʾ, 2011.
_______. Ibn Rushd al-ḥafīd: Sīra wathāʾiqiyya. Casablanca: Maṭbaʿat al-Najāḥ al-Jadīda, 1999.
Bou Aql, Ziad, éd. Averroès: le philosophe et la loi. Édition, traduction et commentaire de “L’Abrégé du Mustasfa”. Berlin: de Gruyter, 2015.
Būrshāshn, Ibrāhīm. Al-Fiqh wa-l-falsafa fī al-khiṭab al-falsafī li-Ibn Rushd. Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2010.
Ibn ʿAbd al-Malik, Abū ʿAbdillah Muḥammad al-ʾAnṣārī al-Murrākushī. Adh-Dhayl wa-t-takmila li-kitābay al-mawṣūl wa-ṣ-ṣila. Edited by ʾIḥsān ʿAbbās, Muḥammad Binsharīfa, and Bash-shār Maʾrūf ʾawwād, vol. 4. Tunis: Dār al-Gharb Al-Islāmi, 2012.
Ibn ad-Darrāj, Muḥammad b. ʾUmar as-Sabtī. Kitāb al-ʾImtāʿ wa-l-intifāʿ bi-masʾalat samāʿ as-samāʿ. In Ittijāhāt adabiyya wa-ḥaḍāriya fī ʻaṣr Banī Marīn. Edited by Muḥammad b. Shaqrūn. Casablanca: Maṭbaʿat al-ʾAndalus, 1982.
Ibn al-ʾAbbār, Muḥammad b. ʾAbdullāh al-Quḍāʾī. At-Takmila li-kitāb aṣ-ṣila. Edited by Bash-shār Maʾrūf ʾawwād, 4 vols. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2011.
Ibn al-ʾAzraq, Muḥammad b. ʾAlī al-Gharnāṭī. Rawḍat al-ʾiʿlām bi-manzilat al-ʿarabiyya min ʿulūm al-Islām. Edited by Saʿīda al-ʿAlamī. Vol. 2. Tripoli: Kulliyyat ad-Daʿwa al-Islāmiyya, 1999.
Ibn ʿArfa, Shams ad-Dīn Muḥammad ad-Dasūqī. Ḥashiyat ad-Dasūqī ʿalā ash-sharḥ al-kabīr. 2 vols. Dār ʾIḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya ʿīsā al-bābī al-ḥalabī wa-shurakāʾuh, [n.d.].
Ibn ʿāshūr, Muḥammad al-Fāḍil. al-Muḥāẓrāt al-maghribiyyat. Edited by ʿAbd al-Karīm Muḥammad. Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2012.
Ibn Farḥūn, Ibrāhīm b. ʿAlī. ad-Dībāj al-mudhahhab fī maʿrifat aʿyān ʿulamāʾ al-madhhab. Edited by Muḥammad al-Aḥmadī Abū an-Nūr. Vol. 2. Cairo: Dār al-Turāth li-ṭ-Ṭabʿ wa-n-Nashr, [n.d.].
Ibn Ḥusayn, Muḥammad ʿAlī al-Makkī al-Mālikī. Tahdhīb al-furūq wa-l-qawāʿid as-saniyya. Ḍabaṭahu wa-ṣaḥḥaḥahu Khalīl al-Manṣur, nushira ʿalā hāmish Idrār ash-shurūq ʿalā ʾanwāʾ al-furūq, wa ʿalā Kitāb al-furūq. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1998.
Ibn Ḥusayn, Muḥammad ʿAlī al-Makkī al-Mālikī. Tahdhīb al-furūq. Ṭubiʿa ʿalā hāmish Ḥawāshī Ibn al-Shāṭ wa-kitāb al-Furūq li-l-Qarāfī. 4 vols. Riyadh: Manshūrāt Wizārat ash-Shuʾūn al-Islāmiyya wa-l-ʾAwqāf wa-d-Daʿwa wa-l-ʾIrshād, 2010.
Ibn Juzayy, Abū l-Qāsim. Al-Qawānīn al-Fiqhiyya fī talkhīṣ madhhab al-mālikiyya wa-t-tanbīh ʿalā madhhab ash-shāfiʿiyya wa-l-ḥanafiyya wa-l-ḥanbaliyya. Edited by Muḥammad b. Sīdī Muḥammad Mūlāy. Kuwait City: Wizārat al-ʾAwqāf wa-sh-Shuʾūn al-Islāmiyya, 2010.
Ibn Khaldūn, ʿAbd ar-Raḥmān. Riḥlat Ibn Khaldūn. Edited by Muḥammad b. Tāwīt aṭ-Ṭanjī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2004.
Ibn Mhanna, Aḥmad b. Ghanīm an-Nafrāwī. Al-Fawākih ad-dawānī ʿalā risalat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī. Edited by ʿAbd al-Wārith Muḥammad ʿAlī. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1979.
Ibn Rushd, Abū l-Walīd Muḥammad b. Aḥmad. Aḍ-Ḍarūrī fī ʾusūl al-fiqh aw Mukhtaṣar al-mustaṣfā. Edited by Jamāl ad-Dīn al-ʿalawī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid li-Abī l-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rushd al-Qurṭubī al-Mālīkī, maʿa ar-rājiḥ min ʾārāʾ al-madhhab al-ʾibāḍī wa-fiqh al-madhāhib al-Islāmiyya. supervised by ʿAbdullah al-Sālimī, introduced and edited by Muḥammad Kamāl al-Dīn ʾImām, 6 vols. Muscat: Wizārat al-ʾAwqāf wa-sh-Shuʾūn al-Dīniyya, 2013.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. 5th ed. Vol. 2. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1981.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Edited by Muḥammad ʾalī Muḥammad Baḥr al-ʿulūm. supervised by Muḥammad Bāqir al-Ḥakīm. 2 vols. Tehran: al-Majmaʿ al-ʿĀlamī li-t-Taqrīb bayn al-Madhāhib al-Islāmiyya, 1380/1961.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Edited by ʿAbd al-ʾAmīr Al-Wardī, Jāsim at-Tamīmī, ʿAqīl ar-Rabīʿī [and others]. 7 vols. Tehran: al-Majmaʿ al-ʿĀlamī li-t-Taqrīb bayn al-Madhāhib al-Islāmiyya, 2010.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Edited by ʿAbd al-Ḥalīm Muḥammad ʿAbd al-Ḥalīm and ʿAbd ar-Raḥmān Ḥasan Maḥmūd. 2 vols. Cairo: Dār al-Kutub al-Ḥadītha, 1975.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Edited by ʿAlī Muḥmmad Muʿawwaḍ and ʿādil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd. 6 vols. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1996.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. 2 vols. 6th ed. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1983.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Edited by Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallaq. 4 vols. Cairo-Jeddah: Maktabat Ibn Taymiyya-Maktabat al-ʿAlam, 1415/1994.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. 2 vols. Rabat: al-Maktab ath-Thaqāfī as-Saʿūdī, 1999.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Cairo: Dār al-Kutub al-ʿArabiyya al-Kubrā, 1327/1910.
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Beirut: Dār al-Fikr, [197?].
_______. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.
_______. Talkhīṣ as-safsaṭa. Edited by Muḥammad Salīm Sālim. Cairo: Maṭbaʿat Dār al-Kutub, 1972.
_______. The Distinguished Jurist’s Primer: A Translation of “Bidāyat al-mujtahid”. Translated by Imran Ahsan Khan Nyazee, reviewed by Muhammad Abdul Rauf. Reading: Garnet Publishing, 1994.
Ibn Saʿīd, ʿAlī b. Mūsā al-Maghribī. Al-Maghrib fī ḥulā al-Maghrib. Edited by Shawqī Dayf. 2 vols. 4th ed. Cairo: Dār al-Maʿārif, 1993.
Ibn Ṭumlūs, Abū l-Ḥajjaj. Kitāb al-qiyyās. In al-Mukhtaṣar fī al-manṭiq, edited by Fouad Ben Ahmad. Leiden-Boston: Brill, 2020.
ʿLīsh, Muḥammad b. Aḥmad. Sharḥ minaḥ al-jalīl ʿalā mukhtaṣar al-ʿallāma Khalīl. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
Makhlūf, Muḥammad b. Muḥammad b. ʿUmar. Shajarat an-nūr az-zakiyya fī ṭabaqāt al-mālikiyya. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2003.
Miftāḥ, Muḥammad. “Ibn Rushd wa-madrasatuhu fī-l-Gharb al-Islāmī: Mā tabaqqā min ar-Rushdiyya fī al-qarn ath-thāmin al-Hijrī ar-rābiʿ ʿashar al-Mīlādī.” In Ibn Rushd wa-madrasatuhu fī-l-Gharb al-Islāmī, 2nd ed., 87–101. Rabat: Manshūrāt Kulliyyat al-ʾAdāb wa-l-ʿUlūm al-ʾInsāniyya, 2013.
Riḍā, Muḥammad Rashīd. Tafsīr al-Qurʾān al-Ḥakīm, Known as Tafsīr al-Manār, 2nd ed. Vol. 3. Cairo: Dār al-Manār, 1947.
Sayili, Aydin M. “Al Qarāfī and His Explanation of the Rainbow.” Isis, Vol. 32, No. 1 (Jul. 1940): 16–26.
Wofhart, P. Heinrichs. “Ḳawāʿid Fiḳhiyya.” In Encyclopaedia of Islam. Second Edition, edited by P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 28 September 2019. http://dx.doi.org.lama.univ-amu.fr/10.1163/15733912_islam_SIM_8763
_______. “Qawāʿid as a Genre of Legal Literature.” In Studies in Islamic Legal Theory. Edited by Bernard G. Weiss, 365–384. Leiden-Boston-Köln: Brill, 2002.
Zarrūq, Aḥmad b. Muḥammad al-Burnusī al-Fāsī. Sharḥ ʿalā matn ar-risāla. Edited by Aḥmad Farīd al-Mazīdī. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2006.
للتوثيق
بن أحمد، فؤاد. ”في المنجز الفقهي لابن رشد: القيمة والتلقي إلى حدود القرن العشرين.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2639>
فؤاد بن أحمد
كنتُ قد قدّمتُ الصيغة الأولى من هذه الدراسة في محاضرة بمؤسّسة دار الحديث الحسنيّة بالرباط، بتاريخ 12 دجنبر 2018؛ وأشكر للأستاذ والصديق عبد العلي العمراني-جمال ملاحظاته؛ كما أشكر، بالمناسبة، الباحث الجادّ الدكتور إبراهيم بوحولين (جامعة محمّد الأوّل-وجدة) تفضّله بمراجعة هذا العمل.
[1] انظر بخصوص سيرة ابن زرقون ومحنته زمن السلطان المنصور الموحديّ: ابن الأبّار القضاعيّ، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق بشّار معروف عوّاد، أربع مجلدات (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2011)، ج. 2، 324، سيرة رقم 1637؛ وعليّ بن محمد الرعينيّ، برنامج شيوخ الرعينيّ، حقّقه إبراهيم شبوح (دمشق: مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، 1962)، 31–37.
[2] وانظر القصّة بِرَسْمِها في: أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاريّ المراكشيّ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، حقّقه وعلّق عليه إحسان عبّاس ومحمّد بن شريفة وبشّار عوّاد معروف (تونس: دار الغرب الإسلاميّ، 2012)، المجلّد الرابع (السفر السادس)، سيرة 51، 23.
[3] وقد تولّى أساتذتنا الرد عليها. انظر: محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998)، 93–94؛ محمد ابن شريفة، ابن رشد الحفيد: سيرة وثائقية (البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1999)، 24، 62، 70، 102، 103–104. وانظر أدناه ردود جمال الدين العلوي.
[4] ابن الأبّار، التكملة لكتاب الصلة، ج. 2، 248.
[5] يقول ابن الأبّار عن ابن رشد: ”روى عن أبيه أبي القاسم. استظهر عليه الموطأ حفظًا، وأخذ يسيرًا عن أبي القاسم بن بشكوال، وأبي مروان بن مسرّة، وأبي بكر بن سمحون، وأبي جعفر بن عبد العزيز، وأجاز له هو وأبو عبد الله المازري.“ التكملة لكتاب الصلة، ج. 2، 247، سيرة رقم 1523. ويَرد عند ابن عبد الملك الأنصاريّ المراكشيّ: ”حدث عن أبوي القاسم: أبيه وابن بشكوال، وأبي جعفر بن عبد العزيز، وأبي الفضل عيّاض، وأبي مروان بن مسرّة. […] ولقي جماعة وافرة من أهل العلم أخذ عنهم؛ وأجاز له أبو عبد الله المازري.“ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، المجلد الرابع (السفر السادس)، 23.
[6] يقول ابن الأبار القضاعي عن ابن رشد، ”درّس الفقه والأصول وعلم الكلام.“ التكملة لكتاب الصلة، ج. 2، 248.
[7] انظر ابن شريفة، ابن رشد الحفيد، 237–243. ويقول ابن الأبّار: ”وقد حدث وسمع منه أبو محمد بن حوط الله، وأبو الحسن بن سهل بن مالك، وأبو الربيع بن سالم، وأبو بكر بن جهور، وأبو القاسم بن الطيلسان، وغيرهم.“ التكملة لكتاب الصلة، ج. 2، 249؛ ويرد عند ابن عبد الملك الأنصاري المراكشي: ”روى عنه أبو بكر بن جهور، وأبو الحسن بن سهل بن مالك، وأبو الربيع بن سالم، وأبو عامر بن نذير، وآباء القاسم: عبد الرحيم بن إبراهيم ابن الفرس وابن عيسى ابن الملجوم والقاسم بن الطيلسان ومحمد بن عبد الرحمن ابن الحاج، وأبو محمد عبد الكبير.“ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، المجلد الرابع (السفر السادس)، 23.
[8] يقول ابن الأبّار عن ابن رشد: ”وكان يُفزع إلى فتواه في الطب، كما يُفزع إلى فتواه في الفقه.“ التكملة لكتاب الصلة، ج. 2، 248، سيرة رقم 1523. وانظر بن شريفة، ابن رشد الحفيد، 103–104.
[9] يقول ابن عبد الملك المراكشي: ”واستقضي بإشبيلية ثم بقرطبة، فنظر حينئذ في الفقه وصنّف فيه كتابه المسمّى بداية المجتهد وكفاية المقاصد.“ الذيل والتكملة، المجلد الرابع (السفر السادس)، 23؛ وانظر ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، ج. 2، 248.
[10] انظر: ابن رشد، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تحقيق جمال الدين العلوي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994).
[11] Ziad Bou Aql, éd., Averroès: le philosophe et la loi. Édition, traduction et commentaire de “L’Abrégé du Mustasfa” (Berlin: de Gruyter, 2015).
[12] أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى، 1327/1910)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مجلدان، ط. 6 (بيروت: دار المعرفة، 1983)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دار الفكر، [?197])؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، راجعه وصححه عبد الحليم محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود، مجلدان (القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1975)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق محمد علي محمد بحر العلوم، إشراف محمد باقر الحكيم، مجلدان (طهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1380/1961)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مجلدان (الرباط: المكتب الثقافي السعودي، 1999)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه ماجد الحموي، 4 أجزاء (بيروت: دار ابن حزم، 1995)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق ومقارنة بآراء الإمامية عبد الأمير الوردي، جاسم التميمي، عقيل الربيعي [وآخرون]، 7 مجلدات (طهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 2010)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، 4 مجلدات (القاهرة-جدة: مكتبة ابن تيمية-مكتبة العلم، 1415/1994)؛ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، 6 مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية، 1996)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية، إشراف عبد الله السالمي، تقديم وتحرير محمد كمال الدين إمام، 6 مجلدات (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2013).
[13] Ibn Rushd, The Distinguished Jurist’s Primer: a translation of “Bidayat al-mujtahid”, trans. Imran Ahsan Khan Nyazee, rev. Muhammad Abdul Rauf (Reading: Garnet Publishing, 1994).
[14] وقد فات بدر الدين الزركشي الإشارة إلى نصوص مبكرة أخرى من تأليف المالكية. انظر تفاصيل أخرى في: محمد بن شريفة، الأعمال الكاملة لأبي المطرف ابن عميرة (ت. 658هـ): 1-السيرة، طبعة مزيدة ومنقحة (الرباط: منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، 2018)، 109–110.
[15] بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، قام بتحريره عمر سليمان الأشقر وراجعه محمد سليمان الأشقر (الكويت: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1988)، ج. 1، 8.
[16] ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريفة وبشار عواد، المجلد الثالث (السفر الخامس)، 497.
[17] وممن نقل عن العبدري شمس الدين البرماوي المصري الشافعي (ت. 831هـ/1428م) في كتابه الفوائد السّنيّة في شرح الألفيّة، ونص نقله: ”ولهذا قال العبدري في المستوفى وابن الحاج في تعليقة المستصفى، وجرى عليه صاحب البديع من الحنفية: ’ذهب طائفة من الحنفية إلى انتفاء الحكم فيما بعدها مع ذهابهم إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية، تصميما على إنكار المفاهيم.‘“ تحقيق عبد الله رمضان موسى (الرياض: منشورات مكتبة دار النصيحة، 2015)، ج. 3، 59.
[18] الزركشي، البحر المحيط، ج. 1، 93–94، 95. ويقول مثلا: ”وفي اقتناص الحد ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في المستوفى في شرح المستصفى.“ 93. قارن ابن رشد، مختصر البرهان، تحقيق تشارلز بترورث، قيد النشر، 190.
[19] الزركشي، البحر المحيط، ج. 4، 5. وقارن: مختصر المستصفى، 118–119.
[20] الزركشي، البحر المحيط، ج. 4، 364؛ وقارن: مختصر المستصفى، 80. وقد حصل تصحيح نص النسخة الخطية في ضوء ما احتفظ به الزركشي.
[21] الزركشي، البحر المحيط، ج. 3، 280.
[22] ابن رشد، مختصر المستصفى، 113–115.
[23] الزركشي، البحر المحيط، ج. 3، 280.
[24] الزركشي، البحر المحيط، ج. 4، 239؛ ابن رشد، مختصر المستصفى، 69.
[25] الزركشي، البحر المحيط، ج. 4، 12.
[26] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة السادسة (بيروت: دار المعرفة، 1982)، ج. 1، 4.
[27] البرماوي، الفوائد السّنيّة، ج. 2، 10.
[28] أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق الغرناطي، روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام، تقديم وتحقيق سعيدة العلمي (طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية، 1999)، ج. 2، 519.
[29] ”بسببه“ في الونشريسي، والصواب ما أثبتناه.
[30] أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي (الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، 1981)ج. 5، 394.
[31] محمد العبدري البلنسي، الرحلة المغربية، تقديم سعد بوفلاقة (بونة: منشورات بونة للبحوث والدراسات، 2007)، 38–39.
[32] انظر: بن شريفة، ابن رشد الحفيد، 246–252؛ المؤلف نفسه، الأعمال الكاملة لأبي المطرف ابن عميرة (ت. 658هـ): 4-المؤلفات: أ-التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات (الرباط: منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، 2018)، 30–37.
[33] أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان (تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 1978)، 167.
[34] قد يطول بنا الكلام بالدخول في تفاصيل هذه المسألة، لذلك نكتفي بإيراد مختصر جدا لبعض الشكوك والمزاعم. وقد أوردنا في البداية التهمة التي نقلها ابن عبد الملك عن أبي العباس بن علي بن هارون عن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين بن زرقون. واعتمادا على هذا الخبر، وعلى عدم وقوفه على أي أثر لشخصية الفيلسوف في بداية المجتهد، أثار عبد الرحمن بدوي، العام 1976، شكوكاً من قبيل:
“Je crois qu’il y a un problème sérieux concernant l’authenticité de Bidāyat al-Mujtahid d’Ibn Rushd. En effet, en lisant ce livre je fus toujours frappé du fait qu’on n’y trouve absolument aucune influence d’Ibn Rushd le philosophe sur Ibn Rushd juriste. Faut-il conclure à l’existence d’une cloison étanche dans l’âme d’Ibn Rushd entre les deux : le philosophe et le juriste ? ou bien ne vaut-il pas mieux scruter de près le problème de l’attribution de ce livre-là à notre philosophe?” ‘Abdrrahman Badawi, “Remarques et questions,”in Multiple Averroès, éd. Jean Jolivet (Paris : Les Belles Lettres, 1978), 42.
ويستعيد علي أمليل هذه الأسئلة ويذهب بها أبعد، دونما حجج وثيقة، إلى الجزم في الفصل بشأن ابن رشد بين شخص الفقيه وشخص الفيلسوف، انظر: السلطة الثقافية والسلطة السياسية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986)، 203، 199، 204. أما طه عبد الرحمن فيذهب حدّ إسقاط كل إبداع عن جهود ابن رشد الفقهية كما الفلسفية، إذ يقول: ”لا أثر عنده لفقه متميز يستمد قيمه أو، على الأقل، توجهه من ممارسته الفلسفية؛ أو قل، باختصار، إن ابن رشد لم يبدع في الفلسفة عن طريق الفقه، ولا أبدع في الفقه عن طريق الفلسفة.“ حوارات من أجل المستقبل (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2011)، 119–120. والصلة التي بين منطق ابن رشد وفقهه هي من القوة بحيث لا يمكن إدراك قيمة سعيه لصوغ قواعد للخلاف الفقهي باستقلال عن بعض المفاهيم المنطقية التي تنظم وتقنن بعض الصنائع، وبخاصة مفهوم الموضع في منطق الجدل. وسنشير إلى هذا أدناه.
[35] جمال الدين العلوي، المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة (البيضاء: دار توبقال، 1986)، 188.
[36] العلوي، المتن الرشدي، 183.
[37] تعرض الدّارس إبراهيم بورشاشن لمكانة الفقه في فلسفة ابن رشد في حيّز كبير من عمله، الفقه والفلسفة في الخطاب الفلسفي لابن رشد (بيروت: دار المدار الإسلامي، 2010).
[38] قام الدارس محمد الأمين العمراني بجرد اختيارات ابن رشد بين المذاهب في عمله: اختيارات ابن رشد الحفيد الفقهية في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جزآن (بيروت: دار ابن حزم، 2011).
[39] يقول ابن عبد الملك المراكشي: ”واستقضي بإشبيلية، ثم بقرطبة، فنظر حينئذ في الفقه وصنف فيه كتابه المسمى بداية المجتهد وكفاية المقاصد.“ الذيل والتكملة، المجلد الرابع (السفر السادس)، 23.
[40] يذهب جمال الدين العلوي إلى أنّ الكتاب عرف زيادة باب الحج، ولم يعرف أي مراجعة أو تهذيب في الصياغة الأولى. انظر: العلوي، المتن الرشدي، 155.
[41] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 1، 2.
[42] انظر: محمد الفاضل ابن عاشور، المحاضرات المغربيات، جمع وإعداد عبد الكريم محمد (تونس، الدار التونسية للنشر، [د.ت.])، 83–84.
[43] ويذهب محمد بن شريفة إلى تقريب الغرض الذي من أجله ألّف ابن رشد كتاب البداية من سياسة المنصور الموحّديّ تجاه كتب الفروع، حيث يقول: ”نرى أنّ كتاب بداية المجتهد قد يكون أُلف في ظل هذا التوجه الرسمي ليكون بديلا لكتب الفروع التي منع استعمالها وتداولها، وأحرق عدد منها في الحواضر الأندلسية والمغربية. ولا يذكر ابن رشد أنه ألف البداية بتوجيه أو تكليف، ولكن صنيع الكتاب يوحي بذلك.“ ابن رشد الحفيد، 72. ألف ابن رشد بداية المجتهد عام 562هـ/1166م ”تذكرة لنفسه،“ عندما كان يشتغل قاضيا بإشبيلية. وأضاف إليه كتاب الحج عام 584هـ/1187م. أما الخليفة أبو يوسف يعقوب الموحّديّ فقد تولى الحكم عام 580هـ/1184م. ويصعب علينا إدراج عمل ابن رشد ضمن سياسة أبي يوسف يعقوب بالتحديد، لكننا نتصور أن يكون التّوجّه العام الذي كان ابن رشد أحد أقوى المُعبّرين عنه، هو ضرورة تنظيم الفروع وتقعيدها. ومن هذه الناحية، فإنّ أبا يوسف كان يعبر سياسيا وسلطويا على ما تقدم إليه ابن رشد، وعبر عنه كتابةً وعلميًا في بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
[44] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 195. مثال الخفاف الذي استعمله ابن رشد هنا يجد أصله في آخر كتاب المباكتات السفسطائية لأرسطو، وقد استرجعه في تلخيصه بشكل يفيد تمامًا تصوره للصناعة الفقهية من جهة أصولها، ومن جهة فروعها. يقول: ”ولذلك كان القول في المبدأ، وإن كان يسيرًا في القدر، فهو عظيم في القوّة. وهذا بعينه عرض لنا في هذه الصناعة بالإضافة إلى سائر الصنائع المنطقية الأربع، فإنه لم نُلْفِ في هذه الصناعة شيئا يتنزل منها منزلة المبدأ، ولا منزلة الجزء […] فلم نجد فيها شيئا يجري مجرى المبدأ، ولا مجرى الجزء، وإنما وجدنا فيها أشياء كثيرة تجري مجرى الأشخاص الموجودة من الصناعة عند أهل تلك الصناعة. فكما أنه من لم يكن عنده علم الصناعة إلى وجود عدد ما من أشخاصها التي تفعلها تلك الصناعة فليس عنده علم بالصناعة. مثال ذلك أنّ من لم يكن عنده من صناعة الخفاف إلا أشخاص من الخفاف محدودة، فليس عنده من صناعة الخفاف شيء كذلك من تعاطى ممن سلف تعليم هذه الصناعة من غير أن يكون عنده منها إلا أقوال محدودة العدد، أعني أقوالا سفسطائية، فهو بمنزلة من رام تعليم الخفاف بأن يعطي الناس خفافا من عنده، أو يقول لهم إنّ القدم ينبغي أن تصان بالخفاف، من غير أن يعرفهم من أيّ شيء تصنع الخفاف، ولا كيف تصنع.“ تلخيص السفسطة، تحقيق محمد سليم سالم (القاهرة: مطبعة دار الكتب، 1972)، 172–175.
[45] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 387–388.
[46] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 1، 187.
[47] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 1، 49.
[48] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 202.
[49] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 155.
[50] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 148.
[51] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 184–185.
[52] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 138. ويقول ابن رشد: ”فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابَ إِنَّمَا وَضَعْنَاهُ لِيَبْلُغَ بِهِ الْمُجْتَهِدُ فِي هَذِهِ الصِّنَاعَةِ رُتْبَةَ الْاِجْتِهَادِ إِذَا حَصَّلَ مَا يَجِبُ لَهُ أَنْ يُحَصِّلَ قَبْلَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْكَافِي لَهُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، وَاللُّغَةِ، وَصِنَاعَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ مُسَاوٍ لِجِرْمِ هَذَا الْكِتَابِ أَوْ أَقَلَّ.“ ج. 2، 195؛ ويضيف: ”بَيْدَ أَنَّ فِي قُوَّةِ هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ الْإِنْسَانُ كَمَا قُلْنَا رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ إِذَا تَقَدَّمَ، فَعَلِمَ مِنَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَعَلِمَ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ مَا يَكْفِيهِ فِي ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ رَأَيْنَا أَنَّ أَخَصَّ الْأَسْمَاءِ بِهَذَا الْكِتَابِ أَنْ نُسَمِّيَهُ كِتَابَ: بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ وَكِفَايَةِ الْمُقْتَصِدِ.“ ج. 2، 388.
[53] لمزيد من التفاصيل عن مفهوم الموضع عند ابن رشد، انظر: فؤاد بن أحمد، ”طريقة الجدل الفلسفي عند ابن رشد: القيم والمنافع والحدود،“ Mélanges de L’université Saint-Joseph, vol LXIII (2010-2011): 259–322, 267–275.
[54] ويقترب موقف عبد اللطيف البغدادي (ت. 629هـ/1231م) من ابن رشد بخصوص هذه المسألة؛ ولكنه يحمل الفيلسوف ابن سينا مسؤولية الخلط الذي سقط فيه الفقهاء بين صناعتهم وصناعة المنطق. وفي هذا يقول: ”ومن الآفات الطارئة على العالم من هذا الرجل أنه كثر التصانيف، وولد بعضها من بعض وبثها في العالم. فتجرأ على قراءة المنطق والحكمة كثير ممن ليس من أهلها، فإن أهل الحكمة هم الذين نشأوا على الشريعة واعتادوا أفعالها وألفوا السيرة الفاضلة؛ ثم كان لهم مع ذلك طباع فاضلة وفطر فائقة؛ ثم تطاول إليها أهل الجدل والخلاف من الفقهاء، وشدوا من مبادئها الشيء النزر، ولم يعرفوا كيف يستعملونه ولا كيف يستعينون بصناعة المنطق في جدلهم ونظرهم، ولا أي جزء من صناعة المنطق هو خاص بالفقه، ولا رأيت ابن سينا بين ذلك لهم. فصاروا يظنون أن صناعة المنطق بأسرها لهم ونافعتهم. وصاروا يصرحون في مجالس المناظرة بالأقيسة الشرطية والحملية والمقدمات والنتائج، وهذا من أعظم الفساد وأقوى الخبال. والفقهاء الذين كانوا قبلهم كانوا أطول منهم باعا وأبسط ذراعا وأثبت حجة وأقوى جدلا، ومع هذا فلم يحتاجوا إلى هذه الشرذمة من المنطق التي يتبجح بها هؤلاء. ومذ ظهرت لم يظهر فيهم إمام فاضل ولا تصنيف بالغ كالذي كان قبلهم. فإن من شأن الحكماء الفضلاء أن يستعملوا في مثل صناعة الفقه والطب والنحو قوة المنطق لا المنطق نفسه، كما يستعمل في الكلام قوة النحو لا النحو نفسه، ولو قال الخطيب: ’أيها الناس أطيعوا الله ورسوله، وهذا اسم منادى مبني على الضم،‘ لضحك منه وهزئ به وسقط عن درجة الخطباء. ولا أعرف من الفقهاء من استعمل قوة الحكمة إلا الماوردي قاضي البصرة، صاحب الأحكام السلطانية وصاحب تعجيل النصر وتسهيل الظفر، ولا أعرف من النحاة بعد الخليل ابن أحمد إلا أبا بكر بن السراج صاحب الأصول وصاحب الاشتقاق ولم يتمه، ولكن في أوله كفاية ودلالة على اطلاعه على صناعة المنطق. وكذلك له كتاب في قوانين العربية، ولا أعرف من الزهاد المتصوفة من استعان بالحكمة في النفس، ولم يظهر على كلامه إلا الفارقي وكلامه مشهور. وأما هؤلاء المتشبعة فيتشدقون بذكره في المجالس فقط من غير ملكة فيه ولا معرفة بما يحتاجون إليه منه ولا كيف استعماله. وقد نهى الحكماء عن بث المنطق وتعليم الحكمة كل من اتفق؛ فإنه ليس كل أحد يصلح لكل علم ولا كل أحد يصلح للعلوم.“ كتاب النصيحتين، تحقيق فؤاد بن أحمد، ضمن عبد اللطيف البغدادي، الأعمال الفلسفية الكاملة، تحقيق نظيرة فدواش ويونس أجعون وفؤاد بن أحمد (الرباط-الجزائر-بيروت: دار الأمان-منشورات الاختلاف-ضفاف للنشر، 2018)، ج. 1، 77–78.
[55] ابن رشد، مختصر المستصفى، 34–35.
[56] ورغم توجهنا بالسؤال لمجموعة من الزملاء والطلبة، فإننا لم نتلق أي جواب يفيد توثيق المسألة.
[57] أحمد البوشيخي، أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف، حققه وعلق عليه أحمد البوشيخي (تونس: دار الغرب الإسلامي، 2009)، ج. 1، 212.
[58] أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار صادر، 1988)، ج. 3، 180.
[59] ويقول بن شريفة: ”فقد ظل الكتاب يُروى ويُقرأ في الأندلس والمغرب.“ ابن رشد الحفيد، 70.
[60] ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، ط. 4 (القاهرة: دار المعارف، 1993)، ج. 1، سيرة رقم: 39، 104–105.
[61] ابن الأبّار، التكملة، ج. 2، 248.
[62] بن شريفة، ابن رشد الحفيد، 103–104، 76؛ وانظر فهرسة المنتوري، دراسة وتحقيق محمد بنشريفة (الرباط: منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، 2011)، 179، 325.
[63] الإشارة إلى ما نشرناه من دراسات عن ابن طملوس. انظر أدناه.
[64] ابن طملوس، كتاب القياس، ضمن المختصر في المنطق، حققه وقدم له وعلق عليه وفهرسه فؤاد بن أحمد (ليدن-بوسطن: بريل، 2020)، 218.
[65] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط. 6 (بيروت: دار المعرفة، 1982)، ج. 2، 132.
[66] انظر: ابن طُمْلُوس الفيلسوف والطبيب (ت. 620هـ/1223م): سيرة بيبليوغرافية (الرباط-بيروت-الجزائر-تونس: دار الأمان-ضفاف-اختلاف-كلمة، 2017)، 48–49.
[67] ابن طُملوس، كتاب القياس، 219.
[68] انظر، ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 1، 382–386.
[69] تُسمى مدونة مالك نسبةً إلى أنّ الأجوبة المتضمّنة فيها هي أجوبة مالك، وتُسمى مدونة ابن القاسم نسبةً إلى أنّ السائل هو تلميذه ابن القاسم المصري (ت. 191هـ/806م)، وتسمى مدونة سحنون نسبةً إلى من بوّبها وفق الأبواب الفقهيّة المعروفة سحنون القيروانيّ (ت. 240هـ/854م).
[70] أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التّأويل في شرح المدونة وحلّ مشكلاتها، اعتنى به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، عشرة أجزاء (الدار البيضاء-بيروت: مركز التراث الثقافي المغربي-دار ابن حزم، 1428هـ/2007م)، ج. 1، 46.
[71] الرجراجي، مناهج التحصيل، ج. 1، 413.
[72] ابن الدراج السبتي، كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع، ضمن اتجاهات أدبية وحضارية في عصر بني مرين، دراسة وإعداد محمد ابن شقرون (الدار البيضاء: مطبعة الأندلس، 1982)، 148.
[73] محمد مفتاح، ”ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي: ما تبقى من الرشدية في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي،“ ضمن ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، ط. 2 (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2013)، 87–101، 94. وقد وقع خلط عند محمد مفتاح بين الجد والحفيد عندما اعتقد أنّ ابن السكاك يتحدث عن ابن رشد الحفيد في القول الذي ينقله المقري في نفح الطيب، ج. 5، 446 [وإحالة مفتاح خاطئة] فلعلّ المقصود بابن رشد هنا هو الجد الذي قرب الفقه المالكي في المقدمات الممهدات، وليس ابن رشد الحفيد.
[74] ابن شقرون، اتجاهات أدبية وحضارية في عصر بني مرين، (أض).
[75] أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي الزموري، حلل المقالة في شرح الرسالة، مخطوط من خزانة خاصة، ورقة 23و، 80و. انظر دليل جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، الدورة 38 (الرباط: منشورات وزارة الثقافة، 2017)، 191. ونشكر الدّارس يونس بقيان إذ أمدنا بكل ما أوردناه هنا بخصوص تلقي الزناتي لبداية المجتهد ونهاية المقتصد واستثماره له.
[76] انظر مواضع متفرقة من الزناتي، حلل المقالة، مثلا: 7و، 8و، 45و، 47و، 49ب، 72و. هذا ووقف يونس بقيان على مناقل الزناتي من بداية ابن رشد وتتبعها وخرجها في سياق تحقيقه العمل الذي نرجو أن يصدر قريبا.
[77] الزرويلي الصغيّر، التقييد على تهذيب المدونة، مخطوطة مكتبة آل النيفر بتونس، رقم 463، ج. 3، ورقة 68و. وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط. 5 (بيروت: دار المعرفة، 1981)، ج. 2، 2. نقلا عن علي العلوي، اجتهاد الزرويلي: كتاب التقييد أنموذجا (تونس: الدار التونسية للكتاب، 2014)، 78.
[78] محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار صادر، د. ت.)، ج. 3، سيرة رقم 506، 79.
[79] أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، تحقيق سعد بن عبد الله آل حميد (الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 2008)، ج. 2، 215–216. ويجدر بنا أن نشير إلى أنّ مفتاح قد تقدم إلى الإشارة إلى هذا الموضع.
[80] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج. 4، 12.
[81] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط. 6 (بيروت: دار المعرفة، 1982)، ج. 1، 4.
[82] ابن فرحون، الديباج المُذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: دار التراث للطبع والنشر، د.ت.)، ج. 2، 258.
[83] زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وولي الدين أبو زرعة العراقي، كتاب طرح التثريب في شرح التقريب (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت.])، ج. 2، 124–125؛ وقارن بداية المجتهد، ج. 1، 22؛ وانظر أيضا طرح التثريب، ج. 2، 11؛ وبداية المجتهد، ج. 1، 6. وقد ورد هذا القول فعلا عند أبي العباس ضياء الدين القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق محي الدين ديب مستو، وأحمد محمد السيد، ويوسف علي بديوي، ومحمود إبراهيم بزال، سبعة أجزاء (دمشق-بيروت: دار الكلم الطيب، 1996)، ج. 1، 539–540.
[84] أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق، شرح على متن الرسالة، اعتنى به وكتب هوامشه أحمد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006)، ج. 1، 450.
[85] شمس الدين الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط. 3 (بيروت: دار الفكر، 1992)، ج. 3، 317.
[86] ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية (القاهرة: ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي، [د.ت.])، ج. 3، 10.
[87] محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، [د. ت.])، ج. 1، سيرة رقم 153، 230. وانظر أيضا: نيل الأوطار، ج. 2، 324؛ ج. 5، 143، 179، 257، 410؛ ج. 8، 257.
[88] أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه وخرج آياته عبد الوارث محمد علي (بيروت: دار الكتب العلمية، 1979)، ج. 1، 319.
[89] أبو الحسن علي بن أحمد العدوي (ت. 1189هـ/1775م)، حاشية على شرح مختصر خليل، ط. 2 (مصر المحمية: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 1317هـ)، حيث يقول: ”قال في التوضيح: ’وأما من صلاها ولم يحصل له فضل الجماعة، فروى أشهب لا يدخل معه.‘ قاله في التوضيح. وكذا إذا شك فلا يدخل حتى يتحقق أنّ معه شيئا، فإن اقتحم ودخل شفع بعد سلام الإمام، وإن لم يعقد ركعة وقطع بعدهما سواء أحرم بفرض أو نفل، ومحل شفعه إن كان وقت نفل وإلا قطع. واعلم أنّه لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا فاته لعذر، وأما لو فاته ولو ركعة اختيارا، فإنه لا يحصل له فضل الجماعة على المعتمد؛ ولذلك قال اللقاني: ’وقيد الحفيد‘، أي: بأن يفوته اضطرارا خلاف ظاهر الروايات، لكن له حظ من النظر، وظاهر المؤلف كظاهر الروايات. ثم إنّ التقييد المذكور يجري فيمن أدرك ركعتين أو ثلاثا من الرباعية، وكذا فيمن أدرك ركعتين من الثلاثية.“ حاشية على شرح مختصر خليل، ج. 2، 18.
[90] شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [لأحمد الدردير] (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، [د. ت.])، ج. 1، 320؛ ج. 2، 107.
[91] أبو العباس أحمد الصاوي، حاشية الصّاوي على الشّرح الصغير، بهامش الشّرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير، خرج أحاديثه وفهرسه مصطفى كمال وصفي (القاهرة: دار المعارف، 1986)، ج. 1، 426، حيث يرد: ”قوله: ’وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة“ قيده حفيد ابن رشد بالمعذور، بأن فاته ما قبلها اضطرارا. […] واللقاني، كما في حاشية شيخنا على خش، قال: ”إن كلام الحفيد كظاهر الروايات.‘“
[92] محمد بن أحمد بن محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (بيروت: دار الفكر، 1984)، ج. 3، 268. حيث يرد: ”وفي النهاية لحفيد ابن رشد: ’وأما تراخي القبول عن الايجاب في العقد فأجازه مالك رحمه الله إن كان يسيرا، ومنعه مطلقا الشافعي وأبو ثور رحمهما الله، وأجازه مطلقا أبو حنيفة رحمه الله. والتفرقة بين الأمد الطويل واليسير لمالك رحمه الله.‘“
[93] محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق عبد القادر أحمد عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، 1988)، ج. 2، 145، 534؛ ج. 4، 178.
[94] محمد بن علي بن محمد الشوكاني، كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه ورتبه وصنع فهارسه أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق (صنعاء: مكتبة الجيل الجديد، [د. ت.])، ج. 6، 2962.
[95] محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، المشتهر بتفسير المنار، ط. 2 (القاهرة: دار المنار، 1947)، ج. 10، 591–592.
[96] محمد أنور شاه الكشميري، العرف الشذي شرح سنن الترمذي، تصحيح محمود شاكر (بيروت: دار إحياء التراث، 2004)، ج. 1، 363.
[97] محمد بن محمد بن عمر مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (بيروت: دار الكتب العلمية، 2003)، ج. 2، 9.
[98] محمد حبيب الله الشنقيطي، زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية-عيس البابي الحلبي وشركاؤه، [د. ت.])، ج. 2، 80.
[99] Wofhart P. Heinrichs, “Ḳawāʿid Fiḳhiyya,” in Encyclopaedia of Islam, Second Edition, ed. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 28 September 2019<http://dx.doi.org.lama.univ-amu.fr/10.1163/1573-3912_islam_SIM_8763>; id., “Qawāʿid as a Genre of Legal Literature,” in Studies in Islamic Legal Theory, ed. Bernard G. Weiss (Leiden-Boston-Köln: Brill, 2002): 365–384, 376.
[100] Heinrichs, “Ḳawāʿid Fiḳhiyya”.
[101] والإشارة إلى أعمال فولفهارت هينريش مثلا.
[102] محمد علي بن حسين المكي المالكي، تهذيب الفروق، طبع على هامش حواشي ابن الشاط وكتاب الفروق للقرافي (الرياض: منشورات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 2010)، ج. 1، 18، 170، 211، 212؛ ج. 2، 203، 204، 206؛ ج. 3، 3، 16، 48، 50، 67، 117، 127، 128، 145، 147، 158، 166، 169، 172، 179، 183، 208، 210، 224، 228، 230، 240، 255؛ ج. 4، 28، 50، 54، 55، 58، 62.
[103] الزركشي، البحر المحيط، ج. 4، 528.
[104] ابن فرحون، الديباج المُذهَّب، ج. 2، 189.
[105] مخطوط الأسكوريال، 707، 74–113؛ مخطوط حكمة تيمور بدار الكتب المصرية بالقاهرة، رقم 83. ونتصور وجود تأثير لابن رشد في هذا العمل.
[106] شهاب الدين القرافي، اليواقيت في أحكام المواقيت، اعتنى به علي الجهاني، قدم له الحبيب بن طاهر (عمان: دار النور المبين، 2014).
[107] من الدراسات المبكرة التي أنجزت عن كتاب الاستبصار مقالةُ أيدين صايلي. انظر:
Aydin M. Sayili, “Al Qarāfī and His Explanation of the Rainbow,” Isis, vol. 32, No. 1 (1940): 16–26.
[108] كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، دراسة وتحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، أربع مجلدات (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2001).
[109]القرافي، كتاب الفروق، ج. 1، 70–71.
[110] Cf. Heinrichs, “Qawāʿid as a Genre of Legal Literature,” 368.
[111] من الأمور الغريبة أن يحصل اهتمام كبير بكتابي القرافي وابن رشد الحفيد في دروس العلوم الشرعية، ولا يحصل الانتباه إلى ما يجمع بينهما.
[112] يقول أحمد بن إدريس القرافي: ”تنبيه: قال ابن رشد في كتاب القواعد: الذين قصروا الربا على الستة: إما منكرو القياس وهم الظاهرية، أو منكرو قياس الشبه خاصة، وأن القياس في هذا الباب شبه فلم يقولوا به، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني؛ فلا جَرَمَ لم يلحق بما ذكر في الحديث إلا الزبيب فقط؛ لأنه من باب لا فارق، وهو قياس المعنى، وهو غير قياس الشبه وقياس العلة؛ لأنه مثل إلحاق الذكور بالإناث من الرقيق في تشطير الحدود؛ لأن قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾[النساء: 25] لم يتناول الذكور فألحقوا بهن لعدم الفارق خاصة لا لحصول الجامع، وكذلك ألحق بالعبد الأمة في التقويم في العتق لقوله صلى الله عليه وسلم ”من أعتق شركا له في عبد“، فلحق به الأمة؛ لأنه لا فارق بينهما. فهذا نوع آخر غير قياس الشبه وقياس المعنى لم يجزه القاضي أبو بكر إلا بين التمر والزبيب دون بقية الستة. فهذا تلخيص الفرق بين قاعدة ما فيه الربا وقاعدة ما لا ربا فيه وحكاية المذاهب في ذلك ومداركها ليحصل الاطلاع على جميع ذلك.“ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، المجلد الثالث، 1046، ف. 2373؛ قدم له وحققه وعلق عليه عمر حسن القيام (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 2003)، ج. 3، 397–398. ويعلق محمد علي بن حسين المكي المالكي قائلا: ”وأما من ذهب إلى أن النهي المتعلق بها من باب الخاص أريد به الخاص وقصروا الربا على الستة، فقال ابن رشد في كتاب القواعد هم إما منكرو القياس، أي استنباط العلل من الألفاظ، وهم الظاهرية، أو منكرو قياس الشبه خاصة، وأن القياس في هذا الباب شبه، فلم يقولوا به، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني، فلا جرم لم يلحق بما ذكر في الحديث إلا الزبيب فقط لأنه من باب قياس لا فارق، وهو قياس المعنى، وهو نوع آخر غير قياس الشبه والعلم لأنه مثل إلحاق الذكور بالإناث من الرقيق في تشطير لأن قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ لم يتناول الذكور فألحقوا بهن لعدم الفارق خاصة لا لحصول الجامع وكذلك ألحق بالعبد الأمة في التقويم في العتق لقوله صلى الله عليه وسلم ’من أعتق شركا له في عبد“ إلخ لأنه لا فارق بينهما، ولم يجر القاضي أبو بكر الباقلاني قياس المعنى إلا بين التمر والزبيب دون بقية الستة. هذا خلاصة ما في الأصل من الفرق بين قاعدة ما فيه الربا وقاعدة ما لا ربا فيه وحكاية المذاهب في ذلك ومداركها، وسلمه ابن الشاط مع زيادة البداية وغيرها ليحصل الاطلاع على جميع ذلك. والله تعالى أعلم.“ تهذيب الفروق والقواعد السنية، ضبطه وصححه خليل المنصور، نشر على هامش إدرار الشروق على أنواء الفروق، وعلى كتاب الفروق (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، ج. 3، 423. وقارن، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دار ابن حزم، 1999)، 501.
[113] ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 2، 443.
[114] ويقول ابن رشد: ”ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في مذهب مالك كتابا جامعا لأصول مذهبه ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليها، وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المدونة، فإنه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرى الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى، بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الانسان كما قلنا رتبة الاجتهاد إذ تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك.“ بداية المجتهد، ج. 2، 388.
[115] أبو القاسم ابن جزي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، تحقيق محمد بن سيدي محمد مولاي (الصفاة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2010).
[116] ويغلب على ظننا أن ابن جزي قد استفاد عنوان عمله، القوانين الفقهية، من كلام ابن رشد في سبب وضعه الكتاب؛ والمقارنة تكفي لإظهار ما نقول.
[117] مولاي، ضمن ابن جزي، القوانين الفقهية، 35.
[118] مولاي، ضمن ابن جزي، القوانين الفقهية، 35، ه. 1.
[119] ابن جزي، القوانين الفقهية، 50–51.
[120] ابن جزي، القوانين الفقهية، 52.
[121] مولاي، ضمن ابن جزي، القوانين الفقهية، 35.
[122] مولاي، ضمن ابن جزي، القوانين الفقهية، 35–36.
[123] مولاي، ضمن ابن جزي، القوانين الفقهية، 142، 152، 224، 307.
[124] عبد الرحمن ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، عارضها بأصولها وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي (بيروت: دار الكتب العلمية، 2004)، 70.
[125] محمد علي فركوس، ضمن الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس (مكة-بيروت: المكتبة المكية-مؤسسة الريان، 1998)، 243.
[126] فركوس، ضمن التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، 241–242.
[127] فركوس، ضمن التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، 242.
[128] فركوس، ضمن التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، 242–243.
[129] فركوس، ضمن التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، 243–245.
[130] أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، قواعد الفقه، تحقيق محمد الدردابي (الرباط: دار الأمان، 2012).
[131] الدردابي، مقدمة ضمن المقري، قواعد الفقه، 47.
[132] الدردابي، مقدمة ضمن المقري، قواعد الفقه، 51.
[133] المقري، قواعد الفقه، 129.
[134] يمكن مراجعة عمل أبي العبّاس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور (ت. 995هـ/1585م)، ومحمد بن أحمد بن علي ابن غازي المكناسي (ت. 919هـ/1513م).
مقالات ذات صلة
الخطاب المعياري عند الماوردي (ت. 450هـ/1058م) بين الفقه والفلسفة والأدب: من التأطير القانوني إلى قراءة نسقية وتاريخية
Al-Māwardī’s (d. 450/1058) Normative Discourse between Islamic Jurisprudence, Philosophy, and Adab: From a Legalistic Framing to a Systematic and Historical-Contextual Reading al-khiṭāb al-miʿyārī ʿinda al-Māwardī (d. 450/1058) bayna al-fiqh wa-l-falsafa wa-l-adab:...
نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“
Toward Terminological Unity in the Translation of The New Rhetoric Naḥwa al-waḥda al-iṣṭilāḥiyya fī tarjamat al-Mufaṣṣal fī al-ḥijāj نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“ محمد قنديلجامعة ابن طفيل، القنيطرة Mohammed Kandil Ibn Tofail University, Kénitra...
آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/922م) في النفس الإنسانية
Ārāʾ al-faylasūf Abī al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381 H/992 M) fī al-nafs al-insānīyah Abū al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381/992) on The Human Soul: A Philosophical Inquiry آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/ 922م) في النفس الإنسانية[1] بلال مدريرالأكاديمية الجهوية للتربية...
النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)
The Second Maghribi Logical Revival: Muḥammad al-Sharīf al-Tilmisānī (710–771/1310–1370) al-Nahḍa al-Manṭiqiyya al-Maghribiyya al-Thāniya:Muḥammad al-Sharīf al-Tilimsānī (710–771/1310–1370) النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)...
الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي: موقع كوكبي الزهرة وعطارد نموذجًا
The Reformist Contribution of Jābir ibn Aflaḥ al-Ishbīlī to Astronomy: Venus and Mercury as a Case Study al-Ishām al-iṣlāḥī fī al-falak li-Jābir b. Aflaḥ al-Ishbīlī: Mawqiʿ kawkabay al-Zuhra wa-ʿUṭārid namūdhajan الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي:موقع...
مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم
The Concept of Paradigm in Ibn al-Haytham's Astronomy Mafhūm al-Parādīghm min khilāl falak Ibn al-Ḥaytham مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم فتاح مكاويFatah Mekkaoui جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاسSidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez الملخص: يعتبر...
في مشروعية الكلام السني ضدا على إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت.505هـ/1111م): قطعة من موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي (ت.520هـ/1126م)، تعريفٌ وتوصيف
On the Legitimacy of Sunni Theology against Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (d. 505/1111): A Section from Abū Bakr al-Ṭurṭūshī’s al-Asrār wa-l-ʿIbar (d. 520/1126) - Introduction and Description Fī Mashrūʿiyyat al-Kalām al-Sunnī Ḍiddan ʿalā Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn...
منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق
Al-Ghazālī’s Methodology in His Writings on Logic Manhaj al-Ghazālī fī al-Taʾlīf fī ʿIlm al-Manṭiq منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق محمد رويMohamed Roui جامعة عبد الملك السعديUniversité Abdelmalek Essaadi ملخص: تتناول هذه الدراسة معالم منهج أبي حامد الغزالي...
المنطق في الحضارة الإسلاميّة
المنطق في الحضارة الإسلاميّة خالد الرويهبKhaled El-Rouayheb جامعة هارفارد-كمبريدجHarvard University-Cambridge ملخص: ”المنطق في الحضارة الإسلامية“ لخالد الرويهب (جامعة هارفارد بكمبريدج) هي في الأصل محاضرة بالعربية ألقيت في مؤسسة البحث في الفلسفة العلوم في...
مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي: بواكير منظور جديد
Navigating Ambiguity: Exploring the Role of Uncertainty in the Classical Arab-Islamic Culture Makānat Al-Iltibās fī al-Thaqāfah al- ʿArabiyya al-Islāmiya Fī ʿAṣrihā al-Klāsīkī:Bawākīr Manẓūr Jadīd مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي بواكير...