![]()
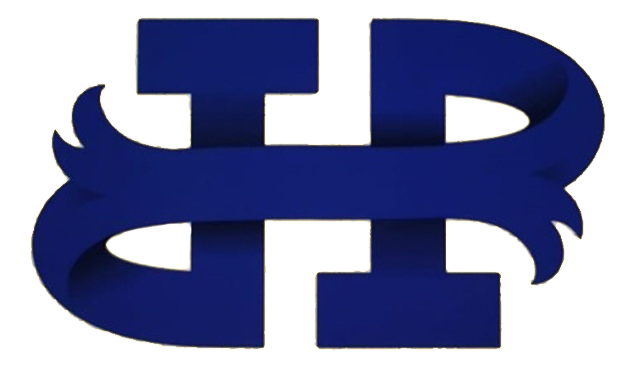
في الرّد على المقرئ أبي زيد الإدريسي

تاريخ الأفكار في السياقات الإسلامية بين إكراهات البحث ورهانات الدعوة
في الرّد على المقرئ أبي زيد الإدريسي
المقرئ أبو زيد الإدريسي سياسي وداعية مغربي معروف في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوماته وسجالاته مع من يختلف معهم ممن يتصور أنهم دعاة العلمانية والحداثة والفرنكفونية والتطبيع… وإلى ذلك، هو أستاذ بجامعة الحسن الثاني، متخصص في اللسانيات التراثية. كان قد أنجز أطروحة جامعية للحصول على دبلوم الدراسات العليا في تخصص اللسانيات، تحت عنوان: مقولة الحرف في اللغة العربية: دراسة نظرية في أجزاء الكلام، وقد ناقشها عام 1987. ولعل هذه الرسالة هي ما نشر، لاحقا، بعنوان، حروف المعاني في اللغة العربية: دراسة دلالية وتركيبية (الدار البيضاء: منشورات مؤسسة الإدريسي الفكرية للدراسات والأبحاث، 2016). وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل هو الوحيد الذي اطلعنا عليه للمقرئ الإدريسي في مجال اختصاصه الأكاديمي، بينما كل المنشورات الأخرى—وهي بالعشرات—تندرج في سياق الدعوة الدينية والتدافع السياسي.
ندرك جيدا أن السجالات الدعوية والخصومات الإيديولوجية لا تكسب صاحبها عادات مفيدة في البحث والنشر العلميين. لذلك، فإننا لا نريد الدخول في أي سجال مع المقرئ أبي زيد الإدريسي؛ إذ لا يهمنا من أنشطة الرجل الكثيرة إلا كونه ينتمي إلى الجامعة المغربية، ويدرك معنى التخصص العلمي؛ فهو، كما ذكرنا، قد أنجز بحثا على الأقل في مجالٍ تَخَصّصِيٍّ بعينه هو علم الدلالة خاصة، واللسانيات عامة؛ كما درّسه لسنوات. وعليه، فهذا هو المدخل الوحيد الذي نود أن نلج منه إلى مناقشته في بعض أحكامه، التي ضمنها تقديمه لكتاب الأمين بوخبزة، الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين: جدلية القبول والرفض (الرباط: منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2021). وبما أننا سنفرد لهذا الكتاب وقفة مستقلة، فإننا نكتفي بالقول إن هذا الأخير كان في الأصل رسالته الجامعية التي ناقشها في كلية دار العلوم بالقاهرة عام 1986 لنيل شهادة الماجستير؛ وإن الجهة التي نشرته إنما فعلت من جهة ما هو أطروحة جامعية. ولهذا السبب، أيضا، صار واجبا علينا، من الناحية العلمية، أن نتفاعل نقديا مع العمل مادام يخص مجالا بحثيا لنا فيه بعض المشاركة.
1. المسافة بين البحث والدعوة
يعرف المنتمون إلى مجال البحث الجامعي والأكاديمي أن من خصائص هذا الأخير النأيُ بالنفس عن الصراعات السياسية والخصومات الإيديولوجية والاتصاف، في المقابل وقدر الوسع، بقيم الحياد والموضوعية والهدوء وتقييد الأحكام بما يشهد لها؛ خاصة وأن ما يحرك الاشتغال العلمي، في مثل مجال كهذا الذي ألف فيه الأمين بوخبزة، هو السعي إلى الفهم السليم متسلحا بالوثيقة والحجة التاريخيتين. غير أن قارئ تقديم المقرئ الإدريسي لكتاب بوخبزة يدرك، من أول قراءة، أن السرعة التي كُتب بها لم تسعف صاحبه لتكييفه مع الغرض الذي من أجله أٌلِّف العمل المقدّم له، وهو غرض علمي أكاديمي في كل الأحوال. فقد كتب التقديم بغرض مواجهة ”السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي،“[1] وبلغة متشنجة، بل عنيفة؛ لذلك جاء مليئا بالأحكام غير المسددة والمتسرعة التي تحتاج مراجعة وتقويما. ولهذا، يحق لمن يهتم بالموضوع الذي ألف فيه الكتاب أن يتساءل، هل هذا الأخير، وهو ذو طابع تاريخي، يتحمل كل أشكال التدليس والتزييف التي ضمنها المقرئ الإدريسي تقديمه؟ لماذا حصل ”استغلال“ الكتاب لتصفية حسابات غير علمية أفسدت النزاهة والجدة اللتين يفترض أن يتسم بهما عمل أكاديمي-تاريخي؟ ألم يكن الأولى أن يحصل تقديم هذا العمل بطريقة تجعله مفيدا للمتخصصين من الدارسين والطلبة، طالما أن الموضوع لا يمس مباشرة الشأنين الدعوي والثقافي؟
يمكن للمرء أن يقول إن الأمر يتعلق باختيارات لا حق لنا فيها لتوجيه التقديم الوجهةَ التي نرتضيها لأنفسنا. بل أكثر من ذلك، يمكن للمهتم أن يقول إن اللغة السّجالية والدعوية الواضحة التي كتب بها الكتاب نفسه قد شجعت المقرئ الإدريسي على مواصلة هذا الطريق في تقديمه لهذا العمل. لكن هذا الأخير يدرك أن الجانب الإيديولوجي من الباعث على البحث في الموضوع ما عاد قائما، أو على الأقل ما عاد بارزا كما كان الشأن في نهاية السبعينيات والثمانينيات، حتى تَحصل استعادتُه، كما لو كان مواجهةً معاصرة بين الدعاة من كل صنف. والحال أن الموضوع لا يتطلب سوى معالجة متأنية متسلحة برؤية علمية نزيهة وبوثائق تُسدّد ما يُشَيّدُ أو يُرَاجع من أحكام. وكما أشرنا من قبل، لن نقف، في هذه الورقة، عند محتويات كتاب بوخبزة، وإنما سنقف وقفة نقدية سريعة عند بعض الأحكام الجزافية وأشكال التلبيس والتدليس التي وردت في تقديم المقرئ الإدريسي. ولذلك، وجوابا على الاعتراض الأول، نقول إنه ما كنا لنتوقف هذه الوقفة أصلا، لو لم يكن التقديم قد كتب لأطروحة جامعية، يُتوجه بها في المقام الأول إلى الباحثين والدارسين؛ والعمل الجامعي الأكاديمي يُفترض فيه أن يظل بعيدا عن السجالات الثقافية العامة.
يدرك المقرئ الإدريسي أن زمنا طويلا قد مر على تأليف بوخبزة عمله؛ وأن أمورا كثيرة قد استجدت في هذا المجال البحثي المحكوم أساسا بالوثائق وبالمخطوطات؛ ولعله يدرك أيضا أن دراسات كثيرة قد نشرت في الموضوع وبلغات البحث المختلفة (عربية وإنجليزية وإسبانية وفرنسية…)؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن رسالة بوخبزة في نظر المقرئ الإدريسي ”تتناول موضوعا لم يغير المناخ الثقافي والفكري والجامعي كثيرا من موقفه المجافي للحقيقة، إلا شيئا ضئيلا.“[2] ومع أن صاحب التقديم لم يأت بأمثلة تظهر هذا الثبات على الموقف الخاطئ في المناخ الثقافي والفكري والجامعي، فالظاهر أن ما يعنيه بهذا هو ما كان يروج في الفضاء الجامعي المغربي المشبع بالإيديولوجيات في زمن ما؛ وإلا فإن هذا الكلام يغدو متجاوزا، عندما نأخذ بعين الاعتبار أن المجالين التاريخي والجغرافي اللذين انشغلا بهما بحث بوخبزة قد عرفا تحولا كبيرا، بفضل ظهور مخطوطات جديدة وإخراجها، ونشر دراسات ومونوغرافيات تغير كثيرا من مشهد غرب إسلامي دخل عصور الانحطاط بفعل انتصار ”الفقهاء“ وموت الفلسفة والعلوم العقلية… وطبعا ليس بوسع غير المتخصص أن يدرك هذا التحول، لأن ذلك يستدعي متابعة لكل ما يستجد في هذا الملف، بل وانخراطا علميا فيه؛ ولا شيء في تقديم الإدريسي يدل على هذا.
فما هو هذا الموقف الذي لم يتغير إلا قليلا؟ الظاهر أن ما لم يتغير في المناخ المذكور، حسب تقويم الإدريسي، هو الدعوى التي:
تفيد بأن الفقهاء ذوو عقلية جامدة جاهزة متحجرة متخشبة تخاف من التفكير وترفض الحرية، لا تؤمن بالعقل وتعكف على صنم النص، تحتكر الحقيقة وتعادي كل من يرمزون إلى معاني الحرية والإبداع والتفكير والخيال والاختراع والتطوير والحداثة والعقلانية واحترام العلم والمعرفة وتقدير الإنسان وقدراته الذاتية والتأمل في الملكوت الكوني بنظرة مجددة وتفكير حر؛ وتهيب بأن من يرمزون لكل هذا هم الفلاسفة.[3]
وبما أن ذلك المناخ لم يغير من دعواه تلك، فإن مبرر انتصاب بوخبزة إلى نشر عمله ما يزال قائما؛ وكما أن ذلك المناخ كان هو الدافع إلى نهوض هذا الأخير إلى الاعتراض على تلك الدعوى، كما يشرح هو نفسه في مقدمة عمله، فإن ثبات ذلك المناخ وجموده على دعواه تلك مبرر لنشر هذه الرسالة، ولتعزيزها من قِبَل الإدريسي بهذا التقديم.
وهذه الدعوى صادرة أساسا من ثلاثة أطراف يوحدهم العداء للدين الإسلامي، في نظر الإدريسي، وهم: العلمانيون، وأتباع المستشرقين، والمشتغلون بالفكر الفلسفي. ويظهر من كلام الإدريسي أن لا أحد نهض إلى مواجهة وتفكيك هذه الدعوى التي كانت سائدة في الأوساط الجامعية المغربية. يقول:
لم يستطع أحد أن يواجه السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي في توجه معاد للدين الإسلامي، وأن يقف في وجه سطوتهم التي رسخت مجموعة من المسبقات والأحكام الظالمة والجاهزة والمغرضة والمستفزة، بل أكاد أقول الكاذبة.[4]
ومن هنا أهمية الرسالة التي ألفها بوخبزة. وفي تقدير المقرئ الإدريسي، فقد ”ساهمت هذه الأطروحة مساهمة مباركة في تفكيك هذا التعميم وفي إبطال هذا الإطلاق، وفي رد حقيقة العلاقة —التي لا ننكر أنها كانت متوترة في عمومها بين الفقهاء والفلاسفة—إلى حجمها الطبيعي، مع السعي إلى بيان مقتضيات هذه العلاقة وخلفياتها وسياقاتها؛“[5] وخاصة في الغرب الإسلامي. وهذا التقييد المنهجي من قِبَل بوخبزة لبحثه بالفقهاء الأندلسيين خاصة، وبالغرب الإسلامي بشكل عام، هو أمر هام، لأن ”كل ما كان يروج منقولا عن المستشرقين المتحاملين المغرضين المتحيزين تحيزا سلبيا هو في أغلبه أمثلة مأخوذة من موقف فقهاء مشارقة من فلاسفة مشارقة.“[6] والحاصل أن إضافة ”موقف فقهاء الأندلس والغرب الإسلامي إلى هذا المشهد، لمما يساعد على مزيد من التدقيق والتحوط والضبط، وبيان الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة.“[7]
هذه، بالجملة، هي الدعوى العامة التي دافع عنها بوخبزة في رسالته، كما قدمها المقرئ أبو زيد الإدريسي. وليس مضمون هذه الدعوى هو ما يهمنا هنا، وإنما ما كتبه الإدريسي ”تعزيزا لأطروحة أخيه الفاضل الأستاذ الأمين مصطفى بوخبزة.“[8] لذلك، فما كتبه الإدريسي، في تقديمه، يدخل في باب نصرة الدعوى المركزية لبوخبزة عن طريق استعمال حجج وشواهد لم يأت بها هذا الأخير، أو لم يستثمرها استثمارا كافيا.
غير أن الإدريسي حتى وإن كان يصرح بأن القصد هو تعزيز أطروحة بوخبزة، فإن ما يأتي به على سبيل تلك الغاية يفيد خروجه عن الإطار العام الذي وضعه بوخبزة لرسالته. أول ما يظهر أن المقرئ الإدريسي يعتبر ثنائية الفقهاء والفلاسفة قاصرة، باعتبار أن ”الإسلام لا يقتصر في هذا السياق على هذه الثنائية وحدها، أقصد ثنائية فقهاء/ فلاسفة، بل يوجد فيه فلاسفة فقهاء مثل ابن رشد الحفيد [ت. 595هـ/1198م]. ويوجد فيه فقهاء فلاسفة مثل ابن تيمية [ت. 728هـ/1328م].“[9] وأما ”في العصر الحديث يوجد […] مفكرون مسلمون أصلاء؛“[10] غير أن الإدريسي لا يسميهم فلاسفة. وكما يتحرر المقرئ الإدريسي من ثنائية بوخبزة، يتحرر من الإطار الزمني الذي وضعه لبحثه، أعني من القرنين السادس والسابع للهجرة، ومن الإطار الجغرافي الذي هو الغرب الإسلامي، فيجد القارئ حديثا عن المفكرين المنتمين إلى القرن الثالث الهجري (ابن حنبل، ت. 241هـ/855م)، بل وإلى العصر الحديث (محمد الغزالي (ت. 1996م)، ويوسف القرضاوي، وعبد الوهاب المسيري (ت. 2008)، ومحمد عمارة (ت. 2020م)، وسعيد رمضان البوطي (ت. 2013م)، ومحمد عمراني حنشي…)؛ وحديثا عن المناطق الجغرافية الأخرى من العالم الإسلامي؛ وباستثناء حنشي، فإن بقية الأسماء المذكورة مشرقية.
وهذا التحرر من الأطر والحدود التي وضعها بوخبزة لرسالته، بقدر ما يتصور المقرئ الإدريسي أنه يساعده على توفير رؤية أشمل للموضوع، يضعه في مآزق كبرى في تقديرنا. وأول المآزق أن هذه الأسماء كلها ليست من الفلاسفة ولا من الفقهاء بالمعنى الصناعي الاصطلاحي. وثاني المآزق أن تركيزه على الأسماء المشرقية يجعل تشديده ”على الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة“[11] في مهب الريح.
2. غموض، وتحقير للأديان والفلسفة، ودفاع عن القطيعة بين المغرب والمشرق
إن أحد مصادر الغموض في التقديم (وفي الرسالة معًا) هو أن صاحبه لم يكلف نفسه عناء التوضيح والتبيين والتحديد للموضوع الذي يتحدث عنه؛ بحيث لا يجد المرء أي بيان للمقصود بالفقهاء وللمقصود بالفلاسفة. وإذا كان بوخبزة يراهن على أن المقصود أوضح من أن يبين، فالظاهر أنه قد سقط في هذا ضحيةً لخصومه المذكورين الذين لا قِبَلَ لهم بالتمييز بين الفقهاء والمحدثين والمتكلمين؛ مع أن الدّارسين يعرفون أن صناعات هؤلاء وعلومهم ليست واحدة: فالمحدث ليس هو المتكلم، وهذا غير الفقيه… ومن ثم، فلعل إطلاق اسم الفقيه عليهم جميعا ليس إلا جهلا محضا أو تجوزا في غير محله. وهكذا فإن مسايرة بوخبزة كلام خصومه عن الفقهاء بإطلاق جعل رسالته تسقط في غموض شديد. مثال ذلك أن الرسالة تتحدث في العنوان، وفي الخاتمة، كما في ثنايا فصولها، عن الفقهاء الذين يمنعون النظر في العقائد، بينما يجد القارئ نفسه في فصول أخرى أمام نظار (أبو الحجاج يوسف المكلاتي (ت. 627هـ/1237م) مثلا) يدعون إلى النظر في العقائد على طريقة المتكلمين الأشاعرة المتأثرة بالفلسفة السينوية. وبدوره، لم يحاول المقرئ الإدريسي نهائيا توضيح مقصوده بالفقهاء وبالفلاسفة، فجاء كلامه عن هؤلاء في غاية اللبس، كما سنبين أدناه. ولذلك، فإذا كان لا ينتظر من غير المختص (حداثيا كان أو علمانيا أو غير ذلك) أن يميز بين الفقيه والمتكلم والمحدث—ويعرف أن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في موضوعات علم الحديث (كطرق تحمل الحديث والنظر في السند…)، كما أن المحدث حافظا كان أو غير ذلك، لا ينظر من جهة ما هو محدث في مسائل الفقه (العبادات والمعاملات…) وأن كلا من هذين لا ينظر من جهة ما هما كذلك في مسائل الكلام والعقائد، كحدث العالم والجوهر الفرد وخلق القرآن ورؤية الله يوم القيامة— فإن الدّارس المتخصص يفترض فيه أن يميز وأن لا يخلط بينهم. وبالمناسبة، فإن أغلب المحدثين والفقهاء الذين لم تكن لهم مشاركة في علم الكلام ما كانوا يقبلون الخوض في مسائله، بل كانوا يعتبرونه خروجا عن العقيدة التوقيفية، وربما خروجا عن الدين نفسه، فما بالك أن يعتبروه رأس العلوم الدينية، على غرار ما فعل الغزالي في مقدمة المستصفى من علم الأصول. هذا بغض النظر عن طبيعة الكلام، هل هو معتزلي أو أشعري أو ماتريدي.
أمر آخر هالنا في التقديم، وهو تلك الأحكام الجزافية و”التحقيرية“ التي صدرت عن صاحبه في حق المسيحية وفي حق الفلسفة اليونانية. وهكذا، فنحن لا نتصور أن السخرية من المعتقدات والمذاهب القديمة، سواء كانت دينية أو فلسفية قد تسعف في بناء حوار عقلاني ولا في التأسيس لقول رشيد ومنصف. وإلا فما معنى أن يقول المقرئ الإدريسي، وهو الشخص الذي لا اختصاص علمي له في الأديان، إن ”دين المسيحية مبني على الجهل والعاطفية والخرافية“؟[12] فما الزاوية التي تخوله الحق في هذا الحكم؟ وفي كل الأحوال، لا نتصور أن يقبل مؤرخُ أديان أو مقارنٌ بينها بأحكام مثل هذه؛ أما المؤمن بدين الإسلام فتحول سماحته دون رمي الأديان الأخرى بما يخسس من قيمتها في نظر المؤمنين بها.
وما قد يقوله المختص في تاريخ الأديان أو المقارنة بينها، سيقوله مؤرخ الأفكار الفلسفية والعلمية، عندما يقرأ ما يلي: ”مرجعية الفيلسوف، لا أقول هي العقل، ولكن العقل اليوناني الذي كان يؤمن بنظريات عجيبة غريبة مضحكة مبنية يفسر بها نشأة الكون، ويفسر بها ظهور الأفلاك والكواكب، مثل نظرية الفيض التي تبناها الفلاسفة المسلمون المشاؤون نقلا عن فلاسفة الإغريق والتي هي مجرد تخرص.“[13] طبعا، يمكننا أن نفهم وصف الغزالي النظريات الكوسمولوجية للمشائين بالتحكمات والترهات…، فذلك سياق سجالي مخصوص ومعروف. ولكن من زاوية تاريخ الأفكار العلمية والفلسفية، لا موجب للمؤرخ بإطلاق أحكام قيمة على أفكار قديمة وتقويمها من زاوية ما آل إليه الفكر العلمي أو الفلسفي اليوم. هذا فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين المشائين ليسوا على مذهب كوسمولوجي واحد، حتى يوصفوا كلهم بالتخرّص، فابن رشد لم يقل بنظرية الفيض بينما قال بها أبو نصر الفارابي (ت. 339هـ/950م). والجدير بالتنبيه أن نظرية الفيض تعود في أصلها إلى أفلوطين (ت. 270م)، ولم يكن هذا فيلسوفا مشائيا. وعندما نستعيد هذا، فنحن لا نكشف جديدا، وإنما نُذَكّر بِما لا يسع المهتم الجهل به؛ وإلا فإنه ليس من النزاهة العلمية في شيء أن يخلط غير المختص بين الفلاسفة وبين أقوالهم ومذاهبهم، بغرض الطعن في الفلسفة بإطلاق. ورحم الله ابن تيمية عندما قال: ”وأما نفي الفلسفة مطلقا أو إثباتها فلا يمكن، إذ ليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه ولا قول يتفقون عليه في الإلهيات والمعاد والنبوات والشرائع بل وفي الطبيعيات والرياضيات، بل ولا في كثير من المنطق؛ ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من الحسيات المشاهدة والعقليات التي لا ينازع فيها أحد.“[14]
ثم إن التمييز الجوهري بين عقلية المغربي والمشرقي ليس له أصل ولا أساس، فضلا عن أن المقرئ الإدريسي لم يكلف نفسه تحديد المعنى الذي يعطيه للعقلية: أهو معنى أنثربولوجي أم أنطلوجي أم سيكولوجي؟ هذا، ويبدو أن صاحب التقديم يصادر على هذا التمييز دون أن يكلف نفسه التصريح بأصوله وبمصادره؛ ومعلوم عند القراء والمهتمين أن محمد عابد الجابري (ت. 2010) هو الذي كان قد رفع هذه الدعوى في زمن ما، وشُنِّع عليه الأمر حينئذ. وبالجملة، فلا أتصور عاقلا اليوم يسلم بالقول بوجود فرق نوعي بين عقلية المغربي والمشرقي.
3. التلبيس والتغيير في الأسماء: الطريق الملكي للتغليط
ما يهمنا الوقوف عنده في هذا الرد هو ذلك التلبيس والتشويش الذي أقحمه المقرئ الإدريسي على اسم الفيلسوف، وذلك عن طريق الخلط المقصود بينه وبين المتكلم تارة، وبينه وبين المفكر تارة أخرى. وإذا كان الخلط الأخير لا يستدعي كبير جهد لتبينه، فإننا سنضطر للتذكير ببعض الأوليات التي إن تبينت صار الخلط بين الفيلسوف والمتكلم حاصل أحد أمرين: إما الجهل بتاريخ العلمين أو الصناعتين، أعني الفلسفة وعلم الكلام؛ وإما القصد إلى التلبيس والتضليل؛ وهذا قصد غير شريف. وعليه، فإننا سنذكّر أدناه ببعض المقدمات المعروفة عند المختصين؛ وسنقف عند الصنائع الأربع: الكلام والفلسفة (الإلهيات) والحديث والفقه من الناحية الدلالية، قبل أن نعرض، باختصار شديد، للتمييز بين الفلسفة والكلام والفقه من الناحية التاريخية.
يعرف محمد علي التهانوي (ت. 1158هـ/1745م) علم الكلام كما يلي: ”ويسمى بأصول الدين […] ويسمى بعلم التوحيد والصفات […] [وهو] العلم المتعلق […] بالأحكام الأصلية أي الاعتقادية.“[15] ويميز التهانوي علم الكلام عن الإلهيات، التي هي قسم من الفلسفة بالقول: ”يمتاز الكلام عن [العلم] الإلهي، باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام لا على قانون العقل، وافق الإسلام أو لا، كما في الإلهي.“[16] وهذا تمييز حاسم بين العلمين، بحيث يجعل الأول علما من علوم الدين، والعلم الآخر الإلهي علما عقليا؛ من غير أن يعني هذا أن علم الكلام غير عقلي، بل هو علم يجمع بين العقل والنقل في تدليلاته، وكما يقول التهانوي: و”أيضا دلائله [علم الكلام] يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل، وهي أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل.“[17] ويتبنى التهانوي الموقف الذي كان قد عبر عنه أبو حامد الغزالي (ت. 505هـ/1111م) في مقدمة المستصفى من علم الأصول، عندما اعتبر علم الكلام علما كليا فيما اعتبر بقية العلوم الدينية علوما جزئية وأنه رأسها،[18] إذ يقول: و”الكلام هو العلم الأعلى إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها […] فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق.“[19] وأما بخصوص موضوعات علم الكلام ومباحثه فيقول التهانوي: ”بالجملة فعلماء الإسلام قد دونوا لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله، وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد، علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها، ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا، فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد.“[20]
أما علم الحديث، و”يسمى بعلم الرواية والأخبار والآثار أيضا […] و[هو] علم تعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله.“[21] وهو، طبعا، غير علم الفقه الذي ”يسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا […]. وهو معرفة النفس ما لها وما عليها […]“ ويتميز علم الفقه عن علم الكلام بطبيعة تلك المعرفة؛ فـ”معرفة ما لها [النفس] وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح. ومعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام.“[22] ويضيف التهانوي مؤكدا على الطابع العملي للفقه: ”وقال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية [المكتسب] من أدلتها التفصيلية […]، فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا، وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.“[23] هذا، وقد جعل أصحاب الشافعي ”للفقه أربعة أركان: العبادات، والمعاملات، والمناكحات والعقوبات.“[24]
أما من الناحية التاريخية، وهي الزاوية التي يحب المقرئ الإدريسي أن يواجه خصومه بها، فالفيلسوف غير المتكلم والفلسفة غير علم الكلام. والتمييز بين الطرفين لا يحتاج الكثير من الجهد. تاريخيا، تعتبر الفلسفة علما إنسانيا لا تعلق له بدين ولا بلغة بعينها، وإن توافق الناس على أن منشأها اليونان بتأثير واقتباس من حضارات أخرى. لكن المعروف، أن المسلمين قد ورثوا هذا العلم من اليونان بعد أن انتقلت كتب هؤلاء وأعمالهم إلى مناطق دخلها المسلمون منذ عام 19 للهجرة (الإسكندرية، وجنديسابور، وأنطاكيا…) وتواصلت عمليات الاحتكاك والتفاعل مع مرور الوقت. وقد خلف المسلمون كتابات عديدة في هذه الصناعة. ويمكن التمثيل لهذا بكتابات الفيلسوفين أبي إسحاق الكندي (ت. 256هـ/873م) وأبي نصر الفارابي وغيرها… لكن المسلمين أيضا عرفوا ظهور علم لا يبعد أن يكون للديانات التي قبل الإسلام تأثير كبير فيه، وخاصة المسيحية… هذا مع أن بلورته قد حصلت في سياق إسلامي. وهذا العلم هو المعروف بعلم الكلام. وبطبيعة الحال، فلو سألت دارسا متخصصا في الدراسات الإسلامية عن علم الكلام لكان جوابه إنه علم ديني. وإن عدت إلى كتب القدماء، وليكن أبا حامد الغزالي، لوجدت أن الكلام علم ديني، بل هو رأس العلوم الدينية، على ما ذكرنا أعلاه. وهو ما لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الفلسفة، التي لا تخلو من نفحات دينية موضوعا ومقاربة، لكن لا أحد اعتبرها علما دينيا أو شرعيا، كما هو شأن علم الكلام. فما مرد هذا الخلط؟
لعل أمورا كثيرة تقف وراء هذا الخلط، سنحاول أن نحصي منها ثلاثةً باختصار شديد:
أول الأمور، أن الفلسفة في السياقات الإسلامية، وخاصة بعد أبي علي ابن سينا (ت. 428هـ/1037م)، عرفت امتدادا وتأثيرا كبيرا، بحيث استطاعت أن تخترق حدود خصومها، وخاصة من الأشعرية. ومن شدة تعاطي هؤلاء للفلسفة، وخاصة في حلتها السينوية، يكاد المرء لا يتبين أهذا الذي أنتجهُ متكلمون، كفخر الدين الرازي (ت. 606هـ/1209م) ونصير الدين الطوسي (ت. 672هـ/1274م)، هو علم كلام أم فلسفة أم هما معا. والمفارقة، أن الأشعرية، التي احتضنت الفلسفة السينوية وتغيرت في هويتها ومعالمها، هي التي اشتهرت أكثر من غيرها برد دعاوى الفلاسفة.
وثانيها، أن الفلسفة قد توسع معناها لتغدو دلالتها تشمل النظر إلى العالم وإلى الكون. ومن هذه الناحية، يمكن للمرء أن يتحدث عن فلسفة الإسلام بمعنى نظرة الإسلام إلى العالم، لا بمعنى فلسفتي ابن سينا وابن رشد. وهنا صارت الفلسفة والفكر الإسلامي مترادفين.
وثالثها، أن المسلمين وخاصة في العصر الحديث، وبعد أن رأوا بعض المستشرقين الكبار ينفون عن المسلمين الفلسفة بمعناها الصناعي المعروف، صاروا، ابتداءً من الشيخ الأزهري مصطفى عبد الرازق (ت. 1947م)، يبحثون عن العلوم التي أبدع فيها المسلمون، فوجدوا أنها أصول الفقه والتصوف وأصول الدين (علم الكلام)، فأسموها فلسفة، بل اعتبروها الفلسفة الحقيقية للإسلام الذي لا حاجة له وللمسلمين إلى علوم الأوائل. وهكذا، فقد صار محمد بن إدريس الشافعي (ت. 204هـ/820م) فيلسوفا رغما عن أنفه، وابن عربي المتصوف (ت. 638هـ/1240م) فيلسوفا رغم تخسيسه للفلسفة ولعقل الفلاسفة، وابن أبي دؤاد المعتزلي (ت. 240هـ/854م) والغزالي الأشعري وركن الدين ابن الملاحمي الخوارزمي المعتزلي (ت. 536هـ/1140م) فلاسفة رغم أنهم ألد خصوم الفلسفة والفلاسفة. ويجدر بنا أن نضيف هنا أن المعتزلة، وبسبب من دفاعهم عن العقل والتأويل العقلي، وظهور تأثرهم ببعض النظريات الفلسفية القديمة، عادة ما يُلحقهم الطلبة والمبتدئون بالفلاسفة؛ هذا مع أنهم، كما قلنا، كانوا علماء دين، وكان علمهم علما دينيا، بل هو رأس العلوم الدينية، الغرض منه إثبات العقائد الدينية؛ هذا فضلا عن خصومتهم للفلاسفة وردودهم عليهم وتمسكهم باستقلال طريقتهم وتميزها بوصفها طريق المسلمين عن طريقة الفلاسفة ومنهجم. ولطالما عابوا على الأشعرية، شافعية وأحنافا، خلطهم طريقة المسلمين، أي المتكلمين، بطريقة المتفلسفة.
يتقصد المقرئ الإدريسي أن يُلبس على القارئ فيأخذ المتكلم بمعنى الفيلسوف عندما يريد أن يثبت تحامل الفلاسفة على الفقهاء، ويميز بينهما عندما يريد الدفاع عن الفقهاء ورد تهمة تحجرهم وامتحانهم الفلاسفة… أولا يقدم المقرئ الإدريسي أبا حامد الغزالي بوصفه فيلسوفا تارة وبوصفه شبه فيلسوف تارة أخرى، ليؤكد أن الفقيه لم يكن متحجرا؛ وثانيا، يبحث الإدريسي عن اسم فيلسوف امتحن الفقهاء، فلا يعثر على أي اسم من الفلاسفة الذين اعتدنا أن نعتبرهم كذلك؛ لكن بما أن المتكلمين عنده أقران الفلاسفة؛ فإنه وإن كان الذي أشرف على محنة ابن حنبل فقيه من المعتزلة الذين اشتهروا بكونهم خصوم الفلاسفة (وبخاصة الفلسفة والمنطق الأرسطيين)، فإنه في هذا السياق، يغدو المتكلمون والفلاسفة سواء. وإذا أخطأ المعتزلة، فالخطأ يتحمله الفلاسفة. ونورد أدناه بعض التفاصيل.
فلكي يدافع المقرئ أبو زيد الإدريسي عن انفتاح الفقيه وعقلانيته ويدفع عنه تهمة الانغلاق التي يصفه بها خصومه، اضطر إلى أن يعتبر الغزالي، وهو من أكبر من يمثل الفقهاء، من الفلاسفة تارة ويعتبره تارة أخرى متكلما قرينا للفلاسفة.[25] بل إن الإدريسي قدم حجة جديدة عادة ما أنكرها الناس على الغزالي، وهي دفاعه عن المنطق اليوناني بوصفه دليل انفتاحه. إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الأجناس الأدبية التي كتب فيها الغزالي، فإنه من باب الأولى أن نسميه أصوليا، وصوفيا، ومتكلما. لكن يصعب أن نسميه فيلسوفا بالمعنى الذي كان للفيلسوف في ذهن الغزالي وكتب ضده. إذ لا يعقل أن يرد الغزالي في تهافت الفلاسفة على الفلاسفة من منطلق جدلي كلامي، كما يقول هو نفسه، ونسميه نحن فيلسوفا، وإلا لزم عن ذلك أن يكون الغزالي يرد على نفسه أو أن نغير في الأسماء. أما إن قلنا إنه فيلسوف بمعنى أنه مفكر؛ فنحن بذلك نخرج عن الكلام الأكاديمي إلى الكلام الثقافي العام. بل ولو قلنا إن الغزالي متكلم متفلسف من جهة أنه قد قرأ الفلسفة السينوية ولخصها وتأثر بها ورد على الفلاسفة، فإنه، في كل الأحوال، ما كان ليرضى لنفسه أن يسمى فيلسوفا؛ ولنا في كتاب المنقذ من الضلال، وهو من كتابات الغزالي المتأخرة، خير مثال. ثم لا يكفي أن يكون الغزالي متكلما لكي يغدو فيلسوفا. فالفلسفة علم والكلام علم آخر، كما بينا أعلاه. ومن هذه الناحية، فإن الغزالي لم ينتقد الفلسفة ولم يرد على الفلاسفة، في تهافت الفلاسفة، من جهة أنه فقيه أصولي شافعي وإنما من جهة أنه متكلم؛ إذ ليس من مهام الفقيه أن يفحص أقوال الفلاسفة في الميتافيزيقا، ولا هو يملك العدة العلمية والمنهجية للرد عليهم. أما دفاع الغزالي عن حاجة الأصول، كلاما وفقها، إلى المنطق، فلم يكن من جهة ما أن هذا الأخير جزء فلسفة أو آلة مخصوصة بالفلسفة، وإنما من جهة ما هو آلة محايدة لا تعلق لها بالعقائد إثباتا أو إبطالا؛ وكذا من جهة أن المنطق يمكن أن ينقذ العلوم الشرعية التي تصور الغزالي أنها في أزمة، وربما قد تندثر ما لم تتمسك بالمنطق بوصفه الأصل في وثاقة كل علم وفي موثوقيته.
ويقول المقرئ الإدريسي:
لست أنكر أنه قد كان لبعض الفقهاء الذين استأسدوا في بعض البلاطات، واستفردوا بقلوب الملوك في بعض الدول شيء من العسف أو الانغلاق، أو شيء من قبيل ’المرء عدو لما جهل‘؛ ولكن ليس يعقل أن يسحب هذا الموقف على كل قبيل الفلاسفة في مواجهة قبيل الفقهاء. وإلا فسبحان الله، ويا للمفارقة والعجب! فإن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل.[26]
الحق أنه لا مجال للاعتراض على هذا القول في جملته، لأن صاحبه يقر بوجود أشكال من الانغلاق سائدة بين الفقهاء وأشكال من العسف صادرة عنهم في حق فلاسفة. كما لا يملك المرء سوى أن يوافق صاحب القول في أنه من غير المعقول أن نعمم حيث يجب التقييد. فلا الانفتاح صفة ملازمة لكل فيلسوف ولا الانغلاق صفة ملازمة لكل فقيه. إلى هنا، لا شيء يثير الانتباه، لأن مراجعة كتب التاريخ تؤكد بأنه لا مجال سوى لتقييد الأحكام. لكن سؤالنا هو: لماذا لجأ المقرئ الإدريسي إلى تغيير الأسماء في آخر سطر من الاقتباس أعلاه؟ لماذا لم يحتفظ باسم الفلاسفة طالما أنه يتحدث عنهم ويريد أن يقنعنا أنهم من نكل بالفقهاء؟ ولماذا أبدل هؤلاء باسم المفكرين، وهو يعلم أن هؤلاء غير أولئك، أو لنقل، على وجه الدقة، لماذا أبدل خاصا بعام أو جزءا بكل؟ ثم دعنا نسأل الإدريسي: من هم هؤلاء الفلاسفة يا رجل؟ دُلّنَا على اسم أو اسمين لفلاسفة استعملوا نفوذهم ليوقعوا بخصومهم ويقصوهم وينكبوا بهم، بل ويقتلوهم، حتى نطمئن لدعواك.
لم يورد المقرئ الإدريسي اسما واحدا من أسماء الفلاسفة ليستشهد به لدعواه الخطيرة تلك. لكنه، في المقابل، يقول في سياق التدليل لدعواه:
لم نسمع بفقيه بنى فرنا ليحرق فيه أعداءه، ولكن سمعنا بمعتزلي يدعي الحرية والعقل هو ابن أبي دؤاد القاضي والوزير، الذي بنى فرنا ليحرق فيه من يختلف معه من الفقهاء ومن السلف، لكنه هو أحرق فيه وقطع فيه تقطيعا قبل أن يحرق.[27]
إننا عندما نقرأ هذا الكلام الذي قدمه الإدريسي دليلا على تنكيل الفلاسفة بخصومهم الفقهاء ندرك تماما لماذا أقدم المقرئ الإدريسي على إبدال اسم الفلاسفة بالمفكرين، تحايلا على القارئ وتضليلا له. يقول المقرئ الإدريسي:
إن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل. من امتحن من؟ ابن حنبل أم المعتزلة؟ وهم الذين كانوا يكثرون من دعاوى العقل والحرية والتفكير؟ إن ما نعرفه تاريخيا، أن ابن حنبل هو الذي سجن وعذب…ويا سبحان الله اليوم ينسب سيد قطب [ت. 1966م] إلى قبيل ابن تيمية وابن حنبل. من سجن من؟ ومن حرض على من؟ القوميون والعقلانيون والإعلاميون والمفكرون الذين كانوا في حاشية عبد الناصر أم سيد قطب؟ سيد قطب هو الذي سجن، وهو الذي عذب عذابا لا قبل لأحد به.[28]
ليس غرضنا أن نشكك في ما حصل لهؤلاء الأعلام ولغيرهم من صنوف العذاب في تاريخ الإسلام وفي ظروف مختلفة يتداخل فيها ما هو ديني بما هو سياسي، وإنما غرضنا أن نتساءل: إذا كان سياق الكلام هو التقابل بين الفلاسفة والفقهاء، فلماذا يأبى الإدريسي إلا أن يغض النظر عن الفلاسفة، ليشرع في الحديث عن مفكري النظام الناصري …وعن المتكلمين المعتزلة، وخاصة أبي دؤاد، الذي غدا الممثل الوحيد للفلاسفة وللظلم الذي سلطوه على الفقهاء ممثلين في ابن حنبل؟ ثم ما مصدر الإدريسي في خبر بناء ابن أبي دؤاد فرنا لإحراق الخصوم، وفي خبر إحراقه فيه؟
بخصوص السؤال الأول، للأسف لم يسعفنا المقرئ الإدريسي بتفاصيل إضافية عن هؤلاء الشخصيات التي كانت حول الرئيس المصري السابق عبد الناصر (حكم بين 1956م و1970م)، فحال دون أن نتعرف فيهم إلى فيلسوف واحد نستطيع به أن نجد لكلامه وجاهة ما؛ لكن أن يمثل للفلاسفة الذين عاقبوا الفقهاء وقتلوهم بأبي دؤاد المعتزلي، فهو، لعمري، أمر في غاية السقوط. يمكن للقارئ أن يبحث مطولا في كتب تاريخ الفلاسفة في السياقات الإسلامية ولن يعثر عن أحمد ابن أبي دؤاد؛ لأن هذا الأخير، كما يعرف أبو زيد جيدا، إنما هو من المتعاطين لعلم من علوم الدين، وهو علم الكلام على طريقة أهل الاعتزال، وإلى ذلك فهو فقيه وقاض،[29] وليس فيلسوفا؛ وأن موضع الخلاف العقدي بينه وبين ابن حنبل ليس موضوعا فلسفيا، بل موضوع من موضوعات علم الكلام؛ أعني أن الخلاف بين أحمد ابن أبي دؤاد وأحمد ابن حنبل إنما هو، نظريا، خلاف ديني بين عالمي دين واحد هو الإسلام. هذا مع أنه يصعب علينا اليوم أن نصدق أن الخلاف بخصوص خلق القرآن بين المعتزلة عموما وأحمد ابن حنبل وأسماء أخرى كان خلافا كلاميا خالصا؛ بل هو خلاف تداخل فيه ما هو سياسي بما هو ديني؛ وأن هذه المحنة لم تكن سوى وجهٍ من وجوه استخدام الدين لأغراض السلطة، على ما بين فهمي جدعان في عمله القيم عن المحنة.[30]
لكن عندما لا نتقدم فنحدد، أولا، ما نقصده بالفقهاء، يصير من حقنا أن نتحدث بإطلاق عن محنة الفقيه ابن حنبل مع المتكلم المعتزلي ابن أبي دؤاد؛ وننسى أو نذهل عن أن هذا الأخير هو أيضا فقيه مثله مثل خصمه، بل كان معروفا بالفقه في زمنه، تماما كما كان ابن حنبل معروفا بالحديث. وإلى ذلك، فإن هذا الأخير لم يمتحن لأنه فقيه، بمعنى أنه ما سُوئل من أجل فتوى في أمور المعاملات أو العبادات… وإنما من جهة قوله في أمور الاعتقادات (رؤية الله، وخلق القرآن…)، وهذه ليست موضوعات الفقيه وإنما موضوعات المتكلم، سواء أكان معتزليا أو أشعريا أو حنبليا أو ماتريديا.
ولا يملك المرء سوى أن يستغرب لقول المقرئ الإدريسي، وهو يحاول أن يقنع مخاطبه بأن ما سجل التاريخ هو محنة الفقهاء ”الموصومين“ بالنقل مع المفكرين الموسومين بالعقل، وكأن هؤلاء هم الفلاسفة الذين ذكرهم في دعواه. وموضع الاستغراب يقوم أساسا في هذه الأسماء التي أتى بها ليظهر كيف أن الفقهاء هم الذين كانوا ضحايا الفلاسفة. فقديما ابن حنبل عُذّب على يد المعتزلة؛ وزمنا بعده، ابتلي ابن تيمية بالباطنية وغلاة الصوفية؛ وحديثا عذب سيد قطب على يد نظام عبد الناصر بدعم وتحريض من الإعلاميين العقلانيين والمفكرين والقوميين. مغالطات المقرئ الإدريسي مكشوفة هنا، فحتى وإن سلمنا له بأن ابن حنبل فقيه وليس محدثا وصاحب قول في العقيدة، وأن ابن تيمية فقيه وليس متكلما حنبليا، وأن سيد قطب فقيه وليس مفكرا سلفيا، فإن المعتزلة والباطنية وغلاة الصوفية والإعلاميين والعقلانيين والمفكرين والقوميين ليسوا من الفلاسفة، في حدود ما نعلم. فهل يجب أن نحيلهم فلاسفةً رغما عنهم لكي تصح دعوى تنكيل الفلاسفة بالفقهاء؟
قد يعترض المقرئ الإدريسي فيقول إن الأمثلة التي سُقْتُها هنا إنما هي للمفكرين بعموم وليست للفلاسفة تحديدا، وأنا ما غيرت اسم الفلاسفة في الفقرة أعلاه إلا لهذا الغرض بالذات، أي ليستقيم لي الاستشهاد بهؤلاء. جوابنا إن الأمر غير ذلك، لأن ما سيترتب على هذه الأمثلة من حكم نهائي يُظهر، بما لا يدع مجالا للشك، أن حديث المقرئ الإدريسي إنما هو عن الفلاسفة بالمعنى الصناعي، وليس عن المفكرين عموما ولا عن المتكلمين. ويقول في خلاصته:
لو أردنا أن نسترسل في هذه المقارنة لخرجنا بخلاصة مفادها إن الذي تحجر على رأيه وغضب لنفسه وتصلب في موقفه وانغلق على ذاته وتعالى مدعيا الحقيقة هم الفلاسفة في الغالب. ولم يكتفوا بهذا، بل استعملوا نفوذهم حيثما كان لهم نفوذ، للإيقاع بخصومهم من الفقهاء، وللتضييق عليهم، وإقصائهم ونكبهم، والأمر قد يذهب إلى قتلهم.[31]
فكيف يستخلص المقرئ الإدريسي من أمثلة خاصة بالمعتزلة، وهم من المتكلمين، وبغلاة الباطنية وبمفكري النظام الناصري حكما خاصا بالفلاسفة؟ الظاهر أن ما يهم الإدريسي هو الدعوى وليس هو وجه دلالة الأدلة عليها. لا يهم الاسترسال في إيراد الأمثلة لنعرف أسماء هؤلاء الفلاسفة الذين استعملوا نفوذهم عند السلاطين والحكام والرؤساء، قديما وحديثا، للإيقاع بالفقهاء والتضييق عليهم وإقصائهم… ما يهم هو ”التصديق“ بأن الخلاصة النهائية تخص الفلاسفة، وليس غيرهم. ربما كان يجب أن نزيف التاريخ ونغير هوية هؤلاء الأعلام المذكورين ونحيلهم فلاسفةً عنوة حتى يستقيم حكم المقرئ الإدريسي؛ وإلا فإن الخلاصة أن هذا الأخير قد قرر حكما مسبقا دون أن يأتي بشاهد واحد يشهد لحكمه.
وأما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بمصادر الإدريسي في حكاياته، فإنه على الرغم من استثمار هذا الأخير معطيات وأخبارا شاذة وخطيرة جدا، من قبيل بناء أحمد بن أبي دؤاد فرنا ليحرق فيه من يختلف معه، وأنه في الأخير هو من أُحرق في ذلك الفرن بعد أن قطع تقطيعا، لا يمد قارئه بمصادر هذه الأخبار التي يبدو أنها قد اتصلت به سماعًا. والحال أن النصوص التاريخية والتراجم، في حدود ما وقفنا عليه، لا تتحدث عن فرن ولا عن حرق، وإنما تفيدنا أن أحمد بن أبي دؤاد قد أصيب بمرض الفالج الذي أعجزه وتوفي به ودفن في داره، على ما أورد الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت. 463هـ/1071م) في تاريخ بغداد.[32] فأن يدعي المقرئ الإدريسي هذا دون أن يأتي بشهادة واحدة ليس سوى تحكم في تقديرنا. غير أنه مما يجدر بنا الوقوف عنده أن الخطيب البغدادي، في آخر المدخل المخصص لابن أبي دؤاد، يورد حكاية طريفة ننقلها هنا للفائدة، علها تسعفنا في فك لغز المصدر الذي أفاد المقرئ الإدريسي بخبر فرن ابن أبي دؤاد واحتراقه بالنار.
أخبرنا أبو الحسين بن بشران المعدَّل، قال: حدّثنا عثمان بن أحمد الدّقّاق، قال: حدّثنا إسحاق ابن إبراهيم الُختُّلي، قال: حدّثني أبو يوسف يعقوب بن موسى بن الفيرزان ابن أخي معروف الكرخي، قال: رأيت فِي المنام كأني وأخًا لي نمر على نهر عِيسَى على الشّط وطرف عمامتي بيد أخي هذا، فبينما نحن نمشي إذا امرأة تقول لصديقي هَذَا: ما تدري ما حدث الليلة؟ أهلك اللَّه ابْن أَبِي دؤاد. فقلتُ أنا لها: وما كَانَ سبب هلاكه؟ قالت: أغضبَ اللّهَ عَلَيْهِ، فغضب عَلَيْهِ من فوق سبع سموات.
قَال إِسْحَاق: وحدثني يعقوب، قال أخبرني بعض أصحابنا، قال: كنت عند سفْيان بْن وكيع، فقال: تدرون ما رأيت الليلة؟ وكانت الليلة التي رأوا فيها النَّار بِبَغْدَادَ وغيرها: رأيت كَأنَّ جهنم زفرت فخرج منها اللهب، أو نحو هَذَا الكلام. فقلت: ما هذا؟ قال:أُعدت لابن أبي دؤاد.[33]
هنا تنتهي رواية الأحلام والمنامات والأماني؛ ونتصور أن ابن أبي دؤاد كان له خصوم كثر يتمنون لو يحرق في الدنيا قبل الآخرة، لذا حصل توهم أن جهنم تخرج إليه لهيبها يوم مماته، أو نحو هذا الكلام! أما في الدنيا، فالذي حصل، وفق رواية الإمام الحافظ البغدادي دائما، هو ما يلي:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم الأزهرى، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بْن محمد بن عَرَفَةَ الأَزْدِيُّ، قال: سنة أربعين ومائتين فيها مات أَحْمَد بن أبي دؤاد.
أخبرني الصَّيْمري، قال: حدّثنا المرزُباني، قال: أخبرنا محمّد بن يحيى الصولي، قال: حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي، قَالَ: مات أَبُو الوليد محمد ابن أحمد بن أبي دؤاد، وهو وأبوه منكوبان، فِي ذي الحجة سنة تسع وثلاثين ومائتين ومات أبوه في المحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع بقين منه، فكان بينه وبين ابنه أبي الوليد شهر أو نحوه.
قال الصولي: ودُفن فِي داره بِبغْداد وصلى عَلَيْهِ ابنه الْعَبَّاس.[34]
عندما نقارن هذا الكلام الوارد عند الخطيب البغدادي بالحكاية التي ”سمعها“ المقرئ الإدريسي ورواها بدون ذكره مصدره فيها، يترجح عندنا أن هذا الأخير قد تشابهت عليه أحداث المنامات والرؤى بالوقائع كما يرويها الإخباريون وأصحاب التراجم. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن الخوض في حوادث التاريخ لا يكون اعتمادا على ما قد يعلق بالذاكرة من قصص وروايات تختلط فيها الشجون بالأماني، وإنما اعتمادا على الوثائق والشواهد. وفي كل الأحوال، فإن المقرئ الإدريسي مطالب بالإدلاء بوثيقة تشهد لحادثة تقطيع ابن أبي دؤاد وإحراقه في الفرن الذي بناه خصيصا لإحراق خصومه، وإلا ظل كلامه تحكما بلا دليل، أو في أحسن الأحوال، تعبيرا عن أمنية.
4. كلود برنار وروجر بيكون: المشاحة في أسماء العلماء
من الملفت للانتباه حقا أنه على الرغم من تمسك المقرئ الإدريسي بأن المسلمين هم أرباب العقلانية الحقة، فإنه يعتبرهم أيضا، أرباب المنهج التجريبي وواضعيه؛ ويدلل الإدريسي قائلا: ”ودوننا أطروحة علي سامي النشار مناهج البحث عند مفكري الإسلام، التي تقادم على كتبها ستين عاما [كذا!] وما تقادمت أهميتها، والتي أثبت فيها أن المنهج التجريبي إنما وضعه المسلمون وتأخر عند الغرب إلى القرن التاسع عشر مع كلود برنارد(Claude Bernard) [في كتابه Introduction à l’étude de la médecine expérimentale، كما ورد في الهامش].“[35]
يحتاج هذا القول الغريب وقفة مطولة. لكن السياق لا يتحمل هذا، لذلك نرى أن نضع سؤالين على المقرئ الإدريسي: أولا: من هم المسلمون الذين تأثر بهم الغربيون؟ هل هم الفقهاء؟ أم هم أولئك الذين خاصمهم الفقهاء والمحدثون؟ وثانيا: أيعقل أن يقول طالب فلسفة (تاريخ العلوم) اليوم أن المنهج التجريبي قد تأخر ظهوره عند الغربيين إلى حدود القرن التاسع عشر؟ ثم، ثالثا، أين قرأ المقرئ الإدريسي هذا؟
قد يبدو السؤال الأخير حشوًا من قبلنا، ما دام المقرئ الإدريسي قد ذكر مصدَره، وهو رسالة مناهج البحث عند مفكري الإسلاملعلي سامي النشار (ت. 1980م). أقول إننا قد وضعنا هذا السؤال بالذات، لأننا ندرك أن الإدريسي قد أحال على عمل النشار، ولكن قصدنا أن نراجع عمل الأخير لنقف على أصل حجته.
في رسالته للحصول على الماجستير في مايو عام 1942م، والتي نشرها عام 1947م دونما تغيير ولا تبديل،[36] حاول علي سامي النشار جاهدا أن يثبت أن المسلمين لم يقبلوا منطق اليونان، لأنه كان يقوم على المنهج القياسي ولا يترك مجالا للتجربة،[37] التي تعبر عن حقيقة المنهج الإسلامي. ويقول النشار: ”قد وصل المسلمون إلى وضع هذا المنهج الاستقرائي الذي يقوم على التجربة. وهذا المنهج التجريبي هو المعبر عن روح الإسلام،“[38] بينما ”المنهج القياسي هو روح الحضارة اليونانية.“[39] ولا يحدد النشار من يقصد بهؤلاء المسلمين الذين وضعوا هذا المنهج التجريبي؛ لكنه يقرر أنهم قد وضعوه ”بجميع عناصره.“[40] ومن هؤلاء انتقل هذا المنهج إلى الأوروبيين في القرن الثالث عشر. ولكي يثبت النشار هذه الدعوى يستشهد بكلام مفكرين مسلمين وأوروپبين. وهكذا، فقد شهد هؤلاء لاستمداد الفيلسوف الإنجليزي روجر بيكون (Roger Bacon, d. 1294) دراسته العلمية من ”الجامعات الإسلامية في الأندلس؛“[41] كما شهدوا أنه لم يكن سوى واسطة في إدخال المنهج التجريبي الإسلامي الأصل إلى أوروبا.
والملاحظ أنه لم يرد في أي موضع من كتاب سامي النشار المذكور أن المنهج التجريبي قد تأخر عند الغرب إلى حدود القرن التاسع عشر للميلاد، وأن الطبيب الفرنسي كلود برنار قد أخذ هذا المنهج عن المسلمين. فلقد تشابه على المقرئ الإدريسي كلود برنارد الذي عاش في القرن التاسع عشر (1813-1874) وروجر بيكون الذي عاش في القرن الثالث عشر. أيعقل أن يسقط الإدريسي ستة قرون كاملة من تاريخ الأفكار العلمية؟ أيعقل أن يغفل الإدريسي عن الفيلسوفين الإنجليزيين فرانسيس بيكون (Francis Bacon, d. 1626) وجون ستوارت ميل (John Stuart Mill, d. 1873)، وقد ورد ذكرهم في كتاب النشار الذي يحيل عليه؟ لا شيء يدل على أن الإدريسي قد راجع مناهج البحث لدى مفكري الإسلام عند كتابة تقديمه هذا والإحالة على النشار. ويجب أن نضيف أخيرا أنه ما كنا لنقف عند هذا الخلط بين الاسمين، بيكون وبرنار، إلا لأنه قد ترتّبَ على ذلك الخلط قول الإدريسي بتأخر الأوروبيين في اكتشاف المنهج التجريبي، مُسقطا، بذلك، ستة قرون كاملة من تاريخ العلوم، وإلا فإن الأخطاء والأوهام والهفوات من صميم البحث العلمي.
ولن ندخل في نقاش آخر بخصوص هؤلاء الذين أسماهم روجر بيكون بالعرب، وبأن علمهم هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. لن ندخل أيضا، في نقاش عن هذا العلم، هل كان علم الفقه؟ وعن أصحابه هل كانوا هم الفقهاء؟ مع أن المقرئ الإدريسي يقول بهذا. ولن ندخل في نقاش بخصوص الجامعات الإسلامية بالأندلس؛ لن ندخل في نقاش بخصوص كل هذه المسائل، لأنه سيخرجنا عن الغرض من هذه الورقة. لكننا نقول يصعب على المرء أن يكون مدققا ومتأنيا في أحكامه عندما يكون تحت إكراهات الدعوة والسجال.
- من يمثل العقل في الإسلام؟ دعوى بدون دليل
وفي الوقت الذي يشيد سامي النشار، ومعه الإدريسي، بالمنهج التجريبي الذي ابتكره العلماء المسلمون، واستفاد منه الأوروبيون؛ من دون أن تحصل تحديد هوية هؤلاء المسلمين وانشغالاتهم العلمية، مع أن المقصود بهم في تلك الاستشهادات التي أوردها النشار ليس الفقهاء ولا المحدّثون ولا المتكلمون، وإنما علماء المسلمين في الطبيعيات والكيمياء والنبات والطب والرياضيات، أمثال جابر ابن حيان (ت. 160هـ/815م)، والحسن ابن الهيثم (ت. 430هـ/1040م)، وغيرهما ممن كان على خصومة مع الفقهاء والمحدّثين الذين كان كثير منهم يعتبرون علوم هؤلاء غير نافعة في الآخرة. وفي كل الأحوال، فقد تدارك سامي النشار الأمر في طبعة ثانية عام 1965م لكتابه مناهج البحث لدى مفكري الإسلام؛[42] واضطر، في فصل جديد مخصص للمنهج التجريبي عند علماء المسلمين، أن يعترف بأن اليونان قد خبروا المنهج التجريبي، وأن العلماء المسلمين من أمثال ابن الهيثم وابن حيان وأبي الريحان البيروني (ت. 440هـ/1048م)… قد طوروه تطويرا كبيرا؛ ومن هؤلاء انتقل إلى أوروبا في القرن الثالث عشر بفضل جهود روجر بيكون وآخرين.
وعلى الرغم من هذا، فإن المقرئ الإدريسي يتمسك بالقول ”إن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة.“[43]وطبعا، يصعب على القارئ المتخصص، فضلا عن غيره، أن يدرك ما يقصده الإدريسي بهذا الكلام، ومن ثم أن يناقش مثل هذه القضايا العامة والغامضة. لكن الجدير بالذكر أن مثل هذه الأحكام بالذات هو ما كان يقرره المستشرقون في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أقصد أن حضارة الإسلام لا يمكن أن تقبل الفلسفة لأنها حضارة فقه ونقل وجزئيات؛ وأن الفلسفة الحقيقية للإسلام هي فلسفة القرآن؛ أما الفلسفة بوصفها فاعلية عقلية خالصة، فلا قبل للمسلمين بها.
وفي سياق الغموض دائما، لا يتردد المقرئ أبو زيد الإدريسي في الإشادة بعقلانية المعتزلة ذاهلا عن نقده لهم من جهة أنهم امتحنوا الفقهاء وأهل السلف. بل إنه يعتبر المتكلمين، إلى جانب الفقهاء والنحويين، هم أرباب العقلانية والتفكير الفلسفي في الإسلام؛ ويقول في هذا: ”العقلانية الحقيقية والتفكير الفلسفي الحقيقي هو في المناهج التي وضعها الأصوليون من أصول فقه، وأصول نحو وأصول دين.“[44] إن أصول الدين هو التسمية الأخرى لعلم الكلام، ليس أكثر؛ ومناهجهم في التأويل وفي الحديث وفي العقيدة وفي أمور أخرى لم يكن يقبلها كثير من الحنابلة وأهل السلف وغيرهم.
والظاهر أن المقرئ الإدريسي لا يبالي أن يكون المعترض على الفلسفة والفلاسفة متكلما أو فقيها أو محدثا؛ فالأهم عنده هو رد دعاوى الفلاسفة؛ وعندئذ فقط يصبح جميع هؤلاء داخلا تحت مظلة الفقيه. وهكذا، فلكي يثبت المقرئ الإدريسي دعواه، التي مفادها أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة، يروي لنا هذه الحكاية:[45]
لقد لخص لنا صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي [ت. 414هـ/1023م] […] المناظرة التاريخية التي جرت ليوم كامل بين أبي سعيد السيرافي [ت. 368هـ/978م] ومتى بن يونس القنائي المنطقي [ت. 328هـ/940م]، وفي محفل الوزير ابن سعدان وأمام جحفل من العلماء والنحاة والفلاسفة والمتكلمين والقراء؛ وهي مناظرة تنتهي إلى نتيجة ألجأَ فيها أبا [كذا! والصواب: ”أبو“]سعيد متى بن يونس القنائي إلى الزاوية وحصره فيها، مقنعا إياه بالحجة المقلوبة عليه من لسانه أنه كما قال له أبو سعيد: ”أنت إذن لست تدعونا إلى علم المنطق وإنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية،“ لأن لغة اليونانيين هي التي صاغت هذا الفكر! وهذا انتباه دقيق من أبي سعيد السيرافي.
لن ندخل في نقاش بخصوص علاقة اللغة بالفكر ولا بخصوص صِدقية واقعة المحاورة بين أبي سعيد ومتى، كما ولن نعترض على إسقاط تمثيلية العقل الحقيقي عند المسلمين عن الفلاسفة، وإنما سندخل في نقاش بخصوص وجه دلالة هذه الواقعة على الدعوى التي يدعيها المقرئ الإدريسي، وهي أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء. وفي الواقع، يصعب أن يساير المرء المستأنس بتاريخ علم الكلام وبردود المتكلمين على المناطقة ما يقوله المقرئ الإدريسي، لأنه يلفق في حججه ويزيف فيها؛ ذلك أن الشاهد الذي يقدمه هنا بوصفه الممثل لعقل الفقهاء في مواجهة عقل الفلاسفة لم يكن في هذه المناظرة فقيها متحدثا باسم علم الفقه، وإنما كان عالما لغويا ومتكلما معتزليا (ولنتذكر أن المتكلم عند المقرئ الإدريسي قرين الفيلسوف)؛ هذا دون أن ندعي أن السيرافي لم يكن له معرفة بالفقه؛ لكن كل ما نعرفه من أعماله اليوم إنما هي في علوم اللغة؛ وهذا أمر يعرفه المقرئ أبو زيد الإدريسي جيدا. وحتى وإن سلمنا أن أبا سعيد السيرافي كانت له مشاركة في الفقه، فإنه، أولا، كان فقيها معتزليا، مثله مثل أحمد ابن أبي دؤاد؛ وثانيا وأساسا، إن موضوع مناظرته مع متى لا يدخل، بأي وجه من الوجوه، ضمن موضوعات الفقه بمعناه الصناعي الذي يعرفه به أهله. إن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في علاقة الفكر باللغة ولا في علاقة المنطق بالنحو، وإنما ينظر في المعاملات والعبادات والمناكحات والعقوبات. أما الموضوع الذي دارت بخصوصه تلك المناظرة فهو يهم اللغويين والمناطقة بالأساس، أي أنه كان يهم السيرافي من حيث هو لغوي متكلم، ومتى ابن يونس من حيث هو منطقي أرسطي. ومن هذه الجهة، فإن الموقف الذي يعبر عنه أبو سعيد السيرافي في هذه المناظرة إنما يُظهر موقفَ المتكلمين المعتزلة الرافض تماما لإدخال المنطق الأرسطي على قواعد اللغة. ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن المعتزلة، وخلاف ما هو شائع، هم ألد خصوم المنطق والفلسفة الأرسطيين؛ وهم في هذا على طرف النقيض من أبي المعالي الجويني (ت. 478هـ/1085م)، بل ومن أبي حامد الغزالي الفقيه الأصولي الذي أدخل المنطق على أصول الفقه والدين، ودافع عن المنطق الأرسطي دفاعا شديدا، معتقدا أن العلوم الإسلامية لن تقوم لها قائمة ولا موثوقية ما لم تحط بالمنطق.
وبالجملة، إن المناظرة بين السيرافي ومتى، إن صح حصولها على الوجه الذي توجد عليه عند التوحيدي لا تعني الفقهاء في شيء، فهي تظهر أساسا موقف اللغويين من المتكلمين المعتزلة من منطق أرسطو وفلسفته. وبسقوط هذا الدليل، تصبح دعواه (الممثل الحقيقي للعقل الإسلامي هم الفقهاء وليس الفلاسفة) بدون دليل؛ اللهم إلا أن يكون المقرئ الإدريسي يعتبر المعتزلة من زمرة الفقهاء عندما يعترضون على الفلسفة والمنطق الأرسطيين، ويعتبرهم فلاسفة عندما يحملون على الحنابلة وأصحاب الأثر. وهذا هو عين التشهّي. فما وافق هواه قبله وما خالفه رفضه.
خاتمة
يمكن لكتاب في التاريخ أن يقدمه فنان أو موسيقي أو روائي؛ ولكن هذا عادة ما يحصل عندما يكون الكتاب ثقافيا وموجها إلى شريحة واسعة من القراء. أما عندما يكون الكتاب جامعيا متخصصا، فمن باب الأولى أن يقدم له متخصص في المجال الذي ينتمي إليه الكتاب؛ ولا أظن أن الجهة الناشرة للأطروحة الجامعية لبوخبزة تخلو من متخصصين في الفلسفة وفي تاريخ التفاعل بين النظار المسلمين في الفترة الكلاسيكية المتأخرة. ومن هنا، فإننا نرى أن تقديم المقرئ الإدريسي لكتاب الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين قد يكون مفيدا من نواح بعينها، لكننا لا نرى له أي فائدة تذكر من الناحية الأكاديمية والعلمية الصرف؛ والسبب هو ما ورد في التقديم من أمور تدخل في صميم ما يسميه المقرئ الإدريسي نفسه بالتخرصات والأغاليط، وقد وقفنا عندها أعلاه. فقد حصل الزج بموضوع تاريخي في خضم سجالات وخصومات مع جهات لا اختصاص لها بالموضوع؛ والحال أن هذا الموضوع ليس في حاجة إلى دعاة يطلقون الأحكام دون سند بقدر ما هو في حاجة إلى مختصين (مؤرخين) يقيدون أحكامهم وخلاصاتهم بوثائق وشواهد ويراجعون أحكام غيرهم من الدارسين، غربيين ومسلمين وغيرهم. بعبارة أخرى، نحن نفهم المحركات الدعوية و”الاعتذارية“ apologetic التي تحرك المقرئ الإدريسي والأمين بوخبزة؛ لكننا نفهم أيضا أن للدعوة وللاعتذار منطقهما وأهلهما وخطابهما ومؤسساتهما، كما للبحث التاريخي منهجه وأهله وخطابه ومؤسساته. لذلك، يجدر بنا أن نؤكد، أخيرًا، أن المجال الذي كتب فيه بوخبزة، وقدّم له الإدريسي، ليس أرضا مشاعا يدخلها من يشاء ويتحرك فيها كما يشاء، وإنما هو مجال له تقاليده وأعرافه العلمية التي ينضبط لها أهله المتخصصون فيه من كل أنحاء العالم؛ وهو، أيضا، مجال لا تُقَوّم فيه الدراسات بدرجة الصخب الذي تثيره، وعِظَم الأحكام الذي ترسله، وإنما تُقوَّم فقط بالقياس إلى ما تحصل من تراكم علمي في ذلك المجال، وما سجلته فيه تلك الدراسات من جديد، بالقياس إلى ذلك التراكم بالذات، على مستوى جدة الوثائق ورصانة التحليل. ولذلك، أيضا، فإن المجال الذي كتب فيه بوخبزة ليس أرضًا خلاء، وإنما هو أرض مأهولة، على الدّاخل إليها أن ينضبط لمعايير البحث والتراكم العلمي المتعارف عليها دوليا، حتى يكون قوله مفيدا للناس ويمكث في الأرض؛ وهو ما سنعود إليه في وقفة ثانية.
تاريخ الأفكار في السياقات الإسلامية بين إكراهات البحث ورهانات الدعوة
في الرّد على المقرئ أبي زيد الإدريسي
المقرئ أبو زيد الإدريسي سياسي وداعية مغربي معروف في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوماته وسجالاته مع من يختلف معهم ممن يتصور أنهم دعاة العلمانية والحداثة والفرنكفونية والتطبيع… وإلى ذلك، هو أستاذ بجامعة الحسن الثاني، متخصص في اللسانيات التراثية. كان قد أنجز أطروحة جامعية للحصول على دبلوم الدراسات العليا في تخصص اللسانيات، تحت عنوان: مقولة الحرف في اللغة العربية: دراسة نظرية في أجزاء الكلام، وقد ناقشها عام 1987. ولعل هذه الرسالة هي ما نشر، لاحقا، بعنوان، حروف المعاني في اللغة العربية: دراسة دلالية وتركيبية (الدار البيضاء: منشورات مؤسسة الإدريسي الفكرية للدراسات والأبحاث، 2016). وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل هو الوحيد الذي اطلعنا عليه للمقرئ الإدريسي في مجال اختصاصه الأكاديمي، بينما كل المنشورات الأخرى—وهي بالعشرات—تندرج في سياق الدعوة الدينية والتدافع السياسي.
ندرك جيدا أن السجالات الدعوية والخصومات الإيديولوجية لا تكسب صاحبها عادات مفيدة في البحث والنشر العلميين. لذلك، فإننا لا نريد الدخول في أي سجال مع المقرئ أبي زيد الإدريسي؛ إذ لا يهمنا من أنشطة الرجل الكثيرة إلا كونه ينتمي إلى الجامعة المغربية، ويدرك معنى التخصص العلمي؛ فهو، كما ذكرنا، قد أنجز بحثا على الأقل في مجالٍ تَخَصّصِيٍّ بعينه هو علم الدلالة خاصة، واللسانيات عامة؛ كما درّسه لسنوات. وعليه، فهذا هو المدخل الوحيد الذي نود أن نلج منه إلى مناقشته في بعض أحكامه، التي ضمنها تقديمه لكتاب الأمين بوخبزة، الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين: جدلية القبول والرفض (الرباط: منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2021). وبما أننا سنفرد لهذا الكتاب وقفة مستقلة، فإننا نكتفي بالقول إن هذا الأخير كان في الأصل رسالته الجامعية التي ناقشها في كلية دار العلوم بالقاهرة عام 1986 لنيل شهادة الماجستير؛ وإن الجهة التي نشرته إنما فعلت من جهة ما هو أطروحة جامعية. ولهذا السبب، أيضا، صار واجبا علينا، من الناحية العلمية، أن نتفاعل نقديا مع العمل مادام يخص مجالا بحثيا لنا فيه بعض المشاركة.
1. المسافة بين البحث والدعوة
يعرف المنتمون إلى مجال البحث الجامعي والأكاديمي أن من خصائص هذا الأخير النأيُ بالنفس عن الصراعات السياسية والخصومات الإيديولوجية والاتصاف، في المقابل وقدر الوسع، بقيم الحياد والموضوعية والهدوء وتقييد الأحكام بما يشهد لها؛ خاصة وأن ما يحرك الاشتغال العلمي، في مثل مجال كهذا الذي ألف فيه الأمين بوخبزة، هو السعي إلى الفهم السليم متسلحا بالوثيقة والحجة التاريخيتين. غير أن قارئ تقديم المقرئ الإدريسي لكتاب بوخبزة يدرك، من أول قراءة، أن السرعة التي كُتب بها لم تسعف صاحبه لتكييفه مع الغرض الذي من أجله أٌلِّف العمل المقدّم له، وهو غرض علمي أكاديمي في كل الأحوال. فقد كتب التقديم بغرض مواجهة ”السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي،“[1] وبلغة متشنجة، بل عنيفة؛ لذلك جاء مليئا بالأحكام غير المسددة والمتسرعة التي تحتاج مراجعة وتقويما. ولهذا، يحق لمن يهتم بالموضوع الذي ألف فيه الكتاب أن يتساءل، هل هذا الأخير، وهو ذو طابع تاريخي، يتحمل كل أشكال التدليس والتزييف التي ضمنها المقرئ الإدريسي تقديمه؟ لماذا حصل ”استغلال“ الكتاب لتصفية حسابات غير علمية أفسدت النزاهة والجدة اللتين يفترض أن يتسم بهما عمل أكاديمي-تاريخي؟ ألم يكن الأولى أن يحصل تقديم هذا العمل بطريقة تجعله مفيدا للمتخصصين من الدارسين والطلبة، طالما أن الموضوع لا يمس مباشرة الشأنين الدعوي والثقافي؟
يمكن للمرء أن يقول إن الأمر يتعلق باختيارات لا حق لنا فيها لتوجيه التقديم الوجهةَ التي نرتضيها لأنفسنا. بل أكثر من ذلك، يمكن للمهتم أن يقول إن اللغة السّجالية والدعوية الواضحة التي كتب بها الكتاب نفسه قد شجعت المقرئ الإدريسي على مواصلة هذا الطريق في تقديمه لهذا العمل. لكن هذا الأخير يدرك أن الجانب الإيديولوجي من الباعث على البحث في الموضوع ما عاد قائما، أو على الأقل ما عاد بارزا كما كان الشأن في نهاية السبعينيات والثمانينيات، حتى تَحصل استعادتُه، كما لو كان مواجهةً معاصرة بين الدعاة من كل صنف. والحال أن الموضوع لا يتطلب سوى معالجة متأنية متسلحة برؤية علمية نزيهة وبوثائق تُسدّد ما يُشَيّدُ أو يُرَاجع من أحكام. وكما أشرنا من قبل، لن نقف، في هذه الورقة، عند محتويات كتاب بوخبزة، وإنما سنقف وقفة نقدية سريعة عند بعض الأحكام الجزافية وأشكال التلبيس والتدليس التي وردت في تقديم المقرئ الإدريسي. ولذلك، وجوابا على الاعتراض الأول، نقول إنه ما كنا لنتوقف هذه الوقفة أصلا، لو لم يكن التقديم قد كتب لأطروحة جامعية، يُتوجه بها في المقام الأول إلى الباحثين والدارسين؛ والعمل الجامعي الأكاديمي يُفترض فيه أن يظل بعيدا عن السجالات الثقافية العامة.
يدرك المقرئ الإدريسي أن زمنا طويلا قد مر على تأليف بوخبزة عمله؛ وأن أمورا كثيرة قد استجدت في هذا المجال البحثي المحكوم أساسا بالوثائق وبالمخطوطات؛ ولعله يدرك أيضا أن دراسات كثيرة قد نشرت في الموضوع وبلغات البحث المختلفة (عربية وإنجليزية وإسبانية وفرنسية…)؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن رسالة بوخبزة في نظر المقرئ الإدريسي ”تتناول موضوعا لم يغير المناخ الثقافي والفكري والجامعي كثيرا من موقفه المجافي للحقيقة، إلا شيئا ضئيلا.“[2] ومع أن صاحب التقديم لم يأت بأمثلة تظهر هذا الثبات على الموقف الخاطئ في المناخ الثقافي والفكري والجامعي، فالظاهر أن ما يعنيه بهذا هو ما كان يروج في الفضاء الجامعي المغربي المشبع بالإيديولوجيات في زمن ما؛ وإلا فإن هذا الكلام يغدو متجاوزا، عندما نأخذ بعين الاعتبار أن المجالين التاريخي والجغرافي اللذين انشغلا بهما بحث بوخبزة قد عرفا تحولا كبيرا، بفضل ظهور مخطوطات جديدة وإخراجها، ونشر دراسات ومونوغرافيات تغير كثيرا من مشهد غرب إسلامي دخل عصور الانحطاط بفعل انتصار ”الفقهاء“ وموت الفلسفة والعلوم العقلية… وطبعا ليس بوسع غير المتخصص أن يدرك هذا التحول، لأن ذلك يستدعي متابعة لكل ما يستجد في هذا الملف، بل وانخراطا علميا فيه؛ ولا شيء في تقديم الإدريسي يدل على هذا.
فما هو هذا الموقف الذي لم يتغير إلا قليلا؟ الظاهر أن ما لم يتغير في المناخ المذكور، حسب تقويم الإدريسي، هو الدعوى التي:
تفيد بأن الفقهاء ذوو عقلية جامدة جاهزة متحجرة متخشبة تخاف من التفكير وترفض الحرية، لا تؤمن بالعقل وتعكف على صنم النص، تحتكر الحقيقة وتعادي كل من يرمزون إلى معاني الحرية والإبداع والتفكير والخيال والاختراع والتطوير والحداثة والعقلانية واحترام العلم والمعرفة وتقدير الإنسان وقدراته الذاتية والتأمل في الملكوت الكوني بنظرة مجددة وتفكير حر؛ وتهيب بأن من يرمزون لكل هذا هم الفلاسفة.[3]
وبما أن ذلك المناخ لم يغير من دعواه تلك، فإن مبرر انتصاب بوخبزة إلى نشر عمله ما يزال قائما؛ وكما أن ذلك المناخ كان هو الدافع إلى نهوض هذا الأخير إلى الاعتراض على تلك الدعوى، كما يشرح هو نفسه في مقدمة عمله، فإن ثبات ذلك المناخ وجموده على دعواه تلك مبرر لنشر هذه الرسالة، ولتعزيزها من قِبَل الإدريسي بهذا التقديم.
وهذه الدعوى صادرة أساسا من ثلاثة أطراف يوحدهم العداء للدين الإسلامي، في نظر الإدريسي، وهم: العلمانيون، وأتباع المستشرقين، والمشتغلون بالفكر الفلسفي. ويظهر من كلام الإدريسي أن لا أحد نهض إلى مواجهة وتفكيك هذه الدعوى التي كانت سائدة في الأوساط الجامعية المغربية. يقول:
لم يستطع أحد أن يواجه السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي في توجه معاد للدين الإسلامي، وأن يقف في وجه سطوتهم التي رسخت مجموعة من المسبقات والأحكام الظالمة والجاهزة والمغرضة والمستفزة، بل أكاد أقول الكاذبة.[4]
ومن هنا أهمية الرسالة التي ألفها بوخبزة. وفي تقدير المقرئ الإدريسي، فقد ”ساهمت هذه الأطروحة مساهمة مباركة في تفكيك هذا التعميم وفي إبطال هذا الإطلاق، وفي رد حقيقة العلاقة —التي لا ننكر أنها كانت متوترة في عمومها بين الفقهاء والفلاسفة—إلى حجمها الطبيعي، مع السعي إلى بيان مقتضيات هذه العلاقة وخلفياتها وسياقاتها؛“[5] وخاصة في الغرب الإسلامي. وهذا التقييد المنهجي من قِبَل بوخبزة لبحثه بالفقهاء الأندلسيين خاصة، وبالغرب الإسلامي بشكل عام، هو أمر هام، لأن ”كل ما كان يروج منقولا عن المستشرقين المتحاملين المغرضين المتحيزين تحيزا سلبيا هو في أغلبه أمثلة مأخوذة من موقف فقهاء مشارقة من فلاسفة مشارقة.“[6] والحاصل أن إضافة ”موقف فقهاء الأندلس والغرب الإسلامي إلى هذا المشهد، لمما يساعد على مزيد من التدقيق والتحوط والضبط، وبيان الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة.“[7]
هذه، بالجملة، هي الدعوى العامة التي دافع عنها بوخبزة في رسالته، كما قدمها المقرئ أبو زيد الإدريسي. وليس مضمون هذه الدعوى هو ما يهمنا هنا، وإنما ما كتبه الإدريسي ”تعزيزا لأطروحة أخيه الفاضل الأستاذ الأمين مصطفى بوخبزة.“[8] لذلك، فما كتبه الإدريسي، في تقديمه، يدخل في باب نصرة الدعوى المركزية لبوخبزة عن طريق استعمال حجج وشواهد لم يأت بها هذا الأخير، أو لم يستثمرها استثمارا كافيا.
غير أن الإدريسي حتى وإن كان يصرح بأن القصد هو تعزيز أطروحة بوخبزة، فإن ما يأتي به على سبيل تلك الغاية يفيد خروجه عن الإطار العام الذي وضعه بوخبزة لرسالته. أول ما يظهر أن المقرئ الإدريسي يعتبر ثنائية الفقهاء والفلاسفة قاصرة، باعتبار أن ”الإسلام لا يقتصر في هذا السياق على هذه الثنائية وحدها، أقصد ثنائية فقهاء/ فلاسفة، بل يوجد فيه فلاسفة فقهاء مثل ابن رشد الحفيد [ت. 595هـ/1198م]. ويوجد فيه فقهاء فلاسفة مثل ابن تيمية [ت. 728هـ/1328م].“[9] وأما ”في العصر الحديث يوجد […] مفكرون مسلمون أصلاء؛“[10] غير أن الإدريسي لا يسميهم فلاسفة. وكما يتحرر المقرئ الإدريسي من ثنائية بوخبزة، يتحرر من الإطار الزمني الذي وضعه لبحثه، أعني من القرنين السادس والسابع للهجرة، ومن الإطار الجغرافي الذي هو الغرب الإسلامي، فيجد القارئ حديثا عن المفكرين المنتمين إلى القرن الثالث الهجري (ابن حنبل، ت. 241هـ/855م)، بل وإلى العصر الحديث (محمد الغزالي (ت. 1996م)، ويوسف القرضاوي، وعبد الوهاب المسيري (ت. 2008)، ومحمد عمارة (ت. 2020م)، وسعيد رمضان البوطي (ت. 2013م)، ومحمد عمراني حنشي…)؛ وحديثا عن المناطق الجغرافية الأخرى من العالم الإسلامي؛ وباستثناء حنشي، فإن بقية الأسماء المذكورة مشرقية.
وهذا التحرر من الأطر والحدود التي وضعها بوخبزة لرسالته، بقدر ما يتصور المقرئ الإدريسي أنه يساعده على توفير رؤية أشمل للموضوع، يضعه في مآزق كبرى في تقديرنا. وأول المآزق أن هذه الأسماء كلها ليست من الفلاسفة ولا من الفقهاء بالمعنى الصناعي الاصطلاحي. وثاني المآزق أن تركيزه على الأسماء المشرقية يجعل تشديده ”على الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة“[11] في مهب الريح.
2. غموض، وتحقير للأديان والفلسفة، ودفاع عن القطيعة بين المغرب والمشرق
إن أحد مصادر الغموض في التقديم (وفي الرسالة معًا) هو أن صاحبه لم يكلف نفسه عناء التوضيح والتبيين والتحديد للموضوع الذي يتحدث عنه؛ بحيث لا يجد المرء أي بيان للمقصود بالفقهاء وللمقصود بالفلاسفة. وإذا كان بوخبزة يراهن على أن المقصود أوضح من أن يبين، فالظاهر أنه قد سقط في هذا ضحيةً لخصومه المذكورين الذين لا قِبَلَ لهم بالتمييز بين الفقهاء والمحدثين والمتكلمين؛ مع أن الدّارسين يعرفون أن صناعات هؤلاء وعلومهم ليست واحدة: فالمحدث ليس هو المتكلم، وهذا غير الفقيه… ومن ثم، فلعل إطلاق اسم الفقيه عليهم جميعا ليس إلا جهلا محضا أو تجوزا في غير محله. وهكذا فإن مسايرة بوخبزة كلام خصومه عن الفقهاء بإطلاق جعل رسالته تسقط في غموض شديد. مثال ذلك أن الرسالة تتحدث في العنوان، وفي الخاتمة، كما في ثنايا فصولها، عن الفقهاء الذين يمنعون النظر في العقائد، بينما يجد القارئ نفسه في فصول أخرى أمام نظار (أبو الحجاج يوسف المكلاتي (ت. 627هـ/1237م) مثلا) يدعون إلى النظر في العقائد على طريقة المتكلمين الأشاعرة المتأثرة بالفلسفة السينوية. وبدوره، لم يحاول المقرئ الإدريسي نهائيا توضيح مقصوده بالفقهاء وبالفلاسفة، فجاء كلامه عن هؤلاء في غاية اللبس، كما سنبين أدناه. ولذلك، فإذا كان لا ينتظر من غير المختص (حداثيا كان أو علمانيا أو غير ذلك) أن يميز بين الفقيه والمتكلم والمحدث—ويعرف أن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في موضوعات علم الحديث (كطرق تحمل الحديث والنظر في السند…)، كما أن المحدث حافظا كان أو غير ذلك، لا ينظر من جهة ما هو محدث في مسائل الفقه (العبادات والمعاملات…) وأن كلا من هذين لا ينظر من جهة ما هما كذلك في مسائل الكلام والعقائد، كحدث العالم والجوهر الفرد وخلق القرآن ورؤية الله يوم القيامة— فإن الدّارس المتخصص يفترض فيه أن يميز وأن لا يخلط بينهم. وبالمناسبة، فإن أغلب المحدثين والفقهاء الذين لم تكن لهم مشاركة في علم الكلام ما كانوا يقبلون الخوض في مسائله، بل كانوا يعتبرونه خروجا عن العقيدة التوقيفية، وربما خروجا عن الدين نفسه، فما بالك أن يعتبروه رأس العلوم الدينية، على غرار ما فعل الغزالي في مقدمة المستصفى من علم الأصول. هذا بغض النظر عن طبيعة الكلام، هل هو معتزلي أو أشعري أو ماتريدي.
أمر آخر هالنا في التقديم، وهو تلك الأحكام الجزافية و”التحقيرية“ التي صدرت عن صاحبه في حق المسيحية وفي حق الفلسفة اليونانية. وهكذا، فنحن لا نتصور أن السخرية من المعتقدات والمذاهب القديمة، سواء كانت دينية أو فلسفية قد تسعف في بناء حوار عقلاني ولا في التأسيس لقول رشيد ومنصف. وإلا فما معنى أن يقول المقرئ الإدريسي، وهو الشخص الذي لا اختصاص علمي له في الأديان، إن ”دين المسيحية مبني على الجهل والعاطفية والخرافية“؟[12] فما الزاوية التي تخول للمقرئ الإدريسي الحكمَ على الديانة المسيحية بالجهل والخرافة؟ وفي كل الأحوال، لا نتصور أن يقبل مؤرخُ أديان أو مقارنٌ بينها بأحكام مثل هذه؛ أما المؤمن بدين الإسلام فتحول سماحته دون رمي الأديان الأخرى بما يخسس من قيمتها في نظر المؤمنين بها.
وما قد يقوله المختص في تاريخ الأديان أو المقارنة بينها، سيقوله مؤرخ الأفكار الفلسفية والعلمية، عندما يقرأ ما يلي: ”مرجعية الفيلسوف، لا أقول هي العقل، ولكن العقل اليوناني الذي كان يؤمن بنظريات عجيبة غريبة مضحكة مبنية يفسر بها نشأة الكون، ويفسر بها ظهور الأفلاك والكواكب، مثل نظرية الفيض التي تبناها الفلاسفة المسلمون المشاؤون نقلا عن فلاسفة الإغريق والتي هي مجرد تخرص.“[13] طبعا، يمكننا أن نفهم وصف الغزالي النظريات الكوسمولوجية للمشائين بالتحكمات والترهات…، فذلك سياق سجالي مخصوص ومعروف. ولكن من زاوية تاريخ الأفكار العلمية والفلسفية، لا موجب للمؤرخ بإطلاق أحكام قيمة على أفكار قديمة وتقويمها من زاوية ما آل إليه الفكر العلمي أو الفلسفي اليوم. هذا فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين المشائين ليسوا على مذهب كوسمولوجي واحد، حتى يوصفوا كلهم بالتخرّص، فابن رشد لم يقل بنظرية الفيض بينما قال بها أبو نصر الفارابي (ت. 339هـ/950م). والجدير بالتنبيه أن نظرية الفيض تعود في أصلها إلى أفلوطين (ت. 270م)، ولم يكن هذا فيلسوفا مشائيا. وعندما نستعيد هذا، فنحن لا نكشف جديدا، وإنما نُذَكّر بِما لا يسع المهتم الجهل به؛ وإلا فإنه ليس من النزاهة العلمية في شيء أن يخلط غير المختص بين الفلاسفة وبين أقوالهم ومذاهبهم، بغرض الطعن في الفلسفة بإطلاق. ورحم الله ابن تيمية عندما قال: ”وأما نفي الفلسفة مطلقا أو إثباتها فلا يمكن، إذ ليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه ولا قول يتفقون عليه في الإلهيات والمعاد والنبوات والشرائع بل وفي الطبيعيات والرياضيات، بل ولا في كثير من المنطق؛ ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من الحسيات المشاهدة والعقليات التي لا ينازع فيها أحد.“[14]
ثم إن التمييز الجوهري بين عقلية المغربي والمشرقي ليس له أصل ولا أساس، فضلا عن أن المقرئ الإدريسي لم يكلف نفسه تحديد المعنى الذي يعطيه للعقلية: أهو معنى أنثربولوجي أم أنطلوجي أم سيكولوجي؟ هذا، ويبدو أن صاحب التقديم يصادر على هذا التمييز دون أن يكلف نفسه التصريح بأصوله وبمصادره؛ ومعلوم عند القراء والمهتمين أن محمد عابد الجابري (ت. 2010) هو الذي كان قد رفع هذه الدعوى في زمن ما، وشُنِّع عليه الأمر حينئذ. وبالجملة، فلا أتصور عاقلا اليوم يسلم بالقول بوجود فرق نوعي بين عقلية المغربي والمشرقي.
3. التلبيس والتغيير في الأسماء: الطريق الملكي للتغليط
ما يهمنا الوقوف عنده في هذا الرد هو ذلك التلبيس والتشويش الذي أقحمه المقرئ الإدريسي على اسم الفيلسوف، وذلك عن طريق الخلط المقصود بينه وبين المتكلم تارة، وبينه وبين المفكر تارة أخرى. وإذا كان الخلط الأخير لا يستدعي كبير جهد لتبينه، فإننا سنضطر للتذكير ببعض الأوليات التي إن تبينت صار الخلط بين الفيلسوف والمتكلم حاصل أحد أمرين: إما الجهل بتاريخ العلمين أو الصناعتين، أعني الفلسفة وعلم الكلام؛ وإما القصد إلى التلبيس والتضليل؛ وهذا قصد غير شريف. وعليه، فإننا سنذكّر أدناه ببعض المقدمات المعروفة بالنسبة للمختصين؛ وسنقف عند الصنائع الأربع: الكلام والفلسفة (الإلهيات) والحديث والفقه من الناحية الدلالية، قبل أن نعرض، باختصار شديد، للتمييز بين الفلسفة والكلام والفقه من الناحية التاريخية.
يعرف محمد علي التهانوي (ت. 1158هـ/1745م) علم الكلام كما يلي: ”ويسمى بأصول الدين […] ويسمى بعلم التوحيد والصفات […] [وهو] العلم المتعلق […] بالأحكام الأصلية أي الاعتقادية.“[15] ويميز التهانوي علم الكلام عن الإلهيات، التي هي قسم من الفلسفة بالقول: ”يمتاز الكلام عن [العلم] الإلهي، باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام لا على قانون العقل، وافق الإسلام أو لا، كما في الإلهي.“[16] وهذا تمييز حاسم بين العلمين، بحيث يجعل الأول علما من علوم الدين، والعلم الآخر الإلهي علما عقليا؛ من غير أن يعني هذا أن علم الكلام غير عقلي، بل هو علم يجمع بين العقل والنقل في تدليلاته، وكما يقول التهانوي: و”أيضا دلائله [علم الكلام] يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل، وهي أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل.“[17] ويتبنى التهانوي الموقف الذي كان قد عبر عنه أبو حامد الغزالي (ت. 505هـ/1111م) في مقدمة المستصفى من علم الأصول، عندما اعتبر علم الكلام علما كليا فيما اعتبر بقية العلوم الدينية علوما جزئية وأنه رأسها،[18] إذ يقول: و”الكلام هو العلم الأعلى إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها […] فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق.“[19] وأما بخصوص موضوعات علم الكلام ومباحثه فيقول التهانوي: ”بالجملة فعلماء الإسلام قد دونوا لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله، وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد، علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها، ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا، فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد.“[20]
أما علم الحديث، و”يسمى بعلم الرواية والأخبار والآثار أيضا […] و[هو] علم تعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله.“[21] وهو، طبعا، غير علم الفقه الذي ”يسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا […]. وهو معرفة النفس ما لها وما عليها […]“ ويتميز علم الفقه عن علم الكلام بطبيعة تلك المعرفة؛ فـ”معرفة ما لها [النفس] وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح. ومعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام.“[22] ويضيف التهانوي مؤكدا على الطابع العملي للفقه: ”وقال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية [المكتسب] من أدلتها التفصيلية […]، فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا، وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.“[23] هذا، وقد جعل أصحاب الشافعي ”للفقه أربعة أركان: العبادات، والمعاملات، والمناكحات والعقوبات.“[24]
أما من الناحية التاريخية، وهي الزاوية التي يحب المقرئ الإدريسي أن يواجه خصومه بها، فالفيلسوف غير المتكلم والفلسفة غير علم الكلام. والتمييز بين الطرفين لا يحتاج الكثير من الجهد. تاريخيا، تعتبر الفلسفة علما إنسانيا لا تعلق له بدين ولا بلغة بعينها، وإن توافق الناس على أن منشأها اليونان بتأثير واقتباس من حضارات أخرى. لكن المعروف، أن المسلمين قد ورثوا هذا العلم من اليونان بعد أن انتقلت كتب هؤلاء وأعمالهم إلى مناطق دخلها المسلمون منذ عام 19 للهجرة (الإسكندرية، وجنديسابور، وأنطاكيا…) وتواصلت عمليات الاحتكاك والتفاعل مع مرور الوقت. وقد خلف المسلمون كتابات عديدة في هذه الصناعة. ويمكن التمثيل لهذا بكتابات الفيلسوفين أبي إسحاق الكندي (ت. 256هـ/873م) وأبي نصر الفارابي وغيرها… لكن المسلمين أيضا عرفوا ظهور علم لا يبعد أن يكون للديانات التي قبل الإسلام تأثير كبير فيه، وخاصة المسيحية… هذا مع أن بلورته قد حصلت في سياق إسلامي. وهذا العلم هو المعروف بعلم الكلام. وبطبيعة الحال، فلو سألت دارسا متخصصا في الدراسات الإسلامية عن علم الكلام لكان جوابه إنه علم ديني. وإن عدت إلى كتب القدماء، وليكن أبا حامد الغزالي، لوجدت أن الكلام علم ديني، بل هو رأس العلوم الدينية، على ما ذكرنا أعلاه. وهو ما لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الفلسفة، التي لا تخلو من نفحات دينية موضوعا ومقاربة، لكن لا أحد اعتبرها علما دينيا أو شرعيا، كما هو شأن علم الكلام. فما مرد هذا الخلط؟
لعل أمورا كثيرة تقف وراء هذا الخلط، سنحاول أن نحصي منها ثلاثةً باختصار شديد:
أول الأمور، أن الفلسفة في السياقات الإسلامية، وخاصة بعد أبي علي ابن سينا (ت. 428هـ/1037م)، عرفت امتدادا وتأثيرا كبيرا، بحيث استطاعت أن تخترق حدود خصومها، وخاصة من الأشعرية. ومن شدة تعاطي هؤلاء للفلسفة، وخاصة في حلتها السينوية، يكاد المرء لا يتبين أهذا الذي أنتجهُ متكلمون، كفخر الدين الرازي (ت. 606هـ/1209م) ونصير الدين الطوسي (ت. 672هـ/1274م)، هو علم كلام أم فلسفة أم هما معا. والمفارقة، أن الأشعرية، التي احتضنت الفلسفة السينوية وتغيرت في هويتها ومعالمها، هي التي اشتهرت أكثر من غيرها برد دعاوى الفلاسفة.
وثانيها، أن الفلسفة قد توسع معناها لتغدو دلالتها تشمل النظر إلى العالم وإلى الكون. ومن هذه الناحية، يمكن للمرء أن يتحدث عن فلسفة الإسلام بمعنى نظرة الإسلام إلى العالم، لا بمعنى فلسفتي ابن سينا وابن رشد. وهنا صارت الفلسفة والفكر الإسلامي مترادفين.
وثالثها، أن المسلمين وخاصة في العصر الحديث، وبعد أن رأوا بعض المستشرقين الكبار ينفون عن المسلمين الفلسفة بمعناها الصناعي المعروف، صاروا، ابتداءً من الشيخ الأزهري مصطفى عبد الرازق (ت. 1947م)، يبحثون عن العلوم التي أبدع فيها المسلمون، فوجدوا أنها أصول الفقه والتصوف وأصول الدين (علم الكلام)، فأسموها فلسفة، بل اعتبروها الفلسفة الحقيقية للإسلام الذي لا حاجة له وللمسلمين إلى علوم الأوائل. وهكذا، فقد صار محمد بن إدريس الشافعي (ت. 204هـ/820م) فيلسوفا رغما عن أنفه، وابن عربي المتصوف (ت. 638هـ/1240م) فيلسوفا رغم تخسيسه للفلسفة ولعقل الفلاسفة، وابن أبي دؤاد المعتزلي (ت. 240هـ/854م) والغزالي الأشعري وركن الدين ابن الملاحمي الخوارزمي المعتزلي (ت. 536هـ/1140م) فلاسفة رغم أنهم ألد خصوم الفلسفة والفلاسفة. ويجدر بنا أن نضيف هنا أن المعتزلة، وبسبب من دفاعهم عن العقل والتأويل العقلي، وظهور تأثرهم ببعض النظريات الفلسفية القديمة، عادة ما يُلحقهم الطلبة والمبتدئون بالفلاسفة؛ هذا مع أنهم، كما قلنا، كانوا علماء دين، وكان علمهم علما دينيا، بل هو رأس العلوم الدينية، الغرض منه إثبات العقائد الدينية؛ هذا فضلا عن خصومتهم للفلاسفة وردودهم عليهم وتمسكهم باستقلال طريقتهم وتميزها بوصفها طريق المسلمين عن طريقة الفلاسفة ومنهجم. ولطالما عابوا على الأشعرية، شافعية وأحنافا، خلطهم طريقة المسلمين، أي المتكلمين، بطريقة المتفلسفة.
يتقصد المقرئ الإدريسي أن يُلبس على القارئ فيأخذ المتكلم بمعنى الفيلسوف عندما يريد أن يثبت تحامل الفلاسفة على الفقهاء، ويميز بينهما عندما يريد الدفاع عن الفقهاء ورد تهمة تحجرهم وامتحانهم الفلاسفة… أولا يقدم المقرئ الإدريسي أبا حامد الغزالي بوصفه فيلسوفا تارة وبوصفه شبه فيلسوف تارة أخرى، ليؤكد أن الفقيه لم يكن متحجرا؛ وثانيا، يبحث الإدريسي عن اسم فيلسوف امتحن الفقهاء، فلا يعثر على أي اسم من الفلاسفة الذين اعتدنا أن نعتبرهم كذلك؛ لكن بما أن المتكلمين عنده أقران الفلاسفة؛ فإنه وإن كان الذي أشرف على محنة ابن حنبل فقيه من المعتزلة الذين اشتهروا بكونهم خصوم الفلاسفة (وبخاصة الفلسفة والمنطق الأرسطيين)، فإنه في هذا السياق، يغدو المتكلمون والفلاسفة سواء. وإذا أخطأ المعتزلة، فالخطأ يتحمله الفلاسفة. ونورد أدناه بعض التفاصيل.
فلكي يدافع المقرئ أبو زيد الإدريسي عن انفتاح الفقيه وعقلانيته ويدفع عنه تهمة الانغلاق التي يصفه بها خصومه، اضطر إلى أن يعتبر الغزالي، وهو من أكبر من يمثل الفقهاء، من الفلاسفة تارة ويعتبره تارة أخرى متكلما قرينا للفلاسفة.[25] بل إن الإدريسي قدم حجة جديدة عادة ما أنكرها الناس على الغزالي، وهي دفاعه عن المنطق اليوناني بوصفه دليل انفتاحه. إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الأجناس الأدبية التي كتب فيها الغزالي، فإنه من باب الأولى أن نسميه أصوليا، وصوفيا، ومتكلما. لكن يصعب أن نسميه فيلسوفا بالمعنى الذي كان للفيلسوف في ذهن الغزالي وكتب ضده. إذ لا يعقل أن يرد الغزالي في تهافت الفلاسفة على الفلاسفة من منطلق جدلي كلامي، كما يقول هو نفسه، ونسميه نحن فيلسوفا، وإلا لزم عن ذلك أن يكون الغزالي يرد على نفسه أو أن نغير في الأسماء. أما إن قلنا إنه فيلسوف بمعنى أنه مفكر؛ فنحن بذلك نخرج عن الكلام الأكاديمي إلى الكلام الثقافي العام. بل ولو قلنا إن الغزالي متكلم متفلسف من جهة أنه قد قرأ الفلسفة السينوية ولخصها وتأثر بها ورد على الفلاسفة، فإنه، في كل الأحوال، ما كان ليرضى لنفسه أن يسمى فيلسوفا؛ ولنا في كتاب المنقذ من الضلال، وهو من كتابات الغزالي المتأخرة، خير مثال. ثم لا يكفي أن يكون الغزالي متكلما لكي يغدو فيلسوفا. فالفلسفة علم والكلام علم آخر، كما بينا أعلاه. ومن هذه الناحية، فإن الغزالي لم ينتقد الفلسفة ولم يرد على الفلاسفة، في تهافت الفلاسفة، من جهة أنه فقيه أصولي شافعي وإنما من جهة أنه متكلم؛ إذ ليس من مهام الفقيه أن يفحص أقوال الفلاسفة في الميتافيزيقا، ولا هو يملك العدة العلمية والمنهجية للرد عليهم. أما دفاع الغزالي عن حاجة الأصول، كلاما وفقها، إلى المنطق، فلم يكن من جهة ما أن هذا الأخير جزء فلسفة أو آلة مخصوصة بالفلسفة، وإنما من جهة ما هو آلة محايدة لا تعلق لها بالعقائد إثباتا أو إبطالا؛ وكذا من جهة أن المنطق يمكن أن ينقذ العلوم الشرعية التي تصور الغزالي أنها في أزمة، وربما قد تندثر ما لم تتمسك بالمنطق بوصفه الأصل في وثاقة كل علم وفي موثوقيته.
ويقول المقرئ الإدريسي:
لست أنكر أنه قد كان لبعض الفقهاء الذين استأسدوا في بعض البلاطات، واستفردوا بقلوب الملوك في بعض الدول شيء من العسف أو الانغلاق، أو شيء من قبيل ’المرء عدو لما جهل‘؛ ولكن ليس يعقل أن يسحب هذا الموقف على كل قبيل الفلاسفة في مواجهة قبيل الفقهاء. وإلا فسبحان الله، ويا للمفارقة والعجب! فإن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل.[26]
الحق أنه لا مجال للاعتراض على هذا القول في جملته، لأن صاحبه يقر بوجود أشكال من الانغلاق سائدة بين الفقهاء وأشكال من العسف صادرة عنهم في حق فلاسفة. كما لا يملك المرء سوى أن يوافق صاحب القول في أنه من غير المعقول أن نعمم حيث يجب التقييد. فلا الانفتاح صفة ملازمة لكل فيلسوف ولا الانغلاق صفة ملازمة لكل فقيه. إلى هنا، لا شيء يثير الانتباه، لأن مراجعة كتب التاريخ تؤكد بأنه لا مجال سوى لتقييد الأحكام. لكن سؤالنا هو: لماذا لجأ المقرئ الإدريسي إلى تغيير الأسماء في آخر سطر من الاقتباس أعلاه؟ لماذا لم يحتفظ باسم الفلاسفة طالما أنه يتحدث عنهم ويريد أن يقنعنا أنهم من نكل بالفقهاء؟ ولماذا أبدل هؤلاء باسم المفكرين، وهو يعلم أن هؤلاء غير أولئك، أو لنقل، على وجه الدقة، لماذا أبدل خاصا بعام أو جزءا بكل؟ ثم دعنا نسأل الإدريسي: من هم هؤلاء الفلاسفة يا رجل؟ دُلّنَا على اسم أو اسمين لفلاسفة استعملوا نفوذهم ليوقعوا بخصومهم ويقصوهم وينكبوا بهم، بل ويقتلوهم، حتى نطمئن لدعواك.
لم يورد المقرئ الإدريسي اسما واحدا من أسماء الفلاسفة ليستشهد به لدعواه الخطيرة تلك. لكنه، في المقابل، يقول في سياق التدليل لدعواه:
لم نسمع بفقيه بنى فرنا ليحرق فيه أعداءه، ولكن سمعنا بمعتزلي يدعي الحرية والعقل هو ابن أبي دؤاد القاضي والوزير، الذي بنى فرنا ليحرق فيه من يختلف معه من الفقهاء ومن السلف، لكنه هو أحرق فيه وقطع فيه تقطيعا قبل أن يحرق.[27]
إننا عندما نقرأ هذا الكلام الذي قدمه الإدريسي دليلا على تنكيل الفلاسفة بخصومهم الفقهاء ندرك تماما لماذا أقدم المقرئ الإدريسي على إبدال اسم الفلاسفة بالمفكرين، تحايلا على القارئ وتضليلا له. يقول المقرئ الإدريسي:
إن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل. من امتحن من؟ ابن حنبل أم المعتزلة؟ وهم الذين كانوا يكثرون من دعاوى العقل والحرية والتفكير؟ إن ما نعرفه تاريخيا، أن ابن حنبل هو الذي سجن وعذب…ويا سبحان الله اليوم ينسب سيد قطب [ت. 1966م] إلى قبيل ابن تيمية وابن حنبل. من سجن من؟ ومن حرض على من؟ القوميون والعقلانيون والإعلاميون والمفكرون الذين كانوا في حاشية عبد الناصر أم سيد قطب؟ سيد قطب هو الذي سجن، وهو الذي عذب عذابا لا قبل لأحد به.[28]
ليس غرضنا أن نشكك في ما حصل لهؤلاء الأعلام ولغيرهم من صنوف العذاب في تاريخ الإسلام وفي ظروف مختلفة يتداخل فيها ما هو ديني بما هو سياسي، وإنما غرضنا أن نتساءل: إذا كان سياق الكلام هو التقابل بين الفلاسفة والفقهاء، فلماذا يأبى الإدريسي إلا أن يغض النظر عن الفلاسفة، ليشرع في الحديث عن مفكري النظام الناصري …وعن المتكلمين المعتزلة، وخاصة أبي دؤاد، الذي غدا الممثل الوحيد للفلاسفة وللظلم الذي سلطوه على الفقهاء ممثلين في ابن حنبل؟ ثم ما مصدر الإدريسي في خبر بناء ابن أبي دؤاد فرنا لإحراق الخصوم، وفي خبر إحراقه فيه؟
بخصوص السؤال الأول، للأسف لم يسعفنا المقرئ الإدريسي بتفاصيل إضافية عن هؤلاء الشخصيات التي كانت حول الرئيس المصري السابق عبد الناصر (حكم بين 1956م و1970م)، فحال دون أن نتعرف فيهم إلى فيلسوف واحد نستطيع به أن نجد لكلامه وجاهة ما؛ لكن أن يمثل للفلاسفة الذين عاقبوا الفقهاء وقتلوهم بأبي دؤاد المعتزلي، فهو، لعمري، أمر في غاية السقوط. يمكن للقارئ أن يبحث مطولا في كتب تاريخ الفلاسفة في السياقات الإسلامية ولن يعثر عن أحمد ابن أبي دؤاد؛ لأن هذا الأخير، كما يعرف أبو زيد جيدا، إنما هو من المتعاطين لعلم من علوم الدين، وهو علم الكلام على طريقة أهل الاعتزال، وإلى ذلك فهو فقيه وقاض،[29] وليس فيلسوفا؛ وأن موضع الخلاف العقدي بينه وبين ابن حنبل ليس موضوعا فلسفيا، بل موضوع من موضوعات علم الكلام؛ أعني أن الخلاف بين أحمد ابن أبي دؤاد وأحمد ابن حنبل إنما هو، نظريا، خلاف ديني بين عالمي دين واحد هو الإسلام. هذا مع أنه يصعب علينا اليوم أن نصدق أن الخلاف بخصوص خلق القرآن بين المعتزلة عموما وأحمد ابن حنبل وأسماء أخرى كان خلافا كلاميا خالصا؛ بل هو خلاف تداخل فيه ما هو سياسي بما هو ديني؛ وأن هذه المحنة لم تكن سوى وجهٍ من وجوه استخدام الدين لأغراض السلطة، على ما بين فهمي جدعان في عمله القيم عن المحنة.[30]
لكن عندما لا نتقدم فنحدد، أولا، ما نقصده بالفقهاء، يصير من حقنا أن نتحدث بإطلاق عن محنة الفقيه ابن حنبل مع المتكلم المعتزلي ابن أبي دؤاد؛ وننسى أو نذهل عن أن هذا الأخير هو أيضا فقيه مثله مثل خصمه، بل كان معروفا بالفقه في زمنه، تماما كما كان ابن حنبل معروفا بالحديث. وإلى ذلك، فإن هذا الأخير لم يمتحن لأنه فقيه، بمعنى أنه ما سُوئل من أجل فتوى في أمور المعاملات أو العبادات… وإنما من جهة قوله في أمور الاعتقادات (رؤية الله، وخلق القرآن…)، وهذه ليست موضوعات الفقيه وإنما موضوعات المتكلم، سواء أكان معتزليا أو أشعريا أو حنبليا أو ماتريديا.
ولا يملك المرء سوى أن يستغرب لقول المقرئ الإدريسي، وهو يحاول أن يقنع مخاطبه بأن ما سجل التاريخ هو محنة الفقهاء ”الموصومين“ بالنقل مع المفكرين الموسومين بالعقل، وكأن هؤلاء هم الفلاسفة الذين ذكرهم في دعواه. وموضع الاستغراب يقوم أساسا في هذه الأسماء التي أتى بها ليظهر كيف أن الفقهاء هم الذين كانوا ضحايا الفلاسفة. فقديما ابن حنبل عُذّب على يد المعتزلة؛ وزمنا بعده، ابتلي ابن تيمية بالباطنية وغلاة الصوفية؛ وحديثا عذب سيد قطب على يد نظام عبد الناصر بدعم وتحريض من الإعلاميين العقلانيين والمفكرين والقوميين. مغالطات المقرئ الإدريسي مكشوفة هنا، فحتى وإن سلمنا له بأن ابن حنبل فقيه وليس محدثا وصاحب قول في العقيدة، وأن ابن تيمية فقيه وليس متكلما حنبليا، وأن سيد قطب فقيه وليس مفكرا سلفيا، فإن المعتزلة والباطنية وغلاة الصوفية والإعلاميين والعقلانيين والمفكرين والقوميين ليسوا من الفلاسفة، في حدود ما نعلم. فهل يجب أن نحيلهم فلاسفةً رغما عنهم لكي تصح دعوى تنكيل الفلاسفة بالفقهاء؟
قد يعترض المقرئ الإدريسي فيقول إن الأمثلة التي سُقْتُها هنا إنما هي للمفكرين بعموم وليست للفلاسفة تحديدا، وأنا ما غيرت اسم الفلاسفة في الفقرة أعلاه إلا لهذا الغرض بالذات، أي ليستقيم لي الاستشهاد بهؤلاء. جوابنا إن الأمر غير ذلك، لأن ما سيترتب على هذه الأمثلة من حكم نهائي يُظهر، بما لا يدع مجالا للشك، أن حديث المقرئ الإدريسي إنما هو عن الفلاسفة بالمعنى الصناعي، وليس عن المفكرين عموما ولا عن المتكلمين. ويقول في خلاصته:
لو أردنا أن نسترسل في هذه المقارنة لخرجنا بخلاصة مفادها إن الذي تحجر على رأيه وغضب لنفسه وتصلب في موقفه وانغلق على ذاته وتعالى مدعيا الحقيقة هم الفلاسفة في الغالب. ولم يكتفوا بهذا، بل استعملوا نفوذهم حيثما كان لهم نفوذ، للإيقاع بخصومهم من الفقهاء، وللتضييق عليهم، وإقصائهم ونكبهم، والأمر قد يذهب إلى قتلهم.[31]
فكيف يستخلص المقرئ الإدريسي من أمثلة خاصة بالمعتزلة، وهم من المتكلمين، وبغلاة الباطنية وبمفكري النظام الناصري حكما خاصا بالفلاسفة؟ الظاهر أن ما يهم الإدريسي هو الدعوى وليس هو وجه دلالة الأدلة عليها. لا يهم الاسترسال في إيراد الأمثلة لنعرف أسماء هؤلاء الفلاسفة الذين استعملوا نفوذهم عند السلاطين والحكام والرؤساء، قديما وحديثا، للإيقاع بالفقهاء والتضييق عليهم وإقصائهم… ما يهم هو ”التصديق“ بأن الخلاصة النهائية تخص الفلاسفة، وليس غيرهم. ربما كان يجب أن نزيف التاريخ ونغير هوية هؤلاء الأعلام المذكورين ونحيلهم فلاسفةً عنوة حتى يستقيم حكم المقرئ الإدريسي؛ وإلا فإن الخلاصة أن هذا الأخير قد قرر حكما مسبقا دون أن يأتي بشاهد واحد يشهد لحكمه.
وأما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بمصادر الإدريسي في حكاياته، فإنه على الرغم من استثمار هذا الأخير معطيات وأخبارا شاذة وخطيرة جدا، من قبيل بناء أحمد بن أبي دؤاد فرنا ليحرق فيه من يختلف معه، وأنه في الأخير هو من أُحرق في ذلك الفرن بعد أن قطع تقطيعا، لا يمد قارئه بمصادر هذه الأخبار التي يبدو أنها قد اتصلت به سماعًا. والحال أن النصوص التاريخية والتراجم، في حدود ما وقفنا عليه، لا تتحدث عن فرن ولا عن حرق، وإنما تفيدنا أن أحمد بن أبي دؤاد قد أصيب بمرض الفالج الذي أعجزه وتوفي به ودفن في داره، على ما أورد الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت. 463هـ/1071م) في تاريخ بغداد.[32] فأن يدعي المقرئ الإدريسي هذا دون أن يأتي بشهادة واحدة ليس سوى تحكم في تقديرنا. غير أنه مما يجدر بنا الوقوف عنده أن الخطيب البغدادي، في آخر المدخل المخصص لابن أبي دؤاد، يورد حكاية طريفة ننقلها هنا للفائدة، علها تسعفنا في فك لغز المصدر الذي أفاد المقرئ الإدريسي بخبر فرن ابن أبي دؤاد واحتراقه بالنار.
أخبرنا أبو الحسين بن بشران المعدَّل، قال: حدّثنا عثمان بن أحمد الدّقّاق، قال: حدّثنا إسحاق ابن إبراهيم الُختُّلي، قال: حدّثني أبو يوسف يعقوب بن موسى بن الفيرزان ابن أخي معروف الكرخي، قال: رأيت فِي المنام كأني وأخًا لي نمر على نهر عِيسَى على الشّط وطرف عمامتي بيد أخي هذا، فبينما نحن نمشي إذا امرأة تقول لصديقي هَذَا: ما تدري ما حدث الليلة؟ أهلك اللَّه ابْن أَبِي دؤاد. فقلتُ أنا لها: وما كَانَ سبب هلاكه؟ قالت: أغضبَ اللّهَ عَلَيْهِ، فغضب عَلَيْهِ من فوق سبع سموات.
قَال إِسْحَاق: وحدثني يعقوب، قال أخبرني بعض أصحابنا، قال: كنت عند سفْيان بْن وكيع، فقال: تدرون ما رأيت الليلة؟ وكانت الليلة التي رأوا فيها النَّار بِبَغْدَادَ وغيرها: رأيت كَأنَّ جهنم زفرت فخرج منها اللهب، أو نحو هَذَا الكلام. فقلت: ما هذا؟ قال:أُعدت لابن أبي دؤاد.[33]
هنا تنتهي رواية الأحلام والمنامات والأماني؛ ونتصور أن ابن أبي دؤاد كان له خصوم كثر يتمنون لو يحرق في الدنيا قبل الآخرة، لذا حصل توهم أن جهنم تخرج إليه لهيبها يوم مماته، أو نحو هذا الكلام! أما في الدنيا، فالذي حصل، وفق رواية الإمام الحافظ البغدادي دائما، هو ما يلي:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم الأزهرى، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بْن محمد بن عَرَفَةَ الأَزْدِيُّ، قال: سنة أربعين ومائتين فيها مات أَحْمَد بن أبي دؤاد.
أخبرني الصَّيْمري، قال: حدّثنا المرزُباني، قال: أخبرنا محمّد بن يحيى الصولي، قال: حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي، قَالَ: مات أَبُو الوليد محمد ابن أحمد بن أبي دؤاد، وهو وأبوه منكوبان، فِي ذي الحجة سنة تسع وثلاثين ومائتين ومات أبوه في المحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع بقين منه، فكان بينه وبين ابنه أبي الوليد شهر أو نحوه.
قال الصولي: ودُفن فِي داره بِبغْداد وصلى عَلَيْهِ ابنه الْعَبَّاس.[34]
عندما نقارن هذا الكلام الوارد عند الخطيب البغدادي بالحكاية التي ”سمعها“ المقرئ الإدريسي ورواها بدون ذكره مصدره فيها، يترجح عندنا أن هذا الأخير قد تشابهت عليه أحداث المنامات والرؤى بالوقائع كما يرويها الإخباريون وأصحاب التراجم. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن الخوض في حوادث التاريخ لا يكون اعتمادا على ما قد يعلق بالذاكرة من قصص وروايات تختلط فيها الشجون بالأماني، وإنما اعتمادا على الوثائق والشواهد. وفي كل الأحوال، فإن المقرئ الإدريسي مطالب بالإدلاء بوثيقة تشهد لحادثة تقطيع ابن أبي دؤاد وإحراقه في الفرن الذي بناه خصيصا لإحراق خصومه، وإلا ظل كلامه تحكما بلا دليل، أو في أحسن الأحوال، تعبيرا عن أمنية.
4. كلود برنار وروجر بيكون: المشاحة في أسماء العلماء
من الملفت للانتباه حقا أنه على الرغم من تمسك المقرئ الإدريسي بأن المسلمين هم أرباب العقلانية الحقة، فإنه يعتبرهم أيضا، أرباب المنهج التجريبي وواضعيه؛ ويدلل الإدريسي قائلا: ”ودوننا أطروحة علي سامي النشار مناهج البحث عند مفكري الإسلام، التي تقادم على كتبها ستين عاما [كذا!] وما تقادمت أهميتها، والتي أثبت فيها أن المنهج التجريبي إنما وضعه المسلمون وتأخر عند الغرب إلى القرن التاسع عشر مع كلود برنارد(Claude Bernard) [في كتابه Introduction à l’étude de la médecine expérimentale، كما ورد في الهامش].“[35]
يحتاج هذا القول الغريب وقفة مطولة. لكن السياق لا يتحمل هذا، لذلك نرى أن نضع سؤالين على المقرئ الإدريسي: أولا: من هم المسلمون الذين تأثر بهم الغربيون؟ هل هم الفقهاء؟ أم هم أولئك الذين خاصمهم الفقهاء والمحدثون؟ وثانيا: أيعقل أن يقول طالب فلسفة (تاريخ العلوم) اليوم أن المنهج التجريبي قد تأخر ظهوره عند الغربيين إلى حدود القرن التاسع عشر؟ ثم، ثالثا، أين قرأ المقرئ الإدريسي هذا؟
قد يبدو السؤال الأخير حشوًا من قبلنا، ما دام المقرئ الإدريسي قد ذكر مصدَره، وهو رسالة مناهج البحث عند مفكري الإسلاملعلي سامي النشار (ت. 1980م). أقول إننا قد وضعنا هذا السؤال بالذات، لأننا ندرك أن الإدريسي قد أحال على عمل النشار، ولكن قصدنا أن نراجع عمل الأخير لنقف على أصل حجته.
في رسالته للحصول على الماجستير في مايو عام 1942م، والتي نشرها عام 1947م دونما تغيير ولا تبديل،[36] حاول علي سامي النشار جاهدا أن يثبت أن المسلمين لم يقبلوا منطق اليونان، لأنه كان يقوم على المنهج القياسي ولا يترك مجالا للتجربة،[37] التي تعبر عن حقيقة المنهج الإسلامي. ويقول النشار: ”قد وصل المسلمون إلى وضع هذا المنهج الاستقرائي الذي يقوم على التجربة. وهذا المنهج التجريبي هو المعبر عن روح الإسلام،“[38] بينما ”المنهج القياسي هو روح الحضارة اليونانية.“[39] ولا يحدد النشار من يقصد بهؤلاء المسلمين الذين وضعوا هذا المنهج التجريبي؛ لكنه يقرر أنهم قد وضعوه ”بجميع عناصره.“[40] ومن هؤلاء انتقل هذا المنهج إلى الأوروبيين في القرن الثالث عشر. ولكي يثبت النشار هذه الدعوى يستشهد بكلام مفكرين مسلمين وأوروپبين. وهكذا، فقد شهد هؤلاء لاستمداد الفيلسوف الإنجليزي روجر بيكون (Roger Bacon, d. 1294) دراسته العلمية من ”الجامعات الإسلامية في الأندلس؛“[41] كما شهدوا أنه لم يكن سوى واسطة في إدخال المنهج التجريبي الإسلامي الأصل إلى أوروبا.
والملاحظ أنه لم يرد في أي موضع من كتاب سامي النشار المذكور أن المنهج التجريبي قد تأخر عند الغرب إلى حدود القرن التاسع عشر للميلاد، وأن الطبيب الفرنسي كلود برنار قد أخذ هذا المنهج عن المسلمين. فلقد تشابه على المقرئ الإدريسي كلود برنارد الذي عاش في القرن التاسع عشر (1813-1874) وروجر بيكون الذي عاش في القرن الثالث عشر. أيعقل أن يسقط الإدريسي ستة قرون كاملة من تاريخ الأفكار العلمية؟ أيعقل أن يغفل الإدريسي عن الفيلسوفين الإنجليزيين فرانسيس بيكون (Francis Bacon, d. 1626) وجون ستوارت ميل (John Stuart Mill, d. 1873)، وقد ورد ذكرهم في كتاب النشار الذي يحيل عليه؟ لا شيء يدل على أن الإدريسي قد راجع مناهج البحث لدى مفكري الإسلام عند كتابة تقديمه هذا والإحالة على النشار. ويجب أن نضيف أخيرا أنه ما كنا لنقف عند هذا الخلط بين الاسمين، بيكون وبرنار، إلا لأنه قد ترتّبَ على ذلك الخلط قول الإدريسي بتأخر الأوروبيين في اكتشاف المنهج التجريبي، مُسقطا، بذلك، ستة قرون كاملة من تاريخ العلوم، وإلا فإن الأخطاء والأوهام والهفوات من صميم البحث العلمي.
ولن ندخل في نقاش آخر بخصوص هؤلاء الذين أسماهم روجر بيكون بالعرب، وبأن علمهم هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. لن ندخل أيضا، في نقاش عن هذا العلم، هل كان علم الفقه؟ وعن أصحابه هل كانوا هم الفقهاء؟ مع أن المقرئ الإدريسي يقول بهذا. ولن ندخل في نقاش بخصوص الجامعات الإسلامية بالأندلس؛ لن ندخل في نقاش بخصوص كل هذه المسائل، لأنه سيخرجنا عن الغرض من هذه الورقة. لكننا نقول يصعب على المرء أن يكون مدققا ومتأنيا في أحكامه عندما يكون تحت إكراهات الدعوة والسجال.
- من يمثل العقل في الإسلام؟ دعوى بدون دليل
وفي الوقت الذي يشيد سامي النشار، ومعه الإدريسي، بالمنهج التجريبي الذي ابتكره العلماء المسلمون، واستفاد منه الأوروبيون؛ من دون أن تحصل تحديد هوية هؤلاء المسلمين وانشغالاتهم العلمية، مع أن المقصود بهم في تلك الاستشهادات التي أوردها النشار ليس الفقهاء ولا المحدّثون ولا المتكلمون، وإنما علماء المسلمين في الطبيعيات والكيمياء والنبات والطب والرياضيات، أمثال جابر ابن حيان (ت. 160هـ/815م)، والحسن ابن الهيثم (ت. 430هـ/1040م)، وغيرهما ممن كان على خصومة مع الفقهاء والمحدّثين الذين كان كثير منهم يعتبرون علوم هؤلاء غير نافعة في الآخرة. وفي كل الأحوال، فقد تدارك سامي النشار الأمر في طبعة ثانية عام 1965م لكتابه مناهج البحث لدى مفكري الإسلام؛[42] واضطر، في فصل جديد مخصص للمنهج التجريبي عند علماء المسلمين، أن يعترف بأن اليونان قد خبروا المنهج التجريبي، وأن العلماء المسلمين من أمثال ابن الهيثم وابن حيان وأبي الريحان البيروني (ت. 440هـ/1048م)… قد طوروه تطويرا كبيرا؛ ومن هؤلاء انتقل إلى أوروبا في القرن الثالث عشر بفضل جهود روجر بيكون وآخرين.
وعلى الرغم من هذا، فإن المقرئ الإدريسي يتمسك بالقول ”إن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة.“[43]وطبعا، يصعب على القارئ المتخصص، فضلا عن غيره، أن يدرك ما يقصده الإدريسي بهذا الكلام، ومن ثم أن يناقش مثل هذه القضايا العامة والغامضة. لكن الجدير بالذكر أن مثل هذه الأحكام بالذات هو ما كان يقرره المستشرقون في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أقصد أن حضارة الإسلام لا يمكن أن تقبل الفلسفة لأنها حضارة فقه ونقل وجزئيات؛ وأن الفلسفة الحقيقية للإسلام هي فلسفة القرآن؛ أما الفلسفة بوصفها فاعلية عقلية خالصة، فلا قبل للمسلمين بها.
وفي سياق الغموض دائما، لا يتردد المقرئ أبو زيد الإدريسي في الإشادة بعقلانية المعتزلة ذاهلا عن نقده لهم من جهة أنهم امتحنوا الفقهاء وأهل السلف. بل إنه يعتبر المتكلمين، إلى جانب الفقهاء والنحويين، هم أرباب العقلانية والتفكير الفلسفي في الإسلام؛ ويقول في هذا: ”العقلانية الحقيقية والتفكير الفلسفي الحقيقي هو في المناهج التي وضعها الأصوليون من أصول فقه، وأصول نحو وأصول دين.“[44] إن أصول الدين هو التسمية الأخرى لعلم الكلام، ليس أكثر؛ ومناهجهم في التأويل وفي الحديث وفي العقيدة وفي أمور أخرى لم يكن يقبلها كثير من الحنابلة وأهل السلف وغيرهم.
والظاهر أن المقرئ الإدريسي لا يبالي أن يكون المعترض على الفلسفة والفلاسفة متكلما أو فقيها أو محدثا؛ فالأهم عنده هو رد دعاوى الفلاسفة؛ وعندئذ فقط يصبح جميع هؤلاء داخلا تحت مظلة الفقيه. وهكذا، فلكي يثبت المقرئ الإدريسي دعواه، التي مفادها أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة، يروي لنا هذه الحكاية:[45]
لقد لخص لنا صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي [ت. 414هـ/1023م] […] المناظرة التاريخية التي جرت ليوم كامل بين أبي سعيد السيرافي [ت. 368هـ/978م] ومتى بن يونس القنائي المنطقي [ت. 328هـ/940م]، وفي محفل الوزير ابن سعدان وأمام جحفل من العلماء والنحاة والفلاسفة والمتكلمين والقراء؛ وهي مناظرة تنتهي إلى نتيجة ألجأَ فيها أبا [كذا! والصواب: ”أبو“]سعيد متى بن يونس القنائي إلى الزاوية وحصره فيها، مقنعا إياه بالحجة المقلوبة عليه من لسانه أنه كما قال له أبو سعيد: ”أنت إذن لست تدعونا إلى علم المنطق وإنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية،“ لأن لغة اليونانيين هي التي صاغت هذا الفكر! وهذا انتباه دقيق من أبي سعيد السيرافي.
لن ندخل في نقاش بخصوص علاقة اللغة بالفكر ولا بخصوص صِدقية واقعة المحاورة بين أبي سعيد ومتى، كما ولن نعترض على إسقاط تمثيلية العقل الحقيقي عند المسلمين عن الفلاسفة، وإنما سندخل في نقاش بخصوص وجه دلالة هذه الواقعة على الدعوى التي يدعيها المقرئ الإدريسي، وهي أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء. وفي الواقع، يصعب أن يساير المرء المستأنس بتاريخ علم الكلام وبردود المتكلمين على المناطقة ما يقوله المقرئ الإدريسي، لأنه يلفق في حججه ويزيف فيها؛ ذلك أن الشاهد الذي يقدمه هنا بوصفه الممثل لعقل الفقهاء في مواجهة عقل الفلاسفة لم يكن في هذه المناظرة فقيها متحدثا باسم علم الفقه، وإنما كان عالما لغويا ومتكلما معتزليا (ولنتذكر أن المتكلم عند المقرئ الإدريسي قرين الفيلسوف)؛ هذا دون أن ندعي أن السيرافي لم يكن له معرفة بالفقه؛ لكن كل ما نعرفه من أعماله اليوم إنما هي في علوم اللغة؛ وهذا أمر يعرفه المقرئ أبو زيد الإدريسي جيدا. وحتى وإن سلمنا أن أبا سعيد السيرافي كانت له مشاركة في الفقه، فإنه، أولا، كان فقيها معتزليا، مثله مثل أحمد ابن أبي دؤاد؛ وثانيا وأساسا، إن موضوع مناظرته مع متى لا يدخل، بأي وجه من الوجوه، ضمن موضوعات الفقه بمعناه الصناعي الذي يعرفه به أهله. إن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في علاقة الفكر باللغة ولا في علاقة المنطق بالنحو، وإنما ينظر في المعاملات والعبادات والمناكحات والعقوبات. أما الموضوع الذي دارت بخصوصه تلك المناظرة فهو يهم اللغويين والمناطقة بالأساس، أي أنه كان يهم السيرافي من حيث هو لغوي متكلم، ومتى ابن يونس من حيث هو منطقي أرسطي. ومن هذه الجهة، فإن الموقف الذي يعبر عنه أبو سعيد السيرافي في هذه المناظرة إنما يُظهر موقفَ المتكلمين المعتزلة الرافض تماما لإدخال المنطق الأرسطي على قواعد اللغة. ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن المعتزلة، وخلاف ما هو شائع، هم ألد خصوم المنطق والفلسفة الأرسطيين؛ وهم في هذا على طرف النقيض من أبي المعالي الجويني (ت. 478هـ/1085م)، بل ومن أبي حامد الغزالي الفقيه الأصولي الذي أدخل المنطق على أصول الفقه والدين، ودافع عن المنطق الأرسطي دفاعا شديدا، معتقدا أن العلوم الإسلامية لن تقوم لها قائمة ولا موثوقية ما لم تحط بالمنطق.
وبالجملة، إن المناظرة بين السيرافي ومتى، إن صح حصولها على الوجه الذي توجد عليه عند التوحيدي لا تعني الفقهاء في شيء، فهي تظهر أساسا موقف اللغويين من المتكلمين المعتزلة من منطق أرسطو وفلسفته. وبسقوط هذا الدليل، تصبح دعواه (الممثل الحقيقي للعقل الإسلامي هم الفقهاء وليس الفلاسفة) بدون دليل؛ اللهم إلا أن يكون المقرئ الإدريسي يعتبر المعتزلة من زمرة الفقهاء عندما يعترضون على الفلسفة والمنطق الأرسطيين، ويعتبرهم فلاسفة عندما يحملون على الحنابلة وأصحاب الأثر. وهذا هو عين التشهّي. فما وافق هواه قبله وما خالفه رفضه.
خاتمة
يمكن لكتاب في التاريخ أن يقدمه فنان أو موسيقي أو روائي؛ ولكن هذا عادة ما يحصل عندما يكون الكتاب ثقافيا وموجها إلى شريحة واسعة من القراء. أما عندما يكون الكتاب جامعيا متخصصا، فمن باب الأولى أن يقدم له متخصص في المجال الذي ينتمي إليه الكتاب؛ ولا أظن أن الجهة الناشرة للأطروحة الجامعية لبوخبزة تخلو من متخصصين في الفلسفة وفي تاريخ التفاعل بين النظار المسلمين في الفترة الكلاسيكية المتأخرة. ومن هنا، فإننا نرى أن تقديم المقرئ الإدريسي لكتاب الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين قد يكون مفيدا من نواح بعينها، لكننا لا نرى له أي فائدة تذكر من الناحية الأكاديمية والعلمية الصرف؛ والسبب هو ما ورد في التقديم من أمور تدخل في صميم ما يسميه المقرئ الإدريسي نفسه بالتخرصات والأغاليط، وقد وقفنا عندها أعلاه. فقد حصل الزج بموضوع تاريخي في خضم سجالات وخصومات مع جهات لا اختصاص لها بالموضوع؛ والحال أن هذا الموضوع ليس في حاجة إلى دعاة يطلقون الأحكام دون سند بقدر ما هو في حاجة إلى مختصين (مؤرخين) يقيدون أحكامهم وخلاصاتهم بوثائق وشواهد ويراجعون أحكام غيرهم من الدارسين، غربيين ومسلمين وغيرهم. بعبارة أخرى، نحن نفهم المحركات الدعوية و”الاعتذارية“ apologetic التي تحرك المقرئ الإدريسي والأمين بوخبزة؛ لكننا نفهم أيضا أن للدعوة وللاعتذار منطقهما وأهلهما وخطابهما ومؤسساتهما، كما للبحث التاريخي منهجه وأهله وخطابه ومؤسساته. لذلك، يجدر بنا أن نؤكد، أخيرًا، أن المجال الذي كتب فيه بوخبزة، وقدّم له الإدريسي، ليس أرضا مشاعا يدخلها من يشاء ويتحرك فيها كما يشاء، وإنما هو مجال له تقاليده وأعرافه العلمية التي ينضبط لها أهله المتخصصون فيه من كل أنحاء العالم؛ وهو، أيضا، مجال لا تُقَوّم فيه الدراسات بدرجة الصخب الذي تثيره، وعِظَم الأحكام الذي ترسله، وإنما تُقوَّم فقط بالقياس إلى ما تحصل من تراكم علمي في ذلك المجال، وما سجلته فيه تلك الدراسات من جديد، بالقياس إلى ذلك التراكم بالذات، على مستوى جدة الوثائق ورصانة التحليل. ولذلك، أيضا، فإن المجال الذي كتب فيه بوخبزة ليس أرضًا خلاء، وإنما هو أرض مأهولة، على الدّاخل إليها أن ينضبط لمعايير البحث والتراكم العلمي المتعارف عليها دوليا، حتى يكون قوله مفيدا للناس ويمكث في الأرض؛ وهو ما سنعود إليه في وقفة ثانية.
تاريخ الأفكار في السياقات الإسلامية بين إكراهات البحث ورهانات الدعوة
في الرد على المقرئ أبي زيد الإدريسي
المقرئ أبو زيد الإدريسي سياسي وداعية مغربي معروف في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوماته وسجالاته مع من يختلف معهم ممن يتصور أنهم دعاة العلمانية والحداثة والفرنكفونية والتطبيع… وإلى ذلك، هو أستاذ بجامعة الحسن الثاني، متخصص في اللسانيات التراثية. كان قد أنجز أطروحة جامعية للحصول على دبلوم الدراسات العليا في تخصص اللسانيات، تحت عنوان: مقولة الحرف في اللغة العربية: دراسة نظرية في أجزاء الكلام، وقد ناقشها عام 1987. ولعل هذه الرسالة هي ما نشر، لاحقا، بعنوان، حروف المعاني في اللغة العربية: دراسة دلالية وتركيبية (الدار البيضاء: منشورات مؤسسة الإدريسي الفكرية للدراسات والأبحاث، 2016). وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل هو الوحيد الذي اطلعنا عليه للمقرئ الإدريسي في مجال اختصاصه الأكاديمي، بينما كل المنشورات الأخرى—وهي بالعشرات—تندرج في سياق الدعوة الدينية والتدافع السياسي.
ندرك جيدا أن السجالات الدعوية والخصومات الإيديولوجية لا تكسب صاحبها عادات مفيدة في البحث والنشر العلميين. لذلك، فإننا لا نريد الدخول في أي سجال مع المقرئ أبي زيد الإدريسي؛ إذ لا يهمنا من أنشطة الرجل الكثيرة إلا كونه ينتمي إلى الجامعة المغربية، ويدرك معنى التخصص العلمي؛ فهو، كما ذكرنا، قد أنجز بحثا على الأقل في مجالٍ تَخَصّصِيٍّ بعينه هو علم الدلالة خاصة، واللسانيات عامة؛ كما درّسه لسنوات. وعليه، فهذا هو المدخل الوحيد الذي نود أن نلج منه إلى مناقشته في بعض أحكامه، التي ضمنها تقديمه لكتاب الأمين بوخبزة، الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين: جدلية القبول والرفض (الرباط: منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2021). وبما أننا سنفرد لهذا الكتاب وقفة مستقلة، فإننا نكتفي بالقول إن هذا الأخير كان في الأصل رسالته الجامعية التي ناقشها في كلية دار العلوم بالقاهرة عام 1986 لنيل شهادة الماجستير؛ وإن الجهة التي نشرته إنما فعلت من جهة ما هو أطروحة جامعية. ولهذا السبب، أيضا، صار واجبا علينا، من الناحية العلمية، أن نتفاعل نقديا مع العمل مادام يخص مجالا بحثيا لنا فيه بعض المشاركة.
1. المسافة بين البحث والدعوة
يعرف المنتمون إلى مجال البحث الجامعي والأكاديمي أن من خصائص هذا الأخير النأيُ بالنفس عن الصراعات السياسية والخصومات الإيديولوجية والاتصاف، في المقابل وقدر الوسع، بقيم الحياد والموضوعية والهدوء وتقييد الأحكام بما يشهد لها؛ خاصة وأن ما يحرك الاشتغال العلمي، في مجال كهذا الذي ألف فيه الأمين بوخبزة، هو السعي إلى الفهم السليم متسلحا بالوثيقة والحجة التاريخيين. غير أن قارئ التقديم الذي قام به المقرئ الإدريسي لكتاب بوخبزة يدرك، من أول قراءة، أن السرعة التي كُتب بها لم تسعف صاحبه لتكييفه مع الغرض الذي من أجله أٌلِّف العمل، وهو غرض علمي أكاديمي في كل الأحوال. فقد كتب التقديم بغرض مواجهة ”السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي،“[1] وبلغة متشنجة، بل عنيفة؛ لذلك جاء مليئا بالأحكام غير المسددة والمتسرعة التي تحتاج مراجعة وتقويما. ولهذا، يحق للمرء المهتم بالموضوع الذي ألف فيه الكتاب أن يتساءل، هل هذا الأخير، وهو ذو طابع تاريخي، يتحمل كل أشكال التدليس والتزييف التي ضمنها المقرئ الإدريسي تقديمه؟ لماذا حصل ”استغلال“ الكتاب لتصفية حسابات غير علمية أفسدت النزاهة والجدة اللتين يفترض أن يتمتع بهما عمل أكاديمي-تاريخي؟ ألم يكن الأولى أن يحصل تقديم هذا العمل بطريقة تجعله مفيدا للمتخصصين من الدارسين والطلبة، طالما أن الموضوع لا يهم مباشرة الشأنين الدعوي والثقافي؟
يمكن للمرء أن يقول إن الأمر يتعلق باختيارات لا حق لنا فيها لتوجيه التقديم الوجهةَ التي نرتضيها لأنفسنا. بل أكثر من ذلك، يمكن للمرء أن يقول إن اللغة السّجالية والدعوية الواضحة التي كتب بها الكتاب نفسه قد شجعت المقرئ الإدريسي على مواصلة هذا الطريق في تقديمه لهذا العمل. لكن هذا الأخير يدرك أن الجانب الإيديولوجي من الباعث على البحث في الموضوع ما عاد قائما، أو على الأقل ما عاد بارزا كما كان الشأن في نهاية السبعينيات والثمانينيات، حتى تَحصل استعادتُه، كما لو كان مواجهةً معاصرة بين الدعاة من كل صنف. والحال أن الموضوع لا يستدعي سوى معالجة متأنية متسلحة برؤية علمية نزيهة وبوثائق تُسدّد ما يُشَيّدُ أو يُرَاجع من أحكام. وكما أشرنا من قبل، لن نقف، في هذه الورقة، عند محتويات كتاب بوخبزة، وإنما سنقف وقفة نقدية سريعة عند بعض الأحكام الجزافية وأشكال التلبيس والتدليس التي وردت على لسان المقرئ الإدريسي في تقديمه. ولذلك، وجوابا على الاعتراض الأول، نقول إنه ما كنا لنتوقف هذه الوقفة أصلا، لو لم يكن التقديم قد كتب لأطروحة جامعية، يُتوجه بها في المقام الأول إلى الباحثين والدارسين؛ والعمل الجامعي الأكاديمي يُفترض فيه أن يظل بعيدا عن السجالات الثقافية العامة.
يدرك المقرئ الإدريسي أن زمنا طويلا قد مر على تأليف بوخبزة عمله؛ وأن أمورا كثيرة قد استجدت في هذا المجال البحثي المحكوم أساسا بالوثائق وبالمخطوطات؛ ولعله يدرك أيضا أن دراسات كثيرة قد نشرت في الموضوع وبلغات البحث المختلفة (عربية وإنجليزية وإسبانية وفرنسية…)؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن رسالة بوخبزة في نظر المقرئ الإدريسي ”تتناول موضوعا لم يغير المناخ الثقافي والفكري والجامعي كثيرا من موقفه المجافي للحقيقة، إلا شيئا ضئيلا.“[2] ومع أن صاحب التقديم لم يأت بأمثلة تظهر هذا الثبات على الموقف الخاطئ في المناخ الثقافي والفكري والجامعي، فالظاهر أن ما يعنيه بهذا هو ما كان يروج في الفضاء الجامعي المغربي المشبع بالإيديولوجيات في زمن ما؛ وإلا فإن هذا الكلام يغدو متجاوزا، عندما نأخذ بعين الاعتبار أن المجالين التاريخي والجغرافي اللذين انشغلا بهما بحث بوخبزة قد عرفا تحولا كبيرا، بفضل ظهور مخطوطات جديدة وإخراجها ونشر دراسات ومونوغرافيات تغير كثيرا من مشهد غرب إسلامي دخل عصور الانحطاط بفعل انتصار ”الفقهاء“ وموت الفلسفة والعلوم العقلية… وطبعا ليس بوسع غير المتخصص أن يدرك هذا التحول، لأن ذلك يستدعي متابعة لكل ما يستجد في هذا الملف، بل وانخراطا علميا فيه؛ ولا شيء في تقديم الإدريسي يدل على هذا.
فما هو هذا الموقف الذي لم يتغير إلا قليلا؟ الظاهر أن ما لم يتغير في المناخ المذكور، حسب تقويم الإدريسي، هو الدعوى التي:
تفيد بأن الفقهاء ذوو عقلية جامدة جاهزة متحجرة متخشبة تخاف من التفكير وترفض الحرية، لا تؤمن بالعقل وتعكف على صنم النص، تحتكر الحقيقة وتعادي كل من يرمزون إلى معاني الحرية والإبداع والتفكير والخيال والاختراع والتطوير والحداثة والعقلانية واحترام العلم والمعرفة وتقدير الإنسان وقدراته الذاتية والتأمل في الملكوت الكوني بنظرة مجددة وتفكير حر؛ وتهيب بأن من يرمزون لكل هذا هم الفلاسفة.[3]
وبما أن ذلك المناخ لم يغير من دعواه تلك، فإن مبرر انتصاب بوخبزة إلى نشر عمله ما يزال قائما؛ وكما أن ذلك المناخ كان هو الدافع إلى نهوض هذا الأخير إلى الاعتراض على تلك الدعوى، كما يشرح هو نفسه في مقدمة عمله، فإن ثبات ذلك المناخ وجموده على دعواه تلك مبرر لنشر هذه الرسالة، ولتعزيزها من قِبَل الإدريسي بهذا التقديم.
وهذه الدعوى صادرة أساسا من ثلاثة أطراف يوحدهم العداء للدين الإسلامي، في نظر الإدريسي، وهم: العلمانيون، وأتباع المستشرقين، والمشتغلون بالفكر الفلسفي. ويظهر من كلام الإدريسي أن لا أحد نهض إلى مواجهة وتفكيك هذه الدعوى التي كانت سائدة في الأوساط الجامعية المغربية. يقول:
لم يستطع أحد أن يواجه السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي في توجه معاد للدين الإسلامي، وأن يقف في وجه سطوتهم التي رسخت مجموعة من المسبقات والأحكام الظالمة والجاهزة والمغرضة والمستفزة، بل أكاد أقول الكاذبة.[4]
ومن هنا أهمية الرسالة التي ألفها بوخبزة. وفي تقدير المقرئ الإدريسي، فقد ”ساهمت هذه الأطروحة مساهمة مباركة في تفكيك هذا التعميم وفي إبطال هذا الإطلاق، وفي رد حقيقة العلاقة —التي لا ننكر أنها كانت متوترة في عمومها بين الفقهاء والفلاسفة—إلى حجمها الطبيعي، مع السعي إلى بيان مقتضيات هذه العلاقة وخلفياتها وسياقاتها؛“[5] وخاصة في الغرب الإسلامي. وهذا التقييد المنهجي من قِبَل بوخبزة لبحثه بالفقهاء الأندلسيين خاصة، وبالغرب الإسلامي بشكل عام، هو أمر هام، لأن ”كل ما كان يروج منقولا عن المستشرقين المتحاملين المغرضين المتحيزين تحيزا سلبيا هو في أغلبه أمثلة مأخوذة من موقف فقهاء مشارقة من فلاسفة مشارقة.“[6] والحاصل أن إضافة ”موقف فقهاء الأندلس والغرب الإسلامي إلى هذا المشهد، لمما يساعد على مزيد من التدقيق والتحوط والضبط، وبيان الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة.“[7]
هذه، بالجملة، هي الدعوى العامة التي دافع عنها بوخبزة في رسالته، كما قدمها المقرئ أبو زيد الإدريسي. وليس مضمون هذه الدعوى هو ما يهمنا هنا، وإنما ما كتبه الإدريسي ”تعزيزا لأطروحة أخيه الفاضل الأستاذ الأمين مصطفى بوخبزة.“[8] لذلك، فما كتبه الإدريسي، في تقديمه، يدخل في باب نصرة الدعوى المركزية لبوخبزة عن طريق استعمال حجج وشواهد لم يأت بها هذا الأخير، أو لم يستثمرها استثمارا كافيا.
غير أن الإدريسي حتى وإن كان يصرح بأن القصد هو تعزيز أطروحة بوخبزة، فإن ما يأتي به على سبيل تلك الغاية يفيد خروجه عن الإطار العام الذي وضعه بوخبزة لرسالته. أول ما يظهر أن المقرئ الإدريسي يعتبر ثنائية الفقهاء والفلاسفة قاصرة، باعتبار أن ”الإسلام لا يقتصر في هذا السياق على هذه الثنائية وحدها، أقصد ثنائية فقهاء/ فلاسفة، بل يوجد فيه فلاسفة فقهاء مثل ابن رشد الحفيد [ت. 595هـ/1198م]. ويوجد فيه فقهاء فلاسفة مثل ابن تيمية [ت. 728هـ/1328م].“[9] وأما ”في العصر الحديث يوجد […] مفكرون مسلمون أصلاء؛“[10] غير أن الإدريسي لا يسميهم فلاسفة. وكما يتحرر المقرئ الإدريسي من ثنائية بوخبزة، يتحرر من الإطار الزمني الذي وضعه لبحثه، وهو القرنين السادس والسابع الهجريين، ومن الإطار الجغرافي الذي هو الغرب الإسلامي، فيجد القارئ حديثا عن المفكرين المنتمين إلى القرن الثالث الهجري (ابن حنبل، ت. 241هـ/855م)، بل وإلى العصر الحديث (محمد الغزالي (ت. 1996م)، ويوسف القرضاوي، وعبد الوهاب المسيري (ت. 2008)، ومحمد عمارة (ت. 2020م)، وسعيد رمضان البوطي (ت. 2013م)، ومحمد عمراني حنشي…)؛ وحديثا عن المناطق الجغرافية الأخرى من العالم الإسلامي .وباستثناء حنشي، فإن بقية الأسماء المذكورة مشرقية.
وهذا التحرر من الأطر والحدود التي وضعها بوخبزة لرسالته، بقدر ما يتصور المقرئ الإدريسي أنه يساعده على توفير رؤية أشمل للموضوع، يضعه في مآزق كبرى في تقديرنا. وأول المآزق أن هذه الأسماء كلها ليست من الفلاسفة ولا من الفقهاء بالمعنى الصناعي الاصطلاحي. وثاني المآزق أن تركيزه على الأسماء المشرقية يجعل تشديده ”على الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة“[11] في مهب الريح.
2. غموض، وتحقير للأديان والفلسفة، ودفاع عن القطيعة بين المغرب والمشرق
إن أحد مصادر الغموض في التقديم (وفي الرسالة معًا) هو أن صاحبه لم يكلف نفسه عناء التوضيح والتبيين والتحديد للموضوع الذي يتحدث عنه؛ بحيث لا يجد المرء أي بيان للمقصود بالفقهاء وللمقصود بالفلاسفة. وإذا كان بوخبزة يراهن على أن المقصود أوضح من أن يبين، فالظاهر أنه قد سقط في هذا ضحيةً لخصومه المذكورين الذين لا قِبَلَ لهم بالتمييز بين الفقهاء والمحدثين والمتكلمين؛ مع أن الدّارسين يعرفون أن صناعات هؤلاء وعلومهم ليست واحدة: فالمحدث ليس هو المتكلم، وهذا غير الفقيه… وأن إطلاق اسم الفقيه عليهم جميعا لا يكون إلا جهلا محضا أو تجوزا في غير محله. وهكذا فإن مسايرة بوخبزة كلام خصومه عن الفقهاء بإطلاق جعل رسالته تسقط في غموض شديد. مثال ذلك أن الرسالة تتحدث في العنوان، وفي الخاتمة، كما في ثنايا فصولها، عن الفقهاء الذين يمنعون النظر في العقائد، بينما يجد القارئ نفسه في فصول أخرى أمام نظار (أبو الحجاج يوسف المكلاتي (ت. 627هـ/1237م) مثلا) يدعون إلى النظر في العقائد على طريقة المتكلمين الأشاعرة المتأثرة بالفلسفة السينوية. وبدوره، لم يحاول المقرئ الإدريسي نهائيا توضيح مقصوده بالفقهاء وبالفلاسفة، فجاء كلامه عن هؤلاء في غاية اللبس، كما سنبين أدناه. ولذلك، فإذا كان لا ينتظر من غير المختص (حداثيا كان أو علمانيا أو غير ذلك) أن يميز بين الفقيه والمتكلم والمحدث—ويعرف أن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في موضوعات علم الحديث (كطرق تحمل الحديث والنظر في السند…)، كما أن المحدث حافظا كان أو غير ذلك، لا ينظر من جهة ما هو محدث في مسائل الفقه (العبادات والمعاملات…) وأن كلا من هذين لا ينظر من جهة ما هما كذلك في مسائل الكلام والعقائد، كحدث العالم والجوهر الفرد وخلق القرآن ورؤية الله يوم القيامة— فإن الدّارس المتخصص يفترض فيه أن يميز بينهم، وأن لا يخلط بينهم. وبالمناسبة، فإن أغلب المحدثين والفقهاء الذين لم تكن لهم مشاركة في علم الكلام ما كانوا يقبلون الخوض في مسائله، بل كانوا يعتبرونه خروجا عن العقيدة التوقيفية، وربما خروجا عن الدين نفسه، فما بالك أن يعتبروه رأس العلوم الدينية، على غرار ما فعل الغزالي في مقدمة المستصفى من علم الأصول. هذا بغض النظر عن طبيعة الكلام، هل هو معتزلي أو أشعري أو ماتريدي.
أمر آخر هالنا في التقديم، وهو تلك الأحكام الجزافية و”التحقيرية“ التي صدرت عن صاحبه في حق المسيحية وفي حق الفلسفة اليونانية. وهكذا، فنحن لا نتصور أن السخرية من المعتقدات والمذاهب القديمة، سواء كانت دينية أو فلسفية قد تسعف في بناء حوار عقلاني ولا في التأسيس لقول رشيد ومنصف. وإلا فما معنى أن يقول المقرئ الإدريسي، وهو الشخص الذي لا اختصاص علمي له في الأديان، إن ”دين المسيحية مبني على الجهل والعاطفية والخرافية“؟[12] فما هي الزاوية التي تخول للمقرئ الإدريسي الحكمَ على الديانة المسيحية بالجهل والخرافة؟ وفي كل الأحوال، لا نتصور أن يقبل مؤرخُ أديان أو مقارنٌ بينها بأحكام مثل هذه؛ أما المؤمن بدين الإسلام فتحول سماحته دون رمي الأديان الأخرى بما يخسس من قيمتها في نظر المؤمنين بها.
وما قد يقوله المختص في تاريخ الأديان أو المقارنة بينها، سيقوله مؤرخ الأفكار الفلسفية والعلمية، عندما يقرأ ما يلي: ”مرجعية الفيلسوف، لا أقول هي العقل، ولكن العقل اليوناني الذي كان يؤمن بنظريات عجيبة غريبة مضحكة مبنية يفسر بها نشأة الكون، ويفسر بها ظهور الأفلاك والكواكب، مثل نظرية الفيض التي تبناها الفلاسفة المسلمون المشاؤون نقلا عن فلاسفة الإغريق والتي هي مجرد تخرص.“[13] طبعا، يمكننا أن نفهم وصف الغزالي النظريات الكوسمولوجية للمشائين بالتحكمات والترهات…، فذلك سياق سجالي مخصوص ومعروف. ولكن من زاوية تاريخ الأفكار العلمية والفلسفية، لا موجب للمؤرخ بإطلاق أحكام قيمة على أفكار قديمة وتقويمها من زاوية ما آل إليه الفكر العلمي أو الفلسفي اليوم. هذا فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين المشائين ليسوا على مذهب كوسمولوجي واحد، حتى يوصفوا كلهم بالتخرّص، فابن رشد لم يقل بنظرية الفيض بينما قال بها أبو نصر الفارابي (ت. 339هـ/950م). والجدير بالتنبيه أن نظرية الفيض تعود في أصلها إلى أفلوطين (ت. 270م)، ولم يكن هذا فيلسوفا مشائيا. وعندما نستعيد هذا، فنحن لا نكشف جديدا، وإنما نُذَكّر بِما لا يسع المهتم الجهل به؛ وإلا فإنه ليس من النزاهة العلمية في شيء أن خلط غير المختص بين الفلاسفة وبين أقوالهم ومذاهبهم، بغرض الطعن في الفلسفة بإطلاق. ورحم الله ابن تيمية عندما قال: ”وأما نفي الفلسفة مطلقا أو إثباتها فلا يمكن، إذ ليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه ولا قول يتفقون عليه في الإلهيات والمعاد والنبوات والشرائع بل وفي الطبيعيات والرياضيات، بل ولا في كثير من المنطق؛ ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من الحسيات المشاهدة والعقليات التي لا ينازع فيها أحد.“[14]
ثم إن التمييز الجوهري بين عقلية المغربي والمشرقي ليس له أصل ولا أساس، فضلا عن أن المقرئ الإدريسي لم يكلف نفسه تحديد المعنى الذي يعطيه للعقلية: أهو معنى أنثربولوجي أم أنطلوجي أم سيكولوجي؟ هذا ويبدو أن صاحب التقديم يصادر على هذا التمييز دون أن يكلف نفسه التصريح بأصوله وبمصادره؛ ومعلوم عند القراء والمهتمين أن محمد عابد الجابري (ت. 2010) هو الذي كان قد رفع هذه الدعوى في زمن ما، وشُنِّع عليه الأمر حينئذ. وبالجملة، فلا أتصور عاقلا اليوم يقبل بالقول بوجود فرق نوعي بين عقلية المغربي والمشرقي.
3. التلبيس والتغيير في الأسماء: الطريق الملكي للتغليط
ما يهمنا الوقوف عنده في هذا الرد هو ذلك التلبيس والتشويش الذي أقحمه المقرئ الإدريسي على اسم الفيلسوف، وذلك عن طريق الخلط المقصود بينه وبين المتكلم تارة، وبينه وبين المفكر تارة أخرى. وإذا كان الخلط الأخير لا يستدعي كبير جهد لتبينه، فإننا سنضطر للتذكير ببعض الأوليات التي إن تبينت صار الخلط بين الفيلسوف والمتكلم حاصل أحد أمرين: إما الجهل بتاريخ العلمين أو الصناعتين، أعني الفلسفة وعلم الكلام؛ وإما القصد إلى التلبيس والتضليل؛ وهذا قصد غير شريف. وعليه، فإننا سنذكّر أدناه ببعض المقدمات المعروفة بالنسبة للمختصين؛ وسنقف عند الصنائع الأربع: الكلام والفلسفة (الإلهيات) والحديث والفقه من الناحية الدلالية، قبل أن نعرض، باختصار شديد، للتمييز بين الفلسفة والكلام والفقه من الناحية التاريخية.
يعرف محمد علي التهانوي (ت. 1158هـ/1745م) علم الكلام كما يلي: ”ويسمى بأصول الدين […] ويسمى بعلم التوحيد والصفات […] [وهو] العلم المتعلق […] بالأحكام الأصلية أي الاعتقادية.“[15] ويميز التهانوي علم الكلام عن الإلهيات، التي هي قسم من الفلسفة بالقول: ”يمتاز الكلام عن [العلم] الإلهي، باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام لا على قانون العقل، وافق الإسلام أو لا، كما في الإلهي.“[16] وهذا تمييز حاسم بين العلمين، بحيث يجعل الأول علما من علوم الدين، والعلم الآخر الإلهي علما عقليا؛ من غير أن يعني هذا أن علم الكلام غير عقلي، بل هو علم يجمع بين العقل والنقل في تدليلاته، وكما يقول التهانوي: و”أيضا دلائله [علم الكلام] يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل، وهي أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل.“[17] ويتبنى التهانوي الموقف الذي كان قد عبر عنه أبو حامد الغزالي (ت. 505هـ/1111م) في مقدمة المستصفى من علم الأصول، عندما اعتبر علم الكلام علما كليا فيما اعتبر بقية العلوم الدينية علوما جزئية وأنه رأسها،[18] إذ يقول: و”الكلام هو العلم الأعلى إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها […] فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق.“[19] وأما بخصوص موضوعات علم الكلام ومباحثه فيقول التهانوي: ”بالجملة فعلماء الإسلام قد دونوا لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله، وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد، علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها، ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا، فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد.“[20]
أما علم الحديث، و”يسمى بعلم الرواية والأخبار والآثار أيضا […] و[هو] علم تعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله.“[21] وهو، طبعا، غير علم الفقه الذي ”يسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا […]. وهو معرفة النفس ما لها وما عليها […]“ ويتميز علم الفقه عن علم الكلام بطبيعة تلك المعرفة؛ فـ”معرفة ما لها [النفس] وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح. ومعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام.“[22] ويضيف التهانوي مؤكدا على الطابع العملي للفقه: ”وقال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية [المكتسب] من أدلتها التفصيلية […]، فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا، وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.“[23] هذا، وقد جعل أصحاب الشافعي ”للفقه أربعة أركان: العبادات، والمعاملات، والمناكحات والعقوبات.“[24]
أما من الناحية التاريخية، وهي الزاوية التي يحب المقرئ الإدريسي أن يواجه خصومه بها، فالفيلسوف غير المتكلم والفلسفة غير علم الكلام. والتمييز بين الطرفين لا يحتاج الكثير من الجهد. تاريخيا، تعتبر الفلسفة علما إنسانيا لا تعلق له بدين ولا بلغة بعينها، وإن توافق الناس على أن منشأها اليونان بتأثير واقتباس من حضارات أخرى. لكن المعروف، أن المسلمين قد ورثوا هذا العلم من اليونان بعد أن انتقلت كتب هؤلاء وأعمالهم إلى مناطق دخلها المسلمون منذ عام 19 للهجرة (الإسكندرية، وجنديسابور، وأنطاكيا…) وتواصلت عمليات الاحتكاك والتفاعل مع مرور الوقت. وقد خلف المسلمون كتابات عديدة في هذه الصناعة. ويمكن التمثيل لهذا بكتابات الفيلسوفين أبي إسحاق الكندي (ت. 256هـ/873م) وأبي نصر الفارابي وغيرها… لكن المسلمين أيضا عرفوا ظهور علم لا يبعد أن يكون للديانات التي قبل الإسلام تأثير كبير فيه، وخاصة المسيحية… هذا مع أن بلورته قد حصلت في سياق إسلامي. وهذا العلم هو المعروف بعلم الكلام. وبطبيعة الحال، فإن سألت دارسا متخصصا في الدراسات الإسلامية عن علم الكلام لكان الجواب إنه علم ديني. وإن عدت إلى كتب القدماء، كأن نقول أبا حامد الغزالي مثلا، لقال لك إنه علم ديني، بل هو رأس العلوم الدينية، على ما ذكرنا أعلاه. وهو ما لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الفلسفة، التي لا تخلو من نفحات دينية موضوعا ومقاربة، لكن لا أحد اعتبرها علما دينيا أو شرعيا، كما هو شأن علم الكلام. فمن أين جاء هذا الخلط؟
جاء الخلط من أمور كثيرة، نحصيها في ثلاثة باختصار شديد:
أول الأمور، أن الفلسفة في السياقات الإسلامية، وخاصة بعد أبي علي ابن سينا (ت. 428هـ/1037م)، عرفت امتدادا وتأثيرا كبيرا، بحيث استطاعت أن تخترق حدود خصومها، وخاصة من الأشعرية. ومن شدة تعاطي هؤلاء للفلسفة، وخاصة في حلتها السينوية، كاد المرء أن لا يتبين أهذا الذي أنتجهُ متكلمون، كفخر الدين الرازي (ت. 606هـ/1209م) ونصير الدين الطوسي (ت. 672هـ/1274م)، هو علم كلام أم فلسفة أم هما معا. والمفارقة، أن الأشعرية، التي احتضنت الفلسفة السينوية وتغيرت في هويتها ومعالمها، هي التي اشتهرت أكثر من غيرها برد دعاوى الفلاسفة.
ثاني الأمور، أن الفلسفة قد توسع معناها لتغدو دلالتها تشمل النظر إلى العالم وإلى الكون. ومن هذه الناحية، يمكن للمرء أن يتحدث عن فلسفة الإسلام بمعنى نظرة الإسلام إلى العالم، لا بمعنى فلسفتي ابن سينا وابن رشد. وهنا صارت الفلسفة والفكر الإسلامي مترادفين.
ثالث الأمور، أن المسلمين وخاصة في العصر الحديث، وبعد أن رأوا بعض المستشرقين الكبار ينفون عن المسلمين الفلسفة بمعناها الصناعي المعروف، صاروا ابتداءً من الشيخ الأزهري مصطفى عبد الرازق (ت. 1947م) يبحثون عن العلوم التي أبدع فيها المسلمون، فوجدوا أنها أصول الفقه والتصوف وأصول الدين (علم الكلام)، فأسموها فلسفة، بل اعتبروها الفلسفة الحقيقية للإسلام الذي لا حاجة له وللمسلمين إلى علوم الأوائل. وهكذا، فقد صار محمد بن إدريس الشافعي (ت. 204هـ/820م) فيلسوفا رغما عن أنفه، وابن عربي المتصوف (ت. 638هـ/1240م) فيلسوفا رغم تخسيسه للفلسفة ولعقل الفلاسفة، وابن أبي دؤاد المعتزلي (ت. 240هـ/854م) والغزالي الأشعري وركن الدين ابن الملاحمي الخوارزمي المعتزلي (ت. 536هـ/1140م) فلاسفة رغم أنهم ألد خصوم الفلسفة والفلاسفة. ويجدر بنا أن نضيف هنا أن المعتزلة، وبسبب من دفاعهم عن العقل والتأويل العقلي، وظهور تأثرهم ببعض النظريات الفلسفية القديمة، عادة ما يُلحقهم الطلبة والمبتدئون بالفلاسفة؛ هذا مع أنهم، كما قلنا، كانوا علماء دين، وكان علمهم علما دينيا، بل هو رأس العلوم الدينية، الغرض منه إثبات العقائد الدينية؛ هذا فضلا عن خصومتهم للفلاسفة وردودهم عليهم وتمسكهم باستقلال طريقتهم وتميزها بوصفها طريق المسلمين عن طريقة الفلاسفة ومنهجم. ولطالما آخذوا الأشعرية، شافعية وأحنافا، لخلطهم طريقة الإسلام بطريقة المتفلسفة.
يتقصد المقرئ الإدريسي أن يُلبس على القارئ فيأخذ المتكلم بمعنى الفيلسوف عندما يريد أن يثبت تحامل الفلاسفة على الفقهاء، ويميز بينهما عندما يريد الدفاع عن الفقهاء ورد تهمة تحجرهم وامتحانهم الفلاسفة… أولا يقدم المقرئ الإدريسي أبا حامد الغزالي بوصفه فيلسوفا تارة وبوصفه شبه فيلسوف تارة أخرى، ليؤكد أن الفقيه لم يكن متحجرا؛ وثانيا، يبحث الإدريسي عن اسم فيلسوف امتحن الفقهاء، فلا يعثر على أي اسم من الفلاسفة الذين اعتدنا أن نعتبرهم كذلك؛ لكن بما أن المتكلمين عنده أقران الفلاسفة؛ فإنه وإن كان الذي أشرف على محنة ابن حنبل فقيه من المعتزلة الذين اشتهروا بكونهم خصوم الفلاسفة (وبخاصة الفلسفة والمنطق الأرسطيين)، فإنه في هذا السياق، يغدو المتكلمون والفلاسفة سواء. وإذا أخطأ المعتزلة، فالخطأ يتحمله الفلاسفة. ونورد أدناه بعض التفاصيل.
فلكي يدافع المقرئ أبو زيد الإدريسي عن انفتاح الفقيه وعقلانيته ويدفع عنه تهمة الانغلاق التي يصفه بها خصومه، اضطر إلى أن يعتبر الغزالي، وهو من أكبر من يمثل الفقهاء، من الفلاسفة تارة ويعتبره تارة أخرى متكلما قرينا للفلاسفة.[25] بل إن الإدريسي قدم حجة جديدة عادة ما أنكرها الناس على الغزالي، وهي دفاعه عن المنطق اليوناني بوصفه دليل انفتاحه. إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الأجناس الأدبية التي كتب فيها الغزالي، فإنه من باب الأولى أن نسميه أصوليا، وصوفيا، ومتكلما. لكن يصعب أن نسميه فيلسوفا بالمعنى الذي كان للفيلسوف في ذهن الغزالي وكتب ضده. إذ لا يعقل أن يرد الغزالي في تهافت الفلاسفة على الفلاسفة من منطلق جدلي كلامي، كما يقول هو نفسه، ونسميه نحن فيلسوفا، وإلا لزم عن ذلك أن يكون الغزالي يرد على نفسه أو أن نغير في الأسماء. أما إن قلنا إنه فيلسوف بمعنى أنه مفكر؛ فنحن بذلك نخرج عن الكلام الأكاديمي إلى الكلام الثقافي العام. وحتى وإن قلنا إن الغزالي متكلم متفلسف من جهة أنه قد قرأ الفلسفة السينوية ولخصها وتأثر بها ورد على الفلاسفة، فإنه، في كل الأحوال، ما كان ليرضى لنفسه أن يسمى فيلسوفا؛ ولنا في كتابالمنقذ من الضلال، وهو من كتابات الغزالي المتأخرة، خير مثال. ثم لا يكفي أن يكون الغزالي متكلما لكي يغدو فيلسوفا. فالفلسفة علم والكلام علم آخر، كما بينا أعلاه. ومن هذه الناحية، فإن الغزالي لم ينتقد الفلسفة ولم يرد على الفلاسفة، في تهافت الفلاسفة، من جهة أنه فقيه أصولي شافعي وإنما من جهة أنه متكلم؛ إذ ليس من مهام الفقيه أن يتكلم في الآراء الميتافيزيقية، ولا هو يملك العدة العلمية والمنهجية لهذا الرد. أما دفاع الغزالي عن المنطق للأصول كلاما وفقها، فلم يكن من جهة ما أن المنطق جزء فلسفة أو آلة مخصوصة بالفلسفة، وإنما من جهة ما هو آلة محايدة لا تعلق لها بالعقائد إثباتا أو إبطالا؛ وكذا من جهة أن المنطق يمكن أن ينقذ العلوم الشرعية التي تصور الغزالي أنها في أزمة، وربما قد تندثر ما لم تتمسك بالمنطق بوصفه الأصل في وثاقة كل علم وفي موثوقيته.
ويقول المقرئ الإدريسي:
لست أنكر أنه قد كان لبعض الفقهاء الذين استأسدوا في بعض البلاطات، واستفردوا بقلوب الملوك في بعض الدول شيء من العسف أو الانغلاق، أو شيء من قبيل ’المرء عدو لما جهل‘؛ ولكن ليس يعقل أن يسحب هذا الموقف على كل قبيل الفلاسفة في مواجهة قبيل الفقهاء. وإلا فسبحان الله، ويا للمفارقة والعجب! فإن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل.[26]
الحق أنه لا مجال للاعتراض على هذا القول في جملته، لأن صاحبه يقر بوجود أشكال من الانغلاق سائدة بين الفقهاء وأشكال من العسف صادرة عنهم في حق فلاسفة. كما لا يملك المرء سوى أن يوافق صاحب القول في أنه من غير المعقول أن نعمم حيث يجب التقييد. فلا الانفتاح صفة ملازمة لكل فيلسوف ولا الانغلاق صفة ملازمة لكل فقيه. إلى هنا، لا شيء يثير الانتباه، لأن مراجعة كتب التاريخ تؤكد بأنه لا مجال سوى لتقييد الأحكام. لكن سؤالنا هو: لماذا لجأ المقرئ الإدريسي إلى تغيير الأسماء في آخر سطر من الاقتباس أعلاه؟ لماذا لم يحتفظ باسم الفلاسفة طالما أنه يتحدث عنهم ويريد أن يقنعنا أنهم من نكل بالفقهاء؟ ولماذا أبدل هؤلاء باسم المفكرين، وهو يعلم أن هؤلاء غير أولئك، أو لنقل، على وجه الدقة، لماذا أبدل خاصا بعام أو جزءا بكل؟ ثم دعنا نسأل الإدريسي: من هم هؤلاء الفلاسفة يا رجل؟ دُلّنَا على اسم أو اسمين لفلاسفة استعملوا نفوذهم ليوقعوا بخصومهم ويقصوهم وينكبوا بهم، بل ويقتلوهم، حتى نطمئن لدعواك.
لم يورد المقرئ الإدريسي اسما واحدا من أسماء الفلاسفة ليستشهد به لدعواه الخطيرة تلك. لكنه، في المقابل، يقول في سياق التدليل لدعواه:
لم نسمع بفقيه بنى فرنا ليحرق فيه أعداءه، ولكن سمعنا بمعتزلي يدعي الحرية والعقل هو ابن أبي دؤاد القاضي والوزير، الذي بنى فرنا ليحرق فيه من يختلف معه من الفقهاء ومن السلف، لكنه هو أحرق فيه وقطع فيه تقطيعا قبل أن يحرق.[27]
إننا عندما نقرأ هذا الكلام الذي قدمه الإدريسي دليلا على تنكيل الفلاسفة بخصومهم الفقهاء ندرك تماما لماذا أقدم المقرئ الإدريسي على إبدال اسم الفلاسفة بالمفكرين، تحايلا على القارئ وتضليلا له. يقول المقرئ الإدريسي:
إن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل. من امتحن من؟ ابن حنبل أم المعتزلة؟ وهم الذين كانوا يكثرون من دعاوى العقل والحرية والتفكير؟ إن ما نعرفه تاريخيا، أن ابن حنبل هو الذي سجن وعذب…ويا سبحان الله اليوم ينسب سيد قطب [ت. 1966م] إلى قبيل ابن تيمية وابن حنبل. من سجن من؟ ومن حرض على من؟ القوميون والعقلانيون والإعلاميون والمفكرون الذين كانوا في حاشية عبد الناصر أم سيد قطب؟ سيد قطب هو الذي سجن، وهو الذي عذب عذابا لا قبل لأحد به.[28]
ليس غرضنا أن نشكك في ما حصل لهؤلاء الأعلام ولغيرهم من صنوف العذاب في تاريخ الإسلام وفي ظروف مختلفة يتداخل فيها ما هو ديني بما هو سياسي، وإنما غرضنا أن نتساءل: إذا كان سياق الكلام هو التقابل بين الفلاسفة والفقهاء، فلماذا يأبى الإدريسي إلا أن يغض النظر عن الفلاسفة، ليشرع في الحديث عن مفكري النظام الناصري …وعن المتكلمين المعتزلة، وخاصة أبي دؤاد، الذي غدا الممثل الوحيد للفلاسفة وللظلم الذي سلطوه على الفقهاء ممثلين في ابن حنبل؟ ثم ما هو مصدر الإدريسي في خبر بناء ابن أبي دؤاد فرنا لإحراق الخصوم وإحراقه فيه؟
بخصوص السؤال الأول، للأسف لم يسعفنا المقرئ الإدريسي بتفاصيل إضافية عن هؤلاء الشخصيات التي كانت حول الرئيس المصري السابق عبد الناصر (حكم بين 1956م و1970م)، فحال دون أن نتعرف فيهم إلى فيلسوف واحد نستطيع به أن نجد لكلامه وجاهة ما؛ لكن أن يمثل للفلاسفة الذين عاقبوا الفقهاء وقتلوهم بأبي دؤاد المعتزلي، فهو لعمري أمر في غاية السقوط. يمكن للمرء أن يبحث مطولا في كتب تاريخ الفلاسفة في السياقات الإسلامية ولن يعثر عن أحمد ابن أبي دؤاد؛ لأن هذا الأخير، كما يعرف أبو زيد جيدا، إنما هو من المتعاطين لعلم من علوم الدين، وهو علم الكلام على طريقة أهل الاعتزال، وإلى ذلك فهو فقيه وقاض،[29] وليس فيلسوفا؛ وأن موضع الخلاف العقدي بينه وبين ابن حنبل ليس موضوعا فلسفيا، بل موضوع من موضوعات علم الكلام؛ أعني أن الخلاف بين أحمد ابن أبي دؤاد وأحمد ابن حنبل إنما هو، نظريا، خلاف ديني بين عالمي دين واحد هو الإسلام. هذا مع أنه يصعب علينا اليوم أن نصدق أن الخلاف بخصوص خلق القرآن بين المعتزلة عموما وأحمد ابن حنبل وأسماء أخرى كان خلافا كلاميا خالصا؛ بل هو خلاف تداخل فيه ما هو سياسي بما هو ديني؛ وأن هذه المحنة لم تكن سوى وجهٍ من وجوه استخدام الدين لأغراض السلطة، على ما بين فهمي جدعان في عمله القيم عن المحنة.[30]
لكن عندما لا نتقدم فنحدد أولا ما نقصده بالفقهاء، يصير من حقنا أن نتحدث بإطلاق عن محنة الفقيه ابن حنبل مع المتكلم المعتزلي ابن أبي دؤاد؛ وننسى أو نذهل عن أن هذا الأخير هو أيضا فقيه مثله مثل خصمه، بل كان معروفا بالفقه في زمنه، تماما كما كان ابن حنبل معروفا بالحديث. وإلى ذلك، فإن هذا الأخير لم يمتحن لأنه فقيه، بمعنى أنه ما سُوئل من أجل فتوى في أمور المعاملات أو العبادات… وإنما من جهة قوله في أمور الاعتقادات (رؤية الله، وخلق القرآن…)، وهذه ليست موضوعات الفقيه وإنما موضوعات المتكلم، سواء أكان معتزليا أو أشعريا أو حنبليا أو ماتريديا.
ولا يملك المرء سوى أن يستغرب لقول المقرئ الإدريسي، وهو يحاول أن يقنع مخاطبه بأن ما سجل التاريخ هو محنة الفقهاء ”الموصومين“ بالنقل مع المفكرين الموسومين بالعقل، وكأن هؤلاء هم الفلاسفة الذين ذكرهم في دعواه. وموضع الاستغراب يقوم أساسا في هذه الأسماء التي أتى بها ليظهر كيف أن الفقهاء هم الذين كانوا ضحايا الفلاسفة. فقديما ابن حنبل عُذّب على يد المعتزلة؛ وزمنا بعده، ابتلي ابن تيمية بالباطنية وغلاة الصوفية؛ وحديثا عذب سيد قطب على يد نظام عبد الناصر بدعم وتحريض من الإعلاميين العقلانيين والمفكرين والقوميين. مغالطات المقرئ الإدريسي مكشوفة هنا، فحتى وإن سلمنا له بأن ابن حنبل فقيه وليس محدثا وصاحب قول في العقيدة، وأن ابن تيمية فقيه وليس متكلما حنبليا، وأن سيد قطب فقيه وليس مفكرا سلفيا، فإن المعتزلة والباطنية وغلاة الصوفية والإعلاميين والعقلانيين والمفكرين والقوميين ليسوا من الفلاسفة، في حدود ما نعلم. فهل يجب أن نحيلهم فلاسفةً رغما عنهم لكي تصح دعوى تنكيل الفلاسفة بالفقهاء؟
قد يعترض المقرئ الإدريسي فيقول إن الأمثلة التي سُقْتُها هنا إنما هي للمفكرين بعموم وليست للفلاسفة تحديدا، وأنا ما غيرت اسم الفلاسفة في الفقرة أعلاه إلا لهذا الغرض بالذات، أي ليستقيم لي الاستشهاد بهؤلاء. جوابنا إن الأمر غير ذلك، لأن ما سيترتب على هذه الأمثلة من حكم نهائي يُظهر، بما لا يدع مجالا للشك، أن حديث المقرئ الإدريسي إنما هو عن الفلاسفة بالمعنى الصناعي، وليس عن المفكرين عموما ولا عن المتكلمين. ويقول في خلاصته:
لو أردنا أن نسترسل في هذه المقارنة لخرجنا بخلاصة مفادها إن الذي تحجر على رأيه وغضب لنفسه وتصلب في موقفه وانغلق على ذاته وتعالى مدعيا الحقيقة هم الفلاسفة في الغالب. ولم يكتفوا بهذا، بل استعملوا نفوذهم حيثما كان لهم نفوذ، للإيقاع بخصومهم من الفقهاء، وللتضييق عليهم، وإقصائهم ونكبهم، والأمر قد يذهب إلى قتلهم.[31]
فكيف يستخلص المقرئ الإدريسي من أمثلة خاصة بالمعتزلة، وهم من المتكلمين، وبغلاة الباطنية وبمفكري النظام الناصري حكما خاصا بالفلاسفة؟ الظاهر أن ما يهم الإدريسي هو الدعوى وليس هو وجه دلالة الأدلة عليها. لا يهم الاسترسال في إيراد الأمثلة لنعرف أسماء هؤلاء الفلاسفة الذين استعملوا نفوذهم عند السلاطين والحكام والرؤساء، قديما وحديثا، للإيقاع بالفقهاء والتضييق عليهم وإقصائهم… ما يهم هو ”التصديق“ بأن الخلاصة النهائية تخص الفلاسفة، وليس غيرهم. ربما كان يجب أن نزيف التاريخ ونغير هوية هؤلاء الأعلام المذكورين ونحيلهم فلاسفةً عنوة حتى يستقيم حكم المقرئ الإدريسي؛ وإلا فإن الخلاصة أن هذا الأخير قد قرر حكما مسبقا دون أن يأتي بشاهد واحد يشهد لحكمه.
وأما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بمصادر الإدريسي في حكاياته، فإنه على الرغم من استثمار هذا الأخير معطيات وأخبارا شاذة وخطيرة جدا، من قبيل بناء أحمد بن أبي دواد فرنا ليحرق فيه من يختلف معه، وأنه في الأخير هو من أُحرق في ذلك الفرن بعد أن قطع تقطيعا، لا يمد قارئه بمصادر هذه الأخبار التي يبدو أنها قد اتصلت به سماعًا. والحال أن النصوص التاريخية والتراجم، في حدود ما وقفنا عليه، لا تتحدث عن فرن ولا عن حرق، وإنما تفيدنا أن أحمد بن أبي دؤاد قد أصيب بمرض الفالج الذي أعجزه وتوفي به ودفن في داره، على ما أورد الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت. 463هـ/1071م) في تاريخ بغداد.[32] فأن يدعي المقرئ الإدريسي هذا دون أن يأتي بشهادة واحدة ليس سوى تحكم في تقديرنا. غير أنه مما يجدر بنا الوقوف عنده أن الخطيب البغدادي، في آخر المدخل المخصص لابن أبي دؤاد، يورد حكاية طريفة ننقلها هنا للفائدة، علها تسعفنا في فك لغز المصدر الذي أفاد المقرئ الإدريسي بخبر فرن ابن أبي دؤاد واحتراقه بالنار.
أخبرنا أبو الحسين بن بشران المعدَّل، قال: حدّثنا عثمان بن أحمد الدّقّاق، قال: حدّثنا إسحاق ابن إبراهيم الُختُّلي، قال: حدّثني أبو يوسف يعقوب بن موسى بن الفيرزان ابن أخي معروف الكرخي، قال: رأيت فِي المنام كأني وأخًا لي نمر على نهر عِيسَى على الشّط وطرف عمامتي بيد أخي هذا، فبينما نحن نمشي إذا امرأة تقول لصديقي هَذَا: ما تدري ما حدث الليلة؟ أهلك اللَّه ابْن أَبِي دؤاد. فقلتُ أنا لها: وما كَانَ سبب هلاكه؟ قالت: أغضبَ اللّهَ عَلَيْهِ، فغضب عَلَيْهِ من فوق سبع سموات.
قَال إِسْحَاق: وحدثني يعقوب، قال أخبرني بعض أصحابنا، قال: كنت عند سفْيان بْن وكيع، فقال: تدرون ما رأيت الليلة؟ وكانت الليلة التي رأوا فيها النَّار بِبَغْدَادَ وغيرها: رأيت كَأنَّ جهنم زفرت فخرج منها اللهب، أو نحو هَذَا الكلام. فقلت: ما هذا؟ قال:أُعدت لابن أبي دؤاد.[33]
هنا تنتهي رواية الأحلام والمنامات والأماني؛ ونتصور أن ابن أبي دؤاد كان له خصوم كثر يتمنون لو يحرق في الدنيا قبل الآخرة، لذا حصل توهم أن جهنم تخرج إليه لهيبها يوم مماته، أو نحو هذا الكلام! أما في الدنيا، فالذي حصل، وفق رواية الإمام الحافظ البغدادي دائما، هو ما يلي:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم الأزهرى، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بْن محمد بن عَرَفَةَ الأَزْدِيُّ، قال: سنة أربعين ومائتين فيها مات أَحْمَد بن أبي دؤاد.
أخبرني الصَّيْمري، قال: حدّثنا المرزُباني، قال: أخبرنا محمّد بن يحيى الصولي، قال: حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي، قَالَ: مات أَبُو الوليد محمد ابن أحمد بن أبي دؤاد، وهو وأبوه منكوبان، فِي ذي الحجة سنة تسع وثلاثين ومائتين ومات أبوه في المحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع بقين منه، فكان بينه وبين ابنه أبي الوليد شهر أو نحوه.
قال الصولي: ودُفن فِي داره بِبغْداد وصلى عَلَيْهِ ابنه الْعَبَّاس.[34]
عندما نقارن هذا الكلام الوارد عند الخطيب البغدادي بالحكاية التي ”سمعها“ المقرئ الإدريسي ورواها بدون ذكره مصدره فيها، يترجح عندنا أن هذا الأخير قد تشابهت عليه أحداث المنامات والرؤى بالوقائع كما يرويها الإخباريون وأصحاب التراجم. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن الخوض في حوادث التاريخ لا يكون اعتمادا على ما قد يعلق بالذاكرة من قصص وروايات تختلط فيها الشجون بالأماني، وإنما اعتمادا على الوثائق والشواهد. وفي كل الأحوال، فإن المقرئ الإدريسي مطالب بالإدلاء بوثيقة تشهد لحادثة تقطيع ابن أبي دؤاد وإحراقه في الفرن الذي بناه خصيصا لإحراق خصومه، وإلا ظل كلامه تحكما بلا دليل، أو في أحسن الأحوال، تعبيرا عن أمنية.
4. كلود برنار وروجر بيكون: المشاحة في أسماء العلماء
من الملفت للانتباه حقا أنه على الرغم من تمسك المقرئ الإدريسي بأن المسلمين هم أرباب العقلانية الحقة، فإنه يعتبرهم أيضا، أرباب المنهج التجريبي وواضعيه؛ ويدلل الإدريسي قائلا: ”ودوننا أطروحة علي سامي النشار مناهج البحث عند مفكري الإسلام، التي تقادم على كتبها ستين عاما [كذا!] وما تقادمت أهميتها، والتي أثبت فيها أن المنهج التجريبي إنما وضعه المسلمون وتأخر عند الغرب إلى القرن التاسع عشر مع كلود برنارد(Claude Bernard) [في كتابه Introduction à l’étude de la médecine expérimentale، كما ورد في الهامش].“[35]
يحتاج هذا القول الغريب وقفة مطولة. لكن السياق لا يتحمل هذا، لذلك نرى أن نضع سؤالين على المقرئ الإدريسي: أولا: من هم المسلمون الذين تأثر بهم الغربيون؟ هل هم الفقهاء؟ أم هم أولئك الذين خاصمهم الفقهاء والمحدثون؟ وثانيا: أيعقل أن يقول طالب فلسفة (تاريخ العلوم) اليوم أن المنهج التجريبي قد تأخر ظهوره عند الغربيين إلى حدود القرن التاسع عشر؟ ثم، ثالثا، أين قرأ المقرئ الإدريسي هذا؟
قد يبدو السؤال الأخير حشوًا من قبلنا، ما دام المقرئ الإدريسي قد ذكر مصدَره، وهو رسالة مناهج البحث عند مفكري الإسلاملعلي سامي النشار (ت. 1980م). أقول إننا قد وضعنا هذا السؤال بالذات، لأننا ندرك أن الإدريسي قد أحال على عمل النشار، ولكن قصدنا أن نراجع عمل الأخير لنقف على أصل حجته.
في رسالته للحصول على الماجستير في مايو عام 1942م، والتي نشرها عام 1947م دونما تغيير ولا تبديل،[36] حاول علي سامي النشار جاهدا أن يثبت أن المسلمين لم يقبلوا منطق اليونان، لأنه كان يقوم على المنهج القياسي ولا يترك مجالا للتجربة،[37] التي تعبر عن حقيقة المنهج الإسلامي. ويقول النشار: ”قد وصل المسلمون إلى وضع هذا المنهج الاستقرائي الذي يقوم على التجربة. وهذا المنهج التجريبي هو المعبر عن روح الإسلام،“[38] بينما ”المنهج القياسي هو روح الحضارة اليونانية.“[39] ولا يحدد النشار من يقصد بهؤلاء المسلمين الذين وضعوا هذا المنهج التجريبي؛ لكنه يقرر أنهم قد وضعوه ”بجميع عناصره.“[40] ومن هؤلاء انتقل هذا المنهج إلى الأوربيين في القرن الثالث عشر. ولكي يثبت النشار هذه الدعوى يستشهد بكلام مفكرين مسلمين وأوروپبين. وهكذا، فقد شهد هؤلاء لاستمداد الفيلسوف الإنجليزي روجر بيكون (Roger Bacon, d. 1294) دراسته العلمية من ”الجامعات الإسلامية في الأندلس؛“[41] كما شهدوا أنه لم يكن سوى واسطة في إدخال المنهج التجريبي الإسلامي الأصل إلى أوروبا.
والملاحظ أنه لم يرد في أي موضع من كتاب سامي النشار المذكور أن المنهج التجريبي قد تأخر عند الغرب إلى حدود القرن التاسع عشر للميلاد، وأن الطبيب الفرنسي كلود برنار قد أخذ هذا المنهج عن المسلمين. فلقد تشابه على المقرئ الإدريسي كلود برنارد الذي عاش في القرن التاسع عشر (1813-1874) وروجر بيكون الذي عاش في القرن الثالث عشر. أيعقل أن يسقط الإدريسي ستة قرون كاملة من تاريخ الأفكار العلمية؟ أيعقل أن يغفل الإدريسي عن الفيلسوفين الإنجليزيين فرانسيس بيكون (Francis Bacon, d. 1626) وجون ستوارت ميل (John Stuart Mill, d. 1873)، وقد ورد ذكرهم في كتاب النشار الذي يحيل عليه؟ لا شيء يدل على أن الإدريسي قد راجع مناهج البحث لدى مفكري الإسلام عند كتابة تقديمه هذا والإحالة على النشار. ويجب أن نضيف أخيرا أنه ما كنا لنقف عند هذا الخلط بين الاسمين، بيكون وبرنار، إلا لأنه قد ترتّبَ على ذلك الخلط قول الإدريسي بتأخر الأوروبيين في اكتشاف المنهج التجريبي، مُسقطا، بذلك، ستة قرون كاملة من تاريخ العلوم، وإلا فإن الأخطاء والأوهام والهفوات من صميم البحث العلمي.
ولن ندخل في نقاش آخر بخصوص هؤلاء الذين أسماهم روجر بيكون بالعرب، وبأن علمهم هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. لن ندخل أيضا، في نقاش عن هذا العلم، هل كان علم الفقه؟ وعن أصحابه هل كانوا هم الفقهاء؟ مع أن المقرئ الإدريسي يقول بهذا. ولن ندخل في نقاش بخصوص الجامعات الإسلامية بالأندلس؛ لن ندخل في نقاش بخصوص كل هذه المسائل، لأنه سيخرجنا عن الغرض من هذه الورقة. لكننا نقول يصعب على المرء أن يكون مدققا ومتأنيا في أحكامه عندما يكون تحت إكراهات الدعوة والسجال.
- من يمثل العقل في الإسلام؟ دعوى بدون دليل
وفي الوقت الذي يشيد سامي النشار، ومعه الإدريسي، بالمنهج التجريبي الذي ابتكره العلماء المسلمون، واستفاد منه الأوروبيون؛ من دون أن تحصل تحديد هوية هؤلاء المسلمين وانشغالاتهم العلمية، مع أن المقصود بهم في تلك الاستشهادات التي أوردها النشار ليس الفقهاء ولا المحدّثون ولا المتكلمون، وإنما علماء المسلمين في الطبيعيات والكيمياء والنبات والطب والرياضيات، أمثال جابر ابن حيان (ت. 160هـ/815م)، والحسن ابن الهيثم (ت. 430هـ/1040م)، وغيرهما ممن كان على خصومة مع الفقهاء والمحدّثين الذين كان كثير منهم يعتبرون علوم هؤلاء غير نافعة في الآخرة. وفي كل الأحوال، فقد تدارك سامي النشار الأمر في طبعة ثانية عام 1965م لكتابه مناهج البحث لدى مفكري الإسلام؛[42] واضطر، في فصل جديد مخصص للمنهج التجريبي عند علماء المسلمين، أن يعترف بأن اليونان قد خبروا المنهج التجريبي، وأن العلماء المسلمين من أمثال ابن الهيثم وابن حيان وأبي الريحان البيروني (ت. 440هـ/1048م)… قد طوروه تطويرا كبيرا؛ ومن هؤلاء انتقل إلى أوروبا في القرن الثالث عشر بفضل جهود روجر بيكون وآخرين.
وعلى الرغم من هذا، فإن المقرئ الإدريسي يتمسك بالقول ”إن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة.“[43]وطبعا، يصعب على القارئ، وخاصة المتخصص، أن يدرك ما يقصده الإدريسي بهذا الكلام، ومن ثم أن يناقش مثل هذه القضايا العامة والغامضة. لكن الجدير بالذكر أن مثل هذه الأحكام بالذات هو ما كان يقرره المستشرقون في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أقصد أن حضارة الإسلام لا يمكن أن تقبل الفلسفة لأنها حضارة فقه ونقل وجزئيات؛ وأن الفلسفة الحقيقية للإسلام هي فلسفة القرآن؛ أما الفلسفة بوصفها فاعلية عقلية خالصة، فلا قبل للمسلمين بها.
وفي سياق الغموض دائما، لا يتردد المقرئ أبو زيد الإدريسي في الإشادة بعقلانية المعتزلة ذاهلا عن نقده لهم من جهة أنهم امتحنوا الفقهاء وأهل السلف. بل إنه يعتبر المتكلمين، إلى جانب الفقهاء والنحويين، هم أرباب العقلانية والتفكير الفلسفي في الإسلام؛ ويقول في هذا: ”العقلانية الحقيقية والتفكير الفلسفي الحقيقي هو في المناهج التي وضعها الأصوليون من أصول فقه، وأصول نحو وأصول دين.“[44] إن أصول الدين هو التسمية الأخرى لعلم الكلام، ليس أكثر؛ ومناهجهم في التأويل وفي الحديث وفي العقيدة وفي أمور أخرى لم يكن يقبلها كثير من الحنابلة وأهل السلف وغيرهم.
والظاهر أن المقرئ الإدريسي لا يبالي أن يكون المعترض على الفلسفة والفلاسفة متكلما أو فقيها أو محدثا؛ فالأهم عنده هو رد دعاوى الفلاسفة؛ وعندئذ فقط يصبح جميع هؤلاء داخلا تحت مظلة الفقيه. وهكذا، فلكي يثبت المقرئ الإدريسي دعواه، التي مفادها أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة، يروي لنا هذه الحكاية:[45]
لقد لخص لنا صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي [ت. 414هـ/1023م] […] المناظرة التاريخية التي جرت ليوم كامل بين أبي سعيد السيرافي [ت. 368هـ/978م] ومتى بن يونس القنائي المنطقي [ت. 328هـ/940م]، وفي محفل الوزير ابن سعدان وأمام جحفل من العلماء والنحاة والفلاسفة والمتكلمين والقراء؛ وهي مناظرة تنتهي إلى نتيجة ألجأَ فيها أبا [كذا! والصواب: ”أبو“]سعيد متى بن يونس القنائي إلى الزاوية وحصره فيها، مقنعا إياه بالحجة المقلوبة عليه من لسانه أنه كما قال له أبو سعيد: ”أنت إذن لست تدعونا إلى علم المنطق وإنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية،“ لأن لغة اليونانيين هي التي صاغت هذا الفكر! وهذا انتباه دقيق من أبي سعيد السيرافي.
لن ندخل في نقاش بخصوص علاقة اللغة بالفكر ولا بخصوص صِدقية واقعة المحاورة بين أبي سعيد ومتى، كما ولن نعترض على إسقاط تمثيلية العقل الحقيقي عند المسلمين عن الفلاسفة، وإنما سندخل في نقاش بخصوص وجه دلالة هذه الواقعة على الدعوى التي يدعيها المقرئ الإدريسي، وهي أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء. وفي الواقع، يصعب أن يساير المرء المستأنس بتاريخ علم الكلام وبردود المتكلمين على المناطقة ما يقوله المقرئ الإدريسي، لأنه يلفق في حججه ويزيف فيها؛ ذلك أن الشاهد الذي يقدمه هنا بوصفه الممثل لعقل الفقهاء في مواجهة عقل الفلاسفة لم يكن في هذه المناظرة فقيها متحدثا باسم علم الفقه، وإنما كان عالما لغويا ومتكلما معتزليا (ولنتذكر أن المتكلم عند المقرئ الإدريسي قرين الفيلسوف)؛ هذا دون أن ندعي أن السيرافي لم يكن له معرفة بالفقه؛ لكن كل ما نعرفه من أعماله اليوم إنما هي في علوم اللغة؛ وهذا أمر يعرفه المقرئ أبو زيد الإدريسي جيدا. وحتى وإن سلمنا أن أبا سعيد السيرافي كانت له مشاركة في الفقه، فإنه، أولا، كان فقيها معتزليا، مثله مثل أحمد ابن أبي دؤاد؛ وثانيا وأساسا، إن موضوع مناظرته مع متى لا يدخل، بأي وجه من الوجوه، ضمن موضوعات الفقه بمعناه الصناعي الذي يعرفه به أهله. إن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في علاقة الفكر باللغة ولا في علاقة المنطق بالنحو، وإنما ينظر في المعاملات والعبادات والمناكحات والعقوبات. أما الموضوع الذي دارت بخصوصه تلك المناظرة فهو يهم اللغويين والمناطقة بالأساس، أي أنه كان يهم السيرافي من حيث هو لغوي متكلم، ومتى ابن يونس من حيث هو منطقي أرسطي. ومن هذه الجهة، فإن الموقف الذي يعبر عنه أبو سعيد السيرافي في هذه المناظرة إنما يُظهر موقفَ المتكلمين المعتزلة الرافض تماما لإدخال المنطق الأرسطي على قواعد اللغة. ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن المعتزلة، وخلاف ما هو شائع، هم ألد خصوم المنطق والفلسفة الأرسطيين؛ وهم في هذا على طرف النقيض من أبي المعالي الجويني (ت. 478هـ/1085م)، بل ومن أبي حامد الغزالي الفقيه الأصولي الذي أدخل المنطق على أصول الفقه والدين، ودافع عن المنطق الأرسطي دفاعا شديدا، معتقدا أن العلوم الإسلامية لن تقوم لها قائمة ولا موثوقية ما لم تحط بالمنطق.
وبالجملة، إن المناظرة بين السيرافي ومتى، إن صح حصولها على الوجه الذي توجد عليه عند التوحيدي لا تعني الفقهاء في شيء، فهي تظهر أساسا موقف اللغويين من المتكلمين المعتزلة من منطق أرسطو وفلسفته. وبسقوط هذا الدليل، تصبح دعواه (الممثل الحقيقي للعقل الإسلامي هم الفقهاء وليس الفلاسفة) بدون دليل؛ اللهم إلا أن يكون المقرئ الإدريسي يعتبر المعتزلة من زمرة الفقهاء عندما يعترضون على الفلسفة والمنطق الأرسطيين، ويعتبرهم فلاسفة عندما يحملون على الحنابلة وأصحاب الأثر. وهذا هو عين التشهّي. فما وافق هواه قبله وما خالفه رفضه.
خاتمة
يمكن لكتاب في التاريخ أن يقدمه فنان أو موسيقي أو روائي؛ ولكن هذا عادة ما يحصل عندما يكون الكتاب ثقافيا وموجها إلى شريحة واسعة من القراء. أما عندما يكون الكتاب جامعيا متخصصا، فمن باب الأولى أن يقدم له متخصص في المجال الذي ينتمي إليه الكتاب؛ ولا أظن أن الجهة الناشرة للأطروحة الجامعية لبوخبزة تخلو من متخصصين في الفلسفة وفي تاريخ التفاعل بين النظار المسلمين في الفترة الكلاسيكية المتأخرة. ومن هنا، فإننا نرى أن تقديم المقرئ الإدريسي لكتاب الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين قد يكون مفيدا من نواح بعينها، لكننا لا نرى له أي فائدة تذكر من الناحية الأكاديمية والعلمية الصرف؛ والسبب هو ما ورد في التقديم من أمور تدخل في صميم ما يسميه المقرئ الإدريسي نفسه بالتخرصات والأغاليط، وقد وقفنا عندها أعلاه. فقد حصل الزج بموضوع تاريخي في خضم سجالات وخصومات مع جهات لا اختصاص لها بالموضوع؛ والحال أن هذا الموضوع ليس في حاجة إلى دعاة يطلقون الأحكام دون سند بقدر ما هو في حاجة إلى مختصين (مؤرخين) يقيدون أحكامهم وخلاصاتهم بوثائق وشواهد ويراجعون أحكام غيرهم من الدارسين، غربيين ومسلمين وغيرهم. بعبارة أخرى، نحن نفهم المحركات الدعوية و”الاعتذارية“ apologetic التي تحرك المقرئ الإدريسي والأمين بوخبزة؛ لكننا نفهم أيضا أن للدعوة وللاعتذار منطقهما وأهلهما وخطابهما ومؤسساتهما، كما للبحث التاريخي منهجه وأهله وخطابه ومؤسساته. لذلك، يجدر بنا أن نؤكد، أخيرًا، أن المجال الذي كتب فيه بوخبزة، وقدّم له الإدريسي، ليس أرضا مشاعا يدخلها من يشاء ويتحرك فيها كما يشاء، وإنما هو مجال له تقاليده وأعرافه العلمية التي ينضبط لها أهله المتخصصون فيه من كل أنحاء العالم؛ وهو، أيضا، مجال لا تُقَوّم فيه الدراسات بدرجة الصخب الذي تثيره، وعِظَم الأحكام الذي ترسله، وإنما تُقوَّم فقط بالقياس إلى ما تحصل من تراكم علمي في ذلك المجال، وما سجلته فيه تلك الدراسات من جديد، بالقياس إلى ذلك التراكم بالذات، على مستوى جدة الوثائق ورصانة التحليل. ولذلك، أيضا، فإن المجال الذي كتب فيه بوخبزة ليس أرضًا خلاء، وإنما هو أرض مأهولة، على الدّاخل إليها أن ينضبط لمعايير البحث والتراكم العلمي المتعارف عليها دوليا، حتى يكون قوله مفيدا للناس ويمكث في الأرض؛ وهو ما سنعود إليه في وقفة ثانية.
تاريخ الأفكار في السياقات الإسلامية بين إكراهات البحث ورهانات الدعوة
في الرد على المقرئ أبي زيد الإدريسي
المقرئ أبو زيد الإدريسي سياسي وداعية مغربي معروف في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوماته وسجالاته مع من يختلف معهم ممن يتصور أنهم دعاة العلمانية والحداثة والفرنكفونية والتطبيع… وإلى ذلك، هو أستاذ بجامعة الحسن الثاني، متخصص في اللسانيات التراثية. كان قد أنجز أطروحة جامعية للحصول على دبلوم الدراسات العليا في تخصص اللسانيات، تحت عنوان: مقولة الحرف في اللغة العربية: دراسة نظرية في أجزاء الكلام، وقد ناقشها عام 1987. ولعل هذه الرسالة هي ما نشر، لاحقا، بعنوان، حروف المعاني في اللغة العربية: دراسة دلالية وتركيبية (الدار البيضاء: منشورات مؤسسة الإدريسي الفكرية للدراسات والأبحاث، 2016). وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل هو الوحيد الذي اطلعنا عليه للمقرئ الإدريسي في مجال اختصاصه الأكاديمي، بينما كل المنشورات الأخرى—وهي بالعشرات—تندرج في سياق الدعوة الدينية والتدافع السياسي.
ندرك جيدا أن السجالات الدعوية والخصومات الإيديولوجية لا تكسب صاحبها عادات مفيدة في البحث والنشر العلميين. لذلك، فإننا لا نريد الدخول في أي سجال مع المقرئ أبي زيد الإدريسي؛ إذ لا يهمنا من أنشطة الرجل الكثيرة إلا كونه ينتمي إلى الجامعة المغربية، ويدرك معنى التخصص العلمي؛ فهو، كما ذكرنا، قد أنجز بحثا على الأقل في مجالٍ تَخَصّصِيٍّ بعينه هو علم الدلالة خاصة، واللسانيات عامة؛ كما درّسه لسنوات. وعليه، فهذا هو المدخل الوحيد الذي نود أن نلج منه إلى مناقشته في بعض أحكامه، التي ضمنها تقديمه لكتاب الأمين بوخبزة، الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين: جدلية القبول والرفض (الرباط: منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2021). وبما أننا سنفرد لهذا الكتاب وقفة مستقلة، فإننا نكتفي بالقول إن هذا الأخير كان في الأصل رسالته الجامعية التي ناقشها في كلية دار العلوم بالقاهرة عام 1986 لنيل شهادة الماجستير؛ وإن الجهة التي نشرته إنما فعلت من جهة ما هو أطروحة جامعية. ولهذا السبب، أيضا، صار واجبا علينا، من الناحية العلمية، أن نتفاعل نقديا مع العمل مادام يخص مجالا بحثيا لنا فيه بعض المشاركة.
1. المسافة بين البحث والدعوة
يعرف المنتمون إلى مجال البحث الجامعي والأكاديمي أن من خصائص هذا الأخير النأيُ بالنفس عن الصراعات السياسية والخصومات الإيديولوجية والاتصاف، في المقابل وقدر الوسع، بقيم الحياد والموضوعية والهدوء وتقييد الأحكام بما يشهد لها؛ خاصة وأن ما يحرك الاشتغال العلمي، في مجال كهذا الذي ألف فيه الأمين بوخبزة، هو السعي إلى الفهم السليم متسلحا بالوثيقة والحجة التاريخيين. غير أن قارئ التقديم الذي قام به المقرئ الإدريسي لكتاب بوخبزة يدرك، من أول قراءة، أن السرعة التي كُتب بها لم تسعف صاحبه لتكييفه مع الغرض الذي من أجله أٌلِّف العمل، وهو غرض علمي أكاديمي في كل الأحوال. فقد كتب التقديم بغرض مواجهة ”السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي،“[1] وبلغة متشنجة، بل عنيفة؛ لذلك جاء مليئا بالأحكام غير المسددة والمتسرعة التي تحتاج مراجعة وتقويما. ولهذا، يحق للمرء المهتم بالموضوع الذي ألف فيه الكتاب أن يتساءل، هل هذا الأخير، وهو ذو طابع تاريخي، يتحمل كل أشكال التدليس والتزييف التي ضمنها المقرئ الإدريسي تقديمه؟ لماذا حصل ”استغلال“ الكتاب لتصفية حسابات غير علمية أفسدت النزاهة والجدة اللتين يفترض أن يتمتع بهما عمل أكاديمي-تاريخي؟ ألم يكن الأولى أن يحصل تقديم هذا العمل بطريقة تجعله مفيدا للمتخصصين من الدارسين والطلبة، طالما أن الموضوع لا يهم مباشرة الشأنين الدعوي والثقافي؟
يمكن للمرء أن يقول إن الأمر يتعلق باختيارات لا حق لنا فيها لتوجيه التقديم الوجهةَ التي نرتضيها لأنفسنا. بل أكثر من ذلك، يمكن للمرء أن يقول إن اللغة السّجالية والدعوية الواضحة التي كتب بها الكتاب نفسه قد شجعت المقرئ الإدريسي على مواصلة هذا الطريق في تقديمه لهذا العمل. لكن هذا الأخير يدرك أن الجانب الإيديولوجي من الباعث على البحث في الموضوع ما عاد قائما، أو على الأقل ما عاد بارزا كما كان الشأن في نهاية السبعينيات والثمانينيات، حتى تَحصل استعادتُه، كما لو كان مواجهةً معاصرة بين الدعاة من كل صنف. والحال أن الموضوع لا يستدعي سوى معالجة متأنية متسلحة برؤية علمية نزيهة وبوثائق تُسدّد ما يُشَيّدُ أو يُرَاجع من أحكام. وكما أشرنا من قبل، لن نقف، في هذه الورقة، عند محتويات كتاب بوخبزة، وإنما سنقف وقفة نقدية سريعة عند بعض الأحكام الجزافية وأشكال التلبيس والتدليس التي وردت على لسان المقرئ الإدريسي في تقديمه. ولذلك، وجوابا على الاعتراض الأول، نقول إنه ما كنا لنتوقف هذه الوقفة أصلا، لو لم يكن التقديم قد كتب لأطروحة جامعية، يُتوجه بها في المقام الأول إلى الباحثين والدارسين؛ والعمل الجامعي الأكاديمي يُفترض فيه أن يظل بعيدا عن السجالات الثقافية العامة.
يدرك المقرئ الإدريسي أن زمنا طويلا قد مر على تأليف بوخبزة عمله؛ وأن أمورا كثيرة قد استجدت في هذا المجال البحثي المحكوم أساسا بالوثائق وبالمخطوطات؛ ولعله يدرك أيضا أن دراسات كثيرة قد نشرت في الموضوع وبلغات البحث المختلفة (عربية وإنجليزية وإسبانية وفرنسية…)؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن رسالة بوخبزة في نظر المقرئ الإدريسي ”تتناول موضوعا لم يغير المناخ الثقافي والفكري والجامعي كثيرا من موقفه المجافي للحقيقة، إلا شيئا ضئيلا.“[2] ومع أن صاحب التقديم لم يأت بأمثلة تظهر هذا الثبات على الموقف الخاطئ في المناخ الثقافي والفكري والجامعي، فالظاهر أن ما يعنيه بهذا هو ما كان يروج في الفضاء الجامعي المغربي المشبع بالإيديولوجيات في زمن ما؛ وإلا فإن هذا الكلام يغدو متجاوزا، عندما نأخذ بعين الاعتبار أن المجالين التاريخي والجغرافي اللذين انشغلا بهما بحث بوخبزة قد عرفا تحولا كبيرا، بفضل ظهور مخطوطات جديدة وإخراجها ونشر دراسات ومونوغرافيات تغير كثيرا من مشهد غرب إسلامي دخل عصور الانحطاط بفعل انتصار ”الفقهاء“ وموت الفلسفة والعلوم العقلية… وطبعا ليس بوسع غير المتخصص أن يدرك هذا التحول، لأن ذلك يستدعي متابعة لكل ما يستجد في هذا الملف، بل وانخراطا علميا فيه؛ ولا شيء في تقديم الإدريسي يدل على هذا.
فما هو هذا الموقف الذي لم يتغير إلا قليلا؟ الظاهر أن ما لم يتغير في المناخ المذكور، حسب تقويم الإدريسي، هو الدعوى التي:
تفيد بأن الفقهاء ذوو عقلية جامدة جاهزة متحجرة متخشبة تخاف من التفكير وترفض الحرية، لا تؤمن بالعقل وتعكف على صنم النص، تحتكر الحقيقة وتعادي كل من يرمزون إلى معاني الحرية والإبداع والتفكير والخيال والاختراع والتطوير والحداثة والعقلانية واحترام العلم والمعرفة وتقدير الإنسان وقدراته الذاتية والتأمل في الملكوت الكوني بنظرة مجددة وتفكير حر؛ وتهيب بأن من يرمزون لكل هذا هم الفلاسفة.[3]
وبما أن ذلك المناخ لم يغير من دعواه تلك، فإن مبرر انتصاب بوخبزة إلى نشر عمله ما يزال قائما؛ وكما أن ذلك المناخ كان هو الدافع إلى نهوض هذا الأخير إلى الاعتراض على تلك الدعوى، كما يشرح هو نفسه في مقدمة عمله، فإن ثبات ذلك المناخ وجموده على دعواه تلك مبرر لنشر هذه الرسالة، ولتعزيزها من قِبَل الإدريسي بهذا التقديم.
وهذه الدعوى صادرة أساسا من ثلاثة أطراف يوحدهم العداء للدين الإسلامي، في نظر الإدريسي، وهم: العلمانيون، وأتباع المستشرقين، والمشتغلون بالفكر الفلسفي. ويظهر من كلام الإدريسي أن لا أحد نهض إلى مواجهة وتفكيك هذه الدعوى التي كانت سائدة في الأوساط الجامعية المغربية. يقول:
لم يستطع أحد أن يواجه السطوة المتغولة للعلمانيين وأتباع المستشرقين، والمشتغلين بالفكر الفلسفي في توجه معاد للدين الإسلامي، وأن يقف في وجه سطوتهم التي رسخت مجموعة من المسبقات والأحكام الظالمة والجاهزة والمغرضة والمستفزة، بل أكاد أقول الكاذبة.[4]
ومن هنا أهمية الرسالة التي ألفها بوخبزة. وفي تقدير المقرئ الإدريسي، فقد ”ساهمت هذه الأطروحة مساهمة مباركة في تفكيك هذا التعميم وفي إبطال هذا الإطلاق، وفي رد حقيقة العلاقة —التي لا ننكر أنها كانت متوترة في عمومها بين الفقهاء والفلاسفة—إلى حجمها الطبيعي، مع السعي إلى بيان مقتضيات هذه العلاقة وخلفياتها وسياقاتها؛“[5] وخاصة في الغرب الإسلامي. وهذا التقييد المنهجي من قِبَل بوخبزة لبحثه بالفقهاء الأندلسيين خاصة، وبالغرب الإسلامي بشكل عام، هو أمر هام، لأن ”كل ما كان يروج منقولا عن المستشرقين المتحاملين المغرضين المتحيزين تحيزا سلبيا هو في أغلبه أمثلة مأخوذة من موقف فقهاء مشارقة من فلاسفة مشارقة.“[6] والحاصل أن إضافة ”موقف فقهاء الأندلس والغرب الإسلامي إلى هذا المشهد، لمما يساعد على مزيد من التدقيق والتحوط والضبط، وبيان الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة.“[7]
هذه، بالجملة، هي الدعوى العامة التي دافع عنها بوخبزة في رسالته، كما قدمها المقرئ أبو زيد الإدريسي. وليس مضمون هذه الدعوى هو ما يهمنا هنا، وإنما ما كتبه الإدريسي ”تعزيزا لأطروحة أخيه الفاضل الأستاذ الأمين مصطفى بوخبزة.“[8] لذلك، فما كتبه الإدريسي، في تقديمه، يدخل في باب نصرة الدعوى المركزية لبوخبزة عن طريق استعمال حجج وشواهد لم يأت بها هذا الأخير، أو لم يستثمرها استثمارا كافيا.
غير أن الإدريسي حتى وإن كان يصرح بأن القصد هو تعزيز أطروحة بوخبزة، فإن ما يأتي به على سبيل تلك الغاية يفيد خروجه عن الإطار العام الذي وضعه بوخبزة لرسالته. أول ما يظهر أن المقرئ الإدريسي يعتبر ثنائية الفقهاء والفلاسفة قاصرة، باعتبار أن ”الإسلام لا يقتصر في هذا السياق على هذه الثنائية وحدها، أقصد ثنائية فقهاء/ فلاسفة، بل يوجد فيه فلاسفة فقهاء مثل ابن رشد الحفيد [ت. 595هـ/1198م]. ويوجد فيه فقهاء فلاسفة مثل ابن تيمية [ت. 728هـ/1328م].“[9] وأما ”في العصر الحديث يوجد […] مفكرون مسلمون أصلاء؛“[10] غير أن الإدريسي لا يسميهم فلاسفة. وكما يتحرر المقرئ الإدريسي من ثنائية بوخبزة، يتحرر من الإطار الزمني الذي وضعه لبحثه، وهو القرنين السادس والسابع الهجريين، ومن الإطار الجغرافي الذي هو الغرب الإسلامي، فيجد القارئ حديثا عن المفكرين المنتمين إلى القرن الثالث الهجري (ابن حنبل، ت. 241هـ/855م)، بل وإلى العصر الحديث (محمد الغزالي (ت. 1996م)، ويوسف القرضاوي، وعبد الوهاب المسيري (ت. 2008)، ومحمد عمارة (ت. 2020م)، وسعيد رمضان البوطي (ت. 2013م)، ومحمد عمراني حنشي…)؛ وحديثا عن المناطق الجغرافية الأخرى من العالم الإسلامي .وباستثناء حنشي، فإن بقية الأسماء المذكورة مشرقية.
وهذا التحرر من الأطر والحدود التي وضعها بوخبزة لرسالته، بقدر ما يتصور المقرئ الإدريسي أنه يساعده على توفير رؤية أشمل للموضوع، يضعه في مآزق كبرى في تقديرنا. وأول المآزق أن هذه الأسماء كلها ليست من الفلاسفة ولا من الفقهاء بالمعنى الصناعي الاصطلاحي. وثاني المآزق أن تركيزه على الأسماء المشرقية يجعل تشديده ”على الفرق النوعي بين عقلية المشارقة والمغاربة، سواء منهم الفقهاء أو الفلاسفة“[11] في مهب الريح.
2. غموض، وتحقير للأديان والفلسفة، ودفاع عن القطيعة بين المغرب والمشرق
إن أحد مصادر الغموض في التقديم (وفي الرسالة معًا) هو أن صاحبه لم يكلف نفسه عناء التوضيح والتبيين والتحديد للموضوع الذي يتحدث عنه؛ بحيث لا يجد المرء أي بيان للمقصود بالفقهاء وللمقصود بالفلاسفة. وإذا كان بوخبزة يراهن على أن المقصود أوضح من أن يبين، فالظاهر أنه قد سقط في هذا ضحيةً لخصومه المذكورين الذين لا قِبَلَ لهم بالتمييز بين الفقهاء والمحدثين والمتكلمين؛ مع أن الدّارسين يعرفون أن صناعات هؤلاء وعلومهم ليست واحدة: فالمحدث ليس هو المتكلم، وهذا غير الفقيه… وأن إطلاق اسم الفقيه عليهم جميعا لا يكون إلا جهلا محضا أو تجوزا في غير محله. وهكذا فإن مسايرة بوخبزة كلام خصومه عن الفقهاء بإطلاق جعل رسالته تسقط في غموض شديد. مثال ذلك أن الرسالة تتحدث في العنوان، وفي الخاتمة، كما في ثنايا فصولها، عن الفقهاء الذين يمنعون النظر في العقائد، بينما يجد القارئ نفسه في فصول أخرى أمام نظار (أبو الحجاج يوسف المكلاتي (ت. 627هـ/1237م) مثلا) يدعون إلى النظر في العقائد على طريقة المتكلمين الأشاعرة المتأثرة بالفلسفة السينوية. وبدوره، لم يحاول المقرئ الإدريسي نهائيا توضيح مقصوده بالفقهاء وبالفلاسفة، فجاء كلامه عن هؤلاء في غاية اللبس، كما سنبين أدناه. ولذلك، فإذا كان لا ينتظر من غير المختص (حداثيا كان أو علمانيا أو غير ذلك) أن يميز بين الفقيه والمتكلم والمحدث—ويعرف أن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في موضوعات علم الحديث (كطرق تحمل الحديث والنظر في السند…)، كما أن المحدث حافظا كان أو غير ذلك، لا ينظر من جهة ما هو محدث في مسائل الفقه (العبادات والمعاملات…) وأن كلا من هذين لا ينظر من جهة ما هما كذلك في مسائل الكلام والعقائد، كحدث العالم والجوهر الفرد وخلق القرآن ورؤية الله يوم القيامة— فإن الدّارس المتخصص يفترض فيه أن يميز بينهم، وأن لا يخلط بينهم. وبالمناسبة، فإن أغلب المحدثين والفقهاء الذين لم تكن لهم مشاركة في علم الكلام ما كانوا يقبلون الخوض في مسائله، بل كانوا يعتبرونه خروجا عن العقيدة التوقيفية، وربما خروجا عن الدين نفسه، فما بالك أن يعتبروه رأس العلوم الدينية، على غرار ما فعل الغزالي في مقدمة المستصفى من علم الأصول. هذا بغض النظر عن طبيعة الكلام، هل هو معتزلي أو أشعري أو ماتريدي.
أمر آخر هالنا في التقديم، وهو تلك الأحكام الجزافية و”التحقيرية“ التي صدرت عن صاحبه في حق المسيحية وفي حق الفلسفة اليونانية. وهكذا، فنحن لا نتصور أن السخرية من المعتقدات والمذاهب القديمة، سواء كانت دينية أو فلسفية قد تسعف في بناء حوار عقلاني ولا في التأسيس لقول رشيد ومنصف. وإلا فما معنى أن يقول المقرئ الإدريسي، وهو الشخص الذي لا اختصاص علمي له في الأديان، إن ”دين المسيحية مبني على الجهل والعاطفية والخرافية“؟[12] فما هي الزاوية التي تخول للمقرئ الإدريسي الحكمَ على الديانة المسيحية بالجهل والخرافة؟ وفي كل الأحوال، لا نتصور أن يقبل مؤرخُ أديان أو مقارنٌ بينها بأحكام مثل هذه؛ أما المؤمن بدين الإسلام فتحول سماحته دون رمي الأديان الأخرى بما يخسس من قيمتها في نظر المؤمنين بها.
وما قد يقوله المختص في تاريخ الأديان أو المقارنة بينها، سيقوله مؤرخ الأفكار الفلسفية والعلمية، عندما يقرأ ما يلي: ”مرجعية الفيلسوف، لا أقول هي العقل، ولكن العقل اليوناني الذي كان يؤمن بنظريات عجيبة غريبة مضحكة مبنية يفسر بها نشأة الكون، ويفسر بها ظهور الأفلاك والكواكب، مثل نظرية الفيض التي تبناها الفلاسفة المسلمون المشاؤون نقلا عن فلاسفة الإغريق والتي هي مجرد تخرص.“[13] طبعا، يمكننا أن نفهم وصف الغزالي النظريات الكوسمولوجية للمشائين بالتحكمات والترهات…، فذلك سياق سجالي مخصوص ومعروف. ولكن من زاوية تاريخ الأفكار العلمية والفلسفية، لا موجب للمؤرخ بإطلاق أحكام قيمة على أفكار قديمة وتقويمها من زاوية ما آل إليه الفكر العلمي أو الفلسفي اليوم. هذا فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين المشائين ليسوا على مذهب كوسمولوجي واحد، حتى يوصفوا كلهم بالتخرّص، فابن رشد لم يقل بنظرية الفيض بينما قال بها أبو نصر الفارابي (ت. 339هـ/950م). والجدير بالتنبيه أن نظرية الفيض تعود في أصلها إلى أفلوطين (ت. 270م)، ولم يكن هذا فيلسوفا مشائيا. وعندما نستعيد هذا، فنحن لا نكشف جديدا، وإنما نُذَكّر بِما لا يسع المهتم الجهل به؛ وإلا فإنه ليس من النزاهة العلمية في شيء أن خلط غير المختص بين الفلاسفة وبين أقوالهم ومذاهبهم، بغرض الطعن في الفلسفة بإطلاق. ورحم الله ابن تيمية عندما قال: ”وأما نفي الفلسفة مطلقا أو إثباتها فلا يمكن، إذ ليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه ولا قول يتفقون عليه في الإلهيات والمعاد والنبوات والشرائع بل وفي الطبيعيات والرياضيات، بل ولا في كثير من المنطق؛ ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من الحسيات المشاهدة والعقليات التي لا ينازع فيها أحد.“[14]
ثم إن التمييز الجوهري بين عقلية المغربي والمشرقي ليس له أصل ولا أساس، فضلا عن أن المقرئ الإدريسي لم يكلف نفسه تحديد المعنى الذي يعطيه للعقلية: أهو معنى أنثربولوجي أم أنطلوجي أم سيكولوجي؟ هذا ويبدو أن صاحب التقديم يصادر على هذا التمييز دون أن يكلف نفسه التصريح بأصوله وبمصادره؛ ومعلوم عند القراء والمهتمين أن محمد عابد الجابري (ت. 2010) هو الذي كان قد رفع هذه الدعوى في زمن ما، وشُنِّع عليه الأمر حينئذ. وبالجملة، فلا أتصور عاقلا اليوم يقبل بالقول بوجود فرق نوعي بين عقلية المغربي والمشرقي.
3. التلبيس والتغيير في الأسماء: الطريق الملكي للتغليط
ما يهمنا الوقوف عنده في هذا الرد هو ذلك التلبيس والتشويش الذي أقحمه المقرئ الإدريسي على اسم الفيلسوف، وذلك عن طريق الخلط المقصود بينه وبين المتكلم تارة، وبينه وبين المفكر تارة أخرى. وإذا كان الخلط الأخير لا يستدعي كبير جهد لتبينه، فإننا سنضطر للتذكير ببعض الأوليات التي إن تبينت صار الخلط بين الفيلسوف والمتكلم حاصل أحد أمرين: إما الجهل بتاريخ العلمين أو الصناعتين، أعني الفلسفة وعلم الكلام؛ وإما القصد إلى التلبيس والتضليل؛ وهذا قصد غير شريف. وعليه، فإننا سنذكّر أدناه ببعض المقدمات المعروفة بالنسبة للمختصين؛ وسنقف عند الصنائع الأربع: الكلام والفلسفة (الإلهيات) والحديث والفقه من الناحية الدلالية، قبل أن نعرض، باختصار شديد، للتمييز بين الفلسفة والكلام والفقه من الناحية التاريخية.
يعرف محمد علي التهانوي (ت. 1158هـ/1745م) علم الكلام كما يلي: ”ويسمى بأصول الدين […] ويسمى بعلم التوحيد والصفات […] [وهو] العلم المتعلق […] بالأحكام الأصلية أي الاعتقادية.“[15] ويميز التهانوي علم الكلام عن الإلهيات، التي هي قسم من الفلسفة بالقول: ”يمتاز الكلام عن [العلم] الإلهي، باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام لا على قانون العقل، وافق الإسلام أو لا، كما في الإلهي.“[16] وهذا تمييز حاسم بين العلمين، بحيث يجعل الأول علما من علوم الدين، والعلم الآخر الإلهي علما عقليا؛ من غير أن يعني هذا أن علم الكلام غير عقلي، بل هو علم يجمع بين العقل والنقل في تدليلاته، وكما يقول التهانوي: و”أيضا دلائله [علم الكلام] يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل، وهي أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل.“[17] ويتبنى التهانوي الموقف الذي كان قد عبر عنه أبو حامد الغزالي (ت. 505هـ/1111م) في مقدمة المستصفى من علم الأصول، عندما اعتبر علم الكلام علما كليا فيما اعتبر بقية العلوم الدينية علوما جزئية وأنه رأسها،[18] إذ يقول: و”الكلام هو العلم الأعلى إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها […] فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق.“[19] وأما بخصوص موضوعات علم الكلام ومباحثه فيقول التهانوي: ”بالجملة فعلماء الإسلام قد دونوا لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله، وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد، علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها، ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا، فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد.“[20]
أما علم الحديث، و”يسمى بعلم الرواية والأخبار والآثار أيضا […] و[هو] علم تعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله.“[21] وهو، طبعا، غير علم الفقه الذي ”يسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا […]. وهو معرفة النفس ما لها وما عليها […]“ ويتميز علم الفقه عن علم الكلام بطبيعة تلك المعرفة؛ فـ”معرفة ما لها [النفس] وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح. ومعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام.“[22] ويضيف التهانوي مؤكدا على الطابع العملي للفقه: ”وقال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية [المكتسب] من أدلتها التفصيلية […]، فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا، وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.“[23] هذا، وقد جعل أصحاب الشافعي ”للفقه أربعة أركان: العبادات، والمعاملات، والمناكحات والعقوبات.“[24]
أما من الناحية التاريخية، وهي الزاوية التي يحب المقرئ الإدريسي أن يواجه خصومه بها، فالفيلسوف غير المتكلم والفلسفة غير علم الكلام. والتمييز بين الطرفين لا يحتاج الكثير من الجهد. تاريخيا، تعتبر الفلسفة علما إنسانيا لا تعلق له بدين ولا بلغة بعينها، وإن توافق الناس على أن منشأها اليونان بتأثير واقتباس من حضارات أخرى. لكن المعروف، أن المسلمين قد ورثوا هذا العلم من اليونان بعد أن انتقلت كتب هؤلاء وأعمالهم إلى مناطق دخلها المسلمون منذ عام 19 للهجرة (الإسكندرية، وجنديسابور، وأنطاكيا…) وتواصلت عمليات الاحتكاك والتفاعل مع مرور الوقت. وقد خلف المسلمون كتابات عديدة في هذه الصناعة. ويمكن التمثيل لهذا بكتابات الفيلسوفين أبي إسحاق الكندي (ت. 256هـ/873م) وأبي نصر الفارابي وغيرها… لكن المسلمين أيضا عرفوا ظهور علم لا يبعد أن يكون للديانات التي قبل الإسلام تأثير كبير فيه، وخاصة المسيحية… هذا مع أن بلورته قد حصلت في سياق إسلامي. وهذا العلم هو المعروف بعلم الكلام. وبطبيعة الحال، فإن سألت دارسا متخصصا في الدراسات الإسلامية عن علم الكلام لكان الجواب إنه علم ديني. وإن عدت إلى كتب القدماء، كأن نقول أبا حامد الغزالي مثلا، لقال لك إنه علم ديني، بل هو رأس العلوم الدينية، على ما ذكرنا أعلاه. وهو ما لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الفلسفة، التي لا تخلو من نفحات دينية موضوعا ومقاربة، لكن لا أحد اعتبرها علما دينيا أو شرعيا، كما هو شأن علم الكلام. فمن أين جاء هذا الخلط؟
جاء الخلط من أمور كثيرة، نحصيها في ثلاثة باختصار شديد:
أول الأمور، أن الفلسفة في السياقات الإسلامية، وخاصة بعد أبي علي ابن سينا (ت. 428هـ/1037م)، عرفت امتدادا وتأثيرا كبيرا، بحيث استطاعت أن تخترق حدود خصومها، وخاصة من الأشعرية. ومن شدة تعاطي هؤلاء للفلسفة، وخاصة في حلتها السينوية، كاد المرء أن لا يتبين أهذا الذي أنتجهُ متكلمون، كفخر الدين الرازي (ت. 606هـ/1209م) ونصير الدين الطوسي (ت. 672هـ/1274م)، هو علم كلام أم فلسفة أم هما معا. والمفارقة، أن الأشعرية، التي احتضنت الفلسفة السينوية وتغيرت في هويتها ومعالمها، هي التي اشتهرت أكثر من غيرها برد دعاوى الفلاسفة.
ثاني الأمور، أن الفلسفة قد توسع معناها لتغدو دلالتها تشمل النظر إلى العالم وإلى الكون. ومن هذه الناحية، يمكن للمرء أن يتحدث عن فلسفة الإسلام بمعنى نظرة الإسلام إلى العالم، لا بمعنى فلسفتي ابن سينا وابن رشد. وهنا صارت الفلسفة والفكر الإسلامي مترادفين.
ثالث الأمور، أن المسلمين وخاصة في العصر الحديث، وبعد أن رأوا بعض المستشرقين الكبار ينفون عن المسلمين الفلسفة بمعناها الصناعي المعروف، صاروا ابتداءً من الشيخ الأزهري مصطفى عبد الرازق (ت. 1947م) يبحثون عن العلوم التي أبدع فيها المسلمون، فوجدوا أنها أصول الفقه والتصوف وأصول الدين (علم الكلام)، فأسموها فلسفة، بل اعتبروها الفلسفة الحقيقية للإسلام الذي لا حاجة له وللمسلمين إلى علوم الأوائل. وهكذا، فقد صار محمد بن إدريس الشافعي (ت. 204هـ/820م) فيلسوفا رغما عن أنفه، وابن عربي المتصوف (ت. 638هـ/1240م) فيلسوفا رغم تخسيسه للفلسفة ولعقل الفلاسفة، وابن أبي دؤاد المعتزلي (ت. 240هـ/854م) والغزالي الأشعري وركن الدين ابن الملاحمي الخوارزمي المعتزلي (ت. 536هـ/1140م) فلاسفة رغم أنهم ألد خصوم الفلسفة والفلاسفة. ويجدر بنا أن نضيف هنا أن المعتزلة، وبسبب من دفاعهم عن العقل والتأويل العقلي، وظهور تأثرهم ببعض النظريات الفلسفية القديمة، عادة ما يُلحقهم الطلبة والمبتدئون بالفلاسفة؛ هذا مع أنهم، كما قلنا، كانوا علماء دين، وكان علمهم علما دينيا، بل هو رأس العلوم الدينية، الغرض منه إثبات العقائد الدينية؛ هذا فضلا عن خصومتهم للفلاسفة وردودهم عليهم وتمسكهم باستقلال طريقتهم وتميزها بوصفها طريق المسلمين عن طريقة الفلاسفة ومنهجم. ولطالما آخذوا الأشعرية، شافعية وأحنافا، لخلطهم طريقة الإسلام بطريقة المتفلسفة.
يتقصد المقرئ الإدريسي أن يُلبس على القارئ فيأخذ المتكلم بمعنى الفيلسوف عندما يريد أن يثبت تحامل الفلاسفة على الفقهاء، ويميز بينهما عندما يريد الدفاع عن الفقهاء ورد تهمة تحجرهم وامتحانهم الفلاسفة… أولا يقدم المقرئ الإدريسي أبا حامد الغزالي بوصفه فيلسوفا تارة وبوصفه شبه فيلسوف تارة أخرى، ليؤكد أن الفقيه لم يكن متحجرا؛ وثانيا، يبحث الإدريسي عن اسم فيلسوف امتحن الفقهاء، فلا يعثر على أي اسم من الفلاسفة الذين اعتدنا أن نعتبرهم كذلك؛ لكن بما أن المتكلمين عنده أقران الفلاسفة؛ فإنه وإن كان الذي أشرف على محنة ابن حنبل فقيه من المعتزلة الذين اشتهروا بكونهم خصوم الفلاسفة (وبخاصة الفلسفة والمنطق الأرسطيين)، فإنه في هذا السياق، يغدو المتكلمون والفلاسفة سواء. وإذا أخطأ المعتزلة، فالخطأ يتحمله الفلاسفة. ونورد أدناه بعض التفاصيل.
فلكي يدافع المقرئ أبو زيد الإدريسي عن انفتاح الفقيه وعقلانيته ويدفع عنه تهمة الانغلاق التي يصفه بها خصومه، اضطر إلى أن يعتبر الغزالي، وهو من أكبر من يمثل الفقهاء، من الفلاسفة تارة ويعتبره تارة أخرى متكلما قرينا للفلاسفة.[25] بل إن الإدريسي قدم حجة جديدة عادة ما أنكرها الناس على الغزالي، وهي دفاعه عن المنطق اليوناني بوصفه دليل انفتاحه. إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الأجناس الأدبية التي كتب فيها الغزالي، فإنه من باب الأولى أن نسميه أصوليا، وصوفيا، ومتكلما. لكن يصعب أن نسميه فيلسوفا بالمعنى الذي كان للفيلسوف في ذهن الغزالي وكتب ضده. إذ لا يعقل أن يرد الغزالي في تهافت الفلاسفة على الفلاسفة من منطلق جدلي كلامي، كما يقول هو نفسه، ونسميه نحن فيلسوفا، وإلا لزم عن ذلك أن يكون الغزالي يرد على نفسه أو أن نغير في الأسماء. أما إن قلنا إنه فيلسوف بمعنى أنه مفكر؛ فنحن بذلك نخرج عن الكلام الأكاديمي إلى الكلام الثقافي العام. وحتى وإن قلنا إن الغزالي متكلم متفلسف من جهة أنه قد قرأ الفلسفة السينوية ولخصها وتأثر بها ورد على الفلاسفة، فإنه، في كل الأحوال، ما كان ليرضى لنفسه أن يسمى فيلسوفا؛ ولنا في كتابالمنقذ من الضلال، وهو من كتابات الغزالي المتأخرة، خير مثال. ثم لا يكفي أن يكون الغزالي متكلما لكي يغدو فيلسوفا. فالفلسفة علم والكلام علم آخر، كما بينا أعلاه. ومن هذه الناحية، فإن الغزالي لم ينتقد الفلسفة ولم يرد على الفلاسفة، في تهافت الفلاسفة، من جهة أنه فقيه أصولي شافعي وإنما من جهة أنه متكلم؛ إذ ليس من مهام الفقيه أن يتكلم في الآراء الميتافيزيقية، ولا هو يملك العدة العلمية والمنهجية لهذا الرد. أما دفاع الغزالي عن المنطق للأصول كلاما وفقها، فلم يكن من جهة ما أن المنطق جزء فلسفة أو آلة مخصوصة بالفلسفة، وإنما من جهة ما هو آلة محايدة لا تعلق لها بالعقائد إثباتا أو إبطالا؛ وكذا من جهة أن المنطق يمكن أن ينقذ العلوم الشرعية التي تصور الغزالي أنها في أزمة، وربما قد تندثر ما لم تتمسك بالمنطق بوصفه الأصل في وثاقة كل علم وفي موثوقيته.
ويقول المقرئ الإدريسي:
لست أنكر أنه قد كان لبعض الفقهاء الذين استأسدوا في بعض البلاطات، واستفردوا بقلوب الملوك في بعض الدول شيء من العسف أو الانغلاق، أو شيء من قبيل ’المرء عدو لما جهل‘؛ ولكن ليس يعقل أن يسحب هذا الموقف على كل قبيل الفلاسفة في مواجهة قبيل الفقهاء. وإلا فسبحان الله، ويا للمفارقة والعجب! فإن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل.[26]
الحق أنه لا مجال للاعتراض على هذا القول في جملته، لأن صاحبه يقر بوجود أشكال من الانغلاق سائدة بين الفقهاء وأشكال من العسف صادرة عنهم في حق فلاسفة. كما لا يملك المرء سوى أن يوافق صاحب القول في أنه من غير المعقول أن نعمم حيث يجب التقييد. فلا الانفتاح صفة ملازمة لكل فيلسوف ولا الانغلاق صفة ملازمة لكل فقيه. إلى هنا، لا شيء يثير الانتباه، لأن مراجعة كتب التاريخ تؤكد بأنه لا مجال سوى لتقييد الأحكام. لكن سؤالنا هو: لماذا لجأ المقرئ الإدريسي إلى تغيير الأسماء في آخر سطر من الاقتباس أعلاه؟ لماذا لم يحتفظ باسم الفلاسفة طالما أنه يتحدث عنهم ويريد أن يقنعنا أنهم من نكل بالفقهاء؟ ولماذا أبدل هؤلاء باسم المفكرين، وهو يعلم أن هؤلاء غير أولئك، أو لنقل، على وجه الدقة، لماذا أبدل خاصا بعام أو جزءا بكل؟ ثم دعنا نسأل الإدريسي: من هم هؤلاء الفلاسفة يا رجل؟ دُلّنَا على اسم أو اسمين لفلاسفة استعملوا نفوذهم ليوقعوا بخصومهم ويقصوهم وينكبوا بهم، بل ويقتلوهم، حتى نطمئن لدعواك.
لم يورد المقرئ الإدريسي اسما واحدا من أسماء الفلاسفة ليستشهد به لدعواه الخطيرة تلك. لكنه، في المقابل، يقول في سياق التدليل لدعواه:
لم نسمع بفقيه بنى فرنا ليحرق فيه أعداءه، ولكن سمعنا بمعتزلي يدعي الحرية والعقل هو ابن أبي دؤاد القاضي والوزير، الذي بنى فرنا ليحرق فيه من يختلف معه من الفقهاء ومن السلف، لكنه هو أحرق فيه وقطع فيه تقطيعا قبل أن يحرق.[27]
إننا عندما نقرأ هذا الكلام الذي قدمه الإدريسي دليلا على تنكيل الفلاسفة بخصومهم الفقهاء ندرك تماما لماذا أقدم المقرئ الإدريسي على إبدال اسم الفلاسفة بالمفكرين، تحايلا على القارئ وتضليلا له. يقول المقرئ الإدريسي:
إن الذي سجل لنا التاريخ هو محنة الفقهاء الموصومين بالنقل مع المفكرين الموصوفين بالعقل. من امتحن من؟ ابن حنبل أم المعتزلة؟ وهم الذين كانوا يكثرون من دعاوى العقل والحرية والتفكير؟ إن ما نعرفه تاريخيا، أن ابن حنبل هو الذي سجن وعذب…ويا سبحان الله اليوم ينسب سيد قطب [ت. 1966م] إلى قبيل ابن تيمية وابن حنبل. من سجن من؟ ومن حرض على من؟ القوميون والعقلانيون والإعلاميون والمفكرون الذين كانوا في حاشية عبد الناصر أم سيد قطب؟ سيد قطب هو الذي سجن، وهو الذي عذب عذابا لا قبل لأحد به.[28]
ليس غرضنا أن نشكك في ما حصل لهؤلاء الأعلام ولغيرهم من صنوف العذاب في تاريخ الإسلام وفي ظروف مختلفة يتداخل فيها ما هو ديني بما هو سياسي، وإنما غرضنا أن نتساءل: إذا كان سياق الكلام هو التقابل بين الفلاسفة والفقهاء، فلماذا يأبى الإدريسي إلا أن يغض النظر عن الفلاسفة، ليشرع في الحديث عن مفكري النظام الناصري …وعن المتكلمين المعتزلة، وخاصة أبي دؤاد، الذي غدا الممثل الوحيد للفلاسفة وللظلم الذي سلطوه على الفقهاء ممثلين في ابن حنبل؟ ثم ما هو مصدر الإدريسي في خبر بناء ابن أبي دؤاد فرنا لإحراق الخصوم وإحراقه فيه؟
بخصوص السؤال الأول، للأسف لم يسعفنا المقرئ الإدريسي بتفاصيل إضافية عن هؤلاء الشخصيات التي كانت حول الرئيس المصري السابق عبد الناصر (حكم بين 1956م و1970م)، فحال دون أن نتعرف فيهم إلى فيلسوف واحد نستطيع به أن نجد لكلامه وجاهة ما؛ لكن أن يمثل للفلاسفة الذين عاقبوا الفقهاء وقتلوهم بأبي دؤاد المعتزلي، فهو لعمري أمر في غاية السقوط. يمكن للمرء أن يبحث مطولا في كتب تاريخ الفلاسفة في السياقات الإسلامية ولن يعثر عن أحمد ابن أبي دؤاد؛ لأن هذا الأخير، كما يعرف أبو زيد جيدا، إنما هو من المتعاطين لعلم من علوم الدين، وهو علم الكلام على طريقة أهل الاعتزال، وإلى ذلك فهو فقيه وقاض،[29] وليس فيلسوفا؛ وأن موضع الخلاف العقدي بينه وبين ابن حنبل ليس موضوعا فلسفيا، بل موضوع من موضوعات علم الكلام؛ أعني أن الخلاف بين أحمد ابن أبي دؤاد وأحمد ابن حنبل إنما هو، نظريا، خلاف ديني بين عالمي دين واحد هو الإسلام. هذا مع أنه يصعب علينا اليوم أن نصدق أن الخلاف بخصوص خلق القرآن بين المعتزلة عموما وأحمد ابن حنبل وأسماء أخرى كان خلافا كلاميا خالصا؛ بل هو خلاف تداخل فيه ما هو سياسي بما هو ديني؛ وأن هذه المحنة لم تكن سوى وجهٍ من وجوه استخدام الدين لأغراض السلطة، على ما بين فهمي جدعان في عمله القيم عن المحنة.[30]
لكن عندما لا نتقدم فنحدد أولا ما نقصده بالفقهاء، يصير من حقنا أن نتحدث بإطلاق عن محنة الفقيه ابن حنبل مع المتكلم المعتزلي ابن أبي دؤاد؛ وننسى أو نذهل عن أن هذا الأخير هو أيضا فقيه مثله مثل خصمه، بل كان معروفا بالفقه في زمنه، تماما كما كان ابن حنبل معروفا بالحديث. وإلى ذلك، فإن هذا الأخير لم يمتحن لأنه فقيه، بمعنى أنه ما سُوئل من أجل فتوى في أمور المعاملات أو العبادات… وإنما من جهة قوله في أمور الاعتقادات (رؤية الله، وخلق القرآن…)، وهذه ليست موضوعات الفقيه وإنما موضوعات المتكلم، سواء أكان معتزليا أو أشعريا أو حنبليا أو ماتريديا.
ولا يملك المرء سوى أن يستغرب لقول المقرئ الإدريسي، وهو يحاول أن يقنع مخاطبه بأن ما سجل التاريخ هو محنة الفقهاء ”الموصومين“ بالنقل مع المفكرين الموسومين بالعقل، وكأن هؤلاء هم الفلاسفة الذين ذكرهم في دعواه. وموضع الاستغراب يقوم أساسا في هذه الأسماء التي أتى بها ليظهر كيف أن الفقهاء هم الذين كانوا ضحايا الفلاسفة. فقديما ابن حنبل عُذّب على يد المعتزلة؛ وزمنا بعده، ابتلي ابن تيمية بالباطنية وغلاة الصوفية؛ وحديثا عذب سيد قطب على يد نظام عبد الناصر بدعم وتحريض من الإعلاميين العقلانيين والمفكرين والقوميين. مغالطات المقرئ الإدريسي مكشوفة هنا، فحتى وإن سلمنا له بأن ابن حنبل فقيه وليس محدثا وصاحب قول في العقيدة، وأن ابن تيمية فقيه وليس متكلما حنبليا، وأن سيد قطب فقيه وليس مفكرا سلفيا، فإن المعتزلة والباطنية وغلاة الصوفية والإعلاميين والعقلانيين والمفكرين والقوميين ليسوا من الفلاسفة، في حدود ما نعلم. فهل يجب أن نحيلهم فلاسفةً رغما عنهم لكي تصح دعوى تنكيل الفلاسفة بالفقهاء؟
قد يعترض المقرئ الإدريسي فيقول إن الأمثلة التي سُقْتُها هنا إنما هي للمفكرين بعموم وليست للفلاسفة تحديدا، وأنا ما غيرت اسم الفلاسفة في الفقرة أعلاه إلا لهذا الغرض بالذات، أي ليستقيم لي الاستشهاد بهؤلاء. جوابنا إن الأمر غير ذلك، لأن ما سيترتب على هذه الأمثلة من حكم نهائي يُظهر، بما لا يدع مجالا للشك، أن حديث المقرئ الإدريسي إنما هو عن الفلاسفة بالمعنى الصناعي، وليس عن المفكرين عموما ولا عن المتكلمين. ويقول في خلاصته:
لو أردنا أن نسترسل في هذه المقارنة لخرجنا بخلاصة مفادها إن الذي تحجر على رأيه وغضب لنفسه وتصلب في موقفه وانغلق على ذاته وتعالى مدعيا الحقيقة هم الفلاسفة في الغالب. ولم يكتفوا بهذا، بل استعملوا نفوذهم حيثما كان لهم نفوذ، للإيقاع بخصومهم من الفقهاء، وللتضييق عليهم، وإقصائهم ونكبهم، والأمر قد يذهب إلى قتلهم.[31]
فكيف يستخلص المقرئ الإدريسي من أمثلة خاصة بالمعتزلة، وهم من المتكلمين، وبغلاة الباطنية وبمفكري النظام الناصري حكما خاصا بالفلاسفة؟ الظاهر أن ما يهم الإدريسي هو الدعوى وليس هو وجه دلالة الأدلة عليها. لا يهم الاسترسال في إيراد الأمثلة لنعرف أسماء هؤلاء الفلاسفة الذين استعملوا نفوذهم عند السلاطين والحكام والرؤساء، قديما وحديثا، للإيقاع بالفقهاء والتضييق عليهم وإقصائهم… ما يهم هو ”التصديق“ بأن الخلاصة النهائية تخص الفلاسفة، وليس غيرهم. ربما كان يجب أن نزيف التاريخ ونغير هوية هؤلاء الأعلام المذكورين ونحيلهم فلاسفةً عنوة حتى يستقيم حكم المقرئ الإدريسي؛ وإلا فإن الخلاصة أن هذا الأخير قد قرر حكما مسبقا دون أن يأتي بشاهد واحد يشهد لحكمه.
وأما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بمصادر الإدريسي في حكاياته، فإنه على الرغم من استثمار هذا الأخير معطيات وأخبارا شاذة وخطيرة جدا، من قبيل بناء أحمد بن أبي دواد فرنا ليحرق فيه من يختلف معه، وأنه في الأخير هو من أُحرق في ذلك الفرن بعد أن قطع تقطيعا، لا يمد قارئه بمصادر هذه الأخبار التي يبدو أنها قد اتصلت به سماعًا. والحال أن النصوص التاريخية والتراجم، في حدود ما وقفنا عليه، لا تتحدث عن فرن ولا عن حرق، وإنما تفيدنا أن أحمد بن أبي دؤاد قد أصيب بمرض الفالج الذي أعجزه وتوفي به ودفن في داره، على ما أورد الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت. 463هـ/1071م) في تاريخ بغداد.[32] فأن يدعي المقرئ الإدريسي هذا دون أن يأتي بشهادة واحدة ليس سوى تحكم في تقديرنا. غير أنه مما يجدر بنا الوقوف عنده أن الخطيب البغدادي، في آخر المدخل المخصص لابن أبي دؤاد، يورد حكاية طريفة ننقلها هنا للفائدة، علها تسعفنا في فك لغز المصدر الذي أفاد المقرئ الإدريسي بخبر فرن ابن أبي دؤاد واحتراقه بالنار.
أخبرنا أبو الحسين بن بشران المعدَّل، قال: حدّثنا عثمان بن أحمد الدّقّاق، قال: حدّثنا إسحاق ابن إبراهيم الُختُّلي، قال: حدّثني أبو يوسف يعقوب بن موسى بن الفيرزان ابن أخي معروف الكرخي، قال: رأيت فِي المنام كأني وأخًا لي نمر على نهر عِيسَى على الشّط وطرف عمامتي بيد أخي هذا، فبينما نحن نمشي إذا امرأة تقول لصديقي هَذَا: ما تدري ما حدث الليلة؟ أهلك اللَّه ابْن أَبِي دؤاد. فقلتُ أنا لها: وما كَانَ سبب هلاكه؟ قالت: أغضبَ اللّهَ عَلَيْهِ، فغضب عَلَيْهِ من فوق سبع سموات.
قَال إِسْحَاق: وحدثني يعقوب، قال أخبرني بعض أصحابنا، قال: كنت عند سفْيان بْن وكيع، فقال: تدرون ما رأيت الليلة؟ وكانت الليلة التي رأوا فيها النَّار بِبَغْدَادَ وغيرها: رأيت كَأنَّ جهنم زفرت فخرج منها اللهب، أو نحو هَذَا الكلام. فقلت: ما هذا؟ قال:أُعدت لابن أبي دؤاد.[33]
هنا تنتهي رواية الأحلام والمنامات والأماني؛ ونتصور أن ابن أبي دؤاد كان له خصوم كثر يتمنون لو يحرق في الدنيا قبل الآخرة، لذا حصل توهم أن جهنم تخرج إليه لهيبها يوم مماته، أو نحو هذا الكلام! أما في الدنيا، فالذي حصل، وفق رواية الإمام الحافظ البغدادي دائما، هو ما يلي:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم الأزهرى، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بْن محمد بن عَرَفَةَ الأَزْدِيُّ، قال: سنة أربعين ومائتين فيها مات أَحْمَد بن أبي دؤاد.
أخبرني الصَّيْمري، قال: حدّثنا المرزُباني، قال: أخبرنا محمّد بن يحيى الصولي، قال: حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي، قَالَ: مات أَبُو الوليد محمد ابن أحمد بن أبي دؤاد، وهو وأبوه منكوبان، فِي ذي الحجة سنة تسع وثلاثين ومائتين ومات أبوه في المحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع بقين منه، فكان بينه وبين ابنه أبي الوليد شهر أو نحوه.
قال الصولي: ودُفن فِي داره بِبغْداد وصلى عَلَيْهِ ابنه الْعَبَّاس.[34]
عندما نقارن هذا الكلام الوارد عند الخطيب البغدادي بالحكاية التي ”سمعها“ المقرئ الإدريسي ورواها بدون ذكره مصدره فيها، يترجح عندنا أن هذا الأخير قد تشابهت عليه أحداث المنامات والرؤى بالوقائع كما يرويها الإخباريون وأصحاب التراجم. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن الخوض في حوادث التاريخ لا يكون اعتمادا على ما قد يعلق بالذاكرة من قصص وروايات تختلط فيها الشجون بالأماني، وإنما اعتمادا على الوثائق والشواهد. وفي كل الأحوال، فإن المقرئ الإدريسي مطالب بالإدلاء بوثيقة تشهد لحادثة تقطيع ابن أبي دؤاد وإحراقه في الفرن الذي بناه خصيصا لإحراق خصومه، وإلا ظل كلامه تحكما بلا دليل، أو في أحسن الأحوال، تعبيرا عن أمنية.
4. كلود برنار وروجر بيكون: المشاحة في أسماء العلماء
من الملفت للانتباه حقا أنه على الرغم من تمسك المقرئ الإدريسي بأن المسلمين هم أرباب العقلانية الحقة، فإنه يعتبرهم أيضا، أرباب المنهج التجريبي وواضعيه؛ ويدلل الإدريسي قائلا: ”ودوننا أطروحة علي سامي النشار مناهج البحث عند مفكري الإسلام، التي تقادم على كتبها ستين عاما [كذا!] وما تقادمت أهميتها، والتي أثبت فيها أن المنهج التجريبي إنما وضعه المسلمون وتأخر عند الغرب إلى القرن التاسع عشر مع كلود برنارد(Claude Bernard) [في كتابه Introduction à l’étude de la médecine expérimentale، كما ورد في الهامش].“[35]
يحتاج هذا القول الغريب وقفة مطولة. لكن السياق لا يتحمل هذا، لذلك نرى أن نضع سؤالين على المقرئ الإدريسي: أولا: من هم المسلمون الذين تأثر بهم الغربيون؟ هل هم الفقهاء؟ أم هم أولئك الذين خاصمهم الفقهاء والمحدثون؟ وثانيا: أيعقل أن يقول طالب فلسفة (تاريخ العلوم) اليوم أن المنهج التجريبي قد تأخر ظهوره عند الغربيين إلى حدود القرن التاسع عشر؟ ثم، ثالثا، أين قرأ المقرئ الإدريسي هذا؟
قد يبدو السؤال الأخير حشوًا من قبلنا، ما دام المقرئ الإدريسي قد ذكر مصدَره، وهو رسالة مناهج البحث عند مفكري الإسلاملعلي سامي النشار (ت. 1980م). أقول إننا قد وضعنا هذا السؤال بالذات، لأننا ندرك أن الإدريسي قد أحال على عمل النشار، ولكن قصدنا أن نراجع عمل الأخير لنقف على أصل حجته.
في رسالته للحصول على الماجستير في مايو عام 1942م، والتي نشرها عام 1947م دونما تغيير ولا تبديل،[36] حاول علي سامي النشار جاهدا أن يثبت أن المسلمين لم يقبلوا منطق اليونان، لأنه كان يقوم على المنهج القياسي ولا يترك مجالا للتجربة،[37] التي تعبر عن حقيقة المنهج الإسلامي. ويقول النشار: ”قد وصل المسلمون إلى وضع هذا المنهج الاستقرائي الذي يقوم على التجربة. وهذا المنهج التجريبي هو المعبر عن روح الإسلام،“[38] بينما ”المنهج القياسي هو روح الحضارة اليونانية.“[39] ولا يحدد النشار من يقصد بهؤلاء المسلمين الذين وضعوا هذا المنهج التجريبي؛ لكنه يقرر أنهم قد وضعوه ”بجميع عناصره.“[40] ومن هؤلاء انتقل هذا المنهج إلى الأوربيين في القرن الثالث عشر. ولكي يثبت النشار هذه الدعوى يستشهد بكلام مفكرين مسلمين وأوروپبين. وهكذا، فقد شهد هؤلاء لاستمداد الفيلسوف الإنجليزي روجر بيكون (Roger Bacon, d. 1294) دراسته العلمية من ”الجامعات الإسلامية في الأندلس؛“[41] كما شهدوا أنه لم يكن سوى واسطة في إدخال المنهج التجريبي الإسلامي الأصل إلى أوروبا.
والملاحظ أنه لم يرد في أي موضع من كتاب سامي النشار المذكور أن المنهج التجريبي قد تأخر عند الغرب إلى حدود القرن التاسع عشر للميلاد، وأن الطبيب الفرنسي كلود برنار قد أخذ هذا المنهج عن المسلمين. فلقد تشابه على المقرئ الإدريسي كلود برنارد الذي عاش في القرن التاسع عشر (1813-1874) وروجر بيكون الذي عاش في القرن الثالث عشر. أيعقل أن يسقط الإدريسي ستة قرون كاملة من تاريخ الأفكار العلمية؟ أيعقل أن يغفل الإدريسي عن الفيلسوفين الإنجليزيين فرانسيس بيكون (Francis Bacon, d. 1626) وجون ستوارت ميل (John Stuart Mill, d. 1873)، وقد ورد ذكرهم في كتاب النشار الذي يحيل عليه؟ لا شيء يدل على أن الإدريسي قد راجع مناهج البحث لدى مفكري الإسلام عند كتابة تقديمه هذا والإحالة على النشار. ويجب أن نضيف أخيرا أنه ما كنا لنقف عند هذا الخلط بين الاسمين، بيكون وبرنار، إلا لأنه قد ترتّبَ على ذلك الخلط قول الإدريسي بتأخر الأوروبيين في اكتشاف المنهج التجريبي، مُسقطا، بذلك، ستة قرون كاملة من تاريخ العلوم، وإلا فإن الأخطاء والأوهام والهفوات من صميم البحث العلمي.
ولن ندخل في نقاش آخر بخصوص هؤلاء الذين أسماهم روجر بيكون بالعرب، وبأن علمهم هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. لن ندخل أيضا، في نقاش عن هذا العلم، هل كان علم الفقه؟ وعن أصحابه هل كانوا هم الفقهاء؟ مع أن المقرئ الإدريسي يقول بهذا. ولن ندخل في نقاش بخصوص الجامعات الإسلامية بالأندلس؛ لن ندخل في نقاش بخصوص كل هذه المسائل، لأنه سيخرجنا عن الغرض من هذه الورقة. لكننا نقول يصعب على المرء أن يكون مدققا ومتأنيا في أحكامه عندما يكون تحت إكراهات الدعوة والسجال.
- من يمثل العقل في الإسلام؟ دعوى بدون دليل
وفي الوقت الذي يشيد سامي النشار، ومعه الإدريسي، بالمنهج التجريبي الذي ابتكره العلماء المسلمون، واستفاد منه الأوروبيون؛ من دون أن تحصل تحديد هوية هؤلاء المسلمين وانشغالاتهم العلمية، مع أن المقصود بهم في تلك الاستشهادات التي أوردها النشار ليس الفقهاء ولا المحدّثون ولا المتكلمون، وإنما علماء المسلمين في الطبيعيات والكيمياء والنبات والطب والرياضيات، أمثال جابر ابن حيان (ت. 160هـ/815م)، والحسن ابن الهيثم (ت. 430هـ/1040م)، وغيرهما ممن كان على خصومة مع الفقهاء والمحدّثين الذين كان كثير منهم يعتبرون علوم هؤلاء غير نافعة في الآخرة. وفي كل الأحوال، فقد تدارك سامي النشار الأمر في طبعة ثانية عام 1965م لكتابه مناهج البحث لدى مفكري الإسلام؛[42] واضطر، في فصل جديد مخصص للمنهج التجريبي عند علماء المسلمين، أن يعترف بأن اليونان قد خبروا المنهج التجريبي، وأن العلماء المسلمين من أمثال ابن الهيثم وابن حيان وأبي الريحان البيروني (ت. 440هـ/1048م)… قد طوروه تطويرا كبيرا؛ ومن هؤلاء انتقل إلى أوروبا في القرن الثالث عشر بفضل جهود روجر بيكون وآخرين.
وعلى الرغم من هذا، فإن المقرئ الإدريسي يتمسك بالقول ”إن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة.“[43]وطبعا، يصعب على القارئ، وخاصة المتخصص، أن يدرك ما يقصده الإدريسي بهذا الكلام، ومن ثم أن يناقش مثل هذه القضايا العامة والغامضة. لكن الجدير بالذكر أن مثل هذه الأحكام بالذات هو ما كان يقرره المستشرقون في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أقصد أن حضارة الإسلام لا يمكن أن تقبل الفلسفة لأنها حضارة فقه ونقل وجزئيات؛ وأن الفلسفة الحقيقية للإسلام هي فلسفة القرآن؛ أما الفلسفة بوصفها فاعلية عقلية خالصة، فلا قبل للمسلمين بها.
وفي سياق الغموض دائما، لا يتردد المقرئ أبو زيد الإدريسي في الإشادة بعقلانية المعتزلة ذاهلا عن نقده لهم من جهة أنهم امتحنوا الفقهاء وأهل السلف. بل إنه يعتبر المتكلمين، إلى جانب الفقهاء والنحويين، هم أرباب العقلانية والتفكير الفلسفي في الإسلام؛ ويقول في هذا: ”العقلانية الحقيقية والتفكير الفلسفي الحقيقي هو في المناهج التي وضعها الأصوليون من أصول فقه، وأصول نحو وأصول دين.“[44] إن أصول الدين هو التسمية الأخرى لعلم الكلام، ليس أكثر؛ ومناهجهم في التأويل وفي الحديث وفي العقيدة وفي أمور أخرى لم يكن يقبلها كثير من الحنابلة وأهل السلف وغيرهم.
والظاهر أن المقرئ الإدريسي لا يبالي أن يكون المعترض على الفلسفة والفلاسفة متكلما أو فقيها أو محدثا؛ فالأهم عنده هو رد دعاوى الفلاسفة؛ وعندئذ فقط يصبح جميع هؤلاء داخلا تحت مظلة الفقيه. وهكذا، فلكي يثبت المقرئ الإدريسي دعواه، التي مفادها أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء وليس عقل الفلاسفة، يروي لنا هذه الحكاية:[45]
لقد لخص لنا صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي [ت. 414هـ/1023م] […] المناظرة التاريخية التي جرت ليوم كامل بين أبي سعيد السيرافي [ت. 368هـ/978م] ومتى بن يونس القنائي المنطقي [ت. 328هـ/940م]، وفي محفل الوزير ابن سعدان وأمام جحفل من العلماء والنحاة والفلاسفة والمتكلمين والقراء؛ وهي مناظرة تنتهي إلى نتيجة ألجأَ فيها أبا [كذا! والصواب: ”أبو“]سعيد متى بن يونس القنائي إلى الزاوية وحصره فيها، مقنعا إياه بالحجة المقلوبة عليه من لسانه أنه كما قال له أبو سعيد: ”أنت إذن لست تدعونا إلى علم المنطق وإنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية،“ لأن لغة اليونانيين هي التي صاغت هذا الفكر! وهذا انتباه دقيق من أبي سعيد السيرافي.
لن ندخل في نقاش بخصوص علاقة اللغة بالفكر ولا بخصوص صِدقية واقعة المحاورة بين أبي سعيد ومتى، كما ولن نعترض على إسقاط تمثيلية العقل الحقيقي عند المسلمين عن الفلاسفة، وإنما سندخل في نقاش بخصوص وجه دلالة هذه الواقعة على الدعوى التي يدعيها المقرئ الإدريسي، وهي أن العقل الحقيقي عند المسلمين هو عقل الفقهاء. وفي الواقع، يصعب أن يساير المرء المستأنس بتاريخ علم الكلام وبردود المتكلمين على المناطقة ما يقوله المقرئ الإدريسي، لأنه يلفق في حججه ويزيف فيها؛ ذلك أن الشاهد الذي يقدمه هنا بوصفه الممثل لعقل الفقهاء في مواجهة عقل الفلاسفة لم يكن في هذه المناظرة فقيها متحدثا باسم علم الفقه، وإنما كان عالما لغويا ومتكلما معتزليا (ولنتذكر أن المتكلم عند المقرئ الإدريسي قرين الفيلسوف)؛ هذا دون أن ندعي أن السيرافي لم يكن له معرفة بالفقه؛ لكن كل ما نعرفه من أعماله اليوم إنما هي في علوم اللغة؛ وهذا أمر يعرفه المقرئ أبو زيد الإدريسي جيدا. وحتى وإن سلمنا أن أبا سعيد السيرافي كانت له مشاركة في الفقه، فإنه، أولا، كان فقيها معتزليا، مثله مثل أحمد ابن أبي دؤاد؛ وثانيا وأساسا، إن موضوع مناظرته مع متى لا يدخل، بأي وجه من الوجوه، ضمن موضوعات الفقه بمعناه الصناعي الذي يعرفه به أهله. إن الفقيه من جهة ما هو فقيه لا ينظر في علاقة الفكر باللغة ولا في علاقة المنطق بالنحو، وإنما ينظر في المعاملات والعبادات والمناكحات والعقوبات. أما الموضوع الذي دارت بخصوصه تلك المناظرة فهو يهم اللغويين والمناطقة بالأساس، أي أنه كان يهم السيرافي من حيث هو لغوي متكلم، ومتى ابن يونس من حيث هو منطقي أرسطي. ومن هذه الجهة، فإن الموقف الذي يعبر عنه أبو سعيد السيرافي في هذه المناظرة إنما يُظهر موقفَ المتكلمين المعتزلة الرافض تماما لإدخال المنطق الأرسطي على قواعد اللغة. ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن المعتزلة، وخلاف ما هو شائع، هم ألد خصوم المنطق والفلسفة الأرسطيين؛ وهم في هذا على طرف النقيض من أبي المعالي الجويني (ت. 478هـ/1085م)، بل ومن أبي حامد الغزالي الفقيه الأصولي الذي أدخل المنطق على أصول الفقه والدين، ودافع عن المنطق الأرسطي دفاعا شديدا، معتقدا أن العلوم الإسلامية لن تقوم لها قائمة ولا موثوقية ما لم تحط بالمنطق.
وبالجملة، إن المناظرة بين السيرافي ومتى، إن صح حصولها على الوجه الذي توجد عليه عند التوحيدي لا تعني الفقهاء في شيء، فهي تظهر أساسا موقف اللغويين من المتكلمين المعتزلة من منطق أرسطو وفلسفته. وبسقوط هذا الدليل، تصبح دعواه (الممثل الحقيقي للعقل الإسلامي هم الفقهاء وليس الفلاسفة) بدون دليل؛ اللهم إلا أن يكون المقرئ الإدريسي يعتبر المعتزلة من زمرة الفقهاء عندما يعترضون على الفلسفة والمنطق الأرسطيين، ويعتبرهم فلاسفة عندما يحملون على الحنابلة وأصحاب الأثر. وهذا هو عين التشهّي. فما وافق هواه قبله وما خالفه رفضه.
خاتمة
يمكن لكتاب في التاريخ أن يقدمه فنان أو موسيقي أو روائي؛ ولكن هذا عادة ما يحصل عندما يكون الكتاب ثقافيا وموجها إلى شريحة واسعة من القراء. أما عندما يكون الكتاب جامعيا متخصصا، فمن باب الأولى أن يقدم له متخصص في المجال الذي ينتمي إليه الكتاب؛ ولا أظن أن الجهة الناشرة للأطروحة الجامعية لبوخبزة تخلو من متخصصين في الفلسفة وفي تاريخ التفاعل بين النظار المسلمين في الفترة الكلاسيكية المتأخرة. ومن هنا، فإننا نرى أن تقديم المقرئ الإدريسي لكتاب الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين قد يكون مفيدا من نواح بعينها، لكننا لا نرى له أي فائدة تذكر من الناحية الأكاديمية والعلمية الصرف؛ والسبب هو ما ورد في التقديم من أمور تدخل في صميم ما يسميه المقرئ الإدريسي نفسه بالتخرصات والأغاليط، وقد وقفنا عندها أعلاه. فقد حصل الزج بموضوع تاريخي في خضم سجالات وخصومات مع جهات لا اختصاص لها بالموضوع؛ والحال أن هذا الموضوع ليس في حاجة إلى دعاة يطلقون الأحكام دون سند بقدر ما هو في حاجة إلى مختصين (مؤرخين) يقيدون أحكامهم وخلاصاتهم بوثائق وشواهد ويراجعون أحكام غيرهم من الدارسين، غربيين ومسلمين وغيرهم. بعبارة أخرى، نحن نفهم المحركات الدعوية و”الاعتذارية“ apologetic التي تحرك المقرئ الإدريسي والأمين بوخبزة؛ لكننا نفهم أيضا أن للدعوة وللاعتذار منطقهما وأهلهما وخطابهما ومؤسساتهما، كما للبحث التاريخي منهجه وأهله وخطابه ومؤسساته. لذلك، يجدر بنا أن نؤكد، أخيرًا، أن المجال الذي كتب فيه بوخبزة، وقدّم له الإدريسي، ليس أرضا مشاعا يدخلها من يشاء ويتحرك فيها كما يشاء، وإنما هو مجال له تقاليده وأعرافه العلمية التي ينضبط لها أهله المتخصصون فيه من كل أنحاء العالم؛ وهو، أيضا، مجال لا تُقَوّم فيه الدراسات بدرجة الصخب الذي تثيره، وعِظَم الأحكام الذي ترسله، وإنما تُقوَّم فقط بالقياس إلى ما تحصل من تراكم علمي في ذلك المجال، وما سجلته فيه تلك الدراسات من جديد، بالقياس إلى ذلك التراكم بالذات، على مستوى جدة الوثائق ورصانة التحليل. ولذلك، أيضا، فإن المجال الذي كتب فيه بوخبزة ليس أرضًا خلاء، وإنما هو أرض مأهولة، على الدّاخل إليها أن ينضبط لمعايير البحث والتراكم العلمي المتعارف عليها دوليا، حتى يكون قوله مفيدا للناس ويمكث في الأرض؛ وهو ما سنعود إليه في وقفة ثانية.
للتوثيق
بن أحمد، فؤاد. ”تاريخ الأفكار في السياقات الإسلامية بين إكراهات البحث ورهانات الدعوة: في الرد على المقرئ أبي زيد الإدريسي.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2739>
فؤاد بن أحمد
1] المقرئ أبو زيد الإدريسي، ”تقديم المقرئ أبي زيد الإدريسي،“ ضمن الأمين بوخبزة، الفقهاء والفلاسفة في الغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين: جدلية القبول والرفض (الرباط: منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2021)، 12.
[8] نظر: الإدريسي، ”تقديم،“ 13. وقد وردت العبارة في الأصل كما يلي: ”ومما يمكن أن أعزز به أطروحة أخينا الفاضل الأستاذ الأمين مصطفى بوخبزة.“
[14] أحمد ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق محمد رشاد سالم (الرياض: منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1986)، ج. 1، 358.
[18] يقول أبو حامد الغزالي: ”فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام.“ المستصفى من علم الأصول، دراسة وتحقيق حمزة بن زهير حافظ (المدينة المنورة: شركة المدينة المنورة للطباعة، 1413هـ)، ج. 1، 12؛ ويقول أيضا: ”المتكلم هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها، فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة، إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات.“ المستصفى من علم الأصول، ج. 1، 16.
[23] التهانوي، الكشاف، 41. ويقول الغزالي: ”صار [الفقه] بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأحكام المكلفين.“ المستصفى من علم الأصول، ج. 1، 8.
[25] يقول: ”إن فيلسوفا مثل أبي حامد الغزالي لا يمكن أن يحكم عليه بالانغلاق.“ ويقول أيضا: ”الغزالي معروف بأنه المحامي الأول عن المنطق اليوناني، ومعروف أنه من المتكلمين، والمتكلمة هم أقران للفلاسفة.“ الإدريسي، ”تقديم،“ 13.
[29] انظر: شمس الدين ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار صادر، 1978)، ج.1، 81.
[30] انظر: فهمي جدعان، المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام، ط. 3: منقحة (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014).
[32] انظر تفاصيل حياته ومماته في: الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار معروف عواد (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2001)، ج. 5، سيرة رقم 2095، 233–252. وانظر أيضا، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. 1، 88، 89.
[33] البغدادي، تاريخ مدينة السلام، ج. 5، 252.
[34] الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، ج. 5، 252.
[36] انظر: علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي (الإسكندرية: دار الفكر العربي، 1947)، 4.
[37] النشار، مناهج البحث، 242.
[38] النشار، مناهج البحث، 241.
[39] النشار، مناهج البحث، 242.
[40] النشار، مناهج البحث، 243.
[41] النشار، مناهج البحث، 247.
[42] انظر: علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي، ط. 2 (القاهرة: دار المعارف، 1965).
مقالات ذات صلة
محمد بن عمر بن أبي محلي وامتحان الناس بسجلماسة: مراجعة لمقالة كايتلين ألسون حول آفاق جديدة في دراسة العقيدة الأشعرية في الغرب الإسلامي بعد السنوسي
Muḥammad b. ʿUmar Ibn Abī Maḥallī and the Persecution of People in Sijlmassah: A Review of Caitlyn Olson's Article on New Perspectives on the Study of the Ashʿari Creed in the Post-Sanussi Islamic West Muḥammad b. ʿUmar Ibn Abī Maḥallī wa-mtiḥān al-nās bi-Sijilmāssa:...
حوار شامل مع فؤاد بن أحمد
حوار شامل مع فؤاد بن أحمد أنجزه محمد عبد الصمد الإدريسي (صحيفة المساء 4532، 6 يوليوز 2021) أنجزت مؤخرا بالتعاون مع روبرت پاسناو من جامعة كولورادو-بولدر مدخلا مفصّلا عن الفيلسوف ابن رشد بموسوعة استانفورد الفلسفية وهي أهم موسوعة فلسفية.. هل كان لا بد من كل هذا التأخر...
نقاش علمي حول تهافت الفلاسفة للغزالي: النص والسياق والأثر (الحلقة الأولى)
https://www.youtube.com/watch?v=gPdcapniS9M مقالات ذات صلة

