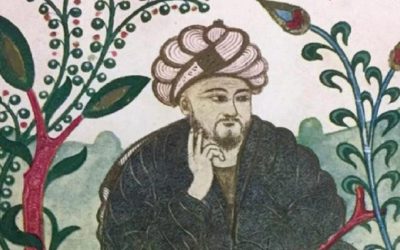![]()
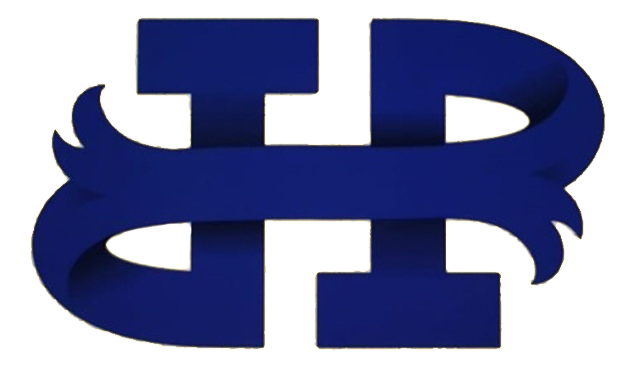
جانبٌ من المنعطف السِّينوي في علم الكلام السُّنِّي

جانبٌ من الـمُنعطف السّينويّ في علم الكلام السُّنّي[1]
روبرت ويسنوڤسكي[2]
جامعة ماكگيل، مونتريال
ترجمة هشام بوهدي[3]
جامعة القرويين، الرباط
تقديم الترجمة
ما أنوي كتابته في هذه الفقرة المختصرة ليس تقديماً لمضمون المقالة ولا لصاحبها؛ لأنّ المقالة قد أصبحت من كلاسيكيّات البحث في تاريخ الحركيّة الفكريّة (الفلسفيّة والكلاميّة) في السياقات الإسلاميّة؛ كما أن صاحبها روبرت ويسنوڤسكي هو أحد اللّاعبين المحوريّين في هذا المجال. ما أنوي التّأكيد عليه، في المقابل، هو الأبعاد التّربوية لهذه الترجمة. يُقدّم ويسنوڤسكي في دارسته جينيالوجيا دقيقةً للتّمييز الذي اشتهر به ابن سينا بين واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره/ممكن الوجود بذاته، عن طريق الحفر في النّصوص السابقة عليه سعيا عن وراء جذورها. وفي هذا الباب، يقوم بتقييد حكم معروف لابن رشد (ت. 595هـ/1198م) يفيد بأن ابن سينا (ت. 428هـ/1037م) قد أخذ منهجه في هذه القسمة من المتكلّمين المسلمين، وبخاصّةٍ المعتزلة، قبل أن تنتقل إلى الأشعريّة بتأثيرٍ من ابن سينا نفسه. طبعاً، نُشرت الدراسة عام 2004؛ ولا شكّ أنّ تاريخ البحث في المسألة قد عرف تحوّلاتٍ بفعل ظهور نصوصٍ وقراءاتٍ جديدةٍ في الموضوع؛ وهو أمر طبيعي ومحمود. ولكنّ أهمية المقالة لا تكمن، في تقديرنا، في مدى صوابيّة الاستنتاجات التي انتهى إليها ويسنوڤسكي—والتي يمكن التّفاعل معها في دراساتٍ مستقلّةٍ—، وإنّما في ما تفتحه المقالة، للباحثين من الذين يقرأون بالعربيّة، من أبواب ونوافذ لمزيد من البحث والمراجعة والتدقيق في مسائل وإشكالاتٍ نادراً ما تعكسها الكتابات العربيّة المنتشرة في الموضوع. وبالمناسبة، فعلى الرّغم من شهرة أعمال ويسنوڤسكي وقيمتها وتداولها بين الدّارسين والمختصّين، فإن هذه المقالة ربما تكون مقالته الثّانية التي تُترجم إلى العربيّة، بينما تُرجمت مقالاتٌ عدّةٌ له إلى الفارسيّة والتركيّة. وأتصور، من زاويةٍ بعينها، أنّ الإقدام على ترجمة المزيد من المقالات لهذا الدارس ولآخرين مثله، وهم كثر، من شأنه أن يحرّك مياه البحث في الجامعة المغربيّة، حيث يشكو الكثير من الطلبة والأساتذة نُدرة الموضوعات الجديرة بالبحث. ولكل هذا، فقد سعدنا بترجمة الباحث الجادّ هشام بوهدي الذي أقدم بهمّةٍ عاليّةٍ، معهودة فيه، على نقل هذا العمل الشّاق اعتماداً على أصوله العربيّة؛ إذ لا يوجد اقتباسٌ استعمله المؤلّف لم يرجع فيه المترجم إلى أصوله العربيّة. ولـمّا عرضنا التّرجمة على الزّميل الفاضل روبرت ويسنوڤسكي—والذي هو عضو الهيئة العلمية لمجلة الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية—سُرّ بها، كما رحّب بنشرها في موقعنا. فإليه، وإلى هشام بوهدي، أتوجّه صادقاً بجزيل الشّكر.
فؤاد بن أحمد
—————————————————————-
نص المقالة المترجمة
يتّفق معظم دارسي تاريخ الفكر الإسلاميّ في الوقت الحاضر على تشوّه الصّورة الغربيّة التّقليديّة التي تُقدّم أبا حامدٍ الغزاليّ (ت. 505هـ/1111م) بوصفه الـمُحاميَ عن عقيدة أهل السّنّة، الّذي كان كتابه تهافت الفلاسفة نقداً في غاية القوّة، تسبّب في القضاء على النّشاط الفلسفيّ في الحضارة الإسلاميّة.[4] وقد خلص بعض هؤلاء، في الواقع، إلى أنّ أهميّة الغزاليِّ، في تاريخ علم الكلام والفلسفة الإسلاميّة، تنبع من حرصه على إدماج الأفكار الميتافيزيقيّة الأساسيّة في المذاهب المركزيّة للكلام السّنيّ، بقدر ما تنبع من تنكيله ذائع الصّيت بالفلاسفة. غير أنّ الّذي ليس معروفاً كثيراً هو أنّ دور الغزاليّ في ”فلسفة“ [philosophizing = إضفاء الطّابع الفلسفيّ] كلام أهل السّنّة لم يكن مجرّد جهدٍ فرديٍّ لنابغةٍ واحدٍ، وإنّما كان جزءاً من توجّهٍ أوسع، يبدو أنّه قد بدأ خلال فترة حياة ابن سينا، ثم ازدادت سرعته خلال الجيلين الأوّل والثّاني اللّذين تليا وفاته في العام 428هـ/1037م، وذلك من خلال الجُهود التي قام بها شيخ الغزاليّ، الأشعريُّ أبو المعالي الجوينيّ (ت. 478هـ/1085م)، والماتريديُّ أبو اليسر البَزْدَوِي (ت. 493هـ/1099م)، وهي الجهود الّتي استأنفها بعدهما العشراتُ من الأعلام المتأخّرِين التّابعِين لهاتين المدرستين الكلاميّتين الرّائدتين. ومن الواضح، في الحقيقة، أنّ الخطّ الفاصل بين المتكلّمين السّنيّين الّذين عادةً ما يُشار إليهم، في التّقليد الإسلاميّ المتأخّر، باسم ”المتقدّمين،“ وأولئك الذين يُشار إليهم باسم ”المتأخّرين،“ لم يكن هو الغزاليّ، وإنّما كان هو ابن سينا نفسه. لذلك، فالمنعطف الّذي شَهِدَه الكلام السّنيّ قد كان سينويًّا، ولم يكن غزاليًّا.
ويُمكننا أخذ صورةٍ شاملةٍ عن هذا المنعطف السّينويّ من خلال التأمّل في كتاب التّوحيد لأبي منصورٍ الماتريديّ (ت. 333هـ/944م)، وهو الكتاب الذي صرنا قادرين على تقويم مصادره ومحتوياته وأثره بشكل أفضل، منذ أن نُشرت الدراسة المونوگرافية الحديثة لأُلرِيش رُدُولف(Ulrich Rudolph).[5] فقد تبيّن أنّ الماتريديّ في الوقت الّذي قدّم فيه العديد من الإسهامات المفاهيميّة الهامّة في النّقاشات الكلاميّة حول جملةٍ من القضايا الإشكاليّة —لاسيما أدلّته في إثبات قدم صفات الفعل [الإلهي]، والتي سأتطرّق إليها باختصارٍ في موضعٍ لاحقٍ من هذا المقال—، فإن الطّريقة التي هَيْكَلَ بها كتابه التّوحيد لا تقلّ عنها أهميّة. والسّبب في ذلك أنّ ترتيب الموضوعات الّذي جاء به الماتريديّ في هذا الكتاب، قد زوّد المتكلّمين اللّاحقين بنموذجٍ (template) سار على منواله معظمُهم في كتاباتهم ومصنّفاتهم الخاصّة.
ففي كتاب التّوحيد،[6] يبتدئ الماتريديّ بمناقشةٍ عامّةٍ لنظريّة العلم [الابستمولوجيا] (3–11)؛ ومن ثمّ ينتقل للحديث عن حدوث العالم ووجود الصّانع (11–37)؛ وبعدها يُناقش وحدانيّة الله والإشكاليّات المتعلّقة بالصّفات الإلهيّة (38–85)، ويُقوِّم أقاويل الإسلاميّين وغير الإسلاميّين بخصوصها (86–176)؛ ثمّ يحلّل مفهوم النّبوّة (176–215)؛ ويُعبّر في الأخير عن موقفٍ معتدلٍ بخصوص مسائل: خلق أفعال العباد (215–323)، والذّنوب وعقاب مقترفيها (323–372)، والإيمان (373–401).
ويكتسي هذا النّموذج [الموضوعاتيّ] الّذي اعتمده الماتريديّ أهميّةً خاصّةً، نظراً لأنّ ترتيبه المعياريّ الجديد للموضوعات [الكلاميّة] —وبالأخصّ الموضوعات الثّلاثة الأولى: (1) نظريّة العلم [الابستمولوجيا]، (2) الوجود الإلهيّ، (3) وحدانيّة الله وصفاته— قد وفّر إطاراً مفاهيميّاً استطاعت من خلاله الإلهيّاتُ السّينويّةُ—وبخاصّةٍ تمييزُ ابن سينا بين الماهيّة والوجود، وبين واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره/ممكن الوجود بذاته—الاندماجَ بشكلٍ تدريجيٍّ داخل المصنّفات الكلاميّة اللّاحقة.
فبالنّسبة للموضوع الأوّل، وهو نظريّة العلم، فإنّنا نجد التّمييزات الكلاميّة-السّنيّة، في حقبة ما قبل ابن سينا، بين طرقٍ ثلاثةٍ للعلم (الحسّ، والخبر، والنّظر) وبين نوعيْن من أنواع العلم (المكتسَب، والضّروريّ)، قد كسفتها التّمييزات الكلاميّة-السّنيّة، في حقبة ما بعد ابن سينا، بين موضوعيْن رئيسيْن للعلم (الماهيّة، والوجود) وبين أقسامٍ ثلاثةٍ للعلم (الواجب، والممكن/الجائز، والمستحيل/الممتنع). أمّا بخصوص الموضوع الثّاني، وهو الوجود الإلهيّ، فإنّنا نجد التّمييز الكلاميّ-السّنيّ، في حقبة ما قبل ابن سينا، بين الله بوصفه قديماً والعالم بوصفه مُحدَثاً، قد أخلى المجال للتّمييز الكلاميّ-السّنيّ، في حقبة ما بعد ابن سينا، بين الله بوصفه واجب الوجود بذاته والعالم بوصفه ممكن [أو جائز] الوجود بذاته. أما فيما يخصّ الموضوع الثّالث، وهو المتعلّق بوحدانيّة الله وصفاته، فإنّنا نجد النّقاشات الكلاميّة-السّنيّة، في حقبة ما قبل ابن سينا، حول الطّبيعة الدّقيقة لقِدَم الصّفات الإلهيّة، قد حلّت محلّها النّقاشات الكلاميّة-السّنيّة، في حقبة ما بعد ابن سينا، حول الطّبيعة الدّقيقة لوجوب الصّفات الإلهيّة.
وقد أُنجزت بالفعل بعضُ الدّراسات الهامّة، وإنْ كانت لا تزال في بدايتها، حول تاريخ هذه النّقلة الابستمولوجيّة (وأبرزها عمل جُوزيف ڤَانْ إِيسْ Josef Van Ess)، وحول تاريخ استعمال مفهوميْ ”الوجوب“ و”الإمكان“ في الأدلّة الكلاميّة ما بعد-السّينويّة حول الوجود الإلهيّ (وفي طليعتها عمل هربرت أ. دَاڤِيدْسُون Herbert A. Davidson).[7] لكن، على حدّ علمي، لا أحد شَرَعَ في فحص هذا المُنحنى الموصوف بالمنعطف السّينويّ في النّقاشات الكلاميّة-السّنيّة حول الصّفات الإلهيّة. وعليه، فإنّ هدفي، في هذا المقال، هو تحديد موقع نظريّة ابن سينا عن ”واجب الوجود بذاته“ ضمن تاريخ هذا الجانب الأخير [أي المتعلّق بالصّفات الإلهيّة] من كلام أهل السّنّة.
وما آمله، بوجهٍ خاصٍّ، هو أن أُظهر بأنّ المتكلّمين السّنيّين، لكي يُفسّروا طبيعة القِدَم الّذي تختصّ به الذّات والصّفات الإلهييّن، قد انتقلوا من المواقف المتقدّمة، في حقبة ما قبل ابن سينا، الّتي يذهب أصحابها إلى أنّ ما يقصدونه حقيقةً بالشّيء القديم عندما يُعرّفونه بأنّه ”ما لا أوّل لوجوده“ هو أنّ الشّيء القديم غيرُ معلولٍ، إلى المواقف المتأخّرة، في حقبة ما بعد ابن سينا، الّتي يذهب أصحابها إلى أنّ ما يقصدونه حقيقةً بالشّيء القديم عندما يُعرّفونه بأنّه ”ما لم يَزَل ولا يَزَال“ هو أنّ الشّيء القديم يستحيل عدمُه، وبأنّه لذلك واجبُ الوجود. وعلاوةً على ذلك، فالطّرق المختلفة التي قعّد بها ابن سينا نظريّته، لا يجب أن يُنظر إليها من زاوية تأثيرها في التّصوّرات الكلاميّة المتأخّرة فحسب، وإنّما أيضاً من جهة كونها، في بعض النّواحي الهامّة، تفاعلاً مع النّقاشات الكلاميّة المبكّرة.[8]
وسأبدأُ بالتّركيز على الالتزامات المذهبيّة الّتي وجّهت النّقاشات الكلاميّة حول الصّفات الإلهيّة في فترة ما قبل ابن سينا. ومن ثمّ، سأحلّلُ المعضلات الفلسفيّة التي تولّدت عن تلك الالتزامات. وبعدها، سأتطرّقُ بإيجازٍ إلى المصادر المباشرة لتمييز ابن سينا بين واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره/ممكن الوجود بذاته، وسأتعرّضُ لمناقشة صياغتيْه المبكّرتيْن لهذا التّمييز: الصّياغة الأولى (يعود تاريخها إلى 391هـ/1001م)، والّتي كانت، في جزءٍ منها على الأقلّ، عبارةً عن محاولةٍ لحلّ تلك المعضلات الكلاميّة المتقدّمة؛ والثّانية (يعود تاريخها إلى 403هـ/1013م)، التي تكادُ تكون مطابقةً لأحد النقاشات الأشعريّة (المحتملة) في عصر ابن سينا. وفي الأخير، سأعرضُ عدداً من المقاطع المأخوذة من النّصوص الكلاميّة-السنيّة في القرن الخامس الهجريّ/الحادي عشر الميلاديّ؛ وذلك قصد تسليط الضّوء على ما حظيت به نظريةُ ابن سينا من انتشارٍ سريعٍ وواسع النّطاق.[9]
- ما قبل ابن سينا
خلال القرنين الثّالث والرّابع للهجرة/التّاسع والعاشر للميلاد، دَأَبَ المتكلّمون المسلمون على اعتبار القِدَم أهمّ الصّفات الإلهيّة. والسّبب في ذلك أن المتكلّم عندما يصرّح بأنّ الله قديمٌ، فإنّه يستعمل هذه العبارة لتحقيق غايتين مختلفتين:
[الغاية الأولى:] لقد بنى المعتزلة، وبعدهم المتكلّمون السّنيون، واحداً من أدلّتهم لإثبات الوجود الإلهيّ [وهو المعروف بدليل حدوث العالم] على أساس الطّبيعة المتناقضة للمقابلة بين القديم والمحدَث. [والصّيغة المختصرة لهذا الدّليل هي كالآتي:] بما أنّ الأشياء لا تخلو أن تكون قديمةً أو محدثةً؛ وبما أنّ كل محدَثٍ يفتقر إلى محدِثٍ؛ فحينئذٍ، لكيلا نقع في التّسلسل، لا بدّ أن تنتهي سلسلة الأشياء المحدَثة والمحدِثة إلى محدِثٍ ليس بمحدَثٍ. وحيث إنّه لا يوجد شيءٌ —ما عَدَا القديم— إلّا وهو محدَثٌ، فإنّ هذا المحدِث الأخير لا بدّ أن يكون قديماً. وهذا المحدِث القديم والأخير هو الله تعالى.
[الغاية الثّانية:] لقد استعمل المتكلّمون السّنيّون فكرة قِدَم الصّانع من أجل غايةٍ أخرى، وهي: التّأكيدُ على اختلافهم الجوهريّ مع المعتزلة بخصوص حقيقة الصّفات الإلهيّة وتميزها [عن الذات]، كما هو الشّأن بالنّسبة لصفة العلم والقدرة والحياة وغيرها. فقد ذهب السّنيّون، الّذين أطلقوا على أنفسهم ”أصحابَ الصّفات“ وأتباعَ المتكلم المتقدّم المناهض للمعتزلة عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب (ت. حوالي 241هـ/855م)، إلى القول بأنّ الصّفات لها وجودٌ حقيقيٌّ ومستقلٌّ، وهو وجودٌ يُخولّـها أن لا تكون فقط مماثلةً لذات (أو نفس) الله أو مُضمّنة فيها، كما قال بذلك المعتزلة الأوائل، كأبي الهُذَيل العلّاف (ت. 226هـ/841م) وإبراهيم بن سيّار النّظّام (ت. حوالي 225هـ/840م). وقد استدلّ أهل السّنة [على وجهة نظرهم] بالقول إنّ الصّفات ما دامت معاني حقيقيّةً وملازمةً للذّات الإلهيّة، فإنّها تكون بذلك قديمةً أيضاً، شأنُها في ذلك شأنُ الإله الموصوف بالقِدَم.
وعلى الجملة، يُمكن القول إنّ فكرة قِدَم الإله قد أدّت خدمةً مزدوجةً لصالح المتكلّمين السّنيّين: فقد ساعدتهم، من جهةٍ، في إثبات افتقار العالم المحدَث لمحدِث قديمٍ؛ كما ساعدتهم، من جهةٍ ثانيةٍ، في البرهنة على قِدَم الصّفات الإلهية وتميّزها [عن الذّات]. ومع ذلك، فإنّ ثمّة تنافيّاً جوهريّاً بين هذين الاستعمالين للقِدَم؛ إذ الأوّل موجّهٌ ضدّ الدّهرية، الّذين يعتقدون بقِدَم العالم؛ في حين أنّ الثّاني موجّهٌ ضدّ المعتزلة، الّذين أنكروا قِدَم الصّفات وزيادتها على الذّات. وقد كان [هاجس] حلّ مشكلة التّعارض هذه، أو الالتفاف حولها على الأقلّ، هو المحرِّك الّذي قَادَ هذا الجانب من المُنعطف السّينويّ في الكلام السّنيّ.
وكان من بين نتائج استعمال كلٍّ من المتكلّمين المعتزلة والسّنيّين لفكرة قِدَم الإله في أدلّتهم على وجوده أن مصطلح ”القِدَم“ قد خضع لتحوّلٍ دلاليٍّ، حيث انتقل من الدّلالة على ”التّقدّم“ [في الوجود] إلى الدّلالة على ”عدم المعلوليّة.“[10] وبحسب القاضي عبد الجبّار (ت. 415هـ/1025م)، فالمتكلّم المعتزلّي أبو عليٍّ الجبّائيّ (ت. 303هـ/915م)، الّذي درّس أبا الحسن الأشعريّ (ت. 324هـ/935م) قبل انضمامه إلى صفوف الكُلاَّبية، قد عرّف القديمَ بأنّه ”المتقدّم في الوجود.“[11] ويُعرّف الجبّائيّ القديم، في كتبٍ أخرى، كما ينقلُ عنه عبد الجبّار، بأنه ”ما لا أوّل لوجوده.“[12] وعلى الرّغم من انشقاق الأشعريّ عن المعتزلة، فإنّ كِلاَ تعريفيْ الجبّائيّ قد عَادَا إلى الظّهور في مصنّفات متأخّري الأشاعرة. فأبو بكر ابن فُورك (ت. 406هـ/1015م)، على سبيل المثال، يستعمل تعريف ”التّقدّم في الوجود،“ مشيرًا إلى أنّه التّعريف الّذي استعمله الأشعريّ بنفسه.[13] كما نجد أشعريًّا آخر، وهو أبو عبد الله الحليمي (ت. 403هـ/1012م)، يُعمل تعريف ”ما لا أوّل لوجوده“ على القديم؛ لكنّه يستعمل مصطلح ”الابتداء“ بدل مصطلح ”الأوّل،“ وهو ما يعكسُ، في اعتقادي، بدايات التحوّل الدّلاليّ الّذي أشرتُ إليه.[14] والسّبب في ذلك أنّ مصطلح ”الابتداء“ مُلتبِسٍ؛ إذ على غرار مصطلح ”arkhê“ اليونانيّ، فمصطلح ”الابتداء“ العربيّ هو الآخر يُمكن أن يُراد به ”الأوّل،“ كما يُمكن أن يُراد به ”المبدأ.“
والسّبب المنطقيّ وراء هذا التّحول من ”ما لا أوّل له“ إلى ”ما لا علّة له“ واضحٌ للغاية. فإذا كنتُ متكلّماً، وكان غرضي الأساس من القِدَم هو استعماله في الأدلّة على وجود الإله، فحينئذٍ سأرغبُ في أن تكون الطّبيعة المتناقضة للتقابل بين ”القديم“ و”المحدَث“ هي مَدَارَ معنى هذين المصطلحين. وبعبارةٍ أخرى، سيكون من السّهل عليّ أن أُثبت وجود الإله إذا ما عرَّفتُ القديم بحيثُ يعني لا فقط ”ما لا أول له،“ وإنّما أيضًا ”ما لا علّة له.“ وهذا راجعٌ إلى أنّ فكرة ”ما لا علة له“ سوف تُرضي توقّعاتي بخصوص الطّبيعة التي ينبغي أن يكون عليها مقابل اسم المفعول ”المحدَث،“ على نحوٍ أكمل بكثيرٍ مما سوف تفعل فكرة ”ما لا أول له.“
وحَسب ما يُورد القاضي عبد الجبّار، فالجبائيّ قد تعامل مع ”القديم“ و”المحدَث“ بوصفهما ”نقيضين“: حيث اعتبر القول بوجود شيءٍ واحدٍ قديمٍ ومحدَثٍ في الآن نفسه مما يتناقض.[15] وهذه عند المعتزلي مسألةٌ واضحةٌ بما فيه الكفاية، ما دام أنّه يعتبر الله هو وحده القديم، وما عداه فهو محدَث. وكما هو الشّأن بالنّسبة لسائر الأشياء المتناقضة، فلا وجود لوسطٍ بين القديم والمحدَث. غير أنّي إذا كنتُ متكلّماً سنّياً، فحينئذٍ سأكون قد عقدتُ التزاماً آخر بشأن مسألة القِدَم، يُخفّف من حدّة هذا التّقابل. فعلى عكس نظيري المعتزليّ، فأنا أعتقدُ أن الله ذاته ليس هو الموضوع الوحيد الّذي يمكن حمل ”القِدَم“ عليه؛ إذ تُعتبر الصّفات الإلهيّة قديمةً بدورها. وسوف أُراجعُ بإيجازٍ تاريخ مشكلة قِدَم الصّفات الإلهية، لأبين، من ثمّ، لماذا ولّدت معضلةً في أوساط المتكلّمين السّنيّين.
من أجل تدعيم تصوّرهم المتشدّد للوحدانيّة الإلهيّة، قسّم المعتزلة الصّفات إلى قسمين: ”صفات الذّات،“ و”صفات الفعل.“ أما بالنّسبة لصفات الذّات، كصفة العلم، فإنه يُمكن حملها على الله دون أن تُحيل على خلقه. في حين أنّ صفات الفعل، كصفة الرّزق، لا يُمكن حملها على الله إلا وهي مقترنةٌ بالإحالة على خلقه. وكما يرى المعتزلة، فصفات الذّات، بما في ذلك العلم والقدرة والحياة، لا ينبغي أن تُفهم، بأيّ شكلٍ من الأشكال، على أنّها صفاتٌ بائنةٌ عن الذّات؛ وبدلاً من ذلك، فإنّ الله ”عالمٌ بنفسه.“[16] وقد ذهب أبو الهُذيل حدّ الادّعاء أنّ صفات الله هي عين ذاته، وهو ما أكّده بقوله: إنّ الله ”عالمٌ بعلمٍ هو هو.“[17] وقد أعاد النّظّام صوغ هذه المقالة بطريقة مختلفة، ذاهباً إلى أنّ الله ”لم يزل“ متّصفاً بصفات ذاته. فعلى سبيل المثال، فالله ”لم يَزَل عالماً بنفسه.“[18] وممّا ورد في إحصاء كلٍّ من أبي الهذيل والنّظّام لصفات الذّات: أن الله تعالى قديمٌ. وعليه، فإن الله، بموجب صيغة أبي الهُذيل، ”قديمٌ بقدمٍ هو هو“؛ أما بحسب صيغة النّظّام، فإنّه ”لم يزل قديماً بنفسه.“
وتبدو وجهة نظر ابن كُلّاب، للوهلة الأولى، شبيهةً بتوليفةٍ بين صيغتيْ النّظّام وأبي الهُذيل، وذلك عندما ذهب إلى أنّ الله ”لم يزل عالماً بعلمٍ.“ غير أنّ ابن كُلّابٍ يُعارض نظرية أبي الهُذيل القائلة بعينيّة الصّفات للذات، ويرى، في المقابل، أنّ الله عالمٌ بعلمٍ ”له“ و”قائمٍ به.“ ومن ثمّ، يُجري صيغته الجديدة هذه بطريقةٍ مماثلةٍ على بقيّة الصّفات التّسع والعشرين (29) الّتي أحصاها إلى جانب ”العلم.“ وعلى العموم، يدعي ابن كُلّاب أنّ صفات الله قائمةٌ ”بذاته،“ وبأنّها ”لا هي الله ولا هي غيره.“[19] إلّا أنّ الملفت للنّظر في وصف مذهب ابن كُلّاب هو عدم إدراجه ”القديم“ ضمن قائمة الثّلاثين صفةً (30). وعوضاً عن ذلك، نجده يُذيّل نهاية قائمته بجملةٍ اعتراضيّةٍ غامضةٍ، يقول فيها عن الله: ”إنّه قديمٌ لم يَزَل بأسمائه وصفاته.“[20] فلماذا خصّ ابن كلابٍ صفة ”القديم“ بهذه المعاملة الخاصّة، بينما رأى فيها أبو الهُذيل والنّظّام مجرّد صفةٍ أخرى من صفات الذّات؟
أظنّ أنّ ابن كُلّابٍ كان يُلمّح إلى أنّ صفة ”القديم“ لها طبيعةٌ خاصّةٌ؛ وذلك لأنّها صفةٌ فوقيّةٌ (meta-attribute)، وليست صفةً عاديّةً. ومن أهمّ خصائص الصّفات الفوقيّة، كصفة القديم، أنّها تقبل أن تُحمل لا على الذّات الإلهيّة فحسب، وإنّما أيضاً على بعض أو كلّ صفات الله العادية.[21] فعلى سبيل المثال، عندما يقرّر المتكلّم السّنيّ أن الله ”موجودٌ،“ وبأنّه متّصف لذلك بصفة ”الوجود،“ فحينها يكون مُلزما بأن يقرّر ما إذا كانت كلّ صفةٍ من الصّفات الإلهيّة الأخرى متّصفة على النّحو نفسه بصفة ”الوجود“ أم لا.
وعليه، فإنّ السّبب الّذي جعل ابن كُلّابٍ ينظر إلى صفة ”القديم“ باعتبارها صفةً فوقية (meta-attribute)، في الوقت الّذي اكتفى فيه المعتزلة، في المقابل، بالنّظر إليها من زاوية كونها مجرّد صفةٍ أخرى من صفات الذّات الكثيرة، هو أنّه قد كان شديد الالتزام بالتّأكيد على أزليّة الصّفات. وقد كان موقفه هذا عبارةً عن خطوةٍ اتّخذها في سبيل مُعارضة المحنة العبّاسيّة (218-234هـ/833-848م)، الّتي أُجبِر فيها الفقهاء على الاعتراف بقرار المعتزلة بأن القرآن مخلوق.[22] ففي تصوّر ابن كلاّب، إن القرآن، بما هو صفة كلام الله، ليس فقط شيئاً زائداً على الذّات الإلهيّة، وإنما شيئاً مشاركاً لها في القِدَم أيضاً. ويبدو أنّ هذا هو الباعث الّذي جعل ابن كُلّابٍ يرغبُ في تمييز ”القِدَم“ عن بقيّة الصّفات الأخرى.
بيد أنّ هذه المكانة الخاصّة الّتي منحها ابن كُلّابٍ لصفة ”القديم“ قد أوقعت أتباعه في حيرةٍ من أمرهم؛ إذ كان عليهم الاختيار بين خيارين اثنين. أما الأوّل، فهو الأخذُ بالمبدأ العامّ الذي قارب به ابن كلاب الصّفات الإلهيّة —الله هو ”أ“ [اسم الفاعل] بـ ”أ“ [المصدرية] التي له— وتطبيقُه بنحوٍ مماثلٍ على ”القديم“؛ وفي هذه الحالة، يكون الله ”قديماً بقدمٍ له.“ أما الخيار الثّاني، فهو اعتبار صفة القدم (وبقيّة الصّفات الفوقية بالتّبع) استثناءً من المبدأ العامّ الذي قرّره ابن كُلّابٍ؛ وفي هذه الحالة، يكون الله قديماً ”بنفسه،“ وليس ”بقِدَمٍ له.“[23]
ولم يكن أيٌّ من هذين الخيارين خِلْواً من العيوب. فعلى الرّغم مما يتمتّع به الخيار الأوّل من انسجامٍ واتّساقٍ، فإنّه يضع أصحابه في وضعٍ شائكٍ: فإذا قدّرنا جدلاً أنّ الله قديمٌ بقدمٍ له، [فحينها يأتي السّؤال:] ماذا عن بقيّة الصّفات الأخرى —من قَبِيل العلم والقدرة والكلام—؟ هل هي قديمةٌ أم غير قديمةٍ؟ فإذا لم تكن قديمةً، فحينئذٍ لن تكون صفة الكلام قديمةً أيضاً. ممّا يعني أنّ القرآن لن يكون قديماً. وهذا بالذّات هو موقف المعتزلة الّذي كان الكلاّبيّة شديدي الحرص على النّأي بأنفسهم عنه.
لكن، من ناحيةٍ أخرى، إذا افترضنا بأن الصّفات قديمةٌ، وصحّ لنا أن نستنتج من كون الله ”قديماً بقدمٍ له“ أنّ أيّ صفةٍ من صفاته ستكون بدورها ”قديمةً بقدمٍ لها“؛ فحينئذٍ سيكون لكل صفة من الصّفات الإلهيّة صفةُ ”قِدَمٍ“ خاصّةٍ بها. [وهنا يأتي السّؤال:] ماذا عن صفات ”القِدَم“ الزّائدة هذه؟ هل ستكون كلّ واحدةٍ منها قديمةً أيضاً بقدمٍ لها؟ يظهر من هذا أنّ ”الكُلّابيّ“ لو قرّر سلوك هذه الطّريق، فمن الواضح أنّه سيكون من الصّعب عليه تجنّب الوقوع في تكثّر القُدماء.[24]
والنّتيجة أنّه من أجل تفادي القول بمقالة المعتزلة بشأن خلق القرآن، وتفادي السّقوط في مشكلة تكثّر القدماء المذكورة للتّو، اضْطُرّ أتباع ابن كُلاّبٍ إلى القول بعدم انطباق المبدأ الكلاّبي العامّ بخصوص الصّفات —الله هو ”أ“ [اسم الفاعل] بــ ”أ“ [المصدرية] التي له— على الصّفات الفوقية (meta-attributes)، والقول تبعاً لذلك بأن الله قديمٌ بنفسه، وليس بقدمٍ له. صحيحٌ أن صيغة ”قدم الله بنفسه“ تفوحُ منها رائحة الاعتزال؛ إذ إنّها مطابقةٌ، من جميع الجوانب، لمقالة النّظّام الّتي أشرنا إليها آنفاً. إلّا أنّه يبدو أن الهواجس المحدّدة [الّتي كانت لدى الكُلّابيّة]، بخصوص الانتصارِ لعدم خلق القرآن مهما كلّف من ثمنٍ وتفادِي الوقوع في تكثر القُدماء، قد طَغَت على مخاوفهم من أن يظهروا شديدي الشّبه بالنّظّام [المعتزليّ].
وقد بقي الكُلّابيّة، على الرّغم من تبنّيهم لمقالة ”قدم الله بنفسه،“ عالقين مع المشكلة المتعلّقة بتحديد طبيعة القِدَم الذي تختصّ به الصّفات الإلهيّة. وقد كان بين أيديهم خياران اثنان:
فمن جهة أولى، يمكن للكلابيّ أن يزعم أنّ كلّ صفةٍ من الصّفات الإلهيّة، كما هو الشّأن بالنّسبة للذّات، قديمةٌ بنفسها. غير أن هذا يُثير بضعة مشاكل عويصة. أوّلها، أن الصّفات، بمعناها الدّقيق، ليست عبارةً عن أنفسٍ (أو ذواتٍ)، بل إنّها مجرّد معانٍ تُضاف إلى الأنفس (أو تكون للأنفس، بالتّعدي). وثانيها، أن الكلابيّ كلّما أكّد على قدم الصّفات بشكلٍ صريحٍ، كلّما أظهرها بذلك في صورةٍ أكثر استقلاليّةً من النّاحية السّببيّة [أي أكثر قياماً بنفسها]، وبخاصّةٍ عندما نأخذ في حسباننا ما وقفنا عنده سلفاً من توجّه المتكلّمين إلى اعتبار فكرة ”عدم المعلوليّة،“ وليس فقط فكرة ”ما لا أول له،“ هي الرّكيزة الأساسيّة في تصوّر مفهوم القِدَم. وبعبارةٍ أخرى: إذا قرّر الكُلّابيّ بصريح العبارة أنّ جميع الصّفات قديمةٌ بنفسها، فسيكون عرضةً لخطر رسم صورةٍ يُنظر فيها إلى الصّفات الإلهيّة كما لو أنّها أعيانٌ منفصلةٌ عن الذّات المتّصفة بها وغير مفتقرةٍ في وجودها إليها؛ وهو ما سيعرّضه بدوره لتُهمة الشّرك.[25]
لكن، من جهةٍ ثانيّةٍ، يمكن للكُلّابيّ أن يتمسّك بصيغة ابن كُلّابٍ الغامضة نسبيّاً (الله قديمٌ لم يزل بأسمائه وصفاته)، ويتفادى، من ثمّ، أيّ اتهاماتٍ له بالشّرك نتيجة إطلاقه القول بكون كلّ الصّفات الإلهيّة قديمةً.[26] غير أنّ الخطر الوحيد في تبنّي صيغة ابن كُلّابٍ هذه —بصرف النّظر عن غموضها — يكمن في أنّ اعتناقها يُمكن أن يَحْمِلَ خصوم الكُلّابيّة على سوء تمثّل الموقف الكُلّابيّ بالزّعم أنّ الكلّابيّة قد صيّروا الله معلولاً بجعله قديماً بواسطة صفاته؛ ذلك أنّ من المعاني المستخلصة من حرف الجرّ ”بِـــ“ (في النّصوص الكلاميّة والفلسفيّة على الأقلّ) أنه سببيّ، إما ”بواسطة“ أو ”من خلال“ شيءٍ ما. وباختصار، عندما يقرّر الكُلّابيّ أنّ الله قديمٌ بصفاته، فإنّه يجعل نفسه —وإنْ بنسبةٍ ضئيلةٍ— أمام خطر اتّهامه بالتّلميح إلى أنّ الله قديم بواسطة صفاته، في حين أنّ ما يقصده بكلّ بساطةٍ هو أنّ الله قديم في صفاته أو معها.
هذه هي المعضلات الّتي وجد الأشعريّ نفسه في مواجهتها، عند تخلّيه عن مذهب المعتزلة والتحاقه بصفوف الكُلّابيّة. وربما لو أنّ الأشعري اعتنق في آنٍ واحدٍ القول بأنّ الله قديمٌ بقدمٍ وبأنّ الصّفات الإلهيّة قديمةٌ، لكان سيُفهم موقفه هذا على أنّه اعتقادٌ منه بالمذهب القائل إنّ الصّفات قديمةٌ بقدم؛ وهو ما سيتولّد عنه تسلسلٌ لامتناهٍ للقُدماء الفوقيين. أمّا لو أنّ الأشعريّ اعتنق، في المقابل، القول بأنّ الله قديمٌ بنفسه وبأنّ الصّفات الإلهيّة قديمةٌ، فربّما كان سيُفهم صنيعه، من زاويةٍ أخرى، على أنّه اعتقادٌ منه بالمذهب القائل إنّ الصّفات قديمةٌ بنفسها؛ وهو ما قد يُنتج ملأٌ من الصّفات القائمة بذاتها والمستقلة سببيًا.
وقد كان بإمكان الأشعريّ، بطبيعة الحال، أن يتفادى الوقوع في هذا المأزق عن طريق إنكاره قدمَ الصّفات من أصله؛ غير أنّ هذا لم يكن خياراً مقبولاً ألبتّة، لأنّه سيُلزمه بالاعتراف بأنّ القرآن، بما هو صفة كلام الله، مخلوقٌ. وبدلا من ذلك، يمكن القول إنّه كان بإمكانه الالتزامُ بصيغة ابن كُلّابٍ الغامضة —الله قديمٌ لم يزل بأسمائه وصفاته— كما هي؛ غير أنّ هذا سيمثّل، من وجهة نظرٍ فلسفيّةٍ، نكوصاً منه إلى الغموض بدلاً من المضيّ نحو مزيدٍ من التّدقيق، وهو غموضٌ قد يستغلّه الخصوم ضدّه.
وهكذا، فقد اعتبر الأشعريّ نفسه بوضوحٍ متكلّما كُلّابيّاً فيما يخصّ قدم الصّفات الإلهيّة، وهو ما جعله يصرّح في أحد السّياقات بأن ”الدّلالة [دلّت] على قِدَم البارئ تعالى.“[27] لكنّه، مع ذلك، لم يحسم أمره أبداً بشأن ما إذا كان يجب وصف الله بأنّه ”قديمٌ بقدمٍ“ أو ”قديمٌ بنفسه“؛ ربما بسببٍ من الإلزامات الوخيمة الّتي تنشأ عن اختيار أيٍّ من هذين الخيارين. وفي الحقيقة، فقد أقرّ المتكلّم الأشعريّ أبو بكرٍ ابن فُورك بأنّ خصوم مدرسته كانوا مصيبين في نقدهم تخبّط الأشعريّ في هذه المسألة. وذلك أنّ الأشعريّ، بحسب ابن فُورك، قد تبنّى، في بعض نصوصه، تفسيراً بنائياً-صارمًا لمذهب ابن كُلّابٍ (وهو الّذي يقول فيه بأنّ: الله قديمٌ بقدم)؛ كما تبنّى، في نصوصٍ أخرى، تفسيراً بنائياً-رخواً لمذهبه (وهو الّذي يقول فيه بأنّ: الله قديمٌ بنفسه).[28] ويؤكّد ابن فورك، في سياق تعقيبه على هذه الازدواجيّة الّتي بَصَمَت مواقف الأشعريّ، على أنّ التّفسير البنائيّ-الصّارم هو الّذي يعكس الموقف الأصيل لابن كُلّابٍ؛ وهو الحكمُ الّذي أعاده، قرناً بعد ذلك، المتكلمُ الماتريديّ أبو المعين النّسفيّ (ت. 508هـ/1114م)، الّذي زعم أنّ الماتريديّة هم الورثة الحقيقيّون لابن كُلّابٍ في هذه المسألة، وأنكر على الأشعريّ انحرافه عن رأي ابن كُلاّبٍ فيها.[29] غير أن المتكلّم الأشعريّ المعاصر لابن فُورك، أبو بكر الباقلانيّ (ت. 403هـ/1013م)، يُوثر اتّباع أصحاب التّوجّه البنائيّ-الرّخو، من خلال تبنّيه لمقالة قدم الله بنفسه ([أو على حدّ عبارته:] ”إذ لنفسه كان قديماً“).[30]
ويمكن أن يشعر متكلّمٌ سنيٌّ، كالباقلانيّ، إذْ تخلّى عن صيغة ابن كُلّابٍ، من خلال القول بقدم الله بنفسه بدلاً من القول بقدمه بقدمٍ، أنه على الأقل قد تجنّب مواجهة الإحراج الأصليّ الّذي تقع فيه الكُلّابيّة؛ وذلك، تحديدا، عن طريق إثبات قِدَم الإله والحيلولة دون السقوط في تعدّد قدماءٍ فوقيين—لا يمكن التحكم فيه. إلّا أنّ هذا الاختيار قد دفع المتكلّمين السّنة ليس فقط إلى طرح السّؤال الواضح بخصوص ما إذا كانت الصّفات الإلهيّة ”قديمةً بنفسها“ هي الأخرى أم لا، بل أيضاً إلى إعادة النّظر في استعمالهم لمفهوم ”القديم“ في الأدلّة على الوجود الإلهيّ.
وكما أشرتُ سابقاً، فالمعتزليّ الجبّائيّ قد تعامل مع ”القديم“ و”المحدَث“ بوصفهما ”نقيضين“: معتبراً القول بوجود شيءٍ واحدٍ قديمٍ ومحدَثٍ في الآن نفسه ممّا يتناقضُ. لكنّ المتكلّم السّنيّ بعد تفاديه المعضلة الكلابيّة القديمة، من خلال اعتباره الله قديماً ”بنفسه“ بدلاً من اعتباره قديماً ”بقدمٍ،“ سيميلُ الآن إلى الوصل بين ذينك النّقيضين في صيغة ”قديم بنفسه“ و”محدَث بنفسه.“ وهذا بالتّحديد ما قام به الباقلانيّ (وإن كان يستعمل عبارةً أقلّ قوّةً من النّاحية السّببيّة، وهي ”لنفسه“ [بدل ”بنفسه“]).[31]
غير أنّ هذه التّقابل الذي أقامه الباقلانيّ بين ”القديم لنفسه“ و”المحدَث لنفسه“ هو، في حقيقته، تقابل ”ضدّين“ وليس ”نقيضين،“ وذلك لأنّه يوجد وسطٌ بينهما؛ إذ على الرّغم من استحالة أن يكون الشّيء الواحد ”قديماً لنفسه“ و”محدَثاً لنفسه“ في الآن ذاته، فإنّه من الممكن ألّا يكون أيًّا منهما أيضاً. فمن بين ما تُنعت به الصّفات الإلهيّة، على سبيل المثال، أنها قديمةٌ —وأنّها بكل تأكيدٍ ليست محدَثة—، لكن من الصّعب تصوّر كيف يمكن أن تكون صفةٌ ما قديمةً لنفسها. والسّبب في ذلك، كما ذكرت سابقاً، يكمن في أنّ الصّفات بوجهٍ عامٍّ، والصّفات الإلهيّة بوجهٍ أخصّ، ليست عبارةً عن ”أنفسٍ،“ وإنّما مجرّد أشياء تُحمل على الأنفس (أو تكون للأنفس بالتعدي)؛ كما يكمن في أنّ القول بأن صّفة ما قديمة لنفسها من شأنه أن يمنحها استقلالاً عِليًّا زائداً عن اللّزوم، خاصّةً عندما نستحضر أنّ فكرة ”عدم المعلوليّة“ قد كانت عنصراً أساسيّاً في التصوّر الكلامي للقدم.
وقد ترتّب عن هذا ظهور مشكلةٍ عويصةٍ؛ وذلك لأنّ الطبيعة المتناقضة، وليس المتضادّة، للتّقابل بين مصطلحي ”القديم“ و”المحدَث،“ هي الّتي كانت أساسَ دليل المتكلّمين على وجود الله: فبما أنّ كل محدَث لا بد له من محدِث، فلا بدّ، لكي نتفادى الوقوع في التّسلسل، من أن ننتهي في الأخير إلى شيءٍ ليس بمحدَث. وبما أنّ الشّيء الوحيد الّذي ليس بمحدَث هو القديم، فلا بدّ أن يكون هذا المحدِث الأخير قديماً. غير أنّ هذا الدّليل لن يكون فعّالاً إذا كان المصطلحان المستعملان فيه عبارة عن ضدّين، وليس نقيضين. فإذا كان المصطلحان مجرّد أضدادٍ —كما يظهر ذلك من عبارتي ”قديم لنفسه“ و”محدَث لنفسه“— فسيؤدّي ذلك إلى وجود أشياء قديمةٍ، لكنّها ليست قديمةً لنفسها (وذلك مثل الصّفات الإلهيّة، كما هي في تصّور المتكلّمين السّنة على الأقلّ). وبتعبيرٍ آخر، ستكون هناك أشياءٌ قديمةٌ، لكنّها ليست قائمةً بنفسها. وهكذا، فإنّ هذا الدليل لن يكون ناجعاً مجدّداً إلّا إذا:
أ: تمّ إنشاءُ مقولةٍ جديدةٍ —هي ”القديم لغيره“—؛
ب: ومن ثمّ مساواة ”القديم لغيره“ مع ”المحدَث لنفسه.“
وحينها فقط، يمكن ”للقديم لنفسه“ و”المحدَث لنفسه“ استغراقُ كل الأشياء الدّاخلة في حيّز الإمكان، والمحافظة على الطّبيعة المتناقضة للتّقابل الحاصل بينهما.
ويبدو أن أولى هاتين الخطوتين —أعني إحداث مقولةٍ جديدةٍ (القديم لغيره)— قد حظيت بشيءٍ من القبول في أوساط بعض المتكلّمين السنة. فالماتريديّ (ت. 333هـ/944م)، على سبيل المثال، يزعم، في تفسيره القرآنيّ المُسمّى تأويلات أهل السّنّة، أنّ آية ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [سورة البقرة: 25] يمكن أن تُفهم على أنّها ردٌّ على الجهميّة، الذين اعتقدوا بأنّ الدّفاع عن عقيدة كون ”الله تعالى هو الأوّل والآخر والباقي“ يستلزم القول بفناء الجنّة، مستدلّين لذلك بأنّه ”لو كانت الجنّة باقيّةً غير فانيّةٍ، لكان ذلك تشبيهاً.“
وأصلُ هذا الخطأ الّذي وقع فيه الجهميّة، بحسب الماتريديّ، يكمن في عدم قيامهم بالتّمييز اللّازم بين مصطلحي ”بذاته“ و”بغيره“؛ إذ لو استوعبوا هذا التّمييز وعمِلُوا به، فلا شكّ أنّهم كانوا سيُدركون بأنّ ”الله تعالى هو الأوّل بذاته، والآخر بذاته، والباقي بذاته؛ [بينما] الجنّة وما فيها باقيّةٌ بغيرها.“[32]
ولعلّه سيكون من الجريء جدّاً أن نعتبر التّمييز الذي قدّمه الماتريديّ، في هذا المقطع، عبارةً عن نظريّةٍ متناسقةٍ ومتكاملةٍ؛ ذلك أنّ صفة بقاء الله، كما سبق ونبّه إلى ذلك العالم الأشعريّ المتأخر أبو بكرٍ البيهقيّ (ت. 458هـ/1066م)، ليست كبقاء الجنّة والنّار؛ إذ إنّ ”بقاءه [تعالى] أبديٌّ أزليٌّ، وبقاء الجنّة والنّار أبديٌّ غير أزليٍّ.“[33] وليس يُعيننا التّمييز الذي قام به الماتريديّ بين ”بنفسه“ و”بغيره“ بالشّيء الكثير في فهم كيف يمكن أن يكون الصّانع القديم وصفاته القديمة أزليّيْن بوجهين مختلفين؛ وذلك بأنْ يكون أوّلهما ”قديماً بذاته،“ وثانيهما ”قديماً بغيره.“ وفي الأخير، فحتّى إذا أَجَزْنَا خلق مقولةٍ جديدةٍ من الموجودات —[أعني] ”القديم بغيره“—، فإنّ مساواة هذه المقولة الجديدة مع ”المحدَث لنفسه،“ سيظلّ مع ذلك متنافيّاً مع أحد المقاصد الأساسيّة للمتكلم، وهي أنّ ”القديم“ و”المحدَث“ يجب أن يَحصُل التمييز بينهما من النّاحية الزّمانية ومن النّاحية السّببيّة على حدٍّ سواءٍ.[34]
- زمن ابن سينا
في الجزء الخاصّ بما بعد الطّبيعة في خلاصته الفلسفيّة المبكّرة، الحكمة العروضيّة، التي ألّفها في عام 392هـ/1001م عندما كان عمره لا يتجاوز 21 سنةً، اعتنق ابن سينا، كما فعل الماتريديّ قبله، التمييزَ بين ”القديم بنفسه“ و”القديم بغيره،“ وهو التّمييز المضمَّن في إدخال الباقلانيّ القيد ”لنفسه“ على ”القديم.“ وعلى غرار الماتريديّ، فقد عارض ابن سينا، أيضاً، تطبيق التّمييز بين ”بذاته“ و”بغيره“ على ”المحدَث،“ ناهيك عن مساواة ”القديم بغيره“ مع ”المحدث بذاته.“ ويقول:
أبو عليّ ابن سينا، كتاب المجموع أو الحكمة العروضيّة، تقديم وتحقيق محسن صالح (بيروت: دار الهادي للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 2007)
11.36–18: ويُقال قديمٌ لكل ما ليس قطّ ليساً. وقد يكون الشّيء ”قديماً بذاته،“ وقد يكون ”قديماً بغيره،“ كما تبيّن. وأمّا المحدَث والمتكوِّن، فهو الذي كان ليس في وقتٍ ما، ولن يكون إلاّ بغيره، ولا بدّ له من مادّة، لأنّ كلّ مكوّن فقد تقدّمه إمكانُ وجودٍ، وإلّا لم يكن.[35]
وحينئذٍ، تبقى المشكلة أنّه حتى لو بَدَا أنّ ابن سينا يقصد، بمساواته ”المحدَث بذاته“ مع ”القديم بغيره،“ الإحالةَ على مقولة عقلية من الموجودات، فإنّ متكلّماً أشعريّاً، كالباقلانيّ، سيُعارض وصف الصّفات، سواء بكونها ”محدَثةً لنفسها“ أو ”قديمةً لغيرها،“ لأنّ ذلك سيطرح المزيد من الإشكاليّات الكلاميّة النّوعية، الّتي بعضها مألوفٌ، وبعضها الآخر جديدٌ تماماً. فمن جهةٍ أولى، عندما نعتبر صفةً ما محدَثةً ”لنفسها“ أو ”لذاتها،“ فإن حيازتها ”نفساً“ أو ”ذاتاً“ من شأنه أن يمنحها الكثير من الاستقلال الوجوديّ، في حين أنّ الصّفة —كما تقدّم معنا— ليست ”ذاتاً“ بالمعنى الدّقيق، وإنّما مجرد شيءٍ يُحمل على الذّات (أو يكون للذّات، بالتّعدي). وأيضاً، بما أنّ المحدَث لا بدّ أن يعنيَ المحدَث في الزّمان، حتّى يكون صالحاً لاستعماله في أدلّة الوجود الإلهيّ الّتي تقوم على المعادلة بين العدم السّابق والمعلوليّة، فإنّ الصّفات، عندما نصفها بأنّها محدَثة، سيُنظر إليها باعتبارها محدودةً بالزّمان عوضاً عن أن تكون قديمةً، كما أنّ القرآن، المفهوم على أنّه كلام الله، سيُنظر إليه باعتباره مخلوقاً عوضاً عن أن يكون غير مخلوقٍ.
ومن جهةٍ ثانيةٍ، إذا كانت الصّفات الإلهيّة ”قديمةً لغيرها،“ فإنّ درجةً مقلقة من ”الغيريّة“ ستصيب العلاقة بين ذات الله وصفاته. وبذلك، لن تكون الصّفات قادرةً على استيفاء الشّرط الذي وضعه ابن كُلّابٍ لها، وهو أن تكون لا هي عين الذّات ولا هي غير الذّات. والأسوأُ من ذلك أنّ افتراض وجود درجةٍ كبيرةٍ من ”الغيريّة“ بين ذات الله وصفاته، قد يلزم منه حصول تكثّرٍ في الأشياء التي تُوصف بالقِدَم — أشياء يقال إنها قائمة بشيء آخر غيرها، ولكنّها تظل مع ذلك قديمةً ومستقلّةً [في وجودها]. وباختصار، فهذه الوضعيّة الغامضة للصّفات —بجعلها أشياءً قديمةً، وغير قائمةٍ بنفسها رغم ذلك— تكشفُ لنا عن المشاكل الكامنة في التّوجه السّنيّ في فترة ما قبل ابن سينا نحو اعتبار ”عدم المعلوليّة“ هو أساس مفهوم القدم.
وفي محاولةٍ لمواجهة هذه المشكلة، قدّم المتكلّمان الأشعريّان الباقلانيّ والحليميّ معنىً آخر للقديم، وهو: ”الّذي يستحيل عدمه.“[36] حتى إنّهما استشهدا بمؤسّس المذهب [أبي الحسن الأشعريّ] لدعم هذا التعريف الجديد، [وذلك في قوله]: ”لأنّ ضدّ العلم لو كان قديماً، لاستحال أن يبطل.“[37]
ويصعب للوهلة الأولى أن نرى كيف يمكن أن يُفيد هذا التّعريف الجديد الباقلانيّ والحليميّ بشيءٍ ذي بالٍ؛ إذ حتّى لو طبّقا هذا الفهم الجديد للقديم —”الّذي يستحيل عدمه“— على دليلهما للوجود الإلهيّ، فإنّ هذا لن ينقذهما من المآزق المختلفة المحيطة بالصّفات الإلهيّة. والسّبب في ذلك أنّ دليلهما [على وجود الله] متوقّف على استحالة التّسلسل اللّانهائي للعلل والمعلولات. لذلك، فمهما كانت الجملة التي تُنتقى لتوضيح معنى القديم، فإنّ المعنى الأساسيّ لهذا الأخير يجب أن يظلّ هو ”غير المعلول،“ وهذا إذا كان القصد منه هو جعله مقابلاً للمحدَث، ومن ثمّ مفيداً في الاستدلال على وجود الله. وكما كان الحال في السّابق، فإنّ المشكلة تنشأ عندما تطبّق هذه العبارة الجديدة المختارة —”الّذي يستحيل عدمه“— بنحوٍ مماثلٍ على الصّفات.
ومع ذلك، يمكن أن يشعر المرء بأنّ المتكلّمين السّنة لو اتّخذوا خطوة صغيرة أخرى، وهي اعتبار ”واجب الوجود“ —لا فقط ”مستحيل العدم“— هو المعيار الأساس للقدم، لاستطاعوا بذلك، على الأقلّ، التّخفيف من حدّة المآزق التي تطرحها المعضلة الكلابيّة القديمة. وكما سبق معنا، فالمتكلمون السّنة قد اعتبروا القدم يُحمل على ذات الله وصفاته معاً، وإنْ جعلوا ذلك بأوجهٍ مختلفةٍ ربما. غير أنّه بخلاف القدم، لا يعتبر الوجوب مجرد ”صفةٍ فوقيةٍ“ (meta-attribute)، وإنما هو أيضاً ”جهةُ حملٍ،“ ما دام أنّه يتولّى توجيه عمليّة حمل الصّفات على موضوعها ككل.
وقصدي أنّه، في قضايا من قبيل ”الله موجودٌ“ و”الله عالمٌ“ و”الله رازقٌ،“ يُمكن إدخال القيد الموجّه (modal qualifier) ”واجبٌ أن“ (أو ”وجوباً“) [على القضيّة] لإظهار كيفية ارتباط كلّ واحدةٍ من المحمولات أو الصّفات المضمّنة فيها بموضوعها. ومن ذلك، على سبيل المثال، قولنا: ”واجبٌ أن يكون [أو يوجد] الله عالماً.“ والنتيجة أنّ ”وجوب الوجود“ يُمكن رؤيته حاصلاً في الرّابطة الّتي تبيّن وجه العلاقة القائمة بين المحمولات (الصّفات الإلهيّة) والموضوع (الذّات الإلهيّة)، وليس فقط بوصفه أحد المُسندات إلى الذّات والصّفات، كما كان الأمر مع الصّفات الفوقيّة (meta-attributes).[38] وإذا أردنا صياغة هذه المسألة بلغة العصور اللّاتينيّة الوسطى، فيمكن القول إنّ المتكلّمين السّنيّين قد استفادوا من غياب تمييزٍ دقيقٍ، عند أرسطو وأيضاً في المنطق العربيّ القديم، بين:
- الوجوب الوصفيّ (de re necessity)، الّذي يكون الوجوب فيه حاصلاً في الشّيء المحمول على الموضوع (أ هو وجوباً — ب)؛
- والوجوب الذّاتيّ (de dicto necessity)، الّذي يكون الوجوب فيه حاصلاً في العبارة أو الحمل نفسه (وجوباً: أ هو ب).[39]
وقد استطاع مفهوم وجوب الوجود، جزئيّاً بسبب هذا الخلط، أن يخفّف من وطأة المآزق المُصاحبة للطّرح الكلّابيّ القديم على نحوٍ أفضلٍ بكثيرٍ ممّا قام به مفهوم القدم. فعلى خلاف هذا الأخير، فإنّ وجوب الوجود لا يمكن استعماله في وصف الصّفات إلّا في الحدود التي تكون فيها مُسندةً إلى الذّات الإلهيّة، وهو ما يعني التّخلص من خطر الافتراض غير المقصود لوجود صفاتٍ قائمةٍ بنفسها، أو على الأقلّ التّقليلُ من احتماليّته.
وبالنّظر إلى المزايا الواضحة التي يتمتّع بها مفهوم ”الوجوب“ بالمقارنة مع مفهوم ”القدم،“ لماذا كان المتكلّمون السّنيّون، في حقبة ما قبل ابن سينا، في غاية التردّد بشأن اتّخاد هذه الخطوة النهائيّة الصّغيرة، ليُعبروا صراحةً عن أنّ القِدَم ما دام أنّه قد صار يُعرّف باستحالة العدم، وبما أنّ استحالة العدم مُساويةٌ لوجوب الوجود، فإنّ قدم الإله يجب أن يُحيل في أدنى المستويات على وجوب وجوده؟
الجواب المختصر عن هذا السّؤال هو أنّهم لم يكونوا مرتاحين إلى استعمال عبارة ”الواجب“ على هذا النّحو؛ ذلك أنّ المتكلّمين المتقدمين عندما يرغبون في التّنبيه على أن قضيّةً ما عبارةٌ عن مسلّمةٍ أو مسألةٍ معلومةٍ بالضّرورة (أو البداهة) —وذلك في سياق أن القضيّة الضّروريّة تُعبّر عن حقيقةٍ أوّليّةٍ—، فإنّهم يلجأون بالأساس إلى مصطلح ”الضّروري.“ فعلى سبيل المثال، إنّ ”الكلّ أكبر من أيِّ جزءٍ من أجزائه“ هي قضيّةٌ ”ضروريّةٌ.“[40]
وفي المقابل، فَهِمَ متكلمو هذه الحقبة اسم الفاعل ”وَاجِب“ باعتباره دالّاً على الواجب الدّيني أو الشّرعي (الفرض)، واستعملوا معه الحرف ”على“ للدّلالة على: ”اللّازم شرعاً على [المكلّف].“[41] وليس مجانباً للصّواب القول إنّ العديد من هؤلاء المتكلّمين أنفسهم قد لجأوا إلى الجدر اللّغويّ ”و-ج-ب“ لتقديم فكرة اللّزوم المنطقيّ. فعلى سبيل المثال، نجد الأشعريّ يستعمل، في رسالته استحسان الخوض في علم الكلام، فعل ”وَجَبَ“ بهذا المعنى:
أبو الحسن الأشعريّ، رسالةٌ في استحسان الخوض في علم الكلام، تحقيق محمد الوليّ (بيروت: دار المشاريع للنّشر والتّوزيع، 1995)
4.44–9: وبذلك نحتج على من قال: إنّ الله تعالى وتقدس يُشبه المخلوقات وهو جسمٌ، بأن نقول له: لو كان يُشبه شيئاً من كلّ جهاته، أو يُشبهه من بعض جهاته. فإن كان يُشبهه من كلّ جهاته، وَجَبَ أن يكون مُحدَثاً من كلّ جهاته. وإن كان يُشبهه من بعض جهاته، وَجَبَ أن يكون مُحدَثاً مثله من حيث أشبهه، لأنّ كل مُشتبهين حكمهما واحدٌ فيما اشتبها به، ويستحيل أن يكون المحدَث قديماً والقديم محدَثاً.
وقد استطاع المتكلّمون المتأخّرون، بطبيعة الحال، تبريرَ إضافة معنى الضرورة القياسيّة-المنطقيّة إلى الحقل الدّلاليّ للواجب من خلال تشديدهم على النّظرية الاعتزاليّة [عن الُحسن والقُبح العقليّين]، والّتي تعتبر أنّ معرفة مفاهيم الحَسَنِ والقبيح واجبةٌ شرعاً ومعلومةٌ عقلاً، ما دام المكلّفُ حائزاً على معرفةٍ فطريّةٍ بالحَسَنِ والقبيح، ومُلزماً شرعاً بالتّصرف وفقاً لتلك المعرفة.[42] ومع ذلك، فإنّ استعمال اسم الفاعل ”وَاجِب“ —على عكس الفعل ”وَجَبَ/يَجِبُ“— للدّلالة على ضروريّة (بدهيّة) قضيّة ما قد كان نادراً في الكلام السّنيّ في فترة ما قبل ابن سينا.
على عكس مُعظم المتكلّمين، فإنّ عدداً من نظّار وأدباء أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر [للميلاد] لم تُسَاوِرْهُم أيّة شكوكٍ في الخلوص إلى أنّ الله ما دام مستحيل العدم، فإنّه واجب الوجود. فعلى سبيل المثال، نجد إخوان الصّفاء، في رسائلهم، يُشيرون إلى الله في أحد المواضع باعتباره ”الواجب الوجود.“[43] كما نجد أبا عليّ ابن مسكويه (ت. 421هـ/1030م)، الّذي على الرّغم من أنّ تاريخ وفاته متقدّم نسبيّاً على تاريخ وفاة ابن سينا بنحو جيلٍ أو جيلين، يذهب أيضاً إلى القول: ”وإذا كان الوجود فيه كما قلنا ذاتيّاً، فليس يجوز أن يُتوهّم معدوماً، فهو واجب الوجود، وما كان واجب الوجود فهو دائم الوجود، وما كان دائم الوجود فهو أزليٌّ.“[44] وتظهر جملة ”واجب الوجود“ مقرونةً بقيد ”بذاته،“ مرّةً أخرى في سياق الإشارة إلى الله، في كتاب الأمد على الأبد لأبي الحسن العامريّ (ت. 381هـ/992م).[45]
وفي الحقيقة، فإنّ العامريّ يبدو أقرب مصدرٍ مباشرٍ يمكن أن يكون ابن سينا قد استلهم منه تمييزه، وذلك لعدّة أسباب. أوّلها، أنّ العامريّ قد كان أوّل من يحمل العبارة الكاملة ”واجب الوجود بذاته“ على الله. وثانيها، أنّه على الرّغم من أنّ العامريّ قد تلقّى تكوينه في بغداد، فإنه قد انتقل إلى بُخَارَى، وكان نشطاً في البلاط السَّامَانِيّ نفسه، كما دَرَسَ في المكتبة السَّامَانِيَّة ذاتها، حيث كَتَبَ ابن سينا ذو 21 عاماً، بعد عقدٍ من الزّمان فقط، مجموعه الفلسفيّ الأوّل، الحكمة العروضيّة، والّذي هو أيضاً أوّل نصٍّ سينويٍّ تظهر فيه عبارة ”واجب الوجود بذاته.“ وآخر الأسباب أنّ العامريّ، في كتابه التّقرير لأوجه التّقدير، قد قام مجدّدا بالتّمييز بين واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود؛ وأوضح ما يقصده بواجب الوجود من خلال مثال ”2+2=4“، وهو المثال نفسه الذي ورد لاحقاً عند ابن سينا، في كتابيْ الحكمة العروضية (أُلِّف سنة 392هـ/1001م) والمبدأ والمعاد (أُلِّف سنة 404هـ/1013م).[46] (لا بدّ أن أعترف بأنّ ”2+2=4“ عبارةٌ عن مثالٍ مبتذلٍ لا يمكن أن يُكوِّن دليلاً قاطعاً في إثبات هذا النّوع من النّسبة بين ابن سينا والعامريّ.)
وفي كتاب التّقرير لأوجه التّقدير، يقوم العامريّ أيضاً بالتّمييز بين ما هو ”واجب الوجوب بالذّات“ وما هو ”واجب الوجود بالإضافة،“ وهو التّمييز ذاته الذي قام به ابن سينا في كتاب المبدأ والمعاد.[47] وطبعاً، ليس مؤكداً ما إذا كان ابن سينا قد استقى أفكاره مباشرةً من النّسخ المُهداة الّتي لا شكّ أنّ العامريّ قد خلّفها في المكتبة السَّامَانِيَّة، أو أنّ ابن سينا والعامريّ قد قرآ النّصوص نفسها هناك وتأثّر بها كلّ واحد منهما بشكلٍ مستقلٍّ.
وإلى ذلك، فقد كان ورود ”واجب الوجود“ —مقروناً في بعض الأحيان بقيد ”بذاته،“ وفي أحيانٍ أخرى بدونه—، ضمن أوصاف الإله خاصيّةً، كذلك، لعددٍ قليلٍ من النّصوص الكلاميّة المصنّفة خلال الثّلاثين سنةً، الممتدّة ما بين 375هـ/985م و405هـ/1015م، بما في ذلك نصوص المتكلّم المعتزليّ عبد الجبّار والأديب الأشعريّ الرّاغب الأصفهانيّ. ولقد تَسَاءَلَ بعض الدّارسين، في الحقيقة، عمّا إذا كانت ثمّة علاقةٌ سببيّةٌ بين وجود عبد الجبّار في الرَّيِّ خلال الفترة ما بين 404-406هـ/1013-1015م وظهور عباراتٍ من قبيل ”واجب الوجود“ في أعماله من جهة، وبين وجود ابن سينا في الرَّيِّ حوالي 405-406هـ/1014-1015م وأفكاره المُستجِدَّة بخصوص الوجود الواجب والممكن من جهة ثانية. وكان الافتراض الشّائع أنّه في حالة ثبوت حصول أي تأثيرٍ [لأحد هذين العَلَمين في الآخر]، فإنه ينبغي أن يكون من جهة عبد الجبّار [باعتباره] الأكبر سنّاً وتجاه ابن سينا [باعتباره] الأصغر سنّاً.[48] وقد دُعِّمَ هذا التّصور بواسطة تعليق ابن رشدٍ الشّهير في تهافت التّهافت، والّذي جاء فيه أنّ ابن سينا قد استلهم فكرة التّمييز بين الوجود الواجب والوجود الممكن من المعتزلة، يقول: ”وهو طريقٌ أخذه ابن سينا من المتكلّمين […] هذا هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعريّة.“[49]
فأيُّ حقيقةٍ يمكن أن تكون وراء ادعاء ابن رشدٍ؟ وفقاً لكتاب المجموع في المحيط بالتّكليف، فالقاضي عبد الجبّار كانت قد راودته فكرة إمكان تفسير قدم الإله بطريقةٍ ما من خلال الإحالة على وجوب وجوده.[50] كما أنّه قد اقترب، في هذا العمل، من إقامة تمييزٍ بين الوجوب الذّاتي والوجوب الغيريّ، وهو ما يُفهم من قوله: ”الوجوبُ لذاته لا لشيءٍ سواهُ.“[51] وقد ربط، في كتابه المُغني، بين هذين التّصورين بطريقةٍ أوثق قليلًا.[52] لكنّه لم يبيّن في أيٍّ من العَمَلَين هذا التّمييز بطريقةٍ واضحةٍ ونسقيّةٍ، ناهيك عن الطّريقة الصّناعيّة التي نجدها عند ابن سينا. لذا، فمن الصّعب الحسمُ بشأن هذا السؤال، وذلك لأنّنا لا نتوفّر على الأجزاء الثّلاثة الأولى من كتاب المُغني، وهي الأجزاء الّتي تناولت موضوع التّوحيد، والّتي من شأنها أن تُطلعنا على السّياق الصّريح الّذي جعل عبد الجبّار يُسهب في الحديث عن قضيّة واجب الوجوب.
وطبعاً، إذا سلّمنا (وهو ما أعتقدُ بأنّ علينا فعله) بأنّ مخطوطة الحكمة العروضيّة (مخطوطة أوبسالا)، الّتي بين أيدينا اليوم، هي حقّاً نسخةٌ دقيقةٌ للنّص نفسه الّذي ألّفه ابن سينا عندما كان عمره 21 سنة، أي عام 392هـ/1001م، فحينئذٍ يكون ذلك التمييز قد ظهر في عمل ابن سينا قبل عدّة أعوامٍ من وقوع عينيه على عبد الجبار في الرَّيِّ؛ ومن ثمّ يكون بمقدورنا ردّ أي ادعاءٍ، بخصوص التّأثير الشّخصي لعبد الجبّار في ابن سينا، استناداً إلى أسسٍ تاريخيّةٍ محضةٍ. وإليكم ما يقوله ابن سينا في الحكمة العروضيّة:
ابن سينا، الحكمة العروضيّة
15.35–10.36: ”الواجب“ هو الضّروري الوجود على ما هو عليه، وذلك إمّا بذاته كمبدأ الموجودات، وإما بغيره ككون اثنين واثنين أربعة. والواجب إما دائماً كمبدأ الموجودات، وإما في حالٍ دون حالٍ ككسوف القمر في وقته. ومبدأ ما هو واجب الوجود بذاته، فلا علّة له. فما له علّة، فليس بواجب الوجود صنع الوجود بذاته، وإلّا لما كان يوجد، فهو إذن في عين ذاته ممكن الوجود، وهو واجب الوجود بعلّته. وما لا علّة له، فإن علّة ذاته علّةٌ له. فإن وجود ذاته لا تنقسم من حالتين يصير بهما معلولاً في كلتا الحالتين، وهو لا بدّ من أن يكون معلولاً ولا يخلو عن المعلوليّة. وكلّ متغيرٍ، فإنّه يكون على حالين ليس ولا واحدة منهما له بذاته، فكلّ واحدةٍ منهما بعلة، ولا يخلو عن المعلوليّة. وكل متغيّرٍ، فإنّه يكون على حالين ليس ولا واحدة منهما له بذاته، فكلّ واحدة منهما بعلّة، ولا يخلو منهما. فكلّ متغير معلول الذّات وممكنه، وكلّ ما هو واجب الوجود بذاته، فهو واجب الوجود من جميع جهاته، فليس يوصف البتّة بنحوٍ من أنحاء التّغير. و”الممكن“ هو الوجود الّذي ليس بضروريٍّ. ويُقال ممكنٌ لما ليس بممتنعٍ. ويقال ممكنٌ لما كان غير ممتنعٍ، يوجد ويعدُم، وليس موجوداً في الحال.
وليس يعني هذا، بطبيعة الحال، أنّ أعمال عبد الجبّار أو الأعمال الاعتزاليّة الأخرى الّتي هي الآن في حكم المفقود، ربّما كانت موجودةً في المكتبة السَّامَانِيَّة واطلع عليها ابن سينا قبل أن يؤلِّف الحكمة العروضيّة. إلّا أنّه:
أ: بالنّظر إلى عدم وجود أدلّة نصيّة تُظهر أسبقيّة المعتزلة إلى التّفكير في هذا التّمييز؛
ب: وبالنّظر إلى تلميحات العامريّ إلى هذا التّمييز، وهو الّذي كان يشتغل في المكتبة السَّامَانِيَّة قبل عدّة أعوامٍ فقط من قدوم ابن سينا عليها؛
فإنّ استنتاجي المبدئيّ هو: إمّا أنّ عمل ابن سينا قد أثَّر في عبد الجبّار، أو، كما يبدو أكثر احتمالاً، أنّ ابن سينا وعبد الجبّار قد توصّل كل منهما إلى هذه الفكرة بشكلٍ مستقلٍّ: أوّلهما [ابن سينا] بطريقةٍ ممنهجةٍ ودقيقةٍ، وبالاستناد المباشر على عمل العامريّ السّالف الذّكر؛ وثانيهما [عبد الجبّار] بطريقةٍ يقرب أن تكون عَرَضِيّة. وأظنُّ أنّ التّعليق الّذي صدر من ابن رشدٍ قد يكون تعبيراً عن عدم ارتياحه تجاه ما حظي به التّمييز السّينويّ من إدماجٍ سريعٍ وواسعٍ، على نحوٍ مثيرٍ للدّهشة، ضمن أدلّة المتكلّمين على وجود الله، وضمن نقاشاتهم حول نظريّة العلم والصّفات الإلهيّة، خلال القرن الذي أعقب وفاة ابن سينا أو نحواً منه.[53]
والعالمُ الأشعريُّ المعاصرُ لابن سينا، والّذي استعمل أيضاً عبارة ”واجب الوجود“ لوصف الله تعالى، هو الرّاغب الأصفهانيّ. ولن أخوض في الكثير من التّفاصيل بشأن الشّك الحاصل في تاريخ وفاة هذا الأخير. ويعتقدُ إِيفْرِيت رُوْسُون (Everett K. Rowson)، في أحدث معالجةٍ لهذا السّؤال، أنه قد نشط حوالي 401هـ/1010م، وأنا مقتنعٌ بأدلّته الّتي تستند على العمل السابق الّذي قام به وِيلْفْرِد مَادْلُونج (Wilfred Madelung).[54] ويذهبُ الرّاغب، في كتابه الاعتقادات، إلى أنّ الموجودات والمحدَثات بأسرها لا بدّ أن تنتهي إلى مُوجِدٍ ومحدِثٍ، ”وأنّ ذلك المُوجِد والمحدِث يجب أن يكون واحداً، أزليًّا، واجبَ الوجود لذاته.“[55] ويوضّح، في موضعٍ لاحقٍ، ما يقصده بقوله أنّ الله يجب أن يكون واجب الوجود بالقول:
الأصفهانيّ، الاعتقادات
9.56–11.57: والدّلالةُ على أنّه تعالى موجودٌ واجبُ الوجودِ: أنّه كلّما فَرَضْتَه أو تَوَهَّمْتَه موجوداً لا يخلو من ثلاثة أوجهٍ: إمّا واجب الوجود أو ممتنع الوجود، أو ممكن الوجود. فالواجب الوجود هو الّذي إذا فُرِضَ غير موجودٍ لَزِمَ منه محالٌ، كحصول أربعةٍ من وجود اثنين واثنين. والممتنع الوجود هو الّذي إذا فُرِضَ موجوداً أو غير موجودٍ لم يلزم منه محالٌ، كمجيء المطر في الشّتاء.
والواجبُ الوجودِ ضربان: واجبُ الوجودِ لا لذاته بل لأمرٍ آخر، كوجود أربعةٍ يجب عن حصول اثنين واثنين. وواجب الوجود لذاته لا لشيءٍ آخر، وهو الباري تعالى، والواجب الوجود هو الّذي إذا فُرِضَ غير موجودٍ حصل من محالٍ، ولا محتاج في وجوده إلى شيءٍ يوجده، ويكون أزليّاً، وذلك هو الله تعالى. والواجب الوجود لذاته لا يصحّ إلّا أن يكون واحداً؛ وذلك أنّا متى فرضنا ثابتا واجب الوجود لذاته جاء منه محالٌ، فإنّ هذا الثاني لا بدّ أن صار ثانيا بشيءٍ، فهو الأوّل. وإذا لم يكن هناك شيءٌ حصل به الاثنويّة، فوجوده إذاً بذاته، وبذلك الشيء فهو مفتقرٌ في الوجود إلى ذلك الشّيء، والواجب الوجود هو الّذي لا يفتقر في وجوده إلى شيءٍ غير ذاته؛ فَثَبَتَ أنّه لا يصحّ أن يكون واجب الوجود لذاته إلا واحداً، وذلك هو الله تعالى.
وتبدو الطّريقة التي صَاغَ بها الرّاغب شرحه —الّذي يعود تاريخه، وفقاً لتخمين رُوْسُون، إلى حوالي عام 401هـ/1010م— مشابهةً، على نحوٍ لافتٍ للنّظر، للشّرح الّذي نجده في مقطعٍ مطابقٍ مأخوذٍ من كتاب المبدأ والمعاد لابن سينا، والّذي ألَّفه عام 404هـ/1013م (أي بعد 12 سنةً فقط من بداية تعرّفه على فكرة وجوب الوجود في الحكمة العروضيّة):
ابن سينا، المبدأ والمعاد
5.2–17: إنّ الواجب الوجود هو الموجود الّذي متى فُرض غير موجودٍ عَرَضَ منه محالٌ، وإنّ الممكن الوجود هو الّذي متى فُرِضَ غير موجودٍ أو موجوداً لم يعرض منه محالٌ.
فالواجب الوجود هو الضّروريّ، والممكن الوجود هو الّذي لا ضرورة فيه بوجهٍ، أي لا في وجوده ولا في عدمه. وهذا هو الّذي نعنيه في هذا الموضع بممكن الوجود. وإن كان قد يُعنى بممكن الوجود ما هو في القوّة، ويُقال الممكن على كلّ صحيح الوجود، وقد فُصِّل ذلك في المنطق.
ثمّ إنّ الواجب الوجود قد يكون بذاته وقد يكون لا بذاته؛ والّذي هو واجب الوجود بذاته فهو الّذي لذاته، لا لشيء آخر، أيّ شيء كان، صار محالاً فرضُ عدمه. وإنّ الواجب الوجود لا بذاته هو الّذي، لوضع شيء ما ليس هو، صار واجب الوجود، مثل أنّ الأربعة واجبةُ الوجود لا بذاتها، ولكن عند فرض اثنين واثنين، والاحتراق والاحراق واجب الوجود لا بذاته. ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطّبع والقوّة المنفعلة بالطّبع، أعني المُحرِقة والمُحترِقة.
وكما كان الحال مع عبد الجبّار، عندما لم نستطع الحسم في مسألة ما إذا كان هو الّذي أثّر في ابن سينا أم العكس، بسبب عدم توفّرنا على الأجزاء الثّلاثة الأولى من كتابه المُغني، فكذلك الشّأن مع الرّاغب؛ إذ إنّ عدم اليقين الحاصلَ بشأن تواريخه الخاصّة يفرض علينا أن نكون نسبيّين بخصوص ما إذا كان هو أم ابن سينا من أَتَى بهذه الصّيغة الجديدة أَوَّلاً. إلّا أنّني أعتقدُ بأنّ عبء الإثبات يقع على عاتق من يُنكر أنّ العامريّ هو أرجح مصدرٍ مباشرٍ لنظريّة ابن سينا، ما دام أنّه هو المؤلِّف الوحيد الّذي يُحتمل أن تكون أعماله قد وُجدت في المكان المناسب (بُخَارَى) والزّمان المناسب (حوالي 390هـ/1000م) لاستثارة الخيال الميتافيزيقيّ لابن سينا الشّاب.[56]
- ما بعد ابن سينا
الأمر المؤكّد أنّه خلال القرن التّالي لصياغة ابن سينا الأولى لنظريّته، شَرَعَ العديد من المتكلّمين السّنيّين البارزين في وصف الله صراحةً بأنه ”واجب الوجود.“ وبتعبيرٍ أدقّ، فتعريف ”واجب الوجود“ على أنّه ”الّذي لا يُتصوّر أو يستحيل عدمه“ —وهو التّعريف الذي نجده عند الرّاغب وعند ابن سينا في المبدأ والمعاد— هو الّذي كان له صدىً واسعٌ في أوساط المتكلّمين السّنيّين في حقبة ما بعد ابن سينا. وربّما يكون السّبب في انتشار هذا التّعريف هو أنّ الرّاغب كان قد جاء به مُتزامناً مع ابن سينا، واستطاع من ثمّ توفير أصلٍ أشعريٍّ لهذا التّعريف. لكن، بالنّظر إلى المكانة الهامشيّة التي يحظى بها الرّاغب كمتكلم، فإنّ السّبب الأرجح هو أنّ هذا التّعريف لواجب الوجود —”الّذي لا يتصور أو يستحيل عدمه“— قد أتاح للأشاعرة، الذي جاؤوا بعد ابن سينا، المطابقةَ بين واجب الوجود والقديم؛ وذلك من خلال الاستعانة الصّريحة بالتّعريف الذي سبق للباقلانيّ أن أعطاه للقديم (أي ”الّذي يستحيل عدمه“). وفي كلّ الأحوال، فالاستشهاد بالباقلانيّ، وهو مفكرٌ أشعريٌ أرفع شأناً بكثيرٍ من الرّاغب، قد كان أكثر نجاعةً في إعطاء الهويّة الأشعريّة (ashʿarize) لتمييز ابن سينا.
ولا بدّ من الاعتراف بأنّ أكثريّة المتكلمين السّنة، المنتمين إلى الجيلين الأوّل والثّاني من حقبة ما بعد ابن سينا —بمن فيهم الحنبليّان أبو يعلى ابن الفرّاء (ت. 458هـ/1066م) وأبو إسحاق الفيروزآبادي الشّيرازيّ (ت. 478هـ/1083م)، اللّذان يبدو أنّهما كانا مُتردِّدين بين الأشعريّة والحنبليّة، والأشعريُّ أبو سعدٍ الـمتوليّ (ت. 478هـ/1086م)— قد عَدَلُوا عن الاستدلال القائم على أنّه:
أ: بما أنّ الله قديم؛
ب: وبما أنّ القديم مستحيل العدم؛
ج: وبما أنّ كلّ ما هو مستحيل العدم، فهو واجب الوجود؛
فالنّتيجة، إذن، أنّ الله واجب الوجود.
وفي مقابل ذلك، تمسّكوا بقول الباقلانيّ السّالف، الّذي يؤكّد فيه أنّ كلّ ما هو قديمٌ، فهو مستحيل العدم.[57]
وقد أَخَذَ العالمُ الأشعريُّ إمامُ الحرمين الجوينيّ (419-478هـ/1028-1085م)، على الرّغم من تردّد أصحابه السّنيّين، زمامَ المبادرة، ليصرّح بوضوحٍ أنّه:
أ: بما أنّ القدم يقتضي استحالة العدم؛
ب: وبما أنّ استحالة العدم تقتضي وجوب الوجود؛
فالنّتيجة، إذن، أنّ القدم ووجوب الوجود مُتلازمان. يقول:
الجوينيّ، الشّامل في أصول الدّين، تحقيق عبد الله محمود محمد عمر (بيروت: دار الكتب العلميّة، 1999)
19.292–20: والوجه الآخر في الجواب أن نقول: وجوب الوجود عبارةٌ عن انتفاء جواز العدم، وليس براجعٍ إلى ثبوت صفةٍ، فليس القديم في وجوب وجوده على صفةٍ ذاتيّةٍ، بل المعنى بذلك انتفاء جواز العدم عنه.
9.308–10: فإنّ القديم هو الواجب الوجود، الممتنع تقدير انتفائه. وهذا هو المعنى بقول الأئمّة: إنّ القديم واجبٌ وجوده، والحادث جائزٌ وجوده.
الجوينيّ، العقيدة النّظامية، تحقيق محمد زاهد الكوثريّ (القاهرة: مطبعة الأنوار، 1948)
1.32–3: يجب القطع بأن الله تعالى باقٍ، وما وَجَبَ قدمه استحال عدمه، فإنّ القديم هو الّذي قضى العقل بوجوب وجوده.
الجوينيّ، لُـمَعٌ في قواعد أهل السّنة والجماعة، تحقيق مِيشِيل ألّار [ضمن: Textes apologétiques de Ğuwainī] (بيروت: دار المشرق، 1968)
10–9.137: الرّب عزّ وجلّ باقٍ واجب الوجود، إذ قد ثبت بما قدّمناه قدمه، والقديم يستحيل عدمه باتّفاق العقلاء، وذلك يصرّح بكونه باقيّاً ومستمرّ الوجود.
وربّما للأسباب المذكورة آنفاً، يشير الجوينيّ إلى أنّ الباقلانيّ نفسه قد كان أوّل من يتوصّل إلى هذا الاستنتاج، ويزعمُ أيضاً أن هُناك ما يشبه الإجماع، بين علماء أهل السّنّة على الأقلّ، على أنّ الله واجب الوجود. يقول:
الجوينيّ، الشّامل في أصول الدّين
11–7.365: وربّما يحرّرها القاضي [الباقلانيّ] على وجهٍ آخر فيقول: وقد ثبت استحالة افتقار محدِث العالم إلى محدِثٍ، من حيث يُفضي ذلك إلى التّسلسل، وكل وجودٍ ثبت غير مفتقرٍ إلى مُقتضٍ، فهو واجبٌ.
13–11.358: اعلموا أنّ مُثبتي الصّانع مُطْبِقُون على وجوب وجوده. ولم يُؤثَر عن أحدٍ منهم المنازعة في ذلك إلّا الباطنيّة والزّنادقة، لعنهم الله؛ فإنّهم امتنعوا عن وصف الصّانع بالوجود والعدم.
ولكن، ماذا عن الصّفات —هل هي واجبة الوجود أيضاً—؟ إنّ أبعد ما يذهب إليه الجوينيّ هو التّأكيد على أنّ الصّفات الإلهية ”واجبةٌ لله.“ وهو ما يدلّ على أن الجوينيّ قد استفاد من المُعطى الّذي ناقشناه أعلاه، وهو أنّ الوجوب الوجوديّ يمكن النّظر إليه من زاويتين:
أ: من جهة أنه صفةٌ محمولةٌ على الله (”الله واجب الوجود“)؛
ب: ومن جهة أنه قيدٌ موجّهٌ، يقوم بتحديد طبيعة العلاقة (الرّابطة) القائمة بين الله —بما هو موضوعٌ— والصّفات —بما هي محمولٌ— (”واجبٌ أن يكون الله [أو يوجد] عالماً“).
ويسير الجوينيّ في العقيدة النّظامية والإرشاد على النّهج نفسه تقريباً، حيث يناقش في فصولٍ متفرّقةٍ المباحث المتعلّقة بــ:
- الصّفات الواجبة لله (”الكلامُ في ما يجب لله تعالى“: العقيدة النّظامية، 16، س19، وما يليها؛ ”بابُ القول في ما يجب لله تعالى من الصّفات“: الإرشاد، 17، س16، وما يليها)؛
- والصّفات المستحيلة على الله (”الكلامُ في ما يستحيل على الله تعالى“: العقيدة النّظامية، 14، س12، وما يليها؛ ولم يُفرد الجوينيّ فصلاً مستقلّاً في الإرشاد لهذا القسم من الصّفات)؛
- والصّفات الجائزة على الله (”الكلامُ في ما يجوز من أحكام الله تعالى“: العقيدة النّظامية، 25، س3، وما يليها؛ ”بابُ القول في ما يجوز على الله تعالى“: الإرشاد، 94، س3، وما يليها).[58]
وفي سياق تصنيفه للصّفات الإلهيّة على أساس القيد الموجّه، الّذي يصف كيفيّة ارتباط كلّ صفةٍ من الصّفات بالله، يتجاوز الجوينيّ [أفكار] العالم الحنبليّ ابن الفرّاء، على سبيل المثال، والّذي يقدّم فقط التّمييزَ السّائد في عصره بخصوص صفات الذّات، والّذي تنقسم هذه الأخيرة بموجبه إلى ضربين:
- صفات نفسيّة، كصفة القيام بالنّفس بالنّسبة للإله، وهي الّتي لو قدّرنا انتفاءها، لوجب انتفاء ذات الإله؛
- وصفات معنويّة، كصفة العلم بالنّسبة للإله، وهي الّتي لو قدّرنا انتفاءها، لم يجب انتفاء ذات الإله.[59]
ومن بين علماء أهل السّنّة الجسورين المعاصرين للجوينيّ المتكلمُ الماتريديّ أبو اليسر البَزْدَوِيّ (ت. 493هـ/1099م)، الّذي يساوي، على غرار الجوينيّ، القديمَ مع واجب الوجود، وهو ما عبّر عنه في سياق محاولته إثبات حدوث الأعراض بالقول:
البزدويّ، كتاب أصول الدّين، تحقيق هانز بيتر لينس (القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، 1963)
7.15–11: فلو کانت الأعراض قدیمةً، لما تُصوّر بطلانها؛ لأنّ القدیم واجب الوجود، فلا یُتصوّر علیه البطلان والعدم، لأنّه لو جاز عدمه فی المستقبل من الزّمان، جاز عدمه فی الماضي من الزّمان؛ فلا یُتصوّر العدم. وهذا کما یجب أنّ الإثنين إذا ضُمّا إلی واحدٍ یکون ثلاثةً، وإذا کان هذا واجباً فإنّه لا یُتصوّر أن یوجد زمانٌ یُضمّ الاثنان إلی الواحد ولا یکون ثلاثةً.
وعلى خلاف الجوينيّ، الّذي يبدو، كما سبق أن أشرنا، قنوعاً بمجرد الاكتفاء بجعل القدم ووجوب الوجود متلازمين، فإنّ البَزْدَوِيّ يبدو أوضح نسبيّاً في موقفه، الّذي يقدّم فيه وجوب الوجود على أنّه أخصّ صفات الله. كما أنّ القدم قد صار يُنظر إليه الآن باعتباره مُتفرّعا بطريقة ما عن وجوب الوجود:
البزدويّ، كتاب أصول الدّين
2.20–5: لأنّ الله تعالی واجب الوجود، لما بیّنّاه أنّه لا بدّ للمحدَثات من مُحدِثٍ، وما کان واجب الوجود یستحیل عدمه، وإذا استحال یتعیّن القِدَم. وهو باقٍ أیضاً لأنّ القدیم یستحیل عدمه، لأنّ القدیم واجب الوجود، ولأنّه لو جاز عدمه في زمانٍ، جاز عدمه في زمانٍ آخر، فیبطل القِدَم.
غير أنّه فيما يخصّ موضوع الصّفات الإلهيّة بشكلٍ عامٍّ، فلا بدّ من القول إنّ البَزْدَوِيّ قد كان أقلّ جرأةً من الجوينيّ، حيث إنّه تردّد في اعتبار الصّفات واجبةً لله (على غرار ما قام به الجوينيّ)، ناهيك عن اعتبارها واجبة الوجود بذاتها. وفي المقابل، نجد تلميذ الجوينيّ البارز، الأشعريّ أبا حامد الغزاليّ (ت. 505هـ/1111م)، يقرّر السّير على خطى شيخه من خلال إنكاره الصّريح أن تكون الصّفات ممكنة الوجود. إلّا أنّه قد تردّد، مع ذلك، في الاعتراف صراحةً بأنها واجبة الوجود، يقول:
الغزاليّ، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد (القاهرة: محمد علي صبيح، 1971)
6.75–13: إنّ الصّفات کلّها قدیمةٌ، فإنّها إن کانت حادثةً، کان القدیم سبحانه محلّاً للحوادث، وهو محالٌ […] الدّلیل الأوّل: إنّ کلّ حادثٍ فهو جائز الوجود، والقدیم الأزليّ واجب الوجود. ولو تطرّق الجواز إلی صفاته لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده، فإنّ الجواز والوجوب یتناقضان. فكلّ ما هو واجب الذّات، فمن المحال أن یكون جائز الصّفات، وهذا واضحٌ بنفسه.
وقد يكون تردّد الغزاليّ هنا نابعاً من إدراكه أنّ الإقرار الصّريح بوجوب الصّفات قد يُعرِّضه للمخاطر نفسها، الّتي واجهها المتكلمون الكُلّابيّون قبله، جرّاء قولهم بقدم الصّفات. غير أنّ المعضلة التي قد تنشأ، في حالة الغزاليّ هذه، ستكون هي حصول تعدّدٍ في واجبي الوجود، عوضاً عن تعدّدٍ في القدماء.
ومن المسائل الأخرى الّتي يتخطّى فيها الغزاليّ شيخه الجويني بنصف خطوةٍ أنّه قد ساوى القديم لا مع واجب الوجود فحسب، وإنّما مع واجب الوجود بذاته. بل يذهب أبعد من ذلك بتصريحه الواضح وضوح الشّمس أنّ وجوب الوجود عبارةٌ عن أصلٍ، بينما القدم عبارةٌ عن فرعٍ له، يقول:
الغزاليّ، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق وتقديم فضلة شحّادة (بيروت: دار المشرق، 1971)
8.159–13: الباقي هو الموجود الواجب وجوده بذاته، ولكنّه إذا أُضیف في الذّهن إلی الاستقبال سُمّي باقیّاً، وإذا أُضیف إلی الماضي سمّي قدیماً […] وقولك: واجب الوجود بذاته، متضمّنٌ لجمیع ذلك، وإنّما هذه الأسامي بحسب إضافة هذا الوجود في الذّهن إلی الماضي أو المستقبل.
وعلى غرار مُعاصره الغزاليّ، نظر المتكلّم الماتريديّ أبو المعين النّسفيّ (ت. 508هـ/1114م) هو الآخر إلى وجوب الوجود باعتباره أصلاً وإلى القدم باعتباره فرعاً، وهو عبّر عنه بالقول:
أبو المعين النّسفيّ، كتاب تبصرة الأدلّة
12.61–15: لأنّ القدیم مما یستحیل علیه العدم، وهذا لأنّ القدیم ینبغي أن یكون واجب الوجود؛ لأنّه لو لم یكن واجب الوجود لكان جائز الوجود أو ممتنع الوجود، إذ لا قسمة لما یخطر بالبال وراء هذه الأقسام، أعني أنّه إمّا أن یكون واجب الوجود، وإمّا أن یكون جائز الوجود، وإمّا أن یكون ممتنع الوجود.
وقد تواصل التّضمين التّدريجي للقِدَم تحت مُسمّى وجوب الوجود في الكلام السّنيّ. ونتيجةً لذلك، أخذ وجوب الوجود في الحلّ تدريجيّاً محلّ القِدَم بوصفه أبرز صفات الله الفوقية (meta-attribute).[60] لكن، لا بدّ من الاعتراف بأنّ وجوب الوجود قد انتهى به الأمر ليُؤدّي نفس الدّور المزدوج الخطير الذي اضطلع به القدم في السّابق، وهو: إثبات وجود الله من جهةٍ، وتمثيل أهمّ صفاته الفوقيّة من جهةٍ ثانيّةٍ؛ وقد خلقت هذه الغاية المزدوجة للمتكلّمين ما بعد-السّينويّين العديدَ من المعضلات نفسها، الّتي كان على المتكلّمين ما قبل ابن سينا التعامل معها. فكما أنّ القدم قد اِسْتُخْدِمَ في سياقاتٍ مختلفةٍ تماماً —بجعله تارةً دالّاً على عدم المعلوليّة في أدلّة الوجود الإلهيّ، وجعله تارةً أخرى نعتاً مُضافا إلى الصّفات في سياق النّقاشات الكلاميّة حول الصّفات الإلهيّة— فكذلك الشّأن بالنّسبة لوجوب الوجود؛ إذ إنّه اسْتُخْدِمَ في سياقاتٍ متباينةٍ أيضاً. والنتيجةُ أنّه عندما تُعتبر الصّفات الإلهيّة واجبةَ الوجود —فما بالك باعتبارها واجبة الوجود لذاتها—، فإنّها تُحصِّل بذلك قدراً من الاستقلاليّة السّببيّة [القيام بالنّفس]، الّتي تجعل كل واحدةٍ منها، في الواقع، عبارةً عن إلهٍ صغيرٍ [قائمٍ بنفسه]. صحيحٌ أنّ فكرة الجوينيّ الفريدة، عن حصول الوجوب في الصّفات حال إسنادها إلى الله فقط، قد جعلت وجوب الوجود فكرةً أكثر جاذبيّة من القِدَم بوصفه صفةً للصّفات (صفة فوقيّة). لكن، حتّى إذا غضضنا الطّرف عن الخلط بين الوجوب الوصفيّ (de re necessity) والوجوب الذّاتيّ (de dicto necessity) الكامن في فكرة الجوينيّ، فإنّه لم يعالج بعدُ المشكلة النّاشئة عن استعمال واجب الوجود لتحقيق غايتين مُتضاربتين.
ولا يتّسع المجال، في هذا المقال، لعرض المعالم الكبرى لتاريخ هذه المشكلة في الكلام السّنيّ في فترة ما بعد ابن سينا. لكن، كمثالٍ على مدى تعقيد هذا النّقاش وديناميّته، سأنقلُ مقطعين من شرح العقائد النّسفيّة (والعقائدُ من تأليف نجم الدّين أبو حفص النّسفيّ [537هـ/1142م]) لسعد الدّين التّفتازانيّ (ت. 792هـ/1389م) —الّذي يُعدّ فكره الكلاميّ عبارةً عن مزيجٍ بين الكلامين: الأشعريّ والماتريديّ— يُحاول فيهما التّوفيق بين هذين المطلبين المتعارضين بشكلٍ ظاهرٍ:
التّفتازاني، شرح العقائد النّسفيّة، تحقيق مصطفى مرزوقي (الجزائر: شركة دار الهدى للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 2000)
7.36–8.35: [في شرح قوله ”القديم“:] هذا تصريحٌ بما عُلم التزاماً، إذ الواجب لا یكون إلاّ قدیماً، أيْ لا ابتداء لوجوده، إذ لو کان حادثاً مسبوقاً بالعدم، لكان وجوده من غیره ضرورةً، حتّی وقع في کلام بعضهم [بعض المتكلمين]: أنّ الواجب والقدیم مترادفان. لكنّه لیس بمستقیم للقطع بتغایر المفهومین؛ وإنّما الكلام في التّساوي بحسب الصّدق، فإنّ بعضهم علی أنّ القدیم أعمّ لصدقه علی صفات الواجب، بخلاف الواجب فإنّه لا یصدق علیها، ولا استحالة فی تعدّد الصّفات القدیمة، وإنّما المستحیل تعدّد الذّوات القدیمة. وفي کلام بعض المتأخّرین [من المتكلمين] کالإمام حمید الدین الضّریر [ت. 666هـ/1267م]، رحمه الله ومن تبعه، تصریحٌ بأنّ واجب الوجود لذاته هو الله تعالی وصفاته، واستدلّوا علی أنّ کلّ ما هو قدیم فهو واجب لذاته، بأنّه لو لم یكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه، فیحتاج في وجوده إلی مخصّص فیكون محدثاً، إذ لا نعني بالمحدَث إلاّ ما یتعلّق وجوده بإیجاد شيءٍ آخر […] وهذا كلامٌ فی غایة الصّعوبة، فإنّ القول بتعدّد الواجب لذاته مُنافٍ للتوحید، والقول بإمكان الصّفات یُنافي قولهم بأنّ کلّ ممكنٍ فهو حادثٌ.
6.45–5.44: [في شرح قوله ”وهي لا هو ولا غیره“: ] یعني أنّ صفات الله تعالی لیست عین الذّات ولا غیر الذّات، فلا یلزم قِدَم الغیر ولا تكثّر القدماء […] وأیضاً، لا یُتصوّر نزاع من أهل السّنة والجماعة في كثرة الصّفات وتعدّدها، متغایرةً کانت أو غیر متغایرةٍ. فالأوْلی أن یُقال: المستحیل تعدّد ذواتٍ قدیمةٍ لا ذاتٍ وصفاتٍ، وأن لا یُجترأ علی القول بكون الصّفات واجبة الوجود لذاتها، بل یقال: هي واجبة لا لغیرها، بل لما لیس عینها ولا غیرها، أعني: ذات الله تعالی وتقدّس؛ ویكون هذا مُراد من قال: الواجب الوجود لذاته هو الله تعالی وصفاته، یعني أنّها واجبةٌ لذات الواجب تعالی وتقدّس؛ وأمّا في نفسها فهي ممكنة، ولا استحالة فی قِدَم الممكن إذا کان قائماً بذات القدیم، واجباً له غیر منفصلٍ عنه، فلیس کلّ قدیمٍ إلهاً حتّی یلزم من وجود القدماء وجود الآلهة، لكن ینبغي أن یقال: الله تعالی قدیم بصفاته؛ ولا یطلق القول بالقدماء لئلّا یذهب الوَهْمُ إلی أنّ کلّا منها قائمٌ بذاته، موصوفٌ بصفات الألوهیّة؛ ولصعوبة هذا المقام، ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلی نفي الصّفات، والكرّامیة إلی نفي قِدَمها، والأشاعرة إلی نفي غیریّتها وعینیّتها.
وما يقترحه التّفتازانيّ، في الواقع، هو أنّه يجب على أصحابه المتكلّمين، عندما يكونون بصدد مناقشة قِدَم الصّفات، التّعويل على الصّيغة المُلتبسة الّتي كان قد جاء بها ابن كُلّابٍ قبل خمسة قرون، والّتي يكون الله بموجبها ”قديماً بصفاته“؛ وذلك نظراً للعواقب غير المحمودة الّتي تتبع أيّ محاولةٍ لمزيدٍ من التّدقيق بشأن طبيعة القِدَم التي تختصّ به الصّفات الإلهية. غير أنّ التّفتازانيّ قد كانت لديه مساحةٌ أكبر للمناورة عندما تعلّق الأمر بمسألة الوجوب والإمكان. [وبحسب ما خلص إليه]، فالله يبقى واجباً لذاته، في حين أنّ الصّفات، في المقابل، ”واجبةٌ لذات الواجب“؛ وأمّا ”في نفسها،“ فهي ممكنةٌ. وبعبارةٍ أخرى، إنّ التّفتازانيّ يلجأ هنا إلى روح التّمييز السّينويّ بين واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره/ممكن الوجود لذاته، ما دام أن كلّاً من التّفتازانيّ وابن سينا يروم الغاية نفسها: وهي إيجاد طريقةٍ منطقيّةٍ ومتماسكةٍ للتّفريق بين الشّيء القديم القائم بنفسه (وهو الله، بالنّسبة لابن سينا؛ وذات الله، بالنّسبة للتّفتازانيّ)، والشّيء القديم غير القائم بنفسه (العقول والنّفوس والأجرام السماويّة، بالنّسبة لابن سينا؛ والصّفات الإلهيّة، بالنّسبة للتّفتازانيّ).
ومن خلال اعتناقه لهذه النّسخة المعدّلة قليلاً من تمييز ابن سينا، ومن ثمّ استخدامها في شرحٍ عقائديٍّ للتّخلص من المعضلة الكلاميّة القديمة النّاشئة عن الطّبيعة الغامضة للصّفات الإلهيّة، يُظهر لنا التّفتازانيّ بجلاءٍ ما كان قد أطلق عليه عبد الحميد صبرة، في إشارةٍ منه إلى تاريخ العلوم العربيّة، سيرورات التّملك والتّكييف.[61] غير أنّ الّذي خضع للتّملك والتّكييف، في حالة التّفتازانيّ، ليس هو العلوم اليونانيّة، وإنّما الإلهيّات السّينويّة.
في مقالٍ منشورٍ لي في عددٍ سابقٍ من هذه المجلّة [مجلّة الفلسفة والعلوم العربيّة]، بينتُ أنّ ابن سينا، في تمييزه بين الماهيّة والوجود، مدينٌ للنّقاشات الكلاميّة السّابقة حول الأشياء والموجودات، بالقدر نفسه الّذي يدينُ به للأبحاث اليونانيّة في هذا الموضوع؛ [وأوضحتُ أيضاً] أنّ موقف ابن سينا، في نصوصٍ أخرى، بخصوص كيفيّة تعلّق الأشياء والموجودات ببعضها البعض، قد كان أقرب إلى موقف متكلّمي الأشعريّة والماتريديّة في القرن الرّابع الهجريّ/العاشر الميلاديّ، منهُ إلى موقف زميله الفيلسوف، أبي نصرٍ الفارابيّ (ت. 339هـ/950م).[62] وفي مقالٍ آخر، حاولتُ أن أُبرهن على أنّ المواقف التي عبّر عنها المتكلّمون ما بعد-السّينويّون، في صفوف السّنة والشّيعة على حدٍّ سواءٍ، بخصوص الماهيّة والوجود، قد كانت أكثر قرباً إلى موقف ابن سينا الخاصّ، من تلك الّتي صدرت عن الفيلسوفيْن ما بعد-السّينويّيْن: شهاب الدّين السّهروردي (ت. 587هـ/1191م) ومُلَّا صدرا الشّيرازيّ (ت. 1050هـ/1641م)، اللّذين وضعتهما ماهويّة أحدهما الجذريّة ووجوديّة الآخر الجذريّة، على التّوالي، خارج نطاق ما يمكن تسميّته على نحوٍ دقيقٍ بـ”التّقليد السّينويّ.“[63] وفي مقالتي الحاليّة، عملتُ على إظهار أنّ صياغة ابن سينا لنظريّة وجوب الوجود لذاته قد كانت، في جزءٍ منها، تفاعلاً مع النّقاشات الكلاميّة-السّنيّة السّابقة حول الصّفات الإلهيّة، وبأنّ المتكلّمين السّنيّين المتأخّرين سرعان ما استولوا على نظريّة ابن سينا باعتبارها طريقَ هروبٍ محتملٍ للنّجاة من المعضلات التي نجمت عن النّقاشات سالفة الذّكر. والخلاصة النّهائيّة التي كنتُ أتوصّل إليها، في كلّ مقالٍ من هذه المقالات، هي أنّه في الوقت الّذي لطالما قَدّمَ فيه المتكلّمون والفلاسفة مشاريعهما الخاصّة على أنّها متباينةٌ بشكلٍ قطعيٍّ، فإنّ خيوط هذين الفكرين [الكلامي والفلسفي] قد كانت، في الحقيقة، شديدة التّرابط على المستوى المفاهيميّ، لدرجةٍ يكاد يستحيل معها الفصلُ بينهما دون أن يُؤدّي ذلك إلى تمزيق النّسيج المتشابك للتّاريخ الفكريّ الإسلاميّ.
———————————————-
بيبليوگرافيا
ابن الفرّاء، أبو يعلى الحنبليّ. كتاب المعتمد في أصول الدّين، تحقيق وديع زيدان حدّاد. بيروت: دار المشرق، 1974.
ابن رشد، أبو الوليد. تهافت التّهافت، تحقيق مُورِيس بْوِيج. بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة، 1930.
ابن سينا، أبو عليّ. المبدأ والمعاد، تحقيق عبد الله نوراني. طهران: مؤسسة مطالعات اسلامى، 1984.
______. كتاب المجموع أو الحكمة العروضيّة، تقديم وتحقيق محسن صالح. بيروت: دار الهادي للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 2007.
ابن عساكر، أبو القاسم. تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى أبي الحسن الأشعريّ. دمشق: القدسي، 1928.
ابن فُورك، أبو بكر. مُجرّد مقالات الشّيخ أبي الحسن الأشعريّ، تحقيق دانيال جيماريه. بيروت: دار المشرق، 1987.
إخوان الصّفاء. رسائل إخوان الصّفاء وخلّان الوفاء. بيروت: دار صادر، 1957.
الأشعريّ، أبو الحسن. رسالةٌ في استحسان الخوض في علم الكلام، تحقيق محمد الوليّ. بيروت: دار المشاريع للنّشر والتّوزيع، 1995.
______. كتاب اللّمع في الرّد على أهل الزّيغ والبدع، تحقيق الأب رتشارد يوسف مكارثي. بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة، 1953.
______. مقالات الإسلاميّين، تحقيق هلموت ريتر. إسطنبول: مطبعة الدّولة، 1929-1930.
الأصفهانيّ، الرّاغب. الاعتقادات، تحقيق شمران العجلي. بيروت: مؤسسة الأشراف للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 1988.
الباقلانيّ، أبو بكر. كتاب التّمهيد، تحقيق رتشارد يوسف مكارثي. بيروت: المكتبة الشرقيّة، 1957.
البزدويّ، أبو اليسر. كتاب أصول الدّين، تحقيق هانز بيتر لينس. القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، 1963.
التّفتازانيّ، سعد الدّين. شرح العقائد النّسفيّة، تحقيق مصطفى مرزوقي. الجزائر: شركة دار الهدى للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 2000.
الجوينيّ، أبو المعالي. الشّامل في أصول الدّين، تحقيق عبد الله محمود محمد عمر. بيروت: دار الكتب العلميّة، 1999.
______. الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد، تحقيق [مع ترجمة للفرنسية] ج. د. لُوسياني. باريس: المطبعة الدوليّة، 1938.
______. العقيدة النّظامية، تحقيق محمد زاهد الكوثري. القاهرة: مطبعة الأنوار، 1948.
______. لمعٌ في قواعد أهل السّنة والجماعة، تحقيق ميشيل ألّار. بيروت: دار المشرق، 1968.
الحليمي، أبو عبد الله. المنهاج في شُعب الإيمان. ضمن: أبو بكر البيهقيّ، كتاب الأسماء والصّفات، تحقيق محمـد زاهد الكوثري. بيروت: [ناشر مجهول]، 1970.
السّمرقنديّ، أبو اللّيث. شرح الفقه الأبسط لأبي حنيفة، تحقيق ديبر هانز. ضمن: The Islamic Concept of Belief in the 4th/10th Century. Tōkyō: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), 1995.
السّمرقنديّ، الحكيم. كتاب السّواد الأعظم. القاهرة: [ناشر مجهول]، 1837-1837.
السّنوسيّ، أبو عبد الله. العقيدة السّنوسيّة. ضمن: إبراهيم الباجوري، حاشيّة على متن السّنوسيّة. القاهرة: [ناشر مجهول]، 1856.
الشّيخ المفيد، محمد بن محمد النّعمان. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات. طهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامى، 1993.
الصّابوني، نور الدّين. كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدّين، تحقيق فتح الله خليف. الإسكندريّة: دار المعارف، 1969.
العامريّ، أبو الحسن. كتاب التّقرير لأوجه التّقدير، مخطوطة برنستون، رقم 2163، 26–76.
الغزاليّ، أبو حامد. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق وتقديم فضلة شحادة. بيروت: دار المشرق، 1971.
______. كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. القاهرة: محمد علي صبيح، 1971.
الفضالي، محمد. كفاية العوامّ في علم الكلام. ضمن: إبراهيم الباجوري، حاشيّة على كفاية العوام. القاهرة: [ناشر مجهول]، 1906.
الفيروزآبادي، أبو إسحاق الشيرازيّ. الإشارة إلى مذهب أهل الحقّ، تحقيق مَارِي بِرْنَان. القاهرة: المعهد الفرنسيّ للآثار الشرقيّة، 1987.
الفيوميّ، سَعْدِيَا. كتاب الأمانات والاعتقادات، تحقيق صَامْوِيل لَانْدُور. ليدن: مطبعة بريل، 1880.
القشيريّ، أبو القاسم. شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد علي. القاهرة: دار الحرم للتّراث، 2001.
الماتريديّ، أبو منصور. تأويلات أهل السّنّة [= تفسير الماتريديّ المسمّى تأويلات أهل السّنّة]. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، 1971.
______. كتاب التّوحيد، تحقيق وتقديم فتح الله خليف. بيروت: دار المشرق، 1970.
المتولي، أبو سعد. كتاب المُغني، تحقيق وتقديم مَارِي بِرْنَان. القاهرة: المعهد الفرنسيّ للآثار الشرقيّة، 1986.
النّاشئ الأكبر، أبو العبّاس عبد الله بن محمد. الكتاب الأوسط في المقالات، تحقيق جُوزِيف فَانْ إِيسْ. بيروت: المعهد الألمانيّ للأبحاث الشرقيّة، 1971.
النّسفيّ، أبو البركات عبد الله بن أحمد. عُمدة عقيدة أهل السّنة والجماعة، تحقيق وليام كيورتن. ضمن: Pillar of the Creed. London: Society for the Publication of Oriental Texts, 1843.
النّسفيّ، أبو المعين. تبصرة الأدلّة، تحقيق كلود سلامة. دمشق: المعهد العلميّ الفرنسيّ للدراسات العربيّة، 1993.
الهمذاني، عبد الجبّار. المُغني في أبواب التّوحيد والعدل، تحقيق محمد مصطفى حلمي وأبو الوفا غنيمي. القاهرة: المؤسّسة المصّرية العامّة للتّأليف والأنباء والنّشر-الدّار المصريّة للتّأليف والتّرجمة، 1958.
______. كتاب المجموع في المحيط بالتّكليف، جمع الحسن ابن متويه، عني بتصحيحه ونشره الأب جين يوسف هوبن. بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة، 1965.
Allard, Michel. Le problème des attributs divins dans la doctrine d’al-Aš‘arī et de ses premiers grands disciples. Beirut: Imprimerie Catholique, 1965.
Davidson, Herbert A. Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1987.
Dhanani, Alnoor. ‘‘Rocks in the Heavens?! The encounter between ‘Abd al-Jabbār and Ibn Sīnā.’’ in Before and After Avicenna, edited by David C. Reisman, 127–44. Leiden: Brill, 2003.
Gimaret, Daniel. Les noms divins en Islam. Paris: Éd. du Cerf, 1988.
Hasnawi, Ahmad. “Un Élève d’Abū Bishr Mattā b. Yūnus: Abū ʿamr al-Ṭabarī.” Bulletin d’études orientales 48 (1996): 35–55.
Madelung, Wilferd. “The Origins of the Controversy Concerning the Creation of the Koran.” In Orientalia Hispanica: sive studia F.M. Pareja octogenario dicata, edited by J.M. Barral, 504–25. Leiden: Brill, 1974.
______. ‘Ar-Rāghib al-Iṣfahānī und die Ethik al-Gazālīs.ʾʾ In Islamwissenschaftliche Abhandlungen Fritz Meier zum 60sten Geburtstag, edited by Richard Gramlich, 152–63. Wiesbaden: Steiner, 1974.
Rowson, Everett K. ‘‘al-Rāghib al-Iṣfahānī.ʾʾ Encyclopaedia of Islam (New Edition), VIII, 389–90.
______. K. al-Amad ‘alā al-abad, edited and translated by E. Rowson. New Haven, Conn., 1988.
Sabra, Abdelhamid I. ‘‘The appropriation and subsequent naturalization of Greek science in medieval Islam: A preliminary statement.’’ History of Science 25 (1987): 223–43.
Street, Tony. “Logic.” In The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, edited by Richard C. Taylor and Peter Adamson, 247–265. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Ulrich, Rudolph. al-Māturīdī und die sunnitische Theologie in Samarkand. Leiden: Brill, 1996.
Van Ess, Josef. “Ibn Kullāb und die Miḥna.” Oriens 18-19 (1965-66): 92–142.
______. “Ibn Kullāb.” Encyclopaedia of Islam (New Edition), Suppl., 391–2.
______. Die Erkenntnislehre des ʻAḍudaddīn al-Īcī. Wiesbaden: Steiner, 1966.
Wisnovsky, Robert. ‘‘Notes on Avicenna’s concept of thingness (šay’iyya).’’ Arabic Sciences and Philosophy 10.2 (2000): 181–221.
______. “Avicenna and the Avicennian Tradition.” In the Cambridge Companion to Arabic Philosophy, edited by Peter Adamson and Richard C. Taylor, 92–136. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
______. Avicenna’s Metaphysics in Context. Cornell: Cornell University Press, 2003.
Wolfson, Harry Austryn. ‘‘Philosophical Implications of the Problem of the Divine Attributes in the Kalām.’’ Journal of the American Oriental Society 79 (1959): 73–80.
______. The Philosophy of the Kalām. Cambridge-Mass.-London: Harvard University Press, 1976.
للتوثيق
ويسنوڤسكي، روبرت. ”جانبٌ من المنعطف السِّنوي في علم الكلام السُّنِّي.“ ترجمة هشام بوهدي. ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2799>
روبرت ويسنوڤسكي
[1] المقالة الأصلية:Robert Wisnovsky, “One Aspect of The Avicennan Turn in Sunnī Theology,” Arabic Sciences and Philosophy 14 (2004): 65–100.
أتوجّه بخالص الشّكر والامتنان لأستاذي الدّارس فؤاد بن أحمد على تفضّله بمراجعة هذه التّرجمة، وأشكر له ملاحظاته القيّمة واقتراحاته المفيدة، التي أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في تطوير هذه التّرجمة وتجويدها؛ كما أشكر لزميلي الباحث عمر تمياس قراءته هذا العمل، وما سّجله من ملاحظاتٍ نافعةٍ بخصوصه [المترجم].
[2] رُوبِرت وِيسنُوڤْسكِي (Robert Wisnovsky)، دارسٌ أمريكيٌّ مهتمٌّ بتاريخ الفكر الإسلاميّ، يشتغلُ أستاذًا للفلسفة الإسلاميّة بجامعة ماكگيل، معهد الدراسات الإسلاميّة، مونتريال. ينصبُّ اهتمامه بالأساس على دارسة أصول فلسفة ابن سينا وتطوّرها وأثرها في العالم الإسلاميّ. كما أنه مدير مشروع ”مبادرة قاعدة بيانات الفلسفة الإسلاميّة في العصر ما بعد-الكلاسيكيّ“ (PIPDI)، والتي تعمل على إنشاء دليل لقاعدة بياناتٍ ضخمة لحفظ وفهرسة المخطوطات الإسلاميّة ما بعد-الكلاسيكيّة في مجالات علم الكلام، والمنطق، وفلسفة اللغة، والابستمولوجيا، والأخلاق، والميتافيزيقا، والطبيعيّات، وغيرها من أشكال المعارف العقليّة التي عرفتها الحضارة الإسلاميّة [المترجم].
[4] أنا ممتنّ للمُحكّم السّرّيّ من مجلّة الفلسفة والعلوم العربيّة على انتقاداته النّبيهة واقتراحاته المفيدة. كما أشكرُ طلبتي في فصل الدّراسات العليا عن الماتريديّة —رجب جوكتاس، وجوش هيماني، وويس كيلي، ويارون كلاين، وكريستيان لانج، وحكمت يمن—، لتوجيههم لي نحو العديد من المعطيات الجديدة والهامّة، ولدفعهم لي نحو مزيدٍ من التّفكير النّقدي بخصوص فرضيّتي.
[5] Rudolph Ulrich, al-Māturīdī und die sunnitische Theologie in Samarkand (Leiden: Brill, 1996).
[6] أبو منصورٍ الماتريديّ، كتاب التّوحيد، تحقيق وتقديم فتح الله خليف (بيروت: دار المشرق، 1970).
[7] Josef Van Ess, Die Erkenntnislehre des ʻAḍudaddīn al-Īcī (Wiesbaden: Steiner, 1966); Herbert A. Davidson, Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy )Oxford: Oxford University Press, 1987).
[8] للوقوف على عرضٍ موجزٍ لجهود المتكلّمين السّنة والشّيعة، في فترة ما بعد ابن سينا، في تملّك التّمييز السّينويّ بين الماهيّة والوجود، وبين واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره/ممكن الوجود بذاته؛ انظر: Robert Wisnovsky, “Avicenna and the Avicennian Tradition,” in the Cambridge Companion to Arabic Philosophy, ed. Peter Adamson and Richard C. Taylor (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 92–136.
[9] يُمكن الوقوف على مناقشاتٍ مفصّلةٍ بخصوص الخلفيّة الأرسطيّة (الفصل 11) والأفلاطونيّة المُحدَثة (الفصل 10) والفارابيّة (الفصل 12) لنظريّة ابن سينا، وأيضاً بخصوص تطوّر صياغات ابن سينا الخاصّة لهذه النظريّة (الفصل 14)، في كتابِي: Robert Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in Context (Cornell: Cornell University Press, 2003).
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجزأين الأوّلين، من هذا المقال، يُعيدان إلى حدٍّ كبيرٍ إنتاجَ المادّة الموجودة في الفصل 13 من هذا الكتاب، ولكن مع جملةٍ من التّنقيحات؛ أما بالنّسبة للجزء الثّالث والأخير، فهو جديدٌ بالكامل.
[10] بخصوص مفهوم القِدَم بشكل عام، انظر: Daniel Gimaret, Les noms divins en Islam (Paris: Éd. du Cerf, 1988), 164–9.
[11] القاضي عبد الجبّار الهمذاني، المُغني في أبواب التّوحيد والعدل، تحقيق محمد مصطفى حلمي وأبو الوفا غنيمي (القاهرة: المؤسّسة المصّرية العامّة للتّأليف والأنباء والنّشر-الدّار المصريّة للتّأليف والتّرجمة، 1958)، ج. 5، 233، س17–18؛ 234، س15؛ 235، س1؛ وراجع أيضاً تعريف ”التقدم في الوجود“ في: 234، س6–11.
[12] عبد الجبّار، المُغني، ج. 5، 233، س1–2؛ 234، س7–9.
[13] أبو بكر ابن فُورك، مُجرّد مقالات الشّيخ أبي الحسن الأشعريّ، تحقيق دانيال جيماريه (بيروت: دار المشرق، 1987)، 26، س19–20؛ 42، س19–20.
[14] أبو عبد الله الحليمي، المنهاج في شُعب الإيمان (ضمن: أبو بكر البيهقيّ، كتاب الأسماء والصّفات، تحقيق محمـد زاهد الكوثري [بيروت، 1970]، 29–30، س12–5).
[15] عبد الجبّار، المُغني، ج. 5، 233، س5.
[16] أبو الحسن الأشعريّ، مقالات الإسلاميّين، تحقيق هلموت ريتر (إسطنبول: مطبعة الدّولة، 1929-1930)، 164، س13–14. وبخصوص النّظريات الاعتزاليّة عن الصّفات، انظر: مقالات الإسلاميين، 164–165، س10–13؛ 484–487، س5–14.
[17] الأشعريّ، مقالات الإسلاميّين، 165، س5.
[18] الأشعريّ، مقالات الإسلاميّين، 486، س11–12.
[19] الأشعريّ، مقالات الإسلاميّين، 169–170، س2–3.
[20] الأشعريّ، مقالات الإسلاميّين، 169، س9–10.
[21] سأعقّب ببعض الإيجاز على مسألة ما إذا كانت كلّ الصّفات قديمةً أم بعضها فقط. فبالنّسبة للأشاعرة القدماء، فإنّ صفات الذّات لوحدها هي الّتي يمكن أن تُسمى قديمةً، بينما صفات الفعل مُحدَثةٌ. ودليلهم على ذلك أنّه في حالة ما إذا كانت صفةٌ من صفات الفعل، كالرزق، قديمةً، فحينئذٍ سيكون موضوع ذلك الفعل —وهو هنا المخلوقات التي يزرقها الله— قديماً بدوره. أما بالنّسبة للماتريديّة، الّذين ساروا، في الغالب، على خُطى العالم الحنفيّ الحكيم السمرقنديّ (ت. 348هـ/953م) في هذه المسألة، فإنّهم يرون أن صفات الفعل، إلى جانب صفات الذّات، كلّها قديمةٌ. وقد فسّر الماتريدية قِدَمَ صفات الفعل من خلال الاستعانة بتمييزٍ يبدو، من جميع النّواحي، مطابقاً لتمييز أرسطو الشّهير، في كتابه في النّفس (De anima 2.1)، بين ”الكمال“ الأوّل (first entelekheia) و”الكمال“ الثّاني (second entelekheia). فبحسب الماتريديّة، فإن النّقلة من الاتّصاف بالقدرة على الرّزق (الكمال الأوّل) إلى الممارسة الفعليّة لهذه القدرة (الكمال الثاّني)، مثل النّقلة من العلم بكيفيّة الكتابة إلى ممارسة فعل الكتابة، لا تقع تحت أي جنسٍ من أجناس التّغير [المعروفة] عند أرسطو —التحوّل من جوهر إلى آخر، أو من كيفيّة إلى أخرى، أو من كميّة إلى أخرى، أو من موضع إلى آخر—، وإنّما تُحيل بالأحرى على انتقال الشّيء نفسه من حالةٍ في الوجود إلى حالةٍ أخرى في الوجود. انظر: الحكيم السّمرقنديّ، كتاب السّواد الأعظم، بدون تحقيق (القاهرة: [ناشر مجهول]، 1837-38)، 21، س18–21؛ وأبو اللّيث السّمرقنديّ (ت. 373هـ/983م)، شرح الفقه الأبسط لأبي حنيفة، تحقيق ديبر هانز، ضمن: The Islamic Concept of Belief in the 4th/10th Century (Tōkyō: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), 1995), 138–160; 147–148.
[22] بخصوص هذا الموضوع، انظر:
Wilferd Madelung, “The Origins of the Controversy Concerning the Creation of the Koran,” in Orientalia Hispanica: sive studia F.M. Pareja octogenario dicata, ed. J.M. Barral (Leiden: Brill, 1974), 504–25; Josef Van Ess, “Ibn Kullāb und die Miḥna,” Oriens 18-19 (1965-66): 92–142 (esp. pp. 102ff) and “Ibn Kullāb,” Encyclopaedia of Islam (New Edition), Suppl., 391–2; Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalām (Cambridge-Mass.-London: Harvard University Press, 1976), 235–303.
وبخصوص موضوع الصّفات بشكلٍ عامٍّ، انظر:
Wolfson, ‘‘Philosophical Implications of the Problem of the Divine Attributes in the Kalām,’’ Journal of the American Oriental Society 79 (1959): 73–80; and The Philosophy of the Kalām, 112–234; and Michel Allard, Le problème des attributs divins dans la doctrine d’al-Aš‘arī et de ses premiers grands disciples (Beirut: Imprimerie Catholique, 1965).
[23] الأشعريّ، مقالات الإسلامييّن، 170، س4–6؛ 171–172، س16–3؛ 517، س14–16.
[24] للوقوف على ما يُثبت أنّ تعدّد القُدماء قد كان توجّساً حقيقيّاً لدى المفكّرين السّنيّين، انظر كتاب المتكلّم الأشعريّ والصّوفيّ أبو القاسم القشيريّ (ت. 465هـ/1072م)، شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد علي (القاهرة: دار الحرم للتّراث، 2001)، 55، س8؛ 392، س5–7.
[25] هذا بالذّات هو المأزق الّذي اتّهم المتكلمُ الشيعيُّ (المتأثّر بالمعتزلة) الشّيخ المفيد (ت. 413هـ/1022م) أبَا الحسن الأشعريّ بالوقوع فيه: الشّيخ المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات (طهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامى، 1993)، 11–12، س20–8.
[26] الأشعريّ، مقالات الإسلاميّين، 172، س1–3.
[27] أبو الحسن الأشعريّ، كتاب اللّمع في الرّد على أهل الزّيغ والبدع، تحقيق الأب رتشارد يوسف مكارثي (بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة، 1953)، 12–13، س21–2.
[28] ابن فُورك، مُجرّد مقالات الأشعريّ، 326، س7–12؛ وانظر أيضاً: 28، س12–17. والنّص الّذي كان يُحيل عليه ابن فُورك، بشكلٍ صريحٍ، هو كتاب الإيضاح [= إيضاح البرهان في الردّ على أهل الزّيغ والطّغيان: أبو القاسم ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى أبي الحسن الأشعريّ، بدون تحقيق (دمشق: القدسي، 1928)، 130، س3–4]، والذي تبنّى فيه الأشعريّ صيغة ”القديم بقدمٍ“؛ ثمّ كتاب الـمُختزَن (ابن عساكر، التّبيين، 133، س2–5)، والّذي تبنّى فيه صيغة ”القديم بنفسه.“
[29] أبو المعين النّسفيّ، تبصرة الأدلّة، تحقيق كلود سلامة (دمشق: المعهد العلميّ الفرنسيّ للدّراسات العربيّة، 1993)، 56، س2–10.
[30] أبو بكر الباقلانيّ، كتاب التّمهيد، تحقيق رتشارد يوسف مكارثي (بيروت: المكتبة الشرقيّة، 1957)، 29، س18.
[31] الباقلانيّ، كتاب التّمهيد، 29–30، س17–2.
[32] أبو منصور الماتريديّ، تأويلات أهل السّنّة [= تفسير الماتريديّ المُسمّى تأويلات أهل السّنةّ] (القاهرة: المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة، 1971)، ج. 1، 76–77، س16–4؛ وانظر أيضا: 131، س13. ويتوسّل الماتريديّ أيضا بالتّمييز بين ”بذاته“ و”بغيره“ في: كتاب التّوحيد، 43، س8–9.
[33] البيهقيّ، كتاب الأسماء والصّفات، 33، س6–12.
[34] وبيان ذلك كما يلي: فمن النّاحية الزّمانية، فالقديم هو الذي لا ابتداء لوجوده، بينما المحدَث طارئٌ في الزّمان، وثّمة بدايةٌ لوجوده؛ أما من النّاحية السّببيّة، فالقديم قائمٌ بنفسه ولا علّة/سبب لوجوده، في حين أنّ المحدَث لا يقوم بنفسه ووجوده معلولٌ لغيره؛ ومن ثمّ يظهر لنا وجه التّنافي الحاصل في مساواة ”القديم لغيره“ مع ”المحدث لنفسه،“ لما يُفترض أن ينطوي عليه كلّ واحد منهما من معانٍ يستحيل اجتماعها في شيءٍ واحدٍ [المترجم].
[35] وهنا لا بد من التّنبيه إلى أنّ ويسنوڤسكي قد اعتمد، في نقل نصوص كتاب الحكمة العروضيّة، على المخطوطة الموجودة بمكتبة جامعة أوبسالا (MS Uppsala)، تحت رقم 364؛ بينما اعتمدتُ في نقلها على نشرة محسن صالح المذكورة أعلاه، والّتي عوّل فيها بدوره على مخطوطة أوبسالا السّابقة [المترجم].
[36] الباقلانيّ، كتاب التّمهيد، 29، س5: ”لأنّ القديم لا يجوز عدمه“؛ الحليميّ، كتاب المنهاج في شعب الإيمان (ضمن: البيهقيّ، كتاب الأسماء والصّفات،33، س1–5): ”لأنّه إذا كان موجوداً لا عن أوّلٍ ولا بسببٍ، لم يجُز عليه الانقضاء والعدم.“
[37] الأشعريّ، كتاب اللّمع، 11، 14–15.
[38] هناك بعض الأدلّة (في مقطعٍ واردٍ عند: القاضي عبد الجبّار الهمذانيّ، جمع الحسن ابن متويه، كتاب المجموع في المحيط بالتّكليف، عني بتصحيحه ونشره الأب جِين يُوسف هُوبِن [بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة، 1965]، ج. 1، 152–154، س7–17) على أنّه من الممكن أن يكون المعتزليّ الجبّائيّ قد توقّع هذه الخطوة، حيث نجده يؤكّد على أنّ وجه مخالفة القديم (الله) لغيره من الحوادث، على مستوى ما يُنسب إليه من صفاتِ القدم والقدرة والعلم والحياة وغيرها، كامنٌ في وجوب هذه الصّفات له دون ما سواه (152، س7–14). وقد اختلف معه ابنه أبو هاشم بخصوص وجهة نظره هذه، ذاهباً إلى أنّ هذه المخالفة من جهة الوجوب، والتي يمكن اختزالها في النّهاية في استحقاق الله لصفاته وعدم زواله عنها على الاتّصال والدّوام، ليست حقيقيّة بما يكفي لتفسير وجه مخالفته للموجودات الأخرى (152، س15–19).
[39] انظر بشأن هذا الغياب، وأيضا بشأن تمييز ابن سينا الجديد بين الوصفي والذّاتي في تحليل القضايا الموجّهة:
Tony Street, “Logic,” in The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, eds. Richard C. Taylor and Peter Adamson (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 247–265.
[40] للوقوف على أمثلةٍ لعبارات: بالضّرورة، ضرورةً، ضرورة العقل، ضروريّ (و، بنسبة أقلّ شيوعاً، ”بالاضطرار،“ والتي تقترن غالبا بعبارة ”بالطبع،“ وتقابلها عبارة ”بالاختيار“)، مستعملةً في سياقاتٍ ابستمولوجية في النّصوص الكلاميّة المصنّفة في فترة ما قبل ابن سينا، انظر (بالنّسبة للمعتزلة): الأشعريّ، مقالات الإسلاميّين، 136، س10–15؛ 393، س5–14؛ 480، س6–10؛ والنّاشئ الأكبر (ت. 293هـ/906م)، الكتاب الأوسط في المقالات، تحقيق جُوزِيف فَانْ إِيسْ (بيروت: المعهد الألمانيّ للأبحاث الشرقيّة، 1971)، 109–110، س13–11؛ وسَعْدِيَا الفيّوميّ (ت. 330هـ/942م)، كتاب الأمانات والاعتقادات، تحقيق صَامْوِيل لَانْدُور (ليدن: مطبعة بريل، 1880)، 12–13، س17–10؛ 16–20، س19–18؛ وانظر (بالنّسبة للمتكلّمين السّنة): الماتريديّ، كتاب التّوحيد، 5، س13؛ 7، س11؛ 8، س14–17؛ 42، س20؛ والأشعريّ، كتاب اللّمع، 41–42، س10–15؛ والباقلانيّ، كتاب التّمهيد، 7، 4–10؛ 8، 6–13؛ 9، 2–15؛ 52، س4–7؛ وابن فُورك، مُجرّد مقالات الأشعريّ، 12، س1–20؛ 13–14، س25–20؛ 18–19، س21–6؛ 20–21، س9–13؛ 222، س16–19؛ 247–249، س17–22؛ 284، س15–18؛ 324، س4؛ 328، س14–19.
[41] بخصوص الفرق بين الواجب والضّروري، انظر: Van Ess, Die Erkenntnislehre des ʻAḍudaddīn al-Īcī, 118–19.
وللوقوف على بعض الأمثلة التي يظهر فيها الواجب والفرض كمترادفين، انظر: ابن فُورك، مُجرّد مقالات الأشعريّ، 16، س3–6؛ 32، س7–17؛ 180، س17؛ والباقلانيّ، كتاب التّمهيد،187، س1.
[42] ابن فورك، مُجرّد مقالات الأشعريّ، 285، س7–20؛ والباقلانيّ، كتاب التّمهيد، 8، س4–5؛ 379–380، س11–15.
[43] إخوان الصّفاء، رسائل إخوان الصّفاء وخلّان الوفاء، دون تحقيق (بيروت: دار صادر، 1957)، ج. 2، 471، س1.
[44] Everett K. Rowson, K. al-Amad ‘alā al-abad, ed. and trans. E. Rowson (New Haven, Conn., 1988), 233;
ويُحيل على طبعة القاهرة، 1907، لكتاب الفوز الأصغر لابن مسكويه: 15f؛ وفي الطّبعة التي اطلعتُ عليها [كتاب الفوز الأصغر، دون تحقيق (بيروت: [د.ن.]، 1901)]، تظهر هذه الجملة في الصّفحة: 20، س10–12.
[45] العامريّ، الأمد على الأبد، 78، س12؛ وتظهر جملة ”واجب الوجود“ مجرّدةً عن قيد ”بذاته“ في: 170، س12.
[46] العامريّ، كتاب التّقرير لأوجه التّقدير، 28-30 [مخطوطة برنستون 2163 (B393)، 26–76]؛ وأنا أعتمد هنا على خلاصة رُوسُون في تعليقه على كتاب الأمد، 232–233.
[47] أبو عليّ ابن سينا، المبدأ والمعاد، تحقيق عبد الله نوراني (طهران: مؤسسة مطالعات اسلامى، 1984)، 3، س2–15.
[48] بخصوص الصّلة المحتملة بين ابن سينا وعبد الجبّار، انظر: Alnoor Dhanani, ‘‘Rocks in the Heavens?! The encounter between ‘Abd al-Jabbār and Ibn Sīnā,’’ in Before and After Avicenna, ed. David C. Reisman (Leiden: Brill, 2003), 127–44.
[49] أبو الوليد ابن رشد، تهافت التّهافت، تحقيق مُورِيس بْوِيج (بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة، 1930)، 276، س4–9.
[50] عبد الجبّار، جمع ابن متويه، كتاب المجموع في المحيط بالتّكليف، ج. 1، 50، س24؛ 99، س21–22؛ 141، س10–12؛ 142، س1.
[51] عبد الجبّار، جمع ابن متويه، كتاب المجموع في المحيط بالتّكليف، ج. 1، 51، س20–21.
[52] عبد الجبّار، المُغني، ج. 4، 250، س4–15؛ ج. 11، 432، س11–15.
[53] إنصافاً لابن رشدٍ، لا بدّ من القول إنّه من الممكن أن يكون ثمّة دليلٌ على حصول سوابق اعتزاليّة لتمييز ابن سينا، ممّا هو غير متوفّر بين أيدينا اليوم. وأحدُ هؤلاء الأسلاف المحتملين له هو أبو القاسم الكعبيّ البلخيّ (ت. 319هـ/931م)، أحد أشهر أعلام المدرسة الاعتزاليّة-البغداديّة المهادنة للفلسفة (نسبيّاً)، وممّن تتلمذ على يد أبي الحسين الخيّاط وأبي عليٍّ الجبّائيّ، حيث كان من المشاركين النّشيطين في المناظرات بخُرَاسَان وبلاد ما وراء النّهر خلال الثّلث الأوّل من القرن العاشر [للميلاد]، ويُحتمل أن يكون قد خلّف تلامذةً هناك. لكن، إلى حين تحقيق عمل الكعبيّ البلخيّ بشكلٍ كاملٍ —إذ ما يزال إلى الآن معظمه مخطوطاً— ودراسة أثره، فإنّ قولنا هذا ينبغي أن يظلّ مجرّد اقتراحٍ.
[54] Everett K. Rowson, ‘‘al-Rāghib al-Iṣfahānī,ʾʾ Encyclopaedia of Islam (New Edition), VIII, 389–90; and Wilfred Madelung, ‘‘Ar-Rāghib al-Iṣfahānī und die Ethik al-Gazālīs,ʾʾ in Islamwissenschaftliche Abhandlungen Fritz Meier zum 60sten Geburtstag, ed. Richard Gramlich (Wiesbaden: Steiner, 1974), 152–63.
[55] الرّاغب الأصفهانيّ، الاعتقادات، تحقيق شمران العجليّ (بيروت: مؤسّسة الأشراف للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 1988)، 48، س15–20.
[56] كما سبق وأشرتُ في هامشٍ سابقٍ، يمكن الوقوف على مناقشاتٍ مفصَّلةٍ بخصوص الخلفيّة الأرسطيّة، والأفلاطونيّة الُمحدَثة، والفارابيّة، لتمييز ابن سينا، في كتابِي: Avicenna’s Metaphysics in Context، وبالتّحديد في الفصول 10 و11 و12 منه. وقد أبرز أحمد حسناوي بعض الأدلّة الأخرى المثيرة للاهتمام على أنّ ابن سينا قد وَرِثَ هذا التّمييز عوضاً عن أن يكون قد ابتكره، وذلك في دراسته التالية:
Ahmad Hasnawi, “Un Élève d’Abū Bishr Mattā b. Yūnus: Abū ʿamr al-Ṭabarī,” Bulletin d’études orientales 48 (1996): 35–55, 37.
[57] أبو يعلى ابن الفرّاء، كتاب المعتمد في أصول الدين، تحقيق وديع زيدان حدّاد (بيروت: دار المشرق، 1974)، 47، س15–16: ”ولا يجوز عليه العدم […] استحال عليه العدم“؛ وأيضاً في 48، س8–9: ”والدّلالة على أنّه باقٍ […] ما تقدّم من وجود كونه قديماً فيما لم يزل ولا يزال، وأنّ العدم يستحيل عليه“؛ وأبو إسحاق الفيروزآبادي الشيرازيّ، الإشارة إلى مذهب أهل الحقّ، تحقيق مَارِي بِرْنَان [ضمن: La profession de foi d’Abū Isḥāq al-Šīrāzī] (القاهرة: المعهد الفرنسيّ للآثار الشرقيّة، 1987)، 20، س13–18: ”القديم يستحيل عدمه“؛ وأبو سعد المتوليّ، كتاب المُغني، تحقيق وتقديم مَارِي بِرْنَان (القاهرة: المعهد الفرنسيّ للآثار الشرقيّة، 1986)، 6، س5: ”لأنّ القديم يستحيل عدمه“ (وقد أتبع هذه الجملة بشرحٍ في: 6، س10–19)؛ 4.21-5: ”فإنّ القديم يستحيل عدمه“؛31، س11: ”ويستحيل عدم القديم.“
[58] الإحالاتُ إلى كتاب الإرشاد هنا تعود على نشرة ج. د. لُوسْيَاني [تحقيق مع ترجمة للفرنسيّة] (باريس: المطبعة الدوليّة، 1938). وقد تبع الجوينيَّ، في قصره استعمال عبارة ”وَاجِب“ لتحديد طبيعة العلاقة (الرّابطة) التي تربط الصّفات بالله، متأخرُو شيوخ الأشاعرة، كأبي عبد الله السّنوسيّ (ت. 895هـ/1490م)، العقيدة السّنوسيّة (ضمن: إبراهيم الباجوري [ت. 1277هـ/1860م] حاشية على متن السّنوسيّة، دون تحقيق [القاهرة، 1856]، 57–58، س8–2 (الهامش): ”[…] واجبةٌ له“؛ وإبراهيم اللّقانيّ (ت. 1041هـ/1631م)، جوهرة التّوحيد، دون تحقيق (القاهرة، [د.ت.])، 28، س1؛ 31، س1: ”فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعاً وَجَبَا/عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجَبَا/لله وَالجَائِزَ وَالمُمْتَنِعَا“؛ ومحمد الفضالي، كفاية العوامّ في علم الكلام (ضمن: إبراهيم الباجوريّ، حاشيّة على كفاية العوامّ، دون تحقيق [القاهرة، 1906]، 31–33، س1–1 (المتن): ”اعلم أنّ فهم العقائد الخمسين الآتية يتوقّف على أمورٍ ثلاثةٍ: الواجب، والمستحيل، والجائز. فالواجب هو الّذي لا يتصوّر في العقل عدمه، أي لا يصدّق العقل بعدمه“؛ 38، 2–4 (المتن): ”فإذا قيل هُنا القدرة واجبةٌ لله، كان المعنى: قدرة الله لا يصدّق العقل بعدمها“؛ 44، س1: ”الأوّل من الصّفات الواجبة له تعالى: الوجودُ.“
[59] ابن الفرّاء، كتاب المعتمد في أصول الدّين، 44، 3–14. ويشير ألّار إلى منهجية الجوينيّ الجديدة في تصنيف الصّفات الإلهيّة بوصفها ”خطة أ،“ والتي تقابلها ”خطة ب“ التي تحيل إلى منهج القدماء في التمييز بين ”الصّفات النفسيّة“ (الذّاتية) و”الصّفات المعنويّة“؛ انظر: Allard, Textes apologétiques de Ǧuwaynī, 11; Le problème des attributs divins dans la doctrine dʾal-Ašʿarī et de ses premiers grands disciples, 384–5.
[60] انظر، على سبيل المثال، بعض أعمال متكلّمي الماتريديّة: نور الدّين الصّابوني (ت. 580هـ/1184م)، كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدّين، تحقيق فتح الله خليف (الإسكندريّة: دار المعارف، 1969)، 36–37، س9–15: ”وإذا ثبت أنّه واجب الوجود لذاته ثبت أنّه قدیمٌ، لأنّه لم یتعلّق وجوده بغیره، فكان وجوده لذاته.“ (وقارن 70، س12؛ و72، س1–2)؛ وأبو البركات عبد الله بن أحمد النّسفيّ (ت. 710هـ/1310م)، عمدة عقيدة أهل السّنة والجماعة، تحقيق وليام كيورتن [ضمن: Pillar of the Creed] (لندن: مجتمع لنشر النصوص الشرقية، 1843)، 4–5، س15–1: ”لأنّ القديم واجب الوجود لذاته.“
[61] Abdelhamid I. Sabra, ‘‘The appropriation and subsequent naturalization of Greek science in medieval Islam: A preliminary statement,’’ History of Science 25 (1987): 223–43.
[62] Robert Wisnovsky, ‘‘Notes on Avicenna’s concept of thingness (šay’iyya),’’ Arabic Sciences and Philosophy 10.2 (2000): 181–221.
[وقد نُقل هذا المقال إلى العربيّة بترجمة أيمن شحّادة، تحت عنوان: ”ملاحظاتٌ حول مفهوم الشّيئيّة عند ابن سينا،“ ضمن بين الفلسفة والرّياضيات: من ابن سينا إلى كمال الدّين الفارسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2016)، 101–150 = المترجم]
[63] Wisnovsky, ‘‘Avicenna and the Avicennian tradition.’’
مقالات ذات صلة
الآبلي شيخُ ابن خلدون
الآبلي شيخُ ابن خلدون ناصيف نصار[1] ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد تقديم نُشر مقال ناصيف نصار الذي نترجمه هنا بالمجلة الآتية: Studia Islamica, 1964, No. 20 (1964): 103-114. والمقال من الدراسات القليلة والباكرة التي تعرضت لهذا الموضوع الملغز، أعني علاقة الفيلسوف والرياضي...
في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة
في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة[1] وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra ترجمة وتقديم محمد أبركان*جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس تقديم المترجم صاحب المقال الذي نترجمه هنا هو وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra، الكاتب الفرنسي المتخصص في الصحافة العلمية. وعلى الرغم من أن...
اعتبارات الماهية: الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي
Iʿtibārāt al-Māhiyah:al-Ibdāʿ al-Sīnawī, wa Ibtikār al-Mudarris al-Zanūzī اعتبارات الماهيّة: الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي رامين عزيزي وجهنكير مسعودي جامعة فردوسي، مشهد ترجمها عن الفارسية الهواري بن بوزيان جامعة المصطفى العالمية، قم...
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي لويسْ خَابْيِيرْلُوبيثْ فارْخَاتْجامعة بَانْأمريكَانَا-مكسيكو سيتي ترجمة محمد الولي[1]جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس كثيرة هي الدراسات التي أنجزت في العالم العربي حول دمج كتابي الخطابة والشعر لأرسطو ضمن الأورغانون. وإذا تم الاتفاق...
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م)
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م) خوليو سامسو نقله من الإسبانية إلى العربية مصطفى بنسباعجامعة عبد المالك السعدي-تطوان تقديم رغم أن كتاب علوم الأوائل في الأندلسLas ciencias de los antiguos en al-Andalus للأستاذ خوليو سامسو Julio Samsó قد صدر سنة...
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل* هانس ديبرترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد تقديم الترجمة هانز دايبر مستشرق ألماني من مواليد عام 1942. حصل على الدكتوراه عام 1968. واشتغل أستاذًا للغة العربية والإسلام في الجامعة الحرة بأمستردام من عام 1977 إلى...
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘: ملاحظات أوليّة
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘ملاحظات أوليّة[1] تأليف: ل. فان ليتجامعة يال-نيو هيفن ترجمة وتقديم: سعيد البوسكلاويجامعة محمّد الأوّل-وجدة/جامعة زايد-أبو ظبي تقديم المترجم ننقل إلى القارئ العربيّ دراسة قيّمة ترصد تقليدا فكريّا كاملا في شرح كتاب...
قصة عمر الأرض
قصة عمر الأرض ترجمة وتقديم محمد أبركان جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس تقديم المترجم المقال الذي نترجمه هنا هو للفيزيائي هوبير كريبين Hubert Krivine؛ وقد سبق لهذا العالِم أن اشتغل باحثا ضمن بنية البحث بمختبر الفيزياء النظرية والنماذج الإحصائية بجامعة...
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية[1] تأليف: محسن كَدِيوَر[2] ترجمها عن الفارسية يونس أجعون[3]جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس (1)المقدمة 1. مكانة الفلسفة الإشراقية ضمن الفلسفة الإسلامية تُعدُّ الفلسفةُ الإشراقية أحدَ مدارس الفلسفة الإسلامية الثلاث، وقد...
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس مارون عواد المركز الوطني للبحث العلمي، باريس ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد جامعة القرويين، الرباط تقديم حظيت نظرية الشعر المنطقية باهتمام كبير من قبل الدارسين والمهتمين بالتآليف المنطقية للفلاسفة في السياقات الإسلامية؛ ويحتل...