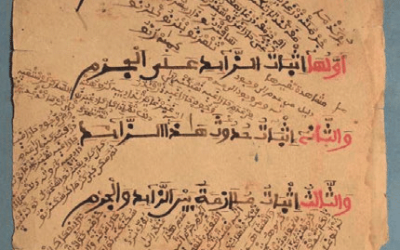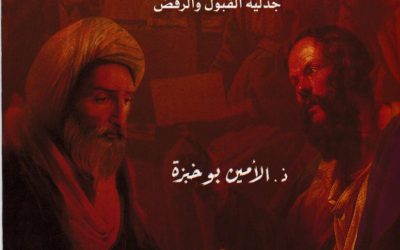![]()
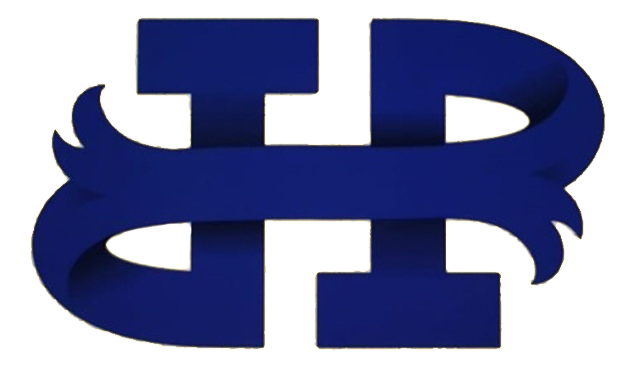
حوار شامل مع فؤاد بن أحمد

حوار شامل مع فؤاد بن أحمد
أنجزه محمد عبد الصمد الإدريسي (صحيفة المساء 4532، 6 يوليوز 2021)
- أنجزت مؤخرا بالتعاون مع روبرت پاسناو من جامعة كولورادو-بولدر مدخلا مفصّلا عن الفيلسوف ابن رشد بموسوعة استانفورد الفلسفية وهي أهم موسوعة فلسفية.. هل كان لا بد من كل هذا التأخر لإيلاء أهم فيلسوف عربي حقه؟
- أتصور أن من الجيد أننا أنجزنا المدخل الآن؛ وإلا تأخر الأمر أكثر. دعني أعترف بداية أن هناك بعض ”الأنا“ حين حديث المرء عن عمل قام به؛ ولكن الواقع أن الأنا هنا مجرد صدفة، لأنه كان يمكن لأي شخص أن يفكر في مدخل لابن رشد ويقترحه على الموسوعة، وإذا قبلته لجنة التحكيم فلا شك أنه كان سينشر. نعم، من صُدف التاريخ الجميلة أنني كنت السبب في أن يُكتب هذا المدخل، بتعاون مع الزميل روبرت پاوسناو من جامعة كولورادو-بولدر. لكن الأهمية الحقيقية ليست في هذا، كما أنها ليست في اللحظة التي كتب فيها، وإنما في طبيعة المقاربة التي تبنيناها في تقديم ابن رشد. فهناك اختلاف كبير جدا بين المدخل الذي خصصناه لابن رشد والمداخل المخصصة لفلاسفة آخرين من السياقات الإسلامية نفسها، ولكن أعدها دارسون من العالم الغربي. نحن، وباتفاق معلن، انطلقنا من فكرة أنه لا بد من أن نقارب ابن رشد من الداخل، ومن سياقه الذي عاش فيه، لا أن نسقط عليه الأسئلة التي تولدت عن تلقي فلسفته في أوروبا. فعندما نقارب مثلا نظرية ابن رشد في النفس لا يهمنا ما آلت إليه فيما بعد؛ ما يهمنا أولا هو نظرية ابن رشد في سياقها الأول. ولقد جرت عادة الدراسين -الغربيين أساسا- على مقاربة الأعلام الفلسفية من خلفيات ثقافية محددة، شاؤوا ذلك أم لا، فالأمر هنا أكبر من الذات. ولا شك أن للسياق أثره على الدارس؛ فإذا كنت، مثلا، متشبعا بثقافة دينية، فلا بد أن تنبعث تلك الثقافة عندما تُؤول الظواهر من حولك. لذلك حرصنا على أن ننجز العمل بمقاربة تخفف من خلفياتنا نحن اليوم لفائدة ابن رشد في سياقه. وفي هذا الباب، فقد ألححنا على مسألة قد تبدو للناس يسيرة، وهي التسمية: وهكذا فقد استعملنا ابن رشد أولا وليس أڤيروس Averroes، مع أن المدخل مكتوب بالإنجليزية طبعا. أتصور أن أي شخص ينتمي إلى الأدب ما بعد الكولونيالي يعرف جيدا أهمية التسمية ودلالتها. فرق كبير بين تسمية الرسول محمد بـ”محمد“ وتسميته بـ Mahomet مثلا.. ما عاد مقبولا الآن أن نستعمل أسماء وضعت واستعملت في السياق الإسلامي بأسماء صيغت في فترات لاحقة وظروف مختلفة. فاسم Averroes أفيروس كما شرحت في مواضع سابقة هو حصيلة سياق ثقافي مختلف تماما عن السياق الذي نشط فيه ابن رشد. ويمكن أن نقول إن Averroes هو من اصطناع أتباع المذهب الرشدي وخصومه في أوروبا، وأكمل تشييد هذه الفكرة إرنست رينان في منتصف القرن التاسع عشر. ومن الغريب أن نظل، نحن كدارسين ننتمي إلى هذا العالم، سجيني هذه المقاربة. ويجب أن نسجل باعتزاز، الآن، أن هناك تحولا وسط الدارسين وعند دور النشر، واتجاها نحو حسم هذه المسألة، بحيث نجد دارسين كبارا كانوا طيلة مسارهم العلمي يطلقون على ابن سينا (Avicenna)، والآن بدأوا يستعملون ابن سينا أو ابن رشد أو ابن باجة بأسمائهم الأصلية، بدل التسميات الغربية التي لها حمولة تأويلية مختلفة تماما.
2- عدا التحيز الحاصل في الاسم ما هي في نظرك أهم التحيزات الحاصلة حول ابن رشد؟
- هناك تحيزات تجاه جوانب كثيرة من فكره، لكن ثمة الآن ما يشبه الإجماع أنها لم تعد مقبولة. كالزعم مثلا بأن ابن رشد كان يقول بالحقيقة المزدوجة: حقيقة دينية وحقيقة فلسفية. هذا الأمر أصبح متجاوزا، ولم يعد أحد يقول به، إلا إذا كان لا يقرأ أو لا يتابع ما ينشر على الأقل. ومن بين التحيزات الأخرى عن ابن رشد إقامة تمييز في كتاباته بين ما يسمى ”الكتابات الفلسفية“ و”الكتابات الموجهة للعموم“، فمثلا شروحه على أرسطو تعتبر وفق هذا المنطق التمييزي من الكتابات الفلسفية بينما بعض كتاباته الأخرى، مثل تهافت التهافت والكشف عن مناهج الأدلة، كتاباتٌ موجهة إلى الجمهور؛ وكأن الجمهور قادر على فك مسائل الكتابين. وهذا كله تصور خاطئ، وإسقاط للتصور الذي كان لدى الدارسين عن أعمال أرسطو على فيلسوف آخر. ابن رشد هو نفس الفكر يتحرك في مجالات عدة وبأغراض مختلفة. لذلك، فابن رشد هو نفسه سواء كان يشرح ما بعد الطبيعة لأرسطو، أو وهو ينتقد الجويني، أو يرد على الغزالي. هو نفس العقل الواحد، ولا معنى لتحويل متن فلسفي واحد إلى جزر وأرخبيلات. ويجب أن أضيف أن الذي نتج عن هذا التمييز الخاطئ هو حصول اختلال في التوازن بين الاهتمام بجانب في فلسفة ابن رشد على حساب جانب آخر. من ذلك أن بعض كتب ابن رشد من هذا الصنف الثاني لم تحقق تحقيقا علميا إلى اليوم. فإلى اليوم لا نتوفر على نشرة نقدية لكتاب مهم كـالكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. وهذا نموذج لهذه التمييزات المصطنعة. طبعا هناك من الدارسين الهامين في تاريخ الرشدية، كالراحل جمال الدين العلوي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، من حاولوا أن يظهروا تهافت هذه الدعوى؛ ويمكن القول إنني أسير في الطريق نفسه.
3- في المدخل الذي كتبته تقول إن تلقي ابن رشد أصبح أهم من معرفة ابن رشد نفسه. هل هناك صراع ما حول ابن رشد؟
- مسألة التلقي مسألة مهمة، وخصوصا في الدراسات الأنگلوساكسونية. إذا ألقيتَ عرضا عن فيلسوف ما عاش في الماضي، فمن بين الأسئلة التي من الوارد أن تطرح عليك: ماذا حصل لأفكاره؟ وكيف تم تلقيها وانتقالها؟ وتلقي فكر ابن رشد من المسائل الغامضة إلى اليوم، والتي يظهر فيها هذا الصراع ما بين المقاربات الغربية، وتلك التي أحاول أن أتبناها. مثلا عندما تأخذ أي دراسة مونوگرافية عن ابن رشد تجد فيها قسما خاصا بتلقي فلسفة ابن رشد. فيتحدث صاحب الدراسة عن تلقيه في الفكر العبري اليهودي وعن تلقيه في الفكر اللاتيني، لكن لا تجد شيئا عن تلقيه في السياقات الإسلامية بعد وفاته، وكأن هذا الفيلسوف ما كانت له حياة بعد وفاته في أعمال النظار المسلمين الذين جاؤوا بعده. وحتى إذا اجتهد كاتب أو دارس ليتحدث عن التلقي العربي الإسلامي لابن رشد، فإنه يقفز مباشرة إلى عصر النهضة مع فرح أنطون ومحمد عبده، ويبدأ في إحصاء مشاكل عصر النهضة (من علمانية وتقدمية وتنمية…)، ويدخل في ذلك بعض الأسماء المعاصرة لنا مثل محمد عمارة وأبو زيد وعابد الجابري وآخرين، باعتبارهم إحياء واستعادة لابن رشد؛ وكأن هذا الاستثمار الأيديولوجي هو التلقي الوحيد الذي حصل لفكر ابن رشد في سياقاتنا الإسلامية والعربية. والحال أن التحدي الحقيقي أمام الباحثين هو ماذا حصل لفكر ابن رشد بعد وفاته في سياقه الأول؟ وهل ترك أثرا؟ هذا هو المجال الذي أشتغل فيه منذ سنوات. وضمن هذا المشروع نشرت مجموعة دراسات، يظهر بعضها أن ابن رشد في القرن السابع عشر للميلاد كان ينافس ابن سينا في بلاد فارس. وبالمناسبة، فما يوجد من مخطوطات عربية لكتب ابن رشد في إيران أكثر مما يوجد في العالم بأسره، حسب ما نتوفر عليه اليوم من معطيات. وهذا يظهر إلى أي حد انتشرت كتب ابن رشد. وفي الواقع، إذا أردنا أن نتتبع أشكال تلقيه، فقد ترك أثرا حتى في خصومه ومنتقديه الذين لم يذكروه أو ذكروه بسوء، بل حتى الذين لم يذكروه نهائيا اقتبسوا منه. وقد أظهرت في تحقيقي لكتاب ابن طملوس، المختصر في المنطق (ليدن: بريل، 2020) كيف أن هذا الفيلسوف الذي هو تلميذ ابن رشد وصاحبه، لم يذكره ولا مرة واحدة في كتابه هذا، لكنه اقتبس من أعماله من أول كتابه إلى آخره. وهناك شواهد وأمثلة كثيرة للعديد من النظار الذين اقتبسوا من ابن رشد دون أن يذكروا اسمه. وهذا نموذج للتحديات التي تواجه الدراسات الرشدية؛ أعني أن تكشف هذا الجانب المنسي من تاريخ ابن رشد حتى ننافس التلقيَيْن اللاتيني المسيحي والعبراني اليهودي. وطبعا، سيكون من السذاجة أن أدّعي أن ابن رشد ترك مدرسة فلسفية لا علم للناس بها، وقد اكتشفتُ معالمها، بل غاية ما أدعيه أن الافتراض الشائع بأن ابن رشد لم يترك أي أثر في الفكر العربي والإسلامي الذي جاء بعده هو افتراض باطل بالحجج والشواهد النصية.
4- هل ابن رشد فعلا هو أهم قطب في الفلسفة الإسلامية أخذا بالاعتبار قول من يقول إنه كان مجرد شارح لأرسطو؟
- لا أريد أن أنساق وراء الحديث عن أهم فيلسوف من غيره. لكن يجب أن أسجل أن ما يحظى به ابن سينا الآن من اهتمام في الأوساط الأكاديمية الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك كندا، هو أكبر بكثير من ابن رشد. أقول انطلاقا من تتبعي لما يصدر على الأقل بثلاث لغات غير العربية. أما بخصوص مسألة الشرح على أرسطو، فإننا نحن نتحدث عن زمن كان الإبداع فيه يحصل من خلال عملية الشرح نفسه. وسأقدم مثالا دالا ليس من تاريخ الفلسفة، وإنما من تاريخ العلوم: فلنأخذ، مثلا، كتاب المناظر لابن الهيثم، وهو عالم بصريات شهير جدا، ونأخذ كتاب تنقيح المناظر لكمال الدين الفارسي؛ وهذا شرح على الأول، ولكن قيمته من الناحية العلمية أكبر بكثير من المتن المشروح. وحتى هذا التمييز بين المتن والشرح قد ولى عهده، لأننا إذا عدنا إلى الوراء، نجد الكثير من النظار كانوا يبتكرون في الحواشي أمورا علمية وفلسفية نفيسة، ثم تجدهم يقولون هذه مجرد تحشية على ما قاله الشيوخ؛ وغالبا ما كانوا يفعلون ذلك من باب التواضع. أما ابن رشد في زمنه، والذي جاء بعده فقد كان يضاهي مكانة أرسطو. واختياره شرح كتب أرسطو كان اختيارا منهجيا ومفكرا فيه، لمواجهة الغموض الذي لفّ تاريخ الفلسفة في السياقات الإسلامية، والناتج في تقديره عن سوء الفهم لمقاصد أرسطو.
5- كيف تنظر للدرس الفلسفي في الجامعة المغربية من حيث الاهتمام والحيز الذي يعطى للفلسفة الإسلامية مقارنة بالفلسفة الغربية؟
- في الواقع، هذا مشكل حقيقي وتختلط فيه الدواعي التربوية بالدواعي الإيديولوجية، وربما بأمور أخرى لا ندري الآن ما هي. كثير من الناس لا يفهمون نعت ”الإسلامية“ متى توصف به الفلسفة؛ والكثير أيضا يخلطون خلطا غير مبرر ما بين شيئين مختلفين: الفكر الإسلامي من جهة والفلسفة الإسلامية من جهة ثانية. وفي هذا الباب، يمكن أن نتساءل: ما الإسلامي في الفلسفة؟ وهذا سؤال مهم، لأننا عندما نتحدث عن ابن رشد أو ابن باجة أو الفارابي أو ابن سينا فنحن نتحدث عن مجال فكري لم تعرفه البشرية من قبل أو بعد؛ فقد كان للسياقات الإسلامية خصوصية هنا، فلأول مرة في التاريخ -ولا يوجد هذا لا في التقليد المسيحي ولا في التقليد اليهودي- أن شخصا وسط مجتمع مسلم، يمكن أن يكون فيلسوفا من غير أن يكون خادما للعقيدة الإسلامية؛ أعني أنه يمكن للفيلسوف أن يكون فيلسوفا دون أن يكون لاهوتيا. وفي المقابل، في أوروبا المسيحية لا يمكن لك أن تدرس الفلسفة إلا خدمة للدين، وعندهم في هذا الباب قولة شهيرة، هي: الفلسفة خادمة اللاهوت، حيث اللاهوت أو الثيولوجيا أولا ثم الفلسفة ثانيا، هذا طبعا إن أردت أن تبقى مسيحيا مستقيما. هذا الأمر لم يعرفه الإسلام، بل استطاع هذا الأخير -وهذا يجب أن يدرس ويبرز- إيجاد حيز لفلاسفة تفلسفوا كل على طريقته الخاصة؛ دون أن يعتبروا أنفسهم فيما قدموه خداما للدين أو للعقيدة. بل أكثر من ذلك، فالفلاسفة في السياقات الإسلامية كانوا شديدي الحرص على تمييز أنفسهم عن علماء الكلام، الموكول إليهم حراسة العقيدة من تشويش المخالفين لها. ولا يبدو أن مدرسي الفلسفات الغربية في الجامعة المغربية يفهمون هذه الأمور؛ مما يسهم في استدامة سوء تفاهم غير مبرر.
6- لكن ابن رشد كتب فصل المقال لكسر الهوة بين الفلسفة والدين؟
- أكيد، ولكن فصل المقال له سببه الخاص؛ فهو هنا يشبه أن يكون فتوى مضادة. ولتوضيح هذا اسمح لي أن أقول إن الكثير من الناس يعتقدون أن تهافت التهافت هو رد ابن رشد الوحيد على تهافت الفلاسفة للغزالي. أقول بكل تواضع إن الرد الحقيقي لابن رشد كان أولا في كتابه فصل المقال، لأن هذا الأخير كان عبارة عن فتوى. إنها فتوى مضادة لتلك الفتوى الأخرى الموجودة في خاتمة تهافت الفلاسفة. فقد كان الغزالي متكلما طوال ردوده على ابن سينا في العشرين مسألة التي تحدث عنها في كتابه تهافت الفلاسفة، حتى جاء إلى الخاتمة فانقلب إلى فقيه يفتي بحكم الشرع في هؤلاء الذين ينكرون البعث الجسماني وعلم الله بالجزئيات ويقولون بقدم العالم. ولذلك أجابه ابن رشد باللغة نفسها من خلال فتوى أخرى، هذه المرة عن حكم الشرع في الإلهيات، أو الفلسفة الأولى. فقد فكك ابن رشد فتوى الغزالي بشكل ذكي جدا، بحيث أظهر أنه لا يمكن أن نكفر الفلاسفة في أمور ليس عليها إجماع؛ إذ إن المسائل مثل طبيعة البعث الجسماني أو العلم بالكليات والجزئيات هي مسائل نظرية وليست عملية، ولا يمكن أن ينعقد عليها إجماع؛ وبالتالي لا يمكن أن نكفر بخصوصها من قال قولا مختلفا؛ كل هذا، ولا مدخل إلى معرفة الله حق المعرفة من دون الإلهيات؛ لذلك أفتى ابن رشد بوجوبها شرعا؛ وكأني به يلمح إلى أن الغزالي في التهافت إنما أراد أن يحرم الناس من معرفة الله المعرفة الحقة.
7- لكن كيف نجمع بين ما قلته عن أن الفلسفة في السياق الإسلامي استطاعت أن تجد لها مسارا مستقلا، وبين ما يشاع عن الصراع بين الفلاسفة والفقهاء في السياق الإسلامي؛ وربما هو الصراع الذي مازلنا نسمعه كل مرة بين شعبتي الفلسفة والدراسات الإسلامية في الجامعات؟
- لا علاقة نهائيا للنقاش الإيديولوجي الذي ساد في السبعينيات بردود ابن رشد على الغزالي في ما مضى. النقاش السائد حاليا بدأه فرح أنطون ومحمد عبده في بداية ما يسمى عصر النهضة، وكلاهما كان ضحية أطروحة إرنست رينان أن الإسلام لا يمكن أن يكون متصالحا مع الفلسفة. والحال أن ابن رشد يحل هذه المسألة ببساطة شديدة جدا باعتباره أن الشريعة والحكمة لا يتقابلان؛ بل الشريعة مدخل للفلسفة، وهذا أمر يصعب أن يفهمه من لم ينشأ في بيئة إسلامية. وإذا أردنا أن نيسر فهم فكرته هذه يمكن أن نقول باختصار إن الشريعة هي التعليم العام، والفلسفة هي التعليم الخاص أو المتخصص. كل أبناء البيئة الإسلامية يتلقون تعليما دينيا ابتداء، ثم يتخصصون بعد ذلك في الفلسفة أو في الموسيقى أو في الهندسة أو غيرها. ولذلك يقول ابن رشد: إن الفلاسفة لا يمكن إلا أن يعظموا الشريعة؛ لأن الشريعة بالنسبة إليهم هي القانون الذي يضبط التدبير أو المدينة، وبدونها لا يمكن أن تقوم مدينة ولا فلسفة. وهذا يعني أن وجود الفلسفة نفسه يكون مهددا عند غياب الشريعة. والشريعة عند ابن رشد هي القانون والضامن لوجود الفلسفة ووجود الصنائع، وهي المدخل الضروري، وبعدها تأتي الفلسفة. هذا هو التمييز الذي يقيمه ابن رشد بين التعليم العام والتعليم الخاص. وما أسهم في غموض العلاقة بين الشريعة والفلسفة، هو الإشكال الموجود في الفكر اللاتيني، حيث التقابل الموجود بين العقل والإيمان. والحال أن الأمر لا يتعلق بتقابل ولا بأفضلية عند ابن رشد، وإنما هذا مدخل إلى ذاك.
8- هذا ربما واضح عند ابن رشد لكنه ليس واضحا عند من يروج لفكرة أن الثقافة العربية والإسلامية اضطهدت الفلسفة والفلاسفة وهي المسؤولة عن خمودها منذ ذلك الحين. هل هذا الصراع حقيقي أم متوهم؟
- هو صراع، العناصر المتوهَّمة فيه أكثر من غيرها. وإنما أقول متوهم، لأننا لا نلمس عناصر الصراع حقيقة. فابن رشد، على سبيل المثال، عاش في كنف الدولة الموحدية وفي بدايتها كان مناصرا لها، ودافع عن دعوة ابن تومرت؛ أي أنه كان مثقفا عضويا —إن جاز التعبير—للدولة الموحدية، ثم انقلب من بعد على ابن تومرت وانتقده، وانتقد المتكلمين الاشعرية الذين كانوا مهيمنين في زمنه، وانتقد الفقهاء نقدا شديدا. ولكن عندما انتقد السلطان حصلت المحنة. وإذن فعناصر الصراع لا توجد ما بين الفلسفة والشريعة أو بين الفلاسفة والفقهاء، بل بالأحرى بين الفلسفة والتسلط.
9- يعني أن القلق الذي كان تجاه الفلسفة كان سياسيا؟
بالضبط، كان توجسا سياسيا بالأساس، ووظفت فيه الأطراف الأخرى كلها. والفلسفة تصبح مزعجة للدين عندما تصبح مزعجة للسلطة، لأنه آنذاك يظهر لهؤلاء الفقهاء، أو يوحى إليهم بذلك، أن الفلسفة مزعجة ومارقة. ولكن نستطيع القول بأنهم لم يكونوا يعبرون عن مواقفهم الشخصية بقدر ما كانوا يعبرون عن مواقف السلطة السياسة السائدة. فالانزعاج كان أساسه سياسيا؛ ولكننا، مع ذلك، لا نختزله في الممارسة السياسة، وإنما كان يحركه التنافس على مواقع القوة ومراكز القرار داخل المجتمع أيضا. وهكذا، فعندما يتولى علمٌ ما منصب القاضي في مدينة كبيرة لا شك في أن يثير حفيظة فقهاء يرون في أنفسهم الأهلية، ومن ثم، الأحقية بذلك المنصب، فيطعنون في علمه؛ وعندما يكتب فيلسوف كتابا رفيعا كبداية المجتهد ونهاية المجتهد، لا شك أنه سيثير غيرة من يعتبر أن ابن رشد لا يمكن إلا أن يكون قد سرق ذلك الكتاب. وفي هذا السياق أنا لا أعثر في تاريخ الفلسفة في السياقات الإسلامية على ما يفيد أن ثمة فيلسوفا قتله فقهاء! ولا أجد محاكمة دينية لفيلسوف. وعندما تحصل مضايقات أو محنة، فالأمر في الأصل سياسي تغذيه عناصر المحاسدة والمنافسة. فالأمر في السياقات الإسلامية خلاف ما حصل في أوربا في حقب بعينها. أعطني نصا تاريخيا واحدا يظهر أن فيلسوفا ما حوكم دينيا، أو قتل أو سجن لموقفه من الدين أو من أمور دينية. خلافا لذلك، نجد أن السياقات الإسلامية عرفت من ينكرون النبوة إنكارا علنيا، وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي: أبو بكر الرازي نموذجا. كانت هناك ردود عليه ونقاشات وسجالات؛ وهو أمر عادي جدا، بل هو مطلوب. قد يكتب فيلسوف كتابا مثل مخاريق الأنبياء حيث يستهزئ بالأنبياء عموما، ويحصل أن يرد عليه المتكلمون والفلاسفة؛ لكن الرازي لم يقتل ولم تطلق زوجته بسبب أفكاره أو فلسفته، حسب اطلاعي على الأقل. وابن رشد نفسه كان قاضي الجماعة لسنوات عدة. أي أنه كان يفتي في شؤون المسلمين اليومية ويبت في النوازل تعرض لهم في عباداتهم ومعاملاتهم؛ وهذا معطى يغفله من يعتقد أن هناك صراعا أبديا بين الإيمان والعقل في السياقات الإسلامية. هذا الصراع بين العقل والإيمان عاشته أوروبا، حيث لا أتصور وجود فيلسوف يحتل منصب القاضي أو الإمام، من دون أن يكون لاهوتيا. ولا أدعي أنه لم يكن في السياق الإسلامي توتر وقلق في العلاقة بين الإيمان والعقل، ولكنه أمر طبيعي جدا، لأن هناك تنافسا وتدافعا فكريا؛ وهو أمر جيد، لأنه يعكس حيوية الجسم الفكري.
11-يبدو أن الكثير من الغبار يجب أن ينفض عن مسائل كثيرة بهذا الخصوص. هل لهذه الحاجة الماسة أطلقتم مجلة جديدة تعنى بالفلسفة والعلوم في السياق الإسلامي كما أسستم جمعية تعنى بالموضوع ذاته؟
- في الحقيقة، إن تأسيس مؤسسة البحث في الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، وإطلاق مجلة نحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد عددها الأول، فضلا عن موقع إلكتروني متجدد، لم يكن من أجل همّ قومي أو وطني مبالغ فيه؛ وإنما من أجل أمر من صميم العمل الأكاديمي الذي ننتمي إليه نحن المنخرطون في هذا العمل. دائما كنت أقول: أليس من العيب في بلد، مثل المغرب الذي عرف فلاسفة كبارا، أن لا تكون فيه مجلة متخصصة في هذا الباب؟ بلد عرف ابن باجة وابن رشد وابن ميمون…ولا توجد فيه مجلة فلسفية متخصصة. أكثر من ذلك، تتجول في عناوين المجلات في العالم العربي ولا تصادف عنوان مجلة متخصصة في تاريخ الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية. كانت قد تأسست واحدة في حلب في السبعينيات من القرن الماضي باسم مجلة تاريخ العلوم العربية، لكن سرعان ما انقرضت لتتخذ صيغة أخرى في باريس باسم Arabic Sciences and Philosophy. فكان لابد من إيجاد منبر يكتب فيه الدارسون الأكاديميون وفق شروط متعارف عليها دوليا. نعم ننشر بشتى اللغات، ولكننا نركز على النشر بالعربية. تأسيس المؤسسة والموقع والمجلة هو طموح منا إلى أن نقدم منتوجا جيدا في هذا الباب يوازي ما يكتب بالإنجليزية، من حيث الدقة والضبط والمقاربة والمنهجية والاطلاع على الأدبيات السابقة. ونبذل قصارى جهدنا مع الدارسين المنخرطين معنا حتى يستحق منشورنا اسم المجلة بمعناه الصناعي؛ خاصة وأن الكثير من الكتابات التي تنشر بالعربية في هذا المجال هي تماما خارج التاريخ. فقد تجد دراسة صادرة في 2010 عن ابن باجة مثلا، أحدث المراجع في لائحتها يعود إلى 1983. وهذا أمر غير مقبول البتة في الأوساط الأكاديمية. لذلك نخضع جميع المواد، سواء تلك التي ترد علينا أو تلك التي من تأليفنا، للتحكيم السري المزدوج قبل نشرها في الموقع الذي يعتبر مجلة إلكترونية تتوفر على ردمد مثله مثل بقية المجلات. وباختصار نحاول، في حدود قدراتنا، أن نؤسس تقليدا علميا يستفيد مما تحقق ونسعى إلى جعله منارة للأجيال القادمة من الباحثين الشباب؛ وهذا هو الرهان الحقيقي.
11- ربما هذا يعود إلى تخلف بنيات البحث الأكاديمي عندنا. أنت اشتغلت في بيئات مختلفة أجنبية. ما الذي حظي باهتمامك بهذا الخصوص وأنت تقارن؟
- لعل الأسلم أن لا تورط نفسك في القيام بأية مقارنة، لأنك قد تصاب بالإحباط وربما بالاكتئاب. لكن إذا اضطرنا للمقارنة، يجب أن نقول: إننا كلنا نعيش في 2021، حيث العالم كله يعرف ازدهارا كبيرا للمكتبات الرقمية؛ لكن ما حصة جامعاتنا من هذه المكتبات؟ هل توفر جامعتنا اليوم الأدوات الأساسية للبحث العلمي؟ في مجالنا البحثي مثلا، وهو الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، ما نحتاجه ليس الأنابيب والمحاليل، بل المصادر والأدبيات والوثائق ورقية كانت أو رقمية. فما حصة المكتبات المغربية الجامعية وغيرها من ذلك؟ يمكن الإشادة هنا بالعمل الهام لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، لأنها كانت سباقة إلى توفير الموارد الأساسية الورقية والإلكترونية للدارس المغربي وغير المغربي. ولكن في مؤسساتنا الجامعية الوضع مختلف تماما، فهي لا تتوفر على ما يكفي من المصادر الإلكترونية والورقية لينجز طالب الدكتوراه بحثه، دون أن يكون بحثه متقادمًا بل خارج التاريخ. وعندما أتحدث عن المصادر الإلكترونية، فإني لا أتحدث عن المواقع الإلكترونية، حيث تحصل قرصنة الكتب والمقالات، وإنما عن خزانات رقمية، يحصل الاشتراك فيها أحيانا بالمجان، من أجل توفير الموارد الأساسية لإنجاز بحوث محترمة.
12- هذا عدا مسألة اللغة التي تحولت إلى أداة مهمة للبحث الحديث؟
نعم، وهذا في حد ذاته عائق كبير. لا أنكر أن هناك دراسات هامة بالفرنسية والإسبانية والألمانية؛ لكن إذا أردت أن تصنع لاسمك مكانا في عالم البحث اليوم، فأنت مضطر إلى أن تكتب بالإنجليزية. ولا يعني هذا أن نجعل من هذه اللغة سلطة للترهيب أو التهويل لا، الأمر ليس كذلك، بل هو ببساطة: أن الإنجليزية بالنسبة للدارسين في هذا المجال أصبحت أشبه باللغة المحايدة Lingua franca -رغم أنه ليس هناك لغة محايدة- التي يلجأ إليها من أجل التواصل بين الدراسين. والأمر في مجمله يسير، ويجري على هذا النحو: إذا كتبت مقالا بالإنجليزية ونشرته في مجلة أكاديمية، ذات فحص سري مزدوج، بعد أشهر ستتلقى تفاعلا أو نقدا، وهذا ما لا يحصل في العربية. حتى قنوات النشر بالعربية غيرها بالإنجليزية أو الفرنسية (أعني في فرنسا وليس في المغرب). إذا أردت أن تنشر بالفرنسية أو الإنجليزية تحتاج أن تمر عبر قنوات واضحة، وعبر مراحل من التقويم والتحكيم تخرج منها مستفيدا. وأما في العالم العربي، فما عاد أحد يهتم بقيمة ما ينشر. جرّب أن تكتب عملا، وأرسله إلى دار نشر: ستنشره بكل سهولة، خاصة إذا كنت ستؤدي ثمن الطبع. بينما لا أتصور دار نشر مثل Oxford University Press أو Cambridge University Press، وهما من أعرق دور النشر، ستقبل نشر عملك أو دراستك بسهولة، دون أن تتعلم أولا كيف تحرر بحوثك، وتتقن عملية الكتابة الأكاديمية، وتمر من القنوات التي يجب أن تمر بها. مثلا: تتقدم بمشروع كتاب عن ابن سينا إلى دار النشر؛ وبعد قبوله شكليا يعرض على محكمين ليقوموه ويقرروا هل تقبل دار النشر ذلك المشروع أم ترفضه؛ وصاحب المشروع مطالب بأن يجيب على ملاحظات المحكمين واحدا واحدا؛ وكل هذا على نحو سري. وبعد إتمام العمل وتسليمه لدار النشر حسب الاتفاق، تعرضه من جديد على محكمين أقران وسريين ليبتوا في قيمته قبل سحبه من المطبعة. ثم بعد صدور العمل، يتولاه الزملاء بالنقد والتفاعل. هذه صورة مختزلة عن مسار النشر في دور النشر المعروفة. أما في دور النشر العربية، فالتحكيم بالمعنى المذكور مفقود تماما ولا أبالغ… شيء اسمه لجنة قراءة عند دور النشر العربية أمر نادر جدا.
13- أين الخلل إذن؟
- المشكل يرجع إلى غياب سلطة علمية مرجعية حقيقية. طبعا، لا يتعلق الأمر بدعوة مني إلى التشريع لوجود شرطة علمية، تتسلط على رقاب الناس، وتتحكم في أفكارهم، وفي ما يجب أن ينشر وما لا يجب. الأمر غير ذلك، بل لا يعدو أن يكون أنني إذا أردت مثلا أن أكتب الآن في جنس أدبي ما؛ فيجب أن أستحضر من كتَبَ قبلي في هذا الجنس، وعندما أستحضره، فأنا أستحضره بوصفه سلطة علمية متخصصة في المجال؛ وإن كان من الأحياء فلا بد أنه سيطلع على ما أكتب، ويفترض أن يتفاعل معه من أجل المزيد من التراكم. هذا ما عليّ أن آخذه بعين الاعتبار عندما أقرر أن أنشر في مجال ما، وهذا ما أعنيه بالسلطة العلمية؛ وهو أمر غائب عندنا. خذ أي مجال من المجالات المعرفية التي يحصل الاشتغال عليها أكاديميا عندنا، وانظر ماذا يكتب وينشر فيها: عندما يعمد أحدهم مثلا إلى الكتابة عن السوسيولوجيا الأنغلوساكسونية، ولا يستعمل مرجعا واحدا بالإنجليزية، فممن يسخر؟ سينشر هذا الكتاب في العالم العربي، ويسمى صاحبه متخصصا، وقد يسمى عالم اجتماع، لكن هل سيستقبل يوما في جامعة أنغلوساكسونية ليلقي عرضا في الموضوع؟ هذا أمر غير وارد على الإطلاق، لأن الأمور عندهم لا تسير بهذه الطريقة. أقول إذن لا توجد لدينا سلطة علمية تراقب سوق النشر العلمي، لأن جامعاتنا ضعيفة. وعندما نتحدث عن الجامعات الأمريكية أو الأوروبية، فليس غريبا أن تكون أقوى دور النشر هي دور النشر الجامعية، دار كمبردج للنشر تابعة لجامعة كمبردج، ودار أكسفورد للنشر تابعة لجامعة أكسفورد، ودار شيكاگو للنشر تابعة لجامعة شيكاگو؛ وهذه مؤسسات عريقة وضخمة ولديها تقاليد راسخة في البحث والنشر العلمين. واضح أنه عندما تصبح للجامعة الكلمة الأولى، فإن أمورا كثيرة سوف تتغير، أما عندما تصبح للفوضى الكلمة الأولى فها نحن نرى نتائج ذلك. يمكنك أن تعد من الغد عملا في أي تخصص تشاء، ويُنشر لك، وقد تستدعى إلى قناة لتتحدث عن عملك، مع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية.
14- الآن الكل يتحدث عن هذه المعضلات وأضف إليها الآن ظاهرة السرقات العلمية التي تنخر الكثير من البحوث. في نظرك ما هي نقطة البداية؟
- كنت أتمنى أن لا يُطرح هذا السؤال المحرج حقيقة. ما هي الفلسفة بدون النقد؟ لماذا يغيب النقد عن كتاباتنا الفلسفية؟ يغيب عنها النقد بشتى المعاني. يمكن أن تذهب إلى المكتبة، وتجد للكتاب الواحد أكثر من طبعة، وتتفحص هل هناك مقالات نقدية كتبت عنه فلا تجد واحدة؛ ترى ما الداعي إلى كتابة طبعة ثانية؟ وهل تتجاوز الطبعة الأولى؟ لنتحدث الآن عن الأمر العادي، والذي يجب أن يحصل دون أن يعتبر معجزة. دور النشر المحترمة عندما تصدر كتابا ترسل نسخا منه إلى مجلات متخصصة في القراءات النقدية، فتتولى المجلة المتخصصة الاتصال بمن هو مؤهل لمراجعة الكتاب مراجعة نقدية. ثقافة المراجعات والقراءات النقدية غائبة تماما عن ساحتنا، وبالتالي يمكن أن تنشر مقالة بحثية أو كتابا، ولا تجد حتى من يشتمك أو يسبّك بخصوص ما نشرت. وغياب هذه الثقافة جعل الكثيرين يستسهلون أمر السرقات العلمية. لكن، يجب أن أقول إن السرقات حقيقةً مسؤولية مشتركة بين السراق والمؤسسات العلمية التي ينتمون إليها. أنا كمؤسسة، لا يشرفني أن ينتمي لص إلي، ولا يشرف تاريخي. ولا أتصور أن جامعة تحترم تاريخها-إن كان لديها تاريخ طبعا- سوف تترك لصا يمرغ سمعتها في الوحل. ولكن، هذه المؤسسات نفسها، هل تمتلك ما يكفي من الترسانة القانونية، والأعراف والتقاليد العلمية التي تنظم الناس وترشدهم إلى مطبات السرقات العلمية؟ مثلا: هل توفر جامعاتنا تكوينات لطلبتها منذ البداية بخصوص السرقة العلمية وأنواعها وعواقبها؟ إذا زرت مواقع جميع الجامعات الأمريكية أو الأوربية تجد في التقديم بخصوص الأخلاقيات تنبيهات مهمة، منها القول: إن الكثير من الطلبة يرتكبون سرقات علمية جهلا؛ لذلك دورنا هنا في هذا التقديم أن نحسسهم بخطورة هذ الأمر. هذا فضلا عن وجود تقنيات حديثة الآن يصعب تطبيقها في العربية لكشف السرقات. بينما يصعب في الإنجليزية مثلا أو الفرنسية أن ترتكب سرقة علمية ولا ينفضح أمرك ولا تعاقب؛ وقد يصل الأمر إلى الطرد. أما في العربية، فيمكنك أن تقول ما شئت ولا أحد سيكترث؛ وفي الغالب، يتم تخريج الأمر وكأنه خلاف شخصي، لا يستحق أن يحفل به؛ أو يمكن تسويته بطريقة ما. تسألني ما الحل؟ لا أقدم نفسي بوصفي مالكا للوصفة السحرية التي ستحل هذه المعضلة، لكن الاهتمام والمزيد من الاهتمام باللغات غير العربية، أي بلغات البحث العلمي الحية، سيطور بلا شك ملكاتنا وأخلاقنا البحثية. عندما تريد أن تكتب وتنشر، فيجب أن تتمرس على قراءة المقالات الجيدة لكي تتعلم كيفية كتابة مقالة جيدة؛ والمقالات الجيدة اليوم منشورة في لغات غير العربية. بكل موضوعية إذا قارنت مثلا مجلات أجنبية كتلك التي تصدر عن Brill، (وأعني تلك التي ليست ممولة من جهات خليجية) تجد مقالات مصنفة عالميا، تتعلم منها، لا فقط كيف تقرأ، وإنما أيضا كيف تكتب. وبذلك تندمج شيئا فشيئا في الدوائر البحثية الدولية، حيث تتشبع بقيم الأمانة والنقد العلميين. هذا من بين المداخل المتاحة لإحداث بعض التحول والمواكبة لما يجري من حولنا. عندما أتحرك بهذه الطريقة المحترفة لا شك سوف تنتهي السرقات، أو تقل حدتها على الأقل.
15- لنختم بهذا السؤال بما أنك أستاذ للفلسفة في مؤسسة للدراسات الإسلامية العليا. بين الحين والآخر يثار السجال بشأن أن الدراسات الإسلامية بصيغتها الحالية أنشئت بهدف مواجهة الدرس الفلسفي بالمغرب؟
- كثير من الناس يقولون هذا بكثير من الاختزال. السؤال الذي يجب أن يأتي وقت لنطرحه ليس هذا، بل هو: هل كان هناك أصلا درس جامعي فلسفي حقيقي في المغرب، خاصة في صيغته المعربة؟ هل درسنا الفلسفي كانت تعطى فيه القيمة للفلسفة، وليس لأشياء أخرى، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها إيديولوجيات؟ هل كانت تولى الأهمية للتقاليد الفلسفية الحقيقية …ولأفلاطون وأرسطو واسبينوزا وكانت وهيغل … أم لماركس ولينين وألتوسير وروزا لكسمبورغ وجورج بوليتزر؟ لماذا نقول هذا، لأن أغلب الكتابات التي كتبها المشتغلون بالفلسفة في ذلك الزمن -إلا قلة قليلة- انشغلوا فيها بالإيديولوجيات أكثر من انخراطهم في تأسيس درس فلسفي حقيقي. هل يجب أن أذكر بأن الكثيرين من الطلبة بل والأساتذة كانوا يعتبرون درس اسبينوزا درسا رجعيا، كما أن درس المنطق الحديث كان درسا مثاليا؟ وأنه من الأولى في نظرهم تدريس المنطق الجدلي الماركسي وتدريس موقف لينين من الفلسفة ومن المنطق. ويحصل ضغط كبير في هذا الشأن. ماذا يساوي لينين في تاريخ الفكر الفلسفي؟ لا أريد أن أصدر أحكاما، لكن فقط أريد أن أقلّب هذه الصفحة من جديد. هل فعلا كان لدينا درس فلسفي؟ أتصور أنه لو كان لدينا درس فلسفي لاستمر وتواصل وجود متخصصين لدينا في أفلاطون وفي أرسطو وابن سينا والفارابي وهيغل وديكارت وكانط وفلسفات أخرى، وهذا أمر لا نلمسه اليوم، أو لنقل لا يفي بالغرض التربوي، فضلا عن أن يفي بالغرض العلمي، وننافس فيه دوليا. وحتى إذا وجدت شخصا يكتب مثلا عن اسبينوزا، فهذا لأنه درس في فرنسا وليس في المغرب. هل الجامعة المغربية وشعبة الفلسفة كانت توفر في صيغتها المعربة تكوينا قويا في الفلسفة؟ ثم ما محل اللغات من تكوين طالب الفلسفة في المغرب اليوم؟ هل تدرّس لطلبة الفلسفة اللغات القديمة (اليونانية، اللاتينية) والحديثة (الألمانية، الفرنسية، الإنجليزية)، والتي يتوقف عليها الدرس الفلسفي والبحث في تاريخ الفلسفة؟ كيف يعقل أن تنجز بحثا للدكتوراه عن الفلسفة اليونانية وكاتبها لا يقرأ باليونانية؟ كيف يمكن أن تكتب عن ماكس ڤيبر وهيجل، وتكون عمدتك في قراءة نصوصهما هي ترجمات عربية رديئة أو فرنسية عن الألمانية؟ هذا الأسئلة يجب أن تطرح للبحث عن جواب لها. ويجب على من كان شاهدا على تلك الفترة أن يدلي بشهادته في الموضوع. نتحدث عن تدهور في الدرس الفلسفي المغربي. أكاد أقول: إن هذا الدرس لم يحصل فيه أي ازدهار أو تأسيس حقيقي حتى يحصل فيه تراجع ونكوص. لأنه عندما تكون الغلبة للجانب الإيديولوجي لابد أن يواجه بإيديولوجيا أخرى. خاصة في زمن السلطة كانت فيه طرف حاضر وبقوة. فقد كانت الدولة تعاين أن الكثير ممن يأتي إلى شعبة الفلسفة، يأتي ليدرس الماركسية وليغير النظام، وليس ليدرس الفلسفة. والحال أننا لا نذهب إلى الجامعة لنغير النظام، فلا وجود لجامعة في العالم تستقبل طلبة في فضاءاتها ليناضلوا من أجل تغيير نظام الحكم، بدل أن يدرسوا، ويحصلوا على ديبلومات دون أن يكونوا قد قاموا بشيء غير النضال وتعبئة الجماهير الطلابية. هنا لم يكن أمام الدولة سوى أن تتدخل. وأنا لا أدافع هنا عن نهج الدولة، فليتها في ذلك الزمن قامت فعلا بالتدخل المناسب، وفرضت نظام تعليم جامعي قائم على الإنتاج والمردودية، في أقسام الفلسفة وفي غيرها، بدل أن تسير في اتجاه اختلاق كيان أطلق عليه شعبة الدراسات الإسلامية لا يحمل -في الغالب الأعم- من الدراسات الإسلامية سوى الاسم. كيان كان همه الأساس هو الدعوة والتبشير بعقيدة بعينها. ولهذا أيضا، فإن شعب الدراسات الإسلامية، في المغرب بأسره، يجب أن تراجع نفسها، بل وتراجع مبرر وجودها ونظام اشتغالها وتقرر هل تقوم بالبحث العلمي أم تقوم بالتعبئة والدعوة إلى مذهب بعينه. وإذا كانت أقسام الدراسات الإسلامية في جامعات عالمية مصنفة أهدافها واضحة، فإن ما أعاينه، بكل ما في الحكم من نسبية، هو أن المتخرج اليوم (المجاز) من شعب الدراسات الإسلامية عندنا لا يتقن لا أصول الفقه ولا علم الكلام (والذي يُدَرس عندنا في جامعات مغربية محدودة تحت اسم ”العقيدة“ تفاديا للحرج الأيديولوجي الذي يثيره المصطلح الأصيل ”علم الكلام“ الذي كان يدرس في شعب الفلسفة)، بل ربما لم يدرسهما أصلا؛ خاصة بعد أن سقطت هذه الشعب أيضا ضحية توجهات مستوردة من الخليج؛ فتجد الطالب بدل أن يدرس علم الكلام يعبأ بعقيدة بعينها. وقد ظهر الآن للجميع أن التبعات كانت كارثية، ويصعب التخلص منها في المستقبل القريب. فالأمر، كما ترى، لم يكن يتعلق بمواجهة بين ملائكة وشياطين، وإنما بصراعات إيديولوجية، أحيانا تكون أمرا متحكما فيه وأحيانا لا.

مقالات ذات صلة
محمد بن عمر بن أبي محلي وامتحان الناس بسجلماسة: مراجعة لمقالة كايتلين ألسون حول آفاق جديدة في دراسة العقيدة الأشعرية في الغرب الإسلامي بعد السنوسي
Muḥammad b. ʿUmar Ibn Abī Maḥallī and the Persecution of People in Sijlmassah: A Review of Caitlyn Olson's Article on New Perspectives on the Study of the Ashʿari Creed in the Post-Sanussi Islamic West Muḥammad b. ʿUmar Ibn Abī Maḥallī wa-mtiḥān al-nās bi-Sijilmāssa:...
في الرّد على المقرئ أبي زيد الإدريسي
تاريخ الأفكار في السياقات الإسلامية بين إكراهات البحث ورهانات الدعوة في الرّد على المقرئ أبي زيد الإدريسي المقرئ أبو زيد الإدريسي سياسي وداعية مغربي معروف في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوماته وسجالاته مع من يختلف معهم ممن يتصور أنهم دعاة العلمانية والحداثة...
نقاش علمي حول تهافت الفلاسفة للغزالي: النص والسياق والأثر (الحلقة الأولى)
https://www.youtube.com/watch?v=gPdcapniS9M مقالات ذات صلة