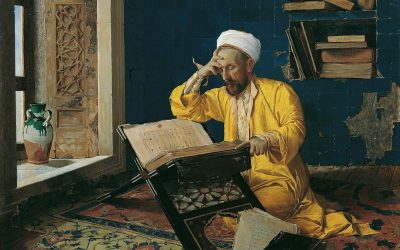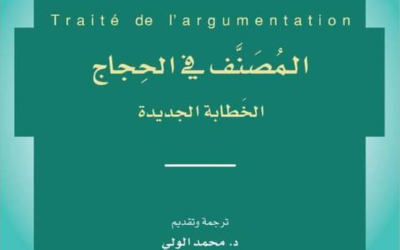![]()
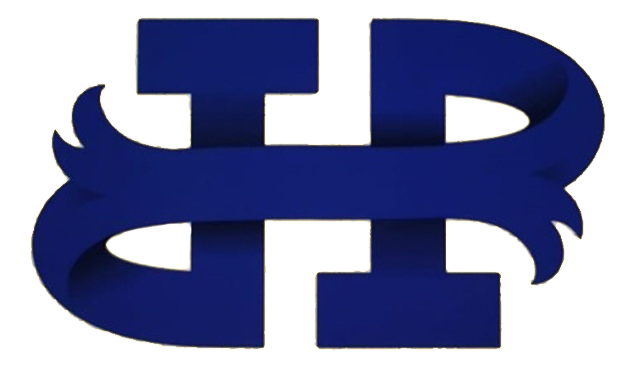
الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة: مراجعة نقدية للترجمة العربية

The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī
by Ayman Shehadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut: Mominoun Without Borders, 2020.
Al-Akhlāqiyāt al-ghāʾiyya ʿinda Fakhr al-Dīn al-Rāzī Li Ayman Shihadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut: Mominoun Without Borders, 2020.
Reviewed by Fouad Ben Ahmed
Al-Quarawiyine University
الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة. ترجمة ماجدولين النهيبي.
الرباط-بيروت: مؤمنون بلا حدود، 2020.
مراجعة نقدية للترجمة العربية
فؤاد بن أحمد
جامعة القرويين
ملخص: الغرض من هذه المقالة هو أن نقدم مراجعةً نقدية مفصلة للترجمة العربية للكتاب الهام الأخلاق الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة. ونحاول أن نظهر فساد هذه الترجمة عن طريق الوقوف على مختلف الأعطاب الشكلية والمنهجية والمضمونية التي جعلت من الترجمة عملا غير صالح للنشر والاستعمال من قبل الدارسين. فالمترجمة لم تكلف نفسها جهد العودة إلى الأصول العربية (والفارسية) للاقتباسات التي استعملها المؤلف في عمله؛ كما أفسدت ترجمة أهم العناصر في الكتاب، وهي أطروحته: فإذا كان المؤلف يدافع عن فكرة أن الرازي قد انفصل عن نظرية التقبيح والتحسين الشرعيين الأشعرية، فإن المترجمة تنقل ما يفيد أنه يلتقي بهذه النظرية بالذات، فضلا عن خلطها بين هذه النظرية ونظرية الكسب المعروفة. وإلى جانب ذلك، فقد وقفت الورقة على العديد من المواضع حيث حرفت المترجمة أقوال المؤلف وأساءت فهمها، فأفسدت معانيها في العربية؛ الأمر الذي يجعل الاستفادة منها ومناقشتها أمرين غير ممكنين.
الكلمات المفاتيح: الأخلاق الغائية عند فخر الدين الرازي، التحسين والتقبيح الشرعيان، الكسب الأشعري، أيمن شحادة، ماجدولين النهيبي.
Abstract: The purpose of this article is to provide a careful critical review of the Arabic translation of The Teleological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi by Ayman Shehadeh (Leiden-Boston: Brill, 2006). The article attempts to show the complete corruption of this translation made by Majdūlīn al-Nuhaybī (Rabat-Beirut: Mominoun Without Borders, 2020) by pointing out the various methodological and substantive flaws that render the Arabic translation unsuitable for publication and use by Arabic-speaking scholars. The translator did not care to trace the Arabic (and Persian) origins of the quotations used by the author in his work; this also spoiled the translation of the most important elements of the book, which is its main claim: while the author defends the idea that al-Rāzī departed from Ashʿari’s theory of voluntarism (“the doctrine that value terms could be defined only in terms of divine command”), the translator says that al-Rāzī joined this specific theory, as well as confusing this theory with the well-known theory of acquisition (kasb). Moreover, the article exposes many places where the translator has distorted and misunderstood the author’s statements, thus corrupting their meaning in Arabic. This makes it impossible to use and discuss this interesting work in its Arabic version.
Keywords : the Arabic translation of The Teleological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi voluntarism, acquisition, Ayman Shihadeh, Majdūlīn al-Nuhaybī
مقدمة
نشر أيمن محمود شحادة، من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن، وحاليا من جامعة نيويوك-أبو ظبي، عملا هاما عن الأخلاق الغائية عند فخر الدين الرازي. وقد صدر عن دار النشر بريل بليدن المحروسة العام 2006.[1] وهذا العمل، في الأصل، عبارة عن رسالته للدكتوراه التي ناقشها عام 2002 بكلية الدراسات الشرقية بجامعة أكسفورد، تحت إشراف كل من يحيى ميشو (Yahya Michot) وفريتز زمرمان (Fritz Zimmermann). ومن أهم ما جاء به شحادة في هذا العمل نشرتُه النقدية لمؤلَّف لم ينشر من قبل، ولعله آخر ما كتب الرازي، وهو رسالة ذم لذات الدنيا، التي يكشف فيها صاحبها عن نزعة شكية واضحة؛ فضلا عن وقوفه على نظرية الرازي الأخلاقية التي انفصل فيها عن مذهب أصحابه الأشعرية في القول بنظرية التحسين والتقبيح الشرعيين voluntarism (والتي بحسبها لا تُعلم قيمة الفعل إلا بأمر أو نهي إلهيين)، مقتربا بذلك من مذهب المعتزلة.
وفي عام 2020، عمدت مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث إلى نشر الترجمة العربية لهذا العمل بعنوان: الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي؛ والظاهر أنها ترجمةٌ تحت الطلب، أعني أن مؤمنون بلا حدود هي من بحث عن مترجمٍ لهذا الكتاب ومُراجعٍ له. وقد تولت عملية الترجمة الدكتورة ماجدولين النهيبي، وهي أستاذة خبيرة في التربية (والتنمية الذاتية) وديداكتيك اللغة العربية، من كلية علوم التربية-جامعة محمد الخامس؛ وتولى مراجعة العمل الدكتور بدر الدين مصطفى أحمد، وهو أستاذ فلسفة الجمال والفلسفة المعاصرة، من كلية الآداب-جامعة القاهرة. وكما هو واضح من السيرتين العلميتين للمترجمة وللمراجع، فإنهما، معًا، أبعد ما يكون عن المجال الذي ينتمي إليه الكتاب المترجم.
فما هي حصيلة هذا العمل؟
النتيجةُ عملٌ فاسدٌ تمامًا ولا يستحق أن ينشر؛ أما وأنه قد نُشر، فقد يجب سحبه من المكتبات. وذلك للدواعي الآتية:
- أولا: ترجمة النصوص من الإنجليزية، بدل العودة إلى أصولها؛ فضلا عن فساد تلك الترجمة؛
- ثانيا: التجاهل شبه الكامل للنص العربي لرسالة ذم لذات الدنيا في الفصل الخاص بتحليلها؛
- ثالثا: الأخطاء في الترجمة وإفساد الدعوى المركزية لشحادة؛
- رابعا: تشويه أسماء الأعلام والأماكن والكتب والمصطلحات الصناعية…
وهذه الدواعي الأربعة هي ما سنعرض له بشيء من التفصيل في الفقرات الآتية.
أولا: فساد ترجمة النصوص المترجمة
كل الاقتباسات التي استعملها أيمن شحادة في عمله، والتي أخذها من نصوص منشورة ومتوفرة، سواء كانت للرازي أو لغيره من الفلاسفة والمتكلمين، قد ترجمها في عمله المذكور إلى الإنجليزية. وبدلا من أن تعود المترجمة إلى الأصول العربية (والفارسية) لتلك الاقتباسات، وهي موجودة سواء بالخزانات أو بالأنترنت، فقد عمدت إلى ترجمتها من الترجمة الإنجليزية. ولا نرى حاجة بنا إلى أن نقف عند كل أشكال الفساد الذي حصل لتلك الاقتباسات، خلال رحلة عودتها على يد المترجمة إلى العربية؛ لكن في المقابل يكفي أن نقف عند بعض الأمثلة مع تسجيل ملاحظاتنا الأولية في الهوامش.
| النص مترجما | النص العربي (للرازي أو لغيره) |
|
”القوة عرض، ولذلك فهي ليست متأخرة [في أكثر من لحظة واحدة] إذا كانت سابقة على الفعل، لن يكون ذلك ممكنا [بالنسبة للمنفذ] أن يكون قادرا على الفعل. حين تكون القدرة موجودة لن يكون الفعل موجودا، فالعدم الممتد لا يمكنه أن يكون موضوعا للقدرة (مقدور). إضافة إلى ذلك، في وقت حدوث الفعل، لن تكون هناك قدرة.“ الأخلاقيات الغائية، 25.[2] |
”لنا أن القدرة عرض فلا تكون باقية، فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن يكون قادرا على الفعل لأن حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل، والعدم المستمر يستحيل أن يكون مقدورا وحال حصول لا قدرة.“ الرازي، المحصل، 253. |
| ”يقول أبو الحسن الأشعري: إن القدرة لا ترتبط بالمتناقضات. وفي نظري، إذا كانت القدرة تحيل على ميزان الأمزجة وسلامة الأعضاء، فإنها سترتبط بكلٍّ من الإنجاز وعدمه، وهذا معلوم مباشرة. لكن إذا دلّ ذلك على أنه، باستثناء قصد حاسم ومهيمن مع القدرة، لا ينتج الأثر، وأنّ الاتحاد لا يرتبط بما يعارضه، يكون ذلك، بالتالي، صحيحا فعلا.“ الأخلاقيات الغائية، 30.[3] | ”قال أبو الحسن الأشعري: القدرة لا تصلح للضدين، وقال المعتزلة إنها صالحة للضدين. وعندي: إن كان المراد من القدرة ذلك المزاج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل والترك، والعلم به ضروري. وإن كان المراد أن القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرجحة فإنها لا تصير مصدرا للأثر، وإن عند حصول المجموعِ لا تصلح للضدين فهذا حق.“ الرازي، معالم أصول الدين، 83–84. |
| ”في أيامنا، من بين أتباع ديانتنا، هذا الرأي متبنى من الأشعرية، وهو رأي ضد الطبيعة البشرية، بالنظر إلى كل من العقائد والأفعال.“ الأخلاق الغائية، 31، هـ2.[4] | ”وهذا القول ينتحله الآن الأشعريون من أهل ملتنا، وهو قول مخالف لطباع الإنسان في اعتقاداته وفي أعماله.“ ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ج. 2، 1126. |
| ”كلما تناقش الرازي وأتباعه مع المعتزلة في مسائل القدر يقولون إن أحد موضوعات قدرة الفاعل يكون غالبا بوجود غالب مهيمن فحسب، وكلما تناقشوا مع الفلاسفة في قضايا خلق العالم، وحول إثبات الاختيار الإلهي، ورفض علة ضرورية، وهو مفهومهم للوجود الإلهي، يتبعون طريق المعتزلة والجهمية في قولهم إن أحد موضوعات القدرة لدى الفاعل يمكنها أن تتغلب على الباقي دون وجود غالب مهيمن.“ الأخلاقيات الغائية، 53.[5] | ”[…] الرازي وأتباعه إذا ناظروا المعتزلة […] نصروا أن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بالمرجح التام. وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختار، وإبطال قولهم بالموجب بالذات، سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح.“ ابن تيمية، منهاج السنة، 1، 111. |
| ”يستلزم التقاء القدرة والدافعية حدوث الفعل، ولكن كلاّ من الملزوم واللازم يحدث بالقدرة الإلهية. كذلك على الرغم من أن المادة والحادث متلازمان، فإنهما يأتيان إلى الوجود بقدرة الله وحده.“ الأخلاقيات الغائية، 60.[6] | ”إنّ مجموع القدرة والداعي يستلزم حصول الفعل، إلا أنّ الملزوم واللازم إنما يحصلانِ بقدرة الله تعالى كما أنّ الجوهر والعرض متلازمان، ومع ذلك فإنهما لا يوجدان إلا بقدرة الله تعالى.“ الرازي، المطالب، ج. 9، 11–12. |
| ”الضرر هو الألم وما يؤدي إليه، كالغم وانعدام النفع، أو ما يقود إليه… النفع هو المتعة والفرح وما يقود إليهما، وما يسبقهما بوصفه شرطا. الذهب والفضة مثالان ’للمعِدّ‘[كذا]، والحياة مثال ’للمؤدي‘ [كذا].“الأخلاقيات الغائية، 68.[7] | ”فأما الضرر فقد قال: إنه الألم، أو ما يجري مجراه نحو الغم […]. والمنفعة قال: إنها اللذة أو السرور، أو ما يؤدي إليهما، أو يصححهما. والمؤدي مثل الذهب والفضة، والمصحح مثل الحياة.“ الرازي، نهاية العقول، 194ب–195أ [=نشرة دار الذخائر، 2015، ج. 3، 243.] |
| ”يؤكد الأشاعرة أن وصف الفعل في اللغة العامة (في إطلاق اللغة) فيه ’جور‘، فليس من المناسب وصف الخطإ بـ’القبيح‘؛ إذ المعنى المعجمي لـ’الجور‘ هو مغادرة المعيار العادي والمقياس المعياري (الزوال عن الرسم المسنون والحد المرسوم)، سواء كان المغادر مكلفا أو لا.“ الأخلاقيات الغائية، 70.[8] | ”واعلم أنه [الأشعري] كان يذهب إلى أن وصف الفعل بأنه جور أو ظلم ليس يجري مجرى وصفنا له بأنه قبيح على إطلاق اللغة، لأن معنى الجور في اللغة هو الزوال عن الرسم المسنون والحد المرسوم، سواء كان الزائل مكلَّفا أو غير مكلَّف.“ ابن فورك، المجرد، 96. |
| ”يدافع الأشعريّ عن أنّ ثمة معنى واحدا لـ’الحسن‘ و’القبيح‘ في عالم الشهود؛ لأن القبيح مجتنب للنقص والضرر الذي يحدث لفاعله […] ليست هناك خلفية لاقتراف الفعل أو عدم اقترافه في العالم المشهود، ما يوجد هو ذلك أو شبيهه.“ الأخلاقيات الغائية، 71.[9] | ”وكان يقول إن سبيل القبيح والحسن في الشاهد سبيل واحد في أنه إنما يجتنبُ القبيح لما فيه من النقص والضرر الراجع إلى فاعله […]. فلا وجه فيما يفعل له الفعل في الشاهد أو يترك إلا ذلك أو نحوه.“ ابن فورك، المجرد، 141–142. |
| ”يعني الحكيم العارف بواقع الأشياء، والشخص القادر على خلقها بشكل كامل بمشيئته.“ الأخلاقيات الغائية، 71، هـ2. | ”الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء والقادر على إحكام فعلها على وفق إرادته.“ الغزالي، الرسالة القدسية، 90. |
| ”حيثما حكم المخطئ على الخطأ بأنه حسن، سيكون غير قادر على اجتناب الخطأ الذي ارتكب ضده؛ إذ تكون حياته معرضة للخطر، وممتلكاته معرضة للنهب، وسيكون واجبا عليه، من ثمّ، بالنظر إلى مصالح نفسه وممتلكاته أن يعدّ الخطأ قبيحا، من أجل حفظ نفسه وملكيته من السلب والإبادة.“ الأخلاقيات الغائية، 105.[10] | ”لو حكم الظالم بحسن الظلم فحينئذ لا يمكنه دفع ذلك الظلم عن نفسه، وحينئذ تصير روحه عرضة للقتل، وماله عرضة للنهب فيجب عليه في رعاية مصالح نفسه وماله أن يحكم بقبح الظلم، حتى تبقى روحه وماله محفوظين عن الهلاك والتلف.“ الرازي، المطالب، ج. 3، 68. |
| ”أجمع المعتزلة والكرامية على إثباتِ العقلانية الأخلاقية (تحسين العقل وتقبيحه)، بينما الفلاسفة والجبرية مجمعون على إنكارها، وموقفنا هو أنها تنطبق على البشر، لكنها لا تنطبق على الله.“ الأخلاقيات الغائية، 127.[11] | ”أطبقت المعتزلة والكرامية على إثبات تحسين العقل وتقبيحه. وأطبقت الفلاسفة والجبرية على إنكاره، والمختار عندنا: أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى العباد معتبر، وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو باطل.“ الرازي، المطالب، ج. 3، 289. |
| ”’الحسن‘ و’القبح‘ […] يحددان أيضا صفات للـ’كمال‘ و’النقصان‘. ولذلك يقال إنّ ’المعرفة حسنة، والجهل قبيح‘، ونقصد بالكمال أنّ للشيء شيئا المفروض أن يكون فيه ’وجود شيء لشيء من شأنه أن يكون له‘ بالنظر إلى خصائصه، ونوعه، أو أصله.“ الأخلاقيات الغائية، 141.[12] | ”اعلم أن لفظ الحسن […] يطلق على صفة الكمال والنقصان، فيقال: العلم حسن، والجهل قبيح، ونعني بالكمال: وجود شيء لشيء من شأنه أن يكون له إما بجنسه أو بنوعه، أو بعينه.“ الرازي، الإشارة في علم الكلام، 32ب [=نشرة المكتبة الأزهرية للتراث، 2009، 226]. |
| ”يدل الاستقراء على أن الكمال محبوب لذاته. ولكن لا بدّ من القول إن كل ما هو أكثر كمالا سيستحق أكثر أن يكون محبوبا ’أولى بالمحبوبية‘. الأكثر كمالا هو الله تعالى، ولذلك هو الأكثر استحقاقا لأن يُحب. إن إدراك ما هو محبوب، أصل ما هو محبوب، يؤثر في المتعة. وبما أنّ إدراك الروح العاقل للحق تعالى أكثر كمالا من إدراك للقدرات الحسية لأهداف كمالها، وبما أنّ الحق تعالى هو أكثر الذوات كمالا فإنّ المتعة الناتجة عن إدراكه ستكون الأكثر كمالا مقارنة بكل المتع الأخرى.“ الأخلاقيات الغائية، 145. | ”الاستقراء دل على أن الكمال محبوب لذاته. وإذا كان كذلك لزم أن يقال: إن الشيء كما كان أشد كمالا كان أولى بالمحبوبية. وأكمل الأشياء الحق سبحانه فكان أولى بالمحبوبية. وإدراك المحبوب من حيث هو محبوب، يوجب اللذة. ولما كان إدراك النفس الناطقة للحق—سبحانه وتعالى —أكمل من إدراك القوى الجسمانية لمدركاتها، وكان الحق سبحانه أكمل الموجودات، وجب أن تكون اللذة الحاصلة من إدراكه أكمل من سائر اللذات.“ الرازي، شرح عيون الحكمة، ج. 3، 167–168. |
| ”لقد كتب كتابا شهيرا أسماه (الإلهيات) ملأه بضخامة هذيانه وتصوراته الجاهلة. من بينها فكرة اعتقد بها وهي أن الشر أكثر من الخير. لو أنك قارنت بين صلاح البشر ولذاته وامتداد راحته بالآلام، الآلام الثقيلة والأعطاب والمصائب المعيقة والبؤس والمآسي والكوارث التي تصيبه، سيكون وجود البشر عبارة عن عقاب وشر كبير يلحقه. وقد بدأ يدعم هذا الرأي بفحصه الاستقرائي لهذه المحن.“ الأخلاقيات الغائية، 201–202. [في الهامش: انظر أبا بكر الرازي، الرسائل، 179–80][13] | ”للرازي كتاب مشهور وسمه بالإلهيات ضمنه من هذياناته وجهالاته عظائم؛ ومن جملتها غرض ارتكبه وهو أن الشر في الوجود أكثر من الخير. وأنك إذا قايست بين راحة الإنسان ولذاته في مدة حياته مع ما يصيبه من الآلام والأوجاع الصعبة والعاهات، والزمانات، والأنكاد والأحزان، والنكبات، فتجد أن وجوده يعني الإنسان نقمة وشر عظيم طلب به. وأخذ أن يصحح هذا الرأي باستقراء هذه البلايا.“ ابن ميمون، دلالة الحائرين، 500. |
من خلال المقابلة بين الاقتباسات المترجمة إلى العربية عن الترجمة الإنجليزية وأصولها العربية يمكننا أن نستنتج أمرين اثنين على الأقل:
- الجهل المطبق بالمعجم الفلسفي والكلامي المستعمل من قبل الرازي ومن قبل النظار الذين استشهد بهم شحادة في عمله.
- هدر الجهد والزمان في ترجمة نصوص متوفرة بالعربية أصلا؛ والحال أن المترجمة لو رجعت إلى هذه، لتجنبت بذلك السقوط في تلك الطوام. وعلاوة على ذلك، فإن قراءة تلك النصوص الأصلية ستعينها، أيضا، في فهم تحليلات وتعليقات شحادة نفسه والمعاني العربية التي يحيل عليها في عمله الإنجليزي، وهو أمر هام كان من الممكن أن تسترشد به المترجمة في تجويد ترجمتها.
ويمكن أن نضيف هنا أنه من هذه الطوام الناتجة عن ترجمة الاقتباسات من الإنجليزية إلى العربية ما يلي: يَرد في الترجمة القول الآتي منسوبًا إلى شرح الإشارات للرازي، حيث ينتقد ابن سينا: ”إنه يقول في كتاب (البرهان للشفا[كذا]): إذا وجدت طالب المعرفة [في الهامش: ’بقراءة علمي، بدل عامي‘] يقول هذا رفيع وهذا دنيء اعلم أنه حائر [في الهامش: ’بقراءة يخلط بدل غلط‘]. إذا —ليت شعري—كيف يسمح لنفسه هنا أن يستعمل هذا المنطلق الخطابي في هذه المناقشة العلمية؟“[14]
لا تنقل المترجمة هذا الاقتباس للرازي من نص شرح الإشارات، وإنما تترجمه عن الإنجليزية بعد أن ترجمه المؤلف من العربية؛ ولكنها في الآن ذاته تنقل ملاحظتين لهذا الأخير على النشرة التي يستعملها [وهو ما وضعناه بين معقوفين في النص أعلاه]، تحملان اقتراحاته لقراءة موضعين من النص بطريقة مختلفة عما يوجد في النشرة التي يقتبس منها. أما وإننا أمام اقتباس منقول من الإنجليزية، فأين يمكن أن نجد فيه مفردة ”عامي“ حتى نقرأ بدلا منها ”علمي“؟ وأين يمكن نجد ”غلط حتى نقرأ بدلها ”يخلط“؟ إن الملاحظتين تصبحان ضربا من الحشو الذي لا معنى له، ما دمنا أمام اقتباس مترجم من الإنجليزية، لا وجود فيه لأي من المفردتين الخاطئتين ولا الصائبتين.
إن ملاحظتي المؤلف لا تستعيدان معنييهما إلا عندما نعود إلى الأصل العربي لشرح الإشارات للرازي، الذي اقتبس منه المؤلف في عمله ولاحظ عليه في موضعين؛ ويَرِد كما يلي: ”قال [ابن سينا] في كتاب البرهان من الشفاء: إذا رأيت الرجل العامي: يقول: هذا شريف وهذا خسيس، فاعلم أنه قد غلط. فليت شعري كيف استجاز استعمال هذه المقدمة الخطابية في هذه المباحث العلمية؟“[15] وعليه فالمقصود بملاحظتي المؤلف هو: ”العامي“ و”غلط“ الواردتين في النص العربي، وهما ما يقترح علينا المؤلف أن نقرأه، على التوالي، كما يلي: ”العلمي“ و”يخلط“.[16]
ثانيا: ذم لذّات الدنيا بين الفيزيائين والأطباء!
لعل أغرب ما يمكن أن يحصل في ترجمةٍ هو أن يكون النص العربي جزءًا من العمل المترجَم، وبدل اعتماده تحصل ترجمة الاقتباسات من الإنجليزية إلى العربية. وبعبارة أوضح، إن إخراج نشرة نقدية لرسالة ذم لذات الدنيا للرازي هي جزء من عمل شحادة، لذلك نشرها بالعربية ملحقًا به؛ وقد خصص الفصل الرابع من عمله، لشرح هذه الرسالة وبيان مضامينها. ولذلك تجده يقتبس من نشرته ويترجم إلى الإنجليزية. لكن المترجمة كان لها رأي آخر؛ إذ إنها تجاهلت، في أغلب أطراف الفصل الرابع، وجود النص العربي وراحت تترجم من الإنجليزية إلى العربية ما كان قد نقله شحادة من العربية إلى الإنجليزية. وهذه بعض الأمثلة التي تكشف غياب الجدية عن العمل:
| النص المترجم لذم لذات الدنيا | النص العربي لذم لذات الدنيا |
| ”ما يغلب على البشر في هذا العالم هو العذاب والبلاء والغم، بينما الخير واللذة نادران جدا.“ 199. | ”فثبت أن الغالب على أهل هذا العالم هو الغموم والهموم والأحزان. وأما اللذة والخير فقليلة جدا.“ 228. |
| ”هذه الحالات ليست لذات، أو إذا كانت لذات، فإنها بالغة التدني والسفالة.“ 198. | ”فثبت أن هذه الأحوال إما أن لا تكون لذات، أو إن كانت لذات، فهي في غاية الخساسة ونهاية القذارة.“ 223. |
| ”يرغب كل البشر في الرئاسة على الآخرين، وأن يكون الجميع تحت سيطرتهم وتحكمهم وسلطتهم؛ لأن سيطرة الشخص على الآخرين وتحكمه فيهم هو صفة للكمال، وصفات الكمال مرغوبة لذاتها. ولكن كون الشخص محكوما من شخص آخر، وواقعا تخت سيطرته هو صفة للنقص، وصفات النقص مكروهة لذاتها. ولذلك، إن طبع كل شخص يقوده إلى رئاسة الآخر والتحكم فيه، وعدم تمكينه من أن يترأس عليه ويتحكم فيه. ومن ثم إن طالب الرئاسة يطلبها لنفسه وحده، بينما كل الآخرين يريدون تقويض هذه الرئاسة وإزاحتها. ومن جهة أخرى، أولئك الذين يسعون إلى تحقيق هذا المبتغى لا يمكن أن يكونوا قليلي العدد، كما أن من يسعون إلى تقويض هذه الرئاسة وإزاحتها هم كثيرو العدد؛ لأن من البديهي أن كل شخص غير ذلك الذي يسعى إلى الرئاسة سيسعى إلى إزاحة هذه الرئاسة وضرب سيادة طالبها.“ 213–214. | ”أن كل أحد يحب أن يكون هو الرئيس للغير، وأن يكون كل ما سواه تحت قدرته وتحت تصرفه وحكمه. وذلك لأن كون الإنسان قادرا على الغير، نافذ التصرف فيه، صفة كمال؛ وصفة الكمال محبوبة لذاتها. وكونه مقدورا للغير ومحلا لتصرف الغير، صفة نقص؛ وصفة النقص مبغوضة لذاتها. فثبت أن طبع كل أحد يحمله على أن يكون هو الرئيس لغيره والمتصرف في غيره، وأن يمنع غيره من أن يكون رئيسا له وحاكما عليه. وإذا كان كذلك، فالساعي في تحصيل الرئاسة لذلك الإنسان المعين، ليس إلا ذلك الإنسان. وأما كل من سواه، فإنهم يسعون في أبطال تلك الرئاسة وإعدامها. وإذا كان كذلك، كان الساعي في تحصيل هذا المطلوب في غاية القلة، لأنه لا أقل من الواحد؛ والساعي في إبطاله ودفعه في غاية الكثرة، لأنه ثبت أن كل من سوى ذلك الواحد فهو يدفع عن تلك الرئاسة ويبطل ذلك التقدم.“ 229–230. |
| ”يقول الفيزيائيون [كذا] أيضا إنه متى صار عضو ما ضعيفا، فإن كل الأعضاء القوية سترسل كل رفضها إليه. وفي المجمل، سيطرة القوي على الضعيف من لوازم الوجود. ومن ثم، يصير من البديهي أن أوضاع البشر غالبا ما تقع تحت هذه الفئات الثلاث… لذلك، هذه الحياة الجسدية ليست أبدا منفصلة عن الأحزان والغم والحسرة.“ 216. | ”بل الأطباء قالوا: ’إنه متى صار عضو من الأعضاء ضعيفا، فإن الأعضاء القوية ترسل إليه جميع الفضلات.‘ وبالجملة فاستيلاء القوي على الضعيف أمر من لوازم الوجود. فثبت أن حال الإنسان لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة؛ […] فثبت أن هذه الحياة الجسمانية لا تنفك البتة عن الحزن والغم وألم القلب.“ 236–237. |
تكفي مقارنة أولية بين الاقتباسات المترجمة والأصل العربي ليظهر بالملموس أن المترجمة لم تكلف نفسها البحث عن الأصل العربي لاقتباسات المؤلف من ذم لذات الدنيا، الذي هو أصلا، وكما قلنا، أحد المرفقات بعمل شحادة الذي بين يديها. وأتصور أنه لو كانت ألقت نظرة على النص العربي، لكان من شأن ذلك أن يجنبها السقوط في أخطاء مؤسفة وفادحة، من قبيل ترجمة physicians بالفيزيائيين. والحال أن الفيزيائيين هي physicists بالنسبة لمن يعرف قليلا من الإنجليزية، كما أن physicians هي الأطباء، وهم من يتحدث عنهم الرازي.
ثالثا: الأخطاء في الترجمة وإفساد الدعوى المركزية
ارتكبت المترجمة أخطاء كثيرة جدًّا في الترجمة، بل أفسدت جزءا هاما من الأطروحة التي يدعيها شحادة لنفسه. ولن نورد هنا سوى قلة قليلة من أمثلة كثيرة جدا تصدم القارئ من أول قراءة.
المثال الأول:
وهذا المثال مثير للانتباه فعلا؛ وذلك أن شحادة يعبر عن شكره وامتنانه تجاه بعض المؤسسات والخزانات التي دعمت عمله، فيذكر من المؤسسات ”الصندوق الأكاديمي الإسلامي“ بكامبردج، وجامعة أكسفورد، كما يذكر المكتبات التي مكنته من نسخ مخطوطة للنص الذي وضع له نشرة نقدية (أو تحقيقا)؛ وهي الخزانة البريطانية وخزانتي ولاية برلين وجامعة برنستون، ومكتبة مرعشي نجفي. غير أن الترجمة العربية تفيدنا بما يلي: ”أعبر عن صادق امتناني للمؤسسات الآتية: الأمانة الأكاديمية الإسلامية، وكامبردج، لدعمهما السخي لي خلال دراستي الجامعية، وجامعة أكسفورد لدعمها لي خلال دراستي الدكتوراه، ولدولتي بريطانيا وألمانيا، ومرعشي نجفي، وكذا مكتبات جامعة برينتسن، لتيسير حصولي على مخطوطات من رسالة ذم لذات الدنيا، وتمكيني من إنجاز نسخة مراجعة منها.“[17] وللقارئ أن يتساءل بسذاجة: ما محل ألمانيا وبريطانيا هنا؟ هل فعلا شحادة يشكر الدولتين؟ وماذا تعني ”مكتبات برينستن“؟ وماذا تعني ”نسخة مراجعة“؟ ثم يقارن مع النص الإنجليزي الذي يقول:
“I am truly grateful to the following institutions: to the Muslim Academic Trust, Cambridge, for generously funding my graduate study; to Oxford University for funding provided during my doctoral study; to the British, Berlin State, Marʿashī-Najafī and Princeton University Libraries, for facilitating access to manuscripts of Risālat Dhamm ladhdhāt al-dunyā, allowing me to produce a critical edition thereof.”[18]
إن ترجمة ليس يقدر صاحبها أن يميز ما يريد أن يقوله صاحب النص الأصلي لا داعي لنشرها، على ما أرى. فالمترجمة هنا لم تستوعب دور علامات الترقيم في النص الإنجليزي، فأنتجت لنا كلاما لا معنى له. والحال أنه بوسعنا أن نترجم كلام المؤلف كما يلي: ”أود أن أعبر عن صادق الامتنان تجاه المؤسسات الآتية: الصندوق الأكاديمي الإسلامي في كامبردج الذي مول بسخاء دراستي الجامعية العليا؛ وجامعة أكسفورد التي وفرت لي موارد مالية خلال دراستي بمرحلة الدكتوراه؛ والخزانة البريطانية وخزانة ولاية برلين ومكتبة مرعشي نجفي ومكتبة جامعة برنستون، التي يسرت لي أمر الحصول على مخطوطات لرسالة ذم لذات الدنيا، وسمحت لي بإنجاز نشرة نقدية لها.“
المثال الثاني:
نقرأ في ترجمة مؤمنون بلا حدود ما يلي: ”تعد هذه الدراسة، إذا، تحليلا لفهم أهم أوجه فكر الرازي ونظريته الأخلاقية، وكشفا عن أهم التوجهات والمناقشات حول تراثه [كذا] الفكري الواسع في الوقت نفسه، كما يتبين من خلالها أن الرازي وضع أسس نظرية أخلاقية متطورة وأصيلة، راقية وبالغة التناسق أيضا. ويلتقي الرازي في نظريته أيضا مع الكسب الأشعري.“[19] أما النص الإنجليزي، فيقول:
“The present study is thus, at once, both a comprehensive analysis of one major facet of al-Rāzī’s thought, viz. his ethical theory, and an exploration of the main trends and debates in its wider intellectual background. It shows that he sets forth a sophisticated and original ethical theory, which is both eclectic and highly consistent internally. In this theory, he departs with classical Ashʿarī voluntarism.”[20]
بغض النظر عن اختلال ترجمة القسم الأول من هذه الفقرة،[21] فإن ما يهمنا أكثر هو القسم الثاني منها، والذي جعل الرازي يلتقي بالأشعرية في ما تدعيه المترجمة ”كسبا أشعريا“. فقد أقدمت المترجمة، بكل اطمئنان، على نقل المفهوم المركزي “voluntarism” بنظرية الكسب، وهو نقل فاسد يوجد في مجموع الكتاب،[22] ويظهر جهل المترجمة بمكونات المذهب الأشعري؛ فنظرية الكسب هي تدخل في باب القضاء والقدر، ولا علاقة لها بقيمة الأفعال؛ بينما “voluntarism” تتعلق بالمصدر الشرعي الذي منه نستمد معرفتنا بقيمة الأفعال. ثم إن شحادة في مجموع كتابه لم يربط هذا المفهوم، أعني “voluntarism” بنظرية الكسب، وإنما فسرها بوضوح بالنظرية التي بحسبها لا تُعرف قيمة الفعل إلا بأمر أو نهي إلهيين؛[23] وهو ما يمكن تقريبه، أيضا، بنظرية التحسين والتقبيح الشرعيين الأشعرية، في مقابل نظرية التحسين والتقبيح العقليين المعتزلية. ثم إن ”الكسب“، وهو مفهوم مركزي في النسق الكلامي الأشعري، يترجم في غالب الأحوال بالمفردة الإنجليزية “acquisition”، وقد استعمله شحادة في عمله بهذا المعنى.[24] وباختصار شديد، إن الترجمة العربية تتضمن تشويها لمفاهيم مركزية في النسق الأشعري، وفي عمل المؤلف، تماما كما تحمل تحريفا لما قدمه هذا الأخير بوصفه الجزء الأهم في ما أنجزته دراسته، وهو أن هذه الأخيرة قد أظهرت أن الرازي قد وضع، من جهة أولى، نظرية أخلاقية متطورة وأصيلة، انتقائية ومتسقة داخليا في آن معا؛ وأبرزت أنه، من جهة ثانية، قد انشق عن مذهب أصحابه، وهم الأشاعرة، بخصوص تعلق الذم والعقاب والمدح والثواب بأفعال المكلفين من جهة أمر الشارع ونهيه.
ولهذا، فإن ترجمة أولية يمكن أن تكون كما يلي: ”تجمع هذه الدراسة، إذن، بين كونها تحليلا شاملا لأحد أهم الجوانب في فكر الرازي، أعني نظريته الأخلاقية، وبين كونها استكشافا لأهم التيارات والنقاشات التي سادت خلفيتها الفكرية الأوسع؛ وتظهر أن الرازي قد وضع نظرية أخلاقية معقدة وأصيلة، وهي نظرية انتقائية وفي الآن نفسه شديدة الاتساق داخليا. وقد حاد الرازي في هذه النظرية عن خط النظرية الأشعرية الكلاسيكية في التحسين والتقبيح الشرعيين.“
وهكذا، فإن ما تقوله الترجمة العربية لمؤمنون بلا حدود هو عكس ما يقوله النص الإنجليزي. وفضلا عن فساد ترجمة “voluntarism” بنظرية الكسب، كما ذكرنا أعلاه، فأن تدعي المترجمة بأن الرازي يلتقي في نظريته الأخلاقية بنظرية الكسب [والصواب أن نقول نظرية التحسين والتقبيح الشرعيين] الأشعرية إنما هو نسف لكل البناء الذي حاول تشييده المؤلف في رسالته؛ وهو أن الرازي، في مرحلته الفكرية المتأخرة هذه حيث عرف نزعة شكية، قد خالف الأشعرية في نظرية التحسين والتقبيح الشرعيين.
المثال الثالث:
وقد جاء في سياق إظهار العوامل التي تقف وراء عمق النظرية الأخلاقية للرازي وتوافقه، في بعض أوجهها، مع مذهب المعتزلة. تقول الترجمة: ”وفي هذا الصدد، تعد موضوعاته الأخلاقية من بين أعمق الموضوعات في تاريخ الإسلام، وتلتقي بمناقشات المعتزلة في كثير من الأوجه. ويعود ذلك أساسا [كذا] إلى قربه وانخراطه في كتابات المعتزلة، ولا سيما منها مدرسة أبي الحسين البصري (ت. 436/1044)، وقد ورد إلى حد غير مسبوق ضمن انتقاداتهم المتقدمة.“[25]
هذه جملة موجودة في فقرة محورية في مقدمة الدراسة، وفهمها في صيغتها المترجمة هذه يحتاج إلى تمائم، وإلا فإن العودة إلى النص الإنجليزي تكشف أن الترجمة لا تميز بين النقاد “critics” والانتقادات “criticisms” ؛ فأدخلت القارئ، بسبب من ذلك وغيره، في دُوار لا قرار له.
طيب، ماذا يقول النص الإنجليزي؟
“In this respect, his discussions of certain ethical themes are among the most penetrating in Islamic history and will easily match corresponding discussions in any extant Muʿtazilī texts. This owes partly to his firsthand familiarity and engagement with the writings of the Muʿtazila, especially the school of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī (d.436/1044), to an extent unprecedented among their earlier critics.”[26]
والأقرب أن نترجم هذه العبارة بما يلي (ونُذَكر أن الأمر يتعلق بتفسير ذلك العمق الذي تتسم به مناقشة الرازي للموضوعات الأخلاقية وتوافقه فيها مع المعتزلة): ”وبهذا الصدد، فإن مناقشاته [الرازي] بعض الموضوعات الأخلاقية تعد من أعمق المناقشات في التاريخ الإسلامي، وسوف تتوافق بسهولة مع المناقشات المقابلة في أي من نصوص المعتزلة الموجودة. ويعود ذلك، في جزء منه، إلى معرفته [الرازي] المباشرة بكتابات المعتزلة، ولا سيما مدرسة أبي الحسين البصري (ت. 436هـ/1044م)، وتعاطيه معها إلى حد غير مسبوق عند منتقديهم [من الأشعرية] المتقدمين.“
المثال الرابع:
نقرأ في الترجمة العربية ما يلي: ”تستثمر هذه الدراسة أهم نخبة موثوقة لأعمال الرازي إلى اليوم، وبعضها يستثمر لأول مرة.“[27]
“The present study uses the most comprehensive selection of al-Razi’s works to date; several are used for the first time.”[28]
والصواب أن نترجم الجملة كما يلي: ”تستعمل هذه الدراسة أشمل مجموعةٍ إلى اليوم من أعمال الرازي، وبعضٌ من هذه الأعمال يُستعمل لأول مرة.“
المثال الخامس:
يرد في الترجمة ما يلي: ”ولذلك، نجد، مثلا، من (المباحث) إلى (شرح كليات القانون)، والعكس، تقودنا إلى الاعتقاد أنهما كتبا في الفترة نفسها، أو أن المراجع في أحدهما على الأقل قد تم إدراجها في مراجعة لاحقة.“[29]
شخصيا، لم أستطع تبين ماذا تريد المترجمة أن تقول، ومن ثم صار كلام المؤلف مستغلقا على الفهم تماما؛ وذلك بسبب البتر الذي طال بعض الكلمات، وسوء ترجمة البعض الآخر، فضلا عن فساد التركيب في الجملة بالعربية. والواقع أن النص الإنجليزي أيسر مأخذا بكثير، ويقول:
“Thus, e.g. we find references in the Mabāḥith to Sharḥ Kulliyyāt al-Qānūn and vice versa, which leads us to conclude either that both were written in the same period, or that references in at least one of them were inserted in a later revision.” [30]
والصواب ترجمته كما يلي: ”هكذا، فإننا، على سبيل المثال، نجد إحالات في المباحث على شرح كليات القانون والعكس صحيح؛ الأمر الذي يفضي بنا إلى استنتاج إما أنهما قد كتبا في الحقبة نفسها، أو أن الإحالات في أحدهما على الأقل قد أُدرجت في مراجعة متأخرة [لأحد الكتابين].“
المثال الخامس:
نقرأ في الترجمة ما يلي: ”في نهاية الإقدام [كذا]، وهو عمل متأخر، نجده [الرازي] يشتغل، إضافة إلى ذلك، بالمنطق الأرسطي وعلم الكلام، لكن مع إقراره، في الخط نفسه مع الأشعرية الكلاسيكية، أن الغرض من معرفته الغائية [كذا] هو الدفاع عن المذهب الأرثوذكسي.“[31]
“In the later Nihāyat al-ʿuqūl, he introduces Aristotelian logic into kalam, but still proclaims, in line with classical Ashʿarism, that the purpose of his theological enquiry is to defend the orthodox creed.”[32]
والظاهر أن الخطأين الصريحين في هذه الجملة قد جعلاها غير مفهومة بالمرة. فأولا، إن الأمر لا يتعلق بنهاية الإقدام وإنما بنهاية العقول، كما لا يتعلق بأي معرفة غائية وإنما بالبحوث الكلامية التي أجراها الرازي في هذا الكتاب الأخير؛ فالظاهر أن المترجمة قد أشكل عليها theological وteleological. وإلى ذلك، فإن أهم فكرة في النص لا تنقلها المترجمة، وهي أن الرازي في كتابه نهاية العقول قد أدخل المنطق إلى علم الكلام مع التمسك بالهدف الأساس من بحوثه الكلامية، وهو الدفاع عن عقيدة أهل السنة.
المثال السادس:
ونقرأ في الترجمة: ”ويمثل [نهاية العقول] مرحلة انتقالية حاسمة بين الفكر الأشعري التقليدي للرازي وبين فكره الفلسفي لاحقا.“[33] وهذه ترجمة للجملة الإنجليزية الآتية:
“It represents a crucial transitory stage between al-Rāzī’s earlier Ashʿarī thought and his later philosophical theology.”[34]
والصواب أن تقول: ”إن نهاية العقول يمثل مرحلة انتقالية حاسمة بين الفكر الأشعري المبكر للرازي وبين كلامه الفلسفي المتأخر.“
المثال السابع:
نقرأ في الترجمة العربية: ”محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: تجميع للنظريات في فلسفة الدين، وهو من أهم وأكثر أعماله تأثيرا ودراسة.“[35] وهذه الجملة ترجمة للأصل الإنجليزي الآتي:
“Muḥaṣṣal afkār al-mutaqaddimīn wa-l-mutaakhkhirīn…A compendium of philosophical theology, and one of al-Razī’s most influential and widely studied works.”[36]
والذي يمكن أن يفهمه القارئ بالعربية مما كتبته المترجمة هو أن محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي إنما هو تجميع للنظريات في فلسفة الدين. وهذا أمر غريب حقا، لأنها أقحمت فلسفة الدين في سياق غير سياقها؛ والحال أن المؤلف يتحدث عن الكلام الفلسفي، أي علم الكلام المخلوط بالفلسفة؛ وقد حصل هذا خاصة بعد ابن سينا وبتأثير منه؛ وهو أمر معلوم عند أهله. كما تظهر المترجمة غريبةً تماما عن المعجم المستعمل عند دارسي تاريخ الأفكار والنصوص في السياقات الإسلامية. فالمقصود بقول المؤلف إن محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين عبارة عن A compendium of philosophical theology هو أن الكتاب عبارة عن مختصر في الكلام الفلسفي.
المثال الثامن:
نقرأ عند المترجمة ما يلي: ”تشير الحجة الضمنية إلى أنه [الأربعين في أصول الدين] كُتب بعد المحصل.“[37] وتقدم هذه الجملة على أنها ترجمة للجملة الإنجليزية الآتية:“Internal evidence suggests that it [al-Arbaʿīn fī uṣūl al-dīn] was written after the Muḥaṣṣal”[38]
فماذا يمكن أن يفهم القارئ بالعربية من ”الحجة الضمنية“ الواردة في الجملة العربية؟ لا شيء. المقصود هو الشاهد الداخلي أو النصي. ومعناه أن في نص الأربعين في أصول الدين ما يفيد أنه قد كتب بعد كتاب المحصل.
المثال التاسع:
نقرأ في الترجمة ما يلي: ”لباب الإشارات: إحاطة محققة للإشارات والتنبيهات لابن سينا.“[39] ويقول النص الأصلي: “Lubāb al-Ishārāt. A critical abridgement of Ibn Sīnā’s al-Ishārāt”[40]. فما معنى أن يكون لباب الإشارات ”إحاطة محققة“ لكتاب ابن سينا المذكور؟ لا شيء. والحال أن المقصود، كما يفيد العنوان، أن لباب الإشارات عبارة عن مختصر نقدي لإشارات ابن سينا.
المثال العاشر:
تقول المترجمة: ”التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: بدأت كتابة هذا التفسير الضخم للقرآن نحو سنة (601-3/1205-7)؛ والأخبار أن الرازي لم يكمل هذا العمل، وأنه أكمل بعد ذلك من لدن أحد تلاميذه، ويبدو أنها مفقودة.“[41]
السؤال الذي من الطبيعي أن يطرحه الإنسان محاولا الفهم: ما الذي يبدو أنه ”مفقود“؟ على ماذا يعود هذا النعت ”مفقودة“ في الجملة؟ يستحيل العثور على جواب. والحال أن النص الإنجليزي يقول:
“Al-Tafsīr al-kabīr, or Mafatīḥ al-ghayb. This huge commentary on the Qurān was started around 595/1199. Chapters 17–30 were authored in 601–3/1205–7. Reports that al-Rāzī did not complete this work, and that it was completed later by one of his disciples, appear to be unfounded.”[42]
عند المقابلة بين الترجمة العربية والأصل الإنجليزي يظهر أنه بالإضافة إلى سقوط أجزاء من الأصل في الترجمة العربية، إذ إن الجزء “595/1199. Chapters 17–30 were authored in” غير موجود في الترجمة العربية، قد يستغرب المرء لفداحة الأخطاء التي تُظهر أن المترجمة لم تستوعب بنية الجملة الأخيرة، ولا بعض المفردات الإنجليزية: فإقحام واو العطف قبل ”يبدو أنها مفقودة“ جعلنا أمام جملتين، وليس جملة واحدة تتألف من مبتدأ وهو ”الأخبار التي تفيد أن الرازي لم يكمل العمل وأن واحدا من تلامذته هو من أكمله،“ ومن خبر وهو الجزء من الجملة “appear to be unfounded” الذي نقلته المترجمة بدون تردد بـ”ويبدو أنها مفقودة“؛ مما يعني أن المترجمة لا تميز في الإنجليزية بين النعتين “unfounded” و“unfound”؛ فكما هو معلوم إن “unfounded” تعني ”لا أساس له/ا من الصحة“ أو ”لا أساس له/ا“ فقط. وبعبارة المؤلف وترجمتنا: ”يبدو أن الأخبار التي تفيد أن الرازي لم يكمل هذا العمل، وأنه أُكمل لاحقا من قبل أحد تلامذته لا أساس لها من الصحة.“
المثال الحادي عشر:
نقرأ في الترجمة: ”(المطالب العالية من العلم الإلهي): أحد أطول أعمال الرازي في الفلسفة والإلهيات، ويعد من أهم كتبه من نواح متعددة، تمت كتابة الكتابين (1-2) في سنة (603/1207)، قريبا من إنهاء التفسير. وبعد أكثر من سنة، في (605/1208) تم إنهاء الكتابين (3-7)، في فترة امتدت إلى (5 أشهر). بينما بقي الكتاب (8)، على ما يبدو غير تام، وغير مؤرخ؛ غير أن التاريخ النهائي محير؛ لأن (ملذات الدنيا) (أسفله) مؤرخة قبل ذلك، لكنها تحيل إلى مناقشات في الكتاب (3و4) في المطالب.“[43] وهذه ترجمة للأصل الإنجليزي الآتي:
“Al-Maṭālib al-ʿāliya min al-ʿilm al-ilāhī. One of the lengthiest of al-Rāzī’s philosophical and theological works, and in many ways the most interesting. Books 1–2 were finished in 603/1207, soon after the completion of the Tafsīr. More than a year later, in 605/1208–9, books 3–7 were apparently finished over a period of 5 months, whereas book 8 seems to be unfinished and is undated. Yet the latter date is puzzling, since Dhamm ladhdhāt al-dunyā (below) is dated earlier, but refers to discussions in books 3 and 4 of the Maṭālib.”[44]
وكما قد يلاحظ القارئ عند المقابلة بين النصين العربي والإنجليزي، أنه لا وجود لأقواس في كلام المؤلف، فعناوين الكتب يكتبها بخط مائل، كما هو معروف في الكتابة بغير العربية. ولست أدري أي مذهب تتبنى المترجمة في الأقواس لتستعملها بشكل عشوائي كما في ترجمتها؛ هذا من الناحية الشكلية. أما من الناحية المضمونية، فلم تكن الترجمة دقيقة ولا أمينة في نقل مضامين الفقرة بالإنجليزية. ولنا على هذا أدلة كثيرة: فالخطأ الأول هو أن تقول المترجمة إن المطالب العالية من العلم الإلهي هو أحد أطول أعمال الرازي في الفلسفة والإلهيات. والمقصود في النص الأصلي أنه أحد أطول أعمال الرازي في الفلسفة وفي علم الكلام؛ وعلم الكلام غير الإلهيات. والخطأ الثاني هو أن قول المترجمة بأن هذا الكتاب يعد، من نواح عدة، من أهم كتب الرازي، إنما هو نقل غير أمين لكلام المؤلف الذي يفيد القطع بأن المطالب العالية من العلم الإلهي هو من نواح عدة أهم أعمال الرازي. والخطأ الثالث أن تتحدث المترجمة عن كتاب للرازي بعنوان ملذات الدنيا، والأدق، كما ورد عند المؤلف، أن تقول: ذم ملذات الدنيا. والخطأ الخامس أن تقول المترجمة إن ”([ذم] ملذات الدنيا) (أسفله) تحيل إلى مناقشات في الكتاب (3و4)“؛ والصواب أن تقول: ”([ذم] ملذات الدنيا) (أسفله) تحيل إلى مناقشات في الكتابين الثالث والرابع.“ والخطأ الخامس أن تقول: ”في (605/1208) تم إنهاء الكتابين (3-7)؛“ والصواب أن تقول: ”في سنة 605 /1208-1209، يبدو أنه قد انتُهيَ من الكتب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع؛“ وهو ما يعنيه المؤلف بوضع عارضة بين 3 و7. والخطأ السادس أن تترجم “the latter date” بـ”التاريخ النهائي“؛ والحال أن المقصود هو ”التاريخ الأخير،“ أي 605/1208-1209.
أما ترجمة أولية للنص أعلاه، فيمكن أن تكون كما يلي:
”المطالب العالية من العلم الإلهي: هو أحد أطول أعمال الرازي في الفلسفة وعلم الكلام، وهو، من نواح عدة، أكثرها أهمية. انتُهيَ من الكتابين الأول والثاني في عام 603هـ/1207م، مباشرة بعد الانتهاء من التفسير. وبعد أكثر من عام، في سنة 605هـ/ 1208-1209، يبدو أنه قد انتُهيَ، خلال خمسة أشهر، من الكتب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، في حين أن الكتاب الثامن يبدو أنه غير مكتمل وهو غير مؤرخ. ومع ذلك، فإن التاريخ الأخير محير، حيث أن ذم لذات الدنيا (انظر أدناه) يحمل تاريخا سابقًا، ولكنه يحيل على مناقشات في الكتابين الثالث والرابع من المطالب.“
المثال الثاني عشر:
نقرأ عند المترجمة ما يلي:
”بالنسبة إلى المتكلمين الكلاسيكيين، وفي علوم الدين الكلاسيكية عموما، المعرفة الدينية ضرورية…“[45] وهذه ترجمة محرفة تماما للنص الإنجليزي الآتي:
“In classical kalām and classical theology generally, theological knowledge is necessary…”[46]
فالأمر لا يتعلق بقول ننسبه إلى المتكلمين الكلاسيكين، وإنما بملاحظة عامة عن الكلام الكلاسيكي وباللاهوت عموما، وهو أن العلم بأمور العقيدة ضروري.
رابعا: الميمونيون وأشياء أخرى
قد يستغرب المرء وضعنا هذا العنوان لهذه الفقرة، لذلك ندعوه ليقرأها إلى الأخير ليقف على التشوهات التي طالت أسماء الأعلام والكتب والأماكن والمصطلحات الصناعية في الترجمة التي بأيدينا.
يمكن للمرء أن يصادف في الترجمة عناوين كتب غريبة، كالدار، والمجمع؛ والمقصود بهما على التوالي: الدرء، والمجموع، وكلاهما لابن تيمية؛ ولا شك أن المترجمة هنا لم تتمكن من قراءة الكتابة الرومانية لعنواني الكتابين بالعربية في الأصل الإنجليزي. كما يمكن أن يصادف الحقيقة النظامية،[47] والمقصود العقيدة النظامية للجويني؛ ويمكن أن يصادف دليل الحيران،[48] والمقصود دلالة الحائرين. وكل هذه الكتب متوفرة بالعربية، ومعروفة عند المهتمين بهذا المجال. كما أن المستشرق الألماني الشهير هانس ديبر صار هاني ديبر؛[49] وكوبرولو صارت كوبولو.[50]
ومن الأمور الباعثة على الضحك والأسى في الآن نفسه هو أن يصبح الفيلسوف والرِبِّي الأندلسى موسى ابن ميمون (ت. 601هـ/1204م) يحمل تارةً اسم ”الميموني“،[51] ويحمل تارة اسم ”الميمونيين“،[52] ويحمل، تارة ثالثةً، اسم ”موزيس ميمونيدس“.[53]
ففي الهامش الثالث من الصفحة 207، نقرأ ما يلي: ”انظر استشهاد الميمونيين، ص 160-161، أعلاه.“ ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذه العبارة القصيرة تحتوي على أخطاء كثيرة. الخطأ الأول الذي ارتكبته المترجمة هو حين نقلت الاسم Maimonides بالميمونيين. والظاهر أن الحرف s الذي في نهاية الاسم قد حمل المترجمة على الاعتقاد أن الأمر يتعلق بجمع، لذلك ترجمت الاسم بـ”الميمونيين“، وهو جمع ”الميموني“ الذي سبق أن ترجمت به الاسم الإنجليزي نفسه في صفحة سابقة؛ أما في لائحة البيبليوگرافيا فقد عربت الاسم الإنجليزي، وكتبت ”ميمونيدس، موزيس“؛[54] وكل هذا يدل على أن اسم موسى ابن ميمون لا يوجد في قاموس المترجمة ولا في ذاكرتها. وأما الخطأ الثاني، فيتعلق بالنقل الحرفي دون روية. وذلك أن إحالة المترجمة على الصفحتين 160–161 مضللة تماما؛ لأنه لا يوجد استشهاد للميمونيين في الصفحتين 160–161 من الكتاب؛ ومرد هذا التضليل هو أن العبارة نقل حرفي لكلام المؤلف الذي يحيل في كتابه على موضع سابق منه. ومن ثم، فإن الصفحتين 160–161 المقصودتين توجدان في النص الإنجليزي وليس العربي، وأن نص ابن ميمون يوجد بـالصفحتين 160–161 من النص الإنجليزي. والأحرى بالمترجمة أن تكتب الصفحة 202 من ترجمتها،[55] حيث يوجد نص ابن ميمون، وليس الميمونيين.
ويظهر أن المترجمة لا تميز بين الأفعال والأسماء في الإنجليزية، فنجدها تكتب في أحد الهوامش ما يلي: ”(ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 2، 1124–6)، تعاليق.“[56] والصواب هو أن ابن رشد يعلق أو يشرح؛ لأن النص الإنجليزي يقول ما يلي: “Ibn Rushd (Tafsīr mā Baʿd al-tabīʿa, 2, 1124–6) comments”[57].
ولا تتردد المترجمة في تعريب المفردة الإنجليزية “theologian” بمفردة ”الفقيه“،[58] وبـ”عالم دين“،[59] والحال أن المقصود هو ”المتكلم. وتترجم “theologians” أحيانا بـ”علماء“ و”علماء الدين“،[60] بل وبـ”علماء الإلهيات“[61] والصواب ترجمتها، كما قلنا، بـ”المتكلمين“. وتترجم “skepticism” بـ”تشكيك“،[62] والحال أن المقصود هو النزعة الشكية أو الريبية أو الشكانية؛ وهو أمر تعرفه المترجمة. وتترجم المصطلح المركزي “occasionlalism” بالمفردات الغريبة بـ”عرضانية“،[63] و”عرضية“،[64] و”ربط الإرادة البشرية بالإرادة الإلهية“،[65] والحال أن المفردة المستعملة في النصوص الكلامية الكلاسيكية هي ”الاقتران“ أو ”المناسبة“ أو ”جريان العادة“. وتترجم “al-Rāzī’s biography” بـ”سيرة الرازي وأعماله“؛[66] والحال أن المقصود هو سيرة الرازي فقط، بدليل أنه لم يرد في هذه الفقرة أي حديث عن أعمال الرازي التي ستخصص لها الفقرة التي تليها. وتترجم “Human Perfection” بـ”إكمال البشر“[67] والحال أن المقصود هو ”الكمال الإنساني“، أو ”كمال الإنسان“.
ويمكن للقارئ أن يصادف مفردة: ”ملف“ في عشرات الصفحات، وتحديدا في هوامش الترجمة حيث ترد الإحالة على المخطوطات (انظر: الأخلاقيات الغائية، 23، هـ1؛ 24، هـ2، هـ3؛ 26، هـ1؛ 32، 1؛ 33، هـ1، 2؛ 64، هـ1، 3؛ 77، هـ3…)، وقد يتساءل عن معناها ومقابلها بالإنجليزية. والمفاجأة غير السارة هي أن المترجمة تستعمل مفردة ملف مقابلا لـ fol.. والظاهر أنها اعتقدت أن المفردة عبارة عن اختصار لـfolder ؛ والحال أن جميع المهتمين يعرفون أن .fol إنما هي اختصار folio، وهي كلمة لاتينية وليست إنجليزية، وتعني الورقة، وتحديدا الورقة من المخطوطة أو النسخة الخطية.
كما يمكن للقارئ أن يجد النعت ”مستعار“[68] مضافا في البيبليوگرافيا إلى عبد الجبار المعتزلي؛ وقد ترجمت به المترجمة المفردة pseudo والحال أن المقصود بالمفردة هو ”منحول،“ أي أن النسبة الصحيحة يجب أن تكون إلى ابن منكديم وليس إلى عبد الجبار.
خاتمة
أتصور أن الترجمة غير مفيدة كثيرا من الناحية العلمية الأكاديمية، وإن كان مفيدة للغاية من الناحية الثقافية؛ إذ لا أرى كيف أن دارسا متخصصا يمكن أن تفيده الترجمة في عمله، لأن تخصصه يقتضي، بالذات، أن يباشر النظر في النصوص بلغاتها الأصلية. أما عندما تكون الترجمة فاسدة، فإنها أضرارها، من الناحية الثقافية، تكون كثيرة، فضلا عن أضرارها الواضحة من الناحيتين العلمية والتعليمية؛ وهي حالة ترجمتنا هذه. ولهذا لا أخفي شدة تبرمي من انتشار هذه ”المنشورات“ التي تسمّى تحكمًا ”ترجماتٍ،“ كما لا أخفي تألمي وقلقي من إقبال الطلبة والأساتذة، في الجامعات العربية، عليها واعتمادها في أبحاثهم ودراساتهم؛ إذ كيف يمكن أن تُعولَ على ترجمة كهذه في الاستشهاد بدعوى أيمن شحادة بخصوص التطور الفكري الرازي؟ وكيف للدارس أن يناقش هذه الدعوى، جزئيا أو كليا، وهو لم يفهمها فهما سليما؟
يظهر، من خلال ما تقدم، أن الترجمة التي بأيدينا فاسدة تماما شكلا ومضمونا؛ لذلك يجدر بالمؤسسة التي أصدرتها سحبها من المكتبات، لأنها تحتوي على أعطاب تمس جوهر العمل وتستعصي على الإصلاح أو الاستدراك في طبعة لاحقة. والحال أن تجاوز هذه الأعطاب غير المحدودة التي وقعت فيها المترجمة يقتضي إعادة ترجمة الكتاب بالكامل، من قبل مترجم جديد، له تكوين معين وخلفية معينة، تؤهله لترجمة هذا النوع من الكتب. أما الترجمة الحالية، فإنها تتضمن، في نظري، احتقارا للقارئ بالعربية وإساءة لسمعة دار النشر الأصلية، أقصد دار بريل للنشر. وما قدمتٌه، أعلاه، عينات فقط لفساد الترجمة، وإلا فإنه بوسعي أن آتي بشواهد من مجموع صفحات الترجمة تقريبا. وبطبيعة الحال، لا يمكن أن أورد، هنا، كل مظاهر الفساد والاختلال فيها، وإلا فإني سأكون مضطرا إلى ترجمة العمل من جديد، وهو ما يخرج عن الغرض من هذا القول، أعني تأليف قراءة نقدية في الترجمة.
نسيت أن أذكر أمرا ”إيجابيا جدا“ يوجد في هذه الترجمة العربية، وهو أنها توفر للقارئ بالعربية مجموع النشرة النقدية التي أنجزها أيمن شحادة لرسالة ذم لذات الدنيا كما أصدرتها دار بريل للنشر؛ إذ أعادت المؤسسة العربية تصويرها كما هي في النشرة الأولى، مكتفيةً بتغيير أرقام الصفحات؛ وبذلك فقد وفرت هذه المؤسسة نصا محققا للقراء بـ 130 درهما (15 دولارا)، بدل اقتناء الدراسة الأصلية بـ 1800 درهما (206 دولارا).
أمر أخير أرغب في قوله مع ترددي فيه لبداهته وظهوره عند العقلاء: أتصور أنه لكي أُوفق في ترجمة هذه الدراسة التي نحن بصددها يفترض بي، فضلا عن الإلمام بالإنجليزية الأكاديمية، المعرفة بنصوص الرازي وبشيء من فلسفة ابن سينا وببعض آراء أهل الكلام. أما الخبرة بالتربية وبديداكتيك العربية والتنمية الذاتية وبفلسفة الجمال وبالفلسفة المعاصرة، فإنها، على أهمية هذه المجالات، لا تسعف نهائيا في فهم دراسة عن فخر الدين الرازي؛ كما أن المال، عندما ينفرد، لا يصنع الجودة ولا البحث العلمي. ومن هذه الجهة، فإني لا أتصور دار نشرٍ فرنسية محترمة تكلِّف متخصصا في علوم التربية وديداكتيك اللغة الفرنسية بترجمة دراسة جامعية بالألمانية إلى الفرنسية عن المعلم إيكهارت (Meister Eckhart, d. 1328)، كما لا أتصورها تطلب من متخصص في فلسفة الجمال مراجعة الترجمة؛ وإلا اعْتُبِر ذلك فضيحة أكاديمية من قبل المختصين. كفى احتقارا للقارئ بالعربية!
للتوثيق
بن أحمد، فؤاد. ”الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة: مراجعة نقدية للترجمة العربية.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2929>
فؤاد بن أحمد
[1] Ayman Shihaddeh, The Teleological Ethics of Fakh al-Dīn al-Rāzī (Leiden-Boston: Brill, 2006).
[2] فضلا عن فساد الترجمة، فإن الفكرة الأساس التي يدور عليها نص الرازي هنا ليست هي ”القوة“—وهي مفهوم فلسفي مخصوص— وإنما ”القدرة“— وهي مفهوم كلامي مركزي لا مجال للتلاعب فيه ولا للتساهل. أما الترجمة، فإنها تبدأ بالحديث عن ”القوة“ وتنتهي بالحديث عن ”القدرة“؛ وكأنه لا فرق بين المفهومين عند الفلاسفة والمتكلمين.
[3] نحن أمام نص مترجم فيه إفساد تام لمضامين النص العربي الأصلي، إذ لا أتصور مهتما بالمجال يستسيغ تصيير ”الضدين“ ”متناقضين“؛ وشتان بين المصطلحين. تماما كما أن المترجمة بتصييرها ”المزاج المعتدل“، وهو مفهوم مركزي، ”ميزانا للأمزجة“، وهو مفهوم لا عهد لي به في النصوص القديمة والحديثة، يظهر المسافة التي تفصل بين المترجمة والمجال المعرفي الذي ينتمي إليه الكتاب الذي تترجمه.
[4] تكفي المقارنة بين النص المترجم والنص الأصلي لابن رشد لتظهر ركاكة الأول وغموضه؛ والحال أن نص هذا الأخير متاح للجميع، وكان بوسع المترجمة العودة إليه بسهولة والاقتباس منه مباشرة.
[5] فضلا عن فساد الترجمة، فإن المترجمة تتجاهل تماما تدخّل المؤلف في النص بالحذف وبالإضافة، وتتعامل وكأن شيئا لم يحدث في الاقتباس؛ والواقع أن المؤلف قد استعمل نقط الحذف والمعقوفتين للزيادة؛ وهو ما يظهر عند المقابلة بالنص الإنجليزي الآتي:
“Whenever … al-Rāzī and his followers debate with Muʿtazilīs on matters of destiny, they … hold that one of the objects of the capacity of the voluntary agent can preponderate only by a complete preponderator. Whenever they debate with the falāsifa on the questions of the creation of the world, the affirmation of God’s choice and the refutation of [their notion of God being] a necessitating cause, they follow the route of Muʿtazilīs and Jahmīs in saying that one of the objects of the capacity of the voluntary agent may preponderate over the other without a preponderator.” Shihaddeh, The Teleological Ethics, 36, n. 99.
[6] أتصور أن تصيير ”الجوهر“ ”مادة“ و”العرض“ ”حادثا“ في الترجمة العربية من الأمور التي لا يمكن أن يستسيغها عاقل، ويكشف جهل المترجمة بالمعجم الفلسفي للرازي وغربتها عن المجال المعرفي الذي ينتمي إليه الكتاب الذي تترجمه. وفضلا عن أن ”العرض“ في هذا السياق يقابل ”الجوهر“، فإن ”الجوهر“، في أحد معانيه، هو ما يتألف من مادة وصورة.
[7] يتعذر فهم المثالين الواردين في الاقتباس؛ وذلك بسبب فساد النقل وعجز المترجمة عن فهم المفردات العربية المكتوبة بالحروف اللاتينية. وهكذا، فمفردة ”المعد“ قد توهمتها المترجمة، فهي غير موجودة في النص الأصلي، ولعلها نتيجة قراءتها الخاطئة لمفردة ”المؤدي“، كما أن المفردة الأخيرة، أي ”المؤدي“ ليست في موضعها المناسب، ومفردة ”المصحح“ ساقطة؛ فصار قول الرازي—بسبب هذه الترجمة الفاسدة—عبارة عن طلاسم خلو من المعنى. وأمامنا قول الرازي كما ترجمه المؤلف:
“Harm is pain and what is akin to it, such as grief, the loss of benefit, or what leads to either … Benefit is pleasure, joy, what is a means to them, and what is a prerequisite for them. Gold and silver are examples of the ‘means’ (muʾaddī). Life is an example of the ‘prerequisite’ (muṣaḥḥiḥ).” Shihadeh, The Teleological Ethics, 49.
[8] يبدو لي النص المترجم عصيا على الفهم هنا؛ ونحتاج إلى أن نقابله بالأصل العربي حتى ندرك ماذا يريد الرازي أن يقول.
[9] بدل الاحتفاظ بمعجم الرازي، وهو يتحدث عن ”الشاهد“ في مقابل ”الغائب“، نقلتنا المترجمة إلى ”عالم الشهود“ و”العالم المشهود.“ وفضلا عن أن مصطلحي ”عالم الشهود“ و”العالم المشهود“ دخيلان على حقل الاستعمال الكلامي وغريبان عنه، فإنه يُستبعد جدا أن يفهم القارئ أنهما يحيلان على ”الغائب“ و”الشاهد“ بمعناهما الصناعي المستعمل عند المتكلمين في تدليلاتهم.
[10] إن تجاهل المترجمة النص العربي جعلها تتحدث عن ”الخطأ“ و”المخطئ“، والحال أن الرازي يتحدث عن ”الظلم“ و”الظالم“.
[11] ومع أن المؤلف قد نبّه على أن الأمر يتعلق في النص العربي بـ”تحسين العقل وتقبيحه،“ فقد صيرت المترجمة الرازي متحدثا عن ”عقلانية أخلاقية.“ فتأمل!
[12] يظهر هنا فساد الترجمة من خلال خلط المترجمة بين ”المعرفة“ و”العلم“، وجهلها بالمعجم الفلسفي والكلامي المستعمل من قبل الرازي. فـ”الخصائص غير ”الجنس“، كما أن ”الأصل“ غير ”العين“.
[13] وفضلا عن بعد الترجمة من النص الأصلي، فإن المترجمة تُسقط من الهامش الإحالة على كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون، فتصبح القولة لأبي بكر الرازي؛ فيغدو هذا منتقدا، بل شاتما نفسه!
[14] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 85.
[15] فخر الدين الرازي، شرح الإشارات، جزءان (القاهرة: 1325هـ)، ج. 2، 50.
[16] ولعل الصواب هو ”خلط“ وليس ”يخلط“، كما فهم شحادة.
[17] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 8.
[18] Shihaddeh, The Teleological Ethics, vii.
[19] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 10.
[20] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 1.
[21] فضلا عن أن مفردة ”تراثه“ ليست بالترجمة السليمة للمفردة الإنجليزية “its background”، فإن الظاهر أن المترجمة قد نسبت ”تراث“ إلى الرازي، بينما “background” في النص الإنجليزي منسوبة إلى النظرية الأخلاقية.
[22] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 66، هـ1، 87، 91، 111، 127، 142، 169؛ بل وفق الترجمة العربية يصير الكسب هو ”الاعتقاد بأن عبارات [كذا] القيمة لا يمكن تعريفها إلا بالرجوع إلى الأوامر الإلهية.“ الأخلاقيات الغائية، 142؛ وتترجم المترجمة المفردة الإنجليزية “voluntarism” بـ ”كسبية“؛ انظر: الأخلاقيات الغائية، 92. وانظر الحذف الذي طال معطيات بخصوص هذا المفهوم في: الأخلاقيات الغائية، 65–66، هـ1؛ وتترجم المترجمة المفردة الإنجليزية“voluntarism” بمفردة ”إرادية“؛ انظر: الأخلاقيات الغائية، 77.
[23] See Shihaddeh, The Teleological Ethics, 47, n. 2, 110.
[24] See Shihaddeh, The Teleological Ethics, 13, 39-40, 53, 279.
[25] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 10.
[26] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 2.
[27] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 15.
[28] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 6.
[29] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 16.
[30] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 7.
[31] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 16.
[32] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 7.
[33] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 17.
[34] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 8.
[35] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 19.
[36] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 9.
[37] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 19.
[38] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 9.
[39] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 19.
[40] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 9.
[41] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 20.
[42] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 10.
[43] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 21.
[44] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 10–11.
[45] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 190.
[46] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 150.
[47] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 74.
[48] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 324.
[49] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 7.
[50] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 317.
[51] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 201.
[52] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 207، هـ3.
[53] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 324.
[54] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 324.
[55] وانظر إحالة مضللة أخرى في شحادة، الأخلاقيات الغائية، 45، هـ4؛ حيث تكتب المترجمة: ”تمت مناقشة ذلك في ص. 118–20 وما بعدها.“ فالمقصود بهذه الإحالة النص الإنجليزي وليس الترجمة العربية، حيث لا نجد مناقشة كهذه في تلك الصفحات وما بعدها.
[56] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 31، هـ2.
[57] Shihaddeh, The Teleological Ethics, 19, n. 25.
[58] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 11، 13، 26، 56.
[59] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 136، 141.
[60] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 14، 175، 190، 223.
[61] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 229.
[62] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 12.
[63] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 169.
[64] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 24.
[65] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 31.
[66] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 12.
[67] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 181.
[68] شحادة، الأخلاقيات الغائية، 322.
مقالات ذات صلة
الخطاب المعياري عند الماوردي (ت. 450هـ/1058م) بين الفقه والفلسفة والأدب: من التأطير القانوني إلى قراءة نسقية وتاريخية
Al-Māwardī’s (d. 450/1058) Normative Discourse between Islamic Jurisprudence, Philosophy, and Adab: From a Legalistic Framing to a Systematic and Historical-Contextual Reading al-khiṭāb al-miʿyārī ʿinda al-Māwardī (d. 450/1058) bayna al-fiqh wa-l-falsafa wa-l-adab:...
نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“
Toward Terminological Unity in the Translation of The New Rhetoric Naḥwa al-waḥda al-iṣṭilāḥiyya fī tarjamat al-Mufaṣṣal fī al-ḥijāj نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“ محمد قنديلجامعة ابن طفيل، القنيطرة Mohammed Kandil Ibn Tofail University, Kénitra...
آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/922م) في النفس الإنسانية
Ārāʾ al-faylasūf Abī al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381 H/992 M) fī al-nafs al-insānīyah Abū al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381/992) on The Human Soul: A Philosophical Inquiry آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/ 922م) في النفس الإنسانية[1] بلال مدريرالأكاديمية الجهوية للتربية...
النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)
The Second Maghribi Logical Revival: Muḥammad al-Sharīf al-Tilmisānī (710–771/1310–1370) al-Nahḍa al-Manṭiqiyya al-Maghribiyya al-Thāniya:Muḥammad al-Sharīf al-Tilimsānī (710–771/1310–1370) النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)...
الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي: موقع كوكبي الزهرة وعطارد نموذجًا
The Reformist Contribution of Jābir ibn Aflaḥ al-Ishbīlī to Astronomy: Venus and Mercury as a Case Study al-Ishām al-iṣlāḥī fī al-falak li-Jābir b. Aflaḥ al-Ishbīlī: Mawqiʿ kawkabay al-Zuhra wa-ʿUṭārid namūdhajan الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي:موقع...
مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم
The Concept of Paradigm in Ibn al-Haytham's Astronomy Mafhūm al-Parādīghm min khilāl falak Ibn al-Ḥaytham مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم فتاح مكاويFatah Mekkaoui جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاسSidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez الملخص: يعتبر...
في مشروعية الكلام السني ضدا على إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت.505هـ/1111م): قطعة من موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي (ت.520هـ/1126م)، تعريفٌ وتوصيف
On the Legitimacy of Sunni Theology against Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (d. 505/1111): A Section from Abū Bakr al-Ṭurṭūshī’s al-Asrār wa-l-ʿIbar (d. 520/1126) - Introduction and Description Fī Mashrūʿiyyat al-Kalām al-Sunnī Ḍiddan ʿalā Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn...
منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق
Al-Ghazālī’s Methodology in His Writings on Logic Manhaj al-Ghazālī fī al-Taʾlīf fī ʿIlm al-Manṭiq منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق محمد رويMohamed Roui جامعة عبد الملك السعديUniversité Abdelmalek Essaadi ملخص: تتناول هذه الدراسة معالم منهج أبي حامد الغزالي...
المنطق في الحضارة الإسلاميّة
المنطق في الحضارة الإسلاميّة خالد الرويهبKhaled El-Rouayheb جامعة هارفارد-كمبريدجHarvard University-Cambridge ملخص: ”المنطق في الحضارة الإسلامية“ لخالد الرويهب (جامعة هارفارد بكمبريدج) هي في الأصل محاضرة بالعربية ألقيت في مؤسسة البحث في الفلسفة العلوم في...
مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي: بواكير منظور جديد
Navigating Ambiguity: Exploring the Role of Uncertainty in the Classical Arab-Islamic Culture Makānat Al-Iltibās fī al-Thaqāfah al- ʿArabiyya al-Islāmiya Fī ʿAṣrihā al-Klāsīkī:Bawākīr Manẓūr Jadīd مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي بواكير...