![]()
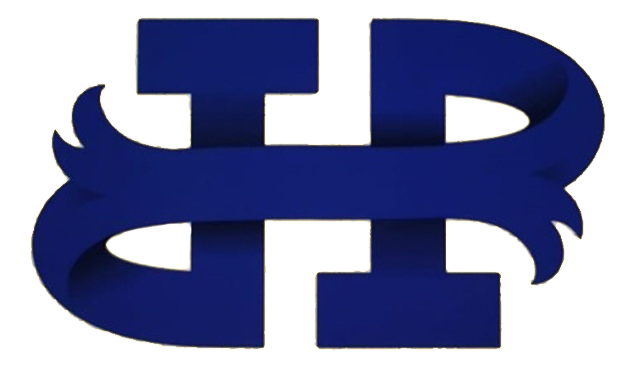
عن ابن رشد وما لا نعرف عنه: في الرد على حسن أوريد ومن معه

عن ابن رشد وما لا نعرف عنه
في الرد على حسن أوريد ومن معه
فؤاد بن أحمد
جامعة القرويين، الرباط
تقديم
اجتهد العربُ المحدثون في ترجمة المفردتين revue وjournal بمفردة ”المجلة،“ بعد أن نقلوا هذه من معناها القديم، وهو ”كتاب يحتوي على أشياء جليلة من الحكم وغيرها.“[1] لكنهم استعملوا، أيضا، المفردة نفسها، أي ”المجلة،“ لتعريب المفردة الفرنسية والإنجليزية magazine، وهي غير revue أو journal؛ وعادة ما تكون مصوّرة (تحمل صورا)، وهي غير يومية، ولا هي دورية، بل غالبا ما تكون شهرية. وقد تقال magazine على النشرة الورقية والرقمية؛ كما قد تقال على النشرات الإذاعية أو التلفزية التي تعالج بانتظام موضوعات بعينها. ومن أشهر المنشورات الفرنسية الورقية والرقمية من صنف le magazine في المغرب: Science et Vie وMagazine Littéraire وL’Histoire وHistoria… وإذا كان الأمر واضحا في الفرنسية والإنجليزية، فإن الأمر غير ذلك في العربية. ومن هذه الجهة، فإنه لا قبل للمتلقي العادي بالتمييز بين مجلة زمان، التي تستوحي بعض النماذج الفرنسية، ويقدمها أهلها بأنها ”مجلة شهرية مغربية مختصة بتاريخ المغرب، وأنها المجلة الأولى والوحيدة للتاريخ في المغرب“ وبين مجلة تاريخ المغرب—على سبيل المثال— التي يقدمها أهلها بأنها ”مجلة علمية متخصصة دورية تهتم بالبحث في تاريخ المغرب.“ إذ لا فرق، في الظاهر، بين المنشورين سوى أن الأولى شهرية والأخرى دورية؛ والحال أن بين المنشورين فرقا قد يخفى على غير المختصين. ويقوم هذا الفرق تحديدا في طبيعة تقديم المواد العلمية المنشورة: فإذا كان المنشور المسمى revue بالفرنسية، أو journal بالإنجليزية، غالبا ما يكون علميا، أي أكاديميا، وصادرا عن مؤسسات جامعية أو عن فاعلين جامعيين، ولا يصدرها صحافيون، فإن الأمر بخلاف ذلك في magazine، التي هي، بالأساس، منشور ذو طابع صحافي وعلمي في آن معا (يصدرها صحافيون ذوو تكوين معرفي في مجال بعينه: العلوم، الفلسفة، التقنيات…ويشتغلون تحت الوصاية العلمية لهيئة تتألف من مختصين وخبراء في المجال)؛ أي أنها تحترم شروط المعرفة العلمية التي تنشرها، وتعمل، في الآن نفسه، على إخراج هذه المعرفة من دائرة المختصين وتعميم فائدتها لتشمل فئة عريضة من القراء أو الجمهور.
ومن هنا خطورة les magazines وأهميتها وصعوبة المهمة المنوطة بأصحابها؛ فهي قنطرة بين المعرفة العلمية الدائرة بين المختصين والمعرفة الموجهة لعموم القراء والمهتمين. غير أن مكمن الصعوبة إنما هو في عملية النقل هذه؛ إذ إن الرهان بالنسبة للقائمين عليها هو كيف ننشر، على نطاق واسع، معارف علمية، هي حصيلة أبحاث أكاديمية دقيقة، دون أن نٌعرِّض تلك المعارف أو نخضعها للتزييف والتحريف. وبالنظر إلى الانتشار الواسع لـ les magazines بين القراء، إذ عادة ما تطبع منها عشرات الآلاف من النسخ، فإن خطورة التزييف والتحريف فيها أكبر بكثير من الأخطاء التي تحصل في المجلات الأكاديمية المتخصصة، والتي عادة ما تسارع إلى تصويب أخطائها في نشراتها اللاحقة.
والآن، بعد هذا التقديم العام، نشرع في الحديث في موضوعنا، وهو الملف الذي خصصته مجلة زمان، وهي للتذكير magazine وليست revue أو journal، للفيلسوف الأندلسي الشهير ابن رشد (ت. 595هـ/1198م). وهكذا، فقد حمل العدد المزدوج 94-95، غشت-شتنبر 2021 من المجلة ملفا بالعنوان الآتي: ”ابن رشد: ما لا نعرف عنه.“ وقد تضمن الملف ست مواد (خمس مقالات وحوارا). أما الحوار فقد أجري مع أحد الجامعيين المغاربة، وهو الزميل عبد النبي الحري، من جامعة الحسن الثاني-المحمدية، الذي كان قد أنجز رسالته للدكتوراه عن القراءات المغربية المعاصرة لابن رشد. وأما المقالات، فقد وقَّع واحدة منها الزميل إبراهيم بورشاشن، من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-القنيطرة، وكان قد أنجز رسالته الجامعية عن علاقة الفلسفة والفقه في الخطاب الفلسفي لابن رشد، كما نشر عدة دراسات عن الفيلسوف نفسه؛ وعنوان مقالته: ”ابن رشد معاصرا“. وباستثناء الحوار وهذه المقالة التي ذكرنا للتو، فإن المواد الأربع من تأليف أعضاء في الهيئة العلمية والتحريرية لـمجلة زمان ومن كتابها. وهكذا، فقد أنجز حسن أوريد، وهو كاتب ومؤرخ المملكة سابقا ومستشار علمي لمجلة زمان، مقالتين هما: ”ابن رشد الحاضر الغائب“ و”جوامع سياسة أفلاطون: الكتاب القضية لابن رشد؛“ وأنجز غسان الكشوري، وهو صحافي من هيئة تحرير مجلة زمان مقالةً واحدة بعنوان: ”كيف أنارت الرشدية ظلام أوربا[؟]“ وكتب موليم العروسي، من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، متخصص في الجماليات والأدب الفرنسي ومستشار علمي لمجلة زمان، مقالةً واحدة بعنوان: ”ابن رشد، أو لعنة الفكر التوفيقي،“ وأعدّ محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) وهو طالب باحث في قسم الدكتوراه —تخصص الدراسات الإسلامية—وحركي إسلامي سابق ومن كُتاب مجلة زمان مقالة واحدةً، بعنوان: ”لماذا يكرهون ابن رشد[؟]“.
وقد تضمن الملف الكثيرَ من المبالغات والأحكام المتسرعة والأخطاء المعرفية والتاريخية، بل تضمن أمورا يصعب السكوت عنها، ولو أن النقاش بخصوصها لا يفيد كثيرا الأبحاث العلمية الجارية عن ابن رشد. وطبعا، لا يسمح المجال في هذه المقالة النقدية بأن نقف عند نواقص الملف كلها، لكننا سنفصل القول في أربعة منها، وبخاصة ما ورد في مقالتي حسن أوريد، مع الإشارة، في البداية وعلى نحو سريع جدا، إلى بعض من المبالغات والأخطاء التي وردت في بقية المواد. ونلفت انتباه القارئ إلى أن جميع إحالاتنا على الملف ستكون في متن مقالتنا، مكتفين بذكر الصفحة وأحيانا العمود، أما إحالاتنا الأخرى فسنثبت مظانها في الهوامش.
أولا: غموض ومبالغات وأخطاء
1. أتصور أن الجملة التي افتتحت بها هيئةُ التحرير ملفها فيها قدر غير قليل من المبالغة: ”لم يشغل أحد الناس من أهل السنة والفكر كما شغلهم ابن رشد“ (ص. 26). وطبعا، فهذا الحكم الذي ربما يعبر عن رغبة هيئة التحرير، وليته كان صحيحا، لم يقم على إحصاء وجرد للمقالات المؤلفة عن ابن رشد ومقارنتها بما ألف عن أبي علي ابن سينا (ت. 428هـ/1037م) وأبي حامد الغزالي (ت. 505هـ/1111م). كما أن إلصاق عبارة ”الظلمات“ بالقرون الوسطى (ص. 26) يحمل حكم قيمة صريح في حق فترة تاريخية لا يمكن أن توصف بالظلمات إلا من قبل أصحاب فترة أخرى، وهي ”الأنوار،“ في سياق البحث عن مبرراتها الذاتية. وفي كل الأحوال، فإن المؤرخين المختصين يميلون أكثر إلى استعمال مفردات واصطلاحات أكثر حيادا.
2. وأتصور، أيضا، أن المهنية تقتضي احترام ما ورد في المقالات عند وضع عبارات بخط عريض وسط المقالات لإثارة انتباه القارئ، وليس تحريفه وقلب معناه. ولنا على ذلك مثالان اثنان يكشفان كيف أفسدت تلك العبارات ما ورد في متن المقالات: أما الأول فهو: ”حاول ابن رشد التوفيق بين الفلسفة الغربية [كذا] والتراث العربي الإسلامي، فحاربه الفقهاء بدءا من ابن تيمية، كما حاربه السلفيون والعقلانيون المغاربة، على رأسهم العروي“ (ص 39). وهكذا فقد صار العروي أحد أعداء ابن رشد. أما مقالة موليم العروسي فقد ورد فيها ما يلي: ”هذا التوجه [الصوفي] هو الذي يسميه الفقهاء والفلاسفة، على حد سواء، في العالم العربي بالفكر غير العقلاني أو الخرافي. حاربه الفقهاء منذ ابن تيمية، وحاربه السلفيون بالمغرب وحاربه أصحاب الفكر العقلاني من أمثال عبد الله العروي وغيره“ (ص 41، العمود الأول). العبارة في واد وكلام المقال في واد آخر، وإلا فأين يرد في مقال العروسي أن العروي قد حارب ابن رشد؟ وأما المثال الثاني فهو: ”تعرض طلبة ابن رشد للتهميش، أيضا، فلم يتموا عمل أستاذهم“ (ص. 50، العمود الأول)بينما مقالة إبراهيم بورشاشن تتحدث عن التهميش الذي تعرض له طلبة جمال الدين العلوي، وهو منهم، لذلك لم يتموا عمل أستاذهم (انظر: ص. 50، العمود الثاني). مرة أخرى، ليس من المهنية تقويل الكتاب ما لم يقولوا و”الكذب“ على القراء. ولا يهمنا هنا حسن النوايا!
3. تخللت مواد الملف بعض أشكال الغموض والخلط والأخطاء المعرفية والتاريخية الصريحة؛ والتي كان من شأن المراجعة العلمية من قبل المختصين أن تساعد على تفاديها:
* ويمكن الإشارة، مثلا، إلى بعض الهفوات من قبيل الحديث عن ترحيل كتب ابن رشد ”إلى بلاد العم سام“ (ص. 56). ولعل الزميل يقصد أوروبا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية التي يُطلق عليها، أليغوريا، بلادُ العم سامLand of Uncle Sam لم يكن لها ”وجود“. وبعبارة أخرى، إن تأثير ابن رشد، في عصر النهضة وما قبله كان في أوروبا، وليس في أمريكا التي لم تكن قد اكتشفت بعد.
* ومثال ثان للأخطاء الناجمة عن القراءة بلغة واحدة هو القول: ”لُقب [ابن رشد] أحيانًا بالشارح الأكبر اعترافا بدوره وشرحه لفلسفة أرسطو بينما اكتفى خصومه بنعته بالمعلق انتقاصا من إسهاماته“ (ص. 48). وقد غاب عن صاحب المقالة أن ”الشارح الأكبر“ و”المعلق“ إنما هما مفردتان عربيتان استعملتا لترجمة المفردة اللاتينية commentator ذاتها، التي ترد، أحيانا، ملحقة بـ Averroes وأحيانا منفردة.
* أما القول بأن السلطان العثماني محمد الفاتح قد أصدر ”أوامره للعالم خوجة زاده بأن يوازن بين كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي وتهافت التهافت لابن رشد“ (ص. 47)، فهذا وإن كان شائعا بين غير المختصين، فإنه غير صحيح، ونص المولى خواجه زاده أو مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوي، الملقب بمصلح الدين (ت. 893هـ/1488م)، متوفر بأيدي الناس. فالنص—وعنوانه التي صدر به حديثا هو التهافت في المحاكمة بين الغزالي والفلاسفة—عبارة عن مقارنة بين الغزالي وعامة الفلاسفة المسلمين، بما في ذلك ابن اسينا والفارابي، وليس بين الغزالي وابن رشد.
* ونضيف، على سبيل التنبيه فقط، إن محمد رفيقي إذا أراد أن يعرف هل يعتبر ابن رشد السنةَ من مصادر التشريع أم لا عليه أن يبحث في مختصر المستصفى أو الضروري في أصول الفقه وبداية المجتهد ونهاية المقتصد وليس في كتبه المنطقية والفلسفية. فمصادر التشريع تُدرس في موضعها كما تدرس المقولات والحجج والحركة وعلل الموجود في مواضعها. وأتصور أن من يبحث في تفسير ما بعد الطبيعة، مثلا، عن مصادر التشريع في الإسلام إنما هو في حاجة مستعجلة إلى من يرشده إلى كتب ابن رشد وموضوعاتها ويعينه على قراءتها. لذلك، نقترح أن يعود محمد رفيقي إلى الكتابين المذكورين، أعني مختصر المستصفى وبداية المجتهد ثم يعيد النظر في قولته هذه: ”من يراجع كتب ابن رشد في الفلسفة والمنطق، يدرك أنه لم يكن يعتبر السنة والمرويات الحديثية من مصادر التشريع.“ (ص. 45).
* يمكن للمرء أن يسأل محمد رفيقي: أي قيمة معرفية أو منهجية للاستشهاد بكلام شخص سلفي وهابي معاصر في حق فيلسوف كابن رشد؟ خصوصا وأن ذلك الكلام نفسه يكشف جهل صاحبه المطبق بمواقف ابن رشد من البعث والنبوة والشريعة (وهل درس محمد رفيقي هذه المواقف أصلا؟). وفي هذا السياق، نُذكر، أيضا، بأن المختصين يميزون جيدا بين النقد الداخلي للنصوص الفلسفية، وقد مارسه المتكلمون المسلمون من مختلف الفرق، والنقد الخارجي، الذي هو في الحقيقة قدح وسباب واتهام، ويستعيد أحكاما قيلت منذ آلاف السنين، ولا يختص بالإسلام دون سواه. فأي جديد في كلام ناصر الفهد بالقياس إلى ما قاله ابن الصلاح منذ مئات السنين؟ وأي أثر لناصر الفهد على مصير الدراسات الرشدية في العالم؟ الجواب عن السؤالين معا: لا شيء.
* أما طامة الطوام، في مقالة محمد رفيقي دائما، فهي القول إن ”ابن رشد كان فقيها وألف واحدا من أشهر كتب الفقه المقارن، وهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مما جعل ردودهم [=المعارضين للفلسفة] عليه أشد عنفا وقسوة، ومن أشهرها كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة“ (ص. 45). يصعب على الإنسان أن يصدق كيف تسمح مجلة، يفترض أن لها هيئةً استشارية علمية، بنشر مثل هذا الكلام في ملف: ”ابن رشد: ما لا نعرف عنه.“ حقا، لا أحد كان يعرف أن الغزالي—وقد توفي عام 505 للهجرة الموافق لـ 1111 للميلاد—قد نهض من قبره ليرد على ابن رشد— وقد توفي عام 595 للهجرة الموافق لـ 1198 للميلاد—إلى أن جاءت مقالة محمد رفيقي بهذه الحقيقة التاريخية المحدَثة…فلنا أن نتأمل!
* وطبعا لا يتسع المقام لإيراد أخطاء أخرى، كما لا يتسع لمناقشة موليم العروسي الذي يلح على تسميه ابن رشد بالفقيه لغرض في نفسه، كما يلح على أن ”مجمل الفلسفة اليونانية كان مترجما إلى اللاتينية إبان حكم روما للعالم“ (ص. 41)، هكذا دون أن يحدد العروسي ما هي هذه الأعمال الفلسفية التي كانت قد ترجمت إلى اللاتينية قبل ترجمة أعمال ابن رشد، ودون أن يقدم لنا تواريخ ترجمة هذه الأعمال ولا متى كانت روما تحكم العالم. وفي كل الأحوال، فإن قول العروسي لا يصمد أمام ما يوجد اليوم من معطيات بخصوص عدد النصوص الفلسفية لأرسطو—تحديدا—التي كانت مترجمة إلى اللاتينية قبل القرن الثاني عشر للميلاد. فليدلنا العروسي عن ترجمات إلى اللاتينية غير تلك التي قام كل من النحوي الأفريقي-الروماني ماريوس فيكتوريوس (Marius Victorius) في القرن الرابع للميلاد (وقد ترجم إلى اللاتينية كتابي المقولات والعبارة من منطق أرسطو)، والنحوي والفيلسوف اللاتيني أنشيوس بويثيوس (Anicius Boethius, d. 524)) في القرن السادس للميلاد، وقد تَرجم إلى اللاتينية أجزاءً من منطق أرسطو (كتب التحليلات الأولى والمقولات والطوبيقا والعبارة). ويعرف المختصون أن إعادة اكتشاف المتن الأرسطي من قبل الدوائر العلمية الأوربية لم تحصل إلا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر؛ وقد لعبت نصوص ابن رشد في هذا دورا لم يعد ينكره أحد. وللعلم، فإن روما لم تكن تحكم العالم في هذه الفترة. وفي كل الأحوال، لم أكن أتوقع من العروسي غير هذا الحكم، لأنه لن يقبل لابن رشد، وهو الفيلسوف المسلم والقاضي الشهير الذي يبت في النوازل التي تعرض لعموم الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، أن يكون قد أسهم في بناء الفكر الفلسفي الأوروبي، وهو الذي لم يكن سوى فقيه سني مالكي، والذي ”يجب أن نعلم“ أنه، أي ”الفقيه ابن رشد لم يكن يعرف اليونانية، وأن ما اطلع عليه هي ترجمات قديمة من لغات أخرى غير اليونانية.“ وعليه، فكون ابن رشد غير عارف باليونانية —وهو من المعارف المعلومة لدى عامة الناس قبل خاصتهم—هو ما يجب أن نعلم، وهو ما يدخل في صميم ملف المجلة: ”ابن رشد ما لا نعرف عنه.“ ولست أدري ما الداعي إلى التهويل على القارئ العادي بالحديث عن ”لغات أخرى“ هكذا بدون أي تحديد، وما الذي نضيفه إلى معلوماته؛ والحال أن ما وصل ابن رشد من نصوص فلسفية وعلمية هي إما مترجمة من اليونانية إلى العربية مباشرة؛ وإما مترجمة إلى العربية بوساطة السريانية. أما تلك النصوص الفلسفية المترجمة إلى العربية عن الفارسية، فهي على قلتها، لم تكن بيد ابن رشد. وفي كل الأحوال، فهذه أمور معروفة عند الدارسين المختصين في الموضوع. ولست أدري المصدر الذي استفاد منه العروسي قوله بأن ابن رشد قد أدان كتاب إحياء علوم الدين (ص. 40)؛ مع أن ما ورد على لسان ابن رشد بخصوص هذا الكتاب يوحي بالعكس؛ وله أن يقرأ ابن رشد من جديد (ويكفيه أن يعود إلى فصل المقال، وهو كتيب سهل المأخذ، للوقوف على ما نقول). ولست أدري، أيضا، أين قرأ العروسي بأن الفيلسوف العربي أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (ت. 252هـ/866م) قد عرّب كتاب التاسوعات لأفلوطين، وأنه هو من نسبه خطأ إلى أرسطو (ص. 40)؛ والحال أن الكندي لم يكن يعرف، من اللغات، غير العربية. أتصور أن قليلا من ”التواضع العلمي“ من شأنه أن يجنبنا الكثير من الفواحش المعرفية والتاريخية.
4. لست أدري لماذا يصر الزملاء على النظر إلى ابن رشد وكأنه لم يَكتب عنه سوى المغاربة وبعض العرب، وأغلبهم ممن قضى. والحال أن ابن رشد، وخاصة في هذا القرن، قد أصبح موضوع بحث كوني. وتكاد الدراسات عنه لا تتوقف بشتى اللغات. طبعا، من حق الإنسان أن يختار، لاعتبارات برغماتية أو واقعية، موضوع دراسته؛ لكننا لا نتصور الدراسات الرشدية المغربية في جزيرة معزولة عن بقية العالم. لذلك، فإننا نرى أنه أمر مفيد جدا لهذه الدراسات المغربية أو العربية نفسها أن ننظر إليها ونختبرها في سياق أشمل عن طريق مقارنتها بمثيلاتها الأوروبية والأمريكية… وهكذا، فإن تاريخ الدراسات الرشدية لم يتوقف عند محمد عابد الجابري (ت. 2010م)، ولا عند محمد المصباحي، كما أنه لم يبدأ مع جمال الدين العلوي (ت. 1992م). بل إن دراسات هؤلاء نفسها لا يمكن أن تظهر قيمتها العلمية، وحدودها أيضا، إلا عند وضعها في هذا الإطار الدولي العام الذي تتحاور فيه القراءات وتتنافس فيه التأويلات؛ وإلا فإن حصر النقاش بخصوص ابن رشد في المغاربة (بين الجابري، وعبد الرحمان طه، ومحمد المصباحي، وعبد المجيد الصغير…) أو المصريين (محمود قاسم (ت. 1973م)، وعاطف العراقي (ت. 2012م)، ومراد وهبة…) فيه ضرب من الإصرار الساذج على إبقاء الدراسات الرشدية، المغربية والعربية معا، حبيسة المحلية، وربما الهواية أيضا؛ خصوصا وأن من هؤلاء الدّارسين من كان يحاور زُملاءه على المستوى الدولي، لا فقط على المستوى المحلي والعربي. وفي كل الأحوال، تكفي كتابة “Ibn Rushd” أو “Averroes” في محركات البحث في الإنترنت أو في رصيد الخزائن الورقية والرقمية حتى نقتنع أننا لسنا الوحيدين في العالم الذين انشغلوا بابن رشد؛ هذا بصرف النظر عن طبيعة تلك الانشغالات والتفاوت في قيمتها المعرفية والمنهجية!
ثانيا: في الرد على حسن أوريد
تولى حسن أوريد كتابة مادتين ضمن الملف الخاص بابن رشد. أما المادة الأولى، وهي عبارة عن مقالة تقديمية عامة، فقد حملت عنوان ”ابن رشد: الحاضر الغائب،“ وتعرض فيها لسيرة ابن رشد وسياقه وأعماله ومعالم من فكره. وأما عنوان المادة الثانية، فهو: ”جوامع سياسة أفلاطون: الكتاب القضية لابن رشد.“ وإذا كان أوريد قد عوّل في المقالة الثانية حصريا على ما هو منشور لمحمد عابد الجابري في الموضوع، وهو أمر مقبول في المقالات التي تنشرها les magazines، فإن الدعوى الجديدة التي حملتها المقالة، وتنسجم تماما مع عنوان الملف، أي ما لا نعرفه عن ابن رشد، هو ربط أوريد بين جوامع سياسة أفلاطون ومقدمة ابن خلدون، عن طريق اكتشاف تلميذ جديد لابن رشد، لا علم للناس به.
ويهمنا أن نقف عند أربع مسائل نراها تستحق أن نثير بخصوصها هذا النقاش، وأولها ادعاء أوريد أن ما نتوفر عليه اليوم من كتابات ابن رشد ليس سوى النزر القليل من أعماله التي أحرقها المسلمون والنصارى؛ وأما المسألة الثانية، فهي حديث أوريد عن كتاب غير معروف لابن رشد، بعنوان: المناهج العدلية؛ وأما المسألة الثالثة، فهي اكتشاف أوريد لتلميذ جديد لابن رشد، معتبرا إياه الحلقة التي توسطت بين هذا الأخير والآبلي، شيخ ابن خلدون؛ وأما المسألة الرابعة والأخيرة، فهي ذات صبغة منهجية تتعلق بطبيعة تعامل أوريد مع اقتباساته ومصادره.
ويجدر بنا أن نُذكر في هذا السياق بأمرين اثنين في مقالة أوريد الأولى: أما الأمر الأول، فهو تمييزه الصريح بين ”دائرة الجمهور“ و”محيط المختصين“ بخصوص المعرفة بابن رشد؛ مما قد يعني أنه يتحدث بلسان المختصين الذي ينفصل عن بادئ الرأي المشترك عند الجمهور بخصوص ابن رشد. وأما الأمر الثاني، فهو أن الكتابات العربية عن ابن رشد لا ترقى، في نظره، إلى ما كتبه الغربيون عنه. وطبعا في المقالتين معا، وباستثناء اعتماده المعلن على عمل الجابري، لا يجد القارئ قائمة مصادر أو مراجع، على غرار المقالات الأخرى؛ الأمر الذي يجعل مهمة التحقق من الاقتباسات ومن مصادر أفكاره وتحليلاته أمرا مستعصيا.
- أعمال ابن رشد بين ”دائرة الجمهور“ و”محيط المختصين“
يقول حسن أوريد: ”حين نبرح دائرة الجمهور إلى محيط المختصين، ندرك أن ما بقي من كتبه هو النزر القليل، لأن أغلبها أحرق، أحرقه المسلمون بعد تنكيب ابن رشد، ومنه ما نالته النيران مع محاكم التفتيش المسيحية. أبقي على بعضها في ترجمات بالعبرية واللاتينية، ولم ينقل أغلبه للعربية، بمعنى أن ما نعرفه من نتاج الرجل قليل لا يشفي الغليل.“ (ص. 29 والتشديد منا). يدعي أوريد، هنا، أن المختصين وحدهم، دون الجمهور، يدركون أن كتب ابن رشد لم يبق منها سوى النزر القليل. ويقدم ثلاث حجج لشد دعواه: الحجة الأولى هي أن المسلمين قد أحرقوا كتب ابن رشد خلال نكبته؛ وأما الثانية فهي محاكم التفتيش المسيحية التي أحرقت كتب ابن رشد. أما الحجة الثالثة، فهي أن أغلب نصوص ابن رشد التي حفظت في ترجماتها العبرية واللاتينية لم ينقل إلى العربية؛ وعليه فإن ”ما نعرفه من نتاج الرجل قليل لا يشفي الغليل.“ (انظر أعلاه).
يمكن أن نقول إن الحجج الثلاث التي قدمها أوريد صائبة بجهة من الجهات، لكن صوابها لا يلزم عنه تلك الدعوى التي ادعاها، وهي أن كتب ابن رشد لم يبق منها سوى النزر القليل. فقد يكون بعض مؤلفات ابن رشد قد تعرض للحرق؛ لكن هذا لم يحصل، إن هو حصل، إلا على نحو معزول ولبعض النسخ من كتبه، ولم تصلنا بخصوصه أخبار موثوقة. لكن من غير المقبول أن تكون كتب ابن رشد قد تعرضت للحرق، على نحو واسع، قبل أن تُترجَم عقدين من الزمن على الأقل بعد وفاته. فقد بدأت ترجمات ابن رشد إلى اللاتينية عشرين سنة بعد وفاة ابن رشد على يد مايكل سكوت (Michael Scot, d. 1232)، وإلى العبرية على يد صمويل بن تيبون (Samuel Ibn Tibbon, 1232) وصهره يعقوب أبّا ماري أناطولي (Jacob Abba Mari Anatoli, d. c. 1256) ابتداءً من العقد الثالث من القرن الثالث عشر (1232م). أما أن تكون أعمال ابن رشد قد تعرضت للحرق خلال إجراءات محاكم التفتيش، فإن ذلك أيضا لم يكن على نطاق واسع ولم يمسَّ سوى بعض النصوص، لأن ما نتوفر عليه اليوم من أعمال ابن رشد في لغتها الأصلية، العربية، فضلا عن ترجماتها، العبرية واللاتينية، يظهر فساد تلك الدعوى.
أكثر من ذلك، إذا عدنا خمسة وثلاثين عاما إلى الوراء، وافترضنا أن الوضعية التي توجد عليها مؤلفات ابن رشد في أصولها العربية هي تلك التي رصدها جمال الدين العلوي في المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة (البيضاء: توبقال، 1986) وأن الدارسين لم يعثروا على مؤلفات أخرى لابن رشد، فإن ما مجموعه ستون مؤلفا يوجد اليوم مخطوطا ومنشورا لابن رشد. وهذا العدد من المؤلفات يفوق نصف العناوين التي نسبتها كتب الفهارس والتراجم إلى ابن رشد، والتي يبلغ عددها 108 عنوانا؛ علما أن من العناوين ما كان غير صحيح أو كانت نسبته غير صحيحة. وفي كل الأحوال، فإن العدد المذكور من مؤلفات ابن رشد المتوفرة اليوم في أصولها العربية بعيد كل البعد عن ”النزر القليل“ الذي يتحدث عنه أوريد (ولعله لا يعرف من كتب ابن رشد سوى تهافت التهافت، والكشف عن مناهج الأدلة، وفصل المقال، والمناهج العدلية والضميمة، ويعتبر هذين الأخيرين مرفقين بكتاب الفصل). أما المختصون فيعرفون اليوم أن قسما هاما من مؤلفات ابن رشد مفقود ولا مدخل إليه من سوى طريق ترجماته اللاتينية أو العبرية أو من كليهما، وقد ترجم أغلبها إلى الإنجليزية، كما هو الشأن بالنسبة لمختصر سياسة أفلاطون، وتلخيص السماع الطبيعي وشرحه، وشرح كتاب النفس… لكن هذا لا يسمح لنا بالقول بأن ما هو متاح اليوم من نتاج الرجل قليل، ناهيك عن وصفه بـ”النزر القليل“. ولست أتوقع أن يخفى على أوريد، وهو الكاتب الروائي، أن معنى ”النزر“ في كلام العرب هو ”القليل التافه من كل شيء.“ هذا، ويجدر بنا أن نذكر أن عدد المؤلفات التي تتوفر بالعربية لابن رشد في تنامٍ، حيث حصل اكتشاف الضروري في أصول الفقه، والضروري في النحو، وشرح عقيدة المهدي.
ثم إن وجود هذا العدد من المؤلفات لابن رشد في أصولها العربية هو دليل على فساد الادعاء بأن أغلب أعماله قد أحرق من قبل المسلمين أو من غيرهم. وفي الواقع، فقد شاع بين دوائر الجمهور أن غالبية أعمال ابن رشد قد أحرقت خلال نكبته أو بعدها، من قبل أبناء عصره، مع أن من يقول بهذا لا يورد مصدرا تاريخيا موثوقا لهذه القصة غير فيلم يوسف شاهين ورواية متأخرة للذهبي في سير أعلام النبلاء. إلا أن المختصين يعرفون أن عملية الإحراق، حتى لو فُرض وقوعها، فقد كانت محدودة جدًّا، ولم تحل دون انتشار أعمال ابن رشد في لغتها الأصلية ورواجها في حياته وبعد وفاته. والدليل على ما نقول هو أن أعماله قد نُسخت بالعربية قبل أن تترجم بعد وفاته بأكثر من عشرين عاما. أما إن ذهبنا مذهب أوريد في القول بالحرق، فأي أصل—ليت شعري—اعتمده التراجمة اللاتين والعبرانيون في ترجماتهم؛ والحال أن عملية الترجمة من العربية قد امتدت، في مرحلتها الأولى، خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر؟ الأقرب إلينا أن ضياع نصوص لابن رشد لم يكن نتيجة عملية حرق من قبل المسلمين، وأن هذه العملية ”السياسية،“ إن صدقنا رواية الذهبي، كانت رمزية وقد كانت محدودة الأثر في كل الأحوال. ويدعم هذا ما وقف عليه محمد بن شريفة (ت. 2018م)، حيث يقول: ”تداول [الناس] كتب ابن رشد في عصره وبعد عصره بالأندلس وبلاد المغرب، ولاشك أن عددا منها ضاع خلال إخراج المسلمين من قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية، ولم يسلم من التلف إلا ما وجد بمملكة غرناطة أو نقل إلى بلاد المغرب، وقد كان بعض هذه المخطوطات موجودا في المكتبات المغربية كمكتبة زيدان السعدي الموجودة في الإسكوريال ومكتبة القرويين […] والمكتبة الأحمدية.“[2] لهذا، ”يبدو أن ما قيل عن إحراق مؤلفات ابن رشد ليس صحيحا أو أنه لا يؤخذ على عمومه، ومما يدل على ذلك مسارد هذه المؤلفات التي ذكرت في البرنامج الذي وضعه أبو العباس يحيى حفيد أبي الوليد، وفي الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي وفي عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة نقلا عن أبي مروان الباجي الإشبيلي. ومما يدل على ذلك [أيضا] النسخ الخطية في عدد من المكتبات في الشرق والغرب، ومنها ما يرقى إلى عصر ابن رشد أو يقرب من عصره.“[3] وبالمناسبة، فإن عمل محمد بن شريفة، ابن رشد الحفيد: سيرة وثائقية، يظل من أهم الدراسات عن ابن رشد في سياقه، وربما هو أهمها إلى الآن. ومع ذلك فهو غائب عن أفق حسن أوريد.
- ”المناهج العدلية“: كتاب جديد لابن رشد؟
يقول أوريد: ”أهم كتبه [ابن رشد] هو فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من اتصال. ماذا يقول ابن رشد في هذا المؤلف الذي ضمنه رؤاه ويكاد أن يوجزها؟ يتكون الكتاب من متن، وهو ”الفصل“، ومرفقين هما ”الضميمة“ ثم ”المناهج العدلية“، وقلما يشار إلى هذين المرفقين.“ (ص. 32). هذا مع أن أوريد يذكر الكشف عن مناهج الأدلة ضمن كتب ابن رشد في بداية مقالته. (ص. 29).
ما هي الأحكام التي تتضمنها هذه الفقرة؟
- فصل المقال، حسب أوريد، هو ”أهم كتب“ ابن رشد؛
- فصل المقال، حسب أوريد، هو كتاب يكاد يوجز رؤى ابن رشد؛
- يتكون كتاب فصل المقال، وهو الفصل، من متن ومن مرفقين هما الضميمة ثم المناهج العدلية؛
- حسب أوريد، قلما يشار إلى الضميمة والمناهج العدلية من قبل الدارسين.
لن نجادل حسن أوريد في تقديمه فصل المقال على أنه أهم كتبه؛ وذلك لأننا نعتبره كتابا مهما فعلا، وخاصة إذا نظرنا إلى سياق تأليفه والغرض منه؛ لكنه بعيد عن أن يكون أهم كتب الفيلسوف؛ وهذا أمر يعرفه المختصون في فلسفة ابن رشد. لذلك، فإن القول بأن ”أهم كتب [ابن رشد] هو فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من اتصال“ (ص. 32) لا يخلو من مبالغة وانطباعية، لا يمكن التخلص منهما إلا بعد بذل جهد للاطلاع على بقية كتب ابن رشد. ومن هذه الجهة أيضا، فالكتاب لا يوجز إلا طرفا من رؤى الفيلسوف وليس كل رؤاه؛ وذلك أن حجمه الصغير مقارنه بالأعمال الكبرى لابن رشد لا تسمح له بذلك.
إلى ما سبق، نضيف أن حديث أوريد عن أن كتاب فصل المقال يتكون من متن ومن مرفقين هو حديث عام وغير دقيق؛ وإلا فإن الفصل كتاب مستقل بنفسه، كما أن مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات، المسماة خطأً بـالضميمة، تأليف مستقل بنفسه أيضا، تماما كما أن فصل المقال لا يتضمن أي كتاب يسمى المناهج العدلية. والأقرب أن يقول حسن أوريد إن النشرة الحديثة التي كانت بيده هي التي تتضمن هذه الأعمال الثلاثة المشار إليها.
أما حديث أوريد عن كتاب لابن رشد بعنوان المناهج العدلية، فهو، باختصار، من المنكرات. ويظهر أن الأمر لا يتعلق بخطأ مطبعي أو سهو، وإنما بكتاب آخر يعتقد أوريد في وجوده؛ وهو غير الكشف عن مناهج الأدلة، لأن أوريد يحيل، في موضع سابق من مقالته (ص. 29)، على هذا الكتاب الأخير باسمه المعروف: الكشف عن مناهج الأدلة. ثم إن الدليل على أنه لا يقصد الكشف عن مناهج الأدلة هو أنه عندما ذكر المناهج العدلية استطرد قائلا بأنه قلما يشار إليه، بينما لم يفعل عندما ذكر الكشف عن مناهج الأدلة. ويمكن للمرء أن يجزم، وهو مطمئن، أن أوريد لم يكن دقيقا عندما قال: إن المناهج العدلية قلما يشار إليه، إذ الصحيح أن يقول: إنه لا يشار إليه بالمرة؛ وذلك لسبب وحيد وهو أن هذا العنوان لا وجود له إلا في وهم أوريد.
ولا يرشد حسن أوريد قارئَه إلى مصدره في الحديث عن هذا الكتاب الجديد لابن رشد؛ ويظهر أنه كان على درجة من الاطمئنان بحيث لم يكن في حاجة إلى توثيق كلامه. غير أن الأقرب عندنا أن حسن أوريد لم يطلع على مضمون الكشف عن مناهج الأدلة ولا على مضمون ما اعتقد أنه المناهج العدلية، لأن من شأن ذلك الاطلاع أن ينجيه من السقوط في مثل هذه الطوام التي هي مدعاة للأسى والأسف على مصير الدراسات الرشدية المغربية عندما يتولاها غير المختصين.
وإلى ذلك، فإن حديث أوريد عن الضميمة بأنه قلما يشار إليه من قبل الدارسين يظل كلاما لا يخلو من انطباعية المبتدئين في مجال ما، ويشبه كثيرا كلام طلبة الإجازة، وهم يقبلون على إنجاز مشاريع بحوثهم، فتجدهم يحكمون بأن موضوعهم غير مطروق والمراجع فيه نادرة؛ والحال أن الاطلاع على ما أُلف في الموضوع، وهو غير قليل، كفيل بأن يجعل المرء يتردد كثيرا قبل الحكم. شخصيا، اطلعتُ على دراسات عدة في موضوع العلم الإلهي عند ابن رشد، وما تجاهلَ أصحابُها المواضعَ التي عالج فيها ابن رشد مسألة العلم الإلهي، ومنها مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات، المشهورة خطأً، كما قلنا، بـالضميمة (انظر دراسات ريتشارد تايلور، وآن تيريز دْرويارْت على سبيل التمثيل لا الحصر).
- من ابن رشد إلى ابن خلدون: السند العلمي والتقويل عند أوريد
عندما أحصى الراحل محمد ابن شريفة (ت. 2018م) حوالي أربعين تلميذا لابن رشد ما كان ليخطر بباله أنه قد ذهل عن أحد أهم تلاميذ أبي الوليد، الذي صيّره حسن أوريد، بجرة قلم سحرية، الواسطة بينه وابن خلدون. إنه حدث القرن بالنسبة للدراسات الرشدية!
يقول أوريد:
هل يمكن أن نفهم ابن خلدون من دون أن نربطه بهذه الحلقة وما يعرض للعمران من تقلب الأحوال؟ يسعفنا الونشريسي في موسوعته المعيار كي نقف على أوجه القرابة ما بين ابن رشد، أو على الأصح كتاب جوامع فلسفة أفلاطون ومقدمة ابن خلدون، ذلك أنه كان من تلامذة ابن رشد الفقيه الحسني التلمساني، وقد قال عنه الونشريسي، من أنه ’كان فارس المعقول والمنقول‘. والذي يهمنا أن من تلامذة الفقيه الحسني العلامة الآبلي، من كان معلما لابن خلدون. ويضيف الونشريسي أن الآبلي أخذ عن الحسني التلمساني كثيرا من كتاب الشفاء لابن سينا، وتلاخيص كتب أرسطو لابن رشد. علاقة القرابة قائمة بين ما وضعه ابن رشد في الجوامع وما سيفصل ابن خلدون [فيه] القول في المقدمة. (ص. 37)
وفي الحقيقة، يحار المرء أمام هذه الأقوال التي توحي بأننا أمام سرد تخييلي يمكن للروائي أن يقول فيه ما يشاء، ويتحلل، في بنائه لأحداث عمله، من كل ضابط تاريخي (وأنا أقرأ هذا الكلام تذكرت سرديات سلمان رشدي الذي جعل ابن رشد يُعاشر جنية فائقة الجمال! وجاك أتالي الذي تخيل ابن رشد يلتقي موسى ابن ميمون!):
- فقد أحصى أوريد الفقيه الحسني التلمساني من تلامذة ابن رشد؛
- وجعل أوريد الفقيه الحسني أستاذ العلامة أبي عبد الله الآبلي (ت. 757هـ/1356م)؛
- وجعل الآبلي يأخذ عن الحسني التلمساني كثيرا من كتاب الشفاء لابن سينا، وتلاخيص كتب أرسطو لابن رشد؛
قلب أوريد، في أقواله أعلاه، المعلومات التاريخية الواردة عند أبي العباس الونشريسي (ت. 914هـ/1509م) رأسا على عقب، مُقَوّلا إياه ما لم يقل.
ويظهر ذلك مما يلي:
* فقد توفي ابن رشد عام 595هـ/1198م، وتوفي الفقيه أبو عبد الله محمد الشريف الحسني التلمساني عام 771هـ/ 1370م مما يعني أن أكثر من 170 سنة تفصل بينهما؛ فكيف يكون الحسني التلمساني تلميذا لابن رشد؟ وكيف تصبح علاقة القرابة قائمة بين ما وضعه ابن رشد في جوامع سياسة أفلاطون وما وضعه ابن خلدون (ت. 808هـ/1406م) في المقدمة؟
* بالعودة إلى الونشريسي، يتضح أن عائقا ما (ربما يكون التسرع) قد حال دون أن يتبين أوريد الأستاذ من التلميذ، فصيّر، بجرة قلم بهلوانية، التلميذَ أستاذًا والأستاذَ تلميذًا. فالصواب، تاريخيا، هو أن الشريف الحسني التلمساني كان أحد تلامذة أبي عبد الله الآبلي، وليس أستاذا له. والصواب، أيضا، أن الآبلي قد درّس الشريف التلمساني كثيرا من كتاب الشفاء لابن سينا، وتلاخيص كتب أرسطو لابن رشد. ومن هنا، فإذا كان السند متصلا بين الآبلي وابن خلدون، لأن هذا الأخير تلميذ الأول في المنطق وفي سائر العلوم الحكمية،[4] فإنه يظل ”منقطعا،“ إلى حد الآن، بين ابن رشد وابن خلدون. فقد كان الأولى بأوريد أن يبحث عن شيوخ الآبلي وشيوخ شيوخه، وصولا إلى ابن رشد، لا أن يغامر بتنصيب الحسني التلمساني تلميذا لابن رشد، وهو الذي عاش ما يقرب من قرنين من الزمان بعد وفاة هذا الأخير. ونقرأ عند الونشريسي:
قلت: وكان هذا الشيخ رحمه الله فارس المعقول والمنقول، وصاحب الفروع والأصول، يعرف بالعلوي نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان تسمى العلويين. قال ابن خلدون: وكان أهل بيته لا يدافعون في نسبهم، وربما تعرض بعض الفجرة ممن لا يزعه دينه ولا معرفة له بالأنساب، فيعد من اللغو لا يلتفت إليه: نشأ هذا الرجل بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها، واختص بأولاد الإمام، وتفقه عليهما في الفقه والأصول والكلام، ثم لزم شيخنا أبا عبد الله الآبلي وتضلع في معارفه، فاستبحر وتفجرت ينابيع العلوم من مداركه […]، وقرأ عليه كثيرا من كتاب الشفاء لابن سينا، ومن تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد في الحساب والهندسة والهيئة والفرائض.[5]
ويظهر أن معرفة أوريد بالونشريسي وبابن خلدون لم تؤهله إلى أن يتعرف على مصدر الونشريسي بخصوص سيرة الشريف الحسني التلمساني. فالحقيقة أن الونشريسي لم يعمل، في مجموع النص أعلاه، سوى على نقل التعريف الذي خص به ابن خلدون الشخص نفسه في عمله. وهذا هو قول ابن خلدون كما ورد في نشرته المعروفة:
ومنهم صاحبنا الإمام العالم الفذ، فارس المعقول والمنقول، صاحب الفروع والأصول، أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني، ويعرف بالعلوي، نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان، تسمى العلوين؛ وكان أهل بيته لا يدافعون في نسبهم، وربما يغمز فيه بعض الفجرة ممن لا يزعه دينه ولا معرفته بالأنساب، فيعد من اللغو، ولا يلتفت إليه. نشأ هذا الرجل بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها، واختص بأولاد الإمام، وتفقه عليهما في الفقه والأصول والكلام، ثم لزم شيخنا أبا عبد الله الآبلي وتضلع في معارفه، فاستبحر وتفجرت ينابيع العلوم من مداركه؛ […] وقرأ عليه كثيرا من كتاب الشفاء لابن سينا، ومن تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد، ومن الحساب والهندسة والهيئة والفرائض.[6] [والتشديد منا]
وعليه، فأقصى ما يمكن أن نقول بخصوص الموضوع الذي أثاره أوريد، هو أن الشريف الحسني التلمساني كان مطلعا على أعمال ابن رشد الفلسفية؛ والفضل في ذلك يعود لشيخه الآبلي. والمعروف أن الآبلي قد درس علوم المعقولات عند ابن البنا المراكشي (ت. 721هـ/1321م).
- مسألة منهجية
يجدر بنا أن نشير، أخيرا، إلى أنه من غير المستساغ معرفيا ومنهجيا استعمال اقتباسات مترجمة إلى العربية بينما هي متوفرة في أصولها العربية. كما أنه من غير المستساغ، أيضا، التصرف في الاقتباسات بالحذف والإضافة دون استعمال الرموز والعلامات الدالة، دوليا، على ذلك. فقد عمد أوريد إلى الاستشهاد بفقرة شهيرة جدا لابن الصلاح الشهرزوري (ت. 643هـ/1245م) عن الفلسفة والمنطق مكتفيا باستعمال صيغتها المترجمة إلى العربية؛ والحال أن مصدر الفقرة معروف وسهل المأخذ. وقد أدى ذلك إلى تحريف وبتر في الفكرة التي يحملها النص الأصلي. تقول الفقرة المترجمة التي اقتبسها أوريد: ”إن الفلسفة وهي قاعدة عدم الحيطة والتجوز [كذا]، عنصر من عناصر الحرج والحيرة، وتقود إلى الكفر. والذي يشتغل بها يحرم رؤيته فضائل الشريعة، والذي يتخذها أداة يضيع، ويصير من أتباع الشيطان. إن المنطق هو مدخل الفلسفة والذي يأتي بالشر هو نفسه شر“ (ص. 33). أما النص الأصلي لابن الصلاح، فيقول: ”الفلسفة رأس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثال الزيع والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة، ومن تلبس بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان […] وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر.“[7] وفضلا عن فساد الترجمة وإخلالها بأقوال ابن الصلاح، فإن أوريد لم يكلف نفسه باستعمال ما هو متعارف عليه من علامات للإخبار بالحذف من الاقتباس.
وكما تصرف أوريد في نص ابن الصلاح، كذلك فعل في نصوص أخرى لابن رشد ولعبد الحق ابن سبعين (ت. 669هـ/1269م)، اقتبسها وتصرف فيها دون أدنى إشارة إلى ذلك (انظر: ص. 32، العمود الثاني، ص. 37، العمودان الأول والثاني). ومثال ما مس أقوال ابن رشد المقتبسة من تحريف وسقط ما نقرأه في مقالة أوريد: ”هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق، على جهة النظر الشرعي [كذا]، مباح بالشرع، أم مأمور به، إما على جهة الندب، وإما على جهة الوجوب؟“ (ص. 32، العمود الأول). أما ابن رشد فيقول إن غرضه في الفصل أن نفحص ”على جهة النظر الشرعي، هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محظور أم مأمور به، إما على جهة الندب أو على جهة الوجوب.“[8]
وأخيرا، فإننا مضطرون إلى أن نلفت انتباه أوريد إلى أمر، يعرفه الناس، مهتمين ومختصين، وهو أن ما قام به ابن رشد، في ما أخرجه الجابري بعنوان الضروري في السياسة أو جوامع سياسة أفلاطون، ليس ترجمةً أنجزها ابن رشد لعمل أفلاطون، وإنما هو اختصار أو تلخيص للنص العربي الذي كان بين يديه، وغالبا لم يكن نص أفلاطون نفسه. ولذلك، فليس من الصواب في شيء الادعاء بأن ”الإقبال [من قبل ابن رشد] على ترجمة [كذا] كتاب أفلاطون هو ذريعة لنقد واقع الحال“ (ص. 36). أتصور أن أوريد يعرف الفرق بين الترجمة والتلخيص أو الاختصار، وهما من أجناس الكتابة التي مارسها ابن رشد، ويعرف جيدا أن ابن رشد لم يترجم، لأنه لا يعرف اليونانية، وهو أمر ما فتئ أوريد وصاحبه العروسي يؤكدان على وجوب العلم به.
خاتمة
لا نرى أي حرج في أن يكتب دَارس في مجال بحثي بعيد قليلا عن مجال خبرته؛ بل نعتبره، من الناحية المبدئية، أمرًا مرحبًا به، بالنظر إلى فوائده على الدارس نفسه وعلى تقدم المعارف وتفاعل أصحابها. كما لا نرى أي مشكل في أن ينشر صحافيون مقالات شبه علمية أو فكرية، بل نعتبر ذلك أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لعموم الناس. إن المشكل، في تقديرنا، لا يكمن في ما إن كان هؤلاء الذين أعدوا الملف عن ابن رشد، وعلى رأسهم حسن أوريد، متخصصين أو أنهم خرجوا عن مجال اختصاصاتهم إلى اختصاصات غيرهم، أو أنهم صحافيون، وإنما المشكل الحقيقي هو هل يملك هؤلاء ما يلزم من العدة المنهجية والمعرفية الضرورية للخوض في هذا الموضوع مع احترام الحد الأدنى من الدقة والوثاقة والفائدة. والواقع أن أغلب أصحاب تلك المواد ليسوا متخصصين في تاريخ الأفكار الفلسفية والعلمية في السياقات الإسلامية ولا في ابن رشد ولا في ابن سينا… ولا في التاريخ بشكل عام، ولا هم صحافيون محترفون في تأليف مقالات للنشر في المجلات المصورة les magazines. فأن تكون متخصصا في الجماليات لا يؤهلك، بالمرة، أن تتحدث حديثا مفيدا في نظرية وحدة الحقيقة عند ابن رشد… وأن تكون وهابيا سابقا وباحثا في الدراسات الإسلامية لا يؤهلك، قطعًا، أن تقول قولا نافعا في ابن رشد ولا في مفهوم الباطن عند ابن تيمية…وأن تكون مؤرخ المملكة السابق، لا يؤهلك، نهائيا، أن تفهم نصوص ابن رشد ولا أن تقرأ عناوين كتبه على نحو سليم. ومع ذلك، لك أن تدلي بقولك في ابن رشد، إن شئت؛ لكن تذكر جيدا أن أقوال العقلاء منزهة عن العبث.
للتوثيق
بن أحمد، فؤاد. ”عن ابن رشد وما لا نعرفه عنه: في الرد على حسن أوريد ومن معه.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2959>
فؤاد بن أحمد
[1] انظر: أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، الفرق 1944. انظر: https://al-maktaba.org/book/1736/483؛ روجع بتاريخ 20 غشت 2021.
[2] محمد بن شريفة، ابن رشد الحفيد: سيرة وثائقية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1999)، 279.
[3] بن شريفة، ابن رشد الحفيد، 274.
[4] انظر: عبد الرحمن ابن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي (بيروت: دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، 1979)، 23، 38، 57.
[5] أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أخرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي (الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، 1981)، ج. 12، 224–225.
[6] انظر: ابن خلدون، التعريف، 65.
[7] أبو عمرو عثمان صلاح الدين الشهرزوري، فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، ومعه أدب المفتي والمستفتي، حققه وخرج حديثه وعلق عليه عبد المعطي آمين قلعجي (بيروت: دار المعرفة، 1986)، ج. 1، 210.
[8] محمد بن أحمد بن رشد، كتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تحقيق جورج فضلو الحوراني (ليدن: بريل، 1959)، 1.
مقالات ذات صلة
قراءة نقديّة: موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (557هـ-629هـ). ما بعد الطبيعة. قدم له وحققه يونس أجعون. بيروت: دار الكتب العلمية، 2017.
Muwaffaq al-Dīn ʿAbd al-Laṭīf Ibn Yūsuf al-Baghdādī (557-629). Mā ba ʿda al-ṭabī ʿah [Metaphysics]. Edited by Yūnus Ajʿūn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2017. ISBN: 978-2-7451-8878-6 Fouad Ben AhmedQarawiyyin University-Rabatموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي...
قصّة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر الله في رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان. الجيزة: بوك ڤاليو، 2021
Review of Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham by Yusuf Zaydān. Giza: Book Value, 2021. ISBN-10. 9778582106 Qiṣṣat Ibn al-Haytham maʿa al-Ḥākim bi Amri al-LāhFī riwāyat Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham قصة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر اللهفي رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان....
الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة: مراجعة نقدية للترجمة العربية
The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī by Ayman Shehadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut: Mominoun Without Borders, 2020. Al-Akhlāqiyāt al-ghāʾiyya ʿinda Fakhr al-Dīn al-Rāzī Li Ayman Shihadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut:...
نصّان في الأشعريّة التقليديّة: إشكالُ القيمة والأبعادُ الفيلولوجيّة والمعرفيّة
نصّان في الأشعَريّة التّقلِيديّة:إشْكَال القِيمَة والأبعادُ الفِيلولوجِية والمعرِفيّة Naṣṣani fī al-Ashʿariyya al-taqlīdiyya:Ishkāl al-qīma wa-l-abʿād al-fīlūlūjiyya wa-l-maʿrifiyya محمد الرّاضي[1]جامعة عبد الملك السعدي-تطوان ملخص تميزت نصوص المتكلمين المتقدمين في...
الفكر العلمي والثقافة الإسلامية لبناصر البعزّاتي
مقدمة يظهر أن استئناس الدارس المغربي بناصر البعزّاتي بالمسائل العلمية والتاريخية التي يثيرها الفكر العلمي والفلسفي المعاصر قد مكنه من مقاربة الثقافة الإسلامية العالمة بترسانة من المفاهيم والآليات والأدوات، فجاءت قراءته لمكونات هذه الثقافة موازية لـقراءته لتاريخ...
مصير العلوم العقلية في الغرب الإسلامي ما بعد ابن رشد
ملخص بعد النقد العنيف الذي وجهه الغزالي للفلاسفة، حصل تعديل في المسار العام للفلسفة في المشرق الإسلامي، وغَلَبَ نوع من التأليف الذي يمزج بين الكلام والفلسفة؛ أما في الغرب الإسلامي، فقد ازدهر القول الفلسفي بعد التهافت، لكن بعد موت ابن رشد، لن نشهد فلاسفة موسوعيين كبار،...
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين فؤاد بن أحمد[1] جامعة القرويين تمهيد ولد الفيلسوف والطبيب والمؤرخ والرحالة موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبي العز يوسف البغدادي، المشهور بابن اللّباد، في بغداد العام 557هـ/1162م، وتوفي...
عن تمثيلات واستعارات ابن رشد
قراءة نقدية في كتاب فؤاد بن أحمد، تمثيلات واستعارات ابن رشد: من منطق البرهان إلى منطق الخطابة. بيروت-الرباط-الجزائر: منشورات ضفاف-دار الأمان-منشورات الاختلاف، 2012. محمد الولي[1] كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ سايس - فاس 1. حول المعنى الحرفي. حينما نتوخى التعبير عن...
الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري گوتاس: قراءة نقدية في الترجمة العربية
ملخص صدر كتاب ديمتري گوتاس، الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية العربية في بغداد وفي المجتمع العباسي المبكر (القرن الثاني-الرابع للهجرة/القرن الثامن-العاشر للميلاد)، عام 1998. وقد صار اليوم من المراجع الكلاسيكية في الموضوع. وقد انتبه الدارسون مبكرا...


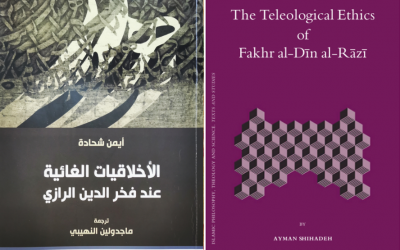

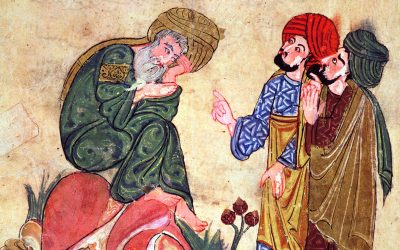



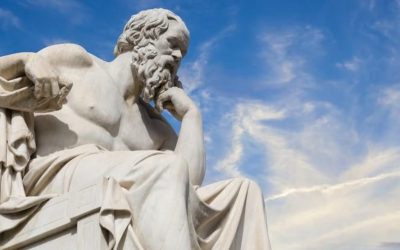
شكرا جزيلا