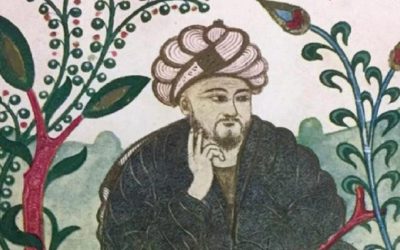![]()
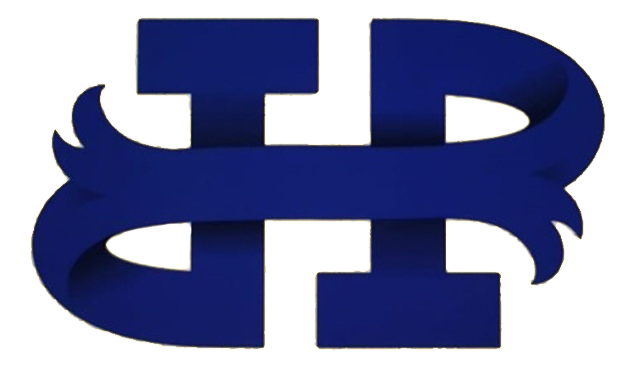
اعتبارات الماهية: الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي

Iʿtibārāt al-Māhiyah:
al-Ibdāʿ al-Sīnawī, wa Ibtikār al-Mudarris al-Zanūzī
اعتبارات الماهيّة:
الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي
رامين عزيزي وجهنكير مسعودي
جامعة فردوسي، مشهد
ترجمها عن الفارسية الهواري بن بوزيان
جامعة المصطفى العالمية، قم
benbouzianereda@gmail.com
ملخص: للماهية في سياقات الفلسفة الإسلامية أحكام متعددة، من تلك الأحكام اعتبارات الماهية، من خلال البحث عن اعتبارات الماهية نصادف ثلاث مفردات مفتاحية كانت العلاقة بينها محل خلاف بين الفلاسفة، هذه المفردات هي: ”الكلي الطبيعي“، ”الماهية من حيث هي هي“، و”اعتبار لا بشرط“، هناك نظريتان مشهورتان بين الفلاسفة في نسبة وعلاقة هذه المفاهيم الثلاثة، يعتقد أنصار النّظرية الأولى أنّ الكلي الطبيعي والماهية من حيث هي هي منطبقان على اعتبار اللابشرط المقسمي، هذا الاتجاه قائل باعتبار اللابشرط المقسمي، ولذا فإنّ الاعتبارات عند هؤلاء أربعة، هذا هو الرأي المشهور لدى الحكماء والفلاسفة، النّظرية الثّانية تشترك مع النّظرية الأولى في أنّ الكلّي الطبيعي هو عين الماهية من حيث هي هي، إلّا أنّه وبخلاف النّظرية الأولى، يعتقد أنصار الاتجاه الثاني بأنّ هذين المفهومين الكلّي الطبيعي والماهية من حيث هي هي هما نفس اعتبار اللابشرط القسمي، لذا فاعتبارات الماهية عند هؤلاء تنحصر في ثلاثة اعتبارات، ولا عبرة عندهم باعتبار اللابشرط المقسمي. وابن سينا (ت.427هـ/1037م) من القائلين بالنظرية الثانية؛ وفي مقابل ذلك ينتقد بشكل واضح علي الزنوزي (ت.1307هـ/1890م) أحد أبرز الممثلين للاتجاه الثالث النّظرية الأولى والثانية، يعتقد الزنوزي أنّ كلتا النظريتين تحتاج إلى تتميم، إنّ النظر الذي أبداه علي الزنوزي يعبر عن مرحلة من النضج وصلت إليها نظرية اعتبارات الماهية، فقد أوصل علي الزنوزي اعتبارات الماهية إلى خمس اعتبارات، في الواقع إنّ مباني علي الزنوزي في باب اعتبارات الماهية ستمكننا من تحليل مسائل من قبيل الحمل الأولي والشائع، اعتبارات ذات الحق وغير ذلك من المسائل بشكل أحسن.
الكلمات المفتاحية: الماهية، اعتبارات الماهية، الكلي الطبيعي، الحكمة المتعالية، ابن سينا، على الزنوزي.
البحث
المعروف أن الفارابي (ت.339هـ/950م) وابن سينا أوّل من فككا بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، لم يتوسع الفارابي كثيرا في هذا المجال بخلاف ابن سينا، مع ذلك يعود فضل التأسيس للفارابي فهو أوّل من ميز بين المفهومين،[1] أمّا ابن سينا فبالإضافة إلى أنّه بسط الكلام في هذا المقام فقد تعرض لجملة من تطبيقاته المتعددة في نظامه الفلسفي.[2]
واحدة من ثمرات ولوازم البحث في تمايز الوجود والماهية، مبحث اعتبارات الماهية، فإنّه بعد التفكيك والتمييز بين الوجود والماهية، والإقرار بالمغايرة بينهما يأتي البحث في نسبة أحدهما إلى الآخر، فالماهية إمّا أن تؤخذ بشرط الوجود العيني أو الوجود الذهني أو تلحظ من دون الالتفات إلى الوجود ومع قطع النظر عن الغير، بحيث تكون الماهية من حيث هي موضوعا لجملة من الأحكام، إذن البحث في اعتبارات الماهية من فروع التفكيك والتمييز بين الوجود والماهية، وأحد أهم ثمار القول بالتغاير.
لقد فهم ابن سينا لوازم المسألة وأشار إليها في كتبه، كما تعرض الفلاسفة المسلمون بعد ابن سينا للمسألة في سياق البحث عن الماهية ولواحقها حيث أبدوا آراءهم وأنظارهم.
في سياق البحث عن اعتبارات الماهية ومن خلال النصوص الفلسفية التي بحوزتنا يظهر جليا ثلاثة مفاهيم مفتاحية، إنّ علاقة هذه المفاهيم ونسبتها إلى بعضها تعتبر بحق معركة الآراء بين الفلاسفة، هذه المفاهيم هي: مفهوم الكلي الطبيعي، مفهوم الماهية من حيث هي هي، ومفهوم اللابشرط المقسمي.
بداية النزاع كانت حول تحديد نحو العلاقة بين هذه المفاهيم الثلاثة، بأن يقال: الكلي الطبيعي يطابق أي اعتبار من الاعتبارات؟ ما هو المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة؟ الماهية من حيث هي هي تطابق أيا من اعتبارات الماهية؟
أشهر النّظريات في علاقة هذه المفاهيم الثلاثة هي كالتالي:
1. تعتقد المجموعة الأولى أن الكلي الطبيعي هو بعينه الماهية من حيث هي هي، ويطابق اعتبار اللابشرط المقسمي، بحسب هؤلاء فإنّ للماهية أربعة اعتبارات فإنّ اعتبار اللا بشرط المقسمي اعتبار من اعتبارات الماهية عندهم، هذا الرأي هو القول المشهور للحكماء والفلاسفة، نجد ذلك جليا عند ملا صدرا (ت.1050هـ/1640م)، يعتقد صدر الدين أنّه بالإمكان أخذ الماهية مع قطع النظر عن كل قيد حتى قيد الإطلاق، فإنّه لا ينبغي الخلط بين الماهية المقيدة بقيد الإطلاق وبين الماهية المطلقة من كلّ قيد حتى قيد الإطلاق، فإنّ الماهية بهذا الإطلاق هي الكلي الطبيعي الموجود بوجود أشخاصه.[3]
وبهذا الخصوص يقول العلامة (ت،1402هـ/1981م): المقسم لاعتبارات الماهية الثلاثة هو الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط واللابشرط المقسمي اعتبار موجود في الخارج بواسطة وجود بعض أقسامه وهي الماهية المخلوطة.[4]
2. المجموعة الثانية كالأولى تعتقد أنّ الكلي الطبيعي هو بعينه الماهية من حيث هي هي، لكن بخلاف ذلك يعتقد هؤلاء أنّ الكلي الطبيعي هو اعتبار الماهية لا بشرط القسمي، لا يعتقد هؤلاء بوجود مقسما للأقسام من الأساس، وبالتالي تنحصر الاعتبارات عندهم في ثلاث اعتبارات، المؤيدون لهذه النظرية من المتقدمين نصير الدين الطوسي (ت.672هـ/1274م)،[5] فياض اللاهيجي (ت. 1051هـ/1641م)[6] ومن المعاصرين مصباح اليزدي (ت.1443هـ/2021م).[7]
في بداية هذا التحقيق سنشرع في بيان نظر الشيخ الرئيس حول اعتبارات الماهية، وتحديد مركزية هذه المسألة في نسقه الفلسفي، ليتضح في الأخير إلى أي مجموعة ينتسب الشيخ، بعد ذلك سنتعرض لنظرية على الزنوزي في هذا الباب، نبحث في لوازم ووجه امتياز نظريته عن القولين المشهورين وبالخصوص عن رأي الشيخ.
ابن سينا واعتبارات الماهية
لقد تعرض الشيخ في موضعين من إلهيات الشفاء إلى اعتبارين متغايرين للماهية، قال الشيخ: ”إنّ ههنا شيئا محسوسا هو الحيوان أو الإنسان مع مادة وعوارض، وهذا هو الإنسان الطبيعي، وههنا شيء هو الحيوان أو الإنسان منظورا إلى ذاته بما هو هو، غير مأخوذ معه ما خالطه، وغير مشترط فيه شرط أنه عام أو خاص أو واحد أو كثير لا بالفعل ولا بالقوة أيضا من حيث هو بالقوة، إذ الحيوان بما هو حيوان، والإنسان بما هو إنسان أي باعتبار حده ومعناه، غير ملتفت إلى أمور أخرى تقارنه، ليس إلّا حيوانا أو إنسانا، وأمّا الحيوان العام والحيوان الشخصي والحيوان من جهة اعتبار أنّه بالقوة، عام أو خاص، والحيوان باعتبار أنّه موجود في الأعيان أو معقول في النفس، هو حيوان وشيء، وليس هو حيوان منظورا إليه وحده.“[8]
وفقا لهذا النّص، فإنّ الماهية إمّا أن تلحظ بشرط وجود العوارض الخارجية وإمّا أن تلحظ بما هي هي. الحيوان بما هو حيوان والإنسان بما هو إنسان في هذا الاعتبار لم يؤخذ معه شيء مغاير للحيوان والإنسان.
هذا هو المراد من اعتبار اللابشرط، أمّا اعتبار الحيوان من جهة أنّه موجود في الأعيان، أو موجود في الأذهان، فهو اعتبار الحيوان مع اعتبار شيء آخر.
في الواقع الحيوان بهذا الاعتبار لم يلحظ لوحده، ولكن أخذ الوجود شرطا معه، إمّا بشرط الوجود الخارجي أو بشرط الوجود الذهني.
هذه العبارة ”والحيوان باعتبار أنّه موجود في الأعيان أو معقول في النفس، هو حيوان وشيء، وليس هو حيوان منظورا إليه وحده“ تشير بشكل واضح إلى هذا التغاير بين اعتبار بشرط شيء واعتبار لا بشرط.
بعد أن تعرض ابن سينا لاعتبارات الماهية في كتابه إلهيات الشفاء، يصرح ولأوّل مرة في مدخل منطق الشفاء بوجود ثلاثة أنحاء من الاعتبارات، حيث يقول: ”وماهيّات الأشياء قد تكون في أعيان الأشياء، وقد تكون في التصور، فيكون لها اعتبارات ثلاثة : 1- اعتبار الماهية بما هي تلك الماهية غير مضافة إلى أحد الوجودين وما يلحقها، من حيث هي كذلك، 2- واعتبار لها من حيث هي في الأعيان، فيلحقها حينئذ أعراض تخص وجودها ذلك، 3- واعتبار لها من حيث هي في التصور، فيلحقها حينئذ أعراض تخص وجودها ذلك، مثل الوضع والحمل، ومثل الكلية والجزئية في الحمل، والذاتية والعرضية في الحمل و[…].“[9]
على الرّغم من أنّ ابن سينا قد تحدّث عن ثلاثة اعتبارات، لكن يبدو أنّه ذكر في هذا النّص اعتبارين من اعتبارات الماهية، الاعتبار الأوّل اعتبار الماهية إمّا بشرط الوجود الخارجي أو بشرط الوجود الذهني والاعتبار الثاني اعتبار الماهية لا بشرط من حيث الوجودان، في بادئ النظر قد يظن أنّ هذا الاعتبار هو اعتبار بشرط لا، والذي يبطل هذا الزعم صريح عبارة الشيخ في أنّ هذا الاعتبار هو اعتبار الماهية بما هي تلك الماهية، لذا فإنّ مراد الشيخ من هذا الاعتبار هو اعتبار لا بشرط، والذي أوقعهم في هذا الزّعم قيد ”غير مضافة إلى أحد الوجودين” ظنا منهم أنّه قيد عدمي والحال أنّه قيد توضيحي أشار به الشيخ إلى إطلاق الماهية، والشّاهد على أنّ هذا الاعتبار هو اعتبار لا بشرط وليس اعتبار بشرط لا ما يذكره الشيخ الرئيس في مواضع أخر من أنّ هناك اعتبارين فقط، اعتبار الماهية بشرط الوجود الخارجي والذهني واعتبار ثان قسيم للاعتبار الأول هو اعتبار الماهية لا بشرط الوجودين، هذا سنتعرض له لاحقا، إذن في هذا الموضع يصرح الشيخ بوجود ثلاثة اعتبارات للماهية إلّا أنّه ذكر اعتبارين منها فقط.
الموضع الآخر الذي يتعرض فيه الشيخ بنحو من الأنحاء للاعتبارات المتعدّدة للماهية عند بيانه للكليات الخمس في مدخل الشفاء، يقول في هذا الصدد: ”إنّ كل واحد من الأمور التي تأتي أمثلة لإحدى هذه الخمس، هو في نفسه شيء، وفي أنه جنس أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام شيء، ولنجعل مثال ذلك من الجنس فنقول: إنّ الحيوان في نفسه معنى، سواء كان موجودا في الأعيان أو متصورا في النفس، وليس في نفسه بعام ولا خاص، ولو كان في نفسه عاما حتى كانت الحيوانية – لأنّها حيوانية – عامّة، لوجب ألّا يكون حيوان شخصيا، بل كان كل حيوان عاما، ولو كان الحيوان – لأنه حيوان – شخصيا أيضا، لما كان يجوز أن يكون إلّا شخصا واحدا، ذلك الشخص الذي تقتضيه الحيوانية، وكان لا يجوز أن يكون شخص آخر حيوانا، بل الحيوان في نفسه شيء يتصور في الذهن حيوان، وبحسب تصوره حيوانا لا يكون إلّا حيوانا فقط.“[10]
بحسب عبارة الشيخ هذه فإنّ اعتبار الماهية من حيث هي اعتبار مطلق من القيد والشرط.
في موضع آخر يتعرض الشيخ لأنحاء اعتبارات الماهية، وذلك في باب المقولات من كتاب منطق الشفاء، يقول في هذا الموضع: ”فإنّ الحيوان بما هو حيوان فقط، بلا شرط تجريد أو غير تجريد، فهو أعم اعتبار من اعتبار الحيوان بشرط التجريد، وذلك لأنّ الحيوان بلا شرط يصلح أن يقرن به شرط التجريد، فيفرض حيوان قد نزع عن الخواص المنوّعة والمشخّصة، ويصلح أن يقرن به شرط الخلط، فيقرن بالخواص المنوّعة والمشخّصة، وأمّا إذا أخذ بشرط التجريد لم يصلح أن يقرن بأحد الشرطين.“[11]
يفهم من عبارة الشيخ هذه أنّه يمكن لحاظ الماهية بلحاظات متعددة، باعتبار لا بشرط، باعتبار بشرط شيء(بشرط الخلط)، وباعتبار بشرط لا( بشرط التجريد)، قد يظن أنّ قول الشيخ ”فهو أعم اعتبار من الاعتبارين الآخرين“ دليل على أنّ مراده من اعتبار اللابشرط، اللابشرط المقسمي، وذلك أنّ اعتبار لابشرط القسمي مباين لبقيّة الأقسام فلا يكون أعم ولا أخص منها، إلّا أنّ هذا الظن مجانب للصواب، في الواقع الإطلاق والتقييد من الأمور النسبية، فإنّ الاعتبارات وإن كانت متباينة مع ذلك أمكن أن تكون النسبة بينها نسبة العموم والخصوص وذلك بالنظر إلى الشروط والقيود التي تؤخذ معها، لأجل ذلك كان اللابشرط القسمي مطلق بالقياس إلى اعتبار بشرط شيء وبشرط لا بالخصوص، بخلاف اللابشرط المقسمي فإن اللابشرط القسمي لا إطلاق له بالقياس إليه.
ذكر ابن سينا في مؤلّفاته في موضعين فقط، جميع الاعتبارات الثلاثة، لا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا، وإن نسب هذه الاعتبارات في كلا الموضعين إلى الوجود الخارجي المعلول، مع ذلك يتضح أن الاعتبارات الثلاثة كانت معلومة لديه، ففي سياق شرحه للواجب والممكن في رسالته الموسومة بعيون الحكمة صرح بوجود اعتبارات ثلاثة للماهية، يقول في الموضع الأول: وكل ذلك إمّا له بذاته وإمّا له بغيره، وما يجب لذاته وجوده فيستحيل أن يكون وجوده يجب بغيره، وينعكس: كل ما يجب وجوده لا عن ذاته فإذا اعتبرت ماهيته بلا شرط لم يجب وجودها وإلّا لكان لذاته واجب الوجود ولم يمتنع وجودها وإلّا لكان ممتنع الوجود لذاته، فلم يوجد ولا عن غيره،فإذن وجوده لذاته ممكن وبشرط لا علّته ممتنع وبشرط علّته واجب، ووجوده لا بشرط علّته غير وجوده بشرط علّته، فبأحدهما هو ممكن وبالآخر واجب.[12]
في هذا النّص تعرّض الشيخ لجميع اعتبارات الماهية الثلاثة، الماهية الممكنة هي الماهية المتصورة مع قطع النظر عن وجود علّتها وعدمها، أي(لا بشرط) عن وجود علّتها وعدمها، فإنّه متى ما لوحظت ذات الماهية خالية من كل قيد فإنها تكون معروضة للإمكان، إذن الماهية الممكنة هي الماهية لا بشرط، وقد تلحظ الماهية بشرط وجود علّتها ( بشرط شيء) فتكون واجبة، فإنّ الماهية تجب بوجوب علّتها وواضح أن المراد من الواجب هنا هو الواجب بالغير، كما تلحظ الماهية بشرط عدم علّتها ( بشرط لا) فتكون ممتنعة.
الموضع الثاني الذي يتعرض فيه ابن سينا للاعتبارات الثلاثة للماهية في رسالته الموسومة برسالة الحدود، ففي سياق تعريفه للمعلول يوظف الشيخ نظرية الاعتبارات الثلاثة للماهية، حيث يقول: ”حد المعلول: هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره، ووجود ذلك الغير ليس من وجوده، ومعنى قولنا، من وجوده غير معنى قولنا مع وجوده، فإنّ معنى قولنا من وجوده هو أن تكون الذات باعتبار نفسها ممكنة الوجود، وإنّما يجب وجودها بالفعل لا من ذاتها بل لأنّ ذاتا أخرى موجودة بالفعل يلزم عنها وجود هذه الذات، ويكون لها في نفسها الإمكان، فيكون لها في نفسها بلا شرط الإمكان، ولها في نفسها بشرط العلّة الوجوب، ولها في نفسها بشرط لا علّة الامتناع.“[13]
في هذه العبارة أيضا وبشكل صريح وكامل يذكر الشيخ جميع الاعتبارات الثلاثة للماهية، إنّ مراد الشيخ من الذات التي وجودها بالفعل من الغير هو نفس ماهية الشيء الموجود.
ومع مراجعة ما ذكرناه على متن الشيخ، يتضح أنّه وعلى الرغم من ذكره في أكثر المواضع اعتبارين للماهية فقط، إلّا أنّ وجود ثلاثة اعتبارات كان أمرا واضحا بالنسبة له، بالإضافة إلى أنه ذكر ذلك بنفسه.
الشيء الوحيد الذي قدمه الفلاسفة الذين جاؤوا بعده، هو التنبيه لاعتبار المقسم لهذه الأقسام الثلاثة، وبالتالي عادت الاعتبارات أربعة [ وذلك بإضافة اللابشرط المقسمي،][14] وإلّا فإنّ ابن سينا هو أول من تعرّض بشكل صريح لوجود ثلاثة اعتبارات للماهية.
إلى هنا تم تحقيق نظر الشيخ بالنسبة لاعتبارات الماهية، نعم النقطة الأكثر أهمية التي أثارها ابن سينا في فلسفته هو ارتباط اعتبارات الماهية ببحث الكلي الطبيعي، وذلك أنّ ابن سينا في موضع الرد على المثل الأفلاطونية من كتاب إلهيات الشفاء، تعرض للاعتبارات الثلاثة فقال: ”ولهذا المعنى يجب أن يكون فرق قائما بين أن نقول: إنّ الحيوان بما هو حيوان مجرد بلا شرط شيء أخر، وبين أن نقول: إنّ الحيوان بما هو حيوان مجرد بشرط لا شيء آخر، ولو كان يجوز أن يكون للحيوان بما هو حيوان مجردا بشرط أن لا يكون شيئا آخر وجود في الأعيان، لكان يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجود في الأعيان، بل الحيوان بشرط لا شيء آخر وجوده في الذهن فقط، وأمّا الحيوان مجردا لا بشرط شيء آخر فله وجود في الأعيان، فإنّه في نفسه وفي حقيقته بلا شرط شيء آخر، وإن كان مع ألف شرط يقارنه من خارج، فالحيوان بمجرد الحيوانية موجود في الأعيان، وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا بل هو الذي في نفسه خال عن الشرائط اللاحقة موجود في الأعيان، وقد اكتنفه من خارج شرائط وأحوال.“[15]
يشير الشيخ هنا إلى أنّ الماهية المتحققة في ضمن الشخص هي الماهية لا بشرط، هذا البحث سيتعرض له الفلاسفة بعده تحت عنوان الكلي الطبيعي، أمّا الشيخ فيعبّر عنه بالطبيعة، في النّص المتقدم يتابع الشيخ قائلا: ”فالحيوان مأخوذا بعوارضه هو الشيء الطبيعي، والمأخوذ بذاته هو الطبيعة.“[16]
إذن يشير الشيخ هنا إلى أنّ الطّبيعة هي نفس الماهية من حيث هي هي، من وجهة نظره لحاظ طبيعة شيء من الأشياء إنّما تتحقق بنحو لا يحمل عليه شيء آخر مغاير لذاته وطبيعته ( الماهية)، ويعبر عنها بالماهية من حيث هي هي.
من جهة أخرى فإنّ الشيخ في مدخل منطق الشفاء في باب الكليات الخمس، وفي الفصل المعنون بـ”فصل في الطبيعي والعقلي والمنطقي“ ذكر أنّ كلّ واحد من الكليات الخمس يمكن تقسيمها إلى الطبيعي والعقلي والمنطقي، مثال ذلك: الجنس يكون طبيعيا وعقليا ومنطقيا، الجنس الطبيعي هو نفس الماهية بما هي، الجنس الطبيعي في نظر ابن سينا هو معروض الجنسية، لأنّ الحيوان من حيث هو حيوان لا يكون جنسا، إلّا بعد حصول اعتبار الجنسية له، هكذا يقول الشيخ: ”بل إنّما تصير جنسا إذا قرن بها اعتبار“ الجنس المنطقي، والجنس المنطقي أمر مجرد، لا تحقق له إلّا في وعاء العقل، وهو الذي يبحث المنطقيون عنه، أمّا الجنس العقلي فهو الجنس الطبيعي في ظرف التصور، فإنّه الموضوع بإضافة اعتبار الجنسية، بعبارة أخرى الجنس العقلي هو الحاصل من تركيب الطبيعي والمنطقي، هذه الاعتبارات الثلاثة تأتي كذلك في النوع والفصل، والعرض العام والعرض الخاص.[17]
إذن إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ كلا من الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص هي الكليّات الخمس، وأنّ كلا منها يمكن تقسيمه إلى الطبيعي والعقلي والمنطقي، فإنّ هذا يعطي أنّ الكلي يكون طبيعيا وعقليا ومنطقيا، من هنا بدأ التأسيس للعلاقة بين الكلي الطبيعي واعتبارات الماهية، العمل الوحيد الذي قام به المحقق الطوسي في هذا المجال هو استبدال عبارة ”الطبيعة“ من كلام الشيخ بعبارة ”الكلي الطبيعي.“[18]
بناء على كل هذه التوضيحات التي تقدمت، لم يعد خافيا إلى أي مجموعة ينتسب الشيخ الرئيس، فإنّه قد ذكرنا أنّ الشيخ يعبّر عن الكلي الطبيعي بالطبيعة، ويعتبرها نفس الماهية من حيث هي، من جهة أخرى فإنّ التحقيق في نظرية اعتبارات الماهية عند الشيخ يعطي نتيجة مفادها أنّ اعتبار اللابشرط المقسمي لم يكن بذلك الوضوح عند ابن سينا، وفي الغالب فإنّ الشيخ لم يشر إلى اللابشرط بوصفه مقسما للاعتبارات الثلاثة، من هنا يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن ابن سينا من أنصار الاتجاه الثاني فهو يعتقد بأنّ الكلي الطبيعي هو بنفسه الماهية بما هي هي، وهو مساوق عنده لاعتبار اللابشرط القسمي.
بعد ابن سينا تعرض جملة من الفلاسفة للمسألة بالبحث والتحقيق تبعا له، منهم المحقق نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد،[19] الفخر الرازي (ت.606هـ/1210م) في مباحثه المشرقية،[20] الكاتبي القزويني (ت.657هـ/1276م) في حكمة العين،[21] وممن تعرض للمسألة قطب الدين الرازي (ت.766هـ/1355م) في شرح الإشارات.[22]
أول من بحث نظرية اعتبارات الماهية بشكل مستقل حيث جعلها من فروع وأحكام الماهية القاضي عضد الدين الإيجي (ت.756هـ/1355م)، في الوقت الذي تعرض فيه الآخرون من جملتهم ابن سينا، الفخر الرازي، المحقق نصير الدين الطوسي، قطب الدين الرازي، وغيرهم لهذا البحث أعني اعتبارات الماهية حيث دعتهم الحاجة إلى ذلك.[23]
يعتبر السيد الداماد (ت.1041هـ/1631م) من جملة أولئك الفلاسفة الذين كان لهم أثر كبير في تطور مسألة اعتبارات الماهية، يبدو أنّ السيد الداماد أول من تعرض وبشكل صريح للاعتبارات الأربعة للماهية، وأشار إلى تمايز صريح بين اللابشرط القسمي واللابشرط المقسمي،[24] بعد ذلك سيصبح القول بالاعتبارات الأربعة للماهية هو الرأي المشهور لدى الحكماء،[25] مع كل ذلك فإنّ الفيلسوف الوحيد الذي قدم نظرا جديدا في المقام هو علي الزنوزي.
المدرّس علي الزنوزي واعتبارات الماهية
ترتبط مسألة اعتبارات الماهية بشكل أساسي ارتباطا وثيقا بمفهوم الإطلاق والتقييد، يرى المدرّس الزنوزي أنّ الإطلاق والتقييد من الأمور النسبية، ولذا يمكن لحاظ كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثة، بشرط لا وبشرط شيء ولابشرط بحسب جميع القيود أو بعض القيود، مثلا بشرط شيء، يمكن أن يلحظ بشرط جميع القيود، أو بشرط بعض القيود، وهكذا بشرط لا، يمكن أن يعتبر بشرط لا عن جميع القيود أو بشرط لا عن بعض من هذه القيود، من هنا قد تختلف هذه القيود سعة وضيقا، بحيث يمكن أن تنطبق جميع هذه الاعتبارات الثلاثة المختلفة على الماهية الواحدة، مثال ذلك: الإنسان بالقياس إلى القيود التي من قبيل العلم والضحك والكتابة، فإنّه يمكن أن يكون بشرط شيء من جهة العلم، كما لو كان عالما، وبشرط لا من جهة الضحك، كما لو كان غير ضاحك، ولا بشرط من جهة الكتابة.
انطلاقا من هذه الملاحظة سيتوصل المدرّس علي الزنوزي إلى فكرة في غاية من الأهمية، وهي أنّ الماهية إمّا أن تؤخذ مقيدة بواحد من هذه الاعتبارات الثلاثة، بحيث تكون كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثة قيدا بالقياس إلى نفس الماهية، فتلحظ الماهية الواحدة بالنظر إلى هذه القيود الثلاثة، بشرط لا أو بشرط شيء أو لا بشرط، وإمّا أن تلحظ الماهية مطلقة وغير مقيدة بواحد من هذه الاعتبارات الثلاثة، بعبارة أخرى قد يؤخذ نفس هذه الاعتبارات قيدا بالقياس إلى الماهية، ثم تقاس الماهية مرة ثانية [26] بالنسبة إلى هذه القيود والاعتبارات، عندها إمّا أن تؤخذ الماهية مقيدة بواحدة من هذه الاعتبارات، بشرط وجود الشيء أو بشرط العدم أو لا بشرط من حيث الوجود والعدم، أو تؤخذ الماهية مطلقة وغير مقيدة بأي اعتبار من هذه الاعتبارات الثلاثة فتكون لا بشرط، من هنا يصبح الفارق جليا بين اعتبارلا بشرط القسمي والمقسمي، فإن الماهية بالقياس إلى الاعتبارات الثلاثة إما أن تؤخذ بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، وإما أن تؤخذ لا بشرط عن ذلك كله، هذا اللابشرط الذي بالقياس إلى كل من هذه الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط، هو المعبر عنه باللابشرط المقسمي، أما اللابشرط بالقياس إلى القيود الأولية التي من قبيل العلم والضحك والكتابة فهو اللابشرط القسمي،[27] إذن الفارق الجوهري بين اللابشرط القسمي واللابشرط المقسمي بحسب علي الزنوزي يرتبط بنحو القيود، فإنّ اللابشرط المقسمي مطلق لكن من جهة القيود والاعتبارات الثلاثة، بشرط شيء وبشرط لا، ولا بشرط، فهو مطلق حتى عن قيد اللابشرطية، بخلاف اللابشرط القسمي فإنّه مطلق بالنسبة للقيود الأولية التي يمكن اقترانها وعدم اقترانها مع الماهية، مع ذلك فإنّه مقيد باعتبار اللابشرطية، بعد هذه المقاربة التي قدمت من طرف علي الزنوزي حول اعتبار لا بشرط المقسمي وبيان الفارق بينه وبين اعتبار لا بشرط القسمي، ينبه على أنّ ما ذكره هو المعنى الصحيح للا بشرط المقسمي، وليس ما هو رائج على الألسنة والمبني على أن الماهية من حيث هي هي عين لا بشرط القسمي.[28]
آية الله الغروي الأصفهاني (ت.1361هـ/1942م) تلميذ علي الزنوزي بواسطة واحدة،[29] في بحثه عن اعتبارات الماهية وبعد أن يختار رأي أستاذه يعلق على مقاربة علي الزنوزي في اللابشرطية وعلى مقاربة غيره مما يجري على الألسنة والأفواه فيقول: وأمّا ما في كلام غير واحد – من أنّ الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي بمجرد الاعتبار – فهو مبني على مرادفة اللابشرط المقسمي مع الماهية من حيث هي، فإنّه لا يزيد القسمي على الماهية إلّا بمجرد الاعتبار، وكأنّهم لاحظوا في ذلك لا بشرطية الماهية ذاتا، لا لابشرطيتها اعتبارا، وقد عرفت: أنّ المراد باللابشرط المقسمي هو اللابشرط من حيث خصوص اعتبارات الماهية: من البشرط شيئية، والبشرط لائية، واللابشرطية.[30]
في الواقع الأمر المهم في المسألة هو الرأي الجديد الذي قدمه على الزنوزي، وهو أنه عندما تقسم الماهية إلى اعتباراتها المتعددة فإنّما يكون ذلك بعد النظر إلى الماهية مقيسة إلى الخارج عن ذاتها، أمّا لو قصر النظر على ذات الماهية من دون النظر إلى الخارج عن ذاتها فلا معنى لكل هذه الاعتبارات.
بخصوص هذا الأمر يقول على الزنوزي: ”اعلم أنّ كلّ ماهية من الماهيّات إذا لوحظت من حيث هي هي، بمعنى أن يقتصر نظر العقل على ذاتها وذاتياتها، مع اغماض النظر عن أي شيء خارج عن الذات والذاتيات، هذه الماهية بهذا اللحاظ وبحسب مرتبة تقرّرها الماهوي غير واجدة لأي شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها، وأي شيء يكون من الخارج يسلب عن مرتبة ذاتها بالسلب التحصيلي […]. “
”أمّا إذا كان نظر العقل إلى الخارج عن حاق ذات الماهية، معتبرا الأمور الخارجة عن ذاتها، فلا يخلو حال الماهية عند نسبتها إلى الخارج عن ذاتها عن أحد هذه الاعتبارات: الأول اعتبار بشرط شيء، بمعنى لحاظ اقترانها بها أو اتحادها معها، الثاني بشرط لا شيء، بمعنى لحاظ عدم اقترانها بها أو اتحادها معها، ثالثا: اعتبار لا بشرط شيء، بمعنى ألّا يلحظ اقترانها أو اتحادها بها، ولا عدم اقترانها أو اتحادها بها.“[31]
ذكرنا سابقا أنّ مسألة اعتبارات الماهية ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الإطلاق والتقييد، فإنّه لا معنى لكلّ واحد من هذه الاعتبارات بشرط شيء، بشرط لا، ولا بشرط، دون ملاحظة الماهية ونسبتها إلى القيود، فإذا لوحظت مع وجود القيد كانت بشرط شيء، وإذا لوحظت مع عدم القيد كانت بشرط لا، وإذا لوحظت مطلقة من وجود القيد وعدمه، كانت لابشرط، وبالتالي جميع الاعتبارات لا معنى لها بدون قياس الماهية إلى القيود والعوارض الخارجة عن ذاتها.
بحسب ما تقدم فإنّ تحقق هذه الاعتبارات يتوقف على وجود أمرين ضروريين:1. القيود والعوارض الخارجة عن ذات الماهية، 2. نسبة الماهية وقياسها إلى هذه القيود والعوارض، إذا لم يتحقق هذان الأمران معا، فإنّه لا معنى للاعتبارات الثلاثة للماهية، وأي كلام عن هذه الاعتبارات سيكون بلا أي معنى محصّل، استنادا إلى هذا يمكن القول إنّه عند لحاظ العقل الماهية من حيث هي هي، مع غض النظر عن جميع صفاتها، بما في ذلك الصفات المتناقضة التي يسلبها عنها بالسلب التحصيلي، لا وجود لأي قيد من القيود، فتنتفي النسبة والمقايسة، ويصبح الكلام عن اعتبارات الماهية حينئذ بلا معنى، في موضع آخر من كتاب البدائع، وفي مقام بيان الفرق بين اعتبار الماهية من حيث هي هي واعتبار اللابشرط المقسمي يقول: ”إذن الماهية بحسب ذلك النظر والاعتبار أعني أن يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، غير واجدة إلّا لذاتها وذاتياتها، وغير مقيسة إلى شيء خارج عن ذاتها، سواء كان الخارج أمرا واقعيا أم من الأمور الاعتبارية، هذا الاعتبار لا يتخصص باعتبار البشرط لائية، كما لا يتقيد باعتبار البشرط شيء، ولا باعتبار اللابشرطية العام والمطلق، فإن النظر الخارج عن حاق الذات، المقيس إلى الأمر الخارج عنها، لا يخرج عن أحد الاعتبارات الثلاثة.“[32]
من خلال التحليلات السابقة، ينتقد المدرس الزنوزي وجهة نظر أولئك الذين اعتقدوا أن لا بشرط المقسمي عين الماهية من حيث هي هي، يقول في تعليقته على شوارق الإلهام: ”اعلم يا أخا الحقيقة أنّ الماهية إذا أخذت من حيث هي فهي بهذا الأخذ ليست إلّا نفسها بالحمل الأولي، ويسلب عنها كل محمول، فلا تكون مقسما لأقسام ولا قسما لمقسم، بل ليست بحسب هذا الاعتبار إلّا هي. “[33] هذه الجملة ”أنّ الماهية من حيث هي […] لا تكون مقسما لأقسام “ رد على القائل بأنّ الماهية لا بشرط المقسمي هي نفس الماهية من حيث هي، إذ لو كانت الماهية من حيث هي مقسما للأقسام لجاز حملها على أقسامها، والحال أنّ الماهية من حيث هي يسلب عنها كل محمول.
الإشكال الأساسي الذي يوجّهه المدرّس الزنوزي لهذا الرأي هو أنّ اللا بشرط المقسمي مطلق من كل قيد حتى قيد الإطلاق، لأجل ذلك توهموا أنّ الماهية المطلقة بهذا الإطلاق هي نفس الماهية من حيث هي، والسبب الذي أوقعهم في هذا الاشتباه هو أنّ الماهية لا بشرط المقسمي وإن كانت تحوز هذا النحو من الإطلاق المقسمي، فإنّها مطلقة من كل قيد حتى قيد الإطلاق، ولكن ما لم يلتفتوا إليه أنّ اللابشرطية في الأساس لا تتحقق إلّا بالمقايسة والنسبة، المدرّس الزنوزي يوجه سؤالا: اللابشرط المقسمي لا بشرط بالقياس إلى أي شيء؟ والجواب هو أنّ اللابشرط لا بشرط بالقياس إلى أقسامه وبالخصوص اللابشرط القسمي، المثير للاهتمام أنّ الفلاسفة قبل الزنوزي يعترفون بهذا التفاوت الذي بين اللا بشرط القسمي واللابشرط المقسمي، وهو أن اللابشرط المقسمي لا يتقيد بالإطلاق وباللابشرطية كما هو الحال بالنسبة إلى اللابشرط القسمي، مع ذلك فإنّ كلامهم هذا يخالف ما ذكروه في خصوص الماهية من حيث هي هي، لأنّ الملاحظ في الماهية من حيث هي هي عندهم اعتبار الذات فقط، ومع كل هذه التوجيهات لا يتضح على أي أساس تم اعتبار الماهية من حيث هي، نفس اعتبار اللابشرط المقسمي.
مع ملاحظة كل ما ذكرناه يمكننا بيان نظر المدرس الزنوزي بهذا النحو: للماهية اعتباران:
1. اعتبار من حيث هي هي بمعنى أن يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، مع إغماض النظر عن كل ما هو خارج عن ذاتها.
2. أخذها مقيسة إلى الخارج عن ذاتها، بمعنى أن يلحظها العقل بالقياس إلى الأمور الخارجة عن ذاتها، هذا الاعتبار مقسم بالنسبة للاعتبارات لا بشرط وبشرط لا وبشرط شيء، أمّا الاعتبار الأول حيث لا يتجاوز العقل لحاظ الذات والذاتيات ولا ينظر إلّا للماهية من حيث هي هي، فهو ليس مقسما لهذه الأقسام.
يعتقد البعض ههنا أنّ لحاظ الماهية من حيث هي ولحاظها بالقياس إلى الأمر الخارج عنها كلاهما يشتركان في أمر، لا شك أنّ هذا الأمر هو نفس الماهية، من هنا يمكن القول بوجد قسم آخر وهو الماهية قبل اللحاظ، ستعود أقسام اعتبارات الماهية بحسب هذا الرأي ستة أقسام عند المدرس الزنوزي:
1. الماهية قبل اللحاظ، 2. الماهية من حيث هي هي، 3. الماهية لا بشرط المقسمي، 4. الماهية بشرط شيء، 5. الماهية بشرط لا، 6. الماهية لا بشرط القسمي.[34]
والسؤال المطروح ههنا أنّ الماهية قبل اللحاظ ما هي؟ أساسا هل نستطيع الكلام عن ماهية لا تقع تحت نظر ولحاظ العقل، ثم ندعي أنّ هذا أحد لحظات الماهية، في الواقع لو نتأمل بتبصر أكثر، سنجد أنّ هذا القول يستبطن تناقضا صارخا، فإنّه إذا دققنا النظر نجد أنّ الاعتبار ليس شيئا وراء اللحاظ الذي هو فعل القوة العاقلة، من جهة أخرى يعتقد صاحب هذه الدعوى أنّ الماهية قبل اللحاظ أحد اعتبارات الماهية، وأنّها في تعداد اعتبارات الماهية، لهذا السبب فإن هذه العبارة ”اعتبار الماهية قبل اللحاظ“ يعود في الحقيقة إلى ”لحاظ الماهية قبل اللحاظ “وبالتالي فإنّها تستبطن تناقضا واضحا،والحاصل أنّ العقل إمّا أن يلحظ الماهية مجردة عمّا عداها وإمّا أن يلحظها مع الأمور الخارجة عن ذاتها وذاتياتها، لأجل ذلك فإنّ هذا الاعتبار الأول ( اعتبار الماهية قبل اللحاظ) ليس له معنى محصّل، في النتيجة يمكن الجزم بأنّ اعتبارات الماهية عند المدرّس الزنوزي خمسة اعتبارات.
نستنتج من كل هذا الذي ذكرناه أنّ على الزنوزي لا ينتمي إلى أي من المجموعتين، في الواقع إنّ على الزنوزي هو الممثل لاتجاه ثالث، والذي بخلاف الاتجاهين السابقين لا يعتقد بأنّ الكلي الطبيعي هو نفس الماهية من حيث هي هي، من هنا يتجه البحث في أنّ الكلي الطبيعي يطابق أي واحد من الاعتبارات الخمسة للماهية بحسب على الزنوزي؟ ههنا ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول: وهو كالمجموعة الأولى، الكلي الطبيعي عنده نفس الماهية من حيث هي هي، هذا الاحتمال يبعده أنّ للكلي الطبيعي خصوصيتان أساسيتان: 1.معروض الكلي المنطقي، 2. موجود بوجود أفراده في الأعيان، والحال أنّ جميع الخصوصيات التي ذكرها علي الزنوزي للماهية من حيث هي هي، لا تنطبق بأي وجه على الكلي الطبيعي، لأجل ذلك، ما ذكره الأستاذ مرتضى مطهّري (ت.1399هـ/1979م) في سياق شرحه لنظرية الزنوزي لا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه، حيث قال هناك: ”وصل المرحوم الزنوزي لتقسيمات جديدة، واكتشفها، يقول: الماهية بحسب أحد اعتباراتها لا تكون حتى مقسما، وذلك إذا نظر إلى ذاتها، وذلك هو الأمر في الحمل الأولي الذاتي، ثم حين النظر خارج ذاتها تصل النوبة إلى التقسيم، بحسب هذا الترتيب الكلي الطبيعي يقابل المقسم. “[35]
في كلام مطهري المبني على أنّ الكلي الطبيعي يقابل المقسم إشارة إلى أن الكلي الطبيعي هو نفس الماهية من حيث هي هي.
الاحتمال الثاني: يعتقد الزنوزي كما هو الحال عند المجموعة الثانية، أن الكلي الطبيعي عين الماهية المطلقة، المحقق الأصفهاني أحد تلامذة علي الزنوزي والمتأثر برأي أستاذه في باب اعتبارات الماهية، يعتقد أنّ الكلي الطبيعي عند الزنوزي هو نفس الماهية لا بشرط القسمي،[36] لكن هذا الرأي لا يخلو من إشكال، والإشكال المعروف المتوجه إليه هو أنّ الماهية لا بشرط القسمي أمر عقلي مع أنّ الكلي الطبيعي أمر متحقق في الأعيان، إذن الماهية المطلقة لا يمكن أن تكون نفس الكلي الطبيعي،[37] والدليل على ذلك أنّ اللابشرط القسمي وجود ذهني، فإنّه مقيد بقيد لا بشرط، وكل أمر مقيد بقيد اللابشرطية لا يمكن أن يتحقق في الأعيان، يقول علي الزنوزي في مورد اللابشرط القسمي: ”اللابشرطية قيد في اللا بشرط القسمي. “[38]
والحاصل أنّ هذا الاعتبار لأنّه مقيد بقيد اللابشرطية لا يمكن أنّ يتحقق في الأعيان.
الاحتمال الثالث: مع أنّ علي الزنوزي لم يتعرض وبشكل صريح إلى أنّ الكلي الطبيعي يطابق أي واحد من الاعتبارات، مع ذلك يبقى الاحتمال الوحيد المعقول في المقام كون الكلي الطبيعي عين الماهية لا بشرط المقسمي،هذا الاعتبار لأنّه غير مقيد بقيد اللابشرطية كما هو الحال بالنسبة إلى اللابشرط القسمي، أمكنه أن يوجد في الأعيان، لأنّ غير المقيد كما يوجد في الأذهان يوجد في الأعيان، بحسب هذا الاحتمال فإنّ الماهية التي تلحظ بالقياس إلى الأمور الخارجة عن ذاتها، هي نفس الماهية الموجودة في الخارج ضمن أفرادها، الموجودة بوجود أفرادها.
لوازم نظرية على الزنوزي في بحث اعتبارات الماهية
1. أحد لوازم الاتجاه الأول أنّ موضوع كل علم هي الطبيعة من حيث هي هي، ويبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذه الطبيعة من حيث هي هي، يعتقد علي الزنوزي أنّ الماهية من حيث هي ليست شيئا غير ذاتها، وبالتالي فلا يمكن أن تكون موضوعا، ولا تكون محمولا، بهذا المعنى لا يمكن أن تكون الماهية من حيث هي هي موضوعا للعلم، من هنا يذهب الزنوزي بخصوص موضوع العلم إلى أنّ :”الطبيعة إذا أخذت من حيث هي، فهي بهذا الأخذ ليست إلّا نفسها، لا موضوع لشيء، ولا محمول على شيء، لا مبدأ ولا صاحب مبدأ، موضوع العلم الطبيعة المطلقة، لا الطبيعة من حيث هي، العارية عن جميع عوارضها، حتى عن الإطلاق واللابشرط والبشرط لا، أمّا اعتبارات الماهية الثلاثة لا بشرط، بشرط لا، وبشرط شيء، إنّما تحصل بعد قياس الماهية والموضوع إلى عوارضها.[39]
2. من المعلوم أنّ الحمل نوع من الاعتبار، فإذا لوحظ الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول فإنّ الحمل سيكون من قبيل الحمل الأولي، أمّا إذا لوحظ الاتحاد المصداقي بين الموضوع والمحمول فإنّ الحمل سيكون من قبيل الحمل المصداقي، في الحمل الأولي بهذا المعنى لا نلحظ شيئا خارجا عن المفهوم، بل يقصر فيه النظر على الذات والذاتيات لا غير، بخلاف الحمل الشائع فإنّ اللحاظ فيه يكون إلى الخارج عن المفهوم أعني علاقة المفهوم بمصاديقه، واندراج هذه المصاديق تحته.
في مبحث الوجود الذهني، ولأجل الخروج عن أحد أهم الإشكالات في المقام وهو اندراج الصورة الذهنية تحت مقولتين– نستند إلى الاختلاف في الحمل، فنقول: الصورة الذهنية للجوهرالخارجي بالحمل الأولي جوهر، لكن بالحمل الشائع كيف نفساني، وبالتالي لا يمكن لشيء واحد أن يندرج حتى مقولتين إلا بحملين واعتبارين ومن جهتين مختلفين، إذا دققنا النظر نكتشف أنّ الاختلاف بين الحمل الأولي والحمل الشائع يعود حقيقة ولبا إلى الاختلاف بين اعتبارين، فإنّنا في ما نحن فيه نتكلم عن شيء واحد، مثال ذلك الصورة الذهنية للشجرة، إذا لاحظنا هذه الصورة من حيث هي هي، كان الحمل أوليا، أمّا إذا لوحظت الصورة من حيث وجودها الذهني، كان الحمل شائعا، لأجل ذلك تندرج الصورة الذهنية باعتبار الحمل الأولي تحت مقولة الجوهر وباعتبار الحمل الشائع تحت مقولة العرض، من هنا ستتكون عندنا جملة من القضايا:
- الشجرة بالحمل الأولي شجرة.
- الشجرة بالحمل الأولي جوهر.
- الشجرة بالحمل الشائع كيف.
طبقا لرأي على الزنوزي فإنّ الشجرة بالحمل الأولي هي بعينها اعتبار الماهية من حيث هي هي، والماهية من حيث هي هي لا تكون موضوعا ولا تكون محمولا.[40]
من خلال البحث سيتضح أنّه بحسب رأي علي الزنوزي، حمل الشيء على نفسه في الواقع ليس حملا بالأساس، لذا فإنّه لا حمل في القضية الأولى حيث أخذت الماهية من حيث هي هي، اعتبار الماهية بحسب الحمل الأولي لا مفاد له إلّا كون الماهية ماهية، ولا يمكن أن يستفاد من هذا الحمل أكثر من ذلك.
السؤال الأصلي بالنسبة للقضية 2 كالتالي: إذا كانت الشجرة بالحمل الأولي نفس الماهية من حيث هي هي والتي لا تكون لا موضوعا ولا محمولا، فكيف وقعت في هذه القضية موضوعا حمل عليها الجوهرية؟ بحسب رأي الكاتب، الحمل الأولي في هذه القضية ليس قيدا في الموضوع، بل هو قيد للقضية فقط.
حتى لا نصطدم بإشكال من هذا القبيل يمكننا القول: ”الشجرة جوهر بالحمل الأولي،“ فإنّ مفاد هذا الحمل الأولي كما أشرنا إليه الإتحاد المفهومي بين الشجرة والجوهر، لكن إذا أخذ الحمل الأولي قيدا في الموضوع، وقيل: ”الشجرة بالحمل الأولي جوهر بالحمل الأولي “فإنّ مفاد هذا الحمل سيكون ”الشجرة من حيث هي هي، جوهر بالحمل الأولي“، بعبارة أخرى الحمل الأولي الأول في القضية أحد القيود المأخوذة في الخبر، مفاده لحاظ الشجرة من هذه الحيثية، حيث كونها شجرة، أما الحمل الأولي الثاني فإنه قيد للقضية، مفاده الإتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول.
من الضروري إلفات النظر إلى أنّ عدم التوجه لهذين المعنيين من الحمل الأولي– الحمل الأولي قيدا للموضوع والحمل الأولي قيدا للقضية، أوجد الكثير من النزاعات، وكيف كان، فقد أخذت الماهية من حيث هي موضوعا في هذه القضية، وهذا مشكل جدا عند علي الزنوزي.[41] إذا أردنا إعادة صياغة القضية2 بملاحظة الاعتبارات فيمكننا القول: ”الشجرة باعتبار لابشرط جوهر.“
في الواقع القضية رقم 3 ”الشجرة بالحمل الشائع “، تشير إلى اعتبار الشجرة بشرط شيء، حيث أخذت الشجرة ههنا باعتبار وجوها الذهني، وبالتالي فإنّ هذه القضية التي أخذ موضوعها بشرط الوجود الذهني لا بد أن يندرج تحت الكيف، في نظر الكاتب لو يتم توظيف مسألة اعتبارات الماهية في تمام المواضع التي يستدعى فيها الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي لأجل الخروج من الإشكالات والاعتراضات، فإن ذلك سيساعد في إيجاد تحليل عميق لمسألة الحمل، هذا من جهة ومن جهة أخرى سيمنع ذلك من الوقوع في الوهم.
3. هذه الاعتبارات المختلفة للماهية تم استدعاؤها من قبل المتألهين، حيث قام هؤلاء بإسراء هذه الأحكام من فضاءات الماهية إلى عوالم الوجود، لقد وظّف المتألهّون من أهل الشهود اعتبارات الماهية في فهم وشرح المراتب المختلفة لحقيقة الوجود. يعتقد العديد من الفلاسفة من أمثال ملا صدرا، وملا هادي السبزواري (ت.1289هـ/1873) أنّه بالإمكان تطبيق اعتبارات الماهية على الوجود، فقد تحدثوا عن ذلك في مواضع متعددة.[42]
أمّا اعتبار بشرط شيء عند المتألهين فإشارة إلى التعينات الحقية، ومقام التجلي العلمي التفصيلي للحق تعالى، في هذه المرتبة تظهر جميع الأسماء والصفات بالعلم الحضوري وبنحو تفصيلي، وتسمى هذه المرتبة بمقام الواحدية أو مقاوم الألوهية، والتي هي أصل الكثرة في الأعيان.[43]
أمّا اعتبار بشرط لا عندهم فإشارة إلى التعين الأول ومرتبة غيب الغيوب وذات الحق تعالى.
الأحدية هي مرتبة تجلي الذات لدى الذات، في هذه المرتبة يتجلى اسم الله الذي يندمج فيه جميع الأسماء والحقائق بنحو اجمالي،[44] وتسمى هذه المرتبة بمقام الأحدية ومقام جمع الجمع، وحقيقة الحقائق.
أمّا اعتبار لا بشرط القسمي عندهم فإنّه ينطبق على مرتبة الوجود المنبسط والهوية السّارية في جميع الموجودات، الوجود المنبسط هو عين التجلي السّاري في الأشياء والرابطة التي بين ذات الواجب والممكنات، إنّ انبساط وإطلاق الوجود يختلف تماما عن انبساط وإطلاق الماهية الكلية، فإن إطلاق الماهية وكليتها في غاية الضعف والإبهام، بخلاف إطلاق الوجود وانبساطه فإنّه من فرط التحصّل، والفعلية، وفي غاية الشدة والقوة.[45]
الاعتبار الأخير، اعتبار لا بشرط المقسمي، الذي يستخدمه العرفاء في ذات الحق تعالى فقط، فاعتباراللابشرط المقسمي عندهم إشارة إلى حقيقة وجود الحق تعالى، المطلقة والعارية عن كل قيد حتى قيد الإطلاق،[46] بخلاف اللابشرط القسمي المقيد بالإطلاق، الحاكي عن الوجود المنبسط والهوية السارية في جميع الموجودات، بهذه الطريقة يقارب العرفاء إطلاق الحق فإنّ الحق تعالى عندهم وبشكل واضح مطلق بالإطلاق المقسمي، فهو المقسم لجميع ظهوراته وتعيناته، بتبع ذلك، تقارب هذه التعينات بحسب هذه الاعتبارات، بشرط شيء، بشرط لا ولا بشرط القسمي.[47]
قد تقدم أنّ اللابشرط المقسمي بحسب علي الزنوزي يؤخذ بالقياس وبلحاظ الغير، هذه اللابشرطية ليس لها معنى محصّل إلّا عند قياسها إلى الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء، وبشرط لا، ولا بشرط القسمي، بهذا البيان فإنّ نسبة الإطلاق المقسمي لذات الحق تعالى سيخلو من الدقة، فإنّ مرتبة الذات هي المرتبة التي لا تقاس إلى شيء من الأشياء، ولا ينسب شيء إليها، مقام ذات الحق تعالى مقام لا اسم له ولا رسم له، غيب مطلق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنسب إليه صفة أو اسم أو يحكم عليه بحكم من الأحكام سواء كان هذا الحكم إيجابيا أو سلبيا، نعم مع ملاحظة تقسيمات اعتبارات الماهية عند علي الزنوزي فإنّ الأليق بذات الحق هو اعتبار الماهية من حيث هي هي – حيث يقتصر النظر فيها إلى ذاتها– هذا الاعتبار أدق من اعتبار لا بشرط المقسمي، فإنّ اللابشرط المقسمي بحسب دقيق النظر وغور الحقيقة ليس من قبيل الاعتبار الذي لم يلحظ فيه أي حيثية وجهة خارجة عن ذاته، بل إنّه حقيقة أخذت بالقياس إلى الغير، بعبارة أخرى اللابشرط المقسمي هو لحاظ الظهور، ظهور تجلياته، وهذا اللحاظ يلغي ويبطل إطلاقه الذاتي، وغيب إطلاقه، هذا الإطلاق هو المستوعب للإطلاق النسبي المقابل للتقييد، الجامع للغيب النسبي المقابل للشهادة.[48]
وبالتالي ما طرحه على الزنوزي من اعتبار الماهية من حيث هي (الاعتبار الأول)، أكثر مناسبة لمقام ذات الحق تعالى، وكما قيل في مورد الماهية من حيث هي، فإنّها لا تقع مقسما للأقسام، ولا ينسب إليها أي حكم سواء كان إيجابيا أو سلبيا، ولا تقع موضوعا لأي علم، كذلك في باب ذات الحق تعالى، فإنّ الذات لا تكون مقسما، كما لا تكون قسما، لا ينسب إليها حكم، ولا يسلب عنها حكم، لذا لا مجال في مقام الذات لاعتبار شيء غير نفس الذات.
من هنا نصل إلى نتيجة حاصلها أنّ ذات الحق تعالى من حيث هي ذات لا يمكن أن تكون موضوعا للعرفان النظري، نعم ما يمكن أن يكون موضوعا للعرفان هو ذات الحق بالاعتبار المقسمي وهي الذات المأخوذة لا بشرط من حيث ظهوراتها وتعيناتها، ذات الحق تعالى بهذا الاعتبار هو موضوع العرفان.
مما تقدم يمكن النظر إلى ذات الحق سبحانه بنحوين الأول من جهة الغيب والآخر من جهة الظهور، بعبارة أخرى يمكن أن نعتبر ذات الحق تعالى بالقياس إلى النسب والإضافات فيعود مفادها التنزل عن حيثيتها الإطلاقية، والتقيد والتعين بالأسماء والصفات الإجمالية والتفصيلية في سياق الظهور والتجلي، ويمكن عدم لحاظ ذات الحق من جهة التجلي والظهور وترابط الأسماء والصفات، سواء كان هذا اللحاظ بالحيثية التقييدية الاندماجية أو بلحاظ الحيثية الشّأنية، هذا اللحاظ يجعل جميع الأحكام التي تصب على ذات الحق في حكم الباطل، بحيث سيكون كلّ حكم من الأحكام ونقيضه في هذا المقام صحيح،[49] لذا بناء على نظرية المدرس الزنوزي في الاعتبارات يمكن اقتراح تفسير أعمق للمسألة السالفة الذكر، وهذه أحد جوانب الرجحان في نظرية الزنوزي مقارنة ببقية الآراء.
4. بحسب اعتقاد الزنوزي فإنّ الماهية من حيث هي لا تقع لا موضوعا ولا محمولا، يقول في هذا الصدد: ”الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي، لا موضوع لشيء، ولا محمول على شيء،“[50] وههنا إشكال قد ينقدح في الأذهان حاصله كيف يتم تصحيح الحمل في حمل الماهية بهذا الاعتبار على نفسها؟ أليست الماهية بهذا الاعتبار إلّا هي، بحيث يصدق القول إنها هي هي، هذا معناه أنّ اعتبار الماهية من حيث هي هي من مصاديق حمل الشيء على نفسه، في الجواب عن هذا الإشكال لابد أن نسجل أنّ هذا المطلب بات واضحا بالنسبة للزنوزي، فإن الضرورة الفطرية تأبي الحمل في مورد حمل الشيء على نفسه، هذا بديهي وواضح في نظر الزنوزي،[51] الإشكال الأساسي الذي يوجهه الزنوزي على حمل الشيء على نفسه حاصله أنّه إمّا أن لا يكون هناك تفاوت بين المدرَك في الموضوع والمحمول وبالتالي لن تتحقق النسبة فلا تتحقق القضية، وإمّا أن يعود التفاوت بين الموضوع والمحمول إلى التفاوت في نحو الإدراك، بحيث يؤخذ التفاوت في الإدراك حيثية تقييدية في المحمول، وبالرغم من توفر الحد الأدنى من شرائط الحمل في هذه الصورة مع ذلك فإنّه حمل لا قيمة له.[52]
لابد أن ننبه ههنا على أنّ الحمل الأولي في قولنا: ”الماهية من حيث هي هي يعني مع قصر النظر على ذاتها وذاتياتها بالحمل الأولي ليست إلّا هي،“[53] قيد للموضوع وليس قيدا للقضية حتى يرد الاعتراض السابق، فإنّ المستشكل يبني على كون الحمل الأولي قيدا للقضية.
أحد لوازم نظرية الزنوزي بخصوص اعتبار الماهية من حيث هي هي أنّه في مورد حمل الشيء على نفسه لا حمل في الأساس، هذا هو اللازم الذي استوعبه المدرس الزنوزي بشكل تام، تجدر الإشارة إلى أنّ معظم علماء المنطق المسلمين لم يجوزوا أيضا حمل الشيء على نفسه، هؤلاء لم يعتبروا هذا الحمل من مصاديق الحمل الحقيقي، وعلى القول بإمكانه فإنّ هذا الحمل لا فائدة متصورة له، المحقق نصير الدين الطوسي في أساس الاقتباس يقول: ”في الحمليات الموضوع والمحمول ينبغي أن لا يكون أمرا واحدا، فإنّ حمل الشيء على نفسه لا يكون،“[54] أيضا فقد اعتبر الفخر الرازي حمل الشيء على نفسه ممتنعا وذلك لعدم توفر شرط تغاير الموضوع والمحمول،[55] كما رفض السهروردي (ت.586هـ/1191م)، حمل الشيء على نفسه.[56]
5. أحد نتائج نظرية علي الزنوزي هي أنّ اللابشرطية التي تنتزع من الماهية بالقياس إلى الخارج عن ذاتها وذاتياتها لابشرطية اعتبارية، فإنه عندما تلحظ الماهية بالقياس إلى الأمر الخارج عن ذاتها، تظهر الاعتبارات المختلفة، نتيجة للنسبة والمقايسة، لذا فإنّ الإطلاق والتقييد الحاصلان من قبيل الأمر الاعتباري، سواء كانت اللابشرطية المنتزعة قسمية أو مقسمية، هذا الأمر يختلف بالنسبة للماهية من حيث هي، فإن الماهية من حيث هي تلحظ من غير قياس ونسبة إلى أي نحو من القيود والصفات، نسبة لا بشرطية، أساسا في مرتبة تقرر الذات لا وجود لأي قيد حتى تؤخذ الماهية بالقياس إليه، لذا فإنّ الماهية من حيث هي هي لا بشرط، إلا أنّه ليس من قبيل اللابشرط الاعتباري المنتزع من قياس الماهية إلى الأمر الخارج عن ذاتها، بل هو من قبيل اللابشرط الحقيقي، المنتزع من لحاظ الذات في مرتبة تقررها.[57]
6. كما ذكرنا، فإنّ الحمل لا يتحقق عند اعتبار الماهية من حيث هي هي، أمّا بحسب بقية الاعتبارات فالأمر مختلف، فإنّ بقية اعتبارات الماهية لا تتحقق إلّا في القضية، يقول الزنوزي: ”فلا تحصل هذه الاعتبارات إلّا في القضية، والمحمول لا يكون محمولا إلّا لابشرط، أي لا بشرط الإتحاد مع الموضوع، وإلّا تكون القضايا ضرورية، وبلا فائدة كقولك زيد القائم قائم، ولا بشرط عدم الإتحاد وإلّا تكون القضايا سلبية والإيجاب غلطا، كقولك زيد اللاقائم قائم، ولذا يقولون المعتبر في طرف المحمول هو المفهوم لا المصداق، وأما الموضوع فهو أيضا بالنسبة إلى المحمول لا يكون إلا لا بشرط وإلا لزم ما مر.[58] هذا اللابشرط المنتزع من نسبة الموضوع إلى المحمول وبالعكس هو اللابشرط القسمي، والحاصل أنّ اللابشرطية في اللابشرط المقسمي لابشرطية اعتبارية، بخلاف اللابشرطية عند لحاظ الماهية من حيث هي هي، فإنّها لابشرطية حقيقية، بحسب رأي الزنوزي فإنّ اللابشرطية الحقيقية تشكل متن القضايا التي موضوعها الحق تعالى، في مثل هذه الحالة يكون الموضوع عين المحمول وإن كان غيره مفهوما، يقول الزنوزي: ”وفي الحقيقة جميع القضايا بشرط شيء، وهو الوجود إمّا في ثبوت المحمول أو في عروضه، نعم لا يقال للأول بحسب الاصطلاح مشروطة، فاللابشرط الحقيقي هو ما كان الموضوع فيه هو الحق تعالى وحينئذ يكون المحمول عين الموضوع وإن كان غيره مفهوما وتسمى القضية حينئذ ضرورية أزلية،“[59] إذن بحسب الزنوزي الاختلاف بين القضية الضرورية والقضية الضرورية الأزلية يعود حقيقة ولبا إلى الاختلاف بين اعتبار اللابشرط الاعتباري واللابشرط الحقيقي، ففي الوقت الذي يكون الموضوع عين الحق تعالى يؤخذ الموضوع مطلقا من كل قيد وشرط، حتى قيد الإطلاق، هذا الإطلاق في القضية الضرورية الأزلية إطلاق مرجعه إطلاق موضوعه أعني الحق تعالى، فإطلاق الحق إطلاق حقيقي وليس إطلاق مقسمي أو قسمي.
النتيجة
لقد اتضح من خلال هذا التحقيق أنّ ابن سينا هو المبدع الأول لنظرية اعتبارات الماهية، لقد وجدت هذه الاعتبارات، اعتبار بشرط شيء، وبشرط لا، ولا بشرط في أعماله، وأثيرت من طرفه، نعم لم يتعرض الشيخ الرئيس لاعتبار اللابشرط المقسمي، مع ملاحظة ما وصلنا من أعمال ابن سينا فإنّه يمكن القول إنّ اعتبار لابشرط المقسمي لم يكن بذلك الوضوح عند الشيخ، المبحث الآخر الذي توصل إليه الشيخ، العلاقة التي بين مسألة اعتبارات الماهية وبين بحث الكلي الطبيعي، والذي ذكره الشيخ بعنوان الطبيعة.
بعد أن تعرض الشيخ الرئيس لإشكالية العلاقة بين الكلي الطبيعي وبحث اعتبارات الماهية وجدت ثلاثة مفاهيم مفتاحية في أعمال الفلاسفة الإسلاميين، كانت العلاقة بينها محل نزاع وخلاف بينهم، هذه المفاهيم: هي مفهوم ”الكلي الطبيعي“،مفهوم ”ماهية من حيث هي هي“، مفهوم ”لا بشرط“.
يعتقد ابن سينا المؤسس لهذا الاتجاه، أنّ الكلي الطبيعي عين الماهية من حيث هي هي، ومساوي لاعتبار لا بشرط القسمي، من أتباع هذا الاتجاه من القدماء نصير الدين الطوسي، ومن المعاصرين مصباح اليزدي، بعد الشيخ أصبحت مسألة اعتبارات الماهية مورد للبحث والتحقيق من قبل أغلبية الفلاسفة ونتيجة لهذه التحقيقات تم إضافة اعتبار رابع هو اعتبار الماهية لا بشرط المقسمي، بعد ذلك وجدت نظرية ثانية اشتهرت بين الفلاسفة والحكماء حيث اعتقد هؤلاء بأنّ الكلي الطبيعي هو الماهية من حيث هي هي ويساوي اعتبار لابشرط المقسمي، وممن اختار هذا الرأي ملا صدرا والميرداماد.
أمّا علي الزنوزي فقد كان له رأي جديد في المسألة حيث أوصل اعتبارات الماهية إلى خمسة اعتبارات، بحسب علي الزنوزي فإنّ اعتبار الماهية من حيث هي هي، مغاير لاعتبار الماهية من حيث إنّها مقسم للأقسام الثلاثة، ففي الاعتبار الأول يقتصر النظر فيه على حاق الذات والذاتيات، بخلاف الاعتبار الثاني فإنّه ينتزع من قياس الماهية إلى الأمر الخارج عن ذاتها، بحسب الحكيم المؤسس فإن الماهية من حيث هي هي، لا تكون مقسما للأقسام كما لا تكون موضوعا للعلم، لذا يعتقد علي الزنوزي المؤسس لهذا الاتجاه الجديد أنّ الكلي الطبيعي ليس هو الماهية من حيث هي هي، إنما يطابق الكلي الطبيعي اعتبار الماهية لا بشرط المقسمي، حيث ينتزع هذا اللحاظ من قياس الماهية إلى الأمور الخارجة عن ذاتها، أما الماهية من حيث هي هي فلا تكون مقسما ولا قسما.
بحسب مبنى على الزنوزي يمكننا أن نصل إلى تحليل أعمق لمسائل من قبيل الحمل الأولي والذاتي، مقام ذات الباري تعالى، حمل الشيء على نفسه، والتفكيك بين اللابشرط الحقيقي والاعتباري.
مما مضى يمكننا القول إنّ البحث في اعتبارات الماهية مر بثلاث مراحل بحسب السياقات التاريخية في الفلسفة الإسلامية: المرحلة الأولى تبدأ مع الشيخ الرئيس وبعض تلامذته، كبهمنيار، في هذه المرحلة تم التأسيس للفكرة من قبل الشيخ، المرحلة الثانية مرحلة التحقيق وتبدأ مع المحقق الطوسي حيث اكتمل البحث فيها من الناحية الفلسفية، في هذه المرحلة استقر رأي الفلاسفة على الاعتبارات الأربعة للماهية، المرحلة الثالثة مرحلة الإبداع، حيث وصلت نظرية اعتبارات الماهية لمرحلة من النضج على يد علي الزنوزي، من هنا يمكننا القول إن نظرية اعتبارات الماهية أخذت شكلها الكامل والنهائي مع المدرس الزنوزي.
البيبليوگرافيا
ابن تركه، صائن الدين. تمهيد القواعد. تصحيح وتعليق سيد جلال الدين آشتياني مع حواشي محمد رضا قمشه ای وميرزا محمود قمي. قم: بستان كتاب، 1381هـ.ش.
ابن سينا، حسين بن عبد الله. رسائل ابن سينا. قم: منشورات بيدار، 1400هـ.ش.
ابن سينا، حسين بن عبد الله. الشفا (منطق). تصحيح سعيد زايد. قم: مكتبة آية الله المرعشي نجفي، 1404هـ.ش.
ابن سينا، حسين بن عبد الله. الشفا (إلهيات). تصحيح سعيد زايد. قم: مكتبة آية الله المرعشي نجفي، 1404هـ.ش.
ابن سينا، حسين بن عبد الله. الاشارات والتنبيهات. شرح خواجه نصير الدين الطوسي. قم: نشر البلاغة، 1375هـ.ش.
أبو ترابي، أحمد. ”حمل الشيء على نفسه في الرسالة الحملية وعند المناطقة المسلمون وفلاسفة الغرب.“ فصلية حكمت إسلامي، 2 (5) (1394 هـ.ش.): 33–64.
جرجاني، مير سيد شريف. شرح المواقف في علم الكلام. قم: الشريف الرضي، 1325.
حلي، حسن بن يوسف. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 1408 هـ.ش.
خادمي، منوچهر. ”لا أدرية العارف في مقام الذات.“ نصف سنوية حكمت معاصر، 21 (1392هـ.ش.): 4–51.
السبزواري، ملاهادي. شرح المنظومة منطق وحكمة، طباعة حجرية، طهران: دار العلم، بدون تاريخ.
السبزواري، ملا هادي. غرر الفرائد. طهران: مؤسسة مطالعات فرهنكي إسلامي جامعة طهران،1378هـ.ش.
السهروردي، يحي بن حبش. منطق التلويحات. تحقيق علي أكبر فياض، طهران: جامعة طهران،1334هـ.ش.
شهيدي، فاطمة وحكمت نصرالله. ”تمايز الوجود والماهية عند ابن سينا والسهروردي دراسة مقارنة،“ فصلية حكمة سينوي، 12 (39) (1387هـ.ش): 112–130.
صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم. الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية.بيروت:دار إحياء التراث العربي.1981م.
الطباطبائي، سيد محمد حسين. نهاية الحكمة.طهران: منشورات الزهراء،1363.
الطوسي (نصير الدين)، محمد بن محمد. أساس الاقتباس. تصحيح المدرس الرضوى. طهران: جامعة طهران،1376هـ.ش.
الطوسي (نصير الدين)، محمد بن محمد. تجريد الاعتقاد.تحقيق محمد جواد حسيني جلالي، طهران: مكتب الإعلام الإسلامي،1407هـ.ق.
الطوسي (نصير الدين)، محمد بن محمد، شرح الإشارات والتنبيهات مع شرح الشرح للعلامة قطب الدين الرازي. قم: نشر البلاغة، 1375هـ.ش.
الغروي الاصفهاني، محمد حسين. تحفة الحكيم. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بدون تاريخ.
الغروي الاصفهاني، محمد حسين. نهاية الدراية في شرح الكفاية، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث،1429هـ.ق.
الفخر الرازي، محمد بن عمر.شرح عيون الحكمة. تحقيق أحمد حجازي وأحمد السقا، طهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.1373هـ.ش.
الفخر الرازي، محمد بن عمر.المباحث المشرقية. قم: انتشارات بيدار، 1411هـ.ش.
القيصري، داود بن محمد. شرح فصوص الحكم. تصحيح سيد جلال الدين الآشتياني، طهران: منشورات علمى وفرهنكى، 1375هـ.ش.
الكاتبي القزويني، نجم الدين على، حكمة العين وشرحه. باعتناء جعفر زاهدى، مشهد: منشورات جامعة فردوسي، 1353هـ.ش.
كديور، محسن. تحليل نقدي لآراء الحكيم المؤسس علي المدرس الطهراني المبتكرة في الحكمة المتعالية،(أطروحة دكتوراه). جامعة تكوين الأساتذة، طهران، إيران، 1377هـ.ش.
اللاهيجي، فياض. شوارق الالهام. طبعة حجرية، إيران، 1303هـ.ش.
المدرس الزنوزي، علي. بدائع الحكم. مقدمة وتنظيم أحمد واعظي، طهران: الزهراء، 1375هـ.ش.
المدرس الزنوزي، علي. مجموعة مصنفات الحكيم المؤسس علي الطهراني، تحقيق محسن كديور، طهران: اطلاعات، 1378هـ.ش.
مصباح اليزدي، محمد تقي. تعليقة على نهاية الحكمة، قم: مؤسسه التعليم والتحقيق الإمام الخميني، 1393هـ.ش.
المطهري، مرتضى. العلوم الإسلامية: كلام، عرفان، الحكمة العملية، طهران: صدرا، 1369هـ.ش.
الميرداماد، محمد باقر. القبسات. باعتناء مهدي محقق وآخرين، طهران: جامعة طهران، 1367هـ.ش.
للتوثيق
عزيزي، رامين و مسعودي، جهنكير. ”اعتبارات الماهية: الإبداع السينوي، وابتكار المدرس الزنوزي.“ ترجمها عن الفارسية الهواري بن بوزيان. ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/3710>
الهواري بن بوزيان
[1] فاطمة شهيدي وحكمت نصر الله، ”تمايز الوجود والماهية عند ابن سينا والسهروردي دراسة مقارنة،“ فصلية حكمت سينوي، 12 (39) (1387 هـ.ش)، 111.
[2] ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، شرح نصير الدين الطوسي (قم: منشورات البلاغة، 1375 هـ.ش.)، المجلد الأول، 42–43، 31–32، 346–347.
[3] الشيرازي، الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1981م)، المجلد الرابع، 250.
[4] الطباطبائي، نهاية الحكمة (طهران: منشورات الزهراء،1363 هـ.ش.)، 74.
[5] الطوسي، تجريد الاعتقاد، تحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي (طهران: مكتب الإعلام الإسلامي 1407 هـ.ق)، 122.
[6] اللاهيجي، شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام (إيران: طبعة حجرية 1303 هـ.ش)، 151.
[7] مصباح اليزدي، تعليقة على نهاية الحكمة (قم: مؤسسة التعليم والتحقيق 1393هـ.ش)، 108–109.
[8] ابن سينا، الشفاء (إلهيات)، تصحيح سعيد زايد (قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي 1404 هـ.ش)، 201.
[9] ابن سينا، الشفاء (مدخل المنطق)، تصحيح سعيد زايد (قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي 1404هـ.ش)، 15.
[10]ابن سينا، مدخل المنطق، 65.
[11] ابن سينا، مدخل المنطق، 39.
[12] ابن سينا، رسالة عيون الحكمة (قم: منشورات بيدار1400 هـ.ش)، 69.
[13] ابن سينا، رسائل ابن سينا (قم: منشورات بيدار1400 هـ.ش)، 117.
[14] إضافة مني للتوضيح (المترجم).
[15]ابن سينا، الإلهيات، 204.
[16]ابن سينا، الإلهيات، 204..
[17] ابن سينا، الشفاء(مدخل المنطق)،65–70.
[18] الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 1408هـ.ق)، 70–71.
[19] الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، 70–71.
[20] الرازي، المباحث المشرقية (قم: منشورات بيدار 1411 هـ.ش)، المجلد الأول، 190.
[21] الكاتبي القزويني، حكمة العين وشرحه، باعتناء جعفر زاهدي (مشهد: منشورات جامعة فردوسي1353 هـ.ش)، 71–72.
[22] القطب الرازي، شرح الإشارات والتنبيهات للطوسي مع محاكمات القطب الرازي (قم: منشورات البلاغة 1375هـ.ش) المجلد الأول، 76.
[23] الجرجاني، شرح المواقف في علم الكلام (قم: الشريف الرضي 1325)، المجلد الثالث، 25–31.
[24] الميرداماد، القبسات، باعتناء مهدي محقق وآخرين (طهران: جامعة طهران 1367 هـ.ش)، 143–144.
[25] صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية، المجلد الرابع، 250–251، الطباطبائي، نهاية الحكمة، 74.
[26] القيود على نحوين أولية من قبيل العلم والكتابة…، ينتزع اعتبار لا بشرط القسمي بالقياس إليها، وثانوية من قبيل بشرط لا، ولابشرط وبشرط شيء، ينتزع اعتبار لا بشرط المقسمي بالقياس إليها. (المترجم)
[27] هذا المقطع من البحث لدقته ترجمته مع التصرف خدمة للفكرة. (المترجم)
[28] هكذا ورد في المقال، وهو خطأ والصحيح ”المقسمي“ كما في بدائع الحكم، 191–293. (المترجم)
[29] ميرزا محمد باقر الإصطهباناتي، راجع مجموعة مصنفات حكيم مؤسس آقا علي مدرس طهراني، الجلد الثاني، 14، وقد ورد في مقدمة تحقيق نهاية الدراية، الجلد الأول، 12، ما نصه: فقد أخذ هذه العلوم على الفيلسوف الشهير الميرزا محمد باقر الإصطهباناتي رحمه الله، والذي كان يعد من كبار الفلاسفة والحكماء العارفين.(المترجم)
[30] الغروي الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية (قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 1429 هـ.ق)، المجلد الثاني، 491–494.
[31] المدرس الزنوزي، بدائع الحكم، مقدمة وتنظيم أحمد واعظي (طهران: منشورات الزهراء 1375هـ.ش)، 291–293.
[32] المدرس الزنوزي، بدائع الحكم، 375.
[33] المدرس الزنوزي، مجموعة مصنفات الحكيم المؤسس علي الطهراني، تحقيق محسن كديور (طهران: اطلاعات 1378هـ.ش)، المجلد الثاني، 463.
[34] كديور، تحليل انتقادى آراء ابتكارى حكيم مؤسس آقا علي مدرس طهرانى در حكمت متعاليه (أطروحة دكتوراه)، جامعة تكوين الأساتذة (طهران: 1377 هـ.ش)، 228–229.
[35] المطهري، العلوم الإسلامية كلام، عرفان، الحكمة العملية (طهران: منشورات صدرا، 1369 هـ.ش)، 70.
[36] الغروي الاصفهاني، تحفة الحكيم (قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بدون تاريخ)، 34–35.
[37] السبزواري، شرح المنظومة منطق وحكمة (طهران: دار العلم، طباعة حجرية، بدون تاريخ)، 89.
[38] المدرس الزنوزي، بدائع الحكم،291–293.
[39] المدرس الزنوزي، مجموعة مصنفات حكيم مؤسس على الطهراني، المجلد الثاني، 463.
[40] المدرس الزنوزي، مجموعة مصنفات حكيم مؤسس علي الطهراني، المجلد الثاني 463.
[41] المدرس الزنوزي، مجموعة مصنفات حكيم مؤسس علي الطهراني، المجلد الثاني 463.
[42]السبزواري، غرر الفرائد (طهران: مؤسسة مطالعات فرهنكي إسلامي، جامعة طهران، 1378 هـ.ش)، المجلد الثاني، 339.
[43] صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية، المجلد الثاني، 310، القيصري، شرح فصوص الحكم، تصحيح سيد جلال الدين الاشتياني (طهران: منشورات علمي وفرهنكي 1375 هـ.ش)، 34.
[44] القيصري، شرح فصوص الحكم، 34.
[45] المدرس الزنوزي، بدائع الحكم، 385.
[46] قيصري، شرح فصوص الحكم،245.
[47]ابن تركه، تمهيد القواعد، تصحيح وتعليق سيد جلال الدين اشتياني مع حواشي محمد رضا قمشه أي وميرزا محمود قمي (قم: بستنان كتاب، 1381هـ.ش)، 216، وهذا نص ما ورد في التمهيد: ”الحقيقة الحقة والطبيعة الواجبة– من حيث إنها طبيعة واجبة– لا يمكن أن يشوبها شائبة القيد بوجه من الوجوه، ولا يتطرق إليها التعينات الخارجة عنها بجهة من الجهات. نعم، تعينها إنما هو الإطلاق الحقيقي وأحدية الجمع الذاتي، كما نبهت عليه في المقدمة، فليتدبر، فإنها من جلائل النكت“.
[48] خادمي، ”لا أدرية العارف في مقام الذات،“ نصف سنوية حكمت معاصر، 21 (1392هـ.ش)، 36.
[49] خادمي، ”لا أدرية العارف في مقام الذات،“ 37.
[50] لم أعثر على هذا النص، والموجود في الكتاب هذه العبارة: ”اعلم يا أخا الحقيقة أن الماهية إذا أخذت من حيث هي فهي بهذا الأخذ ليست إلا نفسها بالحمل الأولي ويسلب عنها كل محمول.“ مجموعة مصنفات الزنوزي، الجلد الثاني، 463. (المترجم)
[51] الزنوزي، مجموعة مصنفات الزنوزي، المجلد الثاني، 199.
[52]أبو تراب، حمل الشيء على نفسه في الرسالة الحملية وعند المناطقة المسلمون وفلاسفة الغرب، فصلية حكمت إسلامي، 2 (5)، 64–33، 1394 هـ.ش، 51.
[53] المدرس الزنوزي، مجموعة مصنفات الزنوزي، المجلد الثاني، 463.
[54] الطوسي، أساس الاقتباس، تصحيح المدرس الرضوي (طهران: جامعة طهران 1376 هـ.ش)، 74.
[55] الفخر الرازي، شرح عيون الحكمة، تحقيق أحمد حجازي وأحمد السقا (طهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر 1373)، المجلد الأول 75.
[56] السهروردي، منطق التلويحات، تحقيق علي أكبر فياض (طهران: جامعة طهران، 1334 هـ.ش)، 6.
[57] الغروي الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، المجلد الثاني،491–494.
[58] المدرس الزنوزي، مجموعة مصنفات الزنوزي، المجلد الثاني، 297.
[59] المدرس الزنوزي، مجموعة مصنفات الزنوزي، المجلد الثاني، 298.
مقالات ذات صلة
الآبلي شيخُ ابن خلدون
الآبلي شيخُ ابن خلدون ناصيف نصار[1] ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد تقديم نُشر مقال ناصيف نصار الذي نترجمه هنا بالمجلة الآتية: Studia Islamica, 1964, No. 20 (1964): 103-114. والمقال من الدراسات القليلة والباكرة التي تعرضت لهذا الموضوع الملغز، أعني علاقة الفيلسوف والرياضي...
في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة
في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة[1] وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra ترجمة وتقديم محمد أبركان*جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس تقديم المترجم صاحب المقال الذي نترجمه هنا هو وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra، الكاتب الفرنسي المتخصص في الصحافة العلمية. وعلى الرغم من أن...
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي لويسْ خَابْيِيرْلُوبيثْ فارْخَاتْجامعة بَانْأمريكَانَا-مكسيكو سيتي ترجمة محمد الولي[1]جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس كثيرة هي الدراسات التي أنجزت في العالم العربي حول دمج كتابي الخطابة والشعر لأرسطو ضمن الأورغانون. وإذا تم الاتفاق...
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م)
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م) خوليو سامسو نقله من الإسبانية إلى العربية مصطفى بنسباعجامعة عبد المالك السعدي-تطوان تقديم رغم أن كتاب علوم الأوائل في الأندلسLas ciencias de los antiguos en al-Andalus للأستاذ خوليو سامسو Julio Samsó قد صدر سنة...
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل* هانس ديبرترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد تقديم الترجمة هانز دايبر مستشرق ألماني من مواليد عام 1942. حصل على الدكتوراه عام 1968. واشتغل أستاذًا للغة العربية والإسلام في الجامعة الحرة بأمستردام من عام 1977 إلى...
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘: ملاحظات أوليّة
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘ملاحظات أوليّة[1] تأليف: ل. فان ليتجامعة يال-نيو هيفن ترجمة وتقديم: سعيد البوسكلاويجامعة محمّد الأوّل-وجدة/جامعة زايد-أبو ظبي تقديم المترجم ننقل إلى القارئ العربيّ دراسة قيّمة ترصد تقليدا فكريّا كاملا في شرح كتاب...
قصة عمر الأرض
قصة عمر الأرض ترجمة وتقديم محمد أبركان جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس تقديم المترجم المقال الذي نترجمه هنا هو للفيزيائي هوبير كريبين Hubert Krivine؛ وقد سبق لهذا العالِم أن اشتغل باحثا ضمن بنية البحث بمختبر الفيزياء النظرية والنماذج الإحصائية بجامعة...
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية[1] تأليف: محسن كَدِيوَر[2] ترجمها عن الفارسية يونس أجعون[3]جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس (1)المقدمة 1. مكانة الفلسفة الإشراقية ضمن الفلسفة الإسلامية تُعدُّ الفلسفةُ الإشراقية أحدَ مدارس الفلسفة الإسلامية الثلاث، وقد...
جانبٌ من المنعطف السِّينوي في علم الكلام السُّنِّي
جانبٌ من الـمُنعطف السّينويّ في علم الكلام السُّنّي[1] روبرت ويسنوڤسكي[2]جامعة ماكگيل، مونتريال ترجمة هشام بوهدي[3]جامعة القرويين، الرباط تقديم الترجمة ما أنوي كتابته في هذه الفقرة المختصرة ليس تقديماً لمضمون المقالة ولا لصاحبها؛ لأنّ المقالة قد أصبحت من كلاسيكيّات...
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس مارون عواد المركز الوطني للبحث العلمي، باريس ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد جامعة القرويين، الرباط تقديم حظيت نظرية الشعر المنطقية باهتمام كبير من قبل الدارسين والمهتمين بالتآليف المنطقية للفلاسفة في السياقات الإسلامية؛ ويحتل...