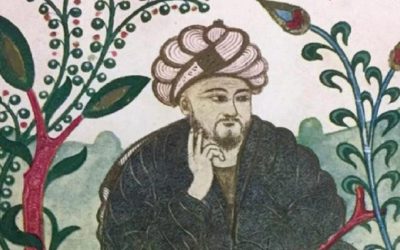![]()
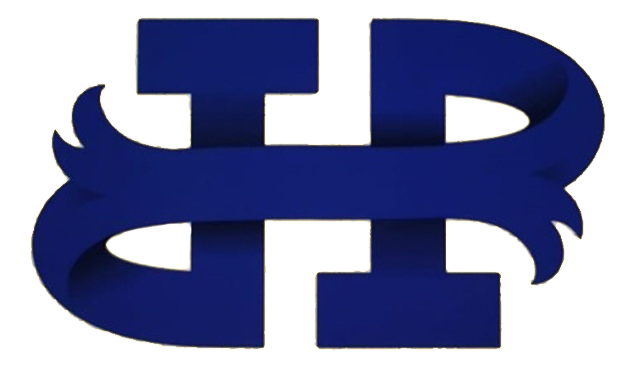
في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة

في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة[1]
وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra
ترجمة وتقديم محمد أبركان*
جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس
تقديم المترجم
صاحب المقال الذي نترجمه هنا هو وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra، الكاتب الفرنسي المتخصص في الصحافة العلمية. وعلى الرغم من أن ما ينشره هذا الكاتب يندرج، عموما، ضمن إشاعة الثقافة العلمية أو ضمن تعميم العلم La vulgarisation de la science، فإن مقالاته لا تخلو من إثارة أسئلة هامة، يمكن للباحث المتخصص أن يعمق البحث فيها. هكذا، فبعد أن درس البيولوجيا، انخرط في كتابة مقالات ونشرها في مجلات كعلوم ومستقبل Sciences et Avenir والبحث La recherche وغيرهما؛ كما أنه اشتغل متعاونا مع مؤسسات البحث العلمي من بينها الكوليج دُ فرانس Collège de France، ومعهد الدراسات المتقدمة بجامعة ستراسبورغ. ومن مقالاته، يمكن أن نذكر: ”عودة إلى المغامرة الكبرى للحياة على الأرض“ “Retour sur la grande aventure de la vie sur terre” والمنشور على موقع Sciences et Avenir[2] و”كوبرنيك أو فجر الانقلاب الأكبر“ “Copernic ou l’aurore d’un grand chambardement” والمنشور ضمن العدد نفسه الذي نشر فيه المقال موضوع ترجمتنا.
ويعالج المقال مسألة مرتبطة بتاريخ العلم. إذ يبحث فيه وليام رو-بيرا عن جذور ممكنة للفيزياء الحديثة؛ الشيء الذي يعني أنه ينخرط، من خلال هذا المقال، في أسئلة تواجه كل مؤرخ للعلم أو من يبحث في تاريخ الأفكار العلمية، والتي تتعلق، في مجملها، بنشأة المعرفة العلمية وبكيفية تطورها. والجدير بالذكر أن السؤال الذي يحرج بشكل كبير المشتغلين بهذا المجال هو الذي يتم التعبير عنه عادة بهذه الصيغة: كيف تتجدد المعرفة العلمية؟ وهذا السؤال يمكن صياغته بطرق مختلفة، يمكن أن تأتي كما يلي: كيف يتم الانتقال من طور تكون قد بلغته المعرفة العلمية خلال فترة تاريخية إلى طور آخر تصبح فيه هذه المعرفة تطرح أسئلة أخرى وتبني تصورا آخر حول العالم وحول الوقائع؟ أو بتعبير أكثر تداولا في الأوساط التي تشتغل بهذا المجال: كيف تتقدم المعرفة العلمية؟
ولعل الفترة التاريخية التي استأثرت باهتمام مؤرخي العلم هي الفترة التي يُطلق عليها فترة العلم الحديث؛ والأسئلة التي لا تزال مطروحة على من يشتغل بهذه الفترة تهم، أساسا، معرفة ما الذي حدث، وكيف، ومع من، أو من هم رواد العلم الحديث؛ لكن السؤال المتعلق ”بكيف حدث ما حدث؟“ يبدو الأكثر إحراجا. وإذا كان بالإمكان الإقرار بأن هذا السؤال يحرج المشتغل بالتاريخ بشكل عام، فكيف بالمشتغل بتاريخ الأفكار العلمية، ذلك أن هذه الأخيرة، قد يصدق عليها القول، إنها تنشأ بشكل يثير عدة أسئلة، كما أنها تنتقل بين الفترات وبين العلماء والثقافات والحضارات بشكل لا يسهل مهمة مؤرخ هذه النوعية من الأفكار.
ولئن كان صاحب المقال يتحرك ضمن دائرة الأسئلة السابقة، فإن اهتمامه ينصب عموما حول هذين السؤالين: كيف حدث ما حدث خلال الفترة التي نسميها في تاريخ العلم بفترة العلم الحديث؟ وهل كل ما حدث كان وليد بيئة علمية، أو سياق حضاري في استقلال عن سياقات حضارية أخرى سبقت هذه الفترة؟
وعلى الرغم من الطابع التقريري والتركيبي للمقال، فإن الذي حركنا إلى ترجمته هو أنه يسلط الضوء على مشكلة تشغلنا، إن تدريسا أو بحثا، ترتبط بتطور الأفكار العلمية عامة والأفكار في الفلك والكسمولوجيا قبل العصر الحديث خاصة. هكذا، ففي سياق تناوله لهذه المسألة لم يفوت فرصة الوقوف عند الإسهام الخاص بسياقات المسلمين من خلال الحديث عن بغداد كملتقى لمعارف تنتمي إلى حضارات مختلفة، وعن أسماء علماء أنجزوا ما أنجزوه ضمن هذه السياقات، كأبي الهذيل العلاف[3] (ت. 235𞸤/850م) و أبي عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني، المعروف بالبتاني (ت. 317𞸤/929م) والحسن بن الهيثم (ت. 432𞸤/1041م)، وأبي الحسن ابن الشاطر (ت.777𞸤/1375م )الذي يعرف الدارسون والباحثون في تاريخ علم الفلك مدى الشبه الكامن بين ما أورده صاحب نهاية السول في تصحيح الأصول بخصوص هيئة القمر وبين ما أورده مدشن الثورة الكوبرنيكية، أي كوبرنيك (Nicolas Copernic, d.1543). وهذه الأسماء التي يذكرها صاحب هذا المقال، سبق لدراسات أخرى أن انتبهت إلى أهمية إسهامها في مسيرة تطور الأفكار العلمية.[4]
وفي سياق الحديث عن المشكلة التي تثيرها نشأة العلم الحديث، وكيف تمت هذه النشأة، يخصص صاحب المقال جزءا من مقاله للحديث عما شغل كثيرا بال مؤرخي العلم والإبستملوجيين؛ ويتعلق بالدور الذي كان للمبدأ المعروف بـ”القصور الذاتي“ أو ”مبدأ العطالة“ في التجديد العلمي الحديث. وبإقراره بأن هذا المبدأ قد وصفه علماء صينيون منذ القرن الخامس قبل الميلاد، فإنه يدعو إلى ضرورة استئناف البحث في مسألة حدوث الثورة أو التجديد في العلم؛ وضمن هذا يدعو إلى عدم الانسياق وراء الاعتقاد بأن هذا التجديد يحدث بهدم كل ما بناه السابقون والبداية من الفراغ الذي تركه هذا الهدم. وما يقوله صاحب المقال عن مبدأ القصور الذاتي، يعيد إلى الأذهان ما فعله كوبرنيك بخصوص فرضية دوران الأرض، وعلاقة هذه الفرضية بما سبق منذ القرن الثالث قبل الميلاد أن فعله العالم اليوناني أرسطرخس الساموسي (ت. حوالي 320 ق م) عندما افترض أن الأرض ليست ثابتة.
هذا، وقد أورد صاحب المقال وليام رو بيرا فكرته بخصوص الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة في ثلاثة عناوين أساسية، هي على التوالي: بغداد، ”ملتقى المعارف الصينية والهندية والفارسية واليونانية،“ ثم ”الفلك امتياز للإمبراطور،“ ثم ”مبدأ العطالة الذي تم وصفه بالصين منذ القرن الخامس قبل الميلاد.“
——————————————————-
نص الترجمة
ينسب تاريخ العلوم لنفسه الكثير من الوجوه الأوروبية. في حين نجد أن بعض قوانين العالم قد اكْتُشِفَ خارج هذه القارة، وذلك خلال زمن بعيد. وعليه، فيتعين علينا التوجه نحو الشرق للعثور على أولئك الرواد الذين شكلت أعمالهم أسسا غير مباشرة للثورة العلمية الحديثة.
من بين الأسماء الكبرى في الفيزياء، يحفظ لنا التاريخ اسم كل من كوبرنيك وجاليلي وكيبلر ونيوتن[5] باعتبارهم مؤسسين للفيزياء الحديثة، وأيضا قبل هؤلاء، يحفظ لنا اسمي أنكسماندر [ت. 574 ق م] وأرسطو [ت. 322 ق م]. ولكننا نجد في الشرق، وأحيانا حتى قبل نظرائهم الإغريق، عقولا تميزت بالحدة في ميلها نحو البحث للتحقق من الكيفية التي يسير وفقها الكون. فإسهاماتهم الخيالية أحيانا، والرصينة في غالب الأحيان ، قد أسهمت بشكل غير مباشر في إرساء أسس الفيزياء الحديثة. ففي الهند، حوالي ست مائة عام قبل عصرنا (العصر الميلادي)، كان الحكيم كانادا Le sage Kanada أسس مدرسة فايشيشيكا الفلسفية L’école philosophique Vaisheshika التي تطرح في أحد قوانينها مسألة عدم اتصالية الكون، المشكل من الفراغ ومن مادة مركبة هي ذاتها من وحدات لا تتجزأ وغير قابلة للملاحظة، أي من ذرات. وقد كان هذا قبل قرون عديدة من مجيء الاغريقي ليوسيبوس Leucippe (القرن الخامس ق م)! وكذلك هناك فلاسفة الحركة الجاينية Les philosophes du mouvement jaïniste التي نشأت حوالي القرن العاشر قبل العصر الميلادي، حيث قدمت هذه الحركة فرضية مفادها أن هذه الوحدات بإمكانها أن تلتقي؛ كما أنه بإمكانها، نظرا لطبيعتها، أن تتفاعل نتيجة قوة التجاذب أو التنافر، مشكلة بهذا مجموعات متراكمة، أكثر اتساعا وتركيبا؛ فكما لو أن الأمر يتعلق هنا بمفهوم أولي للجزيء.
إن هذه الأفكار، التي لا يبدو أنها تأسست على قاعدة تجريبية أو على ملاحظة مباشرة، تندرج ضمن مسعى معرفي له غايات روحية وفلسفية أكثر من كونه مسعى لاكتساب معارف خالصة. غير أن هذا لا يمنعها، مع ذلك، من أن تشكل جهدا في سبيل فهم العالم.
لقد رافقت هذه النظريات الذرية القديمة، الثاقبة إلى حد ما بخصوص الواقع الفيزيائي للمادة نظرية متصلة بالعناصر. هكذا، ففي الوقت الذي يدافع فيه أنباذوقليس [ت. حوالي 430 ق م] عن كون الطبيعة مشكلة من أربعة عناصر أزلية، وهي الماء والهواء والنار والتراب، نجد فلسفة فايشيشيكا تكمل هذه الجواهر الأساسية بعنصر الأثير؛ كما ربطت (أي هذه الفلسفة) خصائصها بالحواس الانسانية؛ هكذا فالأرض تملك خصائص الذوق واللون والشم واللمس، عكس الهواء، الذي لا يحيل سوى على اللمس. وبعيدا في الشرق، وفي الصين تحديدا، نعثر على هذه النظرية الخاصة بالعناصر في مدرسة يان يونغ L’école de Yin-Yang بحيث جلبها إلى القرن الثالث قبل العصر الميلادي الفيلسوف زو يان Zou Yan، ويكمن الفرق بينها وبين ما نجده في نظرية العناصر في تعويض الهواء والأثير بالخشب والمعدن.
إن التفاعلات بين هذه العناصر المركبة والمتسمة بالدينامية، تشكل نظاما في التفكير، والذي نعثر عليه في كثير من مظاهر الحياة الصينية، كما أنها تسمح بتفسير الأمزجة الإنسانية والحواس كالشم والذوق، هذا بالإضافة إلى أنها تسمح بتفسير الكثير من الظواهر الطبيعية. وحسب المختص بالحضارة الصينية، البريطاني جوزيف نيدهام Joseph Needham 1900-1995)) فالفلاسفة الصينيون تناولوا الواقع الفيزيائي باعتباره جسما أو نظاما عضويا عاما، في تفاعل مستمر، ولا جدوى من البحث في تحديد أصله أو سببه أو صورته.
بغداد ملتقى للمعارف الصينية والهندية والفارسية والإغريقية
اعْتبرتْ العلوم العربية الإسلامية جهة الشرق الأوسط في العصر الوسيط، خلال مدة طويلة بمثابة تعقب للتأملات الإغريقية الكلاسيكية ومجرد امتداد لها؛ ولكنها في الحقيقة هي أكثر من هذا بكثير. فالرخاء الاقتصادي للإمبراطورية الأموية خلال القرن الثامن الميلادي عَبّد الطريق لإقلاع في التجديد، شمل ميدان الفلسفة الطبيعية، وبالأخص الرياضيات وتطبيقاتها الفيزيائية؛ وفي بغداد، في القرن التاسع للميلاد، وتحت حكم العباسيين، فُتحَ بيت الحكمة أمام العلماء، الذين كانوا يقصدونها لفحص وترجمة أعمال قدماء اليونان والسريان والسنسكريتيين؛ هكذا مثلت بغداد ملتقى للمعارف من الحضارات الصينية والهندية والفارسية والعربية واليونانية؛ هذه المعارف تم تجميعها ونسخها ودراستها. وهكذا، فأبو الهذيل العلاف (752-841) الذي تبنى نظرية الذرة، قد أدمج هذه الأخيرة في علم الكلام الإسلامي، وذلك بإسناده للتفاعلات الذرية إلى الإرادة الإلهية. أما عالِم الفلك العربي- الفارسي[6] الحازن، واسمه الحقيقي هو ابن الهيثم (965-1040)، فقد اعْتبرَ بمثابة أب لعلم المناظر[7]. إنه المخترع المفترض للغرفة السوداء؛ إنه أول من تكلم قبل فيرما[ Pierre de Fermat1601-1665] وكيبلر عن الضوء، كونه ينتشر على خط مستقيم، وكون سرعة انتشاره متناهية، وأنها تتغير حسب الوسط الذي يمر منه الضوء، ثم تضعف هذه السرعة مع المسافة التي يستغرقها الانتشار. وهكذا، فقد رفض النظرية التي دافع عنها أقليدس Euclide [ت. 265 ق م] وبطلميوس Ptolémée [ت. 170م] والتي مفادها أن العين ترسل شعاعا من الضوء من أجل الرؤية، بينما يؤكد ابن الهيثم بأن الرؤية تقوم على وجود أشعة خارجية تَرِد على العين. اكتشف ابن الهيثم، أيضا، سبب ظواهر أخرى كثيرة، منها خاصة، أن القمر يستمد ضوءه من الشمس؛ ثم، إنه كان في طليعة مؤسسي المنهج التجريبي، وذلك بالنظر إلى أنه كان يتحقق بشكل منظم من فرضياته بواسطة التجريب. وقد سار آخرون على خطاه، بحيث أخضعوا النظريات والمفاهيم اليونانية للملاحظة والتجريب؛ وأنتجوا بحق عقلا علميا عربيا وإسلاميا، بفضله عرفت مجموعة من المجالات أشكالا من التقدم كمجال الطب، ومجال الفلك بالخصوص؛ فالسلطة أو الحكم كان على استعداد لتمويل البحث في هذا المجال (مجال الفلك) على مدى واسع، نظرا لانخراطه في الحياة الدينية وتطبيقاته العملية، كالإبحار عبر المحيط الهندي، وتحديد التوقيت في إطار جداول فلكية.
ولكن، إذا كانت الرغبة المشتركة في فهم الطبيعة قد سكنت مفكري الشرق والغرب معا، فإنهم لم يعتمدوا نفس المقاربة العلمية؛ وفي هذا السياق نجد الفيزيائي الفرنسي ميشيل سوتيف Michel Soutif يوضح هذه الظاهرة بمثال علماء اليونان وعلماء الصين؛ إذ حسب وجهة نظره يبقى بزوغ الفكر العقلاني قد تم تقريبا في نفس عصر سياق هاتين الحضارتين وذلك بمساعدة التقسيم الترابي للسلطة؛ فمن جهة هناك مدن- دول Cités-Έtats ومن جهة أخرى هناك إمارات فصول الربيع وفصول الخريف. و قد كان هذا التقطيع حاسما، لأنه كان يسمح للمفكرين بالهروب من الأنظمة التي تمارس عليهم القهر كلما تعارضت أفكارهم مع العقيدة.
علم الفلك امتياز للإمبراطور
لقد رأينا، بخصوص سؤال تَكَوّن أو تَشَكّل المادة، كيف أن التماثل بين نظرية العناصر لكل من أنباذوقليس وزو يان واضح. وبالمقابل، فالمقاربات تتشعب في دراسة الميكانيكا والحركات. لقد كان اليونان أصحاب رؤية نظرية محملة بتمثلات رمزية. فالتفوق في الهندسة بالخصوص، وتلاميذ السلك الاعدادي والثانوي يمكن أن نتخذهم كأمثلة ساطعة، فعند اكتشافهم لطاليس Thalès [ت. حوالي 546 ق م] وفيثاغورس Pythagore [ت. حوالي 495 ق م] وأيضا أرخميدس Archimède [ت. حوالي 212 ق م ] أصبحوا يدرسون جيدا الأنظمة الستاتيكية. لكن صعوبة تعلمهم للزمن كمتغير تُوَلّد لديهم نوعا من سوء فهم ظواهر الانتشار، كانتشار الضوء مثلا.
إن النهج الصيني كان أكثر برغماتية، كما يشدد على القول جون مارك بوني بيدو J. Marc Bonnet-Bidaud عالم الفلك الفيزيائي، الفرنسي وعضو اللجنة المركزية للطاقة النووية والطاقات البديلة (CEA) ”إنه نهج يتأسس على البحث في الواقع بواسطة التجربة. فعلماء الصين يلاحظون ويقارنون؛ إن مقاربتهم شمولية؛ وهي التي تشبه إلى حد كبير المقاربة التي تتحكم في العلم الحديث.“ إنهم (علماء الصين) يفضلون، خاصة، الجبر على الهندسة، وهو العلم الذي يقيس العالَم بالحساب. وهذا الشبه مع الفيزياء المعاصرة يظهر بوضوح في علم الفلك. والتقارير التي تُقدم عن أرصاد مستعر أعظم Supernovas، بعضها قديم بحوالي ألفي سنة، تنحصر، تقريبا، في توفير معلومات دقيقة من دون نظرية مسبقة.
نجد هذه الدقة، أيضا، في الفعالية المميزة لوضعهم للجداول الزمنية المضبوطة بشكل قل نظيره. وباستكمالهم (علماء الصين) لأرصادهم بواسطة الحساب، تمكنوا من إنشاء روزنامات يومية يتم إسقاطها على مئات السنين. وقد كانت وسيلتهم الوحيدة هي الجبر، وخصوصا الحسابات —وهو استكمال من الدرجة الثانية والثالثة— والتي لن تعرف تطورا في الغرب إلا مع نيوتن بعد عدة قرون. وبهذه الحسابات، كان لهم أن يتنبؤوا بكسوفات الشمس وخسوفات القمر، متى يمكن أن تحدث بالدقيقة تقريبا. وهذه التنبؤات، كما يوضح جون مارك بوني بيدو ، ”هي على درجة من الأهمية، لأنه، ولمدة طويلة، بقي علم الفلك في الصين بمثابة امتياز للإمبراطور ، والذي كان يعتبر نفسه حارسا للتناغم الموجود بين الأرض والسماء، وذلك بفضل تأويل قائم على تنبؤ إلهي ببعض الأرصاد.“
مبدأ العطالة أو القصور الذاتي الذي تم وصفه في الصين منذ القرن الخامس قبل العصر الميلادي
بكيفية عامة، يمكن القول، إن الفلاسفة الطبيعيين الصينيين كانوا يرصدون الظواهر السماوية المتنقلة أو العابرة، كالمذنبات؛ والثابتة كالبقع التي تظهر على الشمس؛ ولكنهم برعوا، أيضا، في دراسة الخصائص المغناطيسية، وهي الدراسة المنجزة، على سبيل المثال، من طرف الموسوعي شين كيو (1095 -1031 Shen Kuo) والذي وصف، و بتفصيل، كيفية استعمال البوصلة المغناطيسية؛ كما برعوا في دراسة الميكانيكا، والفضل يرجع في هذا الأمر إلى أعمال طائفة مسالمة، هي طائفة الموحيينLes Mohistes خصوصا. كان هؤلاء يطرحون، منذ القرن الخامس قبل الميلاد، فرضية كون ”توقف حركة جسم ما يعود إلى قوة مضادة، وبدون هذه القوة فحركته لن تتوقف أبدا أو ستبقى مستمرة.“ وقد كان يجب انتظار ألفي سنة حتى يصبح مبدأ العطالة أو القصور الذاتي مصاغا بهذه الصيغة المعروفة في أوروبا.
وعليه، فكيف يمكن أن نفسر كون أغلبية المؤسسين للعلم، المعترف بهم، يحملون أسماء أوروبية؟ في هذا السياق يلاحظ جون مارك بوني: ”يدو أن أوروبا استعارت الكثير من النتائج التي توصلت إليها من بقية أنحاء العالم؛ وهو دَينُ، لا بد من بذل جهد للاعتراف به؛ فكل العلم الأوروبي تأسس على مكتسبات أدمجت بسرعة في فترة الثورة العلمية الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر.“ إن فلكيي الصين كانوا على معرفة بالبقع التي تظهر على الشمس، وذلك منذ سنة 28 قبل العصر الميلادي، هذا قبل أن يلاحظها جاليلي بمدة طويلة سنة 1610. ويرى بعض مؤرخي العلم أن كوبرنيك، مهندس نظرية مركزية الشمس ، كان قد تأثر بأعمال فلكيين عرب كالبتاني الذي عاش خلال القرن العاشر [ت. 929م] وكابن الشاطر الذي عاش في القرن الرابع عشر [ت. 1375م]؛ فإذا كانت لهذين الأخيرين رؤية تستند إلى أن الأرض هي مركز الكون، فالنماذج الرياضية التي اقترحاها لحركة الكواكب هي نفسها التي تظهر في النظرية الكوبرنيكية. ولكن، كيف تمكنت هذه الأفكار من أن تتنقل عبر الأجيال و عبر الحدود المادية والثقافية؟ إننا نعلم أن المعارف كان بإمكانها أن تنتشر عبر مخطوطات مستنسخة و منشورة. والحال، أن كوبرنيك قد درس في إيطاليا في فترة كان يُتداول فيها مخطوط بيزنطي، يضم نظريات ابن الشاطر؛ فهل حقا اطلع على هذا العمل؟ هذا ما لا تسمح الأبحاث [التي أجريت حتى الآن: المترجم] بتأكيده.
يخلص جون مارك بوني إلى أن ”الأمر لا يتعلق بوضع تراتبية فكرية بين الحضارات. فهذه الأخيرة مغمورة في أوساط وسياقات قد تسمح لها وقد لا تسمح، خلال فترة من الزمن، للتعبير عن قدراتها. والحال، أننا يجب أن نفهم أن العقول الأوروبية خلال العصر الوسيط كانت تخضع لإيديولوجيا دينية، تمنع عليها دراسة مواضيع معينة دراسة علمية، مواضيع كانت السلطة الكنسية تلقي على عاتقها مسؤولية مراقبتها بنفسها، وذلك في حدود معينة. والعلم الحديث، تطور في أوروبا في الفترة التي كانت فيها الثقافة قادرة على استيعاب المفاهيم الأساسية وتحرير بحثها في مجال المعرفة.
للتوثيق
رو-بيرا، وليام. ”في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة.“ ترجمة وتقديم محمد أبركان. ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/3815>
محمد أبركان
* خضعت هذه الترجمة للتحكيم؛ لهذا، فالواجب يقتضي أن أتقدم بالشكر الجزيل للذي قام بهذه المهمة العلمية النبيلة؛ كما أفادني الدارس فؤاد بن أحمد بملاحظات أشكره عليها جزيل الشكر.
[1] العنوان الأصلي والمصدر: ”“Aux origines orientales de la physique moderne والمقال منشور بمجلة علوم ومستقبل Sciences et Avenir، عدد خاص، 212 (يناير/مارس 2023).
[2] انظر: htts://www.sciencesetavenir.fr (11-2-2023)
[3] يذكر صاحب المقال اسم هذا المتكلم، وهو من شيوخ المعتزلة في الإسلام، باعتباره أحد الذين تبنوا النظرية الذرية، وربما يقصد تبنيه لنظرية الجوهر الفرد؛ وعن تفاصيل هذه النظرية كما هي متبناة من قبل العلاف والمتكلمين، يمكن العودة إلى: شلومو بينيس، ”مذهب الجوهر الفرد في علم الكلام“ ضمن مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، ومعه فلسفة محمد بن زكريا الرازي، نقله عن الألمانية محمد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1946)، 1–34.
[4] هناك دراسات تناولت التأثير المفترض لمنجز المسلمين على ما حدث في الفترة الحديثة من تجديد علمي. ونجد كل دراسة من هذه الدراسات قد تناولت هذا الأمر بإثارة مسألة من المسائل التي تهم كيفية فهم ما حدث. ويمكن للقارئ أن يراجع هذه الدراسات: جورج صليبا ”الاتجاهات الحديثة في دراسة تاريخ العلم العربي،“ ضمن دراسات عربية إسلامية مهداة إلى الدكتور مارسدن جونز (بيروت: منشورات الجامعة الأمريكية، 1997)، 105–124. وأشكر فؤاد بن أحمد إذ أمدني بهذه المقالة.
Régis Morelon, “Une proposition de lecture de l’histoire de L’astronomie Arabe,” in De Zénon d’Elée à Poincaré, recueil d’études en hommage à Roshdi Rashed. Edité par Régis Morelon et Ahmed Hasnawi (Paris: Louvain Peeters, 2004), 237–249;
بناصر البعزاتي، ”جذور التجديد الفلكي الكوبرنيكي،“ ضمن التجديد والتقليد في العلم، تنسيق بناصر البعزاتي (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2003)، 103–138؛ و كذلك محمد بن ساسي، ”في منزلة ابن الهيثم من الثورة العلمية الحديثة أو الثورة العلمية من منظور جديد،“ ضمن ابن الهيثم العالم الفيلسوف (تونس: منشورات نيرفانا، 2016)، 159–190. ونورد هذه الدراسات للاستئناس فقط، وإلا فهي لا تذهب إلى ادعاء أن هذا المنجز العلمي للمسلمين كان له تأثير مباشر وواضح على ما جاء به كوبرنيك، وإنما تحاول أن تبين أنه لا يجب، ونحن نؤرخ للعلم، أن نتجاهل فترة من فتراته التاريخية أو نقلل من شأنها دون أن نتعرف على الأفكار والفرضيات والجهود التي تمت فيها.
[5] [ Nicolas Copernic 1474-1543], [Galilée Galileo 1564-1642], [Johannes Kepler 1571-1630], [Isaac Newton 1647-1727].
[6] [لانعرف شيئا عن الأصل الفارسي لابن الهيثم، ما نعرفه حسب ما تمدنا به كتب التراجم والطبقات هو أن ميلاده كان بالبصرة: المترجم]
مقالات ذات صلة
الآبلي شيخُ ابن خلدون
الآبلي شيخُ ابن خلدون ناصيف نصار[1] ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد تقديم نُشر مقال ناصيف نصار الذي نترجمه هنا بالمجلة الآتية: Studia Islamica, 1964, No. 20 (1964): 103-114. والمقال من الدراسات القليلة والباكرة التي تعرضت لهذا الموضوع الملغز، أعني علاقة الفيلسوف والرياضي...
اعتبارات الماهية: الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي
Iʿtibārāt al-Māhiyah:al-Ibdāʿ al-Sīnawī, wa Ibtikār al-Mudarris al-Zanūzī اعتبارات الماهيّة: الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي رامين عزيزي وجهنكير مسعودي جامعة فردوسي، مشهد ترجمها عن الفارسية الهواري بن بوزيان جامعة المصطفى العالمية، قم...
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي لويسْ خَابْيِيرْلُوبيثْ فارْخَاتْجامعة بَانْأمريكَانَا-مكسيكو سيتي ترجمة محمد الولي[1]جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس كثيرة هي الدراسات التي أنجزت في العالم العربي حول دمج كتابي الخطابة والشعر لأرسطو ضمن الأورغانون. وإذا تم الاتفاق...
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م)
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م) خوليو سامسو نقله من الإسبانية إلى العربية مصطفى بنسباعجامعة عبد المالك السعدي-تطوان تقديم رغم أن كتاب علوم الأوائل في الأندلسLas ciencias de los antiguos en al-Andalus للأستاذ خوليو سامسو Julio Samsó قد صدر سنة...
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل* هانس ديبرترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد تقديم الترجمة هانز دايبر مستشرق ألماني من مواليد عام 1942. حصل على الدكتوراه عام 1968. واشتغل أستاذًا للغة العربية والإسلام في الجامعة الحرة بأمستردام من عام 1977 إلى...
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘: ملاحظات أوليّة
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘ملاحظات أوليّة[1] تأليف: ل. فان ليتجامعة يال-نيو هيفن ترجمة وتقديم: سعيد البوسكلاويجامعة محمّد الأوّل-وجدة/جامعة زايد-أبو ظبي تقديم المترجم ننقل إلى القارئ العربيّ دراسة قيّمة ترصد تقليدا فكريّا كاملا في شرح كتاب...
قصة عمر الأرض
قصة عمر الأرض ترجمة وتقديم محمد أبركان جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس تقديم المترجم المقال الذي نترجمه هنا هو للفيزيائي هوبير كريبين Hubert Krivine؛ وقد سبق لهذا العالِم أن اشتغل باحثا ضمن بنية البحث بمختبر الفيزياء النظرية والنماذج الإحصائية بجامعة...
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية[1] تأليف: محسن كَدِيوَر[2] ترجمها عن الفارسية يونس أجعون[3]جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس (1)المقدمة 1. مكانة الفلسفة الإشراقية ضمن الفلسفة الإسلامية تُعدُّ الفلسفةُ الإشراقية أحدَ مدارس الفلسفة الإسلامية الثلاث، وقد...
جانبٌ من المنعطف السِّينوي في علم الكلام السُّنِّي
جانبٌ من الـمُنعطف السّينويّ في علم الكلام السُّنّي[1] روبرت ويسنوڤسكي[2]جامعة ماكگيل، مونتريال ترجمة هشام بوهدي[3]جامعة القرويين، الرباط تقديم الترجمة ما أنوي كتابته في هذه الفقرة المختصرة ليس تقديماً لمضمون المقالة ولا لصاحبها؛ لأنّ المقالة قد أصبحت من كلاسيكيّات...
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس مارون عواد المركز الوطني للبحث العلمي، باريس ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد جامعة القرويين، الرباط تقديم حظيت نظرية الشعر المنطقية باهتمام كبير من قبل الدارسين والمهتمين بالتآليف المنطقية للفلاسفة في السياقات الإسلامية؛ ويحتل...