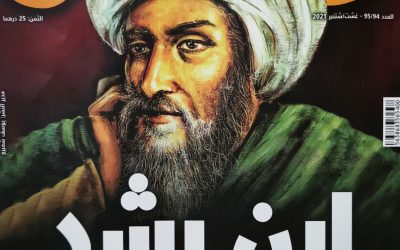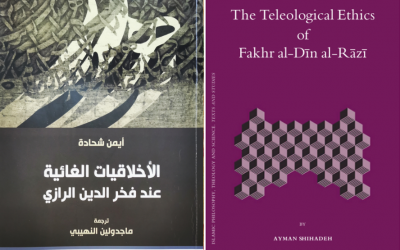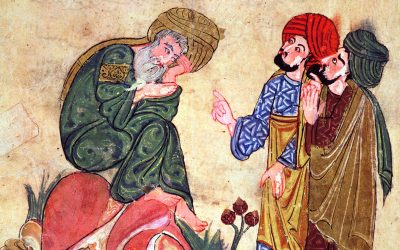![]()
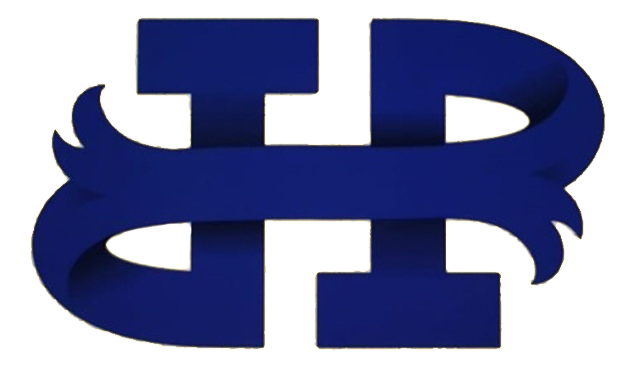
الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري گوتاس: قراءة نقدية في الترجمة العربية

ملخص
صدر كتاب ديمتري گوتاس، الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية العربية في بغداد وفي المجتمع العباسي المبكر (القرن الثاني-الرابع للهجرة/القرن الثامن-العاشر للميلاد)، عام 1998. وقد صار اليوم من المراجع الكلاسيكية في الموضوع. وقد انتبه الدارسون مبكرا إلى أهميته بالنظر إلى التحليلات الجديدة التي قدمها بخصوص التلاقح العلمي الذي حصل عند المسلمين والعرب بفعل الترجمة؛ إذ إنه قبل انتهاء القرن العاشر للميلاد، كان جميع ما ألفه اليونان في الفلسفة والمنطق والطبيعيات، علم التنجيم والكيمياء وعلم النبات والطب… قد نقل إلى اللغة العربية. لذلك يحاول الفكر اليوناني والثقافة العربية أن يقف عند العوامل الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية الرئيسية التي كانت وراء حركة الترجمة غير المسبوقة من اليونانية إلى العربية في بغداد، خلال القرنين الأولين من حكم العباسيين. فقد انتبه إلى الأطر الدينية والاجتماعية والسياسية التي لعبت أدوارا أساسية في هذه الترجمات. وقد اعتمد ديمتري غوتاس على ما تراكم من دراسات تاريخية وفيلولوجية سابقة لكي يحلل الأسباب الاجتماعية والتاريخية لهذه الظاهرة. وفي الواقع، فإن كتاب غوتاس يقدم مسحًا موثقًا لهذه الحركة الضخمة في نقل الثقافة اليونانية القديمة إلى العصور الوسطى. لهذا، ولغيره، عدت ترجمة كتاب غوتاس عام 2003 حدثا ثقافيا هاما. وفعلا فقد حصل الاحتفاء به في وسائل الاعلام العربي، وتلقف المثقفون العرب الترجمة بالكثير من الترحاب، فعقدت له مناقشات ولقاءات للنظر في الجديد الذي أتى به.
مقالنا يسلط الضوء على مسألة أساسية، وهي إلى أي حد ساعدت الترجمة العربية على إجراء نقاشات علمية سليمة ومفيدة؟ محاولة للجواب، وقفنا عند الأخطاء الكثيرة والفجة التي تخللت الترجمة العربية والتي تجعل استعمال الكتاب لأغراض علمية أمرا مستحيلا.
Abstract
Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘abbāsid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries) by Dimitri Gutas is published in 1998. Today it has become one of the classics on the topic. Scholars realized its importance very quickly, given the new analyses it presents concerning the scientific fertilization that occurred among Muslims and Arabs at that time. Before the end of the 10th century AD, everything that Greece wrote in scientific disciplines (such as philosophy, logic, physics, astronomy, optics, astrology, alchemy, botany and medicine) was translated into Arabic. Therefore, Greek thought and Arab culture attempt to examine the main social, political and ideological factors that were at the origin of this unprecedented movement of translation from Greek into Arabic in Baghdad during the first two centuries of Abbasid rule. Gutas’ book paid attention to the religious, social, and political frameworks that played an essential role in these translations. Dimitri Gutas used the accumulated historical and philological studies to analyze the social and historical causes of this phenomenon. Indeed, Gutas’ book provides a well-docume study of this massive movement of transfer of ancient Greek culture to the Middle Ages. For this, and for other reasons, the publication of the Arabic translation of Gutas’ Book in 2003 was a significant cultural event. Indeed, it was well received by the Arab media and many intellectuals welcomed the translation with great appreciation. Meetings were held to discuss its new features and findings.
This article raises a fundamental question: To what extent does the Arabic translation help lead to sound and useful scientific debates about the book? In an attempt to answer this question, the paper focuses on the many serious flaws that have plagued the Arabic translation and made it impossible to use the book for any academic purpose.
مقدمة
كيف يمكن خوض نقاش جدّي حول كتاب مُترجَم معَ أن ترجمته بالذات تقف دون استيعاب مواقف صاحبه؟ هذا ما حصل بالذات مع كتاب الدّارس الأمريكي-اليوناني ديمتري گوتاس، الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية العربية في بغداد وفي المجتمع العباسي المبكر (القرن الثاني-الرابع للهجرة/القرن الثامن-العاشر للميلاد)، في ترجمته التي أنجزها المؤرخ الراحل نِقولا زِيادة. فقد بادر الناس في العالم العربي إلى الكلام عن أهمية الكتاب؛ وصارت الترجمة مرجعا يتداوله الطلبة والباحثون؛ وخُصصت للكتاب مناقشات وقراءات عدة في منابر إعلامية مكتوبة ومسموعة ومرئية. فهذا خالد الحروب في قناة الجزيرة يدعو مهتمين إلى مناقشة الأثر المحتمل لترجمة هذا الكتاب في إغناء الفكر العربي المعاصر. وآخرون يشيدون بأهمية الأسئلة التي طرحها گوتاس ”المعرَّب“ عن الدور الذي لعبته ترجمة كتاب المقولات لأرسطو، وعن الحاجة إلى هذه الترجمة في عهد الخليفة المهدي العباسي (158هـ-169هـ/775م-785م).
وبالجملة، فقد أحدث ظهور الترجمة العربية لكتاب گوتاس ردود فعلٍ انتقينا منها ثلاثة أوضاع:
الوضع الأول:
يقول الدكتور ابراهيم العاتي متحدثا عن أمر الترجمة العربية للفكر اليوناني: ”هو اهتمام شرائح متعددة، شرائح اجتماعية، واهتمام الدولة أيضًا، اهتمام الدولة بالذات، يعني قبل كل شيء، بترجمة العلوم لحاجاتٍ عملية تطبيقية […]، ولحاجات أيضًا سياسية، ولحاجات أيضًا دينية، تخص يعني موضوع الجدل، يعني ترجمة مقولات أرسطو: كتاب المقولات [كذا] أو منطق أرسطو الذي الجدل يعتبر بجد فيه جزءًا هاما وأساسيا منه.“[1] والمتحدث هنا عميد للدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في لندن.
الوضع الثاني:
وقد ورَد فيه: ”وتحت عنوان: ”المهدي والحوار الاجتماعي والديني وحركة الترجمة“، عالج المؤلف جملة من القضايا المهمة، وأولها الأسباب التي دفعت الخليفة العباسي المهدي بن أبي جعفر المنصور إلى طلب ترجمة كتاب المقولات [كذا] لأرسطو إلى اللغة العربية […]. ويقول الباحث إن الخليفة المهدي لم يكن معنيًا بالكتاب بسبب مكانة هذا الكتاب في الدراسات المنطقية اليونانية، وإنما لأنه يعلِّم فن الجدل والمناقشة على أسس منطقية ويزوِّد الفرد بقواعد المناقشة بين خصمين، السائل والمجيب له. ويتساءل الباحث إذا كانت هذه طبيعة كتاب المقولات [كذا] فما حاجة الخليفة المهدي إلى مثل هذا الكتاب؟ ويجيب عن ذلك بقوله إن المهدي تعرَّض لمحاورين أقوياء، فقد انتشرت ”الفرق المانوية“ المختلفة وغيرها من أشكال الزندقة في أرجاء البلاد، […] كما كان المسيحيون واليهود خصومًا من الناحية الفكرية لاسيما أنهم كانوا يملكون خبرة في الحوار بين الأديان. وبالتالي فقد كانت الحاجة ماسة، في مثل هذا الجو، إلى ”دليل“ بالعربية لتعليم فن الحوار والمجادلة، ولهذا نُصح المهدي من قبل مستشاريه بترجمة كتاب المقولات [كذا] لأرسطو. ويؤكد الباحث أن الخليفة المهدي قد قرأ الكتاب بعناية وأتيحت له فرص تطبيقه، وبالتالي كان أول مسلم يدافع عن الإسلام في حوار مع بطريرك النساطرة الذي يبدو أنه هو نفسه الذي عهد إليه المهدي بترجمة كتاب المقولات [كذا].“[1]
الوضع الثالث:
وتقول فيه إحدى الدّارسات: ”وحيث إن المهدي قد تعرض إلى خصوم محاورين أقوياء، كان بحاجة ماسة إلى ”دليل“ بالعربية يمكن أن يعلم فن المحاججة والمجادلة، فلم يكن أقل من كتاب المقولات [كذا] لأرسطو.“[2]
طبعا، هذه الأوضاع الثلاثة ليست سوى عَيّنة قليلة جدا بالقياس إلى الانتشار الذي عرفته الترجمة العربية لكتاب گوتاس التي ما تزال تستعمل من قبل الطلاب والباحثين والأساتذة الجامعيين.[3]
ولكن، ماذا لو اعترض معترض بالقولين الآتيين: أولا، إن ديمتري گوتاس بريء تماما مما نسب إليه من دعاوى واردة في الوضعين معا؛ ومن ثم، ثانيا، فهذا النقاش الذي أثارته هاته التعليقات التي أوردناها فاسد الأساس؟
تجد هنا، أيها القارئ الكريم، تفاصيل هذين الاعتراضين.
يحمل كتاب ديمتري گوتاس العنوان الآتي:Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries). London: Routledge, 1998. [وسنحيل عليه من الآن فصاعدا بـ”النص الأصلي“]؛ وقد أنجز ترجمته، كما ذكرنا أعلاه، نِقولا زِيادة، ونُشرت في بيروت عن المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية، عام 2003. والترجمة مرخص لها بموجب اتفاق مع دار النشر الأصلية؛ وقد نُشرت بالعنوان الآتي: الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية-العربية في بغداد وفي المجتمع العباسي المبكر [وسنحيل عليها من الآن فصاعدا بـ”الترجمة العربية“]. ويحق للجهة الناشرة أن تفخر بكونها قد افتتحت سلسلة أعمالها المترجمة بإصدار عمل عن دور مشاريع الترجمة في إخصاب الثقافة في السياقات الإسلامية قديما. ولذلك، فقد قدمت عملَ گوتاس شهادةً عن الدور الذي تريد، أي المنظمة، القيام به في هذا العصر.
لكن الذي نأسف له، وهو مصدر حرج حقيقي لمشروع المنظمة خاصة وللدينامية الفكرية العربية المعاصرة عامة، هو أن الترجمة قد جاءت مخيبة للآمال. وفي الحقيقة، منذ أن قرأتُ الترجمة العربية لم أتمكن من أن أطرد عن ذهني فكرة تملكتني، وهي أن المترجم قد ترك وراءه عملا مليئا بالأخطاء، عملًا يوحي لمن يقرؤه بفكرة أنه كان في مواضع كثيرة من الكتاب يُترجم ما لا يفهم. ومن ثم، فإنه قد عمد إلى تشويه دعاوى گوتاس حيث كان ينبغي أن يقربها من القارئ بالعربي. فالكتاب يعج أخطاءً تنم عن تسرع، وعدم فهم، وعدم مراجعة. وهذه كلها أمور تنطبق على ترجمة زِيادة وليس على شخصه، بطبيعة الحال. وأرجو وأن يُدرك هذا، حتى لا تُحسب علينا إساءة ما لشخص غادرنا قبل بضع سنين، بعد أن خدم البحث التاريخي العربي خدمة لا ينكرها أحد.
ولا مجال هنا لأن نقوم بمراجعة شاملة لمجموع الكتاب، إذ الأَوْلى بنا عندئذ أن نترجم الكتاب من جديد، وهو ما لا قِبَلَ لنا به الآن؛ لذلك فقد ارتأينا، أن نقصر مراجعتنا على بعض الفِقر من الفصل الثالث تحديدا، وأخرى من مواضع متفرقة من الكتاب، عسى أن ينهض غيرنا إلى ترجمة هذا العمل المفيد.
ونبدأ بعنوان الفصل الثالث بالإنجليزية، كما ورد في فهرس المحتويات وفي متن الكتاب (النص الإنجليزي، x ، 61). فهو كما يلي:
AL MAHDI AND HIS SONS: Social and Religious Discourse and the Translation movement
أما في ترجمة نِقولا زِيادة فقد صار كما يلي: ”المهدي والحوار الاجتماعي والديني وحركة الترجمة،“ (انظر الترجمة العربية، 7، 119). وهكذا فقد أسقط نِقولا زِيادة عَقِب المهدي من العنوان؛ وكأن هؤلاء لم يكن لهم من دور في تنشيط عملية نقل النصوص اليونانية إلى اللسان العربي، حسب زِيادة!
ويستهل ديمتري گوتاس هذا الفصل الثالث من كتابه بفقرة عَنوَنها: “The exigencies of inter- faith discourse: Aristotle’s Topics and Muslim-Christian Dialogue”؛ ويعالج فيها أهمية نقل كتاب الطوبيقا Τοπικά أو المواضع الجدلية لأرسطو، بطلبٍ من المهدي، في توفير الشروط الأولية لبلورة نقاشات ذات طبيعة عقائدية بين المسلمين والمسيحيين. أما في ترجمة نِقولا زِيادة (الترجمة العربية، 7، 119) فقد استحال عنوان الفقرة بالإنجليزي إلى ما يلي: ”بداءات الحوار بين المذاهب: كتاب المقولات لأرسطو والحوار الإسلامي المسيحي.“ وفضلا عن فساد ترجمة “The exigencies” بـ”بداءات“ بدل ”مقتضيات“، والمقصود الشروط المسبقة للخطاب البيـ-ديني، فقد استحال كتاب المواضع بما هو تنظير لصناعة الجدل: أي تحديد المقدمات والأقاويل والمواضع المستعملة في صناعة الجدل، قلت استحال كتاب المواضع كتابا للمقولات. فما علاقة كتاب المقولات بمناخ الجدل الديني أيام المهدي؟ سؤال كان ينبغي أن يطرحه نِقولا زِيادة، ومن ناقش الكتاب في ترجمته العربية، على أنفسهم.
وليت الأمر يتعلق بسهو منحصر في عنوان فقرة، لأن المفاجأة غير السارة التي تنتظر قارئ الترجمة العربية هي أن مترجمها قد صار على نهجه الخاطئ في ترجمته الفصل الثالث كاملا، وفي مواضع أخرى من الكتاب.
ويمكن أن نضيف إنه ليس كتاب الجدل أو الطوبيقا وحده ما أحاله قلم المترجم إلى كتاب آخر، بل إن كتب كثيرة لأرسطو قد عرفت المصير ذاته. كما أنه ليست أسماء الكتب الأرسطية وحدها التي عرفت تحريفا مجانيا، بل أسماء بعض الكتب الأخرى والشخصيات التاريخية وأقوال مفكرين آخرين أوردها ديمتري گوتاس في كتابه.
ونود قبل أن نستعرض وجوه التحريف لعناوين كتب المعلم الأول وغيره، أن نذكر أولا ما حصل لقول إدوارد سعيد ولشخصية المنصور. وهكذا، فقد صار الخليفة العباسي المنصور (حكم بين 136هـ-158هـ/754م-775م) عند گوتاس (النص الإنجليزي، 62) هو ابنه الخليفة المهدي عند نِقولا زِيادة (الترجمة العربية، 122)، من جهة. ومن جهة ثانية، تعرض قول سعيد للبتر، مما جعل فكرته تتخذ صيغة مطلقة بينما هي في الأصل ذات صيغة مقيدة بـ “Partly”. وهكذا، فقد افتتح گوتاس كتابه باقتباس من إدوارد سعيد (النص الأصل، vii)، يقول فيه: “Partly because of empire, all cultures are involved in one another; none is single and pure, all are hybrid, heterogeneous, extraordinarily differentiated, and unmonolithic” ؛ أما في ترجمة نِقولا زِيادة فقد صار قول سعيد كما يلي: ”بسبب من وجود الإمبراطورية، فإن جميع الثقافات متشابكة الواحدة مع الأخرى؛ ولا وجود لثقافة متفردة ومصفاة. جميعها هجينة ومتغايرة الخواص ومتباعدة إلى حد بعيد ومجزأة،“ (الترجمة العربية، 6). ولأول وهلة يظهر وكأن سهوا قد حصل بخصوص سقوط “Partly”، لكن يظهر أن المشكل ربما أعمق، خاصة عندما نقف في خاتمة الكتاب على استرجاع ديمتري گوتاس للدواعي التي جعلته يستشهد بقول إدوار سعيد في بداية كتابه. فقد نقل المترجم قول سعيد وكأنه لم يترجمه قبل ذلك، كما يلي: ”جميع الثقافات متداخلة واحدتها في الأخرى؛ وليس منها أيها متفرد وطاهر، وذلك بسبب الإمبراطورية على نحو جزئي،“ (الترجمة العربية، 308). وللقارئ أن يقارن بين الترجمتين ليتبين مدى التحريف الذي لحق قول سعيد على مستوى الألفاظ المستعملة وعلى مستوى الدعوى التي يحملها، وبالأساس على مستوى الصيغة (المطلقة أو المقيدة) التي صاغ بها سعيد دعواه. بناءً على هذا، بدا لنا أن نسأل سؤالا بسيطا: هل كان مترجم كتاب ديمتري گوتاس هو الشخص الواحد نفسه، أعني نِقولا زِيادة، أم كان هناك أكثر من مترجم؛ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تباعد الألفاظ المستعملة في الترجمة الأولى لقول سعيد عن أسماء الترجمة الثانية للقول ذاته الوارد في الخاتمة؟ ومهما يكن الأمر، فهذه الفروق دليل على أن النص لم يراجع.
وبغض النظر عن كل ما سبق، فإن الشخصية الفكرية التي عانت أكثر من غيرها من ترجمة نِقولا زِيادة هي أرسطو. فقد كان الرجل سيء الحظ، من جهة أن أغلب كتبه المذكورة في كتاب گوتاس تُرجمت ترجمةً غالطة ومُغلِّطة.
ويأتي استنكارنا ما صنعه نِقولا زِيادة بكتاب الطوبيقا لأرسطو من أن الرجل قد استعمل المقولات عنوانا لكتابين مختلف أحدهما عن الآخر: الطوبيقا وكاطيقورياس (الترجمة العربية، 245). صحيح أن الكتابين معا قد صنفهما التقليد المشائي ضمن ما عُرف بالأورغانون الأرسطي. لكن المعروف المشهور هو أن المقولات هو العنوان العربي الذي وضعه المترجمون لكتاب كاطيغورياس؛ وهو أول كتاب من كتب المنطق، كما وضعه أرسطو؛ أما كتاب الطوبيقا فقد ترجم إلى العربي بالطوبيقا وبالمواضع وبالمواضع الجدلية وبالجدل، وهو يأتي خامسا في ترتيب كتب المنطق.
وأما الكتاب المعروف بالحس والمحسوس أو Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶνلأرسطو وهو الذي عرف عند اللاتين بـ De sensu et sensili، وهو كما يعرف المهتمون كتاب ينتمي إلى ما يسمى بالطبيعيات الصغرى، فقد كان لنِقولا زِيادة معه رأي آخر، إذ استعمل عنوان الحس والمحسوس لينقل به كتاب باري إيرمينياس Περὶ Ἑρμηνείας لأرسطو، وهو الذي يعرف في التقليد اللاتيني الغربي بـ De Interpretatione، وهو المعروف عند الدارسين والشراح في السياقات الإسلامية بكتاب العبارة. وهذا الكتاب، كما يعرف الناس، ليس من الطبيعيات في شيء بل هو جزء من المنطق، ويأتي ثانيا فيه.
ولم يترجم نِقولا زِيادة كتاب De Caelo الذي صادفه في كتاب گوتاس (النص الإنجليزي، 145)، فتركه بعنوانه الإنجليزي (الترجمة العربية، 243)؛ والحال أن هذا العمل معروف في أوساط المهتمين بكتاب السماء والعالم Περὶ οὐρανοῦ؛ وفي المقابل، فقد ترجم Meteorology (النص الإنجليزي، 145) بكتاب في الأنواء (الترجمة العربية، 243)، بينما الترجمة المعروفة لهذا الكتاب هي الآثار العلوية Μετεωρολογικά.
وكتاب آخر كان له المصير نفسه على يد نِقولا زِيادة هو التبكيتات السفسطائية أو السفسطة Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι أو Sophistici elenchi (الأصل الإنجليزي، 151)، وهو الجزء السادس والأخير من كتب المنطق، كما وضعها أرسطو، على اعتبار أنه ينظر في الأقيسة المرائية أو المغلطة. أما نِقولا زِيادة فقد اختار لهذا الكتاب عنوانا جديدا تماما هو كتاب الخطابة (الترجمة العربية، 256). واكتفى في موضع آخر (الترجمة العربية، 301) بترك العنوان كما ورد في الأصل، أي Sophistici elenchi (النص الإنجليزي، 184)؛ والمعلوم عند كل المهتمين اليوم أن كتاب الخطابة (أو الريطوريا/الريطوريقا) غير كتاب السفسطة.
وبدوره، فقد استحال كتاب Aphorismes للطبيب الشهير أبقراط (ت. حوالي 370 ق.م) في ترجمة نِقولا زِيادة إلى كتاب تقدمة المعرفة؛ ومن المعروف أن هذا كتاب آخر لأبقراط (قارن: النص الإنجليزي، 139؛ الترجمة العربية، 233)؛ والحال أن المقصود في نص گوتاس هو كتاب الفصول.[1]
أما الفيلسوف والشارح الإسكندراني Ioannes Philoponus فقد أجهد نِقولا زِيادة نفسه في تعريب اسمه كما ورد عند گوتاس (النص الإنجليزي، 145) بـ يوانس فيلوبونوس (الترجمة العربية، 243)، بينما المقصود هو يوحنا أو يحيى النحوي (ت. 570م). وإلى ذلك، فقد عجز زِيادة على التعرف في النص الإنجليزي على اسم أفلوطين، الفيلسوف الأفلاطوني المحدث (ت. 270م)، فأبقى على رسمه الذي كتبه به گوتاس: بلوتينوس (انظر: النص الإنجليزي، 120، 125، 145؛ والترجمة العربية، 204، 212، 242).
ونصل الآن إلى كتاب الطوبيقا لأرسطو:
والواقع أننا قد ترددنا قبل نقل كل الشواهد التي ورد فيها ذكر لكتاب الطوبيقا لأرسطو في النص الإنجليزي ومقابله، أي المقولات، في ترجمة نِقولا زِيادة؛ وقد كان ترددنا حاصل الخوف من أن نثقل على القارئ، خاصة وأن الأمر يتعلق بخطإ واحد متكرر في كل المواضع التي ورد فيها كتاب الطوبيقا. لكن السياقات التي ورد فيها التحريف جعلتنا نقدم على تثبيت هذه الشواهد حتى يَظهر حج الفساد في الترجمة، ويَبينَ أن الأمر لم يكن ليحتاج إلى نباهة ليدرك المترجم أن الأمر يتعلق بكتاب المواضع الجدلية، لا المقولات.
| ديمتري گوتاس في نصه الأصلي | ديمتري گوتاس في ترجمة نِقولا زِيادة |
| “The caliph al-Mahdī (d 785), al- Manṣūr’s son and successor, commissioned the translation into Arabic of Aristotle’s Topics.” 61. |
”أن الخليفة المهدي (ت 169هـ/785)، ابن المنصور وخليفته عهد بترجمة مقولات أرسطو Topicsإلى العربية.“ 119. |
| “This translation of the Topics was not to be the only one.” 61. |
”ولم يكتب لهذه الترجمة للمقولات أن تكون الترجمة الفريدة.“ 119. |
| “The Topics is hardly light reading.” 62. | ”فالمقولات ليست قراءته يسيرة.“ 120. |
|
“Now the Topics teaches one dialectic, ǧadal, the art of argumentation on a systematic basis. Its stated aim is to develop a method that would enable one to debate for or against a thesis on the basis of commonly held beliefs; accordingly, it provides rules of engagement concerning the question and answer process between two antagonists, the interrogator and his respondent, and it lists at great length test cases – about three hundred of them – that provide approaches to arguments, or their topics (the topoi). In the preceding chapter, I discussed how al- Manṣūr fashioned an imperial ideology with universalist claims on the basis that the Abbasid state was pre- ordained, by the stars and ultimately by God.” 62. |
”فالمقولات يعلم الجدل، وهو فن المحاجة على قواعد منتظمة. إن الغرض منه والوارد فيه نصا، هو تطوير أسلوب يمكن الواحد من المحاجة عن مسألة أو ضدها على أساس معتقدات يقبلها الجميع؛ ومن ثم فهو يزودنا بقواعد المناقشة المرتبطة بالمساءلة والجواب بين خصمين – السائل والمجيب له، وتضم لائحة في غاية الطول من القضايا التجريبية – نحو ثلاثمائة- تزودنا ببدايات للجدل أو مقولاته. قد بحثت في الفصل السابق كيف عمل المهدي على صياغة إيديولوجية إمبراطورية مبنية على دعاوى أساسها أن الدولة العباسية كانت قد قامت على ما سمته النجوم، ومعنى هذا في نهاية المطاف، أن ذلك جاء من الله تعالى.“ 121. |
هذه الفقرة العربية الأخيرة، كما هي أمام القارئ، تحمل أكثر من تحريف لأقوال گوتاس، وهي الأقوال المعروفة عند كل دارس مبتدئ لتاريخ المنطق ولتاريخ الخلفاء العباسيين. وفضلا فساد ترجمة approaches ببدايات، بينما الأقر ترجمتها بطرق ومسالك، و test cases بالقضايا التجريبية، وهي تفيد الأمثلة التي ساقها أرسطو للمواضع الجدلية، فإن العين التي لا تعرف للسان الإنجليزي مدخلا يمكن أن تستوعب من أول نظرة أن الأمر يتعلق في نص گوتاس بكتاب المواضع الجدلية وليس بكتاب المقولات. فالمواضع هو الكتاب الذي خصصه أرسطو لتعليم صناعة الجدل (وهو أمر لا نستفيده من ترجمة نِقولا زِيادة)، وهو الذي يصلح دليلا للسائل والمجيب في جدلهما. وأخيرا فإنه على الرغم من أن كل طالب مبتدئ يعرف جيدا أن المهدي ليس غير المنصور، فإن الترجمة العربية كان لها رأي آخر، كما هو مبين في آخر الفقرة أعلاه.
وها أمثلة أخرى:
| “For the state of the Topics in Syriac.” 62, n. 2. | ”لعرض المقولات بالسريانية.“ 121، هـ2. | |
| “Al- Mahdï must have good advisors; they suggested nothing less than the work that started it all, Aristotle’s Topics.” 67. |
”لابد أن المهدي كان حوله مشيرون جيدون، فلم يقترحوا أقل من كتاب المقولات لأرسطو.“ 129. |
|
| “Al- Mahdi was a good student; he read the book carefully…” 67. |
”كان المهدي تلميذا جيدا.“ 129. |
|
| “…he commissioned the translation of the Topics.” 67. | ”الرجل الذي عهد إليه ترجمة المقولات.“ 129. | |
| “The ensuing debate presents an excellent example of the application of the rules of disputation laid down in the Topics.” 68. | ”إن الحوار الذي تلا [كذا] يضع بين أيدينا مثلا ممتازا على تطبيق القوانين التي نص عليها كتاب المقولات.“ 131. | |
| “The Topics was therefore manifestly relevant to the inter-faith debates during the first tow Abbasid centuries, hence the many translations.” 69. | ”فالمقولات كان إذن وثيق الصلة على نحو واضح بالحوارات المتبادلة بين العقائد خلال القرنين العباسيين الأولين.“ 131. | |
| “It is this constellation of circumstances that contributed to the translation of Greek books on the subject, just as they made the translation of the Topics necessary during the caliphate of al-Mahdi. If in the religious debates occasioned by ‘Abbasid policies the translation of Aristotle’s Topics was required in order to provide guidance in Arabic for the method of disputation, then the translation of other books was sought after.” 72 | ”إن هذا التجمع البارز للأحوال التي شجعت ترجمة الكتب اليونانية على نحو ما جعل مثل هذا التجمع ترجمة المقولات أمرا لازما في خلافة المهدي. وإذا كانت ترجمة المقولات لأرسطو لازمة بسبب من المجادلات الدينية التي فرضتها السياسة العباسية، وذلك من أجل تزويد الترشيد بالعربية إلى أساليب المناقشة، فإن ترجمة كتب أخرى.“ 136. | |
| “Al-Mahdi, for example, had to have recourse, for the translation of Aristotle’s Topics, to the best person he knew.” 137. | ”فالمهدي، على سبيل المثال، لما اعتزم ترجمة المقولات لأرسطو اضطر إلى خير من يعرفه.“ 229. | |
ونستنتج من هذه العينات التي عرضناها أمام أنظار القارئ، حتى يتابع معنا حجمَ ما أصابَ عمل گوتاس من اختلال وفساد في ترجمته إلى العربية، أنه قد بات من المتعذر الخروج بدعوى واضحة يمكن أن ننسبها إليه. إننا لم نقرأ، بعد في العربية، ما كتبه الرجل، ولم نفهم موضوع كتابه قبل أن نستشكل ما أثاره فيه من قضايا ومسائل أو نعترض على ما أورده من دعاوى وحجج. وسبب هذا، في الغالب، هو عدم تمكن المترجم من العدة المعرفية التي استثمرها صاحب النص في كتابه عموما، وفي الفصل الذي ركزنا عليه خاصة، أعني عدم استئناسه بالمفاهيم المنطقية المستعملة من قبيل الموضع، والمقدمات المشتركة التصديق، والقواعد، السؤال والجواب، الاعتراض، المناظرة…فضلا عن معرفته المشوشة والمضطربة أيضا بأعمال أرسطو المترجمة إلى العربية، وبالشروح التي أنجزت حول هذه النصوص. هذا، مع أن المثير للعجب حقا هو أن المترجم كان يملك أمامه كل الإحالات على كتاب المواضع الجدلية (من قبيل كتاب الجدل لابن سينا: انظر الهامش الأول من الصفحة 120 من الترجمة العربية)، وقد ثبتها بنفسه، لكننا لا ندري لماذا لم يتبين بكتاب المواضع الجدلية وليس بكتاب المقولات.
أمام هذا الوضع، فإنّ الأرحم بالقُرَّاء باللسان العربي سحبُ هذا الكتاب الذي ترجمه الراحل نِقولا زِيادة، والبحث عن مترجم ثان لنقله من جديد نقلا يحترم حاجة القُرَّاء بهذا اللسان، ويأخذ بعين الاعتبار خطورة الترجمة في توجيه هؤلاء الوجهة السليمة بدلا من تضليلهم. والحال أن ما أتينا به من عينات يُظهر أن الترجمة التي بين أيدينا تقلب أغلب المضامين والدعاوى التي أجهد ديمتري گوتاس نفسه لبلورتها وصوغها. ولهذا، فمن العبث اعتماد هذه الترجمة العربية مرجعا في دراسة مَا؛ بل إنه من المضحك، حقا، الدخول في مناقشات وحوارات بخصوص الكتاب، اعتمادًا على هذه الترجمة.
ولا نرى في إعادة الترجمة عيبا. لنتعظ بما حصل أيام عصر الترجمة من اليونانية إلى العربية، فقد كان الكتاب الواحد يترجم أكثر من مرة، وتصلح الترجمات والنقول أكثر من مرة، حتى يحصل تخطي عثرات المترجم الأول، لأسباب ليس هاهنا موضع التفصيل فيها؛ بل إن هذه هي حال كتاب المواضع الجدلية بالذات الذي ترجمه تيموثاوس النسطوري بطلب من الخليفة المهدي بعد أن وقف على فساد الترجمة الأولى. وقد وردت أخبار ببعض هذه الأمور وما يشبهها في كتاب گوتاس هذا.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
للتوثيق
بن أحمد، فؤاد. ”الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري گوتاس: قراءة نقدية في الترجمة العربية.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط < https://philosmus.org/archives/697 >
فؤاد بن أحمد
[1] https://www.aljazeera.net/programs/a-book-is-the-best-companion/2005/1/10/الفكر-اليوناني-والثقافة-العربية. روجع بتاريخ 19 يونيو 2020. والتشديد مني. وبالنظر إلى الطابع الشفوي لهذه الشهادة فقد تصرفنا في بعض المواضع دون إخلال بالمعنى.
[2] http://www.elmeda.net/spip.php?article693# والتشديد مني. روجع بتاريخ 19 يونيو 2020.
[3] هالة علي، ”الترجمة العربية في نهضتها الأولى: قراءة في كتاب الفكر اليوناني والثقافة العربية [لـ]ديمتري غوتاس،“ مجلة الآداب العالمية 135 (2008): 265-272، 270.
[4] انظر دراسات متفرقة من العمل الآتي: مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة الإسلامية، تنسيق بناصر البعزاتي (الرباط: منشورات
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2008).
[5] وقد راح أحد الأساتذة ضحية الترجمة الفاسدة لزِيادة عندما اقتبس قولا له يتضمن عنوان هذا الكتاب. انظر: محمد أيت حمو، ”من بغداد إلى قرطبة: خصوبة فكرية في بيوت العلم،“ ضمن مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة الإسلامية، 93-114، 99.
مقالات ذات صلة
قراءة نقديّة: موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (557هـ-629هـ). ما بعد الطبيعة. قدم له وحققه يونس أجعون. بيروت: دار الكتب العلمية، 2017.
Muwaffaq al-Dīn ʿAbd al-Laṭīf Ibn Yūsuf al-Baghdādī (557-629). Mā ba ʿda al-ṭabī ʿah [Metaphysics]. Edited by Yūnus Ajʿūn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2017. ISBN: 978-2-7451-8878-6 Fouad Ben AhmedQarawiyyin University-Rabatموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي...
قصّة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر الله في رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان. الجيزة: بوك ڤاليو، 2021
Review of Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham by Yusuf Zaydān. Giza: Book Value, 2021. ISBN-10. 9778582106 Qiṣṣat Ibn al-Haytham maʿa al-Ḥākim bi Amri al-LāhFī riwāyat Ḥākim, junūn Ibn al-Haytham قصة ابن الهيثم مع الحاكم بأمر اللهفي رواية حاكم: جنون ابن الهيثم ليوسف زيدان....
عن ابن رشد وما لا نعرف عنه: في الرد على حسن أوريد ومن معه
عن ابن رشد وما لا نعرف عنهفي الرد على حسن أوريد ومن معه فؤاد بن أحمدجامعة القرويين، الرباط تقديم اجتهد العربُ المحدثون في ترجمة المفردتين revue وjournal بمفردة ”المجلة،“ بعد أن نقلوا هذه من معناها القديم، وهو ”كتاب يحتوي على أشياء جليلة من الحكم وغيرها.“[1] لكنهم...
الأخلاقيات الغائية عند فخر الدين الرازي لأيمن شحادة: مراجعة نقدية للترجمة العربية
The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī by Ayman Shehadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut: Mominoun Without Borders, 2020. Al-Akhlāqiyāt al-ghāʾiyya ʿinda Fakhr al-Dīn al-Rāzī Li Ayman Shihadeh. Translated by Majdūlīn al-Nuhaybī. Rabat-Beirut:...
نصّان في الأشعريّة التقليديّة: إشكالُ القيمة والأبعادُ الفيلولوجيّة والمعرفيّة
نصّان في الأشعَريّة التّقلِيديّة:إشْكَال القِيمَة والأبعادُ الفِيلولوجِية والمعرِفيّة Naṣṣani fī al-Ashʿariyya al-taqlīdiyya:Ishkāl al-qīma wa-l-abʿād al-fīlūlūjiyya wa-l-maʿrifiyya محمد الرّاضي[1]جامعة عبد الملك السعدي-تطوان ملخص تميزت نصوص المتكلمين المتقدمين في...
الفكر العلمي والثقافة الإسلامية لبناصر البعزّاتي
مقدمة يظهر أن استئناس الدارس المغربي بناصر البعزّاتي بالمسائل العلمية والتاريخية التي يثيرها الفكر العلمي والفلسفي المعاصر قد مكنه من مقاربة الثقافة الإسلامية العالمة بترسانة من المفاهيم والآليات والأدوات، فجاءت قراءته لمكونات هذه الثقافة موازية لـقراءته لتاريخ...
مصير العلوم العقلية في الغرب الإسلامي ما بعد ابن رشد
ملخص بعد النقد العنيف الذي وجهه الغزالي للفلاسفة، حصل تعديل في المسار العام للفلسفة في المشرق الإسلامي، وغَلَبَ نوع من التأليف الذي يمزج بين الكلام والفلسفة؛ أما في الغرب الإسلامي، فقد ازدهر القول الفلسفي بعد التهافت، لكن بعد موت ابن رشد، لن نشهد فلاسفة موسوعيين كبار،...
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين
كتاب النصيحتين الطبية والحكمية لعبد اللطيف البغدادي: قراءة نقدية في نشرتين فؤاد بن أحمد[1] جامعة القرويين تمهيد ولد الفيلسوف والطبيب والمؤرخ والرحالة موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبي العز يوسف البغدادي، المشهور بابن اللّباد، في بغداد العام 557هـ/1162م، وتوفي...
عن تمثيلات واستعارات ابن رشد
قراءة نقدية في كتاب فؤاد بن أحمد، تمثيلات واستعارات ابن رشد: من منطق البرهان إلى منطق الخطابة. بيروت-الرباط-الجزائر: منشورات ضفاف-دار الأمان-منشورات الاختلاف، 2012. محمد الولي[1] كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ سايس - فاس 1. حول المعنى الحرفي. حينما نتوخى التعبير عن...