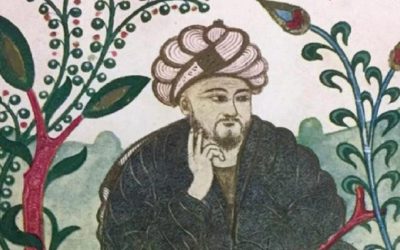![]()
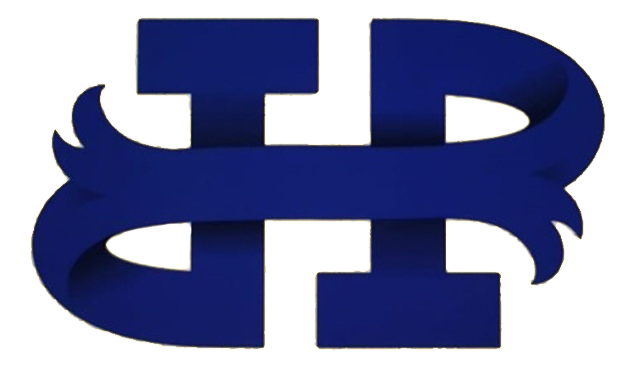
الآبلي شيخُ ابن خلدون

الآبلي شيخُ ابن خلدون
ناصيف نصار[1]
ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد
تقديم
نُشر مقال ناصيف نصار الذي نترجمه هنا بالمجلة الآتية: Studia Islamica, 1964, No. 20 (1964): 103-114. والمقال من الدراسات القليلة والباكرة التي تعرضت لهذا الموضوع الملغز، أعني علاقة الفيلسوف والرياضي الموسوعي أبي عبد الله الآبلي بتلميذه المؤرخ ابن خلدون، مع التركيز على تأثير الآبلي في تكوين فكر المؤرخ التونسي. يبدأ النص بالإشارة إلى أن رواية ابن خلدون عن فترة إقامة الآبلي في المشرق غير مكتملة وغامضة، مما يثير التساؤلات حول الأسباب وراء هذا الصمت. يلمح النص إلى أن الآبلي قد يكون أخفى بعض التفاصيل المتعلقة بتوجهاته الشيعية التي لم تكن مقبولة في المجتمعات المغاربية. ويُشير النص إلى أن الآبلي تأثر بكتابات فلاسفة ومفكرين مشرقيين مثل فخر الدين الرازي ونصير الطوسي، وأنه كان مُلِمًّا بآرائهم ونقلها إلى تلامذته. ويشدد عمل نصار هنا على دور الرازي في تشكيل الفكر النقدي للآبلي، والذي بدوره أثّر على ابن خلدون. يُلاحظ أيضًا أن الآبلي ربما لم يكن على دراية عميقة بفكر ابن تيمية، نظراً للظروف الزمنية والتطورات الفكرية في تلك الفترة. ويتعمق النص في كيفية تأثير الآبلي على ابن خلدون من خلال تدريسه لمجموعة من العلوم العقلية، كالتعاليم والمنطق وأصول الدين والفلسفة. يُظهِر النص أن الآبلي اتبع نهجًا تربويًا يجمع بين الدراسة التاريخية للمشكلات والتفكير النقدي فيها، مما ساعد ابن خلدون على تطوير قدراته الفكرية والنقدية. كما يُشير النص إلى أن الآبلي أثّر في ابن خلدون في مجالات أخرى، منها رؤيته التربوية التي تنتقد الاعتماد الكلي على الكتب دون التفاعل المباشر مع الشيوخ، وتحذيره من المختصرات التي قد تحجب الفهم الحقيقي للأصول العلمية. وقد انعكست هذه الأفكار في أعمال ابن خلدون، خاصة في مقدمته، حيث ناقش قضايا تعليمية مشابهة. وأخيرًا، يؤكد النص أن تأثير الآبلي قد امتد إلى الجوانب الاجتماعية في فكر ابن خلدون، خاصة فيما يتعلق بمفهوم العصبية ودورها في الحركات السياسية والدينية. ويستنتج النص أن الآبلي قد لعب دورًا حاسمًا في توجيه ابن خلدون نحو الأسس والمبادئ الفكرية التي شكّلت لاحقًا جوهر نظرياته في التاريخ والاجتماع.
صدر المقال كما أشرنا أعلاه عام 1964، أي قبل ستين سنة من اليوم. وقد نشره نصار في الوقت الذي كان يشتغل فيه على عمله الأكاديمي، الفكر الواقعي لابن خلدون، الذي صدر بالفرنسية عام 1967. وإذا كانت معطيات كثيرة قد ازدادت إلى ملف ابن خلدون خاصة، بحيث يصعب إحصاء كل ما نشر عن ابن خلدون منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، فإن ملف الآبلي يظل شبه فارغ، بحيث ظل البحث يراوح مكانه وتحت رحمة تكرار الأحكام والأخبار، تأسيا بسنة القدماء مع ابن خلدون والآبلي، وهو الأمر الذي انتبه إليه نصار نفسه.[2] ولقد كان لا بد أن يحمل المقال بعض الأحكام التي كانت رائجة بين النظار آنذاك. وبالفعل، يحتوي النص على جوانب إيديولوجية وأحكام ضمنية بخصوص بعض المفكرين، أبرزهم ابن تيمية والصراع بين ابن خلدون وابن عرفة،[3] وبخصوص بعض الفترات التاريخية في المغرب خاصة. يظهر النص نوعًا من التقييم النقدي تجاه فكر ابن تيمية، حيث يشير إلى أن الآبلي كان قد عبر عن استيائه من موقف هذا الأخير من فخر الدين الرازي. كما أظهر تسليما برواية ابن خلدون لخلافه مع ابن عرفة وتسليما غير نقدي بتوصيف روبير برانشفيك لذلك الخلاف. هذا دون أن يظهر أي حس نقدي تجاه هذه الروايات والتفسيرات. ومن جهة ثانية، يؤكد النص أن المغرب لم يكن مناخا مناسبا للنظر العقلي في فترة الآبلي وابن خلدون، لذلك لم يكونا سوى أفراد يتحدون تدهور الثقافة والركود الاجتماعي السائد.
إننا لم نترجم المقال من الفرنسية إلى العربية لأجل أن نرد عليه أو ننتقد مقاربة صاحبه، ونظهر تقادمها. فالترجمة شيء ومراجعة أحكام صاحب النص مراجعة نقدية شيء آخر، ولا يستقيم الجمع بينهما في مقام واحد. وعليه، فنحن نترجم المقال لأهميته التي لا يبدو أن الزمان قد نال منها كثيرا، وخاصة ما تعلق منها بالآبلي؛ ونترجمه أيضا لنضع في متناول الباحثين نصا كثيرا ما استعمل، وأسيء استعماله وفهمه، وقليلا ما تمت الإحالة إليه. أما إظهار حدود مقاربة نصار ومراجعة أحكامه فسيأتي ذلك في منشور أفردناه لذلك. وفي الأخير، نود أن نشير إلى أننا نترجم هذا المقال لفائدة قراء مجلة فيلوسموس الإلكترونية. وبهذه المناسبة نعبر عن شكرنا الصادق للباحثين عبد الإلاه بوديب وأيمن أفساحي وأيوب أبسومي تجشمهم عناء مراجعتها وتدقيقها.
نص الترجمة
في تاريخ الفكر، تعتبر دراسة تأثير الشيخ على مفكرٍ كبيرٍ، من المهام التي قد تبدو قليلة الأهمية أو الفائدة، لكنها في الواقع تثبت أنها لا غنى عنها بمجرد أن يغادر مؤرخ الأفكار مستوى التحليل المنطقي للأنساق. ذلك أن فهم فكر شخص عبقري يتعمق غالبًا عندما يثريه الضوء الذي تلقيه دراسة التكوين والدور الحاسم الذي تلعبه بعض الشخصيات في نشأة توجه ما. هذا هو شأن ذلك المفكر، العبقري والاستثنائي، الذي لم يتوقف منذ القرن التاسع عشر عن شغل المؤرخين والفلاسفة وعلماء الاجتماع، ومعلمه الشهير في زمنه، أعني ابن خلدون والآبلي.
حتى الآن، لم يفكر النقاد في دراسة جادة لتكوين ابن خلدون. لا شك أن المكانة البارزة التي يحتلها الآبلي في هذا التكوين قد أشار إليها عدة نقاد.[4] لكنها لم تكن أبدًا موضوع تحليلٍ متعمق. وضرورة مثل هذا التحليل لا تحتاج إلى برهان؛ ومن أجل الإسهام في ذلك، نكرس هذه السطور للمعلم الذي أبرز مؤلف المقدمة أهميته الفريدة.
إن صعوبة دراسة علاقة التأثير واضحة جدًا إلى درجة أننا لا نحتاج إلى التذكير بطبيعة هذه السطور التي هي جزئية لا محالة. بل إن هذه السطور هي أكثر جزئيةً من ناحيتين. فمن ناحية، نحن نعزل دراسة علاقات الآبلي وابن خلدون عن مجمل تكوينه، بهدف تخليصها من الوقائع المعقدة التي يجب أخذها في الاعتبار؛ ومن ناحية أخرى، نعتمد على مصادر لا تقدم في معظمها سوى معلومات غامضة. ولا يبدو أن الآبلي قد خلف كتابات. وقد تحدث المؤلفون القدماء عن ذلك بشكل متباين جدا.
لا نجد عند ابن القاضي،[5] وابن فرحون، وأحمد بابا التنبكتي،[6] وابن حجر،[7] شيئًا يكون بالفعل مُضيئًا. فهؤلاء المؤلفون ينقلون، باختصار وأحيانًا بتشويه، شهادات نجدها عند ابن مريم،[8] وعند المقري،[9] وعند شقيق ابن خلدون،[10] وعند ابن خلدون نفسه،[11] الذي يبقى في النهاية المصدر الأكثر تفصيلًا وغنىً. وعلى أي حال، هذه الوثائق كلها لا تكفي للتعرف بكيفية متعمقة بعض الشيء على حياة الآبلي وشخصيته. ما نحاول القيام به هنا ينحصر إذًا في بعض الملاحظات التي قد لا تكون من دون فائدة بقدر ما نحن مضطرون لاستنطاق التاريخ في الوثائق التي احتفظت بها لنا.
حياة الآبلي وثقافته
يمكن تقسيم حياة الآبلي إلى ثلاث فترات حسب رواية ابن خلدون. تمتد الفترة الأولى من 681 هـ/1282م،[12]وهو تاريخ ميلاده، إلى ما يقرب من 700هـ/1299م، وهو تاريخ رحلته إلى المشرق؛ وهي تمثل مرحلة تكوينه الأول. وتمتد المرحلة الثانية تمتد إلى حوالي سبع سنوات، أي حتى عودته إلى المغرب؛ وهي تمثل مرحلة التكوين الثاني. أما المرحلة الثالثة فتمتد حتى وفاته التي حدثت في سنة 757هـ/1356م؛ وهي بوضوح المرحلة الأطول، والأغنى أيضًا تجربةً ونشاطًا.
وُلد أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي في تلمسان. كان والده الذي ينحدر من الأندلس يخدم في جيش بني زيان، حكام مملكة بني عبد الواد. أمه هي بنت محمد بن غلبون، قاضي تلمسان. وهكذا، كان الشاب الآبلي خاضعًا لازدواجية في التوجه. فمن ناحية، كان بإمكانه أن يتبع مُنْتَحل أبيه ويخوض مسيرة عسكرية؛ ومن ناحية أخرى، كان بوسعه أن يميل إلى انتحال العلم والدراسة ويمارس وظيفة فكرية ما.[13] ويبدو أنه قضى أعوامه الأولى لدى جده لأمه؛ مما أسهم في نشأة شغف بالدراسة لديه، مدعومًا بقدرات كبيرة، ونفور من الوظائف العسكرية، الأمر الذي سيحدد العديد من خياراته اللاحقة.
لم تكن الأجواء العامة في مملكة بني زيان، خلال الربع الأخير من القرن السابع الهجري، ملائمة لمواصلة الدراسات بهدوء. في الواقع، تتابعت محاولات الغزو المريني، حتى إنه في عام 698هـ/1297م قرر السلطان أبو يعقوب يوسف إخضاع مدينة تلمسان بتجويعها. كان الحصار محكمًا؛ لكن المدينة لم تستسلم. كان والد الآبلي قائد فرقة في هنين، ميناء تلمسان؛ فوقع أسيرًا عند أبي يعقوب. ذاع في تلمسان حينها خبر أن السلطان المريني يطلق سراح الأسرى مقابل أخذ أبنائهم رهائن. وبتشجيع من والديه، أراد الآبلي أن يستبدل والده في الأسر. خرج من وراء الأسوار، لكنه أدرك أن ذلك كان خبرًا كاذبًا. شجاعته سلّمته إلى الغازي الذي جنده في جيشه. لكن هذا المنصب لم يعجب شابنا. كان عليه أن يتذرع برحلة حج للتملص من الموقف. بتركه الجيش المريني، كان الآبلي قد اختار طريقه على نحو نهائي. وبالقرب من تلمسان، حيث كان مختفيا في صحبة الفقراء، التقى شخصية غامضة، رئيسا شيعيا، جاء من كربلاء يروم إقامة دعوته الحائدة عن طريق السنة. انضم الآبلي إلى صحبته لمواصلة الحج، لأن هذا القائد أدرك بسرعة أن فرصه معدومة أمام قوة المرينيين، وقرر ترك البلاد.[14]
أثناء الرحلة بحرًا بين تونس والإسكندرية، شرب الآبلي الكافور، وأصيب باختلاط في عقله. لهذا السبب، لم يستطع الاستفادة من تعليم الأساتذة الكبار الذين كانوا يدرسون آنذاك في مصر، مثل صفي الدين الهندي، والتبريزي، وابن البديع… وغيرهم. ومع ذلك، واصل رحلته إلى الشام، وأدى فريضة الحج بمكة صحبة الرئيس الشيعي، وعاد معه إلى كربلاء. لكن ماذا فعل بكربلاء؟ وكم من الوقت مكث فيها؟ لا يمكن تقديم معلومات دقيقة بهذا الشأن. وتبقى رواية ابن خلدون، في هذا الصدد، متحفظة جدًا، بل وغامضة. وسنعرض لاحقًا رأينا في الموضوع. باختصار، عاد الآبلي إلى المغرب. وتزامن وصوله مع وفاة أبي يعقوب، الذي أرداه أحد خصيانه، عام 706هـ/1307م.[15] وعندئذ تحررت تلمسان[16] واستقر الآبلي فيها.
وهنا تبدأ الفترة الثالثة من حياته، التي ستكرس كاملة تقريبًا للدراسة والتعليم. وأساتذته هذه المرة معروفون جيدًا. أولًا، يتابع دروس المنطق والأصول لدى ابن الإمام (أبو موسى)، وهو عالم ذو كفاءة عالية وشهرة كبيرة.[17] لكن الحاكم الجديد لتلمسان، أبو حمو موسى الأول (708-718هـ/1309-1319م)، أراد أن يسند إليه إدارة خزائنه، بسبب كفاءته في الحساب. ولكي يرفض هذا الإكراه ويتهرب منه، اضطر صاحبنا إلى الفرار إلى فاس، حيث اختبأ لبعض الوقت لدى رياضي يهودي، أتاح له فرصة تحسين معارفه في الرياضيات. حوالي سنة 710هـ/1411م، دخل الآبلي مراكش، وتعرف إلى العالم الكبير ابن البنّا المراكشي،[18] الذي درس معه كل أنواع المواد المتعلقة بمجال الفلسفة. بعد وفاة ابن البنّا، وحتى سنة 737هـ/1336م، أقام لدى أحد زعماء قبائل هسكورة، أولًا في الجبل، ثم في فاس حيث اضطر هذا الزعيم إلى القدوم بدعوة من السلطان أبي سعيد. خلال هذه الفترة، كان الآبلي يدرّس وقد اكتسب شهرة كبيرة. في سنة 737هـ/1336م، استدعاه السلطان أبو الحسن إلى بلاطه، بناءً على توصية من ابن الإمام. رافق الآبلي السلطان في حملاته. وحضر بشكل خاص معركة طريف (740هـ/1339م) وجاء إلى تونس في أثناء فتح أبي الحسن المريني لإفريقية (748هـ/1347م). في هذه المناسبة، التقى به ابن خلدون. ثم، غادر تونس حوالي سنة 752هـ/1343م، للالتحاق بالسلطان أبي عنان. وتوفي بعد بضع سنوات في فاس سنة 757هـ/1365م.
هذا هو مسار تطور حياة الآبلي وقد رسمنا خطاطته بطريقة مبسطة. وباستثناء بعض المغامرات، فقد كانت هذه الحياة متجانسة نسبيًا، هادئة وخصبة. كان لشهرة الشيخ اعتبار كبير، وكانت سلطته في العلوم العقلية معترفًا بها بالإجماع. أخذ عنه جيل كامل من المتأدبين والفقهاء واستفادوا من تعليمه.[19] ويبدو أنه قد أثار في هؤلاء الحماس بذكائه اللامع وثقافته الواسعة، في الوقت نفسه الذي كان يلهمهم فيه الاحترام.
ومع ذلك، يجب علينا أن نحدد أكثر طبيعة ثقافته وعقلانيته. لأن هذا العالم، ”الذي كانت معارفه موسوعية“[20] أظهر بوضوح تفضيلًا للعلوم القائمة على العقل. بأي اتجاه، وبأي تقليد يمكن أن نربط هذا التفضيل؟ ستبقى الإجابة عن هذا السؤال، في الحالة الراهنة لمعرفتنا، نوعًا ما تخمينية. لكن لا بد من محاولة صياغتها.
لقد رأينا أن الآبلي، بشكل عام، قد خبر جميع العلوم العقلية المعروفة في زمانه: التعاليم، والمنطق، وما بعد الطبيعة، والعقائد؛ وأنه تعرف على أبرز أساتذة المغرب، وكان يدرِّس بشغف ومهارة. لكن يبدو لنا أن رواية ابن خلدون، التي اتبعناها عن كثب في السطور السابقة، إن لم تكن غير دقيقة، فهي على الأقل غامضة بعض الشيء وغير مكتملة.
إن الأمر يتعلق بالصمت الذي يبديه بشأن إقامة الآبلي في المشرق، وخاصة في العراق. هل هو نسيان محض وبسيط؟ لا يبدو ذلك على الإطلاق. هل يعود ذلك إلى نقص حقيقي في الوقائع التي يمكن سردها؟ لا يبدو ذلك أيضًا. لأنه إذا صحت الرواية، فإن إقامة الآبلي في المشرق ستكون قد دامت حوالي سبع سنوات؛ ومن غير المحتمل جدًا أن يستمر الاختلاط العصبي—على افتراض وجوده في الواقع—طول هذه المدة، ثم يختفي فجأة عند عودته إلى المغرب. هل نحن أمام تمويه من طرف الآبلي، الذي ربما اختلق قصة مرضه من أجل إخفاء بعض العلاقات أو الاتجاهات الشيعية غير المقبولة في المجتمعات المغاربية؟ لا تبدو هذه الفرضية خالية تمامًا من أي أساس؛ لكن درجة وضوحها بعيدة عن أن تكون كافية.[21]
من أجل الحصول على مزيد من الوضوح حول هذا الموضوع، ينبغي إجراء دراسة للحركات السياسية والتيارات الفكرية التي أثارها التشيع، والتي كان لها صدى، بشكل ما، على الحياة السياسية والفكرية في المغرب. لكن، على أي حال، ما يهمنا هو الوصول إلى إبراز التوجه الفكري للآبلي، الذي تشكَّل بتأثير أعلام أو مؤلفين مشرقيين، كانت تدور حولهم المناقشات الفكرية في تلك الحقبة. على هذا المستوى، لدينا من أخي ابن خلدون، أبي زكريا يحيى، ومن المقَّري، إشارات ثمينة عدة.
في الواقع، يؤكد أخو ابن خلدون أن الآبلي قد تعرف إلى علماء المشرق واستفاد من دروسهم،[22] دون أن يحدد أي علماء وأي دروس يقصد. هذا الغموض يتضاءل بعدة إشارات نقلها المقَّري،[23] تفيد بأن الآبلي كان شديد الولع بكتابات الرازي. ومن بين أمور أخرى، يورد المقري أن الآبلي صحح من ذاكرته نصًا للرازي كانت بعض عباراته قد صحفت تماما.[24] ومن ناحية أخرى، نعلم من لباب ابن خلدون أن الآبلي كان يعرف تمامًا المحصل للرازي، وشرح الطوسي. لذا، فمن المشروع أن نفترض أن هذه المعرفة اكتسبت خلال إقامته في العراق أو في الشام.
يحيل كل من الرازي والطوسي إلى الغزالي وابن سينا، حيث يواصلان الحوار والنقاش. ونعلم أيضًا أن الآبلي كان يستخدم في تدريسه كتب ابن سينا.[25] هذا لا يعني بالتأكيد، وقطعا، أنه درس هذه الكتب في المشرق؛ لكنه يعزز فرضية أن بداية تعاطيه الفلسفة تمت خلال إقامته هناك، وعن طريق الاتصال بالفلاسفة العقلانيين والمتكلمين الجدليين الذين كانوا يشكلون مجموعة تربطها، إلى حد ما، طريقة معينة في النظر إلى مشكلة المعرفة.[26] يمكن الاعتراض بأن هذه البداية تمت لاحقًا، تحت إشراف ابن الإمام، الذي تعود مصادره إلى الرازي عن طريق ابن زيتون، الذي أدخل الرازي إلى المغرب ودرَّس العديد من التلاميذ. وفي الواقع، النتيجة تبقى نفسها؛ لكن اللجوء إلى هذا الافتراض لا يبدو لنا ضروريا. وربما يكون العكس أكثر توافقًا مع الواقع. ما كان الآبلي ليواصل العمل مع ابن الإمام إلا لأنه كان بالفعل متعمقًا جدًا في مسائل النظر الفلسفي والكلامي، كما تطورت منذ ابن سينا والغزالي.
وهناك مسألة يبقى علينا طرحها. هل عرف صاحبنا ابن تيمية (ت 728هـ/1328م)؟ في هذا الشأن، ليس لدينا أي دليل دقيق وإيجابي. يروي المقَّري، تلميذ الآبلي، أن شيخه استاء عندما سمع عبد الله الزموري يخبره بأن ابن تيمية ينتقد المحصل للرازي، متهمًا إياه بالابتعاد عن الأصول الحقيقية للدين.[27] هذه الإشارة تفيدنا بطبيعة علاقة الآبلي بالرازي أكثر مما تفيدنا بعلاقته بابن تيمية. ومع ذلك، يبدو لنا أن الآبلي لم يكن ليعرف فكر العالم الشهير بطريقة عميقة وكاملة. ففي بداية هذا القرن الثامن، لم يكن ابن تيمية قد رسخ سمعته بشكل نهائي، ولم يكن قد كتب كل مؤلفاته بعد.[28]
وهكذا، يمكن القول إن تكوين الآبلي اكتمل برعاية الفكر المشرقي، الكلامي والفلسفي، حيث الاتجاهات العقلانية فيه مؤكدة بوضوح. وقد جاءت مشكلة معيارية المنطق في مقدمة هذه الاتجاهات. وعلى الأرجح، لم يتبنَّ الآبلي مواقف مؤلف واحد أو مدرسة واحدة. فقد فقد الجدل بين المتكلمين والفلاسفة حدته؛ ولم يكن المغرب ملائمًا بشكل خاص لممارسة النظر الفلسفي. وقد يكون لقاؤه مع ابن الإمام ومع ابن البنَّا أفاده في تدقيق بعض معارفه وتعميقها. ويبدو أن ابن رشد لعب دورًا ضئيلًا في دراساته. وبالجملة، فعلى الرغم من قلة الابتكار الذي قدمه، فإن هذا الرجل يستحق الإعجاب بشجاعته وإشعاع ذكائه.
الآبلي شيخُ ابن خلدون
عندما جاء الآبلي إلى تونس سنة 748هـ/1348م صحبة السلطان أبي الحسن والعديد من الشيوخ الذين كانوا يمثلون النخبة الفكرية للمغرب، لم يكن عمْر ابن خلدون يتجاوز ستة عشر عامًا. كان قد بدأ بالفعل دراسات تقليدية قوية ودينية وفقهية وأدبية؛ لكن مجال العلوم العقلية كان لا يزال مجهولًا عنده. وكانت شهرة الآبلي قد سبقته إلى إفريقية. وسرعان ما ربطته صداقة بوالد عبد الرحمن ابن خلدون، الذي سهل لهذا الأخير اللقاء مع أستاذه الجديد والمرموق. لم تعق الأحداث السياسية ولا آفة الطاعون الكبرى، التي أودت بوالدي ابن خلدون وعدد كبير من الأعلام البارزين، نشاط الآبلي وتأثيره إعاقة كبيرة. وبناءً على إلحاح عائلة ابن خلدون، بقي الآبلي مدة ثلاث سنوات في تونس، منخرطًا في التعليم والمناظرة. من بين الطلاب الذين كانوا يرتادون حلقته، نذكر اسم ابن عرفة، الذي أصبح لاحقًا قاضي تونس الكبير وعدو ابن خلدون. كان ابن خلدون يُظهر تفوقًا على زميله، رغم فارق العمر الكبير بينهما (ولد ابن عرفة عام 716هـ/ 1316م، وابن خلدون عام 732هـ/1332م). نشأت غيرة عميقة في قلب ابن عرفة، غيرة ستنفجر حوالي سنة 780هـ/ 1380م.[29] كان الآبلي يعترف بمؤهلات ابن خلدون.[30] كانت لهيبته وخبرته الكبيرتين أثر السحر على روح عبد الرحمن، حيث يتجاوز تبادل الأفكار والتواصل الفكري مجرد علاقات الاحترام والإعجاب. كان توجها قيد الاستيقاظ.
يقول ابن خلدون إنه درس على شيخه، تباعًا، التعاليم والمنطق والأصول، وبقية العلوم الفلسفية.[31] ولم يحدد أي عناوين بعينها. وبالنظر إلى ثقافته الموسوعية، يصعب معرفة تلك العناوين كما يصعب معرفة ما الذي تمكن من دراسته بشكل أفضل خلال هذه الفترة من تكوينه. لكن أنواع المواد المدروسة وترتيب تقديمها ذو دلالة كبيرة بالفعل. يبدو أن الآبلي قد اتبع في تدريسه الترتيب نفسه الذي اتبعه شخصيا في تكوينه. علاوة على ذلك، فإن هذا الترتيب الذي يعطي مكانة خاصة للرياضيات، والذي يمزج علم الأصول بالعلوم الفلسفية، يعيد إنتاج الحالة التي وصل إليها توازن العلوم النظرية. لقد فرض المنطق نفسه على تقليد المتكلمين؛ ولم تعد الميتافيزيقا تحتكر الآلة العقلية. ويمكننا أن نقدر أن الآبلي كان يستخدم في التعاليم كتب ابن البنَّا، وفي الميتافيزيقا وعلم الكلام الأعمال الكبرى لابن سينا والرازي. في المنطق، يمكننا أن نفترض أنه كان يشرح على وجه الخصوص كتابات الخونجي.[32] والأهم مما ينبغي ملاحظته هو أن تدريسه كان عامًّا، يجمع بين دراسة تاريخية للمشكلات ومتطلبات التفكير فيها. وبذلك، كان يطبق منهجًا تربويًا مثيرًا للاهتمام، يعزز تطوير المعارف دون الإضرار بالقدرة النقدية.
كان اللباب أول ثمرة واضحة لارتباط ابن خلدون بشيخه. إلى جانب الشجاعة التي يدل عليها، فإن هذا الملخص القصير لعمل كبير صعب المنال، يظهر المصادر التي غذَّت التفكير العقلاني لابن خلدون في شبابه. وفي الواقع، كان هذا الارتياض يشترط ويؤدي إلى تدريب العقل على النصوص الصعبة، والإخلاص للمعنى، والتسلسل المنطقي للأفكار، وضرورات الاستدلال والنقد، في الوقت الذي يضع فيه في متناول الفهم جميع أنواع التيارات الموجودة بين المتكلمين والفلاسفة.[33] وينضم إلى العرض التاريخي نقد منهجي، طوره إما الرازي أو الطوسي. لكن الأثر الأعمق الذي كان لهذا التمرين على عقل ابن خلدون، هو أنه وضعه أمام مشكلة مركزية في التقليد العربي الإسلامي، مشكلة المعرفة، أي مصادرها وحدودها. مع الآبلي، كان ابن خلدون يصادف مشكلة فلسفية ومشكلة في الفلسفة في الوقت نفسه. إذا كانت الفلسفة تستند إلى النظر العقلي الخالص، فما هو نصيبها في الوصول إلى الحقيقة أو الواقع؟ هذه هي المسألة التي، فيما يبدو لنا، طرحت على ابن خلدون، انطلاقًا من اتصالاته مع الآبلي وتقاليد الرازي. وبطبيعة الحال، فقد ظلت هذه المسألة غير مُصاغة قبل المقدمة. لكنها كانت تتبلور بالفعل من خلال بحث ابن خلدون الذي يتواصل خلال تجواله السياسي، معبرًا عنه ببعض الكتابات المناسبة،[34] والتي لا يمكن اكتشاف نقطة انطلاقها إلا في نوعية اللقاء مع الآبلي.
امتد تأثير الآبلي إلى مجالات أخرى أيضًا. وفي الواقع، بفضل الخبرة التربوية الكبيرة للآبلي فقد انكشفت له عيوب بعض الأساليب الضارة بشكل خاص بنقل المعرفة. وهكذا نجد لديه، وفقًا لشهادة تلاميذه،[35] أربع أفكار مثيرة للاهتمام: انتشار الكتب يضر بعرض المعارف؛ فلا يكفي الاعتماد على الكتاب وحده لاكتساب العلم، بل لا بد من الرحلة، ولقاء الشيوخ والدراسة تحت إشرافهم؛ المختصرات تحجب الموارد العلمية الحقيقية التي يجب معرفتها؛ لهذا يجب على الطلاب ترك الملخصات والبحث عن العلم في المصادر. لقد استفاد ابن خلدون بالتأكيد من هذه الأفكار، في دراساته وتعليمه وكتاباته. في الجزء السادس من المقدمة، يطور أفكارًا تربوية مماثلة تمامًا حول ضرورة اللقاء بشيخ، والتقدم بشكل منهجي في الدراسة، وتجاوز الصعوبات التي تقدمها الكتب العديدة والمختصرات الغامضة. ها نحن مرة أخرى، نلاحظ ثراء العلاقة بين الآبلي وابن خلدون.
وهذا الثراء يصل إلى الجزء الأكثر أصالة في فكر ابن خلدون، أي فكره الاجتماعي. يذكر ابن خلدون في المقدمة[36] أمثلة، بهدف دعم أفكاره حول العصبية، قدمها له الآبلي. أحدها يتعلق بقضية ذلك الزعيم من كربلاء الذي رافقه الآبلي إلى المشرق. كان هذا الزعيم قد جاء للتبشير بالدعوة الفاطمية؛ لكنه أدرك أن عصبية المرينيين لا تُقهر. كل قضية سياسية أو دينية تحتاج عصبية تدعمها. روى الآبلي هذا الأمر لتلميذه، وربما لم يكن ذلك دون تعليق عليه. علاوة على ذلك، كانت إقامة الآبلي بين قبائل هسكورة قد أظهرت له بما فيه الكفاية واقع بعض العلاقات الاجتماعية وطبيعتها. ها هنا أيضًا، يكون الآبلي قد لفت انتباه ابن خلدون إلى حقائق ستشكل مادة ملاحظته وتجربته خلال ربع قرن.
لم يكن الآبلي الشيخ الوحيد لابن خلدون؛ لكنه كان من دون شك الشيخ الذي مارس عليه أعمق تأثير. سيتجاوز التلميذ معلمه المفضل بكثير؛ لكنه لم يفعل ذلك إلا بفضل الدفع الذي قدمه هذا الأخير لفكره. ربما كانت دراسات ابن خلدون، خاصة الدراسات الفقهية، ستبقى عقيمة لو لم يوجه الآبلي نظر العبقري الشاب نحو المبادئ والأسس والآفاق الواسعة. كان لا بد من وجود شخصية عظيمة ليدعم حماس شاب، ويبث فيه ما يكفي من القوة والثقة لتحدي تدهور الثقافة والركود الاجتماعي.
لا يمكننا الادعاء، في ضوء هذه الملاحظات القليلة، بأننا وصلنا إلى فك أسرار فكر ابن خلدون. وعلى أقصى تقدير، تسمح لنا هذه الملاحظات بربط النزعة العقلانية لابن خلدون ببعض المصادر المحددة شيئا ما. ولفهم كل هذا بشكل أوضح قد يتعين علينا أن نتجاوز التأثيرات والعوامل الجزئية والمتعددة عن طريق إدماجها، لأجل احتضان التجربة الكاملة لرجل ومفكر، تجربةً تلخص عصره، وتنفتح على مشكلة مركزية، تعتبرُ المقدمةُ محاولة لحلها.
للتوثيق
نصار، ناصيف. ”الآبلي شيخُ ابن خلدون،“ ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد. ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/4228>
فؤاد بن أحمد
[1] ناصيف نصار مفكر وأستاذ جامعي لبناني؛ له العديد من الدراسات التي عبر فيها عن انشغالاته الفلسفية والفكرية. وتكاد شهرة أعماله الفكرية تحجب أعماله الأكاديمية الباكرة. كان أنجز عملا مفيدا عن ابن خلدون بالفرنسية، بعنوان: La pensée réaliste d’Ibn Khaldûn (Paris : PUF, 1967).
ونشره بعدئذ بالعربية: بعنوان: الفكر الواقعي عند ابن خلدون: تفسير تحليلي جدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه (بيروت: دار الطليعة، 1981).
[2] يجدر بنا أن نذكر أن من الأمور التي استجدت في ملف الآبلي ما وقف عليه أحمد جبار ومحمد أبلاغ من إشارة إلى شارح مجهول لكتاب التلخيص لابن البنا يقدم نفسه بأنه تلميذ الآبلي. يقول الدارسان: ”إن الشارح الوحيد للتلخيص الذي يصرح بأنه تلميذ للآبلي هو مؤلف الشرح المجهول (الخزانة الحسنية بالرباط، رقم 10748). ويظهر من خلال الإحالة على الآبلي أن هذا الأخير لم يكن يكتفي بتدريس التلخيص بل كان يستعين في ذلك برفع الحجاب أيضا.“ حياة ومؤلفات ابن البنا المراكشي (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2001)، 49-50. ومن الأمور الأساسية التي استجدت بخصوص أسطورة أن الآبلي لم يكتب وأن له نظرية في العزوف عن التأليف، إشارة بناصر البعزاتي الخاطفة إلى تدريس الآبلي الرياضيات لبعض تلامذته، وينقل من أبي عبد الرحمن يعقوب بن أيوب المواحدي (كان حيا: 1350م-1389م) تزييف الآبلي جواب صاحبنا. انظر: ”الرياضيات زمن ابن خلدون،“ ضمن الأبنية الفكرية في الغرب الإسلامي زمن ابن خلدون، تنسيق بناصر البعزاتي (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2007)، 159. والإحالتان معا تؤكدان أمرا معروفا هو تدريس الآبلي للتعاليم. لكن الأهم في الإحالتين، وبخاصة الأخيرة، أنها تشير إلى أن الآبلي قد عرف بموقف نُقل عنه ووصل إلى المواحدي؛ وهو ما يدعونا إلى التشكيك في عزوفه عن التأليف. وسنعود إلى الموضوع في دراسة مستقلة.
[3] نراجع هذا الحكم في في عمل مستقل، انظر: فؤاد بن أحمد وعبد الإلاه بوديب، ”دعوى الانحطاط العلمي في القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد: بين ابن عرفة وابن خلدون“ (قيد النشر).
[4] ونذكر منها خاصة: علي الوردي، منطق ابن خلدون (القاهرة، 1962)، 129-131؛
Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun’s Philosophy of History (London: George Allen and Unwin Ltd, 1957), 34-36; Gaston Bouthoul, Ibn Khaldoun, sa philosophie sociale (Paris: Geuthner, 1930), 16-17.
ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون (القاهرة، 1961)، 71.
[5] درة الحجال [في أسماء الرجال] (الرباط، 1934)، ج. 1: 219، 283، 290، 291. يتحدث هذا المؤلف عن ابن خلدون (ج. 2: 357-358)، لكنه لا يذكر الآبلي ضمن شيوخه.
[6] يحتوي كل من كتاب الديباج لابن فرحون ونيل الابتهاج لأحمد بابا (وقد نُشرا معًا) على إشارات سريعة جدًا وفقيرة.
[7] الدرر الكامنة، ج. 3: 288-289، الرقم 766.
[8] البستان، (الجزائر، 1908)، 214-219. انظر أيضًا الترجمة التي قام بها بروفنزالي (الجزائر 1910)، 246-253.
[9] نفح الطيب، القاهرة، 1302 هـ، ج. 3: 131-133، 119.
[10] Histoire des Beni ‘Abd-El-Wād, rois de Tlemcen, trad. A. Bel (Alger: Imprimerie Orientale Pierre Fontana, 1903), i: 71-72.
النص العربي من بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، موجود في نفس المجلد، 57.
[11] اللباب، طبعة لوتسيانو روبيو، تطوان، 1952. التعريف، طبعة دار الكتاب اللبناني، 21-23، 33-39. المقدمة، تحقيق م. محمد (القاهرة، د.ت.)، 328، 329.
Histoire des Berbères, trad. de Slane (Alger: Imprimerie du Gouvernement, 1856), iv : 156, 167.
[12] سنلتزم بتواريخ الوفيات والأحداث وفق التحقيب الإسلامي فقط، حيث إن تواريخ التحقيب الميلادية لا تختلف تقريبًا في الرقمين الأخيرين. [المترجم: خالفنا خط المؤلف هنا بإضافة التواريخ المناسبة وفق التقويم الميلادي.]
[13] فيما يتعلق بمسألة مهنة ابن خلدون ومساره الوظيفي، انظر:
Robert Brunschvig, La Berberie orientale sous les Hafsides (Paris : Adrien Maisonneuve, 1947), ii: 167-168.
نلاحظ هذه العبارة التي تنطبق كذلك على المغرب الأوسط [إفريقيا الوسطى]: ”سيكون من العبث إنكار أن وضع الأفراد، في الغالبية العظمى من الحالات، كان محددًا بشكل وثيق بوضع والدهم وأقربائهم المقربين.“
[14] التعريف، 35؛ المقدمة، 329.
[15] التعريف 36.
[16] Charles-A. Julien, Histoire de L’Afrique du Nord (Paris : Payot, 1961), ii : 157.
[17] من أجل بعض التفاصيل بخصوص ابني الإمام، انظر: التعريف، 29-32؛ النفح، ج. 3: 118؛ البستان، 123؛ البغية، 57؛ الديباج، 152.
[18] عن ابن البنا، يمكن مراجعة:
Dr H. P. J. Renaud, «Ibn al-Bannā’ de Marrakech sufi et mathématicien,» Hespéries 1938. Le calendrier d’lbn Al- Bannā’ de Marrakech, texte arabe inédit, établi, traduit, annoté, par Dr H. P.J. Renaud (Paris : Larose, 1948). Juan Vernet, Contribución al estudio de la labor astronómicade Ibn Al-Bannā’ (Tetouan, Editora Marroquí, 1952).
[19] يحيى بن خلدون، البغية، 57.
[20] اللباب، المقدمة.
[21] لعل علي الوردي (منطق، 129، 133) يبتعد كثيرا عندما يؤكد بأن الآبلي كان شيعيا وكان يمارس التقية.
[22] ابن خلدون، المقدمة، ج. 1: 57.
[23] المقري هذا هو جد صاحب نفح الطيب، وقد درس على الآبلي.
[24] ابن مريم، البستان، 248.
[25] التعريف، 65، حيث يقول بأن الآبلي قد شرح لمحمد الحسني التلمساني كتاب الإشارات لابن سينا.
[26] Luis Gardet et George Anawati, Introduction à la Théolologie musulmane (Paris : Vrin, 1948), 162 sq.
[27] ابن مريم، البستان، 249. نجد نفس الشيء في نفح الطيب، ج. 3: 119.
[28] وخاصة في كتاب الرد على المنطقيين (طبعة بومباي، 1949). ومع ذلك، يجب ملاحظة أن العلاقات بين الأساتذة المشارقة والأساتذة المغاربة خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري معقدة للغاية وتنتظر دراسة مستقلة في ذاتها.
[29] أي في الوقت الذي عاد فيه ابن خلدون إلى تونس بعد أن كتب المقدمة وبدأ في تأليف تاريخ العبر؛ انظر التعريف، 249 وما بعدها. حول النزاع بين ابن خلدون وابن عرفة، انظر: ر. برنشفيغ، افريقية زمن الحفصيين، 391، حيث يتم تناول القيمة العميقة والرمزية للمعارضة بين الفقيه والمؤرخ-السوسيولوجي بوضوح وتعبير دقيق.
[30] التعريف، 23.
[31] التعريف، 38. نجد، مع بعض الاختلافات، التقسيم نفسه وترتيب العرض نفسه في الجزء السادس من المقدمة.
[32] المقدمة، 579، 532، 492.
[33] كان ابن خلدون واعيًا بكل هذا الثراء، كما يتضح في مقدمة اللباب.
[34] نفح الطيب، ج. 4: 19.
[35] ابن مريم، البستان، 249.
[36] المقدمة، 328-329.
مقالات ذات صلة
في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة
في الأصول الشرقية للفيزياء الحديثة[1] وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra ترجمة وتقديم محمد أبركان*جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس تقديم المترجم صاحب المقال الذي نترجمه هنا هو وليام رو-بيرا William Rowe-Pirra، الكاتب الفرنسي المتخصص في الصحافة العلمية. وعلى الرغم من أن...
اعتبارات الماهية: الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي
Iʿtibārāt al-Māhiyah:al-Ibdāʿ al-Sīnawī, wa Ibtikār al-Mudarris al-Zanūzī اعتبارات الماهيّة: الإبداع السينوي، وابتكار المدرّس الزنوزي رامين عزيزي وجهنكير مسعودي جامعة فردوسي، مشهد ترجمها عن الفارسية الهواري بن بوزيان جامعة المصطفى العالمية، قم...
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي
القياس الشعري والتخييل عند الفارابي لويسْ خَابْيِيرْلُوبيثْ فارْخَاتْجامعة بَانْأمريكَانَا-مكسيكو سيتي ترجمة محمد الولي[1]جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس كثيرة هي الدراسات التي أنجزت في العالم العربي حول دمج كتابي الخطابة والشعر لأرسطو ضمن الأورغانون. وإذا تم الاتفاق...
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م)
العلم العربي والثقافة الإسيدورية (92-206هـ/711-821م) خوليو سامسو نقله من الإسبانية إلى العربية مصطفى بنسباعجامعة عبد المالك السعدي-تطوان تقديم رغم أن كتاب علوم الأوائل في الأندلسLas ciencias de los antiguos en al-Andalus للأستاذ خوليو سامسو Julio Samsó قد صدر سنة...
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل
بأي معنى ولأي غرض ندرس تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ تاريخ تقليد مهمل* هانس ديبرترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد تقديم الترجمة هانز دايبر مستشرق ألماني من مواليد عام 1942. حصل على الدكتوراه عام 1968. واشتغل أستاذًا للغة العربية والإسلام في الجامعة الحرة بأمستردام من عام 1977 إلى...
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘: ملاحظات أوليّة
تقليد عثمانيّ في شرح كتاب الغزالي ’تهافت الفلاسفة‘ملاحظات أوليّة[1] تأليف: ل. فان ليتجامعة يال-نيو هيفن ترجمة وتقديم: سعيد البوسكلاويجامعة محمّد الأوّل-وجدة/جامعة زايد-أبو ظبي تقديم المترجم ننقل إلى القارئ العربيّ دراسة قيّمة ترصد تقليدا فكريّا كاملا في شرح كتاب...
قصة عمر الأرض
قصة عمر الأرض ترجمة وتقديم محمد أبركان جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس تقديم المترجم المقال الذي نترجمه هنا هو للفيزيائي هوبير كريبين Hubert Krivine؛ وقد سبق لهذا العالِم أن اشتغل باحثا ضمن بنية البحث بمختبر الفيزياء النظرية والنماذج الإحصائية بجامعة...
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية
بيبليوگرافيا وصفية للفلسفة الإشراقية[1] تأليف: محسن كَدِيوَر[2] ترجمها عن الفارسية يونس أجعون[3]جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس (1)المقدمة 1. مكانة الفلسفة الإشراقية ضمن الفلسفة الإسلامية تُعدُّ الفلسفةُ الإشراقية أحدَ مدارس الفلسفة الإسلامية الثلاث، وقد...
جانبٌ من المنعطف السِّينوي في علم الكلام السُّنِّي
جانبٌ من الـمُنعطف السّينويّ في علم الكلام السُّنّي[1] روبرت ويسنوڤسكي[2]جامعة ماكگيل، مونتريال ترجمة هشام بوهدي[3]جامعة القرويين، الرباط تقديم الترجمة ما أنوي كتابته في هذه الفقرة المختصرة ليس تقديماً لمضمون المقالة ولا لصاحبها؛ لأنّ المقالة قد أصبحت من كلاسيكيّات...
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس
القياس الشعري حسب كتاب الشعر لابن طُملوس مارون عواد المركز الوطني للبحث العلمي، باريس ترجمة وتقديم فؤاد بن أحمد جامعة القرويين، الرباط تقديم حظيت نظرية الشعر المنطقية باهتمام كبير من قبل الدارسين والمهتمين بالتآليف المنطقية للفلاسفة في السياقات الإسلامية؛ ويحتل...