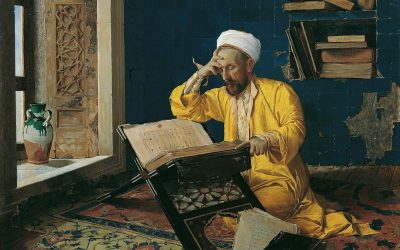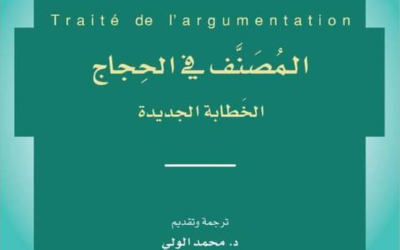![]()
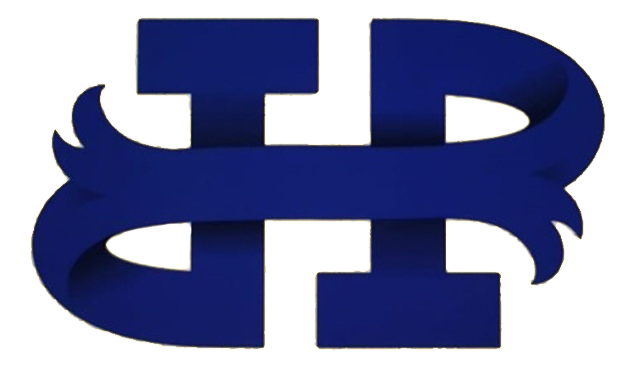
منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق

Al-Ghazālī’s Methodology in His Writings on Logic
Manhaj al-Ghazālī fī al-Taʾlīf fī ʿIlm al-Manṭiq
منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق
محمد روي
Mohamed Roui
جامعة عبد الملك السعدي
Université Abdelmalek Essaadi
ملخص: تتناول هذه الدراسة معالم منهج أبي حامد الغزالي (ت. 505هـ/1111م) في التأليف في علم المنطق، مع العلم أن التأليف في هذا الفن في التراث المنطقي العربي الإسلامي لم يكن على طريقة واحدة، بل تباينت طرائقه بتباين مقاصد المؤلف وغاياته، إضافة إلى تغير الواقع الثقافي والتاريخي الذي يحكم الاختيارات المنهجية، ولذلك يحاول هذا البحث الكشف عن طريقة الغزالي من جانبين مهمين؛ جانب شكلي، وجانب مضموني، يتولى الأول إيضاح الأساليب التي اتبعها في بنية المادة المنطقية، في حين يروم الثاني بيان منهجه في عرض المضامين والمعارف؛ أي من داخل المحتوى. على أن قيمة البحث في هذا الموضوع تكمن في التوصّل إلى كون منهجه التأليفي يتضمن أبعادا إبداعية، إذا وضع في زمنه وواقعه الفكري في القرن الخامس للهجرة.
الكلمات المفتاحية: الغزالي، المنطق، التراث المنطقي العربي الإسلامي، الجانب الشكلي، المادة المنطقية، الواقع الثقافي والتاريخي.
Abstrat: This study examines the characteristics of Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s (505/1111) approach to writing in the field of logic. Writing in this discipline within the Arab-Islamic logical heritage is known to have employed various methods, influenced by the author’s intentions and objectives, as well as the cultural and historical context that shaped methodological choices. Consequently, this research aims to elucidate al-Ghazālī’s argumentative method from two significant perspectives: form and content. The formal aspect clarifies the methods he employed in structuring logical material, while the content aspect seeks to explain his approach to presenting knowledge and ideas. The research reveals that al-Ghazālī’s authorial approach encompasses creative dimensions when considered within the intellectual and historical context of the fifth century AH.
Keywords: Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Logic, Arab-Islamic logical heritage, Methodology, Argumentative method, Formal aspect, Content aspect, Intellectual context, Historical context
مقدمة
حضرت مؤلفات الغزالي (ت.505هـ/1111م) المنطقية في الثقافة العربية الإسلامية حضورا كبيرا ومستمرا، إذ حافظ على مكانته إماما في العلوم الإسلامية (الفقه وأصوله وعلم الكلام وعلم التصوف وغيرها)، وإماما يقصد في تعلم المنطق وتعليمه أيضا، مثلما هو كذلك ناقد في الفلسفة والعقليات عموما، ولعل هذا هو ما يكسبه قيمة علمية وإنسانية متميزة في ذات الوقت؛ علمية لكونه جمع العلوم التي كانت متداولة في عصره، وإنسانية لأن التفرد والقدرة البشرية على الإبداع بادية من أعماله.
لكن، ما يهمنا في هذا البحث هو ما كتبه في المنطقيات من جهة المنهج والأسلوب، فليس ثمة شك أن مؤلفاته في هذا الشأن من الشهرة بمكان، فهو كما يقول تاج الدين السُّبكي(ت.771هـ/1369م) قد ”برع في المنطق، وقرأ الحكمة، والفلسفة، وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدى للرد على مبطليهم، وإبطال دعاويهم، وصنف في كل فن من هذه العلوم كتبا، أحسن تأليفها، وأجاد وضعها، وترصيفه،“[1] فحضوره في قلب الثقافة العربية الإسلامية لم يكن قاصرا على التمكن من علم المنطق بل من محاولة الإبداع فيه، وخاصة في مضمون مادته العلمية وفي طريقة عرضها.
هذا، ونروم هنا استشكال منهج الغزالي في التأليف المنطقي من ناحية الشكل والمضمون، كما عرضه في كتبه المنطقية المعروفة، وذلك بالضرب نحو كتبه هاته، لنستكشف منهجه من متنه، إذ الفهم الجيد للكاتب/الفيلسوف يكون ”من داخل مرجعيته لا من خارجها.“[2] لا سيما أننا ندعي أنه انفرد بمنهج مميز في الجنس التأليفي من بين مناطقة المسلمين الذين بحثوا ”المنطق الأرسطي، ولكنهم لم يبحثوه كما تركه مؤلف الأورغانون نفسه، بل من خلال أبحاث مفسرة له أحيانا، ومكملة له تارة، ومعارضة له طورا.“[3]
وإذا كان هذا الموضوع متعلقا بمنهجه الشكلي والمضموني، فالدراسات التي طرقته قد التفتت أكثر للجانب المضموني، ولعل أقربها دراسة أحمد الفراك الموسومة بآليات التقريب التداولي وتشغيل المنطق عند الغزالي،[4] ودراسة عبد الكريم عنيات أسلمة المنطق: الأورغانون الأرسطي بين يدي الغزالي،[5] ودراسة باللغة الإنجليزية عنوانها ”مقاصد ومراجع معيار العلم في فن المنطق“[6] ليامان توبيك(Yaman Twopek) وقمر الدين صالح (Kamarudin Salleh)، ولكن مع ذلك لا تخلو من إيرادها لبعض ما يتصل بالجانب الشكلي. والملاحظ أن الهم الإشكالي لهذه الدراسات ينطوي على إبراز إسهام الغزالي في المنطق من خلال وضعه كلحظة تاريخية في التراث المنطقي العربي الإسلامي ومساهماته في تطور العلوم الإسلامية، بينما يرنو هذا البحث الكشف عن منهجه التأليفي؛ أي الاقتصار على ما هو منهجي في كتبه المنطقية.
وحتى نقارب هذا الإشكال، بالإمكان تقسيم هذه الورقة إلى محورين أساسين: أولا: في الجانب المنهجي الشكلي، وثانيا: في الجانب المضموني المعرفي.
أولا: في الجانب المنهجي الشكلي
نتطرق في هذا المحور إلى جملة قضايا تدور حول مناهج التأليف في علم المنطق، بحيث نبتدئ بالتعرُّف عليها قبل لحظة الغزالي، ومن ثمة نتجه صوب الكشف عن منهج أبي حامد من خلال استشكال مسألة من تأثر به في هذا الشأن، على أن نثير في نهاية هذا المحور علاقته ببنية الأورغانون الأرسطي وما إذا كان على دراية بمنهجيته التأليفية.
- مناهج التأليف في علم المنطق قبل الغزالي
يُحتم الحديث عن طرق التأليف في علم المنطق قبل الغزالي الانطلاق بداية من صاحب المنطق أرسطوطاليس، ثم المرور على مناهج تقريب المنطق عند مناطقة الإسلام، فأرسطو بعبارة ابن خلدون(ت.808هـ/1406م) هو الذي ”هذّب مباحثه ورتَّب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتها،“[7] والواقع أن أعمال المعلم الأول هي على نحو ما عبارة عن مجموعة من الرسائل جُمعت في كتاب كلي هو ما يُعرف بالأورغانون، وترتيبها كما يقول روبير بلانشي(Robert Blanché) ليس من صنعه؛ إذ ”في القرن الأول قبل المسيح، قام التلميذ الحادي عشر لأرسطو، أندرونيكوس الرودُسي بنشر أعمال المعلم، فرتبها حسب مواضيعها، وهكذا اجتمعت الأعمال المنطقية في مجموعة واحدة.“[8]
على أن الأورغانون الأرسطي يضم ست رسائل أو ستة أجزاء، وأي إطلاق يجوز عليه، وهي: الأولى: قاطغورياس أو المقولات، والثانية: باري أرمينياس أو العبارة، والثالثة: أنالوطيقا الأولى أو التحليلات الأولى أو القياس، والرابعة: أنالوطيقا الثانية أو التحليلات الثانية أو البرهان، والخامسة: الطوبيقا أو المواضع الجدلية، والسادسة: سوفسطيقا أو نقض الأغاليط،[9] غير أن سمبليقيوس، وهو من شرّاح أرسطو اليونانيين، أضاف إلى هذه المجموعة كتابي الخطابة والشعر، ووضع أمونيوس، وهو من الشراح الإسكندريين المتأخرين، إيساغوجي لفرفوريوس الصوري مقدمة لهذه الكتب.[10]
لكن، في هذا الإطار يمكن طرح هذا السؤال: هل اعتمد مناطقة الإسلام المنهج الأرسطي في التأليف في علم المنطق في كتبهم؟ أو بعبارة أخرى: هل اتبعوا المنهج الذي اعتمده أرسطو في موسوعته المنطقية الأورغانون؟
إن منهج أرسطو يعرض المدونة المنطقية في أجزاء أو كتب مستقلة، لكل كتاب موضوعه وهدفه وموقعه، لكن مناطقة العرب يضيفون إلى تقسيم المعلم الأول كتبا أخرى؛ حيث دأبوا ”على أن يقسموا المنطق إلى تسعة أقسام متدرجة ومتلاحقة، وهي: إيساغوجي، وقاطيغورياس أو المقولات، وباري أرمنيياس أو العبارة، وأنالوطيقا الأولى أو التحليلات الأولى، وأنالوطيقا الثانية أو التحليلات الثانية، وطوبيقا أو الجدل، وسوفسطيقا أو السفسطة، وريطوريقا أو الخطابة، وبويطيقا أو الشعر.“[11] أي بزيادة ثلاثة كتب عما عند صاحب الأورغانون.
في حقيقة الأمر، يمكن القول: إن مناهج التأليف في علم المنطق كما في الفكر الفلسفي العربي الإسلامي ليست على طريقة موحدة؛ إذ غالبا ما يتحكم اختيار الـمُؤلف في المنهج البنائي لكتابه وفي الغرض الذي يروم إيصاله من خلاله، أو بحسب الفئة المستهدفة التي يخاطبها؛ ولا يخفى كون بعض المؤلفات في هذا العلم تتقصد ما هو تعليمي، فتتميز بسهولة تلقيها، وقرب مأخذها للمتعلم، وبعضها الآخر تتجه إلى عرض المادة العلمية بشكل مفصل يتجاوز ما هو تربوي، بحيث تُعرَض فيها المادة المنطقية عرضا موسعا، كما يتضمن محتواها العديد من الاجتهادات والتحليلات والمقارنات والانتقادات؛ أي أن الأولى عرضها تعليمي والثانية عرضها نقدي، وهي التي حاذوا فيها حذو منهج المعلم الأول.
ولعل هذا المنهج هو ما ألمح إليه ابن خلدون في نص مطول من مقدمته،[12] يمكن وضعه في الاعتبار إذا كان القصد تعليل هذا التقسيم، ولكن ما دام الأمر متعلقا بمعرفة طرق مناطقة الإسلام في التأليف، فسيتم الانصراف إلى بيان هاته الطرق من خلال مؤلفاتهم.
وكما تمت الإشارة أعلاه فالتأليف في التراث المنطقي العربي الإسلامي له طريقتان: تتبع الأولى المنهج الأرسطي، ومنهج شراحه، أي عرض المادة المنطقية بحسب أجزاء الأورغانون، كما فعل أبو نصر الفارابي (ت.339هـ/950م) في الفصل الذي خصصه لعلم المنطق من كتابه إحصاء العلوم؛ إذ يقول في هذا الشأن: ”أجزاء المنطق بالضرورة ثمانية، كل جزء منها في كتاب،“[13] ثم يعرض محتويات هذه الأجزاء، ولكنه في كتبه التي فصّل فيها مادة المنطق يزيد على ما في أجزاء الأورغانون، فبحسب ما حققه كل من ماجد فخري ورفيق العجم؛ فإن ما كتبه المعلم الثاني يضم اثنَي عشر جزءا، وهي: 1.مدخل إلى صناعة المنطق، 2. الفصول في التوطئة، 3. كتاب الإيساغوجي، 4. كتاب القاطاغورياس، 5. كتاب العبارة، 6. كتاب القياس، 7. كتاب التحليل، 8. كتاب الأمكنة المغلطة، 9. كتاب البرهان، 10. كتاب الجدل، 11. كتاب الخطابة، 12. كتاب الشعر.[14]
وإذا انتقلنا إلى أبي علي ابن سينا(ت.428هـ/1037م) نجده يجاري التقسيم الأرسطي السابق ذكره كما في كتابه الشفاء، فهو يقول في هذا المعنى: ”وأما هذا الكتاب فأكثر بسطا[…] وتحرّيت أن أحاذي به ترتيب كتب صاحب المنطق،“[15] والأمر نفسه أيضا عند أبي محمد ابن حزم الأندلسي (ت.456هـ/1064م) في تقريبه الذي يقول في مقدمته: ”[…] فمنها كتب أرسطاطاليس الثمانية في حدود المنطق،“[16] فهذه الطريقة وإن كانت أحيانا تتباين فيها عدد أجزاء الأورغانون، فهي من الطرق المعتمدة في التأليف المنطقي عند العرب والمسلمين.
إلا أن الطريقة الثانية أيضا وإن كانت تختلف عن الأولى في كونها طريقة تعليمية بالأساس، فإنها، وهذا هو الأهم، يتم فيها عرض المحتوى المنطقي لا على تقسيم الأورغانون الأرسطي، بل يكون ذلك وفقا لقسمين تتشعب منهما أبحاث علم المنطق في هذا المنهج، وهما: التصور والتصديق، ولعل شهرة هذه الطريقة ”تعود لابن سينا“[17] في كتبه الأخرى—غير الشفاء— التي لخص فيها علم المنطق، نجده في بداية كتابه النجاة يقول: ”كل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق، والتصور هو العلم الأول ويُكتسب بالحد وما يجري مجراه، والتصديق إنما يكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه،“[18] ونفس الشيء في كتابه الإشارات والتنبيهات، حيث قال: ”فقصارى أمر المنطقي، إذن: أن يعرف مبادئ القول الشارح، وكيفية تأليفه، حدّا كان أو غيره، وأن يعرف مبادئ الحجة، وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره.“[19]
وصحيح أن ابن سينا هو من اشتهر بهذه الطريقة، ولكن ذلك إنما يختص بمنهجية وضع الكتاب وتقسيمه بعمومه إلى طرق الوصول إلى التصور وإلى التصديق، بحيث يوزع أهم ما يراه من أبحاث أجزاء الأورغانون على هذين القسمين، فإذا انحصرت في التصورات والتصديقات فإن ”لكل منهما مبادٍ ومقاصد: فمبادي التصورات: الكليات الخمس، ومقاصدها: القول الشارح (التعريف)، ومبادي التصديقات: القضايا وأحكامها، ومقاصدها: القياس بأقسامه، فانحصر فن المنطق في هذه الأبواب الأربعة، وأما بحث الدلالات، ومباحث الألفاظ، إنما ذكروها في كتب المنطق؛ لتوقف بحث الكليات الخمس عليه، ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة عدّ الأبواب في المنطق ثمانية، ومن عدّ معها مبحث الألفاظ مستقلا كانت الأبواب تسعة.“[20]
لكن إذا رجعنا إلى ما كتبه الفارابي نجد أنه قد سبق ابن سينا إلى هذا التقسيم، يقول في كتاب البرهان: ”والمعارف صنفان: تصور وتصديق. وكل واحد من هذين، إما أتم وإما أنقص. […] فالتصديق التام هو اليقين، والتصور التام هو تصور الشيء بما يلخص ذاته بنحو ما يخصه، وذلك أن يتصور الشيء بما يدل على حدِّه.“[21] وإلى الشارح الأكبر لأرسطو أبي الوليد ابن رشد (ت.595هـ/1198م)؛ نجد أن الفارابي وابن سينا لم يكونا سبّاقين إلى هذا المنهج، فقد كان المعلم الأول أول من أشار إليه، حيث يقول ابن رشد في بداية تلخيصه لبرهان المعلم الأول: ”والعلم الذي يجب أن يتقدم على كل ما شأنه أن يُدرك بفكر وقياس، على ضربين: إما علم بأن الشيء موجود أو غير موجود؛ وهذا العلم الذي أسميّ: التصديق، وإما علم بماذا يدل عليه اسم الشيء، وهو الذي يسمى: تصورا،“[22] على أنه من جهة تطبيق هذا المنهج وتوزيع المادة المنطقية عليه، فيبدو أن ابن سينا هو من تفردّ واشتهر به على مستوى تاريخ علم المنطق العربي.
- منهج الغزالي التأليفي في المنطق
هل كان الغزالي مبدعا في طريقة بناء كتبه المنطقية أم أنه تأثر بمن سبقه؟
لا شك أن الغزالي عوَّل في استيعابه للمنطق على مؤلفات كل من الفارابي وابن سينا، لكن ذلك لا يفيد مطلقا بأنه تأثر بمنهج ابن سينا في التأليف، ومن أجل الاستدلال على ذلك، يمكن أن نستعين أولا بما قاله أصحاب الطبقات والتراجم المتقدمة عمن تأثر به الغزالي من فلاسفة الإسلام، قبل أن نستدل على ذلك من متن الغزالي المنطقي، فإذا تصفحنا ترجمته المستوفية في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السُّبكي، نجد فيها قولا لأبي عبد الله محمد المازري(ت.536هـ/1141م) —وهو قريب العهد زمنيا من حجة الإسلام —يشير فيه إلى تأثره بأبي علي؛ إذ يقول: ”[…] ثم كان في هذا الزمان المتأخر رجل من الفلاسفة، يعرف بابن سينا، ملأ الدنيا تأليفا في علم الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة، وتلطف جهده حتى تم له ما لم يتم لغيره، وقد رأيت جملا من دواوينه، ورأيت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من الفلسفة،“[23] بل كان مولعا بدراسة كتبه في شبابه،[24] وبعض الباحثين يبالغ بالإشارة إلى أنه ”من بين هؤلاء الفلاسفة المسلمين، كان ابن سينا أكبر اهتماماته.“[25]
وإذا كان الأمر هكذا، فلا غرو أن يكون متأثرا به أيضا في المنطق، باعتباره خادما للعلوم بما في ذلك علم الكلام وأصول الفقه، ومن الطبيعي أن يكون على اطلاع بما كتبه فيها، ولذلك يبالغ مؤرخ المنطق العربي نيقولا ريشر(Nicholas Rescher) بالقول بأن ”الغزالي كان في المنطق تابعا لابن سينا تماما، ولم يقف منه في أغلب الأحيان موقفا نقديا،“[26] وانسجاما مع موقف ريشر يرى عبد الله العروي أن كتاب معيار العلم ما هو إلا تلخيص لما في كتب مناطقة الإسلام كابن سينا،[27] في حين يلاحظ رفيق العجم أن كتابه الآخر مقاصد الفلاسفة —في التركيب الشكلي له— ”عدم اختلافه عن ابن سينا في كتبه المنطقية، من ناحية التبويب والمصطلحات والمواضيع.“[28]
كما لا ينبغي أن يعزب عن بالنا—وإن لم يكن قد ذكر في كتبه المنطقية اسم ابن سينا ولا أشار إلى كتاب منطقي له— أنه كان يستدعيه ولكن في سياقات أخرى غير سياق علم المنطق، وهو ما يتعلق بثنائه على ما نقله وصاغه كل من أبي علي والفارابي من العلوم الفلسفية، يقول في تهافت الفلاسفة: ”وأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة في الإسلام الفارابي أبو نصر وابن سينا[…]،“[29] وفي المنقذ من الضلال: ”[…] على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين (الفارابي وابن سينا)، وما نقله غيرهما لا يخلو من تخبط وتخليط، يتشوش فيه قلب المطالع، حتى لا يفهم.“[30]
وأيّا كان الأمر، فالغزالي في كتبه المنطقية اتبع طريقة ابن سينا التي سبق بيانها، فهو في واقع الأمر أبرز من تمثّلها، أعني في طريقة ترتيب المادة المنطقية إلى قسمي التصور والتصديق، ففي مقاصد الفلاسفة تنقسم العلوم عنده إلى ”التصور والتصديق،“[31] ومن ثمة كما يقول أبو حامد: فـ”أقسام المنطق وترتيبه، يتبين من ذكر مقصوده، ومقصوده الحد والقياس وتمييز الصحيح منهما عن الفاسد،“[32] وفي المعيار: ”وإن أردت أن تعلم فهرست الأبواب، فاعلم أنّا قسمنا القول في مدارك العلوم إلى كتب أربعة: كتاب مقدمات القياس، وكتاب القياس، وكتاب الحدّ، وكتاب أقسام الوجود وأحكامه،“[33] وفي المحك: ”فليكن كتابنا قسمين: قسم هو محك القياس، وقسم هو محك الحدّ.“[34] ولكنه في المقدمة المنطقية للمستصفى يقدم الحديث عن الحد على القياس على غير عادته في كتاباته السابقة، يقول: ”فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول مشتملة على دعامتين: دعامة في الحد، ودعامة في البرهان،“[35]ويبرر تقديمه له بالقول: ”الدعامة الأولى في الحد: ويجب تقديمها، لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات.“[36]
من الصحيح الإشارة إلى أنه لا يعني كون الغزالي يحاذي ابن سينا في منهجه التأليفي أنه من ناحية بناء أبحاث كتبه تابع له بشكل مطابق؛ كلا، فعرض أبي حامد للمنطق له أغراض —سنتعرف عليها لاحقا— يصرّف من أجلها مادته، ونفس الشيء بالنسبة لابن سينا خاصة في كتابه النجاة، الذي يقترب منهجيا من كتب الغزالي.
وبالإمكان هنا عرض نص يبين فيه الغزالي تقسيم أبحاث كتابه معيار العلم وما سيتناوله فيه، فالعلم عنده ”ينقسم إلى العلم بذوات الأشياء كعلمك بالإنسان والشجر والسماء وغير ذلك، ويسمى هذا العلم تصورا، وإلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض؛ إما بالسلب أو بالإيجاب كقولك: الإنسان حيوان، والإنسان ليس بحجر، فإنك تفهم الإنسان والحجر فهما تصوريا لذاتهما، ثم تحكم بأن أحدهما مسلوب عن الآخر أو ثابت له، ويسمى هذا تصديقا؛ لأنه يتطرق إليه التصديق والتكذيب، فالبحث النظري بالطالب: إما أن يتجه إلى تصور، أو إلى تصديق، والموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا، فمنه حدّ، ومنه رسم، والموصل إلى التصديق يسمى حجة، فمنه قياس، ومنه استقراء وغيره، ومضمون هذا الكتاب تعريف مبادئ القول الشارح لما أريد تصوره، حدّا كان أو رسما، وتعريف مبادئ الحجة الموصلة إلى التصديق، قياسا كانت أو غيره، مع التنبيه على شروط صحتهما، ومثارات الغلط فيهما.“[37]
والظاهر أن الغزالي استوعب منهجية ابن سينا، وأدرك أن المادة المنطقية تصدر من التصورات والتصديقات، ومن ثمة عمل على عرض أبحاثه بما يوافق مراميه واهتماماته الفكرية، فهو في توزيع عناوين كتبه يختلف عن توزيع ابن سينا، فإذا كان على سبيل المثال يقدم الحديث عن القياس فإن أبا علي يقدم ما يتعلق بالحدّ عدا ما في مقدمة المستصفى المنطقية، هذا فضلا عن الفوارق الكثيرة في الاصطلاحات وطرق المعالجة والأمثلة. وصحيح أن التصور الأولي يوحي بتطابق منهجهما ولكن إذا تم التدقيق في كتبهما يظهر هذا التباين، وإن كانت أساسيات صناعة المنطق في عمومها محتفظة عند الغزالي بما هو معروف من القوانين وطرق الاستدلال والأبحاث المتداولة فيها.
بعد هذا البيان، يجوز طرح هذا السؤال: ما موقع كتابات أبي حامد الغزالي من هذين المنهجين، أي المنهج الأرسطي والمنهج السينوي؟ وأيّ منهج ارتضاه؟
- الغزالي وبنية الأورغانون الأرسطي: من الإدراك التام إلى الإبداع المنهجي
لسوف يأتي على الأذهان من خلال ما سبق تساؤل مفاده: هل كان الغزالي على دراية بالمنهجين السابقين؟ أجل؛ إن كتب الغزالي ومنهجيته فيها لا تدل على أنه لم يكن على دراية بالمنهج الآخر للتأليف المنطقي الذي يُجزّئ المادة المنطقية إلى كتب وأجزاء، فقد ظل، كما يقول محمد إقبال ”على الجملة تلميذا لأرسطو في المنطق،“[38] ذلك أنه كان يعلم جيدا، كما يقول هو نفسه في المنقذ من الضلال، أن ”أرسطوطاليس هو الذي رتب لهم المنطق، وهذّب لهم العلوم، وخمّر لهم ما لم يكن مخمّرا من قبل، وأنضج لهم ما كان فجّا من علومهم.“[39]
وأكثر من ذلك، تتبدى ملاحظة قيمة من خلال كتبه، وهي أنه أحيانا يذكر أسماء أجزاء الأورغانون الأرسطي، يظهر مثال ذلك في المقدمة الرابعة التي وضعها لكتابه تهافت الفلاسفة؛ إذ يقول فيها: ”[…] ونوضح ما شرحوه في صحة مادة القياس، في قسم البرهان من المنطق، وما شرطوه في صورته في كتاب القياس وما وضعوه من الأوضاع في إيساغوجي وقاطيغورياس التي هي من أجزاء المنطق ومقدماته،“[40] فمن الواضح هنا أنه يذكر أربعة كتب وهي: البرهان والقياس وإيساغوجي وقاطيغورياس، كما كان على وعي بأن الكتابين الأخيرين يعدّان من المقدمات المساعدة للكتابين الأولين، كما كان معروفا عند شراح أرسطو.
ويذكر أيضا في مقاصد الفلاسفة كتاب الإيساغوجي، ولكن الذي يثير الانتباه هو أن فهمه لمحتوياته مختلف تماما عما في كتاب فرفوريوس الصوري، يقول أبو حامد تحت عنوان القول في المنطق: ”ويتضح المقصود منها بتقسيمات خمسة: الأول إيساغوجي: أحدها بطريق المطابقة […] والآخر بطريق التضمن […] والثالث بطريق الالتزام […]،“[41] فيحصر مضامين الإيساغوجي فقط في ما يسمّى الدلالة الوضعية، ومن المعلوم أن فرفوريوس لم يتناول هذا البحث في كتابه،[42] ولا أي من مناطقة العرب كالفارابي[43] وابن سينا،[44] وإنما تناولوا فيه ما يتعلق بالكليات الخمس، وهذا ما لا يشير إليه حجة الإسلام.
مهما يكن، فإن هذا، يبين أنه يعرف المنهج التأليفي الآخر الذي لم ينتهجه، ولكنه، مع ذلك، إذا تأملنا مليا في كتبه المنطقية التي ليست على طريقة التأليف الأولى المشار إليها من قبل؛ يمكن رد بعض الأبحاث منها إلى أجزاء الأورغانون، كون عمل الغزالي المنطقي كان في استثمار هذه الأجزاء في كتبه لغايات ستتضح في المحور الثاني من هذا البحث.
إذا ابتدأنا بالإيساغوجي نجده يتناول أبحاثه في كتابه المعيار ضمن عنوان كبير هو مقدمات القياس، وفي كتابه الآخر المحك ضمن عنوان السوابق أي ما يسبق فن القياس، ففيها تناول ما يتعلق بدلالات الألفاظ ونسبتها إلى المعاني ومفهوم الكلي والجزئي والألفاظ المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة والمتشابهة والمشككة، والذاتي والعرضي، ورسوم المفردات الخمس التي تعرف بالكليات الخمس، ومعنى الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، وغير ذلك.
أما فيما يرتبط بالمقولات فالغزالي لم يتناولها سوى في معيار العلم وتحت عنوان غير معتاد عند المناطقة، وهو أقسام الوجود وأحكامه، وهو الكتاب الرابع من الكتب الأربعة التي قسّم إليها أبحاث المعيار، شرح فيها المقولات العشر: الجوهر والعرض والكم والكيف والمضاف والأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل.[45]
ولو انتقلنا إلى كتاب العبارة فسنتمكن من معرفة أبحاثه من خلال كتاب مقدمات القياس والسوابق في كتابيه المعيار والمحك على الترتيب، ففيهما تكلم عن انقسام اللفظ المفرد إلى اسم وفعل أو كلمة بتعبير المناطقة وإلى حرف، ثم تناول تركيب المعاني المفردة التي تعبّر عن الخبر والإنشاء عند المناطقة، وهي ما يعرف بالقضية، فتكلم عن مكوناتها من محمول وموضوع وعن انقسامها إلى قضية حملية وشرطية، وتكلم عن أحكام القضية كالعكس والنقيض، والقضايا الموجهة.
وبخصوص كتاب القياس فهو من الكتب التي ركز عليها الغزالي، فتطرق إلى صورته ومما يتكون، ومادته، ثم إلى أقسامه كالحملي والشرطي وقياس الخلف والاستقراء والتمثيل وأشكاله، كل هذا في كتبه المنطقية المعيار والمحك ومقدمة المستصفى، بل حتى في القسطاس المستقيم نجد نظرية القياس المنطقي مبثوثة فيه باعتبارها نظرية تطبيقية.
على أنه إذا رجعنا إلى الكتب الأخرى للأورغانون الباقية وهي: البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر، يتبين أن الغزالي أدخل أغلب أبحاثها ضمن كتاب القياس، بما يخدم غرضه في إيراده للمادة المنطقية، بوصفها مواد الأقيسة، فيتحدث مثلا عن البرهان بأنه ”القياس المؤلف من مواد يقينية،“[46] وبأنه ”ما يفيد اليقين الضروري الدائم الأبدي الذي يستحيل تغيُّيره،“[47] وأن المقدمات التي تصلح لمثل هذا القياس البرهاني هي: اليقينيات والمحسوسات والمجربات والقضايا التي عُرفت لا بنفسها بل بوسط؛[48] هذا فضلا عما يتعلق بالحدود والرسوم.
أما بخصوص كتاب الجدل فقد أشار إلى بعض أبحاثه بشكل متفرق، وهو قبل ذلك يعرّفه في سياق كلامه عن مواد القياس بأنه ”اعتقاد مقارب لليقين، مقبولا عند الكافة في الظاهر، لا يشعر الذهن بإمكان نقيضه على الفور، بل بدقيق الفكر، فيسمى القياس المؤلف منه جدليا؛ إذ يصلح لمناظرات الخصوم،“[49]وتكلم عن المطلوبات من العلوم بالسؤال،[50] وعن ترتيب طلب الحد بالسؤال،[51] مثلما أشار إلى ذلك أرسطو في نهاية كتاب الجدل.[52]
وأما ما يتعلق بكتاب السفسطة أو الحكمة الموهومة فالغزالي يعرّف القياس المغالطي بأنه يكون ”مشبّها باليقين أو بالمشهور المقارب لليقين في الظاهر، وليس بالحقيقة كذلك؛ وهو الجهل المحض، ويسمى القياس المؤلف منه مغالطيا وسوفسطائيا؛ إذ لا يقصد بذلك إلا المغالطة والسفسطة، وهو إبطال الحقائق،“[53] كما أثار بعض أبحاث هذا الكتاب في موضعين، موضع يطلق عليه في المغلّطات في القياس في فصلين الأول في حصر مثارات الغلط والثاني في بيان خيال السوفسطائية،[54] وموضع ثانٍ يطلق عليه مثارات الغلط في الحد،[55] فظهر أنه اقتصر على ما يرتبط بالمغلطات في القياس والحد؛ إذ هما ركني المنطق عنده، كما أنه يقابل السفسطة بمثارات الغلط.
والحق أن حجة الإسلام لم يعرض لأبحاث كتابي الخطابة والشعر بشكل مفصل، فقد اكتفى بأن عرّف القياس الذي يتشكل من موادهما، فيقول عن القياس الخطبي: ”يكون اعتقادا بحيث لا يقع به تصديق جزم، ولكن غالب ظن وقناعة نفس، مع خطور نقيضه بالبال، أو قبول النفس لنقيضه إن أُخطر بالبال، وإن وقعت الغفلة عنه في أكثر الأحوال، ويسمى القياس المؤلف منه خطابيا؛ إذ يصلح للإيراد في التعليمات والمخاطبات؛“[56]بينما القياس الشعري: ”لا يُذكر لإفادة علم أو ظن، بل المخاطب قد يعلم حقيقته، وإنما يُذكر لترغيب أو تنفير، أو تسخية أو تبخيل، أو ترهيب أو تشجيع، وله تأثير في النفس بترديدها على هذه الأحوال، وإيجابه انقباضا وانبساطا مع معرفة بطلانه،“[57]ويورد الإمام المنطقي أمثلة شعرية لهذا القياس خلافا للقياس الخطابي الذي لم يزد عن تعريفه السابق.
لكن هل يمكن إضافة تبرير آخر لاختيار الغزالي هذا النهج في توزيع أبحاث كتبه؟
من أجل البحث عن إجابة لهذا السؤال سوف نضطر إلى الرجوع إلى مقدمة المحك وخاتمة المعيار لعلهما تسعفا في زيادة الوعي بمنهج الغزالي في التأليف المنطقي، ففي المحك نراه يقول: ”وتحقق أني جامع لك مع الإيجاز من النكت النفيسة زبدة مخضِها، وصفوة محضها،“[58] وفي خاتمة كتابه الآخر يقول: ”ولنقبض عنان البيان عند هذا؛ فإنه خوضٌ في التفصيل، وليس وضع هذا الكتاب لبيان تفاصيل الأمور.“[59]
فماذا يمكن أن تستنتجه هنا؟
إذا أمعنا النظر في ما قال الغزالي يمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى اعتبار ما كتبه في المنطقيات اختصارا أو تلخيصا لما يراه الغزالي مُهما في ذاته، أو مُهما له في دراساته الشرعية الأخرى البعيدة عن علم المنطق. ولكن، ما المقصود في أدبيات التأليف العربي بالتلخيص؟
إن المقصود به ”التحويل المكثف للنص، قد ينطوي على التضحية بكثير مما يوجد في النص الأصلي من أمثلة ومناقشات، وأوجه للخلاف في الرأي، كما يقوم على التضحية بالظلال الموضحة للمعنى من أساليب البلاغة وجماليات التعبير في النص الأصلي، وقد توجد في النص المطول درجات متعددة من الحكم على الأشياء، وعند التلخيص قد يُختزل ذلك في درجات صارخة من الرفض والقبول، أو الاستهجان والاستحسان، حيث يبدو تكثيف المعاني في التلخيص شبيها بتكثيف الألوان.“[60]
فيلوح من هاهنا أن الغزالي المنطقي إنما صرّف مادته بحسب حاجته التي يتقصدها؛ فمؤلفاته على هذا، تعتبر ملخصات من أجزاء الأورغانون الأرسطي، ولا تشتمل على كل ما ورد فيه. وبهذا، ينتهي ما تم قصده من بيان منهج تأليف الغزالي في علم المنطق على مستوى الشكل، وننتقل في المحور الموالي إلى منهجه على مستوى المضمون، من المبنى إلى المعنى.
ثانيا: في الجانب المضموني المعرفي
يمكن أن نتناول منهج الغزالي في ناحية صياغة المضمون المنطقي في كتبه من خلال إبراز غائية أبي حامد لمتنه المنطقي، والبعد الذي أدخله للمعنى المنطقي، وأيضا رصد منهجه في العرض المضموني لمادته المعرفية، ولعل ذلك قمين بأن يجمل طريقته التأليفية من جهة المضمون، فهذا إذن يتعلق بالمعنى لا المبنى الذي سبق بيانه.
- غائية التأليف المنطقي: من أجل تفهيم طرق الفكر ومسالك الأقيسة
إذا تأملنا أسباب تأليف الغزالي كتبه المنطقية سنصل إلى أنها تعود إلى سببين رئيسيين صرح بهما في كتاب معيار العلم؛ وذلك في قوله: ”إن الباعث على تحرير هذا الكتاب الملقب بمعيار العلم غرضان مهمان: أحدهما: تفهيم طرق الفكر والنظر، وتنوير مسالك الأقيسة والعبر؛ فإن العلوم النظرية لما لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة كانت لا محالة محصلة مطلوبة، وليس كل طالب يحسن الطلب، ويهتدي إلى طريق المطلب، ولا كل سالك يهتدي إلى الاستكمال، ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذروة الكمال، ولا كل ظان الوصول إلى شاكلة الصواب آمن من الانخداع بلامع السراب […] والباعث الثاني الاطلاع على ما أودعناه كتاب تهافت الفلاسفة، فإنا ناظرناهم بلغتهم، وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التي تواطأوا عليها في المنطق، وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك الاصطلاحات،“[61] إلا أنه لا ينبغي أن يتم حصر كل الأسباب فيهما؛ إذ باستطاعة قارئ كتبه التوصل إلى أسباب أخرى، من الممكن أن تكون أسبابا تابعة، ويكون ما صرح به أسبابا أصلية.
نلمح من قوله في المعيار أيضا أن كتابه قد ألفه من أجل غاية أخلاقية فضائلية، وهي تحكيم النفس ومحاولة إبعاد الفكر الحسي والوهمي عن التأثير فيها؛ إذ يقول: ”والنفس في أول الفطرة أشد إذعانا وانقيادا للقبول من الحاكم الحسي والوهمي؛ لأنهما سبقا في أول الفطرة إلى النفس وفاتحاها بالاحتكام عليها، فألفت النفس احتكامهما، وأنِست بهما قبل أن أدركها الحاكم العقلي، فاشتد عليها الفطام عن مألوفها، والانقياد لما هو كالغريب من مناسبة جبلتها، فلا تزال تخالف حاكم العقل وتكذبه، وتوافق حاكم الحس والوهم وتصدقهما، إلى أن تضبط بالحيلة التي سنشرحهما في الكتاب.“[62]
وسبب آخر يتعلق بأمر في غاية الأهمية بالنسبة لمشروع الغزالي المنطقي وهو تقويم الاستدلال الفقهي والكلامي، يمكن أن نلمحه من كتابه محك النظر في قوله: ”وأكثر أقيسة الجدليين من المتكلمين والفقهاء في مجادلاتهم وتصانيفهم مؤلفة من مقدمات مشهورة فيما بينهم، سلّموها لمجرد الشهرة، وذهلوا عن سببها، فلذلك نرى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة، فيتحيّرون فيها، وتتخبط عقولهم في تنقيحها،“[63] فلا غرو أن يكون انتقادُه لهم دليلا على عزمه المساهمة في ضبط هذين النوعين من الاستدلال.
ويطفو سبب آخر موجود في غير كتبه المنطقية أورده في كتابه جواهر القرآن ودرره، ويرتبط بغائية علم المنطق كما يتصوره أبو حامد، وهو كونه آلة للمحاججة في علم الكلام ومع الخصوم من الفلاسفة وأهل التعليم؛ يقول في ذلك: ”ومحاجَة الكفار ومجادلتهم، ومنه يتشعب علم الكلام المقصود لردّ الضلالات والبدع، وإزالة الشّبهات، ويتكفل به المتكلّمون، وهذا العلم قد شرحناه على طبقتين، سمينا الطبقة القريبة منهما الرسالة القدسيّة، والطبقة التي فوقها الاقتصاد في الاعتقاد، ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوَام عن تشويش المبتدعة، ولا يكون هذا العلم مليّا بكشف الحقائق، وبجنسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في تهافت الفلاسفة، والذي أوردناه في الرد على الباطنيّة في الكتاب الملقب المستظهري وفي كتاب حجّة الحقّ وقواصم الباطنية، وكتاب مفصّل الخلاف في أصول الدين، ولهذا العلم آلة يعرف بها طريق المجادلة بل طرق المحاجّة بالبرهان الحقيقي، وقد أَوْدعناه كتاب محكّ النظر وكتاب معيار العلم على وجه لا يُلفى مثله للفقهاء والمتكلمين، ولا يثق بحقيقة الحجّة والشّبهة من لم يُحط بهما علما.“[64]
يتبين مما سبق أن علم المنطق عند الغزالي ينزل منزلة آلة يعرف بها صحيح الحجج من فاسدها، وقوّيها من ضعيفها، في العلوم والأخلاق، فبه يمكن سبر غور النفس بحيث تكون القوة العقلية البرهانية قاضية على الحسية والوهمية، وبه أيضا يمكن التمييز بين حجج كل من المتكلمين والفقهاء والفلاسفة وغير ذلك من المذاهب الفكرية، فمن أجل ذلك ألَّف كتبه المنطقية.
- البعد الإلهي للمادة المنطقية
وقد يبدو أن أهم ما يميز منهج الغزالي في مضمون مادته المنطقية هو اعتباره أصل هذا العلم من لدن الله تعالى؛ بحيث أنزله مع ما أنزل من كتبه على رسله وأنبيائه. ولا شك أن غايته في ذلك هي النظر إلى هذا العلم المشتهر في الفكر اليوناني ابتداء نظرة دينية تستطيع أن تلزم علماء الإسلام تعلمه والاشتغال به، فمتى كان مستند المنطق ”هو كتاب الله ذاته الذي هو مصدر كل العلوم الحقة، فقد لزم تاركه ما يلزم تارك سبيل من سبل العلم الشرعي.“[65]
يعترف الغزالي بذلك في كتاب القسطاس المستقيم عندما سأله خصمه من أهل التعليم عن معنى القسطاس المستقيم: ”فقال: وما القسطاس المستقيم؟ قلت: هي الموازين الخمسة التي أنزلها الله تعالى في كتابه وعلم أنبيائه الوزن بها، فمن تعلم من رسل الله تعالى ووزن بميزان الله تعالى فقد اهتدى، ومن عدل عنها إلى الرأي والقياس فقد ضل وتردّى،“[66] وهي كما يقول: ”موازين القرآن في الأصل ثلاثة؛ ميزان التعادل، وميزان التلازم، وميزان التعاند، لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة؛ إلى الأكبر، والأوسط، والأصغر، فيصير المجموع خمسة.“[67]
وترجع هذه الموازين كلها إلى الأقيسة المنطقية المعروفة، فميزان التعادل الأكبر هو القياس الحملي من الشكل الأول، وميزان التعادل الأوسط هو القياس الحملي من الشكل الثاني، وميزان التعادل الأصغر هو القياس الحملي من الشكل الثالث، أما ميزان التلازم فهو القياس الشرطي المتصل، في حين ميزان التعاند هو القياس الشرطي المنفصل.
ولم يكن يلوي على شيء في التّمثيل لها أو بالأحرى التأصيل لهذه الموازين من آيات القرآن الكريم في كتابه القسطاس، الذي يعتبر في واقع الأمر ”أهم كتب الغزالي المنطقية التي بحث فيها عن تأصيل إسلامي للمنطق اليوناني، فالكتاب نموذج قوي لأسلمة المنطق اليوناني، قد ضبطه بصبغة محلية خالصة سواء من حيث الدين أو اللغة،“[68] لكن فقط في الجانب التطبيقي للقياس المنطقي؛ إذ لم يلتفت لغيرها من مباحث المنطق، كما لا يمكن قصر التأصيل الإسلامي على هذا الكتاب وحده بل تَدخل في ذلك أيضا كتُبه المنطقية الأخرى.
- منهج الغزالي في العرض المضموني للمادة المنطقية
في الغالب يتوخى الفيلسوف، الذي يحيط بعلم ما إحاطة واعية بجوانبه المفيدة وبأي شيء يمكن من خلاله تجسير روابط التبادل العلمي، أن يعمل على صياغة مادة نتاجه المعرفي بحيث يكون فيها متفردا بما استطاع إضافته إليها، كالمصطلحات والألفاظ، لا سيما إذا كانت هذه المادة قد عُرفت قبله، فـ”ما من عمل فلسفي إلا وصاحبه يشتغل بوضع بعض التعاريف لمفاهيمه حتى ولو سبق إلى تعريفها، حرصا منه على التدقيق في معانيه،“[69] وحرصا أيضا منه على بيان التفرد والتميز والإبداع والقدرة البشرية على التطوير والتحديث.
كما تساهم قيمة الشخص العلمية وسلطته الدينية في طريقة تلقي التغيير الذي يطال بعض العلوم التي لم يكن لها قبول أو نفوذ في وسط مجتمع المعرفة، بل إن ”المعارف حتى وإن كانت يقينية في ذاتها، إلا أنها تتحدد أساسا بمن يروج لها، بل إن الألفاظ ذاتها تنطوي على مفعول يتجاوزها كألفاظ، ولعل هذا هو ما يفسر إلحاح حجة الإسلام على ترجمة لغة المنطق ونقلها إلى لغة القسطاس المستقيم نظرا للإيحاء الذي لتلك الألفاظ، فقيمة اللفظ ليست في معناه، وإنما في الوقع الذي يُحدثه.“[70]
وعمل حجة الإسلام يتمظهر أساسا في استعمال التمثيل بالمعاني الإسلامية أو قل معانٍ مستقاة من العلوم الإسلامية عند التعبير عن المعاني المنطقية المعروفة. لكن، في هذا السياق، بالإمكان طرح سؤال حول هذا الأمر، وهو كالآتي: ما الأسباب التي جعلت الإمام المنطقي يتبع هذا المنهج في عرضه لمادته المنطقية؟
نستطيع من خلال تضاعيف متن أبي حامد المنطقي خاصة أن نتوصل إلى المبررات التي اقتضت منه الرجوع إلى آلية التمثيل التي تعتبر في التقليد العربي من الوسائط؛ إذ بها ومنها يظهر أيضا منهجه في العرض المضموني لمادته المنطقية، ولعلها ترتد إلى ثلاثة، وهي:
السبب الأول: ميل همم عصره إلى استعمال الأمثلة الفقهية
في مقدمته لكتاب معيار العلم يصرح الغزالي بأن فقهاء عصره كانوا لا يقبلون إلا ما هو فقهي ولا تميل أنفسهم إلا إليه؛ يقول: ”لما كانت الهمم في عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه بل مقصورة عليه، حتى حدانا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها مآخذ الخلاف أولا، ولباب النظر ثانيا، وتحصين المآخذ ثالثا، وكتاب المبادي والغايات رابعا، وهو الغاية القصوى في البحث الجاري على منهاج النظر العقلي في ترتيبه وشروطه، وأن فارقه في مقدماته، رغبنا ذلك أيضا في أن نورد في منهاج الكلام في هذا الكتاب أمثلة فقهية؛ لتشمل فائدته، وتعم سائر الأصناف جدواه وعائدته.“[71]
يجوز أن نعتبر هذا السبب، سببا تاريخيا، يعود إلى زمن عاش فيه الإمام المنطقي، أي القرن الخامس الهجري، فذهنية المشتغلين بالعلوم في ذلك التاريخ مائلة إلى ما هو مرتبط بالعلوم الإسلامية. ولا غبار أن ذلك أيضا ليس خاصا بالفقه وحده، فقد ينصرف إلى الأمثلة الكلامية والحديثية وغيرها، فإذا أورد معنى منطقيا في ثوب هذه العلوم كان ذلك أدعى إلى قبوله ومن ثمة إلى فهمه ونشره من بعد ذلك. لكن الأهم من ذلك والمطوي في الأمر كله هو محاولته تفهيم ”علماء الدين كيفية القيام بتطبيق المنطق الأرسطي في تخصصاتهم الدينية، والظاهر أن الغزالي كان على قناعة بأن كل من يعمل في العلوم الدينية عليه أن يتعلم طرائق الدليل وشرائط البرهان.“[72]
السبب الثاني: ضعف قريحة المتلقي في زمان الغزالي
قد يتصل معنى هذا السبب بشكل ما بمعنى السبب السابق، فهو يرجع إلى ذات الطالب المتوجه إليه خطاب الغزالي، وهنا يتعلق الأمر بضعف فهم وقريحة المتعلم، وفي واقع الأمر، لم يشر إلى هذا في كتبه المنطقية مثل معيار العلم أو محك النظر أو حتى في المقدمة المنطقية للمستصفى، وإنما ذكره في القسطاس المستقيم، ويأتي سياق إشارته إليه حينما تكلم عن ضعف قريحة التعليمي الذي يناظره في هذا الكتاب؛ إذ يقول: ”ولكن بعثني على إبدال كسوتها بأسام أخر غير ما سموها به ما عرفت من ضعف قريحتك، وطاعة نفسك للأوهام، فإني رأيتك من الاغترار بالظواهر بحيث لو سُقيت عسلا أحمر في قارورة حجّام لم تُطق تناوله؛ لنفور طبعك عن المحجمة، وضعف عقلك عن أن يُعرفك أن العسل طاهر في أي زجاجة كانت،“[73] كما نجد نفس هذا المعنى عندما يتكلم عن أهل التعليم بشكل عام في قوله: ”فلما رأيتك ورأيت رفقاءك من أهل التعليم ضعفاء العقول لا يخدعهم إلا الظواهر نزلت إلى حدّك، فسقيتك الدواء في كوز الماء، وسُقتك به إلى الشفاء، وتلطفت بك تلطف الطبيب بمريضه، ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضته في قدح الدواء لكان يشمئز عن قبوله طبعك، ولو قبلته لكنت تتجرعه ولا تكاد تُسيغه، فهذا عذري في إبدال تلك الأسامي وإبداع هذه، يعرفه من يعرفه، وينكره من يجهله.“[74]
السبب الثالث: تغيير المصطلحات الصناعية من أجل التفهيم
أما بخصوص السبب الثالث فهو مرتبط بغاية الإفهام؛ أي التمثيل بأمثلة غير التي يعتاد المناطقة إيرادها لقضاياهم، ولا يخفى أن هذه الأمثلة تكون أمثلة صناعية لهذا العلم، بحيث تشكل لمن لم يعتدها صعوبة في اقتناص معنى البحث الذي أوردت فيه. وأبو حامد هنا كان على دراية بأن الفهم الجيد والإدراك الواعي للعلم الغريب عن الفضاء الثقافي الذي يخاطبه، إنما يكون باستعمال الأمثلة المعروفة لدى طلاب العلم من علوم الإسلام كالفقه والكلام وغيرهما.
والواقع أن الغزالي كثيرا ما يشير في متنه المنطقي إلى هذا الأمر، فقد يصح القول بأنه لا يخلو كتاب من كبته في هذا العلم من هذه الإشارة، غير أنه أورد في كتابه معيار العلم نصا يتكلم فيه عن هذا الشأن بخطاب واضح يقرر منهجه في ذلك؛ إذ يقول: ”ولعل الناظر بالعين العوراء نظر الطعن والإزراءِ، ينكر انحرافنا عن العادات في تفهيم العقليات القطعية، بالأمثلة الفقهية الظنية، فليكف عن غلوائه في طعنه وإزرائه، وليشهد على نفسه بالجهل بصناعة التمثيل وفائدتها؛ فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد، ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم عنده، فيستقر المجهول في نفسه؛ فإن كان الخطاب مع نجار لا يحسن إلا النجر وكيفية استعمال آلاته، وجب على مرشده ألا يضرب له المثل إلا من صناعة النجارة؛ ليكون ذلك أسبق إلى فهمه، وأقرب إلى مناسبة عقله، وكما لا يحسن إرشاد المتعلم إلا بلغته لا يحسن إيصال المعقول إلى فهمه إلا بأمثلة هي أثبت في معرفته.“[75]
ومما ينهض دليلا على شدة إيمانه بهذا المنهج ما نقف عليه في القسطاس المستقيم عندما يوصي بعدم تبديل ما ارتضاه في كتبه من نظام إيراد أمثلته؛ فهو يقول لطلبته وقراء كتبه: ”وإياكم أن تغيروا هذا النظام، وتنتزعوا هذه المعاني من هذه الكسوة؛ فقد علمتكم كيف يُزيّن المعقول بالإسناد إلى المنقول؛ لتكون القلوب فيها أسرع إلى القبول؛“[76] ولأن ”الألفاظ طافحة مباحة، لم يثبت من جهة الشرع وقفها على معنى معين حتى يُمنع من استعمالها على وجه آخر.“[77]
وارتباطا بهذا، فإنه يتطلب الكلام في هذا الشأن أن نسوق بعض المسائل التطبيقية أو بالأحرى أمثلة لما تمت الإشارة إليه، من التي استعمل فيها الغزالي مصطلحات من العلوم الإسلامية صاغ بها المعاني المنطقية من أجل غاية الإيصال الناجع للمعنى المنطقي، وسوف يتم الاقتصار هنا على مثال واحد من كل من علم الكلام وعلم الفقه وعلم الحديث؛ وإلا فإن كتب الغزالي المنطقية طافحة بهذه الأمثلة.
يرى بعض الباحثين بأنه بظهور الغزالي تشكلت رابطة بين المنطق وعلم الكلام؛[78]وذلك بسبب أن المنطق صار معه سبيلا ”إلى إثبات الحقائق العقدية الإسلامية بالأدلة المستوفية لشرائط البرهان،“[79] وأيضا لأن ”معرفة الذات والصفات بالاستدلال عليهما بالآثار والآيات وهي متوقفة على العلم المسمى بالمنطق،“[80] من هنا كان المنطق مرتبطا بعلم الكلام، والغزالي أبرزُ من عُرف عنه ذلك، سواء في ضرب الأمثلة به أو صياغة المعاني الكلامية في الأقيسة المنطقية كما في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد.
يصوغ أبو حامد في النمط الثاني من أنماط صور البرهان، أي الشكل الثاني من القياس، استدلالا يدافع فيه عن وجهة نظر الأشعرية فيما يخص كون الله تعالى ليس بجسم؛ يقول: ”النمط الثاني: أن تكون العلة حكما في المقدمتين مثاله قولنا: البارئ تعالى ليس بجسم، لأن الباري غير مؤلف، وكل جسم مؤلف؛ فالبارئ تعالى إذن ليس بجسم، فهاهنا ثلاثة معان: البارئ، والمؤلف، والجسم، والمكرر هو المؤلف، فهو العلة، وتراه خبرا في المقدمتين وحكما، ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر، فهما متباينان، فالتأليف ثابت للجسم، منتف عن البارئ تعالى، فلا يكون بين معنى الجسم وبين الباري التقاء؛ أي لا يكون الباري جسما، ولا الجسم هو الباري تعالى.“[81]
أما في ما يتعلق بعلم الفقه، فهو يرى كما يقول المستشرق المجري جولدتسيهر (Ignác Goldziher) أن ”منهج البحث في الأمور الفقهية لا يختلف عن منهج البحث في الأمور العقلية،“[82] وإن كان هذا ليس على إطلاقه؛ فالغزالي مثلا لا يعترف بصدقية نتائج الاستقراء الناقص في العقليات ولكنه في الفقهيات يقلبه.[83] وعلى هذا الأساس فإن ”أصالة الغزالي تكمن في قدرته على المساهمة في تطوير بعض المبادئ المنطقية من أجل تطبيقها على بعض المسائل الفقهية،“[84] كما هو الشأن في مستصفاه وأماكن من كتبه المنطقية.
ونستطيع أن نسوق مثالا على سكب الأمثلة الفقهية في المعاني المنطقية، وذلك مثلما فعل عندما أراد إيراد مثال فقهي للقياس الحملي؛ إذ يقول: ”ومثاله من الفقه: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، فكل مسكر حرام، فالمسكر، والخمر، والحرام: حدود القياس، والخمر: هو الحد الأوسط، والمسكر: هو الحد الأصغر، والحرام: هو الحد الأكبر، وقولنا: كل مسكر خمر؛ هي المقدمة الصغرى، وقولنا: كل خمر حرام؛ هي المقدمة الكبرى،“[85] فلم يقتصر على صياغة استدلال قياسي من الشكل الأول من أشكال القياس، بل بيّن أيضا بمصطلحات الفقه الحد الأوسط، والحد الأصغر، والحد الأكبر، والمقدمة الصغرى والكبرى، وإن كان لم يذكر النتيجة لبيانها عند عرض المثال الفقهي.
وبخصوص علم الحديث وصياغة المعنى المنطقي به، فبالوسع القول بأن هذا العلم قلما يرجع إليه الغزالي للتمثيل به، وقد يكون ذكر فقط مثالا واحدا منه في كتبه المنطقية، كما في محك النظر الذي نقتنص منه هذا المثال، حيث ذكره في الفصل الخاص بمراتب الإدراك، الذي تناول فيه موضوع اليقين، فقسمه إلى ثلاث أحوال؛ الأول: اليقين والقطع، والثاني: التصديق تصديقا جازما، والثالث الذي ذكر فيه المثال الحديثي: ”أن يكون له سكون نفس إلى الشيء والتصديق به وهو يشعر بنقيضه، أو لا يشعر ولكنه إن أشعر به لم ينفر طبعه عن قبوله، وهذا يسمى ظنا، وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى،“[86] ومن أجل التمثيل لهذه القاعدة قال: ”فمن سمع من عدل شيئا سكنت إليه نفسه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون وقوي الظن، فإن انضاف إليه ثالث زادت القوة، فإن انضافت إليه تجربة بصدقهم على الخصوص زادت القوة، فإن انضافت إليه قرينة حال؛ كما إذا أخبروا عن أمر مخُوف وهو على صورة مذعورين صُفر الوجوه مضطربي الأحوال زاد الظن، وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلا في القوة إلى أن ينقلب الظن على التدريج يقينا إذا انتهى الخبر إلى الحد التواتر، والمحدثون يسمون هذه الأحوال علما يقينيا، حتى يطلقون بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل.“[87]
إن نهج الغزالي إذن ينحو منحى الربط الوظيفي بين علم المنطق الأرسطي والعلوم الإسلامية، ففي كتبه المنطقية خاصة المعيار ”يركز أكثر على مناقشة نظريات المنطق وطرائقه في المنظور الإسلامي، ويعرض الأمثلة التطبيقية لكل طريقة منطقية من مجالات العلوم الإسلامية مثل الفقه وعلم الكلام. وهذا النوع من المقاربة جعل نظريات المنطق وطرائقه مكتسبة لعناصر وقيم إسلامية“[88] واضحة جدا في كتبه.
خاتمة
نخلص في نهاية هذه الورقة إلى ثلاث نتائج مهمة؛ أولاها أن الغزالي وإن استأنف القول المنطقي الأرسطي على طريقة الفارابي وابن سينا، فقد انفرد بطريقة خاصة في كتبه المنطقية، بل في كبته الفقهية والصوفية، ألا وهي الترتيب والتبويب المنهجي لأبحاثه المنطقية، والضبط والإحكام في طريقة عرضه لها؛ إذ تقوم على منطق واضح القسمات، في تنظيم فصول وأبواب كتبه فضلا عن الفقرات والجمل، في نظام متسق متراص، ذلك أنه أولى عناية بالغة لبناء كتبه، وكثيرا ما يشير في مقدماته لها إلى ذلك، فالأهمية الكبرى في أغلب مقدمات مؤلفاته تتجه نحو التعبير عن منهج العرض من جهة الترتيب والدقة، فضلا عن دقة الأسلوب وجودة العبارة.
وتتحدد الثانية في اختياره للشكل المنهجي لكتبه المنطقية، فإنه قبل الانصراف إلى تأليفها، كان قد اطلع عل ما ألف قبله كأورغانون أرسطو ومؤلفات الفارابي وابن سينا، وذلك خوّل له، بعد دراستها وفهمها، أن يخط لنفسه منهجا آخر في منهج التأليف في علم المنطق، فإذا كان منهج التأليف الأرسطي في هذا العلم مبنيا على كتب وأجزاء، أو بالأحرى وحدات متفرقة؛ فالغزالي اقتصر على ما يراه مفيدا لرؤيته الغائية للمنطق، فلم يضع بناء وترتيب كتبه على المناهج التأليفية التي تقدمته، بل اهتم أكثر باختصارها وجمعها، أو قل جمع ما يراه جديرا وخادما لرؤيته ولمشروعه الفكري في كتاب واحد، تنطلق أبحاثه وتتشعب من التصور والتصديق.
وتتصل النتيجة الثالثة بالإبداع الذي يتميز به الجانب المضموني من كتبه، فالمادة المعرفية عند الغزالي في القواعد والأسس هي أرسطية بالأساس، ولكن إبداعه يكمن في التمثيل والتطبيق، أعني في قدرته على صياغة المادة المنطقية بمصطلحات شرعية من علم الفقه والكلام والحديث وغير ذلك، وفي تطبيق الآليات المنطقية على المعاني الشرعية، أي ربط الاستنتاج والتوصل إلى التعاريف الشرعية والأحكام بقواعد المنطق. دون أن ننسى أن هذا العلم ترجع أصوله في نظره إلى الدين؛ أي أنه أنزل مع ما أنزل الله تعالى من كتبه على أنبيائه.
Bibliography
Āl Yāsīn, Jaʿfar. Al-Manṭiq al-sinawy: ʿarḍ wa-dirāsat lil-nadarīyah al-manṭiqīyah ʿinda Ibn Sīnā. Beirut: Dār wa-Maktabat al-Baṣāʿir lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2012.
Al-Aḥmad Al-Nikrī, ʿAbd al-nabī ibn ʿAbd al-Rasūl. Dustūr al-ʿulamāʼ fī Jāmiʿ al-ʿUlūm fī iṣṭilāḥāt al-Funūn. Tarjamat: Ḥassan Hānī Faḥṣin, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2000.
Al-ʿAjam, Rafīq. Al-Manṭiq ʿinda Al-Ghazālī fī abʿādih Al-arisṭawiyah wa khuṣuṣiyātih al-Islāmīyah. Beirut: Dār al-Mashriq, 1989.
___ . “Taqdīm.” In Abū Naṣr al-Fārābī, al-Manṭiq ʿinda al-Fārābī. Edited by Rafīq Al- ʿAjam. Beirut: Dār al-Mashriq, 1985.
Al- ʿArwī, ʿAbd Allāh. Mafhūm al-ʿaql, Casablanca-Beirut: Al-Markaz al-Thaqāfī al- ʿArabī, 2012.
Al-Fārābī, Abū Naṣr. Iḥṣāʿ al- ʿUlūm. Edited by ʿUthmān Amīn. Cairo: Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah, 1968.
___ . Isāghūjī. In al-manṭiq ʿinda al-Fārābī. Edited by Rafīq Al-ʿAjam. Beirut: Dār al-Mashriq, 1985.
El-Farrāk, Aḥmad. Alīyāt al-Taqrīb al-tadāwly wa-Tashghīl al-manṭiq ʿinda Al-Ghazālī. Amman: ʿĀlam al-Kutub al-ḥadīth lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2018.
Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Al-Qisṭās al-mustaqīm fī Taqwīm ahl al-Taʿlīm. Edited by Al-Lajnah al-ʿilmīyah bi-Markaz Dār al-Minhāj lil-Dirāsāt wa-al-taḥqīq al-ʿilmī. Beirut: Dār al-Minhāj, 2019.
___ . Al-Mustaṣfá min ʿilm al-uṣūl. Edited by Muḥammad Sulaymān al-Ashqar. Beirut: Muʿassasat al-Risālah, 2015.
___ . Al-munqidh min al-ḍalāl wā-lmofṣiḥ bi-al-aḥwāl. Edited by Muṣṭafá Bījū. Istanbul: Dār al-Rawḍah lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2015.
___ . Tahāfut al-falāsifah. Edited by Ṣalāḥ al-Dīn al-Hawwārī. Beirut: Al-Maktabah al-ʿAṣrīyah, 2018.
___ . Jawāhir al-Qurʿān wa-doraroh. Edited by Khadījah Muḥammad Kāmil. Cairo, Dār al-Kutub wa-al-Wathāʿiq al-Qawmīyah, 2019.
___ . Miḥakk al-nadar. Edited by al-Lajnah al-ʿilmīyah bi-Markaz Dār al-Minhāj lil-Dirāsāt wa-al-taḥqīq al-ʿilmī. Beirut: Dār al-Minhāj lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2016.
___ . Miʿyār al-ʿilm fī Fann al-manṭiq. Edited by Al-Lajnah al-ʿIlmīyah bi-Markaz Dār al-Minhāj lil-Dirāsāt wa-al-taḥqīq al-ʿilmī. Beirut: Dār al-Minhāj lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2019.
___ . Maqāṣid al-falāsifah. Edited by ʿUqbaah Zaydān. Damascus: Dār al-Qabas, 2019.
Al-Jābirī, Muḥammad ʿĀbid. Ibn Rushd: sīrat wa-fikr. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʿArabīyah, 2017.
Al-Nashshār, ʿAlī Sāmī. Manāhij al-Baḥth ʿinda mufakkirī al-Islām. Cairo: Dār al-Salām lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2012.
Al-Subkī, Tāj al-Dīn. Ṭabaqāt al-Shāfiʿīyah al-Kubrá. Edited by Muṣṭafá ʿAbd Al-Qādir Aḥmad ʿAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1999.
Al-Ṣūrī, Phurphuriyūs. Isāghūjī. Edited by Aḥmad Fuʿād Al-Ahwānī. Cairo: Dār Āfāq lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2021.
Al-Urmī al-ʿAlawī al-Athyūbī, Muḥammad al-Amīn ibn ʿAbd Allāh. Al-Kawkab al-Mashriq fī Samāʼ ʿilm al-manṭiq ʿalá al-sulam al-monawriq. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2015.
Arisṭū. Manṭiq Arisṭū. Edited by ʿAbd al-Raḥmān Badawī. Beirut: Dār al-Qalam, 1980.
Bin-ʿAbd al-ʿĀlī, ʿAbd Al-Salām. “Siyāsat al-Maʿrifah fī al-munqidh min al-ḍalāl lil-Ghazzālī.” In Aʿmāl Nadwat: Abū Ḥāmid al-Ghazālī: Dirāsāt fī fikrihi wa-ʿaṣruho wa-taʼtīruhu. Rabat: Manshūrāt Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʿUlūm al-Insānīyah, 1988.
Blānshī, Rūbīr. Al-manṭiq wa-tārīkhuhu min Arisṭū ḥattá Rāsil, Tarjamat: Khalīl Aḥmad Khalīl. Beirut: Al-Muʼassasah al-Jāmiʿīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1980.
Goldziher, Ignác. “Mawqif ahl al-Sunnah al-qudamāʼ biʼizāʼ ʿulūm al-Awāʿil.” In al Turāth al-Yūnānī fī al-Ḥaḍārah al-Islāmīyah: Dirāsāt li-kibār al-mustashriqīn Translated by ʿAbd al-Raḥmān Badawī. Cairo: Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah, 1940.
Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad. Rasāʼil Ibn Ḥazm, Risālat al-Taqrīb Lihad al-manṭiq wā-lmdkhal ilayhi bālʼalfād al-ʿāmmīyah wa-al-amthilah al-fiqhīyah. Edited by Iḥsān ʿAbbās. Beirut: Al-Muʼassasah al-ʿArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr, 2007.
Ibn Khaldūn,ʿAbd al-Raḥmān. Al-muqaddimah. Edited by ʿAlī ʿAbd al-Wāḥid Wāfī. Cairo: Dār Nahḍat Miṣr lil-Nashr, Al-Qāhirah, 2014.
Ibn Rushd, Abū al-Walīd. Sharḥ al-burhān li-Arisṭū. Edited by Khamīs Ḥasan. Cairo: Dār Āfāq lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2020.
Ibn Sīnā, Abū ʿAlī. Al-ishārāt wa-al-tanbīhāt maʿa sharḥ Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūsī. Edited by Sulaymān Dunyā, Cairo: Dār al-Maʿārif, n. d.
___ . Al-Shifāʼ: Al-Manṭiq: Al-Madkhal. Edited by al-Ab Qanawātī wa-Maḥmūd Muḥammad al-Khuḍayrī wa-Fuʼād al-Ahwānī. Cairo: al-Maṭbaʿah al-Amīrīyah, 1952.
___ . Al-Najāh fī al-Ḥikmah al-manṭiqīyah wa-al-ṭabīʿīyah wa-al-ilāhīyah, Cairo: Dār Āfāq lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2020.
Imām, ʿAlī ʿUbayd. Atar al-manṭiq al-Arisṭī ʿalá al-ilāhīyāt ʿinda al-Muslimīn fī raʼy al-Imām Ibn Taymīyah. Cairo: al-Dār al-islāmīyah lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr, 2009.
Inayāt, ʿAbd al-Karīm. Aslamat al-manṭiq: al-Ūrghānūn al-Arisṭī bayna yaday al-Ghazālī. Rabat: Dār al-Amān, 2013.
Iqbāl, Muḥammad. Tajdīd al-tafkīr al-dīnī fī al-Islām. Translated into Arabic by ʿAbbās Maḥmūd. Beirut: Manshūrāt al-Jamal, 2015.
Laʿmūl, ʿAbd al-ʿAzīz. Mabḥath al-Maqūlāt fī Falsafat Ibn Rushd. Beirut: Dār al-Fārābī, 2016.
Mākūflsky, Aliksandar. Tārīkh ʿilm al-manṭiq. Translated by Ibrāhīm Fatḥī. Beirut: Dār al-Fārābī, 1987.
Muḥammad, Maḥmūd Muḥammad ʿAlī. Al-ʿAlāqah bayna al-manṭiq wa-al-fiqh ʿinda mufakkirī al-Islām. Cairo: Dār ʿAyn lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-insānīyah wa-al-ijtimāʿīyah, 2000.
Nabhān, Kamāl ʿIrfān. ʻAbqarīyat al-Taʼlīf al-ʿArabī: ʿAlāqāt al-nuṣūṣ wa-al-ittiṣāl al-ʿiIlmī, Kuwayt: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-islāmīyah, 2015.
Pachniak, Katarzyna. “Ibn Sīnā face à Al-Ghazālī (1058-1111). La défense philosophique de la théologie musulmane.” Noesis 32 (2018) : 1–13. Link:Https://journals. openedition.org/noesis/5009 [20/02/2024]
Patimah. Zarkasyi, Hamid fahmy. kayadibi, Saim. “Examining Discourses on Integration of Philosophy and Religion” (Analysis from Al-Ghazali to Al-Attas). Tasfiyah: Journal pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2022): 165–194.
Rudolph, Ulrich. “Al-Ghazali on Philosophy and Jurisprudence.” In Philosophy and Jurisprudence in the Islamic World, edited by Peter Adamson, 67–91. Berlin: De Gruyter, 2009.
Rīshr, Nīqūlā. Taṭawwur al-manṭiq al-ʿArabī. Translated into Arabic by Muḥammad Mahrān. Cairo: Dār al-Maʿārif, 1985.
Ṭāhā, ʿAbd al-Raḥmān. Tajdīd al-manhaj fī Taqwīm al-Turāth. Casablanca-Beirut: Al-Markaz al-Thaqāfī al-ʿArabī, 2016.
Twopek, Yaman and Kamarudin Salleh. “The Objectives and References of Miʿyar al-ʿilm fi Fann al-Mantiq.” International Journal of Islamic Thought. Volume 9 (2016): 72–86.
للتوثيق
روي، محمد. ”منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/4193>
محمد روي
[1] تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999)، ج. 4: 418.
[2] محمد عابد الجابري، ابن رشد: سيرة وفكر، ط. 6 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017)، 173.
[3] علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ط. 2 (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2012)، 21.
[4] انظر: أحمد الفراك، آليات التقريب التداولي وتشغيل المنطق عند الغزالي (عمان: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 2018).
[5] انظر: عبد الكريم عنيات، أسلمة المنطق: الأورغانون الأرسطي بين يدي الغزالي (الرباط: دار الأمان، 2013).
[6] Yaman Twopek and Kamarudin Salleh. “The Objectives and References of Mi‘yar al-‘ilm fi Fann al-Mantiq, ” International Journal of Islamic Thought, Bangladesh, vol. 9, (2016), 72–86.
[7] عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، ط. 7 (القاهرة: دار نهضة مصر للنشر، 2014)، ج. 3: 1022.
[8] روبير بلانشي، المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1980)، 37.
[9] انظر: ألكسندر ماكوفلسكي، تاريخ علم المنطق، ترجمة: إبراهيم فتحي، ط. 1 (بيروت: دار الفارابي، 1987)، 94–95.
[10] انظر: جعفر آل ياسين، المنطق السينوي: عرض ودراسة للنظرية المنطقية عند ابن سينا (بيروت: دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع، 2012)، 24.
[11] إبراهيم مدكور، من تقديمه لـ: أبو علي ابن سينا، الشفاء، المدخل، تحقيق الأب قنواني ومحمود الخضيري وفؤاد الأهواني (القاهرة: المطبعة الأميرية، 1952)، ج. 1: 44.
[12] يقول ابن خلدون: ”إن حكماء اليونانيين بعد أن تهذبت الصناعة ورتبت، رأوا أنه لابد من الكلام في الكليات الخمس المفيدة للتصور المطابق للماهيات في الخارج، أو لأجزائها أو عوارضها وهي الجنس والفصل والنوع والخاص والعرض العام، فاستدركوا فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعا وترجمت كلها في الملة الإسلامية. وكتبها وتداولها فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته وهي الكلام في الحدود والرسوم نقلوها من كتاب البرهان. وحذفوا كتاب المقولات لأن نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالذات. وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس. وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمين لكنه من توابع الكلام في القضايا ببعض الوجوه، ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادة وحدقوا النظر فيه بحسب المادة وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. وربما يلم بعضهم باليسير منها إلماما وأغفلوها كأن لم تكن هي المهم المعتمد في الفن. ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلاما مستبحرا ونظروا فيه من حيث إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك الإمام فخر الدين بن الخطيب ومن بعده أفضل الدين الخونجي وعلى كتبه معتمد المشارقة لهذا العهد.“ عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ج. 3: 1024–1023
[13] أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، ط. 3 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1968)، 79.
[14] انظر: ماجد فخري، من تقديمه لـ: أبو نصر الفارابي، كتاب البرهان، ضمن: المنطق عند الفارابي، تحقيق ماجد فخري، (بيروت: دار المشرق، 1987م)، ج. 2: 9؛ رفيق العجم، من تقديمه لـ: أبو نصر الفارابي، المنطق عند الفارابي، تحقيق رفيق العجم، (بيروت: دار المشرق، 1985)، ج. 1: 42.
[15] أبو علي ابن سينا. الشفاء، المدخل، ج. 1: 10–11.
[16] أبو محمد ابن حزم، رسالة التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهي، ضمن رسائل ابن حزم، تحقيق إحسان عباس، ط. 2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2007)، ج. 4: 98.
[17] علي إمام عبيد، أثر المنطق الأرسطي على الإلهيات عند المسلمين في رأي الإمام ابن تيمية (القاهرة: الدار الإسلامية للطباعة والنشر، 2009)، 18.
[18] أبو علي ابن سينا، النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية (القاهرة: دار آفاق للنشر والتوزيع، 2020)، 17.
[19] أبو علي ابن سينا، الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق سليمان دنيا، ط. 3 (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، ج. 1: 138.
[20] محمد الأمين بين عبد الله الأرمي العلوي الأثيوبي، الكوكب المشرق في سماء علم المنطق على السلم المنورق (جدة: دار المنهاج، 2015)، 160–161.
[21] الفارابي، كتاب البرهان، ضمن: المنطق عند الفارابي، ج. 4: 19–20.
[22] أبو الوليد ابن رشد، شرح البرهان لأرسطو، تحقيق خميس حسن (القاهرة: دار آفاق للنشر والتوزيع، 2020)، 28.
[23] تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج. 4: 444.
[24] Katarzyna Pachniak,“ Ibn Sīnā face à Al-Ghazālī (1058-1111). La défense philosophique de la théologie musulmane, ”Centre de recherche d’histoire des idées, Nice (2018), 3.
[25] Patimah and Hamid Fahmy Zarkasyi and Saim Kayadibi,“ Examining Discourses on Integration of Philosophy and Religion,” (Analysis from Al-Ghazali to Al-Attas), Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 6, No. 2, (Agustus 2022), hlm: 174.
[26] نيقولا ريشر، تطور المنطق العربي، ترجمة: محمد مهران1 (القاهرة: دار المعارف، 1985)، ج. 1: 178.
[27] انظر: عبد الله العروي، مفهوم العقل، ط. 5 (الدار البيضاء-بيروت: المركز الثقافي العربي، 2012)، 152.
[28] رفيق العجم، المنطق عند الغزالي في أبعاده الأرسطوية وخصوصياته الإسلامية (بيروت: دار المشرق، 1989)، 66.
[29] أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق صلاح الدين الهواري (بيروت: المكتبة العصرية، 2018)، 45.
[30] أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال، تحقيق مصطفى بيجو (إستانبول: دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، 2015)، 50.
[31] أبو حامد الغزالي، مقاصد الفلاسفة، تحقيق عقبة زيدان (دمشق: دار القبس، 2019)، 75.
[32] الغزالي، مقاصد الفلاسفة، 78.
[33] أبو حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي (بيروت: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2019)، 68.
[34] أبو حامد الغزالي، محك النظر، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي (بيروت: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2016)، 55.
[35] أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2015)، ج. 1: 47.
[36] الغزالي، المستصفى، ج. 1: 48.
[37] الغزالي، معيار العلم، 66–67.
[38] محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود (بيروت: منشورات الجمل، 2015)، 177.
[39] الغزالي، المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال، 49.
[40] الغزالي، تهافت الفلاسفة، 50.
[41] الغزالي، مقاصد الفلاسفة، 80–81.
[42] انظر: فرفوريوس الصوري، إيساغوجي، تحقيق أحمد فؤاد الأهواني، ط. 1(القاهرة: دار آفاق للنشر والتوزيع، 2021).
[43] انظر: الفارابي، إيساغوجي، ج. 1: 75–87.
[44] انظر: ابن سينا، الشفاء، المدخل، ج. 1: 9.
[45] يبدو أنه من المناسب هنا الإشارة إلى أن بعض الباحثين في الدراسات المنطقية ينفون تفصيل الغزالي في كتبه الكلام عن المقولات، كما هو الشأن عند عبد العزيز لعمول في دراسته المقولات في فلسفة ابن رشد الذي يقول: ”فضلا عن الغزالي الذي أشار إليها إشارة يتيمة في كتابه معيار العلم دون محك النظر، والقسطاس المستقيم، ومقدمة المستصفى من علم الأصول.“ عبد العزيز لعمول، مبحث المقولات في فلسفة ابن رشد، ط. 1 (بيروت: دار الفارابي، 2016)، 11. والإشارة اليتيمة التي قصدها وأشار إليها لعمول في الحاشية هي قول الغزالي: ”والأجناس العالية التي هي أعلى الأجناس، زعم المنطقيون أنها عشرة، واحد جوهر، وتسعة أعراض، وهي: الكم، والكيف، والمضاف، والأين، ومتى، والوضع، وله، وأن يفعل، وأن ينفعل.“ الغزالي، معيار العلم، 127. وقد غاب عنه أو أنه لم يطلع جيدا على كل ما احتواه كتاب معيار العلم سوى على بعض المواضع كالإشارة اليتيمة التي نقلها عنه، والحق أن الغزالي قد أفرد للمقولات كتابا خاصا من أقسام كتابه المعيار؛ ذلك أنه قسّم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام: الأول: كتاب مقدمات القياس، والثاني: كتاب القياس، والثالث: كتاب الحد، والرابع: كتاب أقسام الوجود وأحكامه، والكتاب الرابع هو عن المقولات، ولكن الغزالي لم يسميها باسمها المعتاد، وارتأى أن يطلق عليها أقسام الوجود، وقد يكون هذا العنوان هو الذي ضلّل عبد العزيز لعمول حتى نفى تفصيل الغزالي في المقولات.
[46] الغزالي، معيار العلم، 237.
[47] الغزالي، معيار العلم، 332.
[48] الغزالي، معيار العلم، 241–247.
[49] الغزالي، معيار العلم، 237.
[50] انظر: الغزالي، معيار العلم، 320.
[51] الغزالي، معيار العلم، 354.
[52] انظر: أرسطو. منطق أرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي (بيروت: دار القلم، 1980)، ج. 3: 726 وما بعدها.
[53] الغزالي، معيار العلم، 238.
[54] انظر: الغزالي، معيار العلم، 269 وما بعدها.
[55] الغزالي، معيار العلم، 366.
[56] الغزالي، معيار العلم، 238.
[57] الغزالي، معيار العلم، 238.
[58] الغزالي، محك النظر، 52.
[59] الغزالي، معيار العلم، 479.
[60] كمال عرفان نبهان، عبقرية التأليف العربي: علاقات النصوص والاتصال العلمي (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2015)، 203.
[61] الغزالي، معيار العلم، 53–55. وعن السبب الأول يقول في محك النظر: ”[…] تحرير محك النظر والافتكار؛ ليعصمك عن مكامن الغلط في مضايق الاعتبار“. الغزالي، محك النظر، 49. وعن السبب الثاني يقول في مقدمة مقاصد الفلاسفة: ”فرأيت أن أقدم على بيان تهافتهم كلاما وجيزا مشتملا على حكاية مقاصدهم من علومهم المنطقية والطبيعية والإلهية من غير تمييز بين الحق والباطل، بل لا أقصد إلا تفهيم غاية كلامهم من غير تطويل بذكر ما يجري مجرى الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد، وأورده على سبيل الاقتناص والحكاية مقرونا بما اعتقدوه أدلة لهم، ومقصود الكتاب حكاية مقاصد الفلاسفة وهو اسمه.“ الغزالي، مقاصد الفلاسفة، 73.
[62] الغزالي، معيار العلم، 57–58.
[63] الغزالي، محك النظر، 127.
[64] أبو حامد الغزالي، جواهر القرآن ودرره، تحقيق خديجة محمد كامل (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2019)، 81.
[65] عبد الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ط. 5 (الدار البيضاء(بيروت: المركز الثقافي العربي، 2016)، 349.
[66] أبو حامد الغزالي، القسطاس المستقيم في تقويم أهل التعليم، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي (بيروت: دار المنهاج، 2019)، 47.
[67] الغزالي، القسطاس المستقيم، 54.
[68] عبد الكريم عنيات، أسلمة المنطق: الأورغانون الأرسطي بين يدي الغزالي، 48.
[69] عبد الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، 157.
[70] عبد السلام بنعبد العالي، ”سياسة المعرفة في المنقذ من الضلال للغزالي،“ ضمن أعمال ندوة: أبو حامد الغزالي: دراسات في فكره وعصره وتأثيره، (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1988)، 293.
[71] الغزالي، معيار العلم، 55–56.
[72] Ulrich Rudolph, “Al-Ghazālī on Philosophy and Jurisprudence, ”in Philosophy and Jurisprudence in the Islamic World, ed. Peter Adamson (Berlin: De Gruyter 2019), 74.
[73] الغزالي، القسطاس المستقيم، 94–95.
[74] الغزالي، القسطاس المستقيم، 96.
[75] الغزالي، معيار العلم، 56–57.
[76] الغزالي، القسطاس المستقيم، 157–158.
[77] الغزالي، محك النظر، 219.
[78] انظر: نيقولاريشر، تطور المنطق العربي، ج.1، 179–180.
[79] عبد الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، 322.
[80] عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد الأنكري، دستور العلماء في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عرّب عبارته الفارسية: حسن هاني فحصن، ط. 1(بيروت: دار الكتب العلمية، 2000)، ج. 3: 233.
[81] الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج. 1: 42–88.
[82] لاجنتس جولدتسهير، ”موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل،“ ضمن: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية: دراسات لكبار المستشرقين، ترجمة عبد الرحمن بدوي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1940)، 155.
[83] انظر: الغزالي، معيار العلم، 226–227.
[84] محمود محمد علي محمد، العلاقة بين المنطق والفقه عند مفكري الإسلام، ط. 1 (القاهرة: دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2000)، 11.
[85] الغزالي، معيار العلم، 171.
[86] الغزالي، محك النظر، 113–114.
[87] الغزالي، محك النظر، 114.
[88] Yaman Twopek and Kamarudin Salleh, “The Objectives and References of Mi‘yar al-‘Ilm,” 73.
مقالات ذات صلة
الخطاب المعياري عند الماوردي (ت. 450هـ/1058م) بين الفقه والفلسفة والأدب: من التأطير القانوني إلى قراءة نسقية وتاريخية
Al-Māwardī’s (d. 450/1058) Normative Discourse between Islamic Jurisprudence, Philosophy, and Adab: From a Legalistic Framing to a Systematic and Historical-Contextual Reading al-khiṭāb al-miʿyārī ʿinda al-Māwardī (d. 450/1058) bayna al-fiqh wa-l-falsafa wa-l-adab:...
نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“
Toward Terminological Unity in the Translation of The New Rhetoric Naḥwa al-waḥda al-iṣṭilāḥiyya fī tarjamat al-Mufaṣṣal fī al-ḥijāj نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“ محمد قنديلجامعة ابن طفيل، القنيطرة Mohammed Kandil Ibn Tofail University, Kénitra...
آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/922م) في النفس الإنسانية
Ārāʾ al-faylasūf Abī al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381 H/992 M) fī al-nafs al-insānīyah Abū al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381/992) on The Human Soul: A Philosophical Inquiry آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/ 922م) في النفس الإنسانية[1] بلال مدريرالأكاديمية الجهوية للتربية...
النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)
The Second Maghribi Logical Revival: Muḥammad al-Sharīf al-Tilmisānī (710–771/1310–1370) al-Nahḍa al-Manṭiqiyya al-Maghribiyya al-Thāniya:Muḥammad al-Sharīf al-Tilimsānī (710–771/1310–1370) النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)...
الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي: موقع كوكبي الزهرة وعطارد نموذجًا
The Reformist Contribution of Jābir ibn Aflaḥ al-Ishbīlī to Astronomy: Venus and Mercury as a Case Study al-Ishām al-iṣlāḥī fī al-falak li-Jābir b. Aflaḥ al-Ishbīlī: Mawqiʿ kawkabay al-Zuhra wa-ʿUṭārid namūdhajan الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي:موقع...
مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم
The Concept of Paradigm in Ibn al-Haytham's Astronomy Mafhūm al-Parādīghm min khilāl falak Ibn al-Ḥaytham مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم فتاح مكاويFatah Mekkaoui جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاسSidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez الملخص: يعتبر...
في مشروعية الكلام السني ضدا على إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت.505هـ/1111م): قطعة من موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي (ت.520هـ/1126م)، تعريفٌ وتوصيف
On the Legitimacy of Sunni Theology against Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (d. 505/1111): A Section from Abū Bakr al-Ṭurṭūshī’s al-Asrār wa-l-ʿIbar (d. 520/1126) - Introduction and Description Fī Mashrūʿiyyat al-Kalām al-Sunnī Ḍiddan ʿalā Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn...
المنطق في الحضارة الإسلاميّة
المنطق في الحضارة الإسلاميّة خالد الرويهبKhaled El-Rouayheb جامعة هارفارد-كمبريدجHarvard University-Cambridge ملخص: ”المنطق في الحضارة الإسلامية“ لخالد الرويهب (جامعة هارفارد بكمبريدج) هي في الأصل محاضرة بالعربية ألقيت في مؤسسة البحث في الفلسفة العلوم في...
مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي: بواكير منظور جديد
Navigating Ambiguity: Exploring the Role of Uncertainty in the Classical Arab-Islamic Culture Makānat Al-Iltibās fī al-Thaqāfah al- ʿArabiyya al-Islāmiya Fī ʿAṣrihā al-Klāsīkī:Bawākīr Manẓūr Jadīd مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي بواكير...
أثر فلسفة ابن رشد في الكلام الأشعري المغربي: دراسة في المنجز حول فكر أبي الحجاج يوسف المكلاتي (ت.626هـ/1229م)
The Impact of Ibn Rushd's (Averroes’) Philosophy on Maghribi Ashʿarī KalāmCurrent State of Studies on al-Miklātī (d.626/1229) Athar Falsafat Ibn Rushd fī al-Kalām al-Ashʿarī al-Maghribī: Dirāsa fī al-Munajaz ḥawl Fikr Abī al-Hajjāj Yusuf al-Miklatī (626/1229) Majda...