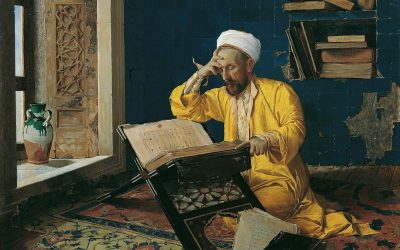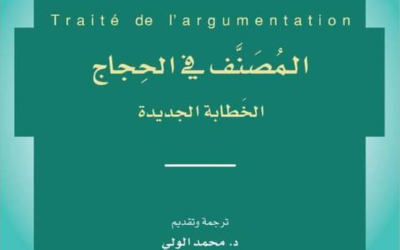![]()
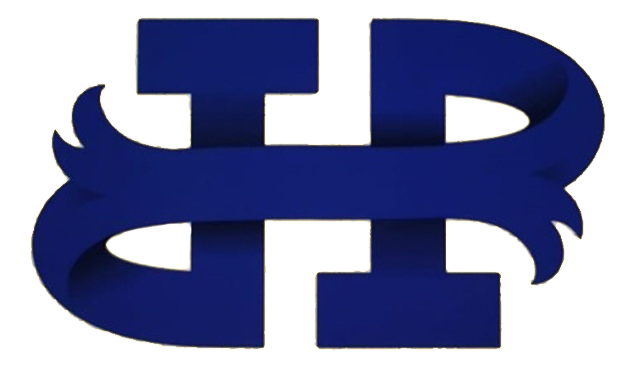
في مشروعية الكلام السني ضدا على إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت.505هـ/1111م): قطعة من موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي (ت.520هـ/1126م)، تعريفٌ وتوصيف

On the Legitimacy of Sunni Theology against Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (d. 505/1111): A Section from Abū Bakr al-Ṭurṭūshī’s al-Asrār wa-l-ʿIbar (d. 520/1126) – Introduction and Description
Fī Mashrūʿiyyat al-Kalām al-Sunnī Ḍiddan ʿalā Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn li-Abī Ḥāmid al-Ghazālī (505/1111): Qiṭʿa min Mawsūʿat al-Asrār wa-l-ʿIbar li-Abī Bakr al-Ṭurṭūshī (520 /1126) – Taʿrīf wa-Tawṣīf
في مشروعية الكلام السني ضدا على إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت.505هـ/1111م)
قطعة من موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي (ت.520هــ/1126م)
تعريفٌ وتوصيف
إبراهيم بوحولين
Ibrahim Bouhaouliane
جامعة محمد الأول، وجدة
Mohammed I University
ملخص: يحاول هذا المقال أن يعرف بقطعة من موسوعة كبيرة سطرها أبو بكر الطرطوشي (ت.520هــ/1126م)، سماها كتاب الأسرار والعبر في علم التزكية والتقوى، كما بين ذلك في تقدمة الموسوعة، هذه القطعة هي كل ما وصلنا منها، وقد احتفظت بها خزانة القصر الملكي، بمراكش تحت رقم: 404، في 178 لوحة.
ضمّت هذه القطعة كتابين، من أصل مئة كتاب المكونة لمجموع الموسوعة، هما كتابَي العقل والعلم، وفي هذين الكتابين ناقش الطرطوشي قضايا كثيرة يرجع أغلبها إلى مشروعية النظر الكلامي السني. حيث سعى فيها إلى الدفاع عن مشروعية النظر انطلاقا من النصوص المؤسسة للمعرفة الإسلامية، ومن ثم مشروعية الاشتغال بالكلام السني في صيغته الأشعرية، وفي ذات السياق فقد عرض صاحب موسوعة الأسرار جملةً من الأقوال التي نسبها أبو حامد الغزالي(ت.505هـ/1111م) في إحياء علوم الدين إلى السلف في ذم علم الكلام والاشتغال به، وقام بفحصها ونقدها من جهة الرواية وصحة سندها، ومن جهة معناها، ليبين من خلال ذلك أنها لا تقف حاجزا دون القول بمشروعية، بل وبندب الاشتغال بهذا العلم الشريف.
ومن ثم فإننا ذهبنا في هذا المقال إلى اعتبار هذا الهم هو الذي حرك الطرطوشي إلى كتابة الأسرار والعبر ضد إحياء علوم الدين، وإلى أنَّ نقد الغزالي للكلام و الفقه الفرعي هو السبب المباشر وراء الإقدام على تأليف الأسرار والعبر، وليس قلة المؤلفات في علم التزكية والتوبة.
وإلى ذلك فقد حاول هذا المقال أن يُقرب محتوى ومضمون هذه الموسوعة انطلاقا من الفهرس العام الذي رسمه الطرطوشي في مقدمة الكتاب، والذي احتفظت به القطعة الموجودة منه، والذي أعلن فيه أبو بكر عن مئة عنوان، غطَّت مختلِف الفنون المنتمية إلى العقيدة والشريعة والأخلاق.
الكلمات المفاتيح: الأسرار والعبر، الطرطوشي، الإحياء، الغزالي، علم الكلام، الأشعرية
Abstrat: This article attempts to introduce a section of a large encyclopedia authored by Abū Bakr al-Ṭurṭūshī (d. 520 AH/1126 CE), titled Kitāb al-Asrār wa-l-ʿIbar on the science of purification and piety, as indicated in the preface to the encyclopedia. This section is the only surviving part and has been preserved in the Royal Palace Library in Marrakesh under the catalog number 404, consisting of 178 folios. This section includes two books, out of the hundred books that make up the entire encyclopedia: the Book of Intellect and the Book of Knowledge. In these two books, al-Ṭurṭūshī discusses numerous issues, most of which pertain to the legitimacy of Sunni theological reasoning (nazar). He aimed to defend the legitimacy of theological reasoning based on the foundational texts of Islamic knowledge, and consequently, the legitimacy of engaging in Sunni theology in its Ashʿarite form. In this context, the author of the Kitāb al-Asrār presents a series of statements attributed by Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505 AH/1111 CE) in Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn to the early scholars (salaf) regarding the condemnation of theological inquiry and engagement in it. Al-Ṭurṭūshī examines and critiques these statements in terms of their transmission and the authenticity of their chains of narration, as well as their meaning, demonstrating that they do not pose an obstacle to affirming the legitimacy, and even the commendability, of engaging in this noble science.Thus, this article argues that this concern motivated al-Ṭurṭūshī to write Kitāb al-Asrār wa-l-ʿIbar as a response to Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn, and that al-Ghazālī’s critique of theology and jurisprudence was the direct reason behind al-Ṭurṭūshī’s decision to compose this work, rather than the lack of works on purification and repentance. Additionally, the article seeks to bring the content and subject matter of this encyclopedia closer to the reader by drawing upon the general index outlined by al-Ṭurṭūshī in the preface, which was preserved in the surviving section. In this preface, Abū Bakr listed one hundred titles covering various disciplines related to creed, law, and ethics.
Keywords: al-Asrār wa-l-ʿIbar, al-Ṭurṭūshī, Iḥyāʾ, al-Ghazālī, ʿIlm al-Kalām, Ashʿarism
مقدمة
معروف جدا الانتشارُ الواسع والذيوع الكبير الذي كُتب لموسوعة إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي(ت.505هـ/1111م)، في المشرق والمغرب الإسلاميين في حياته وبعد مماته، بل حتى في الوقت الذي تم فيه إحراقها في مراكش وقرطبة أيام علي بن يوسف الخليفة المرابطي، وإصدار مذكرات رسمية في تعزير من وجدت عنده نسخة من هذا الكتاب الذي رأى فيه فُقهاء المرابطين تهديدا كبيرا للمشروعية التي أسسوا عليها مواقفهم ومواقعهم في الدولة المرابطية، أعني موقفَه من الاشتغال بالفقه، باعتباره علما من علوم الدنيا وليس من علوم الآخرة، ورميه المشتغلين به بعلماء الدنيا بل وبعلماء السوء.[1]
إلى جانب إفتاء الفقيه القاضي ابن حمدين(ت.508هـ/1114م)، وفريق من فقهاء الأندلس بوجوب إحراق الإحياء، لأن فيه من البدع ومن المفاسد ما يجعل إحراقه خيرا من إبقائه، فقد انتهض علماء آخرون لمعارضته فكريا، وفي هذا الاتجاه يمكن قراءة وفهم موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي(ت.520هــ/1126م)، المغربي الأندلسي، الذي استقر ومات في المشرق. فقد عاصر الإمامُ الغزاليَّ، وسعى، اعتمادا على رواية الضبي في بغية الملتمس، إلى لقائه ومناقشته بخصوص المذهب الذي تبناه صاحب الإحياء بُعيد رحلة الغزالي من بغداد إلى الشام سائحا في الخلوات وتاركا بغداد ونظاميتها وعلومها التي كان يتقنها ويُلقنها لجلة طلبتها، إلا أن الغزالي لم يقبل بهذا اللقاء: ”فلما تحقق أبو حامد أنه يؤمه حاد عنه.“[2]
لم يصلنا من هذه الموسوعة إلا قطعةٌ تضم كتابين هما العقل والعلم، مع مقدمة استهلالية لخَّص فيها الطرطوشي هذا المشروع وسبب الإقدام عليه، فضلا عن وضع الفهرس العام له.
ويسعى هذا المقال إلى التعريف بهذه القطعة، وعبرها التعريف بالموسوعة، كما يهدف إلى معرفة أسباب إقدام أبي بكر الطرطوشي على وضع هذه الموسوعة في معارضة كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ونقده.
أولا: التعريف بصاحب الموسوعة ”أبي بكر الطرطوشي“
اسمه ونسبه وكنيته[3]
هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب، القرشي، الفهري، الطَّرْطُوشي، بفتح الطاء، وقيل: الطُّرطوشي بضمها. نسبة إلى طرطوشة، وهي مدينة بالأندلس[4]، أبو بكر، عُرف بابن أبي رَندَقة.
مولده وطلبه العلم بالأندلس قبل الرحلة إلى المشرق
ولد بطرطوشة سنة 451هـ. وبها نشأ وأخذ الضروري من العلم، قال صاحب وفيات الأعيان: ”قرأ الفرائض والحساب بوطنه.“[5] وذلك بعد قراءته العربية وحفظه القرآن الكريم، ودراسته الضروري من العلوم الشرعية، كما جرت بذلك عادة الأندلسيين في التدرج في التلقي والتحصيل.
وما أن أينع حتى نشطت همته للسفر إلى مدينة سرقسطة لسببين على الأقل:
الأول: للقاء علمائها واستئناف التحصيل أولا، ففيها لقي أبا الوليد الباجي (ت.474هـ/1082م)، العالم والفقيه والأصولي والمتكلم والمحدث والمناظر المالكي، الذي رحل إلى المشرق وأخذ عن جلة علمائها، وأدخل إلى الأندلس كتبا وعلوما شوَّقَت كثيرا من الشباب الأندلسي العالم للرحلة المشرقية للاستزادة من العلوم، سيما العقلية منها.
الثاني: لعل لرحلة الطرطوشي الأولى إلى سرقسطة سببا له صلة بوجود أفراد من عائلته فيها، وهذا ما قد يفهم من خلال قصة ساقها في كتابه سراج الملوك، جاء في مستهلها: ”وكان بسرقسطة فارس يقال له ابن فتحون، وكان يناسبني من جهة أمي فيقع ابن خال والدتي، وكان أشجع العرب والعجم، وكان المستعين أبو المقتدر يرى له ذلك ويعظمه (إلخ). “[6]
رحلته إلى المشرق
هكذا حداه الشوق لينهج نهج أستاذه أبي الوليد الباجي في الرحلة المشرقية، فخرج سنة 476هـ إلى المشرق، أي سنتين بعد وفاة أبي الوليد، فحجّ ودخل بلادا كثيرة، منها البصرة وبغداد، وأخذ عن علماء الحاضرتَين، وقد تزامن دخوله مع أوج نشاط المدارس النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك (ت.485هـ/1092م)[7]، والتي أسهم في تأسيسها ورسم هندستها التربوية التعليمية إمامُ الحرمين عبد الملك الجويني (ت.478هـ/1085م)، ودرَّس فيها الفقهَ الشافعي، كما درّس فيها تلميذُه أبو حامد الغزالي،[8] فتتلمذ الطرطوشي لجلة علماء هذه المدارس. ثم دخل دمشق ودرَّس بها، قبل أن يستقر بالإسكندرية، حيث عُرف واشتهر، وقصده المئات من الطلاب.
وقد تعرض الطرطوشي في مصر لمضايقة من الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر (ت.515هـ/1121م) حين قصده الطرطوشي ووعظه، حيث أبعده عن طلابه، إلى أن توفي الوزير الفاطمي، فعاد إلى درسه وطلابه.
وكان الطرطوشي أيام استقراره بالإسكندرية مهموما بتحصيل قيمة العدل، ولم يتوانَ عن النصح والوعظ للحكام، وألف في ذلك كتبا، لعل أهمها مؤلفه الشهير سراج الملوك، عرض فيه سِير الملوك، وبين فيه قواعد الحكم الرشيد، كما عرض فيه جوانب من الحكمة القرآنية والنبوية في مجال السياسة والتدبير الحكيم.
يلخص ابن بشكوال (ت.578هـ/1182م)، هذه الرحلة الطرطوشية بين حواضر الأندلس أولا، ثم رحلته المشرقية ثانيا بقوله: ”صحب القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة وأخذ عنه مسائل الخلاف وسمع منه وأجاز له. ثم رحل إلى المشرق وحج ودخل بغداد والبصرة فتفقه عند أبي بكر الشاشي، وأبي العباس الجرجاني، وسمع بالبصرة من أبي علي التستري، وسكن الشام مدة ودرس بها.“[9]
عاش أبو بكر الطرطوشي إماما عالما، عاملا زاهدا، ورعا دينا متواضعا، متقشفا متقللا من الدنيا، راضيا منها باليسير[10]، قال صاحب الصلة: ”أخبرنا عنه القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ووصفه بالعلم والفضل والزهد في الدنيا.“[11]
من شيوخه
تقدم أن الطرطوشي: ”صحب في سرقسطة أبا الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلاف وأجاز له.“[12] وقد ذكر ابن خلكان أنه أخذ الأدب عن أبي محمد ابن حزم (ت.456هـ/1064م)[13]، وهو أمرٌ استبعده بعض الباحثين لأسباب تاريخية، ذلك أن ابن حزم توفي سنة 456هـ، والطرطوشي ولد سنة 451هـ، فقد كان عمر مترجمنا حين وفاة ابن حزم زهاء خمس سنوات فقط، أي أنه لم يكن قد خرج بعد من بلدته التي ولد فيها.
أما شيوخه في المشرق، فمنهم:
1. أبو بكر القفال الشاشي (ت.507هـ/1114م)،[14] الفقيه الشافعي، كان رئيسا للشافعية بالعراق في وقته[15]؛
2. أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري (ت.478هـ/1085م)،[16] فقيه شافعي، عرف بالأصول والمناظرة، وله فيه مؤلفات[17]؛
3. أبو العباس أحمد الجرجاني (ت482هـ/1089م)،[18] قاضٍ بالبصرة وشيخ الشافعية بها في عصره[19]؛
4. أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني (ت.478هـ/1085م)،[20] الفقيه الحنفي، قاضي القضاة، انتهت إليه رئاسة مذهب العراقيين[21]؛
5. أبو علي علي بن أحمد التستري ثم البصري (ت. 479هـ/1086م)،[22] راوي سنن أبي داود، عن الهاشمي عن أبي علي اللؤلؤي عن أبي داود،[23] سمع منه بالبصرة؛
6. أبو محمد عبد الله بن الحسين السعيداني البصري (ت.489هـ/1096م)،[24] الإمام المحدث[25]؛
7. أبو محمد رزق الله التميمي الحنبلي البغدادي (ت.488هـ/1085م)،[26] فقيه الحنابلة وشيخهم في وقته[27].
هؤلاء الأعلام الذين أورد ياقوت الحموي أن الطرطوشي أخذ عنهم في بغداد والبصرة، كل واحد منهم هو رأسٌ في علمه في زمنه كما حلاهم بذلك مترجموهم، فيتبين لنا كيف أن أبا بكر اختار شيوخه بعناية أيام مكوثه في بغداد والبصرة لاستكمال الطلب، وقد تنوع اهتمام هؤلاء المذكورين بين الفقه والأصول والحديث، كما أن فيهم الشافعية، وهم الغالب بحكم السياسة الرسمية في بغداد ونواحيها أيام تولي نظام الملك مسؤولية تأسيس وبناء مدارس تعنى بتدريس المذهب الشافعي في الفروع والمنهج الأشعري في الاعتقاد، فضلا عن التصوف السني. ولكن بغداد لم تخل حينها من وجود علماء الحنابلة والحنفية.
ولا يبعد أن يكون الطرطوشي قد أخذ عن معظم الأساتيذ الذين درّسوا بنظامية بغداد ونواحيها في هذا الوقت، ومنهم عبد الملك الجويني الذي توفي سنة 478هـ، وغيره.
خرج الطرطوشي من العراق و دخل الشام عالما كبيرا زاهدا ورعا، قال ابن فرحون ملخصا شيئا من أيام إقامته بالشام:
”وسكن الشام مدة، ودرَّس بها، ولازم الانقباض والقناعة، وبعُد صيتُه هناك، وأخذ عنه الناس هناك علماً كثيراً، وكان إماماً عالماً زاهداً ورعاً ديناً متواضعاً متقشفاً متقللاً من الدنيا راضياً باليسير منها. وتقدم في الفقه مذهباً وخلافاً، وكان بعضُ الجلة من الصالحين هناك يقول: الذي عند أبي بكر من العلم هو الذي عند الناس، والذي عنده مما ليس مثله عند غيره دينُه. وكانت له -رحمه الله تعالى- نفْسٌ أبية، قيل إنه كان ببيت المقدس يطبخ في شقفة، وكان مُجانباً للسلطان معرضاً عنه وعن أصحابه، شديداً عليهم، مع مبالغتهم في بِره. “[28]
وقد رجح أحد الباحثين أنه أقام بالشام زهاء عشر سنوات، أي من سنة 480هـ إلى 490هـ، وذلك بناء على قرائن.[29]
أما تلامذته فلن أوردهم ها هنا تجنبا للتطويل، فإني حين راجعت كتب التراجم، وجدتهم بالعشرات، إن لم يكونوا بالمئات، سيما في الإسكندرية، حتى إنه ليحق لنا أن نقول مع شيء من التحفظ: لم يرحل عالم أو طالب علم من الغرب الإسلامي إلى الحج وإلى المشرق عموما أيام وجود الطرطوشي بالشام والإسكندرية إلا لقي أبا بكر وأخذ عنه، وكذلك علماء العراق والشام وطلبة العلم رحلوا إليه طلبا للعلم والبركة والإجازات. فمن أراد أن يقف عليهم فليراجعهم في كتب التراجم والطبقات.
محنة الطرطوشي ووفاته
بعد استقرار أبي بكر الطرطوشي بالإسكندرية وذيوع صيته بها، وانتشار خبره ووفود الطلبة على دروسه، وقد كان ذلك سنة 490هـ، بدأ يؤلف رسائل في بيان المفاسد الواقعة في الإسكندرية بسببٍ من فساد الحكم، وفساد القضاء، فأرسل إليه الوزير الفاطمي الأفضل ابنُ أمير الجيوش يطلب مثوله إلى القاهرة، ويأمره بالمكوث في مسجد في الفسطاط، وأجرى له جراية، ومنعه من مجالسة الناس والحديث إليهم[30]. وكان أبو بكر يكره الأفضل: ”فلما طال مقامه به ضجر، وقال لخادمه: إلى متى نصبر، اجمع لي المباح، فجمعه، وأكله ثلاثة أيام، فلما كان عند صلاة المغرب قال لخادمه: رميته الساعة، فلما كان من الغد ركب الأفضل فقتل. وولي بعده المأمون بن البطائحي فأكرم الشيخ إكراما كثيرا“[31]. فعاد الطرطوشي إلى الإسكندرية واستأنف التدريس والتأليف، إلى وفاته سنة 520هـ، على أرجح الأقوال[32]. فيكون قد استقر بالإسكندرية زهاء ثلاثين سنة، من 490 إلى وفاته 520هـ.
آثاره
بعد انتهاء أبي بكر من رحلة الطلب التي بدأت ببلدته طرطوشة، ثم سرقسطة، ثم الحجاز، فبغداد والبصرة، فالشام وبيت المقدس، نزل الإسكندرية بعد الأربعين من عمره، عالما كبيرا محيطا بتفاصيل المنقول والمعقول من العلوم. ورغم أنه قد بدأ التدريس والتأليف قبل اسقراره بالإسكندرية، إلا أن أكثر تواليفه كانت أيام استقراره بها، وقد توزعت بين كتب تأسيسية، وشروح وتعليقات، وتقاييد وضعها لتدريس الطلاب، ورسائل أرسلها لخلفاء ووزراء معينين. وهذه الآثار منها المطبوع المشهور، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو في حكم المفقود. أذكر من أعماله، على سبيل التمثيل:
1 كتاب التعليقة في الخلافيات، في خسمة أسفار؛[33]
2 مختصر تفسير الثعالبي؛[34]
3 الكتاب الكبير في مسائل الخلاف؛[35]
4 كتاب في تحريم جبن الروم؛[36]
5 كتاب بدع الأمور ومحدثاتها، المعروف بالحوادث والبدع؛[37]
6 شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛[38]
7 الأسرار والعبر،[39] وهو الكتاب الذي نعرف به في هذا المقال؛
8 سراج الملوك، كتاب مطبوع مشهور؛
9 كتاب بر الوالدين؛[40]
10 سراج الهدى؛[41]
11 تأليف عارض به الإحياء؛[42]
12 رسالة إلى يوسف ابن تاشفين؛[43]
13 النهاية في فروع المالكية.[44] وله رسائل أخرى كثيرة.
ثانيا: التعريف بموسوعة الأسرار والعبر للطرطوشي
وذلك من خلال الوقوف على نسبة الكتاب إليه، ثم الحديث عن موضوعه ومضمونه، ثم الحديث عن هندسته:
نسبة كتاب الأسرار والعبر للطرطوشي
ذكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك كتاب الأسرار وأحال عليه في مواضع، منها:
_ قال الطرطوشي: ”الباب الثالث والعشرون: في العقل والدهاء والخبث والمكر: قد ذكرت في كتاب الأسرار حقيقة العقل وأقسامه ومحله وأحكامه بما لا مزيد عليه.“[45]
_ قال الطرطوشي: ”واعلم أن زمام الأمور التوفيق[…]، وقد كنت جمعتُ فيه كتابا من جملة كتابي في الأسرار: هل التوفيق مكتسب، أو موهبة بلا سبب؟ فلا مزيد عليه.“[46]
وقد ذكره أبو جعفر الضبي فقال: ”وله كتاب يعارض به كتاب الإحياء رأيت منه قطعة يسيرة.“[47]
وقد ذكره بهذا العنوان: الأسرار والعبر، الطرطوشي في مستهل الموسوعة قائلا: ”أما اسمه فسميته كتاب الأسرار والعبر.“[48]
وقد انتبه لهذا الكتاب علَمان من أعلام البحث والتحقيق في مغربنا المعاصر، هما العلامة محمد المنوني (ت.1999م)، والعلامة محمد بن شريفة (ت.2018م).
فقد عرَّف المنوني بالأسرار في ندوة الغزالي التي نشرت أعمالها سنة 1988م/1408هـ. ثم أعاد نشر ورقته ملحقا لكتابه حضارة الموحدين[49]. والمنوني هو أول من اكتشف وعرف بكتاب الأسرار والعبر من الدارسين في العصر الحديث، وذلك أثناء عمله في خزانة القصر الملكي، بمراكش، سنة 1983م.[50]
أما محمد بنشريفة فقد عرف بالأسرار في مقال نُشر جزؤُه الأول في مجلة مرآة التراث، بعنوان: أبو بكر الطرطوشي: هل كان له دور في رجوع السنة إلى مصر؟ وهل عارض كتاب الإحياء للغزالي؟[51]، كما تقدَّمَ أعلاه.
وقد ذهب محمد بن شريفة إلى أنه ألفه في بيت المقدس، وذلك لقول الطرطوشي في تقدمة الكتاب في سياق ذكر دواعي تأليفه وجمعه: ”[…]، على جمعه أنني كنت في الأرض المقدسة في المسجد الأقصى[…]، فعند اختتام المجلس قبض على يدي شيخٌ داهرٌ قد سقطت حاجباه من الكِبَر، وقال لي: يا بني، إن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نلقاه بمذهب مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي، وإنما أمرنا أن نلقاه بالتقوى[…]، فشرعتُ في تأليف كتاب في التقوى وحقيقته وأقسامه.“[52] والظاهر من هذا النص أنه ابتدأ تأليفه في بيت المقدس، وحين قدم الإسكندرية أكمل تأليفه؛ فالقصة التي حصلت له مع هذا الشيخ كانت في بيت المقدس، وشروعه في تأليف الكتاب كان أيضا ببيت المقدس، لكن وضعه هذا التقديم الذي استهل به للكتاب كان في الإسكندرية، والله أعلم هل القصة حصلت له أيام مكوثه بالشام قبل سفره إلى الإسكندرية التي تقدم أنه مكث فيها من 490هـ إلى وفاته، أم أنه بقي مترددا على بيت المقدس أيام استقراره بمصر.
فالكتاب صحيح النسبة إلى أبي بكر الطرطوشي.
موضوع كتاب الأسرار والعبر ومضمونه
تحدث الطرطوشي في تقدمة كتابه الأسرار عن سياق تأليفه هذه الموسوعة، فقال: ”وكان …[53] على جمعه وترتيبه أني كنت في الأرض المقدسة في المسجد الأقصى…[54] مجلسا من مسائل الفقه، ودقائق الخلافيات، فعند اختتام المجلس قبض على يدي شيخ داهر قد سقطت حاجباه من الكِبَر، وقال لي: يا بني، إن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نلقاه بمذهب مالك، والثوري وأبي حنيفة والشافعي، وإنما أمرنا أن نلقاه بالتقوى فقال: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) (النساء: 131) […]، فشرعتُ في تصنيف كتاب في التقوى، أوضحتُ فيه معنى التقوى وحقيقته وأقسامه، وهل هو من أعمال القلوب، أم من أعمال الجوارح أو كليهما.“[55]
ويمكن اعتبار هذه القصة التي حصلت لأبي بكر الطرطوشي مع الشيخ الكبير في بيت المقدس سياقا خاصا للكتاب، لأن ثمة سياقا عاما لإقدامه على وضعه هذا الكتاب وهو انتشار كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وذيوعه، فقد كره منه الطرطوشي خلالا خمسا، بتعبير الطرطوشي في تقدمة الأسرار والعبر، يقول، بعد أن ساق أهم مصادر الموضوع الذي يقدم على التأليف فيه: ”وكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي الطوسي، وهو أكثرها علما، وأقواها حجة، إلا أنا كرهنا منه خلالا خمسا:
أحدها: كثرة الكذب فيه عن الرسول، عليه الصلاة والسلام، ولعمري ما يقوم نفع ألف ديوان بكذبة واحدة على رسول الله، عليه السلام، إلا أن الرجل لم يتعمد منها كلمة إن شاء الله، وإنما نقل من كتب لا معرفة له بها، وقد اعتذر الرجل عن ذلك فقال: بضاعتي في الحديث مزجاة. واعلم أنه من رأى حديثا في كتاب لا يعرف صحته لا يجوز له أن يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة قد أوضحتها في أصول الفقه، وبينت فيه اختلاف العلماء في كيفية رواية الحديث وإيراده.“[56]
ثم ساق الخصال والخلال الأربع الأخرى التي كرهها من كتاب الإحياء، وسأنقل الخصلتين الثانية والخامسة بالمعنى دون اللفظ لطولهما.
الخصلة الأولى، كما نقلنا، هي سوقه الأحاديث الضعيفة والموضوعة على النبي، عليه السلام.
والخصلة الثانية هي نقله أقوالا منسوبة للسلف في ذم علم الكلام، وهذا في نظر الطرطوشي عيب، لأن علم التوحيد عليه يتأسس الدين، وتعلمه فرض عين على أعيان الأمم، فبدل أن يقرر الغزالي في الإحياء عقيدته بناء على القواعد النظرية للاعتقاد، راح ينقل ما قيل في ذمه. والجدير بالذكر في هذا المقام أن الغزالي المتكلم الكبير، صاحب التصانيف الكثيرة والمفيدة في علم الكلام، عاش في الفترة التي ألف فيها إحياء علوم الدين، وهي العُشرية الممتدة بين 485هـ و 495هـ، حياة من العزلة غير فيها كثيرا من مواقفه إزاء كثير من القضايا، منها موقفه من علم الكلام، وحتى موقفه من الفقه الفرعي، حيث اتجه نحو ذم الاشتغال بعلم الكلام، وبالفقه الذي يعنى بفك الخصومات.
وجدير بالذكر أيضا أن هذه الخصلة الثانية هي التي اهتم الطرطوشي بالرد عليها في كتابَي العلم والعقل من موسوعة الأسرار، حيث أتى بالنقول التي ساقها الغزالي في ذم الكلام والاشتغال به وتفاعل معها بالرد والنقد. فكأن هذه الخصلة هي التي حركته لتأليف كتابه.
”والخصلة الثالثة: مذاهب شنيعة نقلها من رسائل إخوان الصفا، وهم قوم باطنية كفار يتأولون القرآن على غير تأويله، ويحرفون الكلام عن مواضعه، ويسوقون الآراء في الشريعة بما لا يجتمع مع العقود الإسلامية بوجه. والخصلة الرابعة: إباحة الغناء والسماع.“[57]
والخصلة الخامسة: اعتماده الحكايات والروايات المختلقة التي لا أصل لها، وشحن كتاب الإحياء بها.
وبعد أن ألقينا نظرة عامة عما كرهه الطرطوشي من كتاب الإحياء، يظهر لنا أنها ليست أمورا عادية يمكن لرجل مثل أبي بكر أن يتغاضى عنها، وفي الواقع فإن هذه الأمور التي كرهها الطرطوشي حين التدقيق فيها يصعب أن يتغاضى عنها أي مسلم،[58] ولكن الأمر الذي هو محل أخذ ورد، هو مدى صحة ما رمى به الطرطوشي كتاب الإحياء في هذه التقدمة للأسرار.
لكن الذي يهمنا نحن في هذا السياق هو أن نثبت أن الطرطوشي إنما ساق هذه المآخذ الخمسة على الإحياء ليسوغ تأليفه الذي أراد من خلاله أن يستدرك على الغزالي، ويقدم للأمة كتابا موسوعيا يستفيد منه أبناؤها دون أن يقعوا في ما وقع فيه أبو حامد الغزالي مما وصفه.
وهكذا ألف الطرطوشي كتاب الأسرار الذي قال عنه: ”فانتخبتُ غرر هذه الدواوين [يعني مصادر علم التصوف التي أوردها قبل هذه الفقرة]، وأنظارها، وجمعت حِكمها ومحاسنها، وغصت فيه على أسرار القرآن وجواهره، واستخرجت الكثير من دقائقه وعجائبه، ولم آل جهدا في الاعتصام بالقرآن وصحيح السنة والآثار […]، وأودعت فيه سير الأنبياء وحكمة الحكماء ونكت العلماء وإشارات الأصفياء وأخلاق الأولياء ما لم يحوه كتاب جامع، وأربيتُ فيه على ما صنف في هذه الأبواب بفوائد عجيبة لم يذكروها.“[59]
صحيح أنه يتحدث عن قيمة كتاب الأسرار بين الكتب المصادر التي ساقها، والتي منها حلية الأولياء، وقوت القلوب، ودليل القاصدين لأبي بكر السمنطاري الصقلي، وكتاب اللوليات لمكحول، والرعاية للمحاسبي، وإحياء علوم الدين للغزالي، لكن من قرأ هذه الفقرة التي سقناها أعلاه في ضوء تقدمة الكتاب كلها، وحتى في ضوء محتوى كتاب الأسرار الذي أعلن عنه في التقدمة بما سنبينه أسفله، تبين له أنه يقصد بالرد والتجاوز كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، فكتاب الأسرار هو كتاب في معارضة كتاب الإحياء ونقده وتجاوزه. فهل كتاب الأسرار والعبر فيه من الحكم والأسرار والسير والعلم ما لم يحوه كتاب الإحياء للغزالي؟
إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال تحتاج منا أن نقف على موسوعة الأسرار كلها للمقارنة بين العملين، وهذا متعذر لعدم وجود زهاء 98 كتابا من موسوعة الأسرار التي تضم مئة كتاب، فإن مما لا شك فيه أن كتاب الإحياء للغزالي كُتب له من النسخ والانتشار والبركة والذيوع والتدريس في المدارس والمعاهد العلمية ما لم يكتب للأسرار لا عُشُره ولا نصف معشاره. والدليل على ذلك كثرة نسخ الإحياء، ليس في خزائن المخطوطات اليوم، بل في المغرب وحده في حياة أبي حامد نفسه، علما أن الإحياء كتب في العشرية التي اعتزل فيها الغزالي الناس، أي ما بين 485 و495هـ، فقد أنهاه عشر سنوات فقط قبل وفاته، ومع ذلك فقد رحل هذا الكتاب إلى المغرب والأندلس، وفي زهاء سنة أو سنتين على الأكثر كانت نسخه بالعشرات، إن لم تكن بالمئات، وبدأ تلامذة الغزالي المباشرون يدرسونه في الحِلَق والجوامع، في قرطبة، وفاس، ومراكش، وغيرها من الحواضر، حتى أزعج هذا الأمر الفقيه ابن حمدين وعددا من فقهاء الدولة المرابطية الذين رفعوا فتوى إلى الخليفة المرابطي علي بن يوسف بضرورة إحراقه لما فيه من الفتنة، والبدع والمحدثات. وهو الأمر الذي لقي استحسانا من علي بن يوسف، فشُرع في إحراقه، وأُمر الناسُ أن يحرقوا ما بحوزتهم من نسخه، حتى وعد الخليفة بمعاقبة من وجد عنده نسخة، وأحرقت منه نسخ كثيرة. ومع ذلك بقي الكتاب وانتشر انتشارا عجيبا، أيام المرابطين أنفسهم.
وما أن جاء ابن تومرت من المشرق وأعلن عن تأسيس دولته بناء على بركة أبي حامد الغزالي الذي ادعى ابن تومرت أنه تتلمذ له، حتى انكب الناس على قراءة الإحياء ونَسخه بشكل يجعلنا لا نملك أي إحصاء بخصوص عدد نسخه، وذلك لوفرتها، ولم يتوقف نَسخُ الإحياء إلى اليوم.
وهذا الأمر لم يحصل مع الأسرار، وقد يكون للأمر علاقة بشخص الغزالي نفسه، وقد تكون ثمة أسباب أخرى لهذا الانتشار في مقابل اندراس الأسرار والعبر، ولكن لا شك أن جودة الترتيب التي عرف بها الإحياء واحدة من هذه الأسباب.
ولا أدل على ذلك من وصف الطرطوشي نفسه كتاب الإحياء في تقدمة الأسرار بأنه إذا قورن بغيرها من المصادر المذكورة، فهو: ”أكثرها علما، وأقواها حجة.“[60] ومِن انتهاج الطرطوشي نفس منهج الغزالي في هندسة كتاب الأسرار، فقد أسسه على أربعة أرباع، تماما كما أسس الغزالي إحياءه على أربعة أرباع، قال الطرطوشي في تقدمة الأسرار: ”وأما تجزئته فجزأته على أربعة أرباع، الأول ربع المعارف، والثاني ربع العبادات، والثالث ربع المعاملات، والرابع ربع الأحوال والمقامات ثم أتبعته بكتاب الجامع.“[61] مع فارق هو أن أرباع كتاب الإحياء هي: ربع العبادات، وربع والعادات، وربع المهلكات، ثم ربع المنجيات. وكون الطرطوشي قد ختم الأسرار بكتاب الجامع، جريا على عادة المالكية في ذلك، تأسيا منهم بموطأِ الإمام مالك، الذي أسس لهذا المنهج.
ومع ذلك فإن عناوين الكتب الأربعين المكونة لكتاب الإحياء كلها مدرجة في كتاب الأسرار، ورغم أن الكتاب الأول ضمن هندسة الأسرار هو كتاب العقل، إلا أنه وضع بين يدي الموسوعة قبل البدء في كتاب العقل فصلا تحدث فيه عن ”شرف أدوات العلم، مثل المحبرة والقلم وتأليف الدواوين وتصنيف المصنفات، وهل ذلك من قبيل المكروه كما قتال بعضهم أو من قبيل المباح أو المندوب.“[62] فضلا عن تخصيصه كتابا مستقلا للعلم مباشرة بعد كتاب العقل، وهما، أي كتابا العقل والعلم، كل ما نتوفر عليه من موسوعة الأسرار والعبر. ومعروف أن أول كتاب، بل لعل أهم كتاب، ضمن إحياء علوم الدين هو كتاب العلم الذي صدّر به الكتاب.
على أن الطرطوشي قد أدرج أغلب الكتب التي أدرجها الغزالي تحت رُبعي: المهلكات والمنجيات تحت الربع الرابع من الأسرار: الأحوال والمقامات.
وقد سعى الطرطوشي في هذه الموسوعة أن يؤلف على غرار الإحياء وطريقته، على أن يتجاوز ما وقع فيه الغزالي من الخلال التي أوردناها أعلاه، مما كرهه الطرطوشي، وأن يأتي بأسرار وعبر وحكم جديدة لم تقع في الإحياء ولا في بقية المصادر التي ذكرها في مقدمة الكتاب.
هندسة كتاب الأسرار والعبر
تقدم أن موسوعة الأسرار قائمة على أربعة أرباع هي: ربع المعارف، وربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأحوال والمقامات، ثم الكتاب الجامع. وذلك وفق الهندسة والتصميم الآتيين:
الربع الأول: ربع المعارف، مشتمل على أربعة وعشرين كتابا، هي: كتاب العقل، العلم، الأمثال، القطب، الأسماء والصفات، القدر، الإرادة، خلق الأفعال، العقائد، زلل الأمم، الإيمان والمعارف، الكفار والمتأولين، العظمة، الحكمة في خلق الملكوت، البدء، السماء والعالم، خلق الملائكة والجن والشياطين، الإنسان والنفس والروح، النبوات، صفة الرسول وأخلاقه، الأولياء والكرامات، التفسير، الرؤيا، الإسراء.[63]
الربع الثاني، ربع العبادات: مشتمل على اثني عشر كتابا، هي: كتاب النية، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، …،[64] الذكر، الدعاء، إحياء الليل، …،[65]وتسبيح الخلائق، قبول الأعمال.[66]
الربع الثالث، ربع المعاملات: مشتمل على أحد عشر كتابا، هي: كتاب النكاح، الأطعمة، اللباس والترحل، الطب، الأرزاق، الكسب، الشبهات، السياسة والصحبة/الصحة، الإمارة والولايات، تحريم الغناء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[67]
أما الربع الرابع، ربع الأحوال والمقامات: ”فمشتمل على…[68] وأربعين كتابا: كتاب أسرار القلوب، كتاب الوصايا والمواعظ، كتاب الأحوال، كتاب التوبة، كتاب الفكرة، كتاب حصر/حصد الأمل، كتاب القرب والمشاهدة، كتاب الرياضة والمجاهدة، كتاب الخلوة والعزلة، كتاب الصمت، كتاب الزهد، كتاب الورع، كتاب الخوف والتقوى، كتاب المفاصلة/المفاضلة، كتاب الرجاء، كتاب الفرج بعد الشدة، كتاب الخشوع، كتاب البكاء والحزن، كتاب فضل الجوع والقناعة، كتاب التوكل، كتاب الشكر، كتاب اليقين، كتاب الصبر، كتاب الإخلاص، كتاب الفقر، كتاب التصوف، كتاب طبقات العباد، كتاب الأدب، كتاب العبودية، كتاب المحبة والشوق، كتاب الجود والسخاء، كتاب الأخلاق، كتاب المروءة، كتاب …[69]، كتاب الصدق، كتاب الاستقامة، كتاب …، [70]كتاب الإفادة، كتاب الرضا، …[71].“[72]
كتاب الجامع: مشتمل على اثني عشر كتابا، هي: كتاب المعاصي، كتاب البدع والحوادث، كتاب العواقب و …[73] الأعمال، كتاب فساد الزمان، كتاب الملاحم والفتن، كتاب المصائب والمحن، كتاب الآداب المنثورة، كتاب فقد الأحبة، كتاب الأشراط، كتاب الموت والخروج من الدنيا، كتاب البرزخ، كتاب القيامة والأهوال وما يتصل بذلك من الحشر والنشر والحساب والعرض، إلى استقرار أهل الدارَين، وصفة الجنة والنار.[74]
هذه هي الكتب المئة التي تمثل مضمون موسوعة الأسرار والعبر ومحتواها، وأنت ترى من خلال وقوع كتابي العقل والعلم في 178 لوحة مخطوطا، أن الأسرار لو كان متاحا بين أيدينا لأمكن أن يقع في عشرات المجلدات مخطوطا. ومع ذلك كله، فإن الطرطوشي قد علق بعد سوقه عناوين هذه الكتب بتعليق قال فيه: ”ولولا كراهة التطويل لرسمتُ لك من أسرار هذه الكتب وعجائب مضمونها ما تقر به عين اللبيب، إلا أنه سيبدي لك كل كتاب صفحات مضمونة عند الإشراف عليه.“[75]
خاتمة
لا يسعنا ونحن نختم هذا المقال حول هذه القطعة المتاحة من موسوعة الأسرار إلا أن نتأسف على ضياع ثمانية وتسعين كتابا منها، وأن نمني النفس بأن يجود بها الزمن. نقول هذا لأن الطرطوشي قد أعلن في هندسة الكتاب الذي احتفظت بها القطعة الموجودة منها عن مشروع علمي وتربوي كبير جدا رمى من خلاله استصلاح المعرفة العقدية والشرعية والتربوية الأخلاقية، بشكل يجعلنا نقول: إن الطرطوشي صاحب هذه الموسوعة ليس هو طرطوشي الحوادث والبدع، الكتاب الذي كتبه في سياق خاص، وعُرف واشتُهر به حتى أضحى أبو بكر عنوانا لمنافحة البدع باختلاف إطلاقات الناس على هذا المفهوم، الأمر الذي استغلته بعض الفرق والطوائف التي تحارب كل جديد لتعلن أن الطرطوشي إنما هو واحد من علماء هذا التيار والتوجه. إن هذه القطعة المتاحة فقط تكفي لنتعرف إلى رجل منافح عن الأشعرية وعن مشروعية النظر الكلامي، وإلى رجل خبير بالمذاهب، والملل والنحل، وعلى دراية كبيرة بالخلافيات.
Bibliography
al-Ḍabbī, Abū Jaʿfar. Bughyat al-Multamis fī Tārīkh Rijāll al-Andalus. Cairo: Dār al-Kātib al-ʿArabī, 1967.
al-Dhahabī, Shams al-Dīn. Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ. Majmūʿa min al-Muḥaqqiqīn bi-ishrāf Shuʿayb al-Arnaʾūṭ. Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1405/1985.
al-Dhahabī, Shams al-Dīn. Tārīkh al-Islām wa-Wafayāt al-Mashāhīr wa-l-Aʿlām. Taḥqīq Bashshār ʿAwwād Maʿrūf, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2003.
al-Dimashqī, Ibn Kathīr. Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyyīn. Edited by Aḥmad ʿUmar Hāshim, Muḥammad Zaynhum Muḥammad ʿAzb. Cairo: Maktabat al-Thaqāfa al-Dīniyya, 1413/1993.
al-Ḥamawī, Yāqūt. Muʿjam al-Buldān. Beirut: Dār Ṣādir, 1995.
al-Ḥanafī, ʿAbd al-Qādir. al-Jawāhir al-Muḍiyya fī Ṭabaqāt al-Ḥanafiyya, Karachi: Mīr Muḥammad Kutub Khānah, n.d.
al-Ḥanbalī, Abū Bakr. al-Taqyīd li-Maʿrifat Ruwāt al-Sunan wa-l-Asānīd. Taḥqīq Kamāl Yūsuf al-Ḥūt. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1408/1988.
al-Ḥanbalī, Ibn al-ʿImād. Shadharāt al-Dhahab fī Akhbār man Dhahab. Edited by Maḥmūd al-Arnaʾūṭ. Damascus: Dār Ibn Kathīr, 1406/1986.
al-Ḥanbalī, Ibn Rajab. Dhayl Ṭabaqāt al-Ḥanābila. Edited by ʿAbd al-Raḥmān ibn Sulaymān al-ʿUthaymīn, Riyadh: Maktabat al-ʿUbaykān, ṭ.1, 1425/2005.
al-Ḥimyarī, Abū ʿAbd Allāh. Ṣifat Jazīrat al-Andalus. Edited by Lāfī Burūfinsāl, Beirut: Dār al-Jīl, 1408/1988.
al-Ishbīlī, Ibn Khayr. al-Fihrasa. Edited by Muḥammad Fuʾād Manṣūr. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1419/1998.
al-Manūnī, Muḥammad. Ḥaḍārat al-Muwaḥḥidīn. Casablanca: Dār Tūbqāl li-l-Nashr, 1409/1989.
al-Maqarrī, Shihāb al-Dīn. Azhar al-Riyāḍ fī Akhbār al-Qāḍī ʿIyāḍ. Edited by Muṣṭafā al-Saqā, Ibrāhīm al-Ibyārī, ʿAbd al-ʿAẓīm Shalbī, Cairo: Maṭbaʿat Lajnat al-Taʾlīf wa-l-Tarjama wa-l-Nashr, 1358/1939.
al-Maqarrī, Shihāb al-Dīn. Nafḥ al-Ṭīb min Ghuṣn al-Andalus al-Raṭīb wa-Dhikr Wazīrihā Lisān al-Dīn ibn al-Khaṭīb. Edited by Iḥsān ʿAbbās, Beirut: Dār Ṣādir, 1997.
al-Maqrīzī, Taqī al-Dīn. al-Muqaffā al-Kabīr. Taḥqīq Muḥammad al-Yaʿlāwī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1427/2006.
al-Qurʾān al-Karīm, riwāyat Warsh ʿan Nāfiʿ min ṭarīq al-Azraq.
al-Ṣafadī, Ṣalāḥ al-Dīn. al-Wāfī bi-l-Wafayāt. Edited by Aḥmad al-Arnaʾūṭ wa-Turkī Muṣṭafā, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth, 1420/2000.
al-Samʿānī, Abū Saʿd. al-Ansāb. Edited by ʿAbd Allāh al-Bārūdī. Amman: Dār al-Janān, 1408/1988.
al-Shiyāl, Jamāl al-Dīn. Abū Bakr al-Ṭurṭūshī: al-ʿĀlim al-Zāhid al-Thāʾir. Beirut: Dār al-Kātib al-ʿArabī, d.t.
al-Subkī, Tāj al-Dīn. Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyya al-Kubrā. Rdited by Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī, ʿAbd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulū, Cairo: Dār Hajr li-l-Ṭibāʿa wa-l-Nashr, 1413.
al-Ṭurṭūshī, Abū Bakr. al-Asrār wa-l-ʿIbar. Makhtūṭ Kizānat al-Qaṣr al-Malikī, Marrakesh, n. 404.
al-Ṭurṭūshī, Abū Bakr. Sirāj al-Mulūk. Cairo: min Awwāʾil al-Maṭbūʿāt al-ʿArabiyya, 1289/1872.
al-Wansharīsī, Abū al-ʿAbbās. al-Miʿyār al-Muʿrib wa-l-Jāmiʿ al-Mughrib ʿan Fatāwāl Ifrīqiyya wa-l-Andalus wa-l-Maghrib. Edited by Jamāʿa min al-Fuqahāʾ bi-ishrāf Muḥammad Ḥajjī. Rabat: Wizārat al-Awqāf wa-l-Shuʾūn al-Islāmiyya, 1401/1981.
Ibn Bashkuwāl, Abū al-Qāsim. al-Ṣila fī Tārīkh Aʾimma al-Andalus. Edited by ʿIzzat al-ʿAṭṭār. Cairo: Maktabat al-Khānijī, ṭ.2, 1374/1955.
Ibn Farḥūn, Burhān al-Dīn. al-Dībāj al-Mudhhab fī Maʿrifat Aʿyān ʿUlamāʾ al-Madhhab. Edited by Muḥammad al-Aḥmadī Abū al-Nūr. Cairo: Dār al-Turāth li-l-Ṭibāʿa wa-l-Nashr, n. d.
Ibn Khallikān, Abū al-ʿAbbās. Wafayāt al-Aʿyān wa-Anbāʾ Abnāʾ al-Zamān. Edited by Iḥsān ʿAbbās, Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
Ibn Makhlūf, Muḥammad. Shajarat al-Nūr al-Zakiyya fī Ṭabaqāt al-Mālikiyya. Edited by ʿAbd al-Majīd Khiyālī, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, n. d.
Ibn Sharīfa, Muḥammad. “Abū Bakr al-Ṭurṭūshī: Hal Kāna lahu Dawr fī Rujūʿ al-Sunna ilā Miṣr? wa-Hal ʿĀraḍ Kitāb al-Iḥyāʾ li-l-Ghazālī?” Mirʾāt al-Turāth, 7 (2021): 63-78.
Khalīfa, Ḥājī. Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa-l-Funūn. Baghdad: Maktabat al-Muthannā, 1941.
للتوثيق
بوحولين، إبراهيم. ”في مشروعية الكلام السني ضدا على إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت.505هـ/1111م): قطعة من موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي (ت.520هـ/1126م)، تعريفٌ وتوصيف.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/4205>
إبراهيم بوحولين
[1] انظر محمد المنوني، حضارة الموحدين، ط.1 (الدار البيضاء: دار تبقال، 1409هـ/1989)، 191-197.
[2] أبو جعفر الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (القاهرة: دار الكاتب العربي، 1967م)، 135.
[3] انظر ترجمته في: أبو سعد السمعاني، الأنساب، تحقيق عبد الله البارودي، ط.1 (عمان: دار الجنان، 1408هـ/1988م)، ج.4: 62؛ أبو القاسم ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، تحقيق عزت العطار، ط.2 (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1374هـ/1955م)، 545؛ الضبي، بغية الملتمس، 135؛ صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى (بيروت: دار إحياء التراث، 1420هـ/2000م)، ج. 5: 115؛ برهان الدين ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: دار التراث للطبع والنشر، د.ت)، ج. 2: 244؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ط.2 (بيروت: دار صادر، 1995م)، ج. 4: 30؛ تقي الدين المقريزي، المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعلاوي، ط.2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1427هـ/2006م)، ج. 7: 220؛ أبو العباس ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، ط.1 (بيروت: دار صادر، 1994م)، ج. 4: 262؛ أبو عبد الله الحميري، صفة جزيرة الأندلس، لأبي عبد الله الحِميري، تعليق لافي بروفنصال، ط.2 (بيروت: دار الجيل، 1408هـ/1988م)، 125؛ شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق بشار عواد معروف، ط.1 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2003م)، ج. 11: 325؛ شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، ط.3 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ/1985م)، ج. 19: 490؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، محمود الأرناؤوط، ط.1 (دمشق: دار ابن كثير، 1406هـ/1986م)، ج. 6: 102؛ شهاب الدين المقّري، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري، عبد العظيم شلبي (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1358هـ/1939م)، ج. 3: 163؛ شهاب الدين المقّري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق إحسان عباس، ط.1 (بيروت: دار صادر، 1997م)، ج. 2: 85؛ جمال الدين الشيال، أبو بكر الطرطوشي: العالم الزاهد الثائر (بيروت: دار الكاتب العربي، د.ت).
[4] قال ياقوت الحموي: ”طَرْطُوشَةُ: بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة، وواو ساكنة، وشين معجمة: مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية، وهي شرقي بلنسية وقرطبة، قريبة من البحر، متقنة العمارة، مبنية على نهر أبره، ولها ولاية واسعة وبلاد كثيرة تعدّ في جملتها، تحلّها التجار وتسافر منها إلى سائر الأمصار.“ معجم البلدان، ج. 4: 30.
[5] ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. 4: 262.
[6] أورد القصة في سراج الملوك، انظر: أبو بكر الطرطوشي، سراج الملوك (القاهرة: من أوائل المطبوعات العربية، 1289هـ/1872م)، 180. ولم أقف على معلومات تخص أسرة الطرطوشي إلا ما جاء في كتاب السراج من إشارات قليلة. إضافة إلى ما جاء في بعض كتب التراجم عن زواجه بالإسكندرية، قال ابن فرحون: ”زوج بالإسكندرية امرأة موسرة، حسنت حاله بها، ووهبت له دارا لها سرية، وصير موضع سكناه معها علوها، وأباح قاعتها وسفلها للطلبة، فجعلها مدرسة ولازم التدريس. وتفقه عنده جماعة من الإسكندرانيين.“ ابن فرحون، الديباج المذهب، ج. 2: 245-246.
[7] خص الطرطوشي في سراج الملوك نظام الملك وسياسته في تأسيس المدارس النظامية، والعناية بحماة الدين بكلام منقبي منه قوله: ”فبنى دور العلم للفقهاء وأنشأ المدارس للعلماء، وأسس الرباطات للعباد والزهاد وأهل الصلاح والفقراء، ثم أجرى لهم الجرايات والكسى والنفقات، وأجرى الخبز والورق لمن كان من أهل العلم مضافا إلى أرزاقهم، وعم بذلك سائر أقطار مملكته.“ انظر: الطرطوشي، سراج الملوك، 128.
[8] الظاهر أنه لم يدرس على الغزالي في النظامية، وذلك لأن أبا حامد دخلها مدرسا سنة 484هـ كما ساق ذلك ابن السبكي. انظر: تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، ط.2 (القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، 1413هـ)، ج. 6: 197. والطرطوشي خرج من العراق إلى الشام سنة 480هـ، كما سيأتي. وقد ذكر الضبي في بغية الملتمس أن أبا بكر قصد أبا حامد لرؤيته حين سمع بوجوده في بيت المقدس: ”فلما تحقق أبو حامد أنه يؤمه حاد عنه.“ الضبي، بغية الملتمس، 135. ولا ندري هل حصل هذا الرفض من الغزالي بسبب تفرغه لخلوته التي عاشها أيام رحلته الصوفية التي خرج فيها إلى دمشق وبين المقدس، أم لأسباب أخرى. وسننقل في التعريف بكتاب الأسرار والعبر نصا نقله المرتضى الزَّبيدي في شرحه الإحياء للطرطوشي نصَّ فيه أنه رأى الغزالي وناقَشه.
[9] ابن بشكوال، الصلة، 545.
[10] ابن بشكوال، الصلة، 545.
[11] ابن بشكوال، الصلة، 545.
[12] ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. 4: 262.
[13] ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. 4: 262.
[14] انظر الحميري، صفة جزيرة الأندلس، 125.
[15] انظر ترجمته في: السبكي، الطبقات، ج. 6: 70.
[16] انظر الحموي، معجم البلدان، ج. 4: 30.
[17] انظر ترجمته في: السبكي، الطبقات، ج. 5: 106.
[18] انظر الحموي، معجم البلدان، ج. 4: 30. على أن النسخة التي اعتمدتها من معجم ياقوت فيها أبو أحمد الجرجاني، وليس أبا العباس أحمد الجرجاني، ولكن النظر في المصادر التي ترجمت للطرطوشي وللفقيه أبي العباس الجرجاني يُظهر أن أبا العباس أحمد هو المقصود. انظر مثلا: ابن كثير الدمشقي، طبقات الشافعيين، تحقيق أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد عزب (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1413هـ/1993م)، ج. 1: 427.
[19] انظر ترجمته في: السبكي، الطبقات، ج. 4: 74.
[20] ذكره ياقوت في المعجم، ج. 4: 30.
[21] انظر ترجمته في: عبد القادر الحنفي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (كراتشي: مير محمد كتب خانه، د.ت)، ج. 2: 96.
[22] أورده ياقوت في المعجم، ج. 4: 30. ويظهر من خلال شهادة القاضي أبي علي الصدفي التي نقلها ياقوت في المعجم، والتي أخبر فيها الصدفي أنه صحب الطرطوشي في الأندلس عند الباجي، ثم لقيه بمكة وأخذ عنه الصدفي سنن أبي دواد عن التستري، ثم بعد ذلك دخل الطرطوشي بغداد ودخلها الصدفي كذلك، فلقيه في بغداد أيضا.
يظهر من خلال هذه الشهادة أن الطرطوشي قد أخذ عن التستري في الحجاز قبل أن يرحل بعد ذلك إلى بغداد. ومع ذلك فإن أبا بكر الحنبلي قال عن الطرطوشي: ”وسمع بالبصرة من أبي علي التستري سنن أبي داود وحدث عنه.“ أبو بكر الحنبلي. التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط.1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ/1988م)، 117.
[23] انظر ترجمته في: الذهبي، تاريخ الإسلام، ج. 10: 443.
[24] أورده ياقوت الحموي في المعجم، ج. 4: 30.
[25] انظر ترجمته في: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. 19: 79.
[26] أورده ياقوت في المعجم، ج. 4: 30.
[27] انظر ترجمته في: ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط.1 (الرياض: مكتبة العبيكان، 1425هـ/2005م)، ج. 1: 172.
[28]ابن فرحون، الديباج المذهب، ج. 2: 245.
[29] انظر: الشيال، أبو بكر الطرطوشي: العالم الزاهد الثائر، 33.
[30] جدير بالتذكير في هذا المقام أن الطرطوشي قد أسهم في نشر وإعادة الفكر والفقه السُّني إلى مصر في وقت كانت فيه مصر بأيدي الشيعة، فالطبيعي هو أن تحصل له هذه المحنة التي نتحدث عنها. وكان الطرطوشي يقول: ”إن سألني الله تعالى عن المُقام بالإسكندرية -لِما كانت عليه في أيام الشيعة العبيدية من ترك إقامة الجمعة و غير ذلك من المناكر التي كانت في أيامهم- أقول له: وجدت قوماً ضلالاً فكنت سبب هدايتهم.“ ابن فرحون، الديباج المذهب، ج. 2: 247.
وقد كتب العلامة محمد بن شريفة مقالا، له صلة بالموضوع من جانب، سماه: ”أبو بكر الطرطوشي: هل كان له دور في رجوع السنة إلى مصر؟ وهل عارض كتاب الإحياء للغزالي؟.“ مرآة التراث، العدد7 (2021م): 63-78.
[31] الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 5: 116. وانظر: المقري، نفح الطيب، ج. 2: 88.
[32] ذكر الضبي أنه توفي سنة 525هـ. انظر: الضبي، بغية الملتمس، 138.
[33] ذكره الضبي في بغية الملتمس، 138. وابن فرحون في الديباج، بعنوان: تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه، ج 2: 245.
[34] ذكره المقري في نفح الطيب، ج. 2: 88.
[35] ذكره المقري في نفح الطيب، ج. 2: 88.
[36] ذكره المقري في نفح الطيب، ج. 2: 88.
[37] ذكره ابن فرحون في الديباج بعنوان: البدع والمحدثات، ج. 2: 245. و المقري في نفح الطيب، ج. 2: 88.
[38] ذكره المقري في نفح الطيب، ج. 2: 88.
[39] ذكره الطرطوشي في سراج الملوك أكثر من مرة، انظر مثلا: ج. 1: 272. وسنأتي بالنقول التي ذكر فيها هذا العنوان، في تعريفنا بالكتاب.
[40] ذكره ابن فرحون في الديباج، ج. 2: 245
[41] محمد ابن مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق عبد المجيد خيالي (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج. 1: 184.
[42] ذكره الضبي في بغية الملتمس، 138. ولعله نفسه كتاب الأسرار والعبر، وذلك لأمرين: أولا كون كتاب الأسرار ألفه الطرطوشي ليعارض به الإحياء، كما وقفنا على ذلك من خلال قراءتنا لما هو متاح منه، ومن خلال تصريحه بذلك في مستهل الكتاب. وثانيا لقول الضبي: ”وله كتاب يعارض به كتاب الإحياء رأيت منه قطعة يسيرة.“ بغية الملتمس، 138. والمتاح الآن من موسوعة الأسرار والعبر قطعة فقط. ولعل القطعة التي رآها الضبي هي المتاحة الآن بين أيدينا. مع أن الطرطوشي أشار في سراج الملوك إلى كتاب التوفيق ضمن الأسرار والعبر، وهو من ضمن المفقود، مما يدل لكونه أتم موسوعته.
[43] ذكرها ابن خير في فهرسته قال: ”حدّثني بها القاضي أبو بكر محمد ابن العربي، رحمه الله، قراءة عليه وأنا أسمع غير مرّة، قال: أخبرني بها أبو بكر الطّرطوشي، رحمه الله.“ ابن خير الإشبيلي، الفهرسة، تحقيق محمد فؤاد منصور، ط.1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ/1998م)، 373.
[44] ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بغداد: مكتبة المثنى، 1941م)، ج. 2: 1989.
[45] الطرطوشي، سراج الملوك، ج. 1: 272. وكتاب العقل هو الذي صدّر به كتاب الأسرار، بعد استهلاله بفصل للحديث عن شرف أدوات العلم. وهو، أي: كتاب العقل، في زهاء 42 لوحة، من الأصل الخطي الذي بين أيدينا من كتاب الأسرار.
[46] الطرطوشي، سراج الملوك، ج. 2: 719. وهذه إشارة تدل أنه أتم موسوعة الأسرار، لأن كتاب التوفيق الذي أحال عليه في الفقرة أعلاه غير موجود ضمن القطعة المتاحة، والتي احتوت على كتابين فقط، هما العقل والعلم، كما تقدم. وبالنظر في هندسة الكتاب التي وضعها الطرطوشي في تقدمة كتابه، والتي ذكر فيها الكتب المئة المكونة للموسوعة، لم نقف على كتاب التوفيق هذا، على أن في الصفحة التي أورد فيها كُتب الرُّبُع الرابع من كتاب الأسرار بترًا غطى على ثلاثة عناوين، وقد يكون كتاب التوفيق ضمن هذه الثلاثة الواقعة في المساحة المبتورة. وإن كان الأمر كذلك فسيكون كتاب التوفيق هذا ضمن الكتب الأخيرة الواقعة في موسوعة الأسرار والعبر. وهذه أمارة أخرى على إتمام هذه الموسوعة الكبيرة التي لم يصلنا منها سوى هذه القطعة. وسنأتي في هذه الدراسة بقرائن أخرى تدل أنه فرغ من تأليف موسوعته الأسرار والعبر.
[47] بغية الملتمِس، 138.
[48] أبو بكر الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم: 404، 5ظ.
[49] انظر: محمد المنوني، حضارة الموحدين، 200.
[50] انظر: المنوني، حضارة الموحدين، 196.
[51] انظر: ابن شريفة ”أبو بكر الطرطوشي،“ 64.
[52] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم: 404، 2وظ.
[53] محو في الأصل بمقدار كلمة.
[54] محو في الأصل بمقدار كلمة.
[55] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم: 404، 2وظ.
[56] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم: 404، 3و.
[57] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم: 404، 3ظ.
[58] قال الطرطوشي عن الإحياء في رسالة بعثها إلى أبي عبد الله بن المظفر إلى الأندلس كلاما أسوأ مما قاله في الأسرار، جاء فيه: ”فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم منه [أي من الإحياء] “ نقل نص الرسالة أبو العباس الونشريسي في المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1401هـ/ 1981م)، ج. 12: 186.
[59] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم: 404، 4و.
[60]الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم: 404، 3و.
[61] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 5ظ. وهذه الفقرة قرينة أخرى على أنه فرغ من موسوعة الأسرار ثم قدم لها بهذه التقدمة.
[62] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 7ظ.
[63] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 5ظ.
[64] فراغ بمقدار كلمة.
[65] فراغ بمقدار كلمة.
[66] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 5ظ.
[67] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 6و.
[68] محو في الأصل بمقدار كلمة، وبإحصاء عدد الكتب التي تحت هذا الربع وجدنا 37كتابا، مع وجود محو غطى موضع ثلاثة كتب.
[69] محو في الأصل بمقدار كلمة.
[70] محو في الأصل بمقدار كلمة.
[71] محو في الأصل بمقدار كلمتين.
[72] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 6و.
[73] محو في الأصل بمقدار كلمة.
[74]الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 7ظ. ملحظ: ساق الناسخ عنوان كتاب الجامع، وأن تحته اثني عشر كتابا في 6و، ثم بدأ الحديث عن أدوات العلم من القلم وغيره، ثم عرض الكتب الإثني عشر في 7ظ. بحيث حصل له خلط وتقديم وتأخير.
[75] الطرطوشي، الأسرار والعبر، مخ. خزانة القصر الملكي، مراكش، تحت رقم:404، 7ظ. وهذه الفقرة قرينة أخرى على أنه أتم موسوعته كاملة، ثم قدم بين يديها بهذه المقدمة التي وصف فيها عمله بعد الفراغ منه.
مقالات ذات صلة
الخطاب المعياري عند الماوردي (ت. 450هـ/1058م) بين الفقه والفلسفة والأدب: من التأطير القانوني إلى قراءة نسقية وتاريخية
Al-Māwardī’s (d. 450/1058) Normative Discourse between Islamic Jurisprudence, Philosophy, and Adab: From a Legalistic Framing to a Systematic and Historical-Contextual Reading al-khiṭāb al-miʿyārī ʿinda al-Māwardī (d. 450/1058) bayna al-fiqh wa-l-falsafa wa-l-adab:...
نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“
Toward Terminological Unity in the Translation of The New Rhetoric Naḥwa al-waḥda al-iṣṭilāḥiyya fī tarjamat al-Mufaṣṣal fī al-ḥijāj نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“ محمد قنديلجامعة ابن طفيل، القنيطرة Mohammed Kandil Ibn Tofail University, Kénitra...
آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/922م) في النفس الإنسانية
Ārāʾ al-faylasūf Abī al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381 H/992 M) fī al-nafs al-insānīyah Abū al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381/992) on The Human Soul: A Philosophical Inquiry آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/ 922م) في النفس الإنسانية[1] بلال مدريرالأكاديمية الجهوية للتربية...
النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)
The Second Maghribi Logical Revival: Muḥammad al-Sharīf al-Tilmisānī (710–771/1310–1370) al-Nahḍa al-Manṭiqiyya al-Maghribiyya al-Thāniya:Muḥammad al-Sharīf al-Tilimsānī (710–771/1310–1370) النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)...
الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي: موقع كوكبي الزهرة وعطارد نموذجًا
The Reformist Contribution of Jābir ibn Aflaḥ al-Ishbīlī to Astronomy: Venus and Mercury as a Case Study al-Ishām al-iṣlāḥī fī al-falak li-Jābir b. Aflaḥ al-Ishbīlī: Mawqiʿ kawkabay al-Zuhra wa-ʿUṭārid namūdhajan الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي:موقع...
مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم
The Concept of Paradigm in Ibn al-Haytham's Astronomy Mafhūm al-Parādīghm min khilāl falak Ibn al-Ḥaytham مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم فتاح مكاويFatah Mekkaoui جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاسSidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez الملخص: يعتبر...
منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق
Al-Ghazālī’s Methodology in His Writings on Logic Manhaj al-Ghazālī fī al-Taʾlīf fī ʿIlm al-Manṭiq منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق محمد رويMohamed Roui جامعة عبد الملك السعديUniversité Abdelmalek Essaadi ملخص: تتناول هذه الدراسة معالم منهج أبي حامد الغزالي...
المنطق في الحضارة الإسلاميّة
المنطق في الحضارة الإسلاميّة خالد الرويهبKhaled El-Rouayheb جامعة هارفارد-كمبريدجHarvard University-Cambridge ملخص: ”المنطق في الحضارة الإسلامية“ لخالد الرويهب (جامعة هارفارد بكمبريدج) هي في الأصل محاضرة بالعربية ألقيت في مؤسسة البحث في الفلسفة العلوم في...
مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي: بواكير منظور جديد
Navigating Ambiguity: Exploring the Role of Uncertainty in the Classical Arab-Islamic Culture Makānat Al-Iltibās fī al-Thaqāfah al- ʿArabiyya al-Islāmiya Fī ʿAṣrihā al-Klāsīkī:Bawākīr Manẓūr Jadīd مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي بواكير...
أثر فلسفة ابن رشد في الكلام الأشعري المغربي: دراسة في المنجز حول فكر أبي الحجاج يوسف المكلاتي (ت.626هـ/1229م)
The Impact of Ibn Rushd's (Averroes’) Philosophy on Maghribi Ashʿarī KalāmCurrent State of Studies on al-Miklātī (d.626/1229) Athar Falsafat Ibn Rushd fī al-Kalām al-Ashʿarī al-Maghribī: Dirāsa fī al-Munajaz ḥawl Fikr Abī al-Hajjāj Yusuf al-Miklatī (626/1229) Majda...