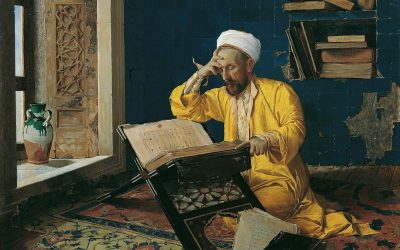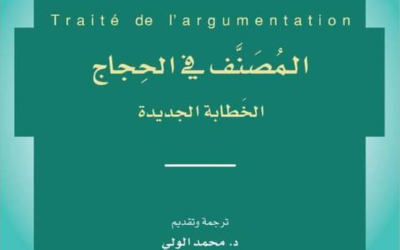![]()
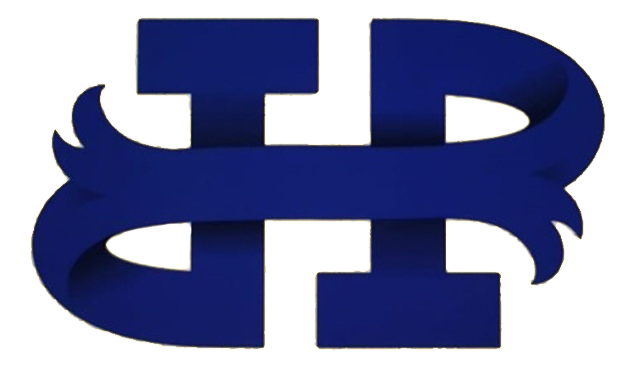
وحدة العلوم العقلية في فلسفة ابن رشد: التصور والتصديق بين المنطق وعلم النفس

Waḥdat al-ʿulūm al-ʿaqliyya fī falsafat Ibn Rushd: al-Taṣawwur wa al-taṣdīq bayn al-manṭiq wa ʿilm al-nafs
Unity of Rational Sciences in Ibn Rushd: Concept and Assent between Logic and Psychology
وحدة العلوم العقلية في فلسفة ابن رشد:
التصور والتصديق بين المنطق وعلم النفس
Abdelali Elamrani-Jamal
CNRS, Paris
عبد العلي العمراني-جمال
المركز الوطني للبحث العلمي، باريس
Abstract: From his first training, both legal and logical, Ibn Rushd’s (Averroes, d. 1198) thought appears from the beginning of his compositions to be characterized by the dominance of logical rules and method. This is manifested in his use of the fundamental notions for the various arts, on which their subjects must be based. Among these notions, those of “concept” (taṣawwur) and “assent” (taṣdīq), from which he opens the works of logic and natural philosophy to each other. At the beginning of his Compendium on Logic, Ibn Rushd defines the two notions of “concept” and “assent” to classify under them all works of logic that are specified as producing proofs of the conceptual and syllogistic type, including dialectical, demonstrative, and rhetorical proofs… Still at the beginning of his writings in natural philosophy, one finds the definition of concept and assent. And if one takes in in his account that the book of On the Soul in Aristotle’ disposition, as it is the case with Ibn Rushd after him, is in the sixth rank of the natural books, it becomes clear the crucial importance of “concept” and “assent” in what will result from the examination of dianetics and noetics in the field of theoretical intellect in Ibn Rushd’s commentaries on Aristotle’s Posterior Analytics and On The Soul. From this pairing of the notions of “concept” and “assent” at the beginning of the art of natural logic and philosophy, I will try to root the link between logic and psychological sciences according to Ibn Rushd which finally leads to metaphysics.
Keywords : Assent, concept, noetics, logic, demonstration, natural philosophy
ملخص: من تكوينه الأول، الفقهي والفلسفي معا، يبدو فكر ابن رشد منذ بداية تآليفه مطبوعا بمنهج القانون والمسطرة. ويتجلى ذلك في تناوله لمفاهيم تأسيسية لمختلف الصنائع، عليها تنبني موادها. ومن بين هذه المفاهيم، مفهوما التصور والتصديق اللذان تُفتتح بهما صناعتا المنطق والعلم الطبيعي. ففي بداية مختصره في المنطق، يحدد ابن رشد مفهومي التصور والتصديق ليرتب تحتهما—مع إدماج آليتي الموطئ والفاعل—سائر الكتب المنطقية التي تُحدَّد إما موطئة أو فاعلة للتصور ولأنواع التصديق القياسي من جدلي وبرهاني وخطبي…كذلك في مستهل كتاباته الطبيعية، نجد تحديد التصور والتصديق من التحديدات الأُول. وإذا ما استحضرنا أن كتاب النفس في ترتيب أرسطو، كما هو الشأن عند ابن رشد بعده، هو في المرتبة السادسة من الكتب الطبيعية، تظهر لنا الأهمية القصوى للتصور والتصديق فيما سينتج عند الفحص في كيفية الفكر (dianoétique)والعقل (noétique) في مجال العقل النظري في كتابي البرهان والنفس. ومن هذه الشراكة لمفهومي التصور والتصديق في مستهل صناعة المنطق والعلم الطبيعي، سنحاول تأصيل العلاقة عند ابن رشد بين المنطق والعلوم النفسية، المؤدية أخيرا إلى علم ما وراء الطبيعة.
كلمات مفتاحية: التصور، التصديق، نظرية العقل، المنطق، البرهان، علم الطبيعة.
مقدمة
من المعروف أن التقليد اليوناني المتأخر جعل من صناعة المنطق المدخل إلى الفلسفة لما رُتِّبَتْ كتب أرسطو المنطقية تحت مجموعة الأُرگانون (Organon)، على النحو الذي نعرفه حتى اليوم. وتتضمن مجموعة الأُرگانون، أي الآلة، الكتب الستة الأولى، أي: المقولات، والعبارة، ثم التحليلات الأولى، والثانية، ثم كتاب الجدل، وكتاب السفسطة. ومعلوم كذلك أن الإسكندرانيين أضافوا إلى هذه المجموعة كتابي الخطابة والشعر، وقد تبعهم العرب في هذه الإضافة.[1] وأصبحت الصناعة عند هؤلاء تشتمل على ثمانية كتب متتالية، والمنطق بكل أجزائه آلة ومدخل لسائر العلوم.
وقد قامت على مجموعة كتب المنطق تلاخيص وشروحات ومختصرات في التقليد اليوناني، ثم في التقليد العربي الإسلامي، وبعده في التقليد اللاّتيني. وقَسَّمَ ابن رشد، في مواضع متفرقة من تآليفه، العلوم إلى ثلاثة أقسام: نظرية، وعملية، وآلية. والعلوم التي تتقدم في التّعلم هي العلوم الآلية، المتمثلة في صناعة المنطق. وسنعتني، في هذا العرض، بتسليط الضوء على بعض الجوانب الجزئية التي تُّعرف بالمنطق ومقاصده عند ابن رشد، وتفيدنا بشمولية موقفه من غرض الصناعة وكيفية تأديتها للحصول على النتائج المتوخّاة من علم من العلوم، حسب الترتيب الذي أشرنا إليه.
1. مقصد بن رشد بتصنيف العلوم في الفترة الأولى من تآليفه
قبل تناول الحديث عن مفهومي التصور والتصديق وتحديد دورهما في بنية ابن رشد الفكرية، يجب أن نقف للحظة على بعض معطيات تصانيفه في سائر العلوم، خلال هذه الفترة التي تنتهي في حدود سنة 560 للهجرة.
فنذكر، أولا، أن أجناس الأقاويل التي صنف فيها بن رشد عموما متعددة[2] ما بين مختصرات وتلاخيص وشروح ومقالات ومسائل… وقد اتَّضح، بفضل الأبحاث المنشورة في الآونة الأخيرة، أن مختلف هذه الأجناس لم تكن هويتها واحدة ولا بنيتها متماثلة.[3]
تميزت الفترة المذكورة، وكأنها كانت عبارة عن طور موسوعي (phase encyclopédiste)من مسيرة ابن رشد، وهو ما تجسّد في اشتغاله بالتصنيف في سائر العلوم بمختصرات وجوامع محيطة في النحو،[4] والفقه،[5] ثم في المنطق،[6] وهو الذي سنتطرق إلى المختصر الذي وضعه فيه لاحقا، ثم جوامع الكتب الطبيعية والإلهية،[7] ثم الكتب الفلكية،[8] والطبية.[9] وتحمل كيفيةُ التأليف في كل هذه الحقول الطابعَ الشخصي لتدوين ابن رشد.
لِنأخذ، على سبيل المثال، جوامع كتاب النفس، المسمى كذلك مختصرا. نجد أن كيفية تأدية معاني الكتاب الأصلي لأرسطو تخضع لقانون تَابَع فيه ابن رشد أحد المنهجين الذين جعلهما أرسطو كفيلين بالفحص عن السؤال الجوهري حول النفس. فإنه قد يكون هو غاية الكتاب، وهو هل النفس تُفارِق أم لا؟[10] بحسب أحد المنهجين، ننظر في جوهر النفس؛ وحسب الثاني، ننظر في آثارها. وقد أخذ ابن رشد بهذا المنهج الثاني، حيث وضع أولا السؤال العام في العلم الطبيعي الذي علمُ النفس جزء منه. وهذا السؤال هو كالتالي: ”على أيّ جهة يمكن أن توجد صورة مفارقة في الهيولى إن وُجِدت؟ ومن أي المواضع والسبل يمكن أن يُوقَفَ على ذلك إن كان؟“[11] ثم يَأخُذ بالمنهج الثاني الذي رسمه أرسطو وهو أن ”تُحْصَى جميع المحمولات التي تلحق الصور الهيولانية بما هي هيولانية… ثم نتأمل جميعها. مثلا في النفس الناطقة، إذْ كانت هي التي يُظن بها من بين قوى النفس أنها تفارق. فإن ألفيناها متصفة بواحد منها، تبيَّن أنها غير مُفارقة… وكذلك نتصفح المحمولات الذاتية التي تخص الصور بما هي صور لا بما هي صور هيولانية. فإن أُلْفِى لها محمول خاص، تبيَّن أنها مُفارقة.“[12]
فهذا منهج تحليلي، وليس تفسيراً لكلام أرسطو فحسب. وقد نجد المنهج نفسه سائدا في جوامع أو مختصرات أخرى، كالذي في مختصر كتاب الخطابة.[13] وهذا المنهج التحليلي لإبراز مضامين كتب أرسطو يفضي بنا إلى ملاحظة عامة حول التقليد اللاتيني بشأن تقسيم كتب ابن رشد، الذي أخفى كيفية هذا المنهج؛ ذلك أن ناشري تراثه المترجم قد قسموا الكتب إلى أجناس ثلاثة: شروح صغرى، ومتوسطة، وكبرى. وقد بقي هذا الترتيب سائدا حتى وضع العالم اليهودي هاري ولفسون (Harry A. Wolfson) في الثلاثينات من القرن الماضي تصميمه لإعادة نشر كتب ابن رشد في صيغها الثلاث: العربية، واللاتينية، والعبرية.[14] غير أن هذا التقسيم لا يفي بمقصد ابن رشد الخاص في جنس من تصانيفه، خصوصا في فترة الجوامع؛ وفيه نوع من التحجير لفكره والإخلال بواقع هذه النصوص وتاريخها.
وسنقف على هذا بوضوح في تناوله لمواد كتب أرسطو المنطقية في مختصره لصناعة المنطق.
2. التصور والتصديق فعلان مؤسِّسَان للقوة الناطقة عند حصول العلوم في نفس الإنسان
لما بَيَّن ابن رشد وجوب قوة غير الحِسِ والخيال في ذات الإنسان تُمَكِّنُه من إدراك المعاني مجردة عن الهيولى، وهي قوة النطق، جعل فعلين أولِيين لها، هما التصور والتصديق: ”وبَيِّنٌ أن فعل هذه القوة ليس هو أن تُدرك المعنى مجرّدا عن الهيولى فقط، بل وأن تُرَكِّبَ بعضها إلى بعض… والفعل الأوّل من أفعال هذه القوة يُسمَى تصورا، والثاني تصديقا.“[15] وبهذا التركيب للمعاني واستنباط بعضها من بعض، بعدما جُرِّدَتْ عن الهيولى، ”تلتئم عن ذلك صنائع كثيرة.“[16]
3. تنظيم مواد صناعة المنطق في المختصر أو الضروري في المنطق
بعد إضافة كتابي الخطابة والشعر إلى مجموعة الأُرگانون في التقليد العربي، صارت الصنائع القياسية خمسا: صنائع برهانية، وجدلية، وسفسطائية، وخطابية، وشعرية. وحيث إن القوة الناطقة لها فعلان أوّليان، هما تجريد المعاني من الهيولى—وهو التصور—وتركيب تلك المعاني—وهو التصديق—، يفتتح ابن رشد مختصره بترتيب الصنائع الخمس حسب مستوى التصور والتصديق الذي يحتمله كل منها، فقال: ”الغرض في هذا القول تجريد الأقاويل الضرورية من صناعة المنطق في تبيين مراتب التصور والتصديق المستعملة في صناعة من الصنائع الخمس؛ أعني البرهانية والجدلية والسفسطائية والخطابية والشعرية. إذ كان هذا المقدار من هذه الصناعة هو الضروري أكثر ذلك في تعلم الصنائع التي قد كَمُلَتْ على نحو ما هو عليه في زماننا هذا أكثر الصنائع كصناعة الطب وغيرها.“[17]
يبدأ ابن رشد بتعديد المطالب المتوخاة في كل صناعة من الصنائع الفكرية، ويحصرها في صنفين، وهما: تصور الأشياء حسب تلك الصناعة، والتصديق بها حسب مرتبة تلك الصناعة في التصديق. فيحدد التصور بأنه ”تفهيم الشيء بما يُقَوِّمُ ذاته أو بما يُظَنُّ أنه يقوم ذاته، وهو المسؤول عنه أكثر ذلك، وأولا بحرف ما مثل قولنا ما هي الطبيعة وما هي النفس؛“ والتصديق بأنه ”إثبات الشيء أو نفيه، وذلك على وجهين: إما بإطلاق، مثل قولنا: هل الخلاء موجود؟ وإما بتقييد، مثل قولنا: هل العالم محدث؟ وهذا النحو من الطلب هو المسؤول عنه أبدا بحرف هل.“[18]
أضاف ابن رشد قانونا ثانيا جعله من اللوازم التي اقتضاها النظر في هذه الصناعة، وهو وجوب اقتران كل من هذين الصنفين من المعرفة بمعنيين اثنين، هما: الموطئ، والفاعل لكل منهما. فيحدد الموطئ والفاعل كلّ على حدة: ”أما الموطئ للتصور، فهو ما يدل عليه اللفظ، وأما الفاعل له فالأشياء التي يَتَقَوَّمُ بها الشيء، وهو أجزاء الحدود والحدود.“ وأما الموطئ للتصديق، ”فانحصار الصدق عند الطلب في جزءين متقابلين أو أجزاء متقابلة،“ وأما ”الفاعل له فالقياس.“[19]
ويكون ابن رشد بوضعه هذه المقدمات، قبل عرضه لمضمون كل كتاب على حدة من مجموعة كتب الأُرگانون، قد وضع تصميما عاما على جهة التحليل وتحديد هوية المنطق تندمج فيه كل المواد للصنائع الخمس التي تشملها الصناعة. ولذلك، ”انقسم النظر في هذه الصناعة باضطرار إلى هذه الأقسام الأربعة.“[20] فإن تتبعنا أجزاء المختصر وجدنا جلها بمقابل أجزاء كتب الأُرگانون. وإلى هذا انتهى ابن رشد حين أخذ يعدد مواد مختصره، حيث قال:
فلنبدأ من القول بدلالات الألفاظ على العموم، ثم نسير إلى القول في المعاني التي بها يقع التصور على الإطلاق ثم نتكلم أيضا في أصناف المتقابلات وبأي أحوال تكون متقابلات حتى ينحصر الصدق في أحدهما وبعد ذلك نتكلم في القياس على الإطلاق ثم نسير بعد ذلك إلى ما يخص تصورا تصورا وتصديقا تصديقا.[21]
فالقول في دلالات الألفاظ، وهو الموطئ للتصور، يتضمن بعض ما جاء في كتاب المقولات. وأما ”القول في المعاني التي يقع بها التصور على الإطلاق،“ وهي الفاعلة للتصور، فقد يقابل بعض ما تضمنه إيساغوجي فرفريوس، الذي كان موضوعا في التقليد اليوناني المتأخر كالمدخل لـكتاب المقولات. وأما الموطئ للتصديق، فهو القول في أصناف المتقابلات وبأي أحوال تكون متقابلات حتى ينحصر الصدق في أحدهما، ”وهو بمقابل كتاب العبارة. وأما الفاعل للتصديق فهو القياس. وبعد التكلم في القياس المطلق، وهو كتاب القياس العام، تتجزأ بقية المختصر حسب مراتب التصديق من برهاني، ثم جدلي، ثم سفسطائي، ثم خطبي، ثم شعري. وقد يوقف على هذا حسب هذا الترتيب.“[22]
يظهر من هذا التقديم التحليلي لمواد مجموعة الأُرگانون في المختصر، مع الإضافات الاختيارية من قبل ابن رشد—كعرض منطق المقاييس الشرطية الذي ليس له مقابل عند أرسطو، أو الاقتصار في عرض المقاييس التي مُقدماتُها ذوات جهة على التي مقدماتها ضرورية أو ممكنة أكثرية—أنه ليس ”شرحا صغيرا“ لأرگانون أرسطو، كما عهدنا حسب التقسيم اللاتيني؛ إذ أخلّ بالعناوين الأصلية لأجزاء المختصر، فأخفى سبيل المنهج التحليلي المقصود.[23]
4. نسبة التصور والتصديق إلى علمي النفس وما بعد الطبيعة
إن أول إشارة في الكتب المنطقية تربط المنطق بعلم النفس، وقد خَصَّتْ معنى التصور أولا، هي تلك التي جاءت في مستهل كتاب العبارة، حيث أرجأ أرسطو النظر في كيفية الربط بين المعاني التي في النفس والموجودات الخارجية إلى كتابه في النفس.[24] وقد لخّص ابن رشد تلك الإحالة بقوله: ”ولكن القول في جهة دلالة المعاني التي في النفس على الموجودات خارج النفس هو من غير هذا العلم. وقد تكلم فيه في كتاب النفس.“[25]
وتقتضي هذه الإحالة وتتضمن بالقوة كل معطيات القوة الناطقة المذكورة في كتاب النفس، والتي تُعنى بكيفية حصول معقولات الأشياء في النفس أو كيف تُتَصور بالعقل الإنساني الموجودات التي خارج النفس؟ وهذه المشكلة هي التي ظلت تشغل الفلسفة إلى زمان إمانويل كانط (Kant Emmanuel) وما بعده، وهي كيف ترتسم صور الأشياء في الذهن؟
وهذا التصور المطلوب في علم النفس ليس مغايرا للتصور الذي اعتمده ابن رشد في تبيينه لمقاصد صناعة المنطق. وليس التصوران يقالان باشتراك الاسم فقط؛ إذ مطلوبهما واحد، وهو ماهية الشيء. فالتصور يسأل عنه أبدا بحرف ”ما.“ وماهية الشيء هي بعبارة علم النفس الصورة التي ينتزعها أو يجرّدها العقل من المادة، وبها يتصور الإنسان المحسوسات التي خارج النفس.
أما التصديق، فإنه موكول، حسب تعليم كتاب العبارة، إلى القول الحملي الجازم، فهو الذي يحتمل الصدق والكذب، وهو مركب من موضوع ومحمول. والتصديقات، كما رأينا، تترتب حسب ترتيب الصنائع الخمس التي يشتمل عليها المنطق.
وعند حد التصديق البرهاني تنتهي العلوم المضطرة إلى عَامِلَيْ التصور والتصديق معا، وهي المفضية إلى المعرفة “الفكرية” فقط (dianoétique). لكن أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة يُمَيِّزُ بين الصدق والكذب في حَيِّزِ المركبات، والصدق أو الحق في حَيِّزِ البسائط، وهي العقول المفارقة.[26]
فالصدق والكذب الذي يُعَبَّر عنه بالقول الحملي الجازم يخصّ الموجودات الطبيعية. مثال ذلك بتفسير ابن رشد أنه ”إذا كان قولنا إن هذا أبيض صادقا، فالسبب في ذلك أن البياض مركب خارج النفس مع الخشب. وإذا كان قولنا إن ضلع المربع مشارك للقطر كاذبا، فسبب كذب ذلك أن الضلع مباين للقطر ومنفصل عنه خارج النفس.“[27]
أما البسائط، فلا يُعَبَّر عن صدقها بعبارة القول الحملي الجازم، حيث لا موضوع ولا محمول. وهذا نص كلام شرحه: ”قوله [أي أرسطو]: وأما التي لا تركيب فيها بأن يكون شيء أو لا يكون، فالصدق والكذب ليس كذلك يريد. وأما الأشياء المفردة البسيطة التي ليس وجودها أو عدمها موقوفا على أن يكون منها شيء أو لا يكون، كالحال في المركبات؛ فإنه ليس الصادق والكاذب الواقعان فيها كالصدق والكذب في الأشياء المركبة… لأن الصدق في البسائط أو الكذب ليس سببه التركيب الموجود خارج النفس أو الانفصال.“[28]
ومن التأويلات المعاصرة لهذا المقطع الذي شَابَهُ الغموض عند أرسطو نذكر تأويل بيير أوبينك(Pierre Aubenque) ليقرب فهمه شيء ما، حيث قال إن من شأن البسائط أن لا يمكن التعبير عنها بقول جازم، وأنها إما أن تُدْرَكَ وإما ألا تُدْرَكَ. ويتساءل أوبينك عما هي الموجودات التي تَأبَى القول الحملي، فيحتمل أن تكون موجودات إلهية حسب ورود لفظة الالهي عند أرسطو سابقا.[29]
ولدينا، في هذا الصدد، استطراد هام في شرح ابن رشد لهذا الموضع، يُعَرِّفُ فيه هذا النوع من الإدراك المخصوص بالموجودات المفارقة، حيث قال:
إن عدم تصورنا الأمور المفارقة بالعقل الإنساني هو في العقل منا في أول الأمر شبيه بالعمي في العين قبل أن يكمل العقل، وذلك برهانه أن هذا ليس يلفا لهذه القوة في وجوده الأول بل في وجوده الأخير الكامل. وهو أمر بيناه في غير ما موضع وبينا أن السعادة القصوى، وهو النظر إلى العقل المفارق، هو بقوة تحدث في العقل النظري عند كماله شبيهة بالقوة التي تحدث عند النظر إلى الألوان لا بقوة من نوع القوى الفكرية التي تُنَال بروية وفكرة لأنه ليس في العقل منا في أول الأمر إلا هو والقوة فإنه ليس الأمر كما ظن أبو بكر بن الصائغ أن ذلك شيء يُنال بفكرة.[30]
إن هذا الاستطراد يستلزم كلاما موسعا؛ إذ كان هذا الإدراك، وهو النظر إلى الألوان هو من باب الإدراك بالكيف، فهل هو نوع من الشهود الذي يجانس ما جعله أهل التصوف إدراكا ذوقيا، إذ امتزج بالإدراك العقلي كيفية ما، وهي الحاصلة في مشاهدة الالوان التي تحتمل القوة والضعف؟[31]
وقد أجاب ابن رشد عن هذه المقارنة في مختصره لعلم النفس لمّا تعرض لوصف حالة اتصال الانسان بالعقل المفارق، حيث قال:
وإذا تُؤُمِلَ كيف حال الإنسان في هذا الاتصال ظهر أنه من أعاجيب الطبيعة، وأنه يعرض له أن يكون كالمركب مما هو أزلي وفاسد، على جهة ما توجد المتوسطات بين الأجناس المناسبة، كالمتوسط بين النبات والحيوان، والحيوان والإنسان. ويكون هذا الوجود مباينا للوجود الذي يخص الإنسان بما هو إنسان، يوجد لسائر قوى النفس في تلك الحال من الدهش والبهت. وبالجملة من تعطل الأفعال الطبيعية ما يوجد حتى يقال إنه قد عرج بأرواحهم. وهي بالجملة موهبة إلهية. وهذه الحال من الاتحاد هي التي ترومها الصوفية. وبين أنهم لم يصلوها قط، إذ كان من الضروري في وصولها معرفة العلوم النظرية. وإنما يدركون من ذلك أشياء شبيهة بهذا الإدراك […] ولذلك كانت هذه الحال كأنها كمال إلهي للإنسان.[32]
في هذه الحالة من المشاهدة لا يكون إلا تصور محض، إلا أنه لا يتأتى إلا بعد كمال العقل النظري، فيصير النظر إلى المفارقات سوي عقل محض أو تصور فقط.
ويتم الوقوف عند الفكرة بتمام الصنائع البرهانية بحصول تصورٍ تام، وهو الوقوف على الحد، وتصديقٍ يقيني يتم في التصديق البرهاني، وهذا مخصوص بعالم المركبات، وهو حيّز ما دون العقل (dianoétique). أما السمو إلى العقل الذي أقصاه ومنتهاه هو النظر إلى العقل المفارق هو من حيّز العقل المحض، وهو ميدان البسائط، أي العقول المفارقة.
خلاصة
إن للتصور والتصديق مجالا واسعا في بنية فكر ابن رشد. فَرَبْطُ استعمالهما في تحديد صناعة المنطق بأُفُقِ مادة كتاب النفس، ثم العلم الإلهي، يؤكد ما اعتقده ابن رشد من تواصل العلوم العقلية ووحدتها المتكاملة وإمكانية الوقوف على نظامها الذي يعطيه نسيج أجزاء الموسوعة الأرسطية.
Bibliography
Al-ʿAlawī, Jamāl al-Dīn. Al-Matn al-Rushdī: Madkhal li qirāa jadīda. Casablanca : Toubkal, 1986.
Aouad, Maroun. “Les fondements de la Rhétorique d’Aristote reconsidérés par Averroès dans l’Abrégé de la Rhétorique ou le développemet du concept de ‘point de vue immédiat’.” In Peripatetic Rhetoric after Aristotle. Edited by William Fortenbaugh and David Mirhady. London-New Brunswick: Transaction Publishers, 1994.
Aristote. La Métaphysique, traduction par Tricot, tome 2. Paris: Vrin, 1981.
Ariṭū. Kitāb al-ʿIbāra. Translated by Isḥāq ibn Ḥunayn. Edited by Abderraḥmān Badawī. Beirut-Kuwait: Dar al-Qalam-Wakālat al-Matbuat, 1980.
Aubenque, Pierre. Le Problème de l’Être chez Aristote. Paris: PUF, 1962.
Black, Deborah. Logic and Aristotle’s Rhetoric and Poetics in Medieval Arabic Philosophy. Leiden-London: Brill, 1990.
Elamrani-Jamal, Abdelali. “Averroès, de l’Epitomé au Commentaire Moyen du De Anima, question de méthode,” in Averroes and the Aristotelian Heritage, edited by Carmela Baffioni, 121–136. Naples: Alfredo Guida Editore, 2004.
Elamrani-Jamal, Abdelali. “Averroès, le Commentateur d’Aristote?,” in Penser avec Aristote, publié par l’U.N.E.S.C.O., 643–651. Paris : éditions Erès, 1991.
Elamrani-Jamal, Abdelali. “La connaissance des simples d’après le Grand Commentaire d’Averroès à la Métaphysique d’Aristote, (Met. 10, 1051b18-1052a3).” In print.
Hasnaoui, Ahmed “La structure du corpus logique dans l’Abrégé de logique d’Averroès,” in Averroes and the Aristotelian Heritage, edited by Carmela Baffioni: 51–62. Naples: Alfredo Guida Editore 2004.
Ibn Rushd, Muḥammad Ben Aḥmad. Al-Mukhtaṣar fī al-Manṭiq (Compendium on Logic). Edited by Charles Butterworth. In print.
————. Tafsīr Mā baʿd al-Tabīʿa. Edited by Maurice Bouygues. Volume II. Beirut: Impremrie Catholique, 1969.
————. Talkhīṣ Kitāb al-ʿIbāra. Edited by Gerard Jehamy. Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnānī, 1982.
————. Talkhīṣ Kitāb al-Nafs (a Compendium). Edited by Fuʾad al-Ahwāni. Cairo: Dar al-Nahda, 1950.
Wolfson, Harry A. “Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem.” Speculum Vol. 6, No. 3 (Jul., 1931): 412–427.
Wolfson, Harry A. “Revised Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum Averrios in Aristotelem.” Speculum 38, No. 1 (Jan., 1963): 88–104.
للتوثيق
العمراني-جمال، عبد العلي. ”وحدة العلوم العقلية في فلسفة ابن رشد: التصور والتصديق بين المنطق وعلم النفس.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/3015>
عبد العلي العمراني-جمال
[1] انظر بخصوص هذه الإضافة:Deborah Black, Logic and Aristotle’s Rhetoric and Poetics in Medieval Arabic Philosophy (Leiden-London: Brill, 1990).
[2] انظر:Abdelali Elamrani-Jamal, “Averroès, le Commentateur d’Aristote?,” in Penser avec Aristote, publié par l’U.N.E.S.C.O. (Paris : éditions Erès, 1991): 643–651.
[3]انظر: جمال الدين العلوي، المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة (الدار البيضاء: توبقال للنشر، 1986). والمرحوم هو الذي نبّه على موضوع المراجعات في كتابات ابن رشد، فكانت الإفادة لإعادة ترتيبها والوقوف على تغيراتها حسب مقاصد مؤلفها.
[4] كتاب الضروري في النحو.
[5] الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي، ثم كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
[6] المختصر أو الضروري في المنطق.
[7] جوامع الكتب الطبيعية الأربعة: كتاب الطبيعة، كتاب السماء والعالم، كتاب الكون والفساد، كتاب الآثار العلوية؛ فـمـختصر كتاب النفس، وجوامع كتاب ما بعد الطبيعة.
[8] مختصر كتاب المجسطى.
[9] كتاب الكليات في الطب.
[10] انظر:Abdelali Elamrani-Jamal, “Averroès, de l’Epitomé au Commentaire Moyen du De Anima, question de méthode,” in Averroes and the Aristotelian Heritage, ed. Carmela Baffioni (Naples: Alfredo Guida Editore, 2004): 121–136.
[11] ابن رشد، تلخيص كتاب النفس (الجوامع أو المختصر)، تحقيق وتقديم أحمد فؤاد الأهواني (القاهرة: دار النهضة، 1950)، 8.
[12] ابن رشد، تلخيص كتاب النفس، 11.
[13] Cf. Maroun Aouad, “Les fondements de la Rhétorique d’Aristote reconsidérés par Averroès dans l’Abrégé de la Rhétorique ou le développemet du concept de ‘point de vue immédiat’,” in Peripatetic Rhetoric after Aristotle, eds. William Fortenbaugh and David Mirhady (London-New Brunswick: Transaction Publishers, 1994).
[14] Harry A. Wolfson, “Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem,” Speculum Vol. 6, No. 3 (Jul., 1931): 412–427; “Revised Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum Averrios in Aristotelem,” Speculum, Vol. 38, No. 1 (Jan., 1963): 88–104; Elmarani-Jamal, “Averroès le commentateur,” op. cit., 644–645.
[15] ابن رشد، مختصر كتاب النفس، 68.
[16] ابن رشد، مختصر كتاب النفس، 68.
[17] ابن رشد، المختصر، المدخل، تحقيق شارلس بترورث، قيد الطبع، فقرة 4.
[18] ابن رشد، المختصر، المدخل، تحقيق شارلس بترورث، قيد الطبع، فقرة 4.
[19] ابن رشد، المختصر، المدخل، تحقيق شارلس بترورث، قيد الطبع، فقرة 4.
[20] ابن رشد، المختصر، المدخل، تحقيق شارلس بترورث، قيد الطبع، فقرة 4.
[21] ابن رشد، المختصر، المدخل، تحقيق شارلس بترورث، قيد الطبع، فقرة 4.
[22] انظر:Elmarani-Jamal, “Averroès le commentateur,” op. cit., 646.؛ وراجع لمزيد من التفصيل مقالة أحمد حسناوي:
Ahmed Hasnaoui, “La structure du corpus logique dans l’Abrégé de logique d’Averroès,” in Averroes and the Aristotelian Heritage, ed. Carmela Baffioni (Naples: Alfredo Guida Editore 2004) : 51–62.
[23] Elamrani-Jamal, “Averroès, le Commentateur d’Aristote?,” 648.
[24] أرسطو، كتاب العبارة، نقل إسحاق بن حنين، ضمن: منطق أرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي (بيروت-الكويت: دار القلم-وكالة المطبوعات، 1980)، ج. 1، الفقرة الأولى، 99-100.
[25] ابن رشد، تلخيص كتاب العبارة، تحقيق جيرار جهامي (بيروت: دار الفكر اللبناني، 1982)، 81.
[26] أرسطو، كتاب ما بعد الطبيعة، المقالة التاسعة بترتيب الترجمة العربية، ضمن: ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق موريس بويج (بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1967) ج. 2، 1223–1230.
Aristote, La Métaphysique, trad. Tricot, t. 2 (Paris: Vrin, 1981), 521–526.
[27] أرسطو، كتاب ما بعد الطبيعة، ضمن: ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ج. 2، 1225.
[28] أرسطو، كتاب ما بعد الطبيعة، ضمن: ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ج. 2، 1225.
[29] Pierre Aubenque, Le Problème de l’Etre chez Aristote (Paris : PUF, 1962), 374: “Dans le cas du simple, de l’incomposé, la vérité ne pourra consister dans la vérité de la proposition, ou ne pas le saisir (tigein) (renvoi à Métaphys. 10, 1051b24.), ]…[ Or quels sont les êtres dont la simplicité selon le chap. 10 du livre 10 répugne à toute attribution? Aristote ne s’explique pas là-dessus. Mais la description qu’il en donne et qui est nécessairement imparfaite, puisqu’il ne peut s’agir d’attribution à proprement parler n’est pas sans évoquer un type d’être que nous avons rencontré et qui est le divin.”
[30] ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 1230.
[31] انظر مقالتنا المعدّة للطبع:Elamrani-Jamal, “La connaissance des simples d’après le Grand Commentaire d’Averroès à la Métaphysique d’Aristote, (Met. 10, 1051b18-1052a3).”
[32] ابن رشد، مختصر كتاب النفس، 95.
مقالات ذات صلة
الخطاب المعياري عند الماوردي (ت. 450هـ/1058م) بين الفقه والفلسفة والأدب: من التأطير القانوني إلى قراءة نسقية وتاريخية
Al-Māwardī’s (d. 450/1058) Normative Discourse between Islamic Jurisprudence, Philosophy, and Adab: From a Legalistic Framing to a Systematic and Historical-Contextual Reading al-khiṭāb al-miʿyārī ʿinda al-Māwardī (d. 450/1058) bayna al-fiqh wa-l-falsafa wa-l-adab:...
نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“
Toward Terminological Unity in the Translation of The New Rhetoric Naḥwa al-waḥda al-iṣṭilāḥiyya fī tarjamat al-Mufaṣṣal fī al-ḥijāj نحو الوحدة الاصطلاحية في ترجمة ”المفصّل في الحجاج“ محمد قنديلجامعة ابن طفيل، القنيطرة Mohammed Kandil Ibn Tofail University, Kénitra...
آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/922م) في النفس الإنسانية
Ārāʾ al-faylasūf Abī al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381 H/992 M) fī al-nafs al-insānīyah Abū al-Ḥasan al-ʿĀmirī (d. 381/992) on The Human Soul: A Philosophical Inquiry آراء الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت.381هـ/ 922م) في النفس الإنسانية[1] بلال مدريرالأكاديمية الجهوية للتربية...
النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)
The Second Maghribi Logical Revival: Muḥammad al-Sharīf al-Tilmisānī (710–771/1310–1370) al-Nahḍa al-Manṭiqiyya al-Maghribiyya al-Thāniya:Muḥammad al-Sharīf al-Tilimsānī (710–771/1310–1370) النهضة المنطقية المغربية الثانية: محمد الشريف التلمساني (710-771هـ/1310-1370م)...
الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي: موقع كوكبي الزهرة وعطارد نموذجًا
The Reformist Contribution of Jābir ibn Aflaḥ al-Ishbīlī to Astronomy: Venus and Mercury as a Case Study al-Ishām al-iṣlāḥī fī al-falak li-Jābir b. Aflaḥ al-Ishbīlī: Mawqiʿ kawkabay al-Zuhra wa-ʿUṭārid namūdhajan الإسهام الإصلاحي في الفلك لجابر بن أفلح الإشبيلي:موقع...
مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم
The Concept of Paradigm in Ibn al-Haytham's Astronomy Mafhūm al-Parādīghm min khilāl falak Ibn al-Ḥaytham مفهوم البراديغم من خلال فلك ابن الهيثم فتاح مكاويFatah Mekkaoui جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاسSidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez الملخص: يعتبر...
في مشروعية الكلام السني ضدا على إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت.505هـ/1111م): قطعة من موسوعة الأسرار والعبر لأبي بكر الطرطوشي (ت.520هـ/1126م)، تعريفٌ وتوصيف
On the Legitimacy of Sunni Theology against Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (d. 505/1111): A Section from Abū Bakr al-Ṭurṭūshī’s al-Asrār wa-l-ʿIbar (d. 520/1126) - Introduction and Description Fī Mashrūʿiyyat al-Kalām al-Sunnī Ḍiddan ʿalā Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn...
منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق
Al-Ghazālī’s Methodology in His Writings on Logic Manhaj al-Ghazālī fī al-Taʾlīf fī ʿIlm al-Manṭiq منهج الغزالي في التأليف في علم المنطق محمد رويMohamed Roui جامعة عبد الملك السعديUniversité Abdelmalek Essaadi ملخص: تتناول هذه الدراسة معالم منهج أبي حامد الغزالي...
المنطق في الحضارة الإسلاميّة
المنطق في الحضارة الإسلاميّة خالد الرويهبKhaled El-Rouayheb جامعة هارفارد-كمبريدجHarvard University-Cambridge ملخص: ”المنطق في الحضارة الإسلامية“ لخالد الرويهب (جامعة هارفارد بكمبريدج) هي في الأصل محاضرة بالعربية ألقيت في مؤسسة البحث في الفلسفة العلوم في...
مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي: بواكير منظور جديد
Navigating Ambiguity: Exploring the Role of Uncertainty in the Classical Arab-Islamic Culture Makānat Al-Iltibās fī al-Thaqāfah al- ʿArabiyya al-Islāmiya Fī ʿAṣrihā al-Klāsīkī:Bawākīr Manẓūr Jadīd مكانة ”الالتباس“ في الثقافة العربية الإسلامية في عصرها الكلاسيكي بواكير...